
كاظم الخليفة - ناقد سعودي | سبتمبر 1, 2024 | مقالات
لا يبدو أن أحقية «تمثيل الحقيقة» والتعبير عنها قد حسمه أفلاطون؛ عندما أقصى الشعراء من جمهوريته وجعل النطق بها، أو عنها، حصرًا على الفلاسفة. فعلاقة الفلسفة بالأدب قد تكون دافعها الحقيقي «المنافسة والغيرة»، وليس بسبب خشية أفلاطون من دخول الوهم وتفشيه في الفكر.
هذا هو الجديد في الطرح والمقاربة للحكم الأفلاطوني، الذي حاول تقديمه في مرافعته الطويلة الباحث في الأدب الفرنسي كاميل ديموليي في كتابه «الأدب والفلسفة، بهجة المعرفة والأدب»، الصادر حديثًا عن معهد تونس للترجمة، ومن ترجمة الصادق قسومة.
الفضاء المشترك
يعتقد ديموليي أن الانشقاق الذي جعل الفلسفة مقابل الشعر هو انشقاق قديم، وأنه عبارة عن خلاف موغل في القدم أعلنه سقراط في الكتاب العاشر من الجمهورية بقوله: «إنه سيصفي حسابه نهائيًّا مع الشعراء، وينفيهم من المدينة الفاضلة». أما جوهر نقد أفلاطون للفنانين والشعراء، كونهم لا يعرفون ما يقولون، ولأن الفنان هو في النتيجة «محاكٍ»، وإنتاجه بعيد من الطبيعة بثلاث درجات، حسب نظريته في المثل: الدرجة الأولى هي درجة الجوهر أو النموذج، والدرجة الثانية هي درجة النسخ أو «الأيقونة»، والدرجة الثالثة هي درجة «الصنم»، أو التلذذ المتخيل. هذه المحاكاة -حسب أفلاطون- تدخلنا ذلك العالم المكون من الصور الزائفة؛ لذا الرسام والشاعر هما ساحران صانعا وهم ليس إلا. لهذا يرى الباحث كاميل، في مقدمة كتابه، أنه آن الأوان للانتهاء من هذا الموضوع نهائيًّا، وعليه أتت فصول الكتاب محاولة لحسم هذا الجدل.
أول دحض لهذا الحكم الأفلاطوني المتعسف، حسب تتبع الباحث، أتى من أرسطو الذي عدّ جنس «المأساة» الأدبي فنًّا علاجيًّا، بينما الشكل العملي للرد، كان من السفسطائيين الذين كانوا يمثلون حكمة يُعبر عنها من خلال خطاب لا تمييز فيه ولا انفصال بين الفلسفي والشعري. وهذه الممارسة أسست لنهج فلسفي يراهن على أنه لا وجود مستقبلًا لأي خطاب فلسفي غير مشوب بالأدب وبتأثيرات الكتابة. ومن جهة أخرى، لا وجود لنص أدبي خالٍ من استعمال فلسفة ما أو أيديولوجيا معينة. وبناءً عليه، يصبح الأدب بصفته متصورًا مفهوميًّا، وبصفته ممارسة فعلية تاريخية تربط مصيره بمصير الفلسفة، ومن ذلك الالتقاء بينهما، يستمد الأدب جوهره.
وعن طبيعة هذا الالتقاء، والفضاء المشترك الذي يشتغل عليه الأدب مع الفلسفة، وعن ظروف الاقتراب والابتعاد -أحيانًا- بينهما، تأتي بقية فصول الكتاب، لتنوع على هذه الإشكالات، مستندة إلى شواهد من حقب زمنية مختلفة، مع ملاحظة مهمة يدعونا الكاتب للأخذ بها من أجل استكشاف تلك الأبعاد، وهي ضرورة أن يكون الأدب ملتفتًا إلى حركة الأفكار؛ فالحركات الأدبية الكبرى لا يمكن أن تُفهَم خارج الحوار الفلسفي في العصر المعني بالدراسة. ولتبيان هذه الإستراتيجية، يقدم الكاتب أمثلة عديدة، أحدها المثال «الباروكي».
فالحركة الفنية -الباروكية- التي بدأت في إيطاليا منتصف القرن السادس عشر، ثم انتشرت في بعض البلدان الأوربية الأخرى، وكانت تقوم على الإيغال في الزخرف، وعلى اعتبار أن الأضداد يمكن أن تكون منسجمة. فمنشأ هذه الظاهرة، يرجعه الكاتب، إلى أنه كان نتيجة لأزمة حقيقية في الوعي الأوربي؛ ساهمت في فتح الأبواب لعصر الأنوار، حيث تتمثل في الانتقال من تصور قديم للعالم قائم على رؤية عالم الفلك اليوناني بتوليمي (٩٠- ١٦٩م)، إلى تصور قائم على رؤية عالم الفلك الإيطالي غاليلي (١٥٦٤- ١٦٤٢م). أي الانتقال من رؤية خلق للعالم يمثل الإنسان غايته ومركزه، إلى قطيعة مع النظام الإلهي، كما يصف الموقف كاميل، وعندها صارت الأرض مجرد كوكب في كون لا نهائي، تأمله فيما بعد بليز باسكال برعب.
وبهذا المفهوم الجديد للكون والإنسان، ابتدع الباروكي، كما رأى دولوز، العمل الفني اللامتناهي، أو العملية اللامتناهية، حيث فتح هذا اللامتناهي عالمًا مرعبًا، مظلمًا، ولا شكل له. فلسفة الباروك قائمة على الإحساس بتدهور النظام الكوني، وبضياع القيم وبقطع العلاقة مع الله، وهذا الإحساس يتجسم في شخصيات الفن وينفخ الروح في الصور الكبرى المعبرة عن ثورة بروميثيوس. وهذا ما أدى إلى تراجع قيمة الأدب في جميع أشكاله من أثر ما طرأ على الفكر من تحولات.
تأثير متبادل
أما عن مناهج القراءة التي يمكنها فرز ما هو أدبي عما هو فلسفي، وعن وضع تصور للعلاقات التي تربط بينهما، فالمؤلف كاميل، يرى أن تذهب في اتجاهين: تأثيرات الفلاسفة في الكُتاب، وتأثير الكُتاب في الفلاسفة، التي كان تمظهرها على الأدب المقارن الذي أبرزها في ثلاث طرق: «مشاكل التلقي»، و«مسألة التأثير»، ودراسة «المقارنة بالمعنى الحصري». ولعل أعمال نيتشه كانت من أبرز الدراسات خصوبة المُطَبَّق عليها؛ وذلك لاعتبار فلسفته تجربة كتابة وحياة، وقد دُفِعَتْ إلى أقصى حدود العقل، وهذا ما جعل منه بطلًا أدبيًّا حقيقيًّا.
ثم أعقب ذلك طرائق عدة لقراءة النصوص من هذا المنظور: تأثير فيلسوف في كاتب، أو العكس. أو وجود عنصر فلسفي في أثر أدبي، أو ربما وجود فلسفة تكون فاعلة في الأثر وموجهة له، أو وجود مشهد فلسفي لعصر معين فيه يندرج النص الأدبي ويعكسه أيضًا.
لذا، عند النظر إلى العلاقة بين الفلسفة والأدب انطلاقًا من نص أدبي فإنها تطرح مسائل متعلقة بالمنهجية وبالقراءة المقارنة. ومتى نُظر إلى العنصر الفلسفي بصفته خطابًا غريبًا في النص الأدبي، يمكن أن تُسند إليه ثلاث وظائف جوهرية، كما بيّن ذلك الفيلسوف الفرنسي المعاصر بيار ماشيري، الذي ينقل عنه كاميل. وهذه الوظائف هي: أولًا «المرجعية الثقافية»، باعتبار أن الفلسفي يَظهر، بادئ ذي بدء في النص الأدبي في شكل مرجعية ثقافية، وذلك سواء تعلق الأمر بمفهوم، أو بإشارة، أو حتى باسم فيلسوف. والثاني هو «فاعل شكلي»، حسب درجة إشعاع الفلسفي في النص الأدبي، وفي هذه الحالة تكون للأطروحة الفلسفية وظيفة شعرية حقيقية. أما المظهر الثالث فيبرز من خلال «حامل رسالة نظرية»، الذي يتحقق عندما يقوى الإشعاع فيه حتى يتغلب على الأدبي ويجعل الأثر «حامل رسالة نظرية»، هي الوظيفة التي نجد خير مثال عليها في الروايات ذات الأطروحة.
أما عن «الفلسفة الضمنية» للأدب، التي هي بصدد التطور بالتوازي مع الفلسفة، كما يقول ماشيري، فهو يتبع دروبًا غير مفهومية، وينظر إلى المشاكل على نحو خاص. وبدل أن يجيب عن سؤال أو أن يطرح نظرية، فإنه يرسم خطوط حدوده، ويوجد مواد ينشر من خلالها الفكرة ويجعلها مدار تدبر. والحاصل إذن، أن الأمر متعلق هنا باعتبار الأدب بصفته فلسفة، وهذا ما ختم به ماشيري قوله بالاستنتاج التالي: «هكذا، فإنه من خلال كل ما يقوله الكُتاب أو يكتبونه، فإنهم يمارسون الأدب بهذا المعنى، أي الأدب بصفته تدبرًا، وذلك بحلوله في العنصر الفلسفي السابق لجميع الفلسفات الخاصة. فمن واجب الأدب إذن أن يطرح الفلسفي الذي في الفلسفة».
لهذا يستنتج الباحث أن الأدب هو فكرة الفلسفة وذلك بمعنيين: أولًا هو فكرتها في معنى أنها ما وضعه قبالته؛ أي أنها إبداعه أو ابتداعه. ثم إنها مدار دراسته. وهكذا لا يوجد أبدًا أدب إلا للفلسفة، وهكذا صار الأدب هو منبع الفلسفة. إنها تعود فيه وكأنها تعود إلى أصلها المَنسيّ.
كان ذلك عن الأدب، أما الفلسفة، فهي منذ أصولها الأولى كانت تستعير من أشكال متعددة للخطاب الأدبي، وهي الأشكال التي تعتبر أنها غريبة عنها: الشعر، الحوار، الأسطورة، الحكاية، القصة… إلخ. فالفلسفة إذن منذ بواكيرها كانت تتزيّا أساسًا بالخطاب الأسطوري. ومؤخرًا، جاءت الحركة الرومانسية، ونقد نيتشه؛ ليقدما محاولات جادّة في إعادة الفلسفة والأدب إلى أصلهما الشعري، حيث الفلسفة يمكن أن تكون ضربًا من الشعر المتحجر، أي خطابًا بواسطة الصور والمجازات، أو هو بمنزلة قصة مثلية نسيت طبيعتها التخييلية. وإن الفلسفة تتعرف إلى ذاتها في الوجه الآخر منها؛ في الأسطورة، وفي الحكاية، وفي الأدب. والمفارقة أن الفلسفة كانت تفكر دائمًا ضد هذه الأشكال من الخطاب والإبداع، والآن صارت تفكر معها، بشرط أن تكون خواتمها دقيقة وألّا تحجّر الأدب لكي تجد مجددًا تفوقها عليه.
يختتم الكاتب في فصله الأخير، بأن الحقيقة تُحدد بكونها ثغرة في المعنى، وعليه فاللجوء إلى القصيدة هدفه احتلال المكان الشاغر، وإن المآل النثري للأدب يرافق مآلًا نثريًّا للعالم الذي عملت عليه الفلسفة، وأن هذا العالم هو ما نقوله عنه، وهو متخيلنا؛ لذا يدرج باحثنا الفرنسي كاميل ديموليي، مقولة للأديب والناقد الأميركي المعاصر كراولي، ونختم بها: «هذا يعني أنه بدل أن نقرأ الرواية بوصفها تصويرًا لفلسفة، يجب أن نقرأ الفلسفة بوصفها تعبيرًا عن منطق قصة».

كاظم الخليفة - ناقد سعودي | سبتمبر 1, 2023 | مقالات
تتجلى القصيدة الحديثة -النثرية- وتفصح عن ذاتها دون مواربة متى ما كانت مواضيعها الشعرية متماهية مع ذات الشاعر المبدعة. ذلك في النظرة المتأنية الفاحصة، أما في المطالعة الأولى، فتبدو مخاتلة تتقافز معانيها في سماء المجاز وتتشتت بعيدًا من مستوى أفق القراءة المتوقع الذي يطول انتظاره حسب ما تفترضه «نظرية الاستقبال والتلقي» لياوس وآيزر. ذلك دون الجري وراء مفاهيم إحالاتها؛ التي تتنوع على رموز ونصوص أخرى تمعن في التناص معها في دوائر متصلة بالمعنى العام المراد التعبير عنه شعريًّا.
فقوى الجذب في القصيدة الحديثة تعمل على استبطان الوجود بحَفْزِ الجانب الرؤيوي للشاعر وإدخاله في مغامرات متصلة السلسلة عند غوصه في قضايا الوجود؛ بإحداث بلبلة حادة في حواسه، وبالانغماس المقصود في كل تجربة حسية وجدانية ممكنة، حتى يتسنى له معرفة الحقيقة الجوهرية الكامنة وراء الظواهر الخارجية والتعبير عنها كما يقول رامبو. حتى يصل إلى ذلك، عليه أن يصبح «بروميثيوسَ» جديدًا يسرق النار الخالدة حقًّا لا خيالًا، وأن يصبح بين الناس المريض الأكبر والمجرم الأكبر والملعون الأكبر، والرائي الأعظم، ذلك لأنه يصل إلى المجهول عندما يصيبه مس الجنون ويبوء بالعجز عن فهم رؤاه تكون هذه الرؤى قد أصبحت ملكة لديه.. هكذا يستكمل رامبو رؤيته.
التفاعل والانفعال
من جهة أخرى، تدفع القصيدة الحديثة باتجاه رفع منسوب التوتر والتأزيم من خلال تركيزها على ممارسة «الاستبطان»، أي التأمل الذاتي الباطني كنوع من الإدراك، مقابل الملاحظة الخارجية الفيزيائية. وفيها يصل الشاعر إلى «حالاته الذهنية الخاصة دون وجود وساطة من مصادر المعرفة الأخرى»، وهو ما يمكن نسبته -كممارسة- إلى تعريفات التصوف؛ كالكشف أو التصوف الباطني، والذي يمكن مقاربته من خلال تعبيرات هيغل عن «التصوف الفلسفي» بوصفه الحد الثالث في القياس المنطقي، حيث: «الحد الأول هو دين الحرية الداخلية، والحد الثاني هو فلسفة العقل الحججي».
هذه النزعة المدهشة لتوجه الشاعر الحديث بتفعيل ملكاته وتركيزها على التفاعل والانفعال مع قضايا الوجود بالتحامه واشتباكه المباشر مع ما يجلبه إليه من أسئلة واستحقاقات، هو مطمح الشعر؛ لذلك يعزز هذه الرؤية عالِم الأديان المقارن ولتر ستيس بإبرازها وإفراده مكانًا واسعًا ومريحًا للشعر بنظريته عن «الحقيقة الشعرية» التي يرى فيها «أن هناك معنى آخر للحقيقة، وهذه الحقيقة يمتلك الشعر ناصيتها -وربما صور أخرى من الفن- وأن الدين والتصوف يمتلكان مثل هذا النوع من الحقيقة».
فالوصول إلى تلك اللحظة الفريدة من الانكشاف الوجودي والقبض عليها وتفعيلها باستدامتها في عمل إبداعي، هي النشوة التي قفزت بالرسام الألماني بول كلي خارج أسوار الذات نحو فضاء خاص من التجربة لا يحدها زمان أو مكان، ليتوحد حينها مع موضوعه «لوحته»، ويصدح بمقولته اللافتة: «اللون وأنا لا نشكّل سوى واحدٍ. أنا اليوم فنان». ومن هذه اللحظة الإبداعية الكاشفة، وبهذا المنظور المفاهيمي أيضًا، نختط مقاربتنا لنصوص الشاعر التونسي رضوان العجرودي في ديوانه: «رأس يطل من نافذتين»، الصادر من خلال سلسلة الإبداع العربي بالقاهرة، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2022م.
القبض على شيفرة الكون
من خلال مقدمتنا التي طالت نوعًا ما، يحق لنا القول: إن الشعراء ميتافيزيقيون متى ما أرادوا للقصيدة أن تكون صوتًا موازيًا يحاكي ذبذبات الكون ويتناغم مع هرمونيته؛ ذلك بالكشف عن المعنى الثاوي والمبثوث في أرجائه، وبتصعيد طموحاتهم في جذب بعض رموزه وتجسيدها من خلال اللغة في لحظة «وجد» صوفية، يشرعون حروفهم، ويجلون مراياتهم؛ للقبض على تلك الخيالات المنعكسة التي يحسبونها شفرة الكون. فالاقتراب من تلك المحاولة هو بمنزلة تحريك جزء بسيط من ترس الساعة أو الزنبرك؛ ليتدافع بعده كل شيء في حركة سريعة منتظمة تطال الأجزاء الميكانيكية جميعها لإظهار الوقت. وفي القصيدة الصوفية تكون البداية في الولوج إلى عالم الحقيقة الشعري؛ «حين تبدو اللغة بالنسبة للعالم موضوعًا ومحمولًا في آن واحد. فالعالم هو اللغة بوصفها كشفًا وإظهارًا، واللغة هي العالم بوصفه انكشافًا وظهورًا للوعي»، كما يقول عاطف جودة نصر.
الشاعر رضوان العجرودي عند نص «في عالم الميكرو-أشياء» ينصب المرايا حتى يستقطب الضوء الذي يلوح له من بعيد ولا يعرف كنهه؛ سوى بمقولات وأفكار حفظها من موروثه:
«أقنعوني بأن كل شيءٍ ضئيل نافعٌ/ ظلُّ ضوءٍ آخر النفق. رفةُ أسهم حادة في بورصة المهربين. رفرفة فراشة في سواد صدري/ اقتنعت وحدي بالتضاؤل. أتجزّأُ بالوهم حتى أصير غبارًا. تدمع مني عين العدم، ويفرك عينيه ويمضي».
يفر منه الضوء الذي يكسب الأشياء معناها ولا يستطيع حبسه، ثم يتهيأ ثانية بعد أن ينسى كل شيء، ويخوض تجربته الوجدانية الخاصة بمعزل عن معارفه وبعد كنسه للمقولات التي احتلت وعيه حسب تعبير كولون ولسون، وبمجاهدة روحية مضنية وحثيثة حتى يصل: «كنت، وأنا أتردد بسرعة موجة في الثانية، آخرَ صورة يابسة ظهرت لبحارة، وصدى صوت نورس في أذن الغريق. كتبوا اسمي بشيفرةٍ رياضيةٍ/ وقالوا: أخرجوه/ سيكون غيمتنا في قيظ الفكرة».
هذا التذاهن الخاص مع الكون لفك شيفرته، وتلك التجربة الروحية التي ترى في ذرة الضوء المتناهية الصغر حياة، هي بالضبط ما أوحت لبعض الفلاسفة المعاصرين أن يروا في «الإلكترون عارفًا بسيطًا»، أو في «النفس ظاهرة كوانتية احتمالية». وأيضًا يمكننا ربط جملة «الشيفرة الرياضية» في نص الشاعر العجرودي بفلسفة فيثاغورس عندما يرى أن في علم الحساب تتمثل الأعداد كأشياء روحانية مجردة، ورموزها ليس لها وجود مستقل عن الأشياء التي تصفها. وهذا ما ذهب إليه الشاعر غوته في تأكيده الروحَ الكونية التي تتحرك الأشياء من خلالها وبإرادتها على أنها أعظم منحة تتلقاها الحياة: «وهذه الحركة الدائرية التي تقوم بها الذرة الروحية حول نفسها، والتي لا تعرف هدوءًا ولا راحة…».
التصوف والميكانيكا
تجربة النص الروحية هذه تنقلنا مباشرة إلى نص الشاعر الآخر «الميكانيكا والتصوف»، وبعد نضج تجربته ووعيه الروحي. فالشاعر، ومن خلال الحقيقة الشعرية، أصبحت لديه القدرة على تحديد منظور الرؤية للوصول إلى الحقيقة، أو المطلق، أو الروح الكونية، ويستطيع أيضًا فرز الحقول المعرفية والأنشطة الإنسانية في مسعاها باكتشافها واستبطان معانيها. ففي هذا النص، يرى في العلوم التجريبية التي تتواصل مع الكون من خلال الفيزياء، أو ما أسماه في نصه السابق «بالشيفرة الرياضية»، بوصفها مسعى روحانيًّا وتجربة تنطلق من «العالم إلى الذات»:
«الكلّ يذهَب نحو الفراغ. ميكانيكيون يَقودُهم ستيف جوبز بلباسه الأَسود المعتاد، قاضِمًا تفاحة سقطت من جيب آدم. آينشتاين بغُبار الطبشور تاركًا شُعاعًا وراءه، يراه المنجّمون مجرةً. هوكينغ وسط حشدٍ من لاهوتيين يُتمتمُ خَوارِزميةً تَدور بها عجلاتُ كُرسيهِ، والخلائق تُؤمِّن لدُعائه. تيسلا المجنون يَركض حافِيًا يمسك بيَد ابن فرناس ويَقفِزان من تحت أعينِ المخابرات. منهم من انطلق بسرعة فهد وآرونَ ببطء سلحفاة. خمسون ألفًا من الملائكة العِظامِ محشورون في قرص مضغوط وأفواههم فاغرة».
وعندما يغير من زاوية الرؤية، ومن خلال الانطلاق من «الذات إلى العالم»، يكتشف أن الحقيقة يمكنها الانكشاف أيضًا على من يزاولون المعرفة النظرية، والفنانين والشعراء، والمنهمكين بالفلسفة والعلوم الإنسانية، حيث يقتربون منها ويصلون إلى جوانب أخرى منها:
 «المتصوفة فئة لا تتحرّك. يَرسُمون بمَخالبِهم على الرمل ويَكسرون جوز الهند بقَواقعِ يَقينهم. نيتشه بينهم، يرفرف بشاربهِ الكث… رابعة العدويّة تَنشّ سِرب نجومٍ نَحو مرعى فَلكِيّ.هؤلاء لن يصلوا بمنطق الفيزياء؛ لأنّ الأجرام تَتحرّكُ نحوهم».
«المتصوفة فئة لا تتحرّك. يَرسُمون بمَخالبِهم على الرمل ويَكسرون جوز الهند بقَواقعِ يَقينهم. نيتشه بينهم، يرفرف بشاربهِ الكث… رابعة العدويّة تَنشّ سِرب نجومٍ نَحو مرعى فَلكِيّ.هؤلاء لن يصلوا بمنطق الفيزياء؛ لأنّ الأجرام تَتحرّكُ نحوهم».
كلتا التجربتين تنجحان في مسعاهما للوصول إلى الحقيقة، وأيضًا يرى العجرودي أنه من خلال مجاهداته وانفعاله مع العالم وتذاهنه مع قواه الكونية استطاع الوصول، ليس من خلال الشعر وحده، إنما بتجربته الخاصة بالتنقل بين الوسائل والانصهار في الهم الوجودي الذي يصله بالمعنى العام للحقيقة: «أَنت أيضًا تُريدُ أن تَذهب نَحو الفراغ، لكن لا طاقَة ميكانيكية لتَدفعكَ ولا يَقين تُقايِضهُ بالمسافة. تَنفُض بُرنُسكَ. تَفترشه لمئة عام بلا رغبة في النظر. يَتقَوقعُ ظهركَ. تتحجّرُ. حينها يقدح عظامك وتنفجر لتبدأ رحلتك».
إذن، كانت هذه البداية الروحية التي انطلق الشاعر العجرودي منها؛ فهو لا يبرح بالتنويع على شرحها وتبيانها، ويمعن في وصفها من زاويا مفاهيمية عديدة، كما في نصه «قصيدة آسنة». فقبل الاستنارة ليس ما بعدها، حيث تتبدل المفاهيم وصور الوجود وينتفي عنها اللون الباهت، والمعنى الزائف للوجود الظاهري:
«فيما مضى/ كانت الدماء شفافة بلا لون ولا رائحة. الأشجار زرقاء بأوراق بيضاء، السماء/ صفراء وغروبها أخضر/ كان العدم ورديًّا والحقيقة حمراء. وسط هذا الزخم لم أَرَ دمائي تنزف. والكدمات في جسدي بعد طول السنين ظننتها أشجارًا وشيبي أوراقها».
أما بعد استنارته وامتلاكه أدوات الوصول إلى الحقيقة، فيمكننا وبوضوح تتبع هذا الأثر والنتيجة التي أحدثتها تجربة الحقيقة الشعرية واستلال المعنى الرفيع لمفهوم التصوف الشعري:
«صوتك الآن تتبعه حمرة الحقيقة المخجلة/ وهو يرفل في ثوب من سنابل. بهذا كله اكتشفت أني بركة راكدة/ لا أحد يهتم لها/ لكني أعكس صورتك كاملة».
وأيضًا لنا أن نلمح هذا المعنى الصوفي، الذي يلوح لنا في أفق ديوان الشاعر، عندما قارب مفهوم «الولادة الثانية» الصوفي في نصه «الولادة بلا قابلة» الذي يشير فيه إلى أن إرهاصات الحضور الأول لنا في العالم، وما التصق به من أثر التربية والبيئة والثقافة السائدة، مَثّلَ «الولادة الأولى»:
«قذفتنا أمهاتنا خارج أرحامهن كما تخرج حبة الفوشار. نتدحرج منذ ذلك الوقت. تدحرجنا في الشوارع والمدارس. تدحرجنا على مدارج الجامعات. في الأزقة والطرق المهجورة. في مرثيات الخنساء، في أغاني الراي وضحكات حبيباتنا، في خطابات الساسة ودعاء الأئمة، في لعبة الغيب».
انعطافة وجودية للروح
والولادة الثانية -باعتبار الأولى ولادة بيولوجية وتنشئة- تُعَدُّ انبعاثًا روحيًّا خالصًا أنضجه لهيب الروح لحظة اشتعالها بتعالقها مع المطلق. وفي اللحظة هذه ترتفع الأنا لتلقي نظرة إلى الخلف على العالم بوصفه قديمًا فوضويًّا بكل مظاهره ومقولاته. هذه الولادة هي لحظة الحقيقة التي يتصالح فيها الصوفي مع عالمه السابق، ويغض النظر عن الاتهامات والنعوت التي يكيلها له رجالات «الدين المؤسسي» باعتبار من يعتنق هذه الطريقة مهرطقة: «ثم. تكورنا حتى رجع الكلام إلى الحلق/ وصرنا نطعن أنفسنا من الخلف ونقول للعدو اقترب كي نحتضنك بحرارة».
لا يفتأ الشاعر العجرودي في مجموعة نصوصه الصوفية التنويع على وصف مرحلة الترقي والعروج، أو دهشة الحقيقة التي مر بها، وليس ذلك سوى أنها تمثل الانعطافة الوجودية لكيانه الروحي كما في نصه «حج المنسيين». فبعدما أسس الحلاج لمفهوم الحج الصوفي، أصبحت الطقوس الشعائرية في الثقافة الصوفية رمزية لا تؤخذ بحرفيتها، بل وسعت من مدلولها للوصول إلى قيمتها الرفيعة بأشد المعاني تطرفًا في اللغة، كقول الحلاج: «للناس حجٌّ ولي حج إلى سكني تهدى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي».
الشاعر العجرودي يمضي على النسق الثقافي الصوفي نفسه ويرتحل بروحه إلى عوالم ميتافيزيقية: «يرحلُ. حمل أرضه على كتفيه. مشى فوق الماء بخفة راهب بوذي/ وسرب أسماك تتدافع عند قدميه. حل الليل بين كتفيه عندما كانت أرضه مشرقة. من جذور الأشجار المداعبة لأنفه يمتص ماءه. خبأ الزواحف في تموجات شعره. مشى طويلًا/ حتى نسي أن عليه أن يسكن فوق الأرض لا تحتها/ حين زفرت عظامه من التعب، والتهمت البراكين الأخضر واليابس، تكور».
بعد هذه التهيئة الروحية والتجرد من المادة التي تشده إلى العالم الفيزيقي، يبدأ ارتحاله نحو العالم الماورائي ويسلك في النظام الكوني بعد توحده معه. طواف ينتظم ويتناغم مع الروح الكونية:
«صارت حركته دورانًا بنسق فلكيّ/ ودموعه تهوي كالشهب حيث لا أحد ينتظرها. أين سيمطر؟ ويطلق ولو أمنية لعودته».
أمنية العودة التي تمناها الشاعر بعد ترقيه الروحي على سلم الوجود تصبح مستحيلة كما وجده المتصوف الأعظم ابن عربي، وبعد أن رمى الشاعر بسلم «فتغنشتين» وقطع ارتباطاته بعالمه القديم الذي لا يمكن الرجوع إليه كما يؤكد الحلاج معنى القطيعة الوجودية: «ما رجع من رجع إلا عن الطريق، فأما الواصلون فإنهم لا يرجعون».
يد الطمأنينة
بعد هذه الرحلة الطويلة من سلوكيات المريد المترقي في سلم العرفان، تستقر الروح القلقة لدى الشاعر، وينتشي بالظفر وتحقيق وجوده في الكون وتوحده مع روحه، فيأتي نصه «التجرد من بردة الدم» كعلامة للحبور المتحصل من تجربته: «مُنتَفِخًا بالوهمِ والحُب/مثْلَ صوفي يلبس بُردَتهُ في يوم قائظ/ اشتعلت روحي حتى صارت بُردتي مِنطادًا/ارتفعتُ/ظلّي يَتسعُ/ويدُ الطُّمأنينة تُلوّحُ لي».
الطمأنينة التي يشير إليها الشاعر، لا تجعله ينكفئ على الذات ويتخلى عن مسؤوليات الكائن إزاء استحقاقات الوجود، بل ينصهر في أتون قضاياه الوجودية وينفعل معها لكنه يصبح مزودًا بأدوات ومناظير مختلفة تتيح له التعامل معها وفق ما تمليه عليه روحه الجديدة: «أتبَعُ سيْرَ خيط بَخورٍ/ومُواءَ روحٍ سابِعةٍ/من هُنا أرى تصدُّع الأفئِدةِ في أراضي اليَقين/عاليًا وفي نِهايةِ نَوبةِ العِشق/كَدستُ أثقالًا لِتخفُتَ روحي وأنزِلَ/وكُلما رميتُ ثقلًا زدتُ ارتفاعًا/هل أنا محلَّقٌ أم غَريق».
وهكذا، بأسمال بالية وجرة ماء، يبدأ المتصوف رحلته ميممًا نحو النور؛ لا ينقصه شيء، وليس لديه رغبة في القيام بأي فعل سوى تتبع تلك الومضة التي تسطع من قاع المخيلة. تغرقه بفيضها وتحتويه بكله عند التماس مع المطلق. وهنا يبدأ الشاعر العجرودي تراتيله على شكل همس رقيق حتى لا يوقظ العقل من سباته، فيترنم العجرودي بهذا الإنشاد: «برفق همد رأسي على ركبتك. شطآنك الفضيةُ كانت مناراتي. وخضرةُ الوشم جزرٌ مهجورةٌ. ضحكتك كان صوت رعدٍ يداعب شعري/ ومطر وجيك يطفئ حرائقي».
بهذه الترنيمة يمكننا اختتام القراءة على مجموعة نصوص الشاعر رضوان العجرودي الصوفية، التي انتقينا بعضها كنماذج من أجل الاطلاع على تجربته الروحية وطريقة انسيابها بأشكالها التعبيرية في لغته الشعرية. وهي كما رأينا لا تتبنى المفهوم الانسحابي والانعزال عن العالم؛ بل تهيأ له التكيف مع حياته وتجعله يتحمل المسؤولية عن جميع تصرفاته، ويتمكن من خلالها من إضفاء المعنى على العالم المحيط من حوله.

كاظم الخليفة - ناقد سعودي | يناير 1, 2023 | مقالات
ينجح الشاعر حيدر العبدالله دائمًا في استثارة وعيه الشعري من خلال استنهاض موروث الشعر العربي والدفع به باتجاه المعاصرة للتعبير عما يفرضه من استحقاقات ثقافية تلحّ على استحداث معانٍ ورؤى تشتبك مع الحاضر وتجيب عن أسئلته وطبيعة ارتباط الفرد بالعالم من خلال القول الشعري. ولعل أحد منابع الجدل المثار دومًا حول نصوص حيدر هو الإطار العام المحدد لمشروعه الشعري، والمتمثل في الولوج إلى عوالم الحداثة الشعرية بمدارسها المختلفة، وتقبلها بشرط الإبقاء على تقاليد الموروث الشعري في حده الأدنى، كعدم الخروج على بحور الشعر العربية. وفيما عدا ذلك، فإن حيدر يعمل على تثوير اللغة والانطلاق بها إلى فضاءات رحبة في عالم المعنى، محمولة بهواجس الإنسان الحديث ومشاعره وتطلعاته. أوجد فعل المراوحةِ هذا التباسًا في ذوق المتلقي الكلاسيكي، ومن جانب آخر لم يلامس برضا تام ذائقة وتطلعات الحداثي. لكن هذا لا ينفي نزعة التجديد الأصيلة في مفهومه للشعر التي ينجح غالبًا فيها، وهي شاعرية أخرى تضاف إلى سمات مشروعه الشعري.
التوحد مع الطبيعة
فعند النظرِ إلى تجربته الجديدة المتمثلة في كتاب «مهاكاة ذي الرمة- أطروحة الهايكو العربي» التي يقدم من خلالها لونًا شعريًّا حديثًا، ويجاهد في تبيئته وربطه بما يشابهه، إنْ بالمعنى، والمتمثل في المرجعية الفكرية عندما قرّبه من الصوفية وأشعار ذي الرمة، أو بالمبنى، عبر إرساء قواعد نظمه على بعض بحور الشعرِ الخليلية وتهيئة استيعابها له. وبذلك استطاع حيدر التمهيد لمشروع التبيئة بمرافعة استباقية ضمّنها جميع الإشكالات الممكن إشهارها في وجه مشروعه، وعمل على إبراز شعرية الطبيعة لدى ذي الرمة، الذي لم يمارس التنظير الصوفي- الفلسفي، بل من خلال التصوف العملي وعبر ذوبانه في الطبيعة وممارسته للتوحد مع كائناتها. ومن جانب آخر، سعى حيدر إلى ربط التصوف الإسلامي بالتصوف البوذي، بغرض المماثلة مع فلسفة الزن الموحية بكتابة هذا اللون الشعري.
يمكننا العبور إلى عالم قصيدة الهايكو اليابانية، من خلال الشعر الآسيوي عامة، وعبر منظور الأميركي «أرشيبالد مكليش» خاصة، عندما قارب مفهوم الشعر عند لوتشي، الشاعر الصيني القديم، في قصائده النثرية المطولة المسماة بالصينية «فو»، التي يقول في إحداها: «يجلسُ الشاعرُ على محورِ الأشياءِ ويتأملُ في سرِّ الكونِ، ويغذي عواطفه وعقله على مآثرِ الماضي العظيمة. وإذ يتقلبُ مع الفصولِ الأربعةِ، يتنهدُ لمرورِ الزمنِ. وإذ ينظرُ إلى ملايينِ الأشياءِ، يفكرُ في تعقيدِ هذا العالمِ. فيحزنُ لتساقطِ الأوراقِ في الخريفِ المفعمِ عنفوانًا. وتملؤهُ غبطةُ أكمامِ الزهرِ الناعمةِ في الربيعِ العطرِ. ويعاني البرودةَ وقلبُهُ حافلٌ بالرهبةِ».
حسب مكليش، فإن ميلاد قصيدة بالنسبة إلى لوتشي لا يتضمن قطبًا كهربائيًّا واحدًا مغروزًا في أعماق حوامض الذات، بل قطبين اثنين هما الإنسان والعالم إزاءه. وموقع الإنسان عند هذا التوحد يكون على محور الأشياء ويواجه سر الكون ليرى العالم، كما في قصيدة لوتشي. «فنّ الشاعرِ طريقٌ للمعنى- طريقٌ تجعلُ العالمَ يعني شيئًا»، وتجعله متجانسًا من ناحيةٍ ثانيةٍ؛ حيث الغاية القصوى من الشعرِ كما يراها فان س. لويس تنبع من إدراك الشاعر لوجود علاقة عامة تكمن تحت الظواهر وتنتظمها جميعًا. فخيال الشاعر «أشدُّ المواهب علمية، إنه وحده الذي يفهمُ التجانسَ الكوني»، كما يقولُ الشاعرُ الفرنسي شارل بودلير، وبتوظيف الاستعارة تتقاطع الأشياء غير المتجانسة مع بعضها، وتتلامس في فضاء الطبيعة من خلال الخيال الشعري.
وبالعودة إلى آخر جملة من نص لوتشي السابق: «وإذا اهتزّ الشاعر هزةَ المنفعلِ، رمى بالكتبِ بعيدًا، وتناولَ ريشتَهُ ليعبّرَ عن نفسهِ في كلماتٍ»، نستطيع الولوج إلى تجربة الشاعر حيدر العبدالله في مقاربته لقصيدة الهايكو، بعد أن رمى كتابَي الشعر لكل من «باشو»، الذي يعد أعظم من كتب هذا اللون الشعري في اليابان، وديوان ذي الرمة، الذي قارب شعر الطبيعة في نصوصه العربية؛ لنستطلع الأفق الشعري وما تمخضت عنه تجربته.
تبيئة الهايكو عربيًّا
بنى حيدر مشروع تبيئة الهايكو عربيًّا على ثلاث قواعد: التوحد مع الطبيعة كنزعة لها ما يمدها من استشهادات في شعر العرب- ومثالها شعر ذي الرمة، والتصوف من خلال اختزال الخصائص المشتركة بين الزن والتصوف الإسلامي إلى خمس سمات كبرى هي: الزهد، والتأمل، والوجد، والفناء، والرضا، والقاعدة الثالثة هي الإيقاع، إضافة إلى دليل ابتكره كتقويم شعري عربي ومعجم من القرائن الفصلية للهايكو وفقًا لعلم الأنواء العربية، مماثل لما يعتمد عليه الهكاة اليابانيون من تقاويم شعرية معدة مسبقًا، تجمع وتصنف القرائن الموسمية الخاصة ببلادهم، وتوفر عليهم مجهود البحث عن قرينة جديدة كل مرة.
ولقياس مدى نجاح حيدر في تطبيقاته ومقدرته على تبيئة الهايكو عربيًّا يمكننا الذهاب إلى «دفتر المهاكاة» الذي يحوي مئة بيت هايكو تستلهم وتحاكي أشعار ذي الرمة؛ لنستحضر منه بعض النماذج:
قال الشاعر الياباني باشو: «زهرة الخزامى/ على جانب الطريق/ تأكلها الفرس»، وفي معنى شعري آخر، قال الشاعر العربي ذو الرمة: «وريحِ الخُزامى رشّها الطلُّ بعدما/ دنا الليلُ حتى مسّها بالقوادمِ»، أما حيدر فيباين بين هذين النصين بقوله: «إذا كانت فرس باشو معجبة بطعم الخزامى، فإن ذا الرمة معجب برائحتها»، ثم يحاول التناص معهما عبر الاستدراك عليهما، باعتبار أن الأقحوانة البيضاء ليست كأسنان (مية) حبيبة ذي الرمة، وليست أيضًا ما يرمي إليه باشو، فحيدر لا يعرف تمامًا ما الذي مس الخزامى بالقوادم في ساعة الغروب، أهو الطل أم الليل، وأيهما كان أسبق إلى مس الخزامى؟ فيكتب بيت الهايكو الخاص به هكذا: «خزامى/ يعتريها الليلُ والطلُّ/ قاطبةً».
ولنا أن نعرض مثالًا آخر، يهاكي فيه حيدر ذا الرمة مباشرة، المثال الذي يصف فيه ذو الرمة علاقة الراحلة براكبها، ومدى التوافق والتفاهم بينهما: «تُصغي إذا شدّها بالكور جانحةً/ حتى إذا ما استوى في غرْزها تثبُ»، وجاءت مهاكاة حيدر له: «مُسافرٌ لم يُودّع بعدُ/ ناقتُهُ/ عجلى بهِ».
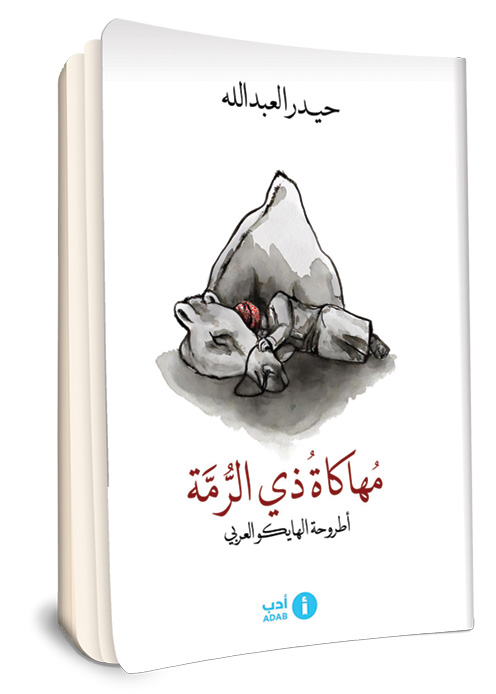 أما في تجربته لإنشاء المهاكاة من دون تناص، وفي شرحه لتطبيق الهايكو على بحور الشعر العربية، نجده يكتب على بحر الوافر: «خزامى / يعتريها الليل والطل/ قاطبة»، وعند المهاكاة على بحر الرمل: «بين أسنانيَ رملٌ/ كمأةً/ كان عشائي»، والمثال الثالث على البحر السريع: «ليسكت الحادي/ تغذُّ المسير/ ناقةٌ». وفي حالة ما أسماه بالبحر «المرسل» أو البحر المنثور بلا تفاعيل، فهو يضع النموذج التالي من نص للشاعر سامح درويش: «على حافة البِئرِ/ الدَلوُ/ يَملؤُهُ المَطَرُ».
أما في تجربته لإنشاء المهاكاة من دون تناص، وفي شرحه لتطبيق الهايكو على بحور الشعر العربية، نجده يكتب على بحر الوافر: «خزامى / يعتريها الليل والطل/ قاطبة»، وعند المهاكاة على بحر الرمل: «بين أسنانيَ رملٌ/ كمأةً/ كان عشائي»، والمثال الثالث على البحر السريع: «ليسكت الحادي/ تغذُّ المسير/ ناقةٌ». وفي حالة ما أسماه بالبحر «المرسل» أو البحر المنثور بلا تفاعيل، فهو يضع النموذج التالي من نص للشاعر سامح درويش: «على حافة البِئرِ/ الدَلوُ/ يَملؤُهُ المَطَرُ».
وعندما نتفحص هذه النماذج، نجدُ أن حيدر العبدالله قد اجتهد في تقديم الهايكو كجنس أدبي يمكن المضي في كتابته عربيًّا، وابتدع خريطة طريق ومنهجًا حرص على تفصيل قواعده، وقدمه باعتباره مرحلة تجريبية يمكن البناء عليها. وما يُجيّر إليه بحقٍّ، هو التزامه في أغلب نماذجه الكتابية بأسلوب الهايكو وقواعده الشعرية: كالاعتماد على الجُمَل الناقصة التي تكون في أغلبها اسمية، وتوظيفه للحواس، واستناده على الأبعاد الرمزية والسريالية والتجريدية، وأيضًا اتباعه للأسلوبين الحسي والرؤيوي كأساليب شعرية معبرة.
هذا عندما نتجاوز فرضية التشابكات الصوفية وتقاطعاتها التي تحتاج إلى تنظير أكبر ومراجعة لا يتيحها موضوع الكتاب؛ لأن الزن يقتبس من الطبيعة جذوة توحده مع عناصر الحياة وفاعليتها، بينما التصوف الإسلامي، وإن قارب الطبيعة من خلال مرموزات تشير إليها، فإنه ينفعل أكثر مع الخيال باعتبارهِ «هيولى جميع العالم، وحياة روحه، وأصل الوجود»، كما يقرُّ بذلك عبدالكريم الجيلي وابن عربي. أي أن الخيال هو ما يعادل «الوساطة» في فلسفة هيغل، وهو المتوسط بين الوجود والعدم، كون الإنسان وحده كونًا صغيرًا: «جسدي يفنى هباءً، وعقلي يحكم الرعودَ» كما يقول درجافن.
والملحوظة الأخرى، نجد وبكل وضوح، أن ما قدمه حيدر من هايكو كأمثلة ونماذج، يعبّر عن هايكو ما قبل الحربِ العالمية الثانية والذي يصنف بـ«الهايكو الطبيعي»، وهو ما يميل إليه حيدر مقابل هايكو ما بعد الحرب، أو «الهايكو المديني» والذي يتحدث عن هواجس هذه المرحلة، وما أفرزه التطور التقني والحضاري من علاقات وترابطات جديدة، ومثاله قصيدة للشاعر تاكاها شوجيبو: «من ناطحةِ السحابِ/ خضرةُ الأشجارِ/ كالبقدونس»، التي نطمح أن يكون مشروع الشاعر حيدر القادم في الكتابة على نمطها، وأقرب مثال يمكن اقتراحه من تاريخ الشعر العربي هو الشاعر «المديني» ابن زمرك الأندلسي (ت: 797هـ) الذي يوصف بشاعر الطبيعة.
أخيرًا، إذا كان الرائد والدليل عن مفهوم الشعر الآسيوي للشاعر الأميركي «أرشيبالد مكليش» هو الشاعر الصيني لوتشي، فدليلنا الرائد لكتابة قصيدة الهايكو العربية هو الشاعر حيدر العبدالله.


 «المتصوفة فئة لا تتحرّك. يَرسُمون بمَخالبِهم على الرمل ويَكسرون جوز الهند بقَواقعِ يَقينهم. نيتشه بينهم، يرفرف بشاربهِ الكث… رابعة العدويّة تَنشّ سِرب نجومٍ نَحو مرعى فَلكِيّ.هؤلاء لن يصلوا بمنطق الفيزياء؛ لأنّ الأجرام تَتحرّكُ نحوهم».
«المتصوفة فئة لا تتحرّك. يَرسُمون بمَخالبِهم على الرمل ويَكسرون جوز الهند بقَواقعِ يَقينهم. نيتشه بينهم، يرفرف بشاربهِ الكث… رابعة العدويّة تَنشّ سِرب نجومٍ نَحو مرعى فَلكِيّ.هؤلاء لن يصلوا بمنطق الفيزياء؛ لأنّ الأجرام تَتحرّكُ نحوهم».
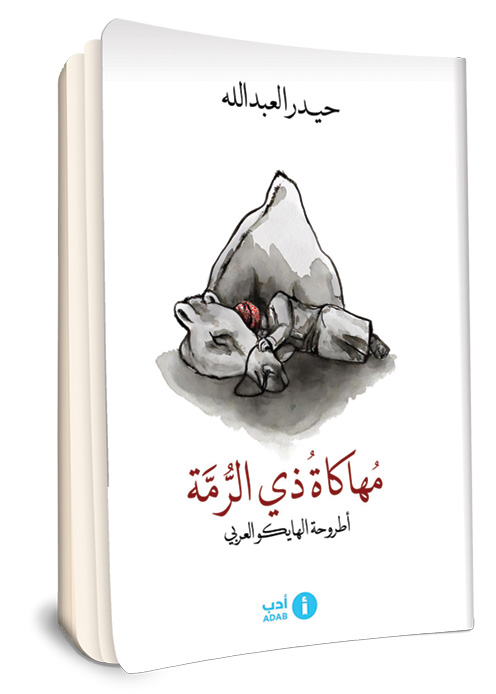 أما في تجربته لإنشاء المهاكاة من دون تناص، وفي شرحه لتطبيق الهايكو على بحور الشعر العربية، نجده يكتب على بحر الوافر: «خزامى / يعتريها الليل والطل/ قاطبة»، وعند المهاكاة على بحر الرمل: «بين أسنانيَ رملٌ/ كمأةً/ كان عشائي»، والمثال الثالث على البحر السريع: «ليسكت الحادي/ تغذُّ المسير/ ناقةٌ». وفي حالة ما أسماه بالبحر «المرسل» أو البحر المنثور بلا تفاعيل، فهو يضع النموذج التالي من نص للشاعر سامح درويش: «على حافة البِئرِ/ الدَلوُ/ يَملؤُهُ المَطَرُ».
أما في تجربته لإنشاء المهاكاة من دون تناص، وفي شرحه لتطبيق الهايكو على بحور الشعر العربية، نجده يكتب على بحر الوافر: «خزامى / يعتريها الليل والطل/ قاطبة»، وعند المهاكاة على بحر الرمل: «بين أسنانيَ رملٌ/ كمأةً/ كان عشائي»، والمثال الثالث على البحر السريع: «ليسكت الحادي/ تغذُّ المسير/ ناقةٌ». وفي حالة ما أسماه بالبحر «المرسل» أو البحر المنثور بلا تفاعيل، فهو يضع النموذج التالي من نص للشاعر سامح درويش: «على حافة البِئرِ/ الدَلوُ/ يَملؤُهُ المَطَرُ».