
العرب وأسئلة المستقبل.. مدخل فلسفي
من أية جهة يمكننا التفلسف عن المستقبل في لغة الضاد؟ من جهة الفلسفة العربية الوسيطة التي اتخذت من «السعادة الأخروية» غاية لها؟ أم من جهة عدم قدرة الملة على احتمال الفيلسوف ضمن فقهها العام؟ هل نقول: إن إمكانية النهوض بفلسفة عربية معاصرة، أي بفكرة المستقبل فلسفيًّا، في أوطاننا مستحيلة طالما ظل فقهاء الأمة أوصياء على جهاز العقل في ثقافتنا؟
تمثل هذه الإشكاليات العالقة بالسؤال العربي عن المستقبل المبحث الفلسفي الأساسي لكل كتابات الفيلسوف العربي فتحي المسكيني منذ «فلسفة النوابت» 1997م، ثم «الهوية والزمان» 2001م، و«الفيلسوف والإمبراطورية»، 2005م، و«الهوية والحرية»، 2011م، ثم «الهجرة إلى الإنسانية» 2016م، وأخيرًا «الإيمان الحر أو ما بعد الملة» 2018م. بحيث يمكن القول: إن كتابات المسكيني على مدى أكثر من عشرين سنة إنما تجد رهانها الجوهري في السؤال الذي نعثر عليه منذ مقدمة كتاب «فلسفة النوابت» بحيث نقرأ ما يأتي: «هكذا صار الرهان واضحًا: كيف نستأنف البحث الفلسفي الذي شرع فيه أسلافنا، ولكن بخاصة في الأفق الإشكالي للفلسفة المعاصرة بالذات»(١).
أسئلتنا حول المستقبل
إن هذا الربط الإشكالي بين استئناف التفلسف في لغتنا والفلسفة المعاصرة بوصفها أفقنا الإشكالي الوحيد لجعل أسلافنا يخاطبوننا مرة أخرى هو نكتة الإشكال في فلسفة المسكيني طيلة عقدين من الزمن. لكن على أي نحو يمكننا ملاقاة مصادر أنفسنا العميقة في أفق محنة المعاصرة حيث يُنَضَّدُ الزمان وفق خطة المستقبل الممكنة لكل ثقافة؟ من أجل مقاربة هذا الإشكال المتوعر تفترع كتابات فتحي المسكيني «جهازًا إشكاليًّا» مغايرًا يشتغل فيه على ترسانة من المفاهيم والأسئلة والحركات التأويلية الجذرية التي تفتح الفلسفة في لغة الضاد على خطورتها الأصلية باذلًا جهده من أجل البقاء ضمن «شجاعة الحقيقة» حتى وإن كانت هذه الشجاعة بلا شكل جاهز ولا ضمانات مسبقة. بحيث يكون همه الفلسفي الأول هو كيف نجعل لغتنا العربية تأخذ الكلمة مرة أخرى بعد ابن رشد.
لكن «هل عاد ابن رشد من المنفى؟»(٢) وبعد المعري، لكن «من وصلته رسالة الغفران؟»، وبعد الفارابي، ولكن كيف نجعل من «نوابت الملة» إمكانيات للتفكير في مشكلاتنا الحالية؟ وبعد متوحد ابن باجة بوصفه الصياغة النموذجية عن النابتة كشكل وحيد للتفلسف في أفق الملة، وبعد ابن خلدون لكن كيف «نفكر مع ابن خلدون بعد ابن خلدون» وكيف «نظر ابن خلدون إلى مستقبل أنفسنا القديمة»… وبعد جبران بوصفه «النسخة العربية من العدمية».. وبعد «حديث القيامة بين الجليل والهائل» حيث ينصب «المسلم الأخير إمبراطوريته ضد «أمركة العالم».. وكيف يمكن زحزحة الغرب بوصفه «خصمًا ميتافيزيقيًّا خارجيًّا» من أجل تحويله إلى «زميل ميتافيزيقي في ترتيب معنى العالم…»؟
هذا بعض من عناصر الجهاز الإشكالي الذي تخترعه كتابات المسكيني بترسانة مفاهيمية خاصة من قبيل مفاهيم «النابتة» و«المسلم الأخير» و«الهووي والحيوي»، و«مصادر أنفسنا» و«الهوية والحرية»، و«نكاح العقل»، و«كوجيتو الكراهية»، و«الرهطيون»، و«سياسات الشهادة»، و«الجسد الآية»، و«الهجرة إلى الإنسانية» و«الإيمان الحر» و«ما بعد الملة» و«المركزيون أو المواطنة المشطة»، واستعارات فلسفية عجيبة من قبيل «العلف الإبستمولوجي» و«العصائد اللاهوتية»، و«نرسيس والحطيئة..»، و«موجز ميتافيزيقي من الأرض…» و«الشعراء يحرسون هشاشة العالم»، و«نحن ثقوب سوداء…»، و«الصمت أحد مخاطر الكلام»، و«العروبة أو المصير بلا مستقبل»، أو «داعش والغبراء…»، أو «آلام وثنية… القراءة والحرية»، أو «شعوب في الأسر… واعتقال المكان»، أو «المنتحرون… في تشغيل الموتى».
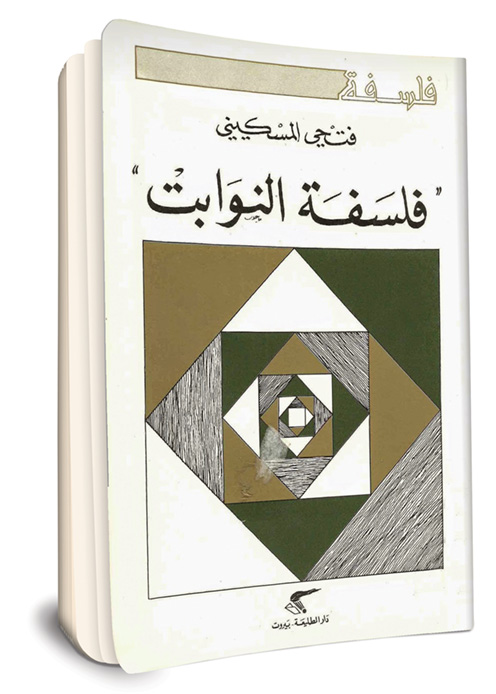 أما عن الأسئلة الجديدة التي نلتقيها في كتاباته فنذكر منها بعض ما نحتاجه في سياق إشكالية المستقبل من منظور عربي تحديدًا، وهي تتعلق بخاصة بالسؤال الكبير الذي يشتغل عليه المسكيني ويحاول في كل ما يكتب الانخراط فيه والنهوض به على أنحاء شتى، وهو: «هل توجد فلسفة عربية معاصرة؟» وهذا السؤال هو الذي يفتتح به المسكيني كتاب الهوية والزمان(٣) بوصفه هو السؤال الذي «يبرر أو يهدم كل استعمال عمومي للفلسفة لدينا»(٤). هكذا يعين المسكيني المجال الفلسفي الممكن بالنسبة لنا لو أردنا أن نتشوق إلى مستقبل ممكن لأنفسنا في لغتنا.
أما عن الأسئلة الجديدة التي نلتقيها في كتاباته فنذكر منها بعض ما نحتاجه في سياق إشكالية المستقبل من منظور عربي تحديدًا، وهي تتعلق بخاصة بالسؤال الكبير الذي يشتغل عليه المسكيني ويحاول في كل ما يكتب الانخراط فيه والنهوض به على أنحاء شتى، وهو: «هل توجد فلسفة عربية معاصرة؟» وهذا السؤال هو الذي يفتتح به المسكيني كتاب الهوية والزمان(٣) بوصفه هو السؤال الذي «يبرر أو يهدم كل استعمال عمومي للفلسفة لدينا»(٤). هكذا يعين المسكيني المجال الفلسفي الممكن بالنسبة لنا لو أردنا أن نتشوق إلى مستقبل ممكن لأنفسنا في لغتنا.
كل أسئلتنا حول المستقبل تولد إذن من إمكانية التفلسف في لغتنا أي إمكانية إنجاز فلسفة عربية معاصرة. لكن كيف النهوض بمسألة «من نحن؟» أي بالسؤال عن الهوية بعد أن بلغ «الكلام حول أنفسنا حد المرض الثقافي الذي يصعب معالجته؟»(٥). من أجل معالجة هذا السؤال الأساسي يَعْمِدُ المسكيني إلى إنجاز ما يسميه «تأويلًا جذريًّا» لمصادر أنفسنا، وفق جملة من الانزياحات التي توقعها نصوصه بين جملة من الثنائيات التي يفترعها، كمن يستنبت ورودًا جديدة في حديقة تخلى عنها أهلها. إن الأمر يتعلق عنده بمعارك فلسفية تخوضها نصوصه بين «الهووي والحيوي»، وبين «معارك الجماعة ومعارك المناعة»، وبين «الهوية والانتماء»، وبين «الآخرة والمستقبل»، وبين «القدر والمصير»، وبين الإيمان الحر… والسردية الحزينة للمسلم الأخير».
وعليه فإن فكرة المستقبل في ثقافتنا غير ممكنة لو لم ننجح في تحويل الفلسفة إلى معركة جذرية ضد أوهامنا حول أنفسنا، أي أن نتكفل بضرب من «هجاء الداخل» ومن تحرير عقولنا من ملة بلا أفق نحو مستقبل في أفق «ما بعد الملة». إن تدخل المسكيني في السؤال عن المستقبل عربيًّا إنما ينبغي أن يُتأول بوصفه توقيعة ميتافيزيقية حاسمة نحو تصحيح الجهة التي يمكن لنا فيها أن نستقبل ما يمكن أن يقبل علينا، بوصفنا كائنات مستقبلية.
لكن هذه الحركة التأويلية الجذرية التي تطمح إلى تصحيح فكرة المستقبل في لغة الضاد لن تكون ممكنة من دون جملة من التحويرات العميقة والمتوعرة التي يمكن تجميعها فيما يأتي:
أولًا– إن المستقبل جهة وليس مكانًا يُحجَز ويُحتَلّ من طرف الثقافات الأكثر اقتدارًا وغلبة.
ثانيًا– المستقبليون لهم انتماء وليس لهم هوية جاهزة وثابتة وسابقة على وجودهم. فالانتماء يقتضي شوقًا إلى أفق مغاير وغير متوقع، في حين يتشبث أصحاب الهوية بالماضي كدلالة جذرية على وجودهم.
ثالثًا– لا يمكن لأية ثقافة أن تدعي امتلاك المستقبل وحدها. وهنا تعمل كتابات المسكيني على تصحيح فكرة الكونية وجعلها تتسع إلى كل الثقافات التي تنجح في جعل انتمائها إلى المستقبل وجهة أساسية لكينونتها الخاصة.
رابعًا– إذا كان المستقبل لدى الغرب مرتبطًا بالانخراط في مشروعات ما بعد الحداثة، فنحن معنيون بالنجاح في التوجه نحو أفق «ما بعد الملة».
خامسًا: لا يمكننا أن نأخذ الكلمة اليوم من جديد إلا بوصفنا نوابت، لكننا مطالبون بالتمييز بين «نوابت الملة» و«نوابت ما بعد الملة». وذلك يعني أننا لا يمكننا أن نتفلسف اليوم إلا ضمن الأفق الإشكالي الكبير للفلسفة المعاصرة؛ وذلك لأن «من يُفكر لا بد أن يعتمل فيه العصر النظري الذي يتحرك من خلاله»(٦).
في دلالة السؤال عن المستقبل عربيًّا
في نص له منشور على الإنترنت تحت عنوان: «موجز تاريخ المستقبل عند الفلاسفة» يقترح المسكيني الأطروحة التالية: إن المستقبل فكرة حديثة وُلدت في الفلسفة من انفصال عميق بين مذاهب الآخرة وتقنيات المستقبل، أي أن المرور قد تم من «سرديات الرجاء» إلى «آداب الأمل في التقدم». ما حدث إذن هو تحديدًا انفصال بين لاهوت الخلاص والأمل التنويري في تقدم أخلاقي محض. لكن لماذا لم تصل فكرة المستقبل إلى الفلسفة إلا مع الحداثة الغربية؟ إن ما يهمنا في سياق هذا التأريخ الفلسفي لفكرة المستقبل هو أن هذه الفكرة قد جاءت إلى الفلسفة مع كانط في سياق زمن التقدم أي ذاك التحول من طقوس الرجاء في خلاص مسيحي إلى يوتوبيا الأمل في تربية أخلاقية للنوع البشري.
نحن نحتاج إذن إلى هذا النوع من التنضيد الاستكشافي الذي يبحث عن إمكانية اختراع المكان الميتافيزيقي الكفيل باستقبال استشكال فلسفي للمستقبل في لغتنا، نحن الذين ننتمي إلى العالم بوصفنا شركاء وأندادًا روحيين لفكرة الإنسانية في الضمير الكوني قاطبة. يتعلق الأمر بالمرور من «سرديات الذاكرة إلى أسئلة ما بعد ميتافيزيقية بلا مذهب جاهز عن الوجود أو الألوهية أو العقل» وتبعًا لهذا التأويل يكون المستقبل هو «الأفق الجديد للتفكير بأنفسنا بلا أجوبة ماهوية عن الزمان». يتعلق الأمر بتحرير طريقة الحكي حول أنفسنا من لغة الخطاب العقدي والقومي والأبولوجي لهوية جاهزة إلى إمكانيات وسلوكات موجبة وصحية لتشخيص ما تتضمنه مسألة الهوية من إحراجات وتحير. وهو تحير يساعدنا عليه تأويل مغاير لفلاسفتنا منذ الكندي إلى ابن رشد، وذلك في أفق استشكال لسياسة الحقيقة الممكنة لسؤال الهوية.
في السؤال عن مستقبل العروبة
في الفقرة رقم 14 من «كتاب الهجرة إلى الإنسانية» للمسكيني، نعثر على عنوان مربك هو «العروبة أو المصير بلا مستقبل»، والسؤال الذي يطرح عندئذ: أي مستقبل لفكرة العروبة؟ من أجل معالجة هذا السؤال يَعْمِدُ المسكيني إلى تشقيق جملة من التمييزات بين العرب والعروبة ومعارك المصير وأسئلة المستقبل وهواجس الهوية ومطالب الحرية. فهو يرى أن العرب باقون لكن فكرة العروبة كهاجس هووي قومي تبدو مهزوزة وبلا مستقبل. وإن هذا التحرر المتوعر من الهواجس الهووية حول أنفسنا إنما يمثل شرطًا أساسيًّا لاختراع تجربة تأويلية جديدة حول أسئلة المستقبل في لغتنا. والمطلوب عندئذ هو إعداد خطة فلسفية عميقة لمراجعة «معنى الهوية في أفق شعوب المستقبل»(٧).
 لكن ماذا سيتبقى من «العروبة» بعد تحريرها من الهواجس الهووية؟ يقول المسكيني: «سوف ترجع العروبة إلى معناها الجذري: أننا نتكلم لغة محددة. وأن هذه اللغة هي المخزون الإستراتيجي للشعوب التي نتكلم باسمها راهنًا»(٨). وبهذا التأويل ينزل المسكيني الثقافة العربية منزلتها العالمية المخصوصة بوصفها تجربة لغوية جذرية تتمتع بكل ثراء الاختلاف عن اللغات العالمية الأخرى، وبوسعها أن تزاحم اللغات العالمية الأخرى في تصميم أسئلة المستقبل، مستقبل الإنسانية في عالم معولم.
لكن ماذا سيتبقى من «العروبة» بعد تحريرها من الهواجس الهووية؟ يقول المسكيني: «سوف ترجع العروبة إلى معناها الجذري: أننا نتكلم لغة محددة. وأن هذه اللغة هي المخزون الإستراتيجي للشعوب التي نتكلم باسمها راهنًا»(٨). وبهذا التأويل ينزل المسكيني الثقافة العربية منزلتها العالمية المخصوصة بوصفها تجربة لغوية جذرية تتمتع بكل ثراء الاختلاف عن اللغات العالمية الأخرى، وبوسعها أن تزاحم اللغات العالمية الأخرى في تصميم أسئلة المستقبل، مستقبل الإنسانية في عالم معولم.
إن أهم النتائج الفلسفية التي نغنمها حينئذ من هذا النوع الطريف من الطرح الفلسفي هو هذا التعريف الجديد للعروبة بوصفها «تجربة لغوية جذرية، وليست مذهبًا سياسيًّا»(٩). إن تحرير فكرة العروبة من الشحنة القومية التي لها، وإعادة تأويلها بإعادة تجذيرها داخل الانتماء اللغوي، تلك هي الحركة الفلسفية التي تهيئنا في هذا السياق للالتحاق بمعارك الفلسفة المعاصرة التي هي في عمقها معارك لغوية.. والسؤال سيكون عندئذ، على الرغم من أن لغتنا لا تزال حية وقادرة على اختراع أسئلة الحياة: لماذا تعطل المستقبل طويلًا في أفق شعوبنا؟ لماذا لا تزال سردية المسلم الأخير تطلب الدم وتقوم على التكفير وتسطو على العقول بالشعوذة؟ عن هذا السؤال يجيبنا المسكيني قائلًا: إنه الماضي، بحيث «لقد عاشت شعوبنا ماضيًا مزيفًا، ولذلك هي الآن بلا مستقبل»(١٠).
ماذا عن فكرة المستقبل راهنًا لدى شعوبنا؟ يشير علينا المسكيني بأننا «نقف راهنًا على عتبة المستقبل…» لكننا مطالبون دومًا بتحرير السؤال عن المستقبل من معارك الهوية بوصفها لا تفعل غير استعمال سطحنا الهووي على نحو عنيف وعدمي في أفق انتظارات لاهوتية سقفها الوحيد هو مفهوم الآخرة كخلاص وحيد. المطلوب إذن هو النضال من أجل مطالب حيوية تجعلنا قادرين على «كسب حرب المناعة الذاتية ضد كل المخاطر المحدقة بالأمل الإنساني المحض في الحياة»(١١).
في مفهوم الانتماء
هل يمكن التفكير في المستقبل من دون مصادر أنفسنا؟ وهنا تظهر مراجعة فتحي المسكيني لمفهوم الانتماء بوصفه ضربًا من الحب لمصادر أنفسنا. والحب لا يتطلب أية عقيدة جاهزة، ولا ينتمي إلى أي شكل من الجماعة المفروضة على مشاعره سلفًا. إن الحب لا ينتمي إلا إلى المستقبل بوصفه مصدرًا لعنايتنا بأسئلة الحياة. وهذا هو ما يكتبه المسكيني قائلًا: «الانتماء مثل الحب: حيث لا حب لا مستقبل لأحد»(١٢). لكن كيف نحب انتماءنا؟ علينا أن ننهض بتراثنا منذ المعلقات إلى كل الحروب التي خاضها العرب بوصفها تجارب معنى ينبغي استئنافها على نحو مغاير لدعاة الملة. وذلك يعني بعبارات المسكيني أنه في «كل مصادر أنفسنا من المعلقات والقرآن الكريم إلى فقهاء عصور الملة وشعرائها وفلاسفتها، ومن الحياة اليومية للنبوة إلى الحروب الإمبراطورية للخلافة، هناك تجارب معنى تدعونا إلى استئناف العلاقة معها على نحو يليق بها، أي في عصور ما بعد الملة: نعني أن نجعلها تنتمي إلينا على نحو مغاير…»(١٣).
لقد غير الانتماء من عناوينه لذلك صار الإيمان الحر هو مستقبل الحياة الروحية لنا؛ بل ربما يكون هذا النمط المستقبلي من الإيمان هو «الفرصة الأخيرة لأي نوع من المؤمنين في أي ثقافة حتى يتم قبولهم كما هم في نادي الإنسانية الجديدة»(١٤). يتعلق الأمر بنمط من الإنسان الديكولونيالي الذي لا يمكنه التحرر من سلطة الغرب على عقله من دون استعمال مغاير لمصادره الروحية الخاصة.
خاتمة
يمكننا تجميع أهم النتائج التي نستخلصها من هذه الورشة الفلسفية المعقدة التي نصبتها فلسفة المسكيني أفقًا تأويليًّا مغايرًا في لغتنا، في ثلاث أفكار كبرى:
الأُولى: إن استعادة قدرة لغة الضاد على التفلسف مرة أخرى فيما أبعد من سطوة العقل الكولونيالي علينا، تبقى رهينة فتح ورشات تأويلية لاختراع أسئلة جديدة قادرة على التحرر من «العلف الإبستمولوجي» لغرب يستعمر عقولنا كآخر جغرافيا ممكنة له، ومن «العصائد اللاهوتية» كآخر أشكال السرديات الحزينة «للمسلم الأخير».
الثانية: إن هوياتنا ليست قدرًا نحمله كمن يحمل عبئًا ثقيلًا. وإن الماضي حينما لا يُخترَعُ تأويليًّا وَفْقَ خطة العقل الخاص بالإنسانية الحالية لن يكون سوى مقبرة. ولذلك فمعارك الانتماء مطالبة بأن تُغيِّر من أفقها: من معارك الهوية إلى معارك المستقبل.
هوامش:
(١) فتحي المسكيني، «فلسفة النوابت»، بيروت، دار الطليعة، 1997م، صص.11-12 .
(٢) فتحي المسكيني، «هل عاد ابن رشد من المنفى؟» وهو عنوان توطئة كتاب «الهجرة إلى الإنسانية»، بيروت، منشورات ضفاف، 2016م، ص.11.
(٣) فتحي المسكيني، «الهوية والزمان»، دار الطليعة بيروت، 2001م، ص.5.
(٤) نفسه، صص.5-6.
(٥) نفسه، ص.17.
(٦) «فلسفة النوابت»، مذكور سابقًا، ص.71.
(٧) نفسه، ص.90.
(٨) نفسه.
(٩) نفسه، ص.91.
(١٠) نفسه.
(١١) نفسه، ص.94.
(١٢) نفسه، ص.52.
(١٣) نفسه، ص.20.
(١٤) نفسه، ص. 31.
