
أحمد المديني - كاتب مغربي | مارس 1, 2025 | نصوص
– 1 –
اكتشفتُها كما اكتشف كريستوفر كولمبوس أميركا. هكذا يحلو لي أن أتحدث عنها، وإن شئتم أن أصِفَها، بعد أن انتهيت من أمرها، انتهت مني، ولي أن أزيدَ للتحلية في مطلع الكلام عن هذه الوجيدة، بأننا لا نلقَى دائمًا ما نحب أن نراه أو نصادفه؛ إذ المرئياتُ هي ما يَعرِض لنا أو يعترضُنا لتتواشج بيننا علاقةٌ كانت كامنةً من قبل، وتأتي الصدفةُ لنُبرم الاتفاق. مجردُ رأيٍ أو انطباعٍ، هو، لكن في حالتي لا أجد تفسيرًا لما رأيت، وما سأحكي إلا هذا، لا غيره.
– 2 –
مع ذلك ليس هذا هو المهم، ذلك أن الزمنَ هو السبب، وفي حالتي فقد كان الخريفُ هو السبب المباشر الذي جعلني أربط العلاقة بالمكان وصاحبه، وتتبلور هذه القصةُ الملتبسة التي يمكن لقارئها أن يتدخل فيها، من مبتداها إلى منتهاها، شريطةَ ألا يُضيعَ لعبتَها، وأن يستخلص المعنى الذي من أجله أُنشئت. كما له أن يجرّب ما يستطيع من مهارةٍ تُسمّى الحذقَ الفنيّ، وهو أكثر من الملَكة، ليُجيد حَبْكها، ويُحسنَ لبوسَها، وعلى الفنّ بعد الله قصدُ السبيل.
– 3 –
لم أكن أتوقع أي مفاجأة عندما واجهني الاسم عددتُه عنوانًا مثيرًا، أنا الذي أزعُم صانعَ حكاياتٍ وعناوين. ففي صبيحة السبت الذي تواجهنا فيه أكون رائقًا تمامًا، وكلُّ ما يحدثُ لي مُدبّرٌ وخاضعٌ لنظام، ولا تنجُمُ عنه أي مفاجأة تُذكر. بعد ممارسة الرياضة، والفطور، أتوجه إلى فندق هيلتون في نهاية شارع سوفرين بالدائرة السابعة، يعتبره بعض الناس، منهم أنا، من الأماكن اللائقة في باريس لتشرب قهوة مزّةً وتلتقي أصدقاءَ ودودين، في جو هادئ.
– 4 –
لا يحتاج الوصول إلى الفندق الفخم سوى دقائق. أمشي إليه من بيتي بخطوٍ متّزن. ألِجه من الباب الخلفي، متلهِّفًا للقاء واحتساء أول فنجان قهوة صباحي. أسترخي على إحدى أرائكه الوثيرة. ينساب الوقت بدَعَةٍ في أطرافنا ونحن حديثٌ يصعد وينزل. تحضر معه الدنيا كلّها. تكبر وتصغُر. ودائمًا، بما لا يُفسد للودّ قضية. الحاصل، ليس ثمّة ما يعكّر المزاج، وقلّ أن يحضُر ضيفٌ ثقيل، أما المفاجآت فنحن قوم كهولٌ نحبّذ تجنُّبها، اللهم إن جاء منها السعيد.
– 5 –
منها المفاجأة التي حدثت لي صباح سبتي هذا في منتصف فصل الخريف. في هذا الوقت يصبح شارع Suffren مُعشوشِبًا بالأوراق المتساقطة. أجملُ منه ألوانُها تتلألأ فوق الأغصان مصابيحَ في نهار وضاء، بلا سُحب بعد، تتأرجح بين الأصفر والحِنائي والعكْري، ما أبهجها! تسُرُّ الناظرين. جئت أخطبُها لأدنو منها أكثر، تتجلّى فاتنةً من الرصيف الأيمن للشارع، فأمشي تحتها، وعنقي إلى بهاء الأغصان مشرئبّ، لا يعنيني إلا الخريف، ولا أكاد أرى سواها.
– 6 –
عدا اللحظة التي انخطف فيها بصري على عَجل، لكن ليرتدّ سريعًا إلى مثوى انخطافه. كأنه إليه جاء، وعنه ما ينبغي أن يُوَلِّي. هكذا شُذَّ إليه، بقيَ مأخوذًا، ما بالك أجَمَالًا صاعقًا به فتنتَ أم أمرًا عجبًا رأيتَ، أم شُبّه لك؟! لا هذا ولا ذاك، فما هي إلا كلماتٌ، لن تعرف إلا فيما بعد أنهما خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. قرأتَهما لمْحَ البصر وكدتَ تتابع الخطى غيرَ آبه، فما أكثر العناوين والأشكال في باريس المغناج، جُعِلتْ فتنةً للناظرين؛ كدتَ تتركها وتمضي، لولا…
– 7 –
أخذك العنوان فتسمرتْ قدماك عند المحل. أعلاه لافتةٌ خشبيةٌ سواء خُط عليها بحرف عريض أبيض عبارة: «Teinturerie littéraire»، (المصبنة الأدبية) وتحتها عنوان فرعي كُتب بالأزرق: «Au sens propre» (بالمعنى العينيّ). التصقتَ بواجهة المحل الزجاجية وعيناك تجوسان عمقَه وجوانبَه المختلفة، قصدُك أن تتأكد أنها حقيقةٌ لا مزحة، وبخاصة أن العبارة الفرعية تنفي وجود معنى مجازي، وتريد أن ينصرف الذهن مباشرة إلى التصبين، تصبين الثياب، طبعًا، بتأويل أنك بسوء نية تجعله مقترنًا بصفة الأدب، وهذه من فِعالك.
– 8 –
أمرٌ ورأي محيِّران بلا شك، فما الخبر؟ جاءك جزءٌ من الجواب وأنت تتبين على اليمين وراء الواجهة رفوفًا تصل إلى السقف ممتلئةً بالكتب، وهنا عدتَ تتحيّر بين الشك واليقين، ما هذا، مصبنة أم مكتبة؟ أم هما معًا؟ لم تعرف موقعًا كهذا في السابق، جُبتَ باريسَ طولًا وعرضًا من غير أن تطأ قدماك مكانًا مماثلًا. ثم ها أنت تستنكر نفسك: لا أحد بمقدوره أن يدّعيَ الإحاطةَ بما في هذه المدينة المذهلة؛ وما العجب أن يوجد هذا في مدينة هي العجب؟!
– 9 –
وبينا أنت كذلك خرج من المحل رجلٌ أنيقُ اللباس، رصينُ الملامح، سبقتْ سلامَه ابتسامةٌ حييّةٌ وعبارةُ تحيةٍ مهذّبة. نفذ رأسًا إلى تعجّبك، إما لأنه اعتاد عليه؛ لكون حيرتك تظهر مفضوحةً على وجهك إلى حدٍّ اضطرته للخروج إليك. ها هو أمامك يشرح: «أهلا سيدي، طبعا ثمّة ما يبلبل، هي فكرة، ما رأيك أليست طريفة؟ بلى جديدةٌ وأصيلة، قلتَ معلقًا: أوه، تقاعدتُ منذ عام، قلت: إنني سأسأم بلا عمل يومي، ففكرتُ في هذا المشروع، ما رأيك؟»
– 10 –
لعله انتبه إلى أن جوابه لم يُشفِ غليلي، فاستأنف وكان صمَتَ: «في الأصل، أنا من عائلة بورجوازية، تربّينا على القراءة، وفي كل بيت لنا خزانةٌ عامرة، وهكذا ترى أنني لا أستطيع فراق الكتب، بالله عليك قل لي: هل يستطيع الإنسان العيشَ بدون الكتاب؟ أشك، اللهم أن ينحدر إلى مرتبة الحيوان، أشك!»، والحقيقة أنني وقفت مشدوهًا أمامه وهو يتلفظ العبارة الأخيرة، أفكر بفزع، أجزع أن تصبح ثلاثةَ أرباع الأمة التي أنتسب إليها بهذا المقياس.
– 11 –
بعد تعليقه هذا شُددت إلى رفوفه المزدحمة بالكتب، أظن أنه انتعش لوضعي وهو يحوم بنظراته متأملًا باغتباط لون الخريف يضيء من شجرة تلاعبُها ريحٌ خفيفة فتميسُ أغصانُها على متجره. قلتُ ممازحًا: هل ترى أن هذه الشجرة تتطلع مثلي بفضول إلى الداخل، نحو الرفوف، لتعرف ما هناك؟ أحسَب أن حديثي أعجبَه فأخذني من يدي مُرحِّبًا، تفضل: «انظر، المسألة جدٌّ تمامًا لا استهواء؛ هل تعلم أن لي زبائن استعاروا منذ شهرين 240 كتابًا، ومنهم من يحضر كتبًا لمكتبتنا بأريحية منقطعة النظير؟!».
– 12 –
«ثم هناك شيء آخر أهمّ، إنه التواصل، العِشرة، اذهب إلى أيّ مَصبنة وستجد الزبون يرمي بغسيله متأفّفًا وينصرف كأنه يتخلص من وباء، أمّا عندي فالزبائن يلتقون، يتحدثون، ومن ثم يتزاورون، ومن يدري قد يتحابّون، وهذا كله جميل، إنساني، ما رأيك سيدي، إنني لا أزيّن لك بضاعتي، هي قناعتي وهذا كلّ ما في الأمر، قلت لك: إنني متقاعد، ومعاشي يكفيني، الباقي تسلية، فضلٌ، قطعةٌ أخرى من الحياة، هذه الحياة التي ترى كيف أصبحت تعيسة».
– 13 –
هممتُ بالانصراف بعد سماع عبارته الحكيمة، شعرتُ بأني أطلت الوقوف، وربما شغَلت الرجل عن شأن تجارته، ثم إني تأخرت عن موعدي الصباحي في الهيلتون. مؤكدٌ أن صديقيّ الصحفيين القيدومين عبدالكريم أبو النصر وبلال الحسن، يخوضان في حديث شائقٍ مؤرِّقٍ عن فلسطين ولبنان ووو لن يتركا همًّا لأمتنا التعيسة إلا وطرقاه، ولا أحب أن أصل متأخِّرًا فلا أعرف من أين ألتقط الخيط ليكون لي رأيٌ لو طُلب مني… زد حاجتي إلى قهوة.
– 14 –
لكنه، خلافًا لتخميني، سارع يستبقيني، وكمن يستدرك شيئًا هامًّا فاته، خاطبني، وهو يطيل النظر إلى كتفي الأيمن، كنت أضع تحت إبطي مذ وقفت أمام المحل إدبارةً تكوّمت على كمية أوراق كتبت فيها أمورًا تخصني: «لا شك أن هناك ما يبرر تعلقك بهذه الرفوف، أقصد مكتبتي المتواضعة، أرى أنك، يشير إلى إبطي، تحمل أوراقًا، هذا يدلُّ على أنك من عالم الإنسان الحقيقي، عالم الكتابة، اعذُر فضولي، ألست كاتبًا، ستكون سعادتي حقًّا هذا الصباح؟
– 15 –
كأنه نبهني إلى إدبارتي، فحركت رأسي بعلامة ملتبسة أردفتها قائلًا: «أوه، الأوراق، أوه، لا تعني، جائز، أنت تعلم، هي الحاجة إلى التلهّي، أقصد أحيانًا لا يجد المرء طريقةً غير الكتابة، أو شيئًا من هذا القبيل، أنت تفهمني جيّدًا لأنك من هذا العالم، وفي النهاية هي مجّرد أوراق».
«أوه، لكم تبدو متواضعًا يا سيدي -عقّب على كلامي- من حقك أن تكتب، وما تشاء، ولك أن تعتز بهذا، وبخاصة في هذا الزمن الذي لم يعد البشر يعيشون فيه إلا في الإنترنت والبورصة».
– 16 –
كلّا، ليس تواضعًا، هو احتراز. سأبوح لك: «أنا أولًا أكتب باللغة العربية وهي لغة فضفاضة وغنية يصعُب التحكم فيها؛ ثانيًا، إنني ما زلت متوهِّمًا أن الكتابة مسؤوليةٌ من كّل النواحي؛ لذا ما أنفكُّ أصحِّحُ وأحذف، أُعدّل وأبدّل، وكلما قدّرت أني أنهيت نصًّا وجدتُني أعود إلى نقطة الصفر تقريبًا مثل أيّ مبتدئ؛ لذلك أرى أنك تبالغ إذ تعتبرني كاتبًا لمجرد هذه الأوراق، لو كنتَ تعرف لغتي لاطّلعت على مخاوفي ووجدتها مشروعةً أيها الرجل الكريم».
– 17 –
«أقدّر تمامًا ما تقول، وهذا ما يقوّي حدسي فيك، ثقتي فيما تكتب، على الأقل هذا أفضل من كلام المفوّهين، ألا ترى وتسمع كيف يتحدثون في التلفزيون، وتصريحاتهِم الرّعناءَ للصحف، إنني لا أفهم، البتة، وهو شيء يبعث فعلًا على الذهول. ثم انظر معي حين يُعلن هنا عن صدور خمس مئة رواية أو أزيَد، ثلاثةُ أرباعها هُراء واستعراضٌ واستعراءٌ وهمومُ بَطِرين ومخنثات، قل لي بربك هل هذه هي الكتابة، هل هذه هي الحياة يا سيدي الفاضل؟!».
– 18 –
لم يكن بوُسعي أن أجيب بنعم، أو بلا، فالرجل أطراني، وحرك شجوني، في آنٍ؛ لذا، وأنا أسعى لحُسن تخلّص، سلمت أمري معلنًا أن الأمور هكذا، ونحن في النهاية لا نملك شيئًا أمام آلة استهلاكٍ ودعايةٍ طاحنتين، وهذا كلُّ ما في الأمر يا سيدي. وأنا أخطو نحو الرصيف المقابل أعتبر لقاءَ صدفتنا انتهى أعادني صوتُه بنداءٍ رفيق، لكن حازم: «سيدي، نسيتُ أن أخبرك ربما بالأهم، قد لا تشاطرني الرأي لكنها فكرة، أقصد المصبنة الأدبية، أصل الفكرة».
– 19 –
«صحيح، أنت محقّ، عدا الكتب التي تعير ويتبادلها الزبناء، ثمة لا شك سِرٌّ في العنوان؟ بكل تأكيد، فكرت أن البشر يغسلون ثيابهم، ولا يساومون في الدفع، فلماذا الكُتّابُ مثلًا لا يغسلون كتبهم بعد الطبع، أو مخطوطاتهم، قبل ذلك، سيعود عليهم هذا الغسيل بالنفع العميم، سيُعفيهم من أيّ نقد صحيح، أو جارح، أو لغو زائد. هناك، أيضًا، مبتدئون، ناشئون يتنطعون أحيانًا بأنهم وُلدوا كاملين. كذلك أفراد يتهيّبون من النشر قد تُسعفهم العملية، معذرة، أنا لا أقصدك، هو خاطر مرّ بي، فقط، إنما لا مانع عندي، وعينُه على الأوراق، لا مانع…».
– 20 –
راقتني الفكرة جدًّا بالرغم من تهيُّبي منها، فسلّمته إدبارتي لم أسأل ما هي الطريقةُ المعتمدة لغسيل الكتابة، ولا تكلفتُها، أدبيًّا وماديًّا، قال عُد لتسلُّمها السبتَ القادم ستجدُها على ما يرام. وككلّ سبت قصدت مجلسي في فندق الهيلتون، وفي الطريق تذكرت موعدي فقلت: أعرّج لاستلام مخطوطتي لا شك هي جاهزة، ووجدتني أمام المصبنة لكن كأنما قدماي شُلّتا، فبقيت في الخارج لا أجرؤ تنهبني الوساوس، لا أعرف ما سأسترد من مخطوطتي، وكم سيكلفني.
– 21 –
تقدم إليّ صاحب المصبنة البورجوازي، قال: حسنًا جئت في الموعد. اطمئن، بضاعتك جاهزة، لقد رفقتْ بها الآلة في النهاية، هاهي ذي، وكل شيء بالداخل حيث ستجد المطلوب. والآن انصرف إلى أصدقائك، واعتبر عملي هديةً مني شريطة أن تجلُب لي زبائنَ غدًا، أو تدعوني حين تشتهِر، وانكببتُ رأسًا على الإدبارة فوجدت ديباجة تتقدمها تقول: «عنون كتابك «خريف»، احتفظنا فيه بقصص وتخلصنا من غيرها بعد الغربلة» فرضيت بهذا الغسيل. عساك أنت، أيضًا، أيها القارئ ترضى وتبتهج معي بقصتي، فالحياة كذلك غربال.

أحمد المديني - كاتب مغربي | نوفمبر 1, 2022 | جوائز
نكتب هذه المقالة بمقتضى مناسبة كبيرة هي الكبرى في تقدير وتبجيل الأدباء، جائزة نوبل، وتستمر الأفخمَ بعد مرور أكثر من قرن على إعلانها (1901م). فيما نبغي تجاوز لحظة الإثارة والانبهار اللذين يرافقان مناسبات من هذا النوع، لنقف على الجوهري في موضوع واسم الفائز ونحدد أنه المتن، أساسًا. كما عُلم، الفائزة في عامنا هي الكاتبة الفرنسية آني إرنو (1940م). يمتد عمرها الإبداعي من روايتها الأولى «الخزائن الفارغة» (1974م) وانتهاءً بـ«Le Jeune Homme» (الفتى) (2022م)، أي أن لها مسيرة كتابة تقترب من نصف قرن، باثنين وعشرين عملًا سرديًّا من طراز فني اختصت به تدريجيًّا وأصبح علمًا عليها وهو ما يعنينا أكثر من غيره.
وهذا ما يضيع غالبًا في بهرجة المناسبات وجعجعة الجوائز أيًّا بلغت قيمتها، ومع إرنو التي تُعدّ الآن كاتبة كلاسيكية، بما أن لها نصوصًا مقررة في المدارس وأطاريحَ وُضعت عن أعمالها؛ لذا ينبغي التأنّي وتوخّي الحذر في التقويم وإصدار الأحكام الفضفاضة، التي تضطر أن تلجأ إليها الأكاديمية السويدية نفسها بعبارات شعارية لتسويغ التتويج «لشجاعتها والرهافة الفائقة، ولحسِّها في كشف جذور الذاكرة الشخصية والقيود الجماعية المفروضة عليها». وأفضل منها، عجبًا، التقريظ الذي خصّها بها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، وعباراته لا شك كتبها مستشار نابه في قصر الإليزيه حين أوجز مشروعها بشكل جامع: «تكتب آني إرنو منذ خمسين عامًا رواية الذاكرة الجماعية والحميمية لبلادنا. إن صوتها لهو صوت حرية النساء ومنسيّي القرن…». ونصرف النظر عن الحفاوة الإعلامية ونفاد كتبها من أدراج المكتبات بعد ساعات من إعلان فوزها، على الرغم من أنها ليست مغمورة، وإنما هو مزيد اعتزاز بكاتبة البلاد كما يليق بالشعوب القارئة المتمدنة حيث للكاتب فيها وضع اعتباري، وهو ممثل رفيع للقيم الرمزية.
ذاكرة الأدب
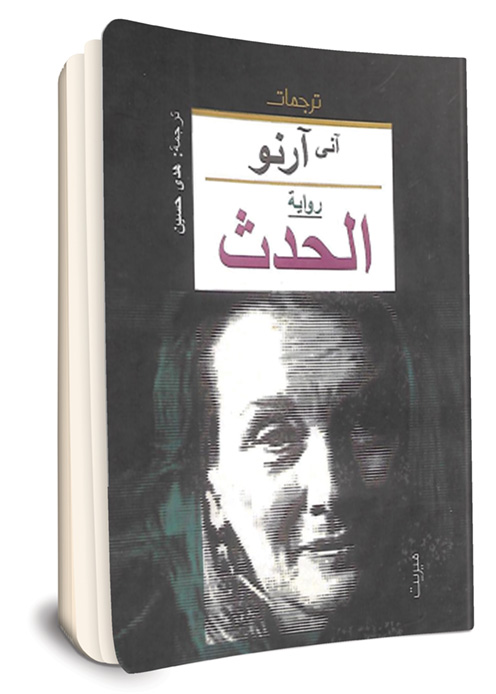 أقول، نحتاج إلى التأنّي في قراءة حدث الفوز بنوبل، وإلى قدر لا بأس به من التبصّر لقراءة المتن مناط الاهتمام، أوله أن ننتبه إلى أن للأدب ذاكرة فلا يوجد نصٌّ أدبيٌّ مفردٌ ومقطوعُ الجذور، مهما بلغ تفوقُه ونبوغُ مُنشئِه، له شجرة أنساب ينتمي إليها وباتصاله مع جذورها تتحدد خصائصه ونوع من يتميز به غصنًا وورقة وزهرة وثمرة ورائحة. نعني أن إرنو -بالرؤية والمحتوى المكوّنين لسردها الذاتي الذي سنشرح مضماره، وباللون الغالب عليه، الصانع لنسيجه- هي بنت تقاليد أدبية تليدة لها آباءٌ وجدات، هم وهن من وضَع اللبنات الأولى لما غدا صرحًا عالي البنيان، ينبغي أن نستحضر فيه من كتابة الوجدان النسائي أسماء لا غنى عنها: مدام لافاييت مؤلفة «أميرة كليف»(1678م)، وجورج ساند (1804- 1876م) صاحبة «أنديانا» (1839م)، و«قصة حياتي» (1855م)، وخصوصًا كوليت (1873- 1954م) في سلسلة «كلودين» (1900- 1903م)، و«ولادة النهار» (1928م)، ونقفز إلى سيمون دوبوفوار (1908- 1986م) التي أطلقت فلسفيًّا من باريس موجةً تحرر بكتابها «الجنس الثاني» (1949م) صوت تفتح المرأة وكيانيتها المستقلة، وعززته بـ«قوة العمر» (1960م). ونضيف إلى هذا السرب مغردتين قويتين هما فرنسواز ساغان (1935- 2004م) بالذات في باكورتها «صباح الخير أيها الحزن» (1954م) والأقوى منها إبداعًا والتزامًا مارغريت دوراس (1914- 1996م) لرواياتها الذاتية ونموذجها النقدي المعتمد «العشيق» (1984م) التي تُوِّجت سنتها بجائزة الغونكور المرموقة.
أقول، نحتاج إلى التأنّي في قراءة حدث الفوز بنوبل، وإلى قدر لا بأس به من التبصّر لقراءة المتن مناط الاهتمام، أوله أن ننتبه إلى أن للأدب ذاكرة فلا يوجد نصٌّ أدبيٌّ مفردٌ ومقطوعُ الجذور، مهما بلغ تفوقُه ونبوغُ مُنشئِه، له شجرة أنساب ينتمي إليها وباتصاله مع جذورها تتحدد خصائصه ونوع من يتميز به غصنًا وورقة وزهرة وثمرة ورائحة. نعني أن إرنو -بالرؤية والمحتوى المكوّنين لسردها الذاتي الذي سنشرح مضماره، وباللون الغالب عليه، الصانع لنسيجه- هي بنت تقاليد أدبية تليدة لها آباءٌ وجدات، هم وهن من وضَع اللبنات الأولى لما غدا صرحًا عالي البنيان، ينبغي أن نستحضر فيه من كتابة الوجدان النسائي أسماء لا غنى عنها: مدام لافاييت مؤلفة «أميرة كليف»(1678م)، وجورج ساند (1804- 1876م) صاحبة «أنديانا» (1839م)، و«قصة حياتي» (1855م)، وخصوصًا كوليت (1873- 1954م) في سلسلة «كلودين» (1900- 1903م)، و«ولادة النهار» (1928م)، ونقفز إلى سيمون دوبوفوار (1908- 1986م) التي أطلقت فلسفيًّا من باريس موجةً تحرر بكتابها «الجنس الثاني» (1949م) صوت تفتح المرأة وكيانيتها المستقلة، وعززته بـ«قوة العمر» (1960م). ونضيف إلى هذا السرب مغردتين قويتين هما فرنسواز ساغان (1935- 2004م) بالذات في باكورتها «صباح الخير أيها الحزن» (1954م) والأقوى منها إبداعًا والتزامًا مارغريت دوراس (1914- 1996م) لرواياتها الذاتية ونموذجها النقدي المعتمد «العشيق» (1984م) التي تُوِّجت سنتها بجائزة الغونكور المرموقة.
هذه بعض أغصان شجرة الأنساب الباسقة التي تنتمي إليها إرنو في نسغ ونهج كتابتها الروائية والأتوبيوغرافية. نسمّي نسقَها نقديًّا (سرد الحميمي موضوعيًّا)، تتميز به في النسق العام للسيرة الذاتية كما كتبها أسلافُها وفجّرن فيها خطاب المرأة وأذَعْن بوحَها ضمن شروط سوسيوتاريخية محددة أخذت منحى تصاعديًّا لترجمة مشاعرهنّ وفرضِ وجودهن في محيط هيمنة مجتمع الرجال، ولانتزاع حقوقٍ حُرمن منها طويلًا، بدءًا من القرن التاسع عشر وانتهاءً بما تشهده الحركات النسائية الراهنة في نضالها الأقصى # me too المناهض لسطوة الذكورية، وليست الفائزة غريبة عنها وإن لم تنخرط في دعاواها مباشرة. يبقى الأهم أن نتعرف عن هذا الشيء أو المَعلَم الذي استطاعت النوبلية الفرنسية الجديدة التفرّد به، وقد شرّفت الأدب الفرنسي بعد آخر تتويج نوبلي له عرفه وناله وحظِي به باتريك موديانو (2014م).
سيرة ذاتية
لا بأس من التذكير هنا بما تعنيه السيرة الذاتية بوصفها نوعًا متفرّعًا عن جنس الرواية الأدبي، بما أنها تعتمد فنّ السرد وتستخدم أغلب أدواته وتفترق عنه في عدم تبنّيها علنًا على الأقل لمفهوم وخطة التخييل، الذي يعني في الحد الأدنى نقلَ الواقع أو تصوّره على صعيدي الممكن والمحتمل، ويمكن صُنعه وتدبيرُه وفق ما يتخيله الكاتب لحدث ما ومسار حكاية وشخصيات بما يناسب الرؤية البانية لعمله. بينما السيرة الذاتية هي سردٌ بطله كاتبها الذي تروي حياته، وبذا فهي حقيقية. وبحسب مُنظِّرها الأدبي الأول فيليب لوجون، الدارس المعتمد لها، في كتابه الشهير «الميثاق الأوتوبيوغرافي» (1975م) وأبحاث أخرى، عرّفها بأنها «محكيٌّ استرجاعي بالنثر ينجزه شخص حقيقي عن وجوده الشخصي، عندما يعالج حياته الفردية، والشخصية خاصة»، وشرطها «ميثاقٌ يُبرمه كاتبٌ مع قرائه يصرّح فيه بهويته في الغلاف وداخل الكتاب، وبأنه يستعرض حياته مفصلةً وحياته فقط». وإذا كان ضمير المتكلم هو اللسان الأول لصدقية وتوثيق العَقد، فإن التفاوت ممكنٌ في استعمال الضمائر، وكذلك في مقدرة الذاكرة على استرجاع الماضي، وفي درجة صدق المَروي وطريقته ومثله مما وجدنا أبا الرواية الجديدة الفرنسية آلان روب غريي (1922- 2004م) يجادل فيه لوجون بناءً على تجربته هو في سيرته الثلاثية بعنوان «روائيات» Romanesques (من 1985 إلى 1994م) (انظر كتابي: «كيف نفهم الرواية الجديدة» (مفترق الطرق، الدار البيضاء، 2021م).
لم تبدأ آني إرنو بهذا النوع وإنما استخدمته بعد عشر سنوات في روايتها «(la Place) (1983م)- تُرجمت إلى العربية بعنوان «المكان» (ترجمة: أمينة رشيد وسيد البحراوي، شرقيات، 1994م)- فشعّ بها اسمها، إذ فازت بجائزة رونودو (1984م)، وفيها تستعيد مقاطع بارزة وشاقة من حياة أبيها بما عاشه من ضنك وتقلّب فيه من مهن بين الفلاحة والبقالة وتتابع مساره إلى أن وافته المنية. في كنَفه وتحت ظلال هذه الحياة صور وملامح عن طفولتها في ظروف العوز، وتحاول أن تموّه البون الذي بات يفصل بين ارتقائها للسُّلَّم الاجتماعي وما كانت عليه وضعية الشقاء العائلي الأول. بذا تطرح البند الأول لخطتها في كتابة السيرة الذاتية، أن تبدأ من خارج، ومن آخَر، لتصل إلى داخل، أو إليها، عكس ما يفعل الآخرون الذين ينطلقون من أناهم، وهي بؤرة السرد، ومن وما حولهم إنما هو امتداد لهم ومحيط، لا أكثر.
من الأب انتقلت إلى سرد قصة بطلتها، أمها، في رواية «Femme» (امرأة) (1987م) التي تستعيد فيها أيضًا مراحل من حياة امرأة عانت كثيرًا من أجل أسرتها، وأسهمت في رفعها من وهدة الفقر، فنقلتها من شقاء العمل الزراعي إلى تجارة متوسطة بين مقهى ومحل بقالة، وحرصت وهي على قدر متواضع من التعليم على أن تكفل دراسة لائقة لابنتها لتهيئها لمستقبل أفضل. وتبرز آني في سلسلة محكيات سرد ذكريات الأم المتفانية التي شقيت حتى احتضارها الطويل بمرض الزهايمر. ثم من الأمّ إلى أختٍ ماتت جنينًا في بطن الأم، باحت لها هذه الأخيرة بقصتها غفلة، فصوّرتها، مثّلتها، كائنًا حيًّا وسكبت حزنها عليها، وقدمتها فداءً لها لمّا أخبرتها أمُّها أن قرار الأسرة كان إنجاب طفل واحد، وقد ماتت لها أختٌ أخرى بالدفتيريا فعاشت مدينة للبنت الجنين بحياتها.
ذات في ذهاب وإياب
هكذا، ثمة آخرُ دائمًا يقابلها تروي قصته ليرتدّ إليها السهم أفقيًّا، ثم ينقلب عموديًّا يغوص حادًّا فيها وفي الوقت هو مرآة لها. فبين الأب والأم والأخت الركائزُ والأبعادُ والامتدادات، تنعكس صورتها وتنطِق سيرتُها. حيواتُ الآخرين وأوضاعُهم ولغتُهم قطعة منها، وهي إذ تسرد حكاياهم وتكتبهم إنما تسرد ذاتَها التي توجد في حركة ذهاب وإياب بينهم وبينها، مرئيةً وخفيةً، جهيرةً ومضمرة، على الرغم من أن بطل السيرة الذاتية تقليديًّا هو (أنا) صاحبها، مؤلفها، مبررُها ومشروعُها نوعًا؛ لكونها تروي حياته (لوجون).
 لكن إرنو تصنع معادلة مختلفة لأداء النوع الأدبي من داخله؛ إذ تقلّص أدبيته بصنع بنيته من عناصر حددتها في مركّب مثلث «شيء من الأدب والاجتماع والتاريخ»، وكل عنصر منها يصلح مدخلًا لدراسة متن هذه الكاتبة المخلخِلة والمكدِّرة لصفاءِ النوع وهي تنقله من نرجسية البطولة الفردية والتاريخ الشخصي المحض، لتلقي به في معترك اليومي من أجل العيش، وتجاعيد المجتمع والصراع الطبقي، في صيرورة تاريخية منطلقُها زمن الطفولة ومسارُها في سلسلة من المشاهد والأحداث والذكريات والمشاعر، تلاحقها ذاكرةٌ ملحاح، تقبض صاحبتُها على زمامها قبضها: «على الرغبة الجنسية، فالذاكرة لا تتوقف، إنها تلقّح الكلمات بالأحياء، الكائنات الحقيقية بالخيالية، الحلم بالتاريخ»، كما جاء في إحدى شذرات استهلال كتابها الجامع «Les années» (السنوات) (2008م) الذي سيضمن لها شهرة واسعة وسيرسّخها كاتبةَ سيرة ذاتية لزمنها ضمن قوسٍ قُزحي يكتبن النوع ذاتَه وتحولن إلى ظاهرة أدبية فرنسية مع تعدد وتباين تجاربهن وأساليبهن.
لكن إرنو تصنع معادلة مختلفة لأداء النوع الأدبي من داخله؛ إذ تقلّص أدبيته بصنع بنيته من عناصر حددتها في مركّب مثلث «شيء من الأدب والاجتماع والتاريخ»، وكل عنصر منها يصلح مدخلًا لدراسة متن هذه الكاتبة المخلخِلة والمكدِّرة لصفاءِ النوع وهي تنقله من نرجسية البطولة الفردية والتاريخ الشخصي المحض، لتلقي به في معترك اليومي من أجل العيش، وتجاعيد المجتمع والصراع الطبقي، في صيرورة تاريخية منطلقُها زمن الطفولة ومسارُها في سلسلة من المشاهد والأحداث والذكريات والمشاعر، تلاحقها ذاكرةٌ ملحاح، تقبض صاحبتُها على زمامها قبضها: «على الرغبة الجنسية، فالذاكرة لا تتوقف، إنها تلقّح الكلمات بالأحياء، الكائنات الحقيقية بالخيالية، الحلم بالتاريخ»، كما جاء في إحدى شذرات استهلال كتابها الجامع «Les années» (السنوات) (2008م) الذي سيضمن لها شهرة واسعة وسيرسّخها كاتبةَ سيرة ذاتية لزمنها ضمن قوسٍ قُزحي يكتبن النوع ذاتَه وتحولن إلى ظاهرة أدبية فرنسية مع تعدد وتباين تجاربهن وأساليبهن.
أبرزهن ماري داريوسيك، وفيرجيني ديمبانتي التي سارت على نهج مغاير تمامًا لنزوات الاستعراء ومركزية الأنا لتتحول إلى «سُرّة» العالم، أو ما يسميه النقد الإعلامي الفرنسي بالنزعة السُّرَرية (le nombrilisme) وهي ظاهرة مستفحلةٌ راهنًا. اختلفت فاعتنقت خط الأيديولوجيا الثقافية لأسلافها الملتزمين في الأربعينيات والخمسينيات، وهو التزام ولد معها في تربة الطفولة والفتوة، وترعرعت به مبادئ تعززت طوال مسيرة حياتها طالبة ومدرّسة مبرّزة ومناضلة في واجهات ومواقف سياسية مباشرة في صف قوى اليسار الفرنسي وإن لم تنتمِ إلى حزب. تخوض المعارك وتوقع البيانات من أجل المضطهدين وذوي الدخل المحدود، والشعوب والأوطان المغتصبة (منها قضية فلسطين). أقول جاء كتابها «السنوات» فسيفساء مركبة استدعت فيه -انطلاقًا من طفولتها حول مائدة العائلة- الحكاياتِ، صنيع الجدات قديمًا حول المدفأة ما جرى في سالف العصر والأوان، إنما بوعي وحذق فني.
ترجيح موضوعية الخطاب
أكتفي به مثالًا نموذجيًّا، فليس غرضي تتبع مجموع أعمالها، التي تمضي كلها طرديًّا في تزويج الذاتي بالجماعي. لا بد سينتبه القارئ إلى نقل التلفّظ من ضمير المتكلم (Je) إلى ضمير الجمع المتكلم (On و Nous) وإحالة الحديث عن الذات إلى سارد مرجعُه ضميرُ الغائب وهو ما يلجِم العاطفة ويُرجّح موضوعية الخطاب، خاصيةٌ نقيض تمامًا لتلقائية وانسيابية البوح الحميمي الدامغ للسيرة الذاتية منذ دشنها في شكلها الحديث جان جاك روسو (1712- 1778م) في «الاعترافات» (نشرت من 1765 إلى1770م) وحَبْك المصير الشخصي بالمسار العام، لا انفصال تزكّيه بقولها: «الحكيُ العائلي والحكيُ الاجتماعي عندي واحد».
اقتناعٌ مرصودٌ ومُرسَلٌ من منظور فلسفي وطبقي شبه أيديولوجي يخصّها من وحي إرادة تريد تصفية حساب مع ماضٍ تعيس وظالم من حيث تستعرض في «السنوات» صورَه وصورَها تباعًا، من سنوات الحرب العالمية الثانية إلى مطلع القرن الجديد. يا لها من بانوراما حافلة بالأحداث، حاشدة بالخلائق، مضطرمة بالمعارك، بِرقّة شفافة وتصوير دقيق ولاذع واحتجاج هامس تكتفي بتوجيه أصبع الاتهام بلا إدانة صريحة وبحياد ماكر. موقع ضمير المتكلم وفاعليته أن يتحول إلى رهان بين العمل والقارئ لتحدد أمامه هويتها إنسانًا وكاتبة، شخصيتها المركبة، همّها كما تُفصح عنها صراحة، «الانتقام» للشقاء المادي والمستوى الطبقي الوضيع الذي عاشته عائلتها.
في مؤلفها: «الكتابة مثل سكين» (2003م) دوّنت: «أكتب من أجل الانتقام لسلالتي (…) أردت أن أقول الطبقة الاجتماعية التي خرجت منها». هذا المبرّر الأول، ويأتي المبرّر الثاني الجارحُ، كما حملته منذ صارت في الوضع الاعتباري للكاتبة، وهو وضع محترم في المجتمعات الغربية، أن تقلّص المسافة بين انتقالها إلى موقع طبقي مرتفع قياسًا بالموقع الدوني لسلالتها المهانة؛ لذلك ليس عندها رأس مال أقوى من الكلمات، لتقول ما لا بد وما لا ينبغي أن يفلت وسيزول حتمًا. والصور التي ستزول حتمًا، الجناز الرهيب الذي تستهل به كتاب «السنوات»، مرثية للعالم والوجود. وهكذا من قلب الحميمي والاجتماعي والتاريخي ترتمي صريعة للتراجيدي.
إنما حذار، فهي ليست شكّاءةً، خَنسائيةَ الطبع، نوّاحة. سنرى كيف تطوّق الحميمي وترميه في حمأة المبتذل، بالكتابة عن العَرضي، التالف، العابر والزائل، بدقة في الفرنسية ephémère (قصير الأمد). تَنقّل البشر في المواصلات، الأسواق العامة، النسيان، الذاكرة، الإجهاض، إلخ.. كل ما ينتسب إلى زماننا الاستهلاكي اللاهث المتسارع والمتبدل، وما اختصر وصفه دومنيك فال، من بين أهم من درس أعمال النوبلية الجديدة، جاء في كتابه: «le temps des mémoires» (زمن الذاكرات) (2014م): [إنها] في قلب هموم العقود الأخيرة. وهي منتبهة سواء للإشكاليات الاجتماعية الكبرى -اختلاف الطبقات، التمايزات السوسيوثقافية، والمطالبات النسائية- وصولًا إلى قضايا حملها الفن والفكر أخيرًا إلى الواجهة من قبيل مسائل الذاكرة واليومي، الإرث والنسب، وهذا بقدر ما هي منخرطة بعمق في مناقشة الظواهر الأدبية الحاسمة مثل العودة إلى الذات، إلى التخييل الذاتي، أو المشاركة في المناقشات التي تربط الأدب الآن بالعلوم الإنسانية.

روح حيادية نابذة
قلت في مطلع هذه المقالة: إن للأدب شجرة أنساب؛ وأزيد شرحًا: إن الفنون الأدبية تتناسل من بعضها، ونصٌّ بلا ذاكرة، أي لم يتشرب تراث سابقيه ويتمثلها، ليس أدبيًّا أو هو لقيط. لذلك حين نلصق الصفات ونسقط الخصائص على النصوص ينبغي أن نعرف صلة النسب. فإذا قلنا: إن كتابة آني إرنو السِّيَر ذاتية متقشفةٌ ونابذةٌ للغنائية، متحفظةٌ من العاطفية، منخولةٌ من النعوت، مصبوبةٌ بروح حيادية متباعدة، مراقبة فاترة أكثر منها حامية في فرن الاستعارات، علينا هنا أن نستحضر بوعي ثقافي التراث السردي الغربي ابتداءً على الأقل من بلزاك الذي زرع أرض الواقعية، وفلوبير من أخصب تربتها بسماد دقة المفردة، ومنهما نصل إلى إميل زولا بنزعته التجريبية الطبيعية، وأندريه جيد في بيانه الباهر عن تداخل الأجناس في «مزيفو النقود» (1925م). هؤلاء جميعًا ومن في جِبِلّتهم، صنعوا القالب المتماسك للسرد الحديث تخييليًّا وأوتوبيوغرافيًّا بلغة وأساليب محكمة منزوعة الدسم، كذلك برؤية معبرة بعمق عن الانقلابات الحاسمة للزمن الصناعي والرأسمالي وديمومة حركة الأنوار بأشكال متطورة. بصماتُهم مطبوعةٌ في نصوص إرنو -لا ننسى أنها مُبرّزة في الأدب الحديث- وهي تلميذة نجيبة في مدرسة بروست الذي دشن ثورة الذاكرة في الرواية الحديثة بداية القرن العشرين. ما تشغيل التذكر عندها قياسًا بطوفانه في «البحث عن الزمن الضائع» إلا نقطة في بحره، ناهيك عن ناتالي ساروت، بدفق تيار الوعي، بعده.
ولكي نجزم في البنية الكلاسيكية المتوارثة للشكل الآرني والمنظور المادي الواقعي المحزوز كحدّ السكين لأعمالها، من الضروري استحضار متنين هما عماد الرواية الفرنسية خلال وبعد الحرب العالمية الثانية: «الغريب» لألبير كامو (1942م) و«المماحي» (1953م) لألان روب غرييه عرّاب مدرسة الرواية الجديدة. هذا النص الأخير نفسه الذي بنى عليه رولان بارت بدايات نقده الأدبي والسيميائي، واشتق منه مصطلح (الكتابة في درجة الصفر)، الواصفة الشيئية العينية المادية صرفًا اللاأدبية، المعادية للنزعة السيكولوجية. هذا كله يطبع أعمال إيرنو، وأقول، بالاحتكام إلى النصوص دائمًا: إنها دون ما أنجزه المعلمون الرواد في هذا الفن، سواء روائيًّا أو مزجًا بين الرواية وسيرة الذات، وهي ابنة شرعية في آن لمنجزهم، وإن لي أن أحتفظ لها بامتيازين:
أولًا- أنها كتبت ما عاشت ووعت بحسّية وذاكرة خصبة ووعي فنّي حاذق وبلغة مسكوكة، أيضًا، بلا قلق من ضوابط الجنس الأدبي وحدوده، فجاء سردها متراوحًا بين النوع الروائي والنوع السير ذاتي ونوع التخييل الذاتي (أنا عبر آخر) السائد حاليًّا، على الرغم من رفضها الانتساب إليه، وأساليب التقرير واليوميات والانطباعات والمَحاضر. استخدمت هذه الطرائق جميعها لتسُنّ طريقتها لها اسم: نسق الحميمي والجماعي كلٌّ واحد.
ثانيًا- جعلت حميميتها المسرودة في خدمة جماعة ولدت فيها وأخلصت لها، وواظبت منتمية لهمومها ومعضلات عيشها مناهضة للظلم والتفاوت الطبقي الفاحش ومناضلة من أجل قيم منبتها يعود إلى الثورة الفرنسية وعهد الأنوار وامتدت في الالتزام السارتري بمسؤولية الإنسان في الوجود، وهي كاتبة ملتزمة، شعلةٌ تكاد تأفل عند كتاب وكاتبات زمانها وزماننا.


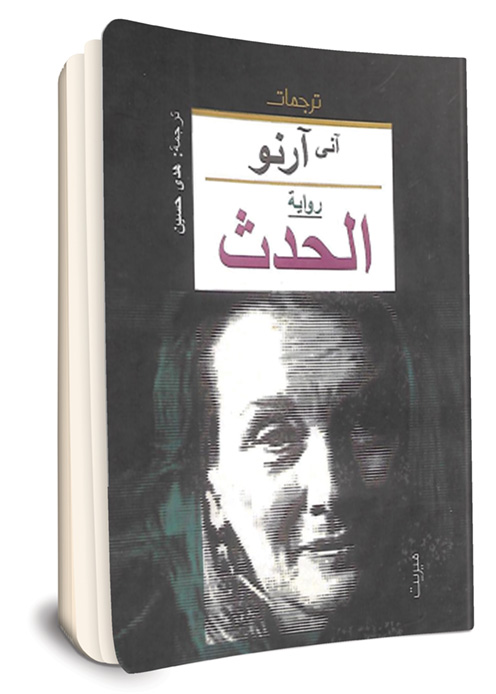 أقول، نحتاج إلى التأنّي في قراءة حدث الفوز بنوبل، وإلى قدر لا بأس به من التبصّر لقراءة المتن مناط الاهتمام، أوله أن ننتبه إلى أن للأدب ذاكرة فلا يوجد نصٌّ أدبيٌّ مفردٌ ومقطوعُ الجذور، مهما بلغ تفوقُه ونبوغُ مُنشئِه، له شجرة أنساب ينتمي إليها وباتصاله مع جذورها تتحدد خصائصه ونوع من يتميز به غصنًا وورقة وزهرة وثمرة ورائحة. نعني أن إرنو -بالرؤية والمحتوى المكوّنين لسردها الذاتي الذي سنشرح مضماره، وباللون الغالب عليه، الصانع لنسيجه- هي بنت تقاليد أدبية تليدة لها آباءٌ وجدات، هم وهن من وضَع اللبنات الأولى لما غدا صرحًا عالي البنيان، ينبغي أن نستحضر فيه من كتابة الوجدان النسائي أسماء لا غنى عنها: مدام لافاييت مؤلفة «أميرة كليف»(1678م)، وجورج ساند (1804- 1876م) صاحبة «أنديانا» (1839م)، و«قصة حياتي» (1855م)، وخصوصًا كوليت (1873- 1954م) في سلسلة «كلودين» (1900- 1903م)، و«ولادة النهار» (1928م)، ونقفز إلى سيمون دوبوفوار (1908- 1986م) التي أطلقت فلسفيًّا من باريس موجةً تحرر بكتابها «الجنس الثاني» (1949م) صوت تفتح المرأة وكيانيتها المستقلة، وعززته بـ«قوة العمر» (1960م). ونضيف إلى هذا السرب مغردتين قويتين هما فرنسواز ساغان (1935- 2004م) بالذات في باكورتها «صباح الخير أيها الحزن» (1954م) والأقوى منها إبداعًا والتزامًا مارغريت دوراس (1914- 1996م) لرواياتها الذاتية ونموذجها النقدي المعتمد «العشيق» (1984م) التي تُوِّجت سنتها بجائزة الغونكور المرموقة.
أقول، نحتاج إلى التأنّي في قراءة حدث الفوز بنوبل، وإلى قدر لا بأس به من التبصّر لقراءة المتن مناط الاهتمام، أوله أن ننتبه إلى أن للأدب ذاكرة فلا يوجد نصٌّ أدبيٌّ مفردٌ ومقطوعُ الجذور، مهما بلغ تفوقُه ونبوغُ مُنشئِه، له شجرة أنساب ينتمي إليها وباتصاله مع جذورها تتحدد خصائصه ونوع من يتميز به غصنًا وورقة وزهرة وثمرة ورائحة. نعني أن إرنو -بالرؤية والمحتوى المكوّنين لسردها الذاتي الذي سنشرح مضماره، وباللون الغالب عليه، الصانع لنسيجه- هي بنت تقاليد أدبية تليدة لها آباءٌ وجدات، هم وهن من وضَع اللبنات الأولى لما غدا صرحًا عالي البنيان، ينبغي أن نستحضر فيه من كتابة الوجدان النسائي أسماء لا غنى عنها: مدام لافاييت مؤلفة «أميرة كليف»(1678م)، وجورج ساند (1804- 1876م) صاحبة «أنديانا» (1839م)، و«قصة حياتي» (1855م)، وخصوصًا كوليت (1873- 1954م) في سلسلة «كلودين» (1900- 1903م)، و«ولادة النهار» (1928م)، ونقفز إلى سيمون دوبوفوار (1908- 1986م) التي أطلقت فلسفيًّا من باريس موجةً تحرر بكتابها «الجنس الثاني» (1949م) صوت تفتح المرأة وكيانيتها المستقلة، وعززته بـ«قوة العمر» (1960م). ونضيف إلى هذا السرب مغردتين قويتين هما فرنسواز ساغان (1935- 2004م) بالذات في باكورتها «صباح الخير أيها الحزن» (1954م) والأقوى منها إبداعًا والتزامًا مارغريت دوراس (1914- 1996م) لرواياتها الذاتية ونموذجها النقدي المعتمد «العشيق» (1984م) التي تُوِّجت سنتها بجائزة الغونكور المرموقة. لكن إرنو تصنع معادلة مختلفة لأداء النوع الأدبي من داخله؛ إذ تقلّص أدبيته بصنع بنيته من عناصر حددتها في مركّب مثلث «شيء من الأدب والاجتماع والتاريخ»، وكل عنصر منها يصلح مدخلًا لدراسة متن هذه الكاتبة المخلخِلة والمكدِّرة لصفاءِ النوع وهي تنقله من نرجسية البطولة الفردية والتاريخ الشخصي المحض، لتلقي به في معترك اليومي من أجل العيش، وتجاعيد المجتمع والصراع الطبقي، في صيرورة تاريخية منطلقُها زمن الطفولة ومسارُها في سلسلة من المشاهد والأحداث والذكريات والمشاعر، تلاحقها ذاكرةٌ ملحاح، تقبض صاحبتُها على زمامها قبضها: «على الرغبة الجنسية، فالذاكرة لا تتوقف، إنها تلقّح الكلمات بالأحياء، الكائنات الحقيقية بالخيالية، الحلم بالتاريخ»، كما جاء في إحدى شذرات استهلال كتابها الجامع «Les années» (السنوات) (2008م) الذي سيضمن لها شهرة واسعة وسيرسّخها كاتبةَ سيرة ذاتية لزمنها ضمن قوسٍ قُزحي يكتبن النوع ذاتَه وتحولن إلى ظاهرة أدبية فرنسية مع تعدد وتباين تجاربهن وأساليبهن.
لكن إرنو تصنع معادلة مختلفة لأداء النوع الأدبي من داخله؛ إذ تقلّص أدبيته بصنع بنيته من عناصر حددتها في مركّب مثلث «شيء من الأدب والاجتماع والتاريخ»، وكل عنصر منها يصلح مدخلًا لدراسة متن هذه الكاتبة المخلخِلة والمكدِّرة لصفاءِ النوع وهي تنقله من نرجسية البطولة الفردية والتاريخ الشخصي المحض، لتلقي به في معترك اليومي من أجل العيش، وتجاعيد المجتمع والصراع الطبقي، في صيرورة تاريخية منطلقُها زمن الطفولة ومسارُها في سلسلة من المشاهد والأحداث والذكريات والمشاعر، تلاحقها ذاكرةٌ ملحاح، تقبض صاحبتُها على زمامها قبضها: «على الرغبة الجنسية، فالذاكرة لا تتوقف، إنها تلقّح الكلمات بالأحياء، الكائنات الحقيقية بالخيالية، الحلم بالتاريخ»، كما جاء في إحدى شذرات استهلال كتابها الجامع «Les années» (السنوات) (2008م) الذي سيضمن لها شهرة واسعة وسيرسّخها كاتبةَ سيرة ذاتية لزمنها ضمن قوسٍ قُزحي يكتبن النوع ذاتَه وتحولن إلى ظاهرة أدبية فرنسية مع تعدد وتباين تجاربهن وأساليبهن.
