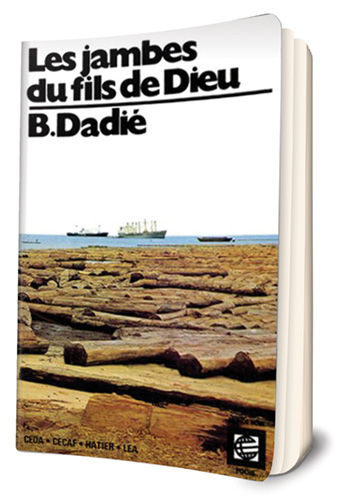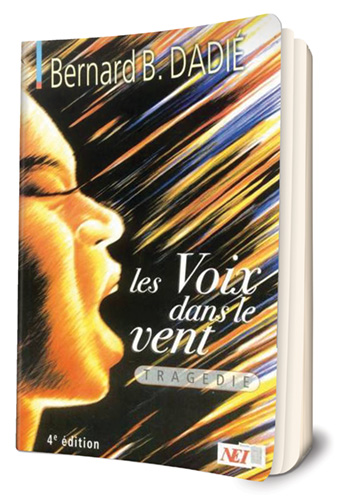جمال الجلاصي - روائي ومترجم تونسي | يناير 1, 2025 | فضاءات
بمناسبة ولادة السلسلة الأدبية الجديدة «العودة إلى البيت»، التي أطلقتها دار نشر فلاماريون، التي تدعو الكتّاب لقضاء أربع وعشرين ساعة في مكان طفولتهم، وافقت مازارين بينجو الابنة السرية للرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران وآن بينجو أستاذة تاريخ الفن، على العودة للمرة الأولى إلى الشقة الباريسية التي عاشت فيها «سريًّا»، من سن التاسعة إلى السادسة عشرة مع والدتها أمينة متحف برانلي، ووالدها فرانسوا ميتران، بالقرب من ألما، في الدائرة السابعة.
في 10 نوفمبر 1994م شاهد عموم الناس صورة التقطها المصوران بيير سو وسيباستيان فالييلا لفرانسوا ميتران وابنته، وهما يغادران مطعم لو ديفالاك. نُشرت الصورة في مجلة باري ماتش الأسبوعية في العدد 2372، وقد أُبلِغَ رئيس الجمهورية مسبقًا وأعطى موافقته على هذا النشر، وبالتالي الكشف عن وجود ابنته المخفية طيلة عشرين عامًا.
أن تحب يعني أن تكف عن محاولة الفهم
في فجر عيد ميلادها الخمسين وافقت مازارين، التي سُمّيت على اسم أقدم مكتبة في فرنسا نظرًا لولع أبويها بالكتب، على مواجهة أشباح هذه الحياة السرية وقضاء أربع وعشرين ساعة في ذلك البيت، الذي جمعها بوالديها. تتذكر المطبخ، الغرفة الأكثر متعة، الغرفة التي يتناول فيها ثلاثتهم وجبة الإفطار في أثناء الاستماع إلى الراديو الذي يتحدث عن والدها. هناك أيضًا لعبة المطاط والكراسي الموجودة في القاعة، وأعمالها المدرسيّة ومقالاتها المتروكة لملحوظات والدها. تدخل وتخرج في سيارة مع اثنين من الحراس الشخصيين. لا ضيوف ولا ألعاب في الفناء مع الأطفال الآخرين الذين كانت تراقبهم مختبئة خلف الستائر.
 تتجوّل في هذه الأماكن التي تغيرت، وتعود أشباح الماضي إلى الظهور. تستعيد الروائح والأصوات ولمحات اللحظات والكلمات، وتثير أحاسيس غريبة يصعب استرجاعها.
تتجوّل في هذه الأماكن التي تغيرت، وتعود أشباح الماضي إلى الظهور. تستعيد الروائح والأصوات ولمحات اللحظات والكلمات، وتثير أحاسيس غريبة يصعب استرجاعها.
«لقد عشت مع والديّ في رصيف برانلي، من التاسعة إلى السادسة عشرة من عمري. وهو ما يتوافق مع ما نسميه مرحلة المراهقة. لم يكن ديكورًا فقط، بل قبرًا أيضًا. كانت شقة وظيفية فارغة، ولا شيء يمكن أن يملأها، خصوصًا أنا. كنت شبحًا، لا يمكن لأحد أن يعرف وجودها في هذا المكان الذي لم يكن لها، ولا هو، ولا لهم. قضيت مراهقتي في سكن عابر حيث لا يعبر أحد. منزلي لم يكن منزل أحد».
حتى بعد تلك السنوات الطويلة، ظل الشعور بالحبس يحاصرها ويكتم أنفاسها إلى حدّ أنّ امرأة اليوم رفضت النوم في المنزل الذي كان سجن تلك الفتاة الصغيرة، فهي لم تعد تلك «الجندية الصغيرة المطيعة»، بل غدت امرأة حرة. غادرت المنزل في آخر المساء وعادت في اليوم التالي، واتصلت بوالدتها لتشاهدا معًا كل غرفة وتستعيدا ذكرياتهما. ثم تترك المفاتيح وتغادر، دون أن تهرب كما فعلت عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.
«هناك جراح في الطفولة نقضي حياتنا في محاولات يائسة لمداواتها دون أن تندمل».
تتحدث مازارين بينجو عن حادثة مؤثرة جدًّا في حياتها، وهي هروبها من بيت عائلتها عندما كانت في سن السادسة عشرة. هذه الحادثة كانت نابعة من شعورها العميق بالتوتر والضغط الناجم عن الحياة السرية التي كانت تعيشها كابنة غير معلنة للرئيس فرانسوا ميتران. كانت مازارين تشعر بثقل السرية التي فُرضت عليها؛ إذ لم يكن بإمكانها أن تعيش حياة طبيعية كأي مراهقة. والدها كان شخصية عامة وسياسية مهمة، بينما علاقتها به كانت في الخفاء. هذا الواقع أدى إلى شعورها بالاختناق والحاجة إلى الهروب من هذا العبء الثقيل. الهروب كان وسيلتها للتعبير عن رفضها لهذا الوضع المعقّد، حيث كانت تسعى إلى استكشاف هويتها الخاصة بعيدًا من ظل والدها الضخم. كان هذا الهروب، في جوهره، محاولة للتخلص من السرية التي حرمتها من الاستقلالية والهوية الذاتية. لكنها في النهاية، عادت إلى بيتها بعد أن واجهت صعوبة العيش وحدها والتأقلم مع الحياة بعيدًا من عائلتها. «أن تحب يعني أن تكف عن محاولة الفهم» هكذا تلخص مازارين غموض ذلك الرجل الذي يزورهم خفية ليلًا ويغادر وهي نائمة.
الزلزال
«بعضٌ يخاف مني، سري يصدّهم، هم لا يعرفون عنه شيئًا، لديهم فقط بعض الشكوك، لكن السر ظاهر، له وجه حزين، عبوس مغلق، نظرة باهتة. سر يرتدي اللون الأسود، ويبعث موجات مشعة، ربما لأننا نحترق به حتى دون أن نقترب منه».
تحدثت مازارين بينجو عن الكشف العلني لعلاقتها بميتران: كانت لحظة الكشف العلني عن هوية مازارين كابنة لميتران شكلت حادثة كبيرة في فرنسا. حادثة الكشف العلني عن هوية مازارين بينجو ابنة للرئيس فرانسوا ميتران كانت لحظة حاسمة وصعبة في حياتها.
«كان الكشف كالزلزال. لقد انفتح العالم كله على ما كان سريًّا وأكثر حميمية، وملجئي وعبئي».
هذا الحدث كان له تأثير كبير في حياتها الشخصية والعامة. مازارين نشأت في ظل السرية، وكان الأمر محصورًا ضمن دائرة ضيقة من العائلة والمقربين فقط. لهذا السبب، شعرت بصدمة شديدة عندما نُشِرَتْ هويتُها علنًا. «كأنّ كلّ شيء لم يكن سوى كذبة، ثم أصبح أكثر وضوحًا، لكنه وضوح مؤلم». لقد فقدت جزءًا كبيرًا من خصوصيتها وحياتها الهادئة التي كانت تحاول الحفاظ عليها. كما شعرت بأن هذا الكشف كان تدميرًا للحدود التي كانت قد وضعتها بينها وبين العالم الخارجي. «يوم عرف كل العالم من أكون، أحسست أن حياتي لم تعد ملكي (…) الأضواء التي أحاطتني أحرقتني، لم أعد شخصًا، صرت سرًّا مكشوفًا».

التعامل مع الإعلام
بعد هذا الكشف، غدت مازارين محط اهتمام وسائل الإعلام بشكل غير مسبوق. أصبحت الصحافة ووسائل الإعلام الفرنسية تلاحقها بشدة، وبدأت الصحف والمجلات تتناول حياتها الشخصية بتفاصيل دقيقة. هذا الهجوم الإعلامي كان يمثل تحدّيًا نفسيًّا كبيرًا لها؛ إذ كان يسحب منها حقها في الخصوصية، مما جعلها تواجه ضغوطًا كبيرة من أجل التكيف مع هذا الاهتمام العام. «طيلة سنوات، كنت تلك الفتاة السرية، ثم في لحظة، لم أعد سوى اسم في الصحف، فعلًا، هل ظللت حقًّا أنا؟»
«نحمل في داخلنا سرًّا لا يمكننا مشاركته لكننا ننتهي في الأخير بأن نكون تجسيدًا له».
التأثير العاطفي والنفسي
«نعتقد أننا جاهزون للحدث، ولكن حين يقع نحس بالتحطم، كأن الأرض تحتنا قد انهارت».
من الناحية العاطفية، يمكن القول: إن مازارين شعرت بالاضطراب والغضب من حقيقة أن سرها قد انكشف بهذا الشكل. كانت ترى في هذا الحدث جزءًا من عملية انتهاك لخصوصيتها وحقها في اختيار متى وكيف يُعَرَّفُ بها علنًا كابنة لرئيس الجمهورية. «ليست الحقيقة ما تخيفنا، إنها لحظة انبثاقها المدمرة التي يمكن تجاوزها». هذا الكشف جلب معه مشاعر متناقضة، من بينها الإحراج، والغضب، والحاجة إلى إعادة تشكيل هويتها في العلن، بعد سنوات من العيش في الظل. «استحضار النظرات الخارجية التي تدقق وتقاضي وتتبدّل منذ اللحظة التي تنتقل فيها الفتاة الصغيرة من الهوية السرية إلى النور الساطع».
وينتقل إلينا هذا الشعور بالانزعاج والصدمة والتمرد الضمني الذي يجب أن يشعر به كل إنسان عندما يقع في شبكة النظرات غير الرحيمة.
الانعكاسات على علاقتها بوالدها
في الوقت نفسه، كان لهذا الكشف تأثير في علاقتها بوالدها، حيث كان هذا الأخير قد حافظ على هذه العلاقة في السر لأسباب سياسية وشخصية. بعد الكشف، أصبحت العلاقة بينهما أكثر علنية، لكنها أيضًا أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب ضغط الإعلام والانتباه العام.
«بعد كل هذا الوقت الذي أفضيت خلاله بأسراري، وجدت نفسي مضطرة إلى إعادة النظر في أسراره، كما لو أن حقيقتنا لم تعد كما كانت قطُّ» نحسّ بالصراع الداخلي للكاتبة، التي أعادت تعريف علاقتها بوالدها بعد معرفة الحقيقة. «لم يعد بيننا أي تواطؤ، فقط صمت ثقيل، وكأن هذا السر قد محا كل شيء». بمجرد الكشف عن السر، يصبح عقبة لا يمكن التغلب عليها، مما يؤدي إلى قطع الاتصال وتغيير العلاقة بين الأب وابنته بشكل عميق. «لم يعد والدي، لقد أصبح رجلًا كذب عليّ، ومنذ تلك اللحظة لم أعد أستطيع الوثوق به كما كان الأمر من قبل». يسلط هذا الاقتباس الضوء على انهيار الثقة الذي يحدث بعد الكشف عن السر. لم يعد يُنظر إلى الأب كشخصية حامية، بل كشخص خان هذه الثقة. «إن إفشاء السر لم يقرّبني منه، بل أظهر مسافة لم أكن أدركها». لقد انكسرت الثقة بينهما إلى الأبد.

القبول والتأقلم مع الوضع
في نهاية المطاف، تعلمت مازارين التكيف مع هذه الظروف الجديدة. أصبحت أكثر حذرًا في تعاملها مع الإعلام، وبدأت تستثمر في الكتابة للتعبير عن نفسها. الكتابة منحتها الفرصة للتحدث عن تجربتها الشخصية بطريقة أكثر تحكمًا وخصوصية، بعيدًا من ضغوط الإعلام. بشكل عام، كان الكشف العلني عن هويتها لحظة محورية في حياتها، حيث تحدّت هذه الحادثة مفهومها عن الهوية الخاصة والخصوصية، وعادت لتجد طريقة جديدة للتفاعل مع العالم الذي أصبح يعرفها بشكل مختلف.
رحيل الوالد وتداعيات وفاته
منذ أن كُشفت علاقتها بوالدها، أصبحت مازارين محط أنظار الصحافة والإعلام الفرنسي، وتعرضت لكثير من الضغط الإعلامي الذي حاول استكشاف حياتها الخاصة وعلاقتها بوالدها. هذا أدى بها إلى تطوير علاقة معقدة مع الإعلام، حيث كانت تحاول حماية حياتها الخاصة والتأقلم مع الشهرة المفروضة عليها.
على الرغم من أن مازارين بينجو لم تتحدث عن وفاة فرانسوا ميتران بطريقة مباشرة وصريحة، في «11 رصيف برانلي»، فإنها تستحضر غيابه وتداعيات وفاته من خلال تأملات أكثر دقة حول الحداد والذاكرة.
«رحل بلا صوت، كأنه لم يكن هنا، كأنه ظل عابر». على الرغم من كونه شخصية عامة كبيرة، يتلاشى بالموت، تاركًا وراءه شعورًا بالفراغ والصمت. تتحدث مازارين بينجو عن الأثر الذي تركه موت والدها، مؤكدة أنه حتى بعد اختفائه، فإن الصمت الذي أحاط به خلال حياته هو كل ما تبقى: «لقد أخذ الموت كل ما بقي منه، باستثناء هذا الصمت الذي كان يرافقه دائمًا والذي هو اليوم الشاهد الوحيد».
«أواصل الحديث معه، وكأن شيئًا لم يحدث، وكأن الكلمات يمكن أن تملأ المساحة الهائلة التي تركها وراءه».
«لقد جعله الموت غريبًا، ومع ذلك ما زلت أبحث عنه، في حركاتي اليومية، في الكلمات التي أفتقدها».
في هذا التأمل، تستحضر الكاتبة صعوبة الاستمرار في العيش بعد فقدان والدها، والبحث عن أجزاء منه في الأشياء الصغيرة في الحياة اليومية. «لم يعد هنا، لكنّ حضوره يطاردني في ثنايا ذاكرتي، كصورة قديمة لا نجرؤ على النظر إليها أبدًا».
الأم المعلنة
«يتردد صوت أمي في قراراتي، ليس كأمر، بل كصدى يرشدني».
«هناك جزء من والدتي في كل ما أنا عليه، حتى فيما أردت الهروب منه. إنها هناك، مثل الظل الناعم، حضور لا أستطيع تجاهله». إذا كان الأب الرئيس خفيًّا وسريًّا بحكم منصبه ومكانته فإن الأم آن بينجو كانت دائمة الحضور على الرغم من وظيفتها أمينةَ متحف رصيف برانلي.
«إن أمهاتنا تعلّمننا أكثر بكثير من مجرد الإشارات أو الكلمات. إنهن ينقلن إلينا طريقة لرؤية العالم، والشعور بالأشياء، غالبًا دون أن نعرف ذلك».
يستحضر هذا المقطع الطريقة الدقيقة التي تستمر بها الأم في مرافقة أطفالها حتى من مسافة بعيدة. وتكشف الاقتباسات التالية عن نظرة معقدة للعلاقة بين الأم وابنتها، بين الميراث والإسقاط.
«أن تكون ابنة يعني أن تتحمل ثقل ما لم تتمكن الأم من تحقيقه، ولكن أيضًا الفخر بما تمكنت من نقله».
«إنك لا تفهمين والدتك حقًّا إلا عندما تصبحين أنت أمًّا. عندها يأخذ الصمت والحركات والغياب معناه الكامل».
كما تعكس هذه التأملات حساسية خاصة تجاه الروابط العائلية، وهي حساسية نموذجية في كتابات مازارين بينجو.

من دور الابنة إلى دور الأم
تمر مازارين بينجو بشكل سلس إلى موضوع الأمومة، مستوحية تجربتها الخاصة كأم. فتتناول تعقيد العلاقة بين الأم والطفل بأسلوب حميمي. فتسرد لنا بشيء من التأمل في المشاعر والتحديات المتناقضة المتعلقة بالأمومة، وتتطرق إلى التوقعات والتضحيات الشخصية. إنها طريقة لمشاركة بعض تجاربها مع منحها بعدًا أدبيًّا وخياليًّا.
«أن تكوني أمًّا يعني قبول فكرة الذوبان قليلًا كل يوم في عيون الآخرين، ونسيان نفسك للسماح لهم بابتكار أنفسهم بشكل أفضل». تتجنّب مازارين عقد أيّ مقارنة بين علاقتها بأبويها وعلاقاتها بأبنائها وتكتفي بعرض تجربتها بشيء من الحكمة الناتجة عن التجربة الشخصية: «هناك لحظات نتساءل فيها عما إذا كنا نعيد إنتاج الإيماءات والكلمات التي رأيناها وسمعناها، دون وعي، وما إذا كانت أمومتنا مجرد انعكاس لمن سبقونا».
«نحن نحب حبًّا لم نعتقد أنه ممكن، لكن هذا الحب لا يخلو من الألم. كل ضحكة وكل ابتسامة طفل تقربنا قليلًا من القلق والخوف من الخسارة».
تكشف بينجو لنا بوضوح كيف تقترب من الأمومة بنوع من التناقض، بين الحب العميق والخسائر الشخصية، وهي القوة العاطفية لهذه السيرة، وهنا تصل السيرة عمقها الإنساني فتنسى أو تتناسى معاناتها الشخصية مندفعة نحو العطاء: «الأمومة ليست مسألة معرفة، إنها وجود، انغماس مستمر فيما لا يمكن التنبؤ به… فأن تكوني أمًّا يعني أن تتخلي تدريجيًّا عن السيطرة على حياتك، وتضعيها في يد كائن أنجبته بنفسك».
«إن مفارقة الأمومة هي الحاجة إلى أن تكون كل شيء بالنسبة للطفل، مع العلم أنه في يوم من الأيام سوف يهرب منا، وأنه سيكون غريبًا عن حبنا». تُظهر هذه المقاطع كيف تستكشف بينجو عمق الأمومة، وتناقضاتها وتخليها عن رغباتها الشخصية وعن الطريقة التي تغير بها الحياة والإدراك الذاتي.
«بمرور الوقت، أكتشف أن الأمومة هي سلسلة من التنازلات، ولكنها أيضًا عبارة عن اكتشافات داخلية، لجوانب من الذات لم نكن ندركها… أنظر إلى طفلي وأعلم أنني أحبه أكثر من أي شيء آخر، لكنني أكتشف أيضًا أن هذا الحب يفضحني كما لم يحدث من قبل، ويجعلني ضعيفة وقوية في الوقت نفسه».
الكتابة وسيلة للتحرر
«أكتب حتى لا أنسى، حتى لا أُنسى».
تتطرق مازارين بينجو لدور الكتابة قي حياتها منذ الطفولة، فهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبحث عن الهوية والذاكرة والمواجهة مع الماضي. تصبح الكتابة، طوال الكتاب، وسيلة للاستكشاف الشخصي والتعبير عن المشاعر الخفية. تستخدم الطفلة والمراهقة والشابة الكتابة؛ لفهم تاريخ عائلتها المعقد والتصالح معه. «الكتابة سرّ نمنحه لأنفسنا، وسيلة لنقول لأنفسنا ما لا نجرؤ على قوله للآخرين». من خلال الكتابة، تدعونا مازارين بينجو إلى التعمّق في فجوات الذاكرة، حيث الذكريات مجزأة، وغير واضحة، وغالبًا ما تكون مشوبة بما لم يُقل: «الكتابة هي أفضل ما وجدته لأعرف من أنا».
وهكذا تصبح الكتابة محاولة لإعادة بناء الماضي، لعالم تبدو فيه الحقيقة أحيانًا بعيدة المنال، وحيث يكون الصمت العائلي ثقيلًا. من خلال الكتابة، تحاول فهم العلاقات الأسرية وفهم الوقت الذي يتسم بظلِّ الأب والأسرار والصراعات التي لم تحلّها. تتيح الكتابة أيضًا استكشاف كيفية نظر الكاتبة إلى نفسها وإلى الآخرين، ولا سيما في سياق التوترات بين الحياة العامة والخاصة: «كل كلمة هي خطوة نحو ما لا أعرفه عن نفسي، نحو ما يفلت مني الذي أتمنى أن أفهمه». تسلط السيرة الذاتية الضوء على تأثير التاريخ الشخصي والسياق العائلي في الطريقة التي تبني بها الفتاة قصتها وترويها. تصبح هذه الكتابة عملية علاجية ومحرِّرة في كثير من الأحيان، وهو ما يسمح للراوية بالتصالح مع ماضيها: «الكتابة هي عملية اكتشاف وفهم، حيث تسمح لك كل كلمة مكتوبة بالكشف عن جزء من نفسك ظل مدفونًا أو بعيد المنال».
أخيرًا، تستخدم مازارين بينجو الكتابة في «11 رصيف برانلي»؛ للتشكيك في مكانة الفن والثقافة في المجتمع المعاصر، ولا سيما من خلال وجود متحف رصيف برانلي، الذي يعد خلفية للتفكير في العلاقة بالتاريخ والذاكرة والهوية. وهكذا بُنِيَت الرواية كنوع من السرديات الكبرى، حيث تصبح الكتابة فعل مقاومة في مواجهة الغموض والشكوك في العالم الحديث.
«هناك ذكريات يجب أن نجبرها على الكلام، وأصوات يجب أن نوقظها، فالكتابة هي وسيلة لإجبار الصمت على التكلم». يعكس هذا الاقتباس قدرة الكتابة على كسر صمت الأسرة، البعيدة أو المدفونة، وإعطاء صوت للقصص والذكريات التي لم تُسرَد بعد. تظهر هذه الاقتباسات بوضوح أن الكتابة، في «11 رصيف برانلي»، هي أداة للذاكرة والتحرّر وطريق للمصالحة مع الماضي المعقّد والمخفي في كثير من الأحيان.
«لكي تكتب، يجب ألا يكون لديك أي دين. لا ندين بأي شيء لأحد. فماذا تفعل بالميراث الذي تُذَكَّرُ به باستمرار؟ هذا الدين يشبه الكرة والسلسلة، وهو ما تريد أن تتحمله أيضًا؛ لأنك لا تستطيع أن تكون جزءًا من المجموعة التي تكره».
قامت مازارين بينجو بنزع الكلمات من ذاكرتها لنقشها بقوة على الورق وفهم علل حياتها كامرأة. حكايتها المهداة لوالدتها محتشمة ومؤثرة ورائعة.
يصبح متحف كيه برانلي، الذي يعد شخصية في حد ذاته، المكان الرمزي لبحثه عن الهوية. وتصف بينجو هذا المتحف بأنه «مساحة يلتقي فيها الماضي بالحاضر، حيث يروي كل قطعة قصة يمكن إعادة تفسيرها». ومن خلال زياراتها، تكتشف البطلة ثراء التنوع الثقافي، وهو ما يشجعها على توسيع رؤيتها للهوية. يصبح كل معرض فرصة للمواجهة والتأمل، وهو ما يسمح له برؤية أن تراثه، على الرغم من أنه مليء بالألم، هو أيضًا مصدر للثروة.
طوال رحلتها، تتعلم كيفية احتضان تراث عائلتها المعقد. يصبح تطور شخصيتها واضحًا: من البحث اليائس، تنتقل إلى قبول أكثر هدوءًا. تكتب: «في بعض الأحيان، بالنظر إلى الوراء، يمكننا المضي قدمًا».
أسلوب مازارين السردي يطغى عليه الشعري والنضج الفكري والعمق. إنها تستخدم استعارات غنية للتعبير عن مشاعرها، وهو ما يخلق جوًّا غامرًا. تضيف الأوصاف المثيرة للذكريات لباريس والمتحف بُعدًا حسيًّا إلى العمل، وهو ما يعزز تأثير التجارب التي عاشتها. تتخلل الكتابة تأملات عميقة حول الذاكرة والهوية، كما هي الحال عندما تدرك البطلة: «ذكرياتنا كنوز، لكنها يمكن أن تكون أيضًا أعباءً».
أشاد النقاد بهذا العمل لعمقه النفسي. وأشارت صحيفة لوموند إلى أن «بينجو نجحت في التقاط جوهر جيل يبحث عن المعنى، مع استكشاف تعقيدات العلاقات الأسرية». وبالمثل، أشار أحد النقاد من تيليراما: إلى أن «المتحف يوضح تمامًا الصراع الداخلي للبطلة، حيث يعمل ملجأً ومرآةً في الوقت نفسه».

جمال الجلاصي - روائي ومترجم تونسي | سبتمبر 1, 2022 | ثقافات
«الكتابة بالنسبة إليّ هي الرغبة في درء الظلام
والرغبة في فتح نافذة على العالم لكل إنسان». برنار دادييه
إلى جانب ليوبولد سيدار سنغور وإيمي سيزير، يظل الكاتب برنار دادييه أحد أكثر الشخصيات شهرة في الأدب الإفريقي الناطق بالفرنسية. لقد ساهم بنشاط كبير في كل المحطات البارزة في التاريخ الأدبي لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال استكشاف أجناس أدبية مختلفة. وهذا من خلال إدراكه، طوال حياته، توازنًا معينًا بين تعطشه للكتابة والوقائع السياسية التي واجهها ولم يكن له مفر منها. كان الإيفواري شاعرًا، وروائيًّا، ورجل مسرح، وسياسيًّا أيضًا، ووزيرًا للثقافة في حكومة هوفويت بوانيي. قريبًا من الجبهة الشعبية الإيفوارية، دافع عن لوران غباغبو في أثناء سجنه منذ عام 2011م في مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (هولندا). كاتب «كليمبي» وغيرها من الأعمال التي أصبحت من كلاسيكيات الأدب الإفريقي، أول كاتب إفريقي يحتفل بمرور مئة عام على ولادته.
ولد الكاتب في عام 1916م في أسّيني، ليس بعيدًا من أبيدجان، على ضفاف المحيط الأطلسي، وترعرع في عائلة حيث النضال والسياسية والالتزام لم تكن مجرد كلمات فارغة. كان والده مؤسس أول اتحاد زراعي إفريقي. حرص هذا الأب المناضل، الذي وقف ضد المزارعين البيض والإدارة الاستعمارية، على أن يتلقى ابنه تعليمه غربيًّا بتسجيله في المدرسة الفرنسية. بعد دراسات ابتدائية وثانوية باهرة، تابع تعليمه في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين في مدرسة ويليام بونتي المرموقة في داكار، التي مر خلالها العديد من قادة إفريقيا المستقلة. عند مغادرته المدرسة، عُيّن في المعهد الفرنسي لإفريقيا السوداء وقضى عشر سنوات في السنغال، قبل أن يعود إلى بلده نهائيًّا في نهاية الحرب العالمية الثانية.
جزيرة غوريه: رمز تاريخي لمعاناة الإنسان الأسود
قدمت مدرسة بونتي في غوريّه للشاب الإيفواري درسًا تاريخيًّا عظيمًا. خلاصة كل معاناة العرق الأسود. تعرض هذه الجزيرة- «ذات المنازل المتهدمة التي تسيطر عليها قلعة مليئة بالمدافع»، حيث سيذهب للقيام بالإعدادات العسكرية- قبل كل شيء «الرمال والحجارة». عندما يسمح له وقت الفراغ، مثل بطله كليمبي، يتجول في الجزيرة مع رفاقه، ويحضر المناورات العسكرية، ويزور مرات عدة «بيت العبيد» وزنازينه. وهناك تعلم، من خلال التاريخ القاسي للماضي، معنى تدفق الزمن. لقد عزز اشمئزازه من الظلم، واستمد قوته من المعنى الذي سيعطيه في عمله لمهمة الكاتب. اكتسب طعم الاستحضار التاريخي. وجد هناك الفكرة المهووسة، والحافزة، لعمله المسرحي والشعري: تجارة الرقيق، والعبودية. لكن غوريه، هذه البقعة من الغبار في مقدمة القارة الإفريقية، هذه المحطة غير المعروفة الآن التي لم يعد أحد يخرج منها لأي أفق، حتى المأساوي، مثلت أيضًا هذا المصير المسدود الذي كان الاستعمار يعده من الآن فصاعدًا إلى «النخب» الإفريقية… لم يكن دادييه مخطئًا.
فيكتور هوغو الإيفواري
برنار بينلين دادييه أبو الأدب الإيفواري ورائده البارز. إنه مؤلف غزير الإنتاج، يغطي جميع الأنواع الأدبية: الشعر والروايات والمسرح واليوميات والحكايات التقليدية، وأهمها المسرح. بعد الدراسة في جزيرة غوريه السنغالية، عمل لمدة عشر سنوات في المعهد الأساسي لإفريقيا السوداء في داكار. في عام 1947م، عاد إلى بلاده وكان ناشطًا في التجمع الديمقراطي الإفريقي. أدت الاضطرابات التي حدثت في فبراير 1949م إلى سجنه لمدة ستة عشر شهرًا، حيث يحتفظ بمذكرات لن تُنشَر حتى عام 1981م، «دفاتر السجن». عندما نالت كوت ديفوار استقلالها، شغل مناصب مدير مكتب وزير التربية الوطنية، ومدير الشؤون الثقافية، والمفتش العام للفنون والآداب، وفي عام 1977م أصبح وزير الثقافة والإعلام.
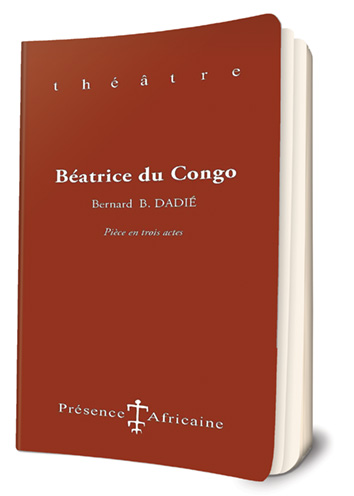 في أثناء تكريمه، كتب الروائي كوفي كواهوليه في «جون أفريك» بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده في عام 2016م مشيدًا به: «دادييه في الأدب كما هو في السياسة. وبعبارة أخرى، سلف لا غنى عنه. حتى المصفوفة التي ولد منها الأدب الإيفواري. وقال الكاتب في الاحتفال المئوي: الكتابة بالنسبة إليّ هي الرغبة في درء الظلام، والرغبة في فتح نافذة على العالم لكلّ إنسان». على الرغم من سنه المتقدّمة، فقد حضر عميد الرسائل الإفريقية شخصيًّا، يوم الخميس، 11 فبراير 2016م، إلى قصر ثقافة أبيدجان ليحصل على جائزة جيمس توريس بودي الأولى التي منحته اليونسكو تكريمًا لحياته المهنية الطويلة كاتبًا.
في أثناء تكريمه، كتب الروائي كوفي كواهوليه في «جون أفريك» بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده في عام 2016م مشيدًا به: «دادييه في الأدب كما هو في السياسة. وبعبارة أخرى، سلف لا غنى عنه. حتى المصفوفة التي ولد منها الأدب الإيفواري. وقال الكاتب في الاحتفال المئوي: الكتابة بالنسبة إليّ هي الرغبة في درء الظلام، والرغبة في فتح نافذة على العالم لكلّ إنسان». على الرغم من سنه المتقدّمة، فقد حضر عميد الرسائل الإفريقية شخصيًّا، يوم الخميس، 11 فبراير 2016م، إلى قصر ثقافة أبيدجان ليحصل على جائزة جيمس توريس بودي الأولى التي منحته اليونسكو تكريمًا لحياته المهنية الطويلة كاتبًا.
تتمثّل خصوصية برنار دادييه في ممارسة جميع الأنواع الأدبية، لقد أبدع في كل شيء. اعتاد الرجل على جمع المراتب الأولى. «كليمبي»، روايته الأكثر شهرة على الأرجح، التي نشرت في عام 1956م، هي أول رواية في كوت ديفوار. مع مسرحيته «المدن»، التي عُرضت في أبيدجان في إبريل 1934م، قدّم دادييه أول مسرحية للمجموعة الدرامية من إفريقيا الناطقة بالفرنسية. كان هو الأديب الأول والوحيد الذي فاز مرتين بالجائزة الكبرى للأدب في إفريقيا السوداء؛ المرة الأولى في عام 1965م مع روايته «زعيم نيويورك»، والمرة الأخرى عام 1968م مع رواية «المدينة التي لا يموت فيها أحد».
الميزة الأخرى البارزة لعمل برنار دادييه هي رفضه «للزنوجة» كمصدر للإلهام، وبالتالي قاطعًا مع الأيديولوجية العزيزة على الأفارقة العظماء في جيله. بالنسبة إليه، يكتب نيكول فينسيليوني، المتخصص في الأدب الإيفواري: «إن إفريقيا تجربة حية وليست حنينًا إلى الماضي؛ لذلك، ينظر إلى العالم بقلب شديد الإفريقية إلى درجة لا يمكنه معها المطالبة باعتراف الآخرين[…]».
برنار دادييه المسرحي
بالتأكيد لم يكن برنار دادييه سنغور الكوت ديفوار، لكنه كان فيكتور هوغو، دون مقارنات. الكاتب المبكّر، دخل الأدب فتيًّا، مؤلّفًا أول نص مسرحي له، «المدن»، في عام 1931م، عن عمر يناهز 15 عامًا، وهو لا يزال تلميذًا في المدرسة الابتدائية العليا في بينغرفيل. دخل المسرح حياته في بنغرفيل، في عام 1931م، الطفرة الحاسمة التي ستؤذن بميلاد المسرح الإفريقي الناطق بالفرنسية أو وفقًا لتعبير يشير بحق إلى المسرح الإفريقي التقليدي. «المسرح الإفريقي الجديد». حول هذا الموضوع قصة يحكيها برنار دادييه بنفسه في كيلمبي:
«ذات يوم، استبدل الخياط بأزرار الزي الرسمي الخشبية أزرارًا أخرى معدنية ذهبية. هذا يجعل مني شرطيًّا». بدت المناسبة مناسبة للتسلية. آكا بيليه، طالب في السنة الأولى، أخذ عصا، ووضع حزامه فوق السترة، ومرّر العصا عبر الحزام وأصبح رقيبًا في الحراسة يتبعه مساعدان. رافقوا البيض في الحسابات. المدير، الذي جذبه الضحك، المهتم بالتمثيل، نَظَّفَ مساحة مربعة كبيرة محاطة بأسرّة زهور طُهِّرَت من خلف قاعة الطعام. وهناك، يمكن للطلاب أن يناقشوا ويتحدثوا بحرية. لتشجيع أحداث الفُلكلور، وقد خصّص أمسية كل سبت للمسرح».
علاوة على ذلك، لم يقتصر المسرح على المدرسة، كما يقول نفسه: «عندما جاء الحاكم ريست، الذي كان نشاطه شديدًا، رأى الإضافة التي يمكن أن يقدمها المسرح الفرنسي الإفريقي للاحتفالات الشعبية التي أراد تنظيمها. خرج المسرح من المدرسة. كانت هناك عروض عامة مع المئات من المتفرجين». في الواقع، كان ذلك عمليًّا بالاشتراك مع مدرسة ويليام بونتي، التي قدّمت بعد ذلك مسرحية «مقابلة بنهزين مع بايولي» 11 يونيو 1933م.
في الواقع، يمكن لبداية مسيرة دادييه المهنية ككاتب مسرحي مؤرخة من عرض مسرحية «المدن» في أبيدجان في إبريل 1934م: «كانت فرصتي الثالثة هي يوم الطفل مع الحاكم ريستي، حيث كتبت بهذه المناسبة «المدن»، أول مسرحية لي، وهي عبارة عن حوار بين مجموعة المدن الإيفوارية». في سن الحادية والعشرين، شارك في كتابة مسرحية هزلية مستوحاة من نشأة الكون، تحمل عنوانًا: «اسمين ديهلي، ملك سانوي». عُرضت المسرحية عام 1937م في مسرح الشانزليزيه في باريس، بمناسبة المعرض العالمي. ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف الإيفواري قط عن الكتابة وأنتج أكثر من عشرين كتابًا، كل الأنواع مجتمعة. يحكي عمله نضالات شعبه وأساطيره وطموحاته التي يجسدها الكاتب نفسه متطِوّعًا مناهضًا للاستعمار، قبل أن يشارك في السياسة، على وجه الخصوص، وزيرًا للثقافة في حكومة هوفويت- بونيي.
يصف برنار دادييه الجو العائلي الذي نشأ فيه، فيقول في حوار: «سمعنا بين الحين والآخر حديثًا عن سنغور، وعن مارك كودجو توفالو، وعن زنوج اتّحدوا في باريس للدفاع عن مصالح إفريقيا، وعن وجود صحف محظورة مثل «الزنجي المصفّد»، و«العالم الزنجي»، و«القارات». ستارة من الحديد أرادت أن تفصلنا عن العالم كله. وهناك صحيفة أخرى أسسها الزنوج: «البرقية الإفريقية». أظهرت لنا الأعداد القليلة التي تمكنت من تجاوز الخطوط الجمركية -لأنها كانت موجهة إلى رجال مهمين، وإلى مواطنين فرنسيين- صور محامين وكتّاب وأساتذة وفنانين وشعراء وصناعيين سود. لم نكن بحاجة إلى معرفتهم. كانت مشاهدتهم دليلًا على أننا أيضًا يمكن أن ندرك أنفسنا».

النضال السياسي والأدبي
لدى عودته إلى كوت ديفوار في عام 1947م، انخرط دادييه في النشاط المناهض للاستعمار في التجمع الديمقراطي الإفريقي (RDA)، وهو تشكيل أنشئ تحت قيادة فيليكس هوفويت بوانيي. في نهاية الحرب العالمية الثانية، مع عودة الجنود الأفارقة الذين شاركوا في المعارك على الجبهات الأوربية ورأوا أوربا الشقيّة في حرب طويلة ورهيبة بين الأشقاء، اهتزت المستعمرات الإفريقية من خلال تحركات خجولة من أجل التحرير. مع رفاقه الذين يناضلون من أجل الاستقلال ألقي القبض على دادييه وسجن في عام 1949م بتهمة «أنشطة معادية لفرنسا». سيمضي ثمانية عشر شهرًا في السجن، قبل أن يطلق سراحه لعدم رفع الدعوى.
في مناسبات عدة، سوف يستحضر هذه السنوات في أعماله: ومن بينها «العقيد طورو وزنوجه»: حيث يتحدث والده باسم مستعار غادا: «العمل الاستعماري، رسالة الحضارة، التنصير؟ رعايا سهلة الانقياد للبعض والبعض الآخر، روبوتات، وعندما تولى البيض، وبخاصة الفرنسيون، الدفاع عن السكان الأصليين، عاملتهم السلطات كشيوعيين. أنا شخصيًّا عرفت شخصًا معينًا من سيمرمان طُرد لأنه، في جريدته، «واصلة»، شجب فضيحة نزوغي، وهي قرية احترقت عند الفجر لأن القرويين رفضوا إعطاء عمال لاثنين من قاطعي الأشجار. نشرت هذه الصحيفة في عام 1932م في أحد أعدادها مقالًا للطبيب الإفريقي فيليكس هوفويت، رئيس الجمعية الوطنية اليوم، مقالًا بعنوان «لقد تعرضنا للسرقة أكثر من اللازم». قد تكون في أقصى اليمين، وتتناول قضية السكان الأصليين فيضعونك في أقصى اليسار».
عندئذٍ، يلجأ الشاب، الذي أصيب بصدمة نفسية نتيجة مروره بالصراع السياسي المتشدد، إلى الكتابة، عشقه الأول. وسوف يعرب منذ ذلك الحين عن التزامه من خلال الأدب، بينما يقود في الوقت نفسه حياة مهنية وسياسية مكثفة في الإدارة الإيفوارية.
قاد العمل السياسي دادييه من المكاتب الوزارية إلى الحكومة. كان أحد أركان الإدارة الثقافية الإيفوارية خلال المدة الرئاسية الطويلة لهوفيت بوانيي. أول رئيس مكتب وزير التربية الوطنية، ثم مدير خدمات المعلومات (1959-1961م)، ومدير الفنون الجميلة (1962-1963م) والشؤون الثقافية (1973-1976م)، سينهي مسيرته السياسية وزيرًا للثقافة والإعلام، وهو منصب شغل بين 1977م و 1986م. في هذه السنوات التسع على رأس هذه الوزارة الحساسة، دعّم دادييه حرية الصحافة وتحرير الممارسات الفنية والثقافية.
واضح وقاسٍ
وفي السنوات من 1950م إلى 1980م، أنتج برنار دادييه معظم أعماله الأدبية. عرف لأول مرة شاعرًا، مع نشره في باريس، في عام 1950م، مجموعته الشعرية بعنوان مثير «إفريقيا المنتصبة»، فالقصائد ذات نبرة حربية وخالية من الزخارف اللفظية، تردد صراعات الرجال السود المستعبدين وتعلن الطابع الحتمي للتغيير المقبل:
نجمة انبثقت/ في سماء كاب كوست في المينا/ سوداء بالوعود./ رجال -سلع/ مكدسون في قبو القلاع/ بين الفئران والبارود والنار والقوافل،/ الأرض المليئة بالدم واللحم/ تربطنا ببعض./ الرجال- الماشية مقيدون بالسلاسل من أجل المعرض،/ فاصلة كبيرة في التاريخ/
يستأنف الزمن مساره،/ خمسيّة الأبنوس/ والنسر الأسود، طيرانه./ البضائع مختومة بختم السيد،/ فوقك الاحتفال./ تحسب الأرباح حسب رؤوس/ الزنجي والزنجي الصغير. /
حسب دزينة من حيوانات الحقل،/ حسب مئات الرجال المأسورين، والصغار المخطوفين./ احتفظ المحيط بصوته الغاضب/ رجل أسود، نجمة سوداء/ الديك يصيح لليقظة
هذه المرحلة الجديدة./ أيها الأطلس، يا حامل الشعلة القديم/ كيب كوست غوا! المينا وِيداه!/ قلاع الموت، سلالم الجحيم/ غيّرت الإمبراطورية اسمها/ وسفينة الرقيق الراية./
أيها الإنسان!/ كيب كوست غوا! المينا ويداه!/ المقابر والأضرحة/ هنا في اليوم مات من الأحلام./ هنا في السلاسل وفي الليل مات بشر.
تتابع الأعمال دون أن تتشابه. في العقدين التاليين، كان برنار دادييه في قمة فنّه ونشر معظم الأعمال التي خلقت شهرته. في أول كتبه القصصية، «الأساطير الإفريقية» (Seghers، 1954) الوزرة السوداء (Présence Africaine، 1956م)، مستلهمًا من التقاليد الشفوية الإفريقية الضاربة في القدم، يقدّم الحكمة من ماضي شعبه ويمزج ببراعة السحري بالواقعي والغنائية. تظل إعادة بناء الحكايات القديمة ونقلها جانبًا رئيسًا في عمل برنار دادييه، لم يتوقف عن تكرار أن الناس المتجذرين في ماضيهم فقط يعرفون اتجاههم، مهما عانوا ويلات فظيعة.
صدرت رواية كليمبي عام 1956م، بين الرواية ووقائع سيرته الذاتية، مثل الروايات التدريبية من الحقبة الاستعمارية، والمعضلات المثيرة لهوية الشباب السود المتعلمين. ممزقون بين القيم الإفريقية لأسلافهم وفتنة الحضارة التي تحاول أوربا فرضها عليهم من خلال مدارسها وقوتها وهيمنتها. جميع شباب إفريقيا السوداء يعرفون «كليمبي»، التي أصبحت من كلاسيكيات الأدب الفرنكفوني. وأخيرًا، اكتملت ثلاثية «زنجي في باريس» (وجود الإفريقية، 1959م) «زعيم نيويورك» (Présence Africaine، 1964م) «المدينة حيث لا أحد يموت» (Présence Africaine، 1969م)، إبداعات مميزة لهذه الحقبة الميمونة، أبرزت، مازجة لذّة السخرية بالأخلاقية، المواجهة بين الرجل الإفريقي والحواضر الغربية (باريس ونيويورك وروما)، مع حداثتهم المريبة المظلِّلة. يظهر المؤلف في هذه الثلاثية الأصلية كل موهبته في النقد الاجتماعي، بكل وضوح ومن دون رحمة.
العودة إلى المسرح و… إلى السياسة
في السبعينيات، يجدّد برنار دادييه صلاته بالمسرح، الباب الذي دخل منه إلى الأدب في شبابه. ونشرت له تباعًا دار نشر حضور إفريقي، «السيد طوغو نيني» )1970م)، مسرحية هجائية للأخلاق الاستعمارية، «بياتريس الكونغو» (1970م)، مسرحية تاريخية عن الاستعمار البرتغالي في وسط إفريقيا، «جزر العاصفة» (1973م) دراما في عديد من اللوحات تعرف بالنضال التحرري في هايتي، فضلًا عن مسرحيات أخرى أقل شهرة عند ناشرين أفارقة آخرين. غنيًّا بالموارد الإفريقية الدرامية يلقى مسرح دادييه كثيرًا من المعجبين وعُرضت مسرحياته على أكبر المسارح الدولية، في باريس، أفينيون، حتى نيويورك.
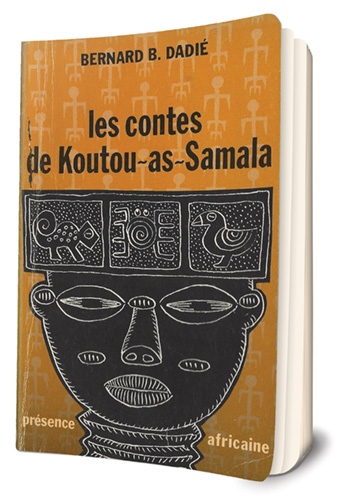 إذا كان لم ينشر دادييه أي شيء تقريبًا في العقود الأخيرة من حياته، فإن الأديب المئوي لم يفقد شيئًا من قدراته النضالية، كما يتضح من خلال الاهتمام المستمر بسياسة بلاده. ألم يكرّس جهده مؤخرًا لفضح رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، متهمًا إياه بإهمال صوت الشعب؟ وكان أيضًا منذ مدة طويلة دافع عن لوران غباغبو، متحمّلًا منذ عام 2002م قيادة المؤتمر الوطني للنضال من أجل الديمقراطية (NDRC)، الحركة التي أسّستها سيمون غباغبو للدفاع عن زوجها. في عام 2016م، بمناسبة عيد ميلاده المئة، أطلق عريضة عامة للمطالبة بالإفراج عن غباغبو، مذكرًا بأنه «لأكثر من خمس سنوات لم تقدّم المحكمة الجنائية الدولية أي دليل مادي لدعم التهم الموجهة إلى لوران غباغبو». كان الالتماس قد جمع 26 مليون توقيع!
إذا كان لم ينشر دادييه أي شيء تقريبًا في العقود الأخيرة من حياته، فإن الأديب المئوي لم يفقد شيئًا من قدراته النضالية، كما يتضح من خلال الاهتمام المستمر بسياسة بلاده. ألم يكرّس جهده مؤخرًا لفضح رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، متهمًا إياه بإهمال صوت الشعب؟ وكان أيضًا منذ مدة طويلة دافع عن لوران غباغبو، متحمّلًا منذ عام 2002م قيادة المؤتمر الوطني للنضال من أجل الديمقراطية (NDRC)، الحركة التي أسّستها سيمون غباغبو للدفاع عن زوجها. في عام 2016م، بمناسبة عيد ميلاده المئة، أطلق عريضة عامة للمطالبة بالإفراج عن غباغبو، مذكرًا بأنه «لأكثر من خمس سنوات لم تقدّم المحكمة الجنائية الدولية أي دليل مادي لدعم التهم الموجهة إلى لوران غباغبو». كان الالتماس قد جمع 26 مليون توقيع!
الموقف الذي اتخذه برنار دادييه ضد النظام في ساحل العاج لم يمنع وزير الثقافة في حكومة الحسن واتارا من حضور حفل تسليم اليونسكو الجائزة للكاتب، ذلك الحفل الذي عقد في أبيدجان في 11 فبراير، 2016م. ربما لأن أعمال دادييه الأدبية والمعترف بها في جميع أنحاء العالم، لا تنتمي إلى أي معسكر وتتجاوز الخصومات السياسية. حيث تعوّد الكاتب أن يسخر مكررًا في السنوات التي قضاها في العمل السياسي جنبًا إلى جنب مع فيليكس هوفويت بوانيي إنه «ليس مع الرئيس هوفويت ولا ضده لكن ببساطة كان دائمًا مع الكوت ديفوار ومع إفريقيا!».
«أغنّي إفريقيا»
أيتها الإلهة، مستيقظًا فجأة، عليّ، اليوم أيضًا، كابن جاحد، تكرار الحركات القديمة دون تناغم.
امنحيني القوة لتجديد شبابها وعدّلي أوتار قيثاري لأغني إفريقيا.
مثل مسيَّر، مضغوطًا من آلام الخبز اليومي، سأقابل في طريقي، الظلَّ والضوء والحرارة والنضارة، سأرى اليعسوب والفراشات ترفرف، والأطفال والطيور يلعبون ويضحكون.
امنحيني القوة لأحبّهم وأضبط عُودي لأغني إفريقيا.
النسيم يداعب بشرتي، يتموج في البحر المتموج، يثير الحب في ظل السقف القديم.
امنحي قلبي حبَّ إفريقيا.
ها قد حل المساء، مساء الحسابات العظيمة، ماذا سأقدم لك بعد عملي الشاق؟ لقد بحثت في الكتب عبثًا، وفي الكلمات عبثًا، ولم أجد سوى عبارات مبتذلة، ولا حتى جوهرة من العبارات لأضعها على مائدتك، في إكليل من الكلمات والصور المتشابكة مع العباقرة المجانين بالإيقاع والألحان. نظرت في المحاسن الأخرى، الجمال الإلهي لإفريقيا، في ألحان أخرى، ألحانها الرائعة. شبكتي القصيرة بالكاد تلامس النهر الذهبي للعبارات الأبدية، ومن باب الوفاء لا أجرؤ على اصطياد زنابق الماء من بحيرة الظل.
ينزل الليل سلم الأزمنة في الموج المتقزح من الظلال المتقلبة، ويحجب الأشكال والأشياء، والأفعال والكلمات، والإيقاع والألحان، والأمل والحلم. عبر عباءة الصمت الهائلة والصلاة الخاشعة، يسود النغم عرش النجوم وعبر السماء الصافية ذات جزّة النار المحتشمة، تعالي إلى أرض البشر وألهمي عاشقًا يحتضر منتظرًا روعة نهار العبارات الأبدية ليرصّع بها لوح الثلج للإلهة إفريقيا، من آخر جوهرة ليزيّن تاجها الإمبراطوري، بخيط الديباج الأخير ليزركش فستانها بالفراء وفي ذراعيها، ذراعي الأم التقية، لتحلّق نحو مناطق السعادة الصافية.
عدّلي أوتار عودي لأغني بها سحر السفر ومخمل بشرة الآبنوس، فهل سأكون الصامت الوحيد عندما ترتفع مقدمة الحفل الموسيقي الكبير في كل مكان؟ لا، خذيني على أجنحتك المتوهجة وفي برق الطيران الرائع، اغمرني في كوبك القرمزي، أيها الإلهام، لأغني إلى الأبد في أناشيد جديدة، إفريقيا الخالدة.
«جففي دموعك يا إفريقيا»
جففي دموعك يا إفريقيا!
أطفالك يعودون إليك
في قلب العاصفة وأنواء الرحلات الجدباء.
على ضحكة الموج وثرثرة النسيم،
على ذهب الشروق
وأرجوان الغروب
من قمم الجبال الفخورة
والسافانا المغمورة بالضوء
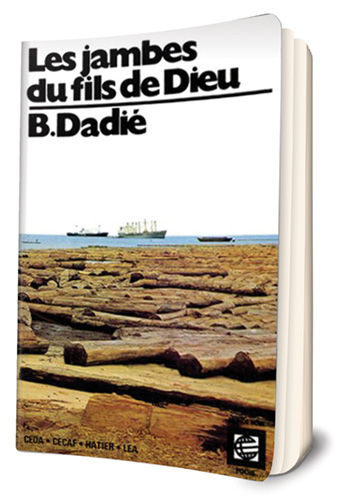 يعودون إليك
يعودون إليك
في عاصفة وأنواء الرحلات الجدباء.
جففي دموعك يا إفريقيا
شربنا من كل ينابيع
النكبات
والأمجاد
انفتحت حواسنا
على روعة جمالك
على عطور غاباتك،
على سحر مياهك
على صفاء سمائك
على مداعبة شمسك
وعلى فتنة خضرتك المتلألئة بالندى.
جففي دموعك يا إفريقيا!
أطفالك يعودون إليك
أيديهم مليئة بالألعاب
والقلوب مفعمة بالحب.
يعودون ليكسوك
من أحلامهم وآمالهم.
«الحياة ليست حلمًا»
اصعد مع السنونو لتغني بشكل أفضل
الإنسان والسلام والحرية
اصعد لتكون إعصارًا ضد الجوْر
اصعد ساحبًا خلفك حجاب الكذب الكبير
حتى يضيء يوم جديد على الأرض أخيرًا،
يوم يمنح الزنبق كل بياضه،
يوم يحصل فيه الطفل على أجمل ابتسامة (…)
الحياة ليست حلمًا يا أخي،
النضال وقانونه (…)
دعونا نفكر في إفريقيا التي تنتظرنا،
دعونا نفكر في العالم الذي ندين له كثيرًا!
لنناضل دون هوادة يا أخي
فالحياة ليست حلمًا!
«أشكرك يا إلهي»
أشكرك يا إلهي
لأنك جعلتني مجموع كل الآلام،
لأنك وضعت على رأسي، العالم.
لدي حُلّة سنتور
وأنا أحمل العالم منذ الصباح الأول.
الأبيض لون المناسبات
الأسود، اللون اليومي
وأنا أحمل العالم منذ الليلة الأولى.
أنا سعيد
بشكل رأسي
المصنوع لحمل العالم،
راضٍ
بشكل أنفي
الذي يستنشق كل رياح العالم،
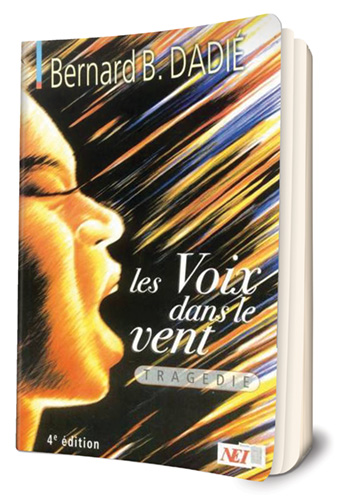 سعيد
سعيد
بشكل ساقي
الجاهزتين لتركضا كل مراحل العالم.
أشكرك يا إلهي لأنك خلقتني أسود،
لأنك جعلتني
مجموع كل الآلام.
ستة وثلاثون سيفًا اخترقت قلبي.
ستة وثلاثون موقدًا حرقوا جسدي.
ودمي على كل المحن جعل الثلج أحمر،
ودمي في كل شروق جعل الطبيعة حمراء.
على أي حال
أنا سعيد أن أحمل العالم،
سعيد بذراعيّ القصيرتين
بذراعيّ الطويلتين
من ثخانة شفتي.
أشكرك يا إلهي لأنك خلقتني أسود،
الأبيض لون المناسبات
الأسود اللون اليومي
وأنا أحمل العالم منذ فجر التاريخ.
وضحكي على العالم، ليلًا، يخلق النهار.
أشكرك يا إلهي لأنك خلقتني أسود.
«في عينيك»
في عينيك الصافيتين
قرأت أحلام الإنسان
في عينيك الرقيقتين
أتأمّل الطبيعة منشرحة مزهرة
في عينيك الشفافتين
أرى كل العيون
الزرقاء للأنهار
البيضاء للجبال
كل العيون الخضراء للمروج
الحمراء للنيران والنجوم
عيون العوالم الأخرى
كل العيون…
في همساتك
أسمع ثرثرة الماء
سيمفونية ضحكات البشر
كل همسات الكون اليقظ
في دقات يديك الملاكين
أسمع كل التمتمات المتناغمة
كل أغاني الكون
وعندما أمسك يديك
أمسك كل أيادي الفجر الوردية
كل أيادي الآمال البتول
يد القرون المزخرفة ويد الكائنات
في عينيك الصافيتين
أقرأ كل أحلام البشر
والخلود المتشبث برموشك
يعيد لي لحن الكون
في عينيك الزرقاوين، الزرقاوين
يزهر العشق
في عينيك البعيدتين، البعيدتين…
يشرق عشقي
في عينيك القريبتين، القريبتين…
يغنّي قلبي
في عينيك الطفولية
أتأمّل الطبيعة منشرحة مزهرة.
سنمسك دعاة الحرب من ياقاتهم
حسنًا ! لا !
نقول: لا! إلى الحرب.
نقول: لا! للاستبداد،
لا! للحكام الهستيريين،
لا! للرعب الذي ينتشر في بلادنا.
نقول: لا! للظلام
وفي وجوه الوحوش البشرية، نرمي احتقارنا.
نقول: توقفوا! لقطاع الطرق الملتحفين بالنعم، بالنجوم،
لأننا شعب فرنسا وشعوب إفريقيا،
نحن، المناضلين من أجل الحرية والسلام،
بعضنا في المصانع، وبعضنا الآخر في الحقول
يدًا بيد،
أعلى من أكاذيب دعاة الحرب،
أعلى من جبهات المدافع
أعلى من غيوم القلاع الحصينة،
دعونا نبني سدًّا ضد الحرب،
سنمسك دعاة الحرب من ياقاتهم
لأننا نريد الحياة!
لأننا نريد السلام!
«أنت السيد»
أنت الذي تزرع الأرز
أنت الذي تغزل الصوف،
أنت الذي تبني القلاع
وأنت الذي يتضور جوعًا
وأنت الذي يلبس الخرق،
وأنت الذي ينام تحت النجوم.
ليس لديَّ حق الوصول إلى فصلهم،
ليس لديَّ حق الوجود في كتبهم.
أنا من عالم آخر، عالم الشعب.
لهذا على كورا إفريقيا القديمة
اليوم في تحوّل،
عبر المدن والسجون،
تحت بوابات مفترقات الطرق،
أُنشد لكل فرد:
أنت ملك المصانع
أنت ملك الحقول
أنت الشعب
أنت السيد!

 تتجوّل في هذه الأماكن التي تغيرت، وتعود أشباح الماضي إلى الظهور. تستعيد الروائح والأصوات ولمحات اللحظات والكلمات، وتثير أحاسيس غريبة يصعب استرجاعها.
تتجوّل في هذه الأماكن التي تغيرت، وتعود أشباح الماضي إلى الظهور. تستعيد الروائح والأصوات ولمحات اللحظات والكلمات، وتثير أحاسيس غريبة يصعب استرجاعها.



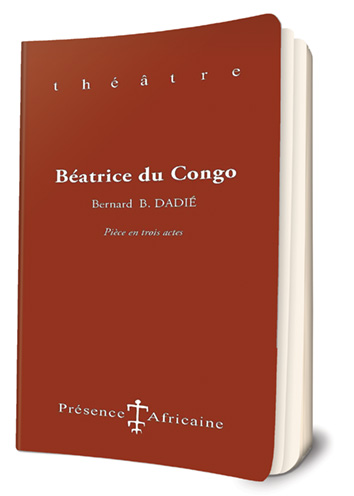 في أثناء تكريمه، كتب الروائي كوفي كواهوليه في «جون أفريك» بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده في عام 2016م مشيدًا به: «دادييه في الأدب كما هو في السياسة. وبعبارة أخرى، سلف لا غنى عنه. حتى المصفوفة التي ولد منها الأدب الإيفواري. وقال الكاتب في الاحتفال المئوي: الكتابة بالنسبة إليّ هي الرغبة في درء الظلام، والرغبة في فتح نافذة على العالم لكلّ إنسان». على الرغم من سنه المتقدّمة، فقد حضر عميد الرسائل الإفريقية شخصيًّا، يوم الخميس، 11 فبراير 2016م، إلى قصر ثقافة أبيدجان ليحصل على جائزة جيمس توريس بودي الأولى التي منحته اليونسكو تكريمًا لحياته المهنية الطويلة كاتبًا.
في أثناء تكريمه، كتب الروائي كوفي كواهوليه في «جون أفريك» بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده في عام 2016م مشيدًا به: «دادييه في الأدب كما هو في السياسة. وبعبارة أخرى، سلف لا غنى عنه. حتى المصفوفة التي ولد منها الأدب الإيفواري. وقال الكاتب في الاحتفال المئوي: الكتابة بالنسبة إليّ هي الرغبة في درء الظلام، والرغبة في فتح نافذة على العالم لكلّ إنسان». على الرغم من سنه المتقدّمة، فقد حضر عميد الرسائل الإفريقية شخصيًّا، يوم الخميس، 11 فبراير 2016م، إلى قصر ثقافة أبيدجان ليحصل على جائزة جيمس توريس بودي الأولى التي منحته اليونسكو تكريمًا لحياته المهنية الطويلة كاتبًا.
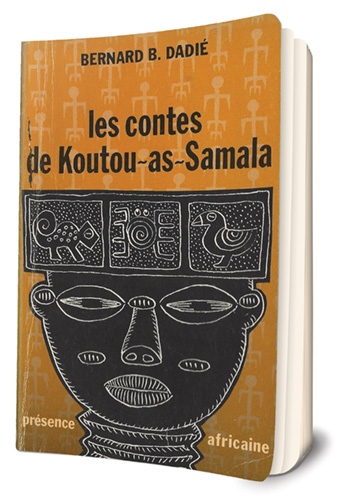 إذا كان لم ينشر دادييه أي شيء تقريبًا في العقود الأخيرة من حياته، فإن الأديب المئوي لم يفقد شيئًا من قدراته النضالية، كما يتضح من خلال الاهتمام المستمر بسياسة بلاده. ألم يكرّس جهده مؤخرًا لفضح رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، متهمًا إياه بإهمال صوت الشعب؟ وكان أيضًا منذ مدة طويلة دافع عن لوران غباغبو، متحمّلًا منذ عام 2002م قيادة المؤتمر الوطني للنضال من أجل الديمقراطية (NDRC)، الحركة التي أسّستها سيمون غباغبو للدفاع عن زوجها. في عام 2016م، بمناسبة عيد ميلاده المئة، أطلق عريضة عامة للمطالبة بالإفراج عن غباغبو، مذكرًا بأنه «لأكثر من خمس سنوات لم تقدّم المحكمة الجنائية الدولية أي دليل مادي لدعم التهم الموجهة إلى لوران غباغبو». كان الالتماس قد جمع 26 مليون توقيع!
إذا كان لم ينشر دادييه أي شيء تقريبًا في العقود الأخيرة من حياته، فإن الأديب المئوي لم يفقد شيئًا من قدراته النضالية، كما يتضح من خلال الاهتمام المستمر بسياسة بلاده. ألم يكرّس جهده مؤخرًا لفضح رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، متهمًا إياه بإهمال صوت الشعب؟ وكان أيضًا منذ مدة طويلة دافع عن لوران غباغبو، متحمّلًا منذ عام 2002م قيادة المؤتمر الوطني للنضال من أجل الديمقراطية (NDRC)، الحركة التي أسّستها سيمون غباغبو للدفاع عن زوجها. في عام 2016م، بمناسبة عيد ميلاده المئة، أطلق عريضة عامة للمطالبة بالإفراج عن غباغبو، مذكرًا بأنه «لأكثر من خمس سنوات لم تقدّم المحكمة الجنائية الدولية أي دليل مادي لدعم التهم الموجهة إلى لوران غباغبو». كان الالتماس قد جمع 26 مليون توقيع!