
جودت هوشيار - كاتب و مترجم عراقي | مايو 1, 2023 | بورتريه
أجرت الصحفية والمترجمة الفنلندية كريستينا روتكيرش -التي تكتب باللغتين السويدية والفنلندية- لقاءات صحفية مع أحد عشر كاتبًا روسيًّا معروفًا تحدثوا خلالها عن سيرهم الذاتية وتجاربهم الحياتية وأعمالهم وأساليبهم الأدبية. وقد جمعت روتكيرش نصوص هذه اللقاءات في كتاب صدر قبل بضع سنوات في ستوكهولم باللغة السويدية بعنوان: «لقاءات مع أحد عشر كاتبًا روسيًّا». ثم ترجمت الكتاب إلى اللغة الفنلندية ونشرته تحت عنوان: «مئة صنف من السجق وفكرة واحدة». عنوان هذا الكتاب تهكم لاذع على الأدب الروسي المعاصر. روسيا البوتينية التي تسعى إلى بناء اقتصاد السوق تجد في متاجرها اليوم أصنافًا كثيرة من السجق، الذي كان شحيحًا في الحقبة السوفييتية. ولكن الأدب الروسي يعاني اليوم ظاهرةَ الأدب التجاري الخفيف وشح الأفكار الملهمة. ولم تجد كريستينا روتكيرش بين أحد عشر كاتبًا من يكتب الأدب الحقيقي سوى لودميلا أوليتسكايا. وهذه الأخيرة يعرفها القارئ العربي بعد ترجمة بعض رواياتها إلى اللغة العربية في الآونة الأخيرة بعد حوالي ربع قرن على صدورها.
نشرت أوليتسكايا كتابها الأول بعد أن بلغت الخمسين من العمر. وربما كان ذلك أفضل لنضوجها الفكري والفني واكتساب الخبرة الحياتية إنسانة وكاتبة؛ ليكون لديها ما تقوله لقرائها في روسيا والعالم. أوليتسكايا كاتبة غزيرة الإنتاج بشكل مثير للدهشة. نشرت أكثر من عشرين رواية ومجموعات قصصية وكتبت العديد من المسرحيات وسيناريوهات الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية في مدة زمنية قصيرة نسبيًّا وتُرجمت رواياتها إلى أكثر من 30 لغة أجنبية.
أصبحت مؤلفة روايات «صونيتشكا» و«ميديا وأطفالها» و«الخيمة الخضراء» و«قضية كوكوتسكي» و«دانيال شتاين مترجمًا»، والعديد من الأعمال الأخرى، واحدة من ألمع ظواهر الأدب الروسي المعاصر، ولفتت انتباه القراء والنقاد في روسيا والعالم. تجمع أعمالها بنجاح بين الحبكة المثيرة والأفكار الفلسفية المعقدة وهي الكاتبة الروسية المعاصرة الأكثر إثارة للاهتمام. تعكس رواياتها الحياة المأساوية لشخصياتها المعقدة التي تكافح من أجل البقاء ويتداخل في أعمالها الحاضر والماضي والديني والسياسي والاجتماعي والشخصي. ويتضمن المنهج الدراسي للمدارس الثانوية الروسية في مادة «الأدب» دراسة أعمال أوليتسكايا.
فازت بأهم الجوائز الأدبية في روسيا وأوربا، ورُشِّحت لجائزة نوبل أكثر من مرة في السنوات الماضية وآخرها هذا العام، حيث كانت تتقدم على آني إرنو في لوائح التوقعات. ويمكن أن يطلق عليها ضمير روسيا لكن السلطات لا تحبها.
تكتب أوليتسكايا في موضوعات تهمها شخصيًّا. في الأساس حول القضايا الصعبة في البلد الصعب الذي ولدت ونشأت فيه والذي كانت تعيش فيه غالبًا قبل أن تهاجر إلى ألمانيا بعد أسابيع من الغزو الروسي لأوكرانيا.
عن سيرة أوليتسكايا
وُلدت في 23 فبراير 1943م في مدينة دوفليكانوفو، بعد إجلاء عائلتها من موسكو خلال الحرب العالمية الثانية. نشأت الكاتبة المستقبلية في عائلة من العلماء: كان والدها مهندسًا لامعًا في مجال الآلات الزراعية وتطويرها وكانت والدتها باحثة في علم الكيمياء الحيوية. وقد تعرَّض والداها إلى الاضطهاد والسجن بتهم مفبركة، فترك هذا أثرًا واضحًا في أدبها. تخرجت أوليتسكايا في كلية علم الأحياء بجامعة موسكو الحكومية عام 1966م وعملت باحثة في معهد علم الوراثة. قالت أوليتسكايا لاحقًا في إحدى مقابلاتها الصحفية: «تم تحديد مهنتي الأولى من خلال الانطباعات الحية لطفولتي. فقد بدا لي المختبر البائس في المبنى القديم لدار الأيتام السابق- حيث عملت والدتي- بمثابة معبد علمي». في عام 1970م فُصلت من المعهد بأمر من جهاز أمن الدولة بتهمة توزيع إصدارات «سام إيزدات» السرية، وعلى الرغم من ذلك كانت إصدارات «سام إيزدات» للأعمال الأدبية المحظورة من قبل الرقابة السوفييتية المتزمتة تجد طريقها إلى المعهد عن طريق باحثين آخرين وهو ما أدى إلى إغلاق المعهد نهائيًّا. انتهت مهنة أوليتسكايا باحثةً في علم الوراثة ولكن تخصصها في علم الأحياء يبدو واضحًا في طريقة وصف شخصياتها الروائية والقصصية ودوافع سلوكهم.
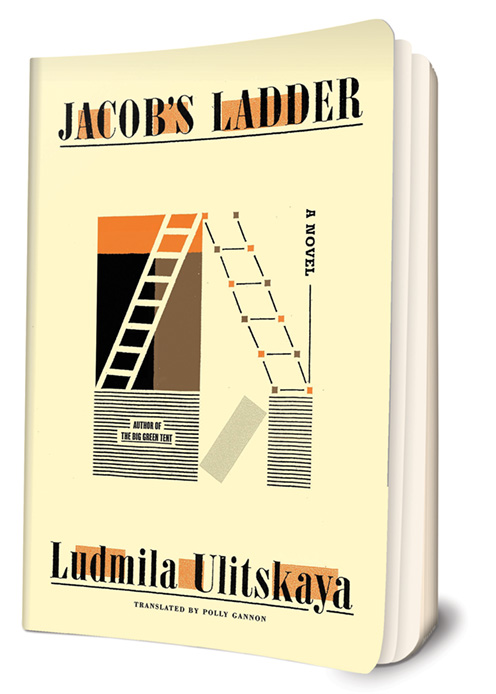 ظلت أوليتسكايا من دون عمل مدة طويلة فلم يكن بوسعها الالتحاق بأي عمل جديد من دون موافقة جهاز الأمن السري. وفي عام 1979م تمكنت بشق الأنفس من الالتحاق بمسرح الدراما في موسكو وأصبحت رئيسة للقسم الأدبي. وكانت مهمتها الرئيسة اجتذاب الكتّاب المسرحيين ومراجعة نصوصهم وإعداد برنامج المسرح. وهي ترى عملها في مسرح الدراما مهمًّا جدًّا؛ فقد ساعدها فيما بعد في كتابة العديد من الأعمال الدرامية للمسرح والسينما والتلفزيون. عملت هناك ثلاث سنوات، وعندما تركت العمل في عام 1982م كانت تعرف على وجه اليقين أنها تريد أن تكون كاتبة ولن تمارس أي مهنة أخرى. بعد نحو عام نشرت كتابها الأول بعنوان «مئة زر»، وهي مجموعة قصصية للأطفال ولم تلق هذه المجموعة أي صدى في روسيا، ثم نشرتْ مجموعة كبيرة من القصص القصيرة في المجلات والصحف الأدبية الروسية من دون أن تلقى اهتمامًا كبيرًا من النقاد، لكن في الوقت نفسه أخذت أعمالها تترجم وتنشر في أوربا الغربية.
ظلت أوليتسكايا من دون عمل مدة طويلة فلم يكن بوسعها الالتحاق بأي عمل جديد من دون موافقة جهاز الأمن السري. وفي عام 1979م تمكنت بشق الأنفس من الالتحاق بمسرح الدراما في موسكو وأصبحت رئيسة للقسم الأدبي. وكانت مهمتها الرئيسة اجتذاب الكتّاب المسرحيين ومراجعة نصوصهم وإعداد برنامج المسرح. وهي ترى عملها في مسرح الدراما مهمًّا جدًّا؛ فقد ساعدها فيما بعد في كتابة العديد من الأعمال الدرامية للمسرح والسينما والتلفزيون. عملت هناك ثلاث سنوات، وعندما تركت العمل في عام 1982م كانت تعرف على وجه اليقين أنها تريد أن تكون كاتبة ولن تمارس أي مهنة أخرى. بعد نحو عام نشرت كتابها الأول بعنوان «مئة زر»، وهي مجموعة قصصية للأطفال ولم تلق هذه المجموعة أي صدى في روسيا، ثم نشرتْ مجموعة كبيرة من القصص القصيرة في المجلات والصحف الأدبية الروسية من دون أن تلقى اهتمامًا كبيرًا من النقاد، لكن في الوقت نفسه أخذت أعمالها تترجم وتنشر في أوربا الغربية.
تغير كل شيء في حياة أوليتسكايا بصدور روايتها القصيرة الرائعة «صونيتشكا» عام 1992م التي لفتت أنظار القراء والنقاد في روسيا بعد أن دخلت إلى القائمة القصيرة لجائزة «البوكر» لعام 1993م وسرعان ما ترجمت إلى الفرنسية ونالت جائزة «ميديسي» الأدبية الفرنسية المرموقة المخصصة لأفضل الأعمال الأدبية الاجنبية.
أسلوب أوليتسكايا
السمة الرئيسة لأسلوب أوليتسكايا هي استجلاء المظاهر الأكثر دقة للطبيعة البشرية والعناية بتفاصيل الحياة اليومية بلغة مشرقة. فهي لا تتسرع في تطوير الحبكة ولا تأتي بمنعطفات حادة، بل تجتذب انتباه القارئ بما هو أكثر أهمية بالنسبة لها: الإنسان وتجاربه ومشكلاته التي تبدو للوهلة الأولى تفصيلات صغيرة وغير مهمة، ولكنها تشكل في مجملها حياة الإنسان. الخيال الإبداعي للكاتبة هو استمرار لتجربتها الخاصة. أعمالها تعكس دائمًا الوجه الحقيقي للواقع الروسي، حيث تُظهر لنا مرآة يرى فيها الجميع غالبًا أنفسهم من دون زخرفة.
وتتميز أعمالها بمواقف مؤثرة ومتعاطفة مع الشخصيات الرئيسة والتعبير الحي عن «الحياة الخاصة» وتأكيد قيمتها الذاتية والحفاظ على كرامة الإنسان في ظل ظروف النظام الشمولي والكشف العميق عن الصراع بين الفرد والدولة. القصص التي ترويها أوليتسكايا يصعب فهمها خارج الأدب الروسي؛ فهي تصور ببراعة عبثية الحياة اليومية لما بعد الاتحاد السوفييتي، أما الموضوع الرئيس لقصصها القصار فهو الحب، فكل ما يحدث بين الناس أو يتعلق بشخص ما تعبر عنه الكاتبة من خلال الحب.
بعض النقاد الروس يرون أن أعمالها تنتمي إلى «ما بعد الحداثة»، الشائعة اليوم في الأدب الروسي المعاصر، ويرى آخرون أن أعمالها تنتمي إلى «الأدب النسوي»؛ لأنها تكتب في موضوعات نسائية أحيانًا تُعبِّر فيها عن مشاعر وهواجس نسائية وتلتقط تفصيلات دقيقة لا تراها إلا عين الأنثى. عن أعمال أوليتسكايا في روسيا كُتب عدد كبير من الأطروحات العلمية والدراسات والمقالات النقدية، ولكن بعض الباحثين والنقاد الروس الذين يحلمون بالإمبراطورية السوفييتية ينتقدونها؛ لأنها تتناول في أعمالها الحياة البائسة الكئيبة في العهد البلشفي. وتعتقد الكاتبة نفسها أن النقد الأدبي الغربي أكثر موضوعية في نقد أعمالها.

أبرز أعمال أوليتسكايا
«صونيتشكا»: تجلت موهبة أوليتسكايا ككاتبة روائية لأول مرة في رواية «صونيتشكا». قصة الفتاة غير الاجتماعية -التي أحبّت القراءة أكثر من أي شيء آخر- مع زوجها الفنان روبرت. صورت الرواية التاريخ الشامل لعائلة واحدة، قصة الحب والغيرة والخيانة والتقارب الغريب والاختلافات في المصاير، كل ذلك على خلفية تاريخ روسيا في القرن العشرين.
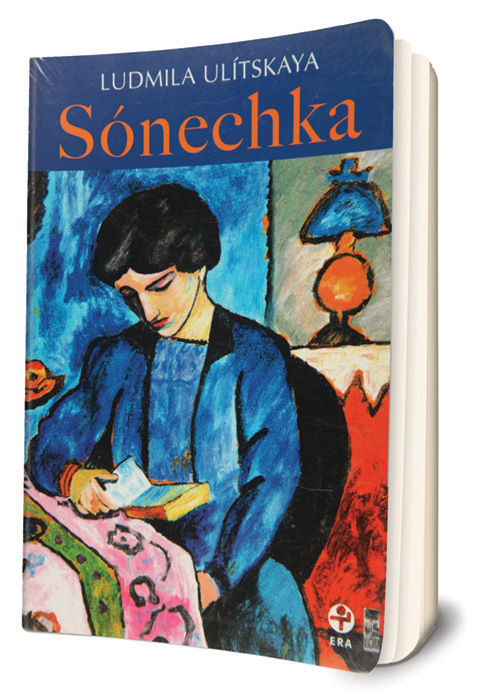 «ميديا وأطفاها»: رواية صدرت في عام 1996م وعُدّتِ الحدث الأدبي الأهم لذلك العام في روسيا وفي إيطاليا. نالت هذه الرواية جائزة جوزيبي أتسيربي، وحصلت أيضًا على جائزة ميديسي لعام 1996م. رواية عن القدر والمصير. ميديا منديس سينوبلي امرأة يونانية من القرم تحملت في حياتها كل مصاعب الأوقات العصيبة وأفراح سنوات الهدوء النادرة. في حياة البطلة وعائلتها كان هناك كل شيء: الحرب والخيانة والقتل والغيرة والحب العظيم. يجد القارئ ميديا في وحدة وهمية: ليس لديها أقارب بالدم لكن منزلها مليء دائمًا بالأشخاص الذين حلوا محل أقاربها. هذه قصة عما يمكن للشخص أن يختاره بنفسه في الحياة وما ليس لديه سلطة عليه.
«ميديا وأطفاها»: رواية صدرت في عام 1996م وعُدّتِ الحدث الأدبي الأهم لذلك العام في روسيا وفي إيطاليا. نالت هذه الرواية جائزة جوزيبي أتسيربي، وحصلت أيضًا على جائزة ميديسي لعام 1996م. رواية عن القدر والمصير. ميديا منديس سينوبلي امرأة يونانية من القرم تحملت في حياتها كل مصاعب الأوقات العصيبة وأفراح سنوات الهدوء النادرة. في حياة البطلة وعائلتها كان هناك كل شيء: الحرب والخيانة والقتل والغيرة والحب العظيم. يجد القارئ ميديا في وحدة وهمية: ليس لديها أقارب بالدم لكن منزلها مليء دائمًا بالأشخاص الذين حلوا محل أقاربها. هذه قصة عما يمكن للشخص أن يختاره بنفسه في الحياة وما ليس لديه سلطة عليه.
«قضية كوكوتسكي»: فازت أوليتسكايا عن هذه الرواية بجائزة «البوكر» الروسية لعام 2001م وهي واحدة من أشهر روايات أوليتسكايا. وقد حُوِّلَت إلى مسلسل تلفزيوني في عام 2005م. تتخذ من قصة طبيب أمراض النساء بافل كوكوتسكي أساسًا لسرد طويل تتشابك فيه أحداث منتصف القرن العشرين -الحرب وحملات ستالين ضد الأطباء وعلم الوراثة- مع مصير أفراد عائلة كوكوتسكي. تشكل قصة كوكوتسكي وزوجته وابنتيه وأزواج هاتين البنتين لوحة فنية معقدة. وتتمثل إحدى ميزات الرواية في إدخال عناصر خيالية: أحلام إيلينا كوكوتسكايا، والكشف عن العلاقات الحقيقية بين الشخصيات بشكل أعمق، التي لا يمكن تمييزها دائمًا في مجرى الحياة اليومية.
«دانيال شتاين مترجمًا»: رواية صدرت في موسكو في عام 2006م، ووصلت القائمة القصيرة لجائزة «البوكر» لعام 2007م، بالإضافة إلى ذلك نالت هذه الرواية جائزة «الكتاب الكبير» في ذلك العام وهي أهم جائزة أدبية روسية. كتبت أوليتسكايا هذه الرواية خلال ما يقرب من عقد من الزمان، وتقع أحداثها في مدة زمنية تبدأ من منتصف الأربعينيات من القرن العشرين وتنتهي في أوائل القرن الحادي والعشرين عبر روسيا وألمانيا وبولندا وإسرائيل والقدس والولايات المتحدة الأميركية. تدور القضايا التي أثيرت في الرواية حول الحرب العالمية الأولى والهولوكوست وصعود الشيوعية وسقوطها وإعادة تفسير المسيحية واليهودية والدين. تثير أوليتسكايا أيضًا مسألة الإيمان والعقيدة الفردية. والأهم من ذلك أنها تعرض مشكلات وعي الجميع المليء بالأزمات. تتمثل إحدى المفارقات الرئيسة في الرواية أن الشخصيات تعيش في عالم متعدد الثقافات إلا أن هويتهم -العرقية والدينية والاجتماعية والجنسية- هي لعنة حياتهم.
«الخيمة الخضراء»: نشرت في عام 2011م وهي مكرسة للجيل الستيني، وتبدأ من وفاة ستالين في عام 1953م وتنتهي في زمن الركود «عهد بريجنيف». وتتناول حركة المنشقين الروس التي اتصفت بعدم التجانس واضطرارهم إلى مغادرة الاتحاد السوفييتي. تؤكد أوليتسكايا التفاصيل الفردية وتجمعها مع رؤيتها، وتخلق أسطورتها الخاصة عن الماضي. رواية «الخيمة الخضراء» هي وسيلة الكاتبة لفهم الماضي والحاضر لخلق صورة عامة للواقع الروسي لمدة أربعين عامًا.
«سلم ياكوف»: رواية نشرت في عام 2015م وتتناول بالتوازي تطور مصير شخصيتين رئيستين هما: المثقف ياكوف أوسيتسكي، وهو رجل لديه شغف عظيم بالمعرفة، وحفيدته نورا أوسيتسكايا- فنانة مسرحية وشخصية عاطفية قوية الإرادة. التقى ياكوف ونورا مرة واحدة فقط في حياتهما، في منتصف الخمسينيات، لكن لم يكن هذا اللقاء أكثر من مشهد عابر. تعرفت نورا حقًّا إلى ياكوف وأدركت مدى عمق العلاقة بينهما بعد عقود عدة، عندما قرأت مذكراته ورسائله وبرقياته، وتمكنت من الوصول إلى ملفه الشخصي في أرشيف الكي جي بي (جهاز أمن الدولة).
«عن جسد الروح»: مجموعة من القصص القصيرة، التي تستهلها المؤلفة بقولها: «نحن نعرف عن الجسد أكثر مما نعرف عن الروح. لا أحد يستطيع رسم أطلس الروح. يمكن أحيانًا اكتشاف المساحة الفاصلة بينهما عندما نقترب منها نكتشف اهتزازات وتفصيلات دقيقة تعجز اللغة عن التعبير عنها. نهج محفوف بالمخاطر وخطير للغاية. هذه المساحة تجذب، وكلما عشنا زمنًا أطول كان الجذب أقوى». يتألف الكتاب من قسمين: الأول يتضمن قصصًا عن القوة المذهلة للحب، التي لا يمكن لأي ظروف -حتى الموت- أن تهيمن عليها. ويتضمن القسم الثاني قصص الأبطال الذين شعروا بكل هشاشة الوجود البشري لكنهم لم يفقدوا القدرة على الشعور والتعاطف مع معاناة الآخرين. من خلال التوازن بين العالمين، يذكرنا أبطال هذه القصص تارة بأشخاص حقيقيين في الحياة، وتارة أخرى بشخصيات خيالية.
أوليتسكايا في ألمانيا
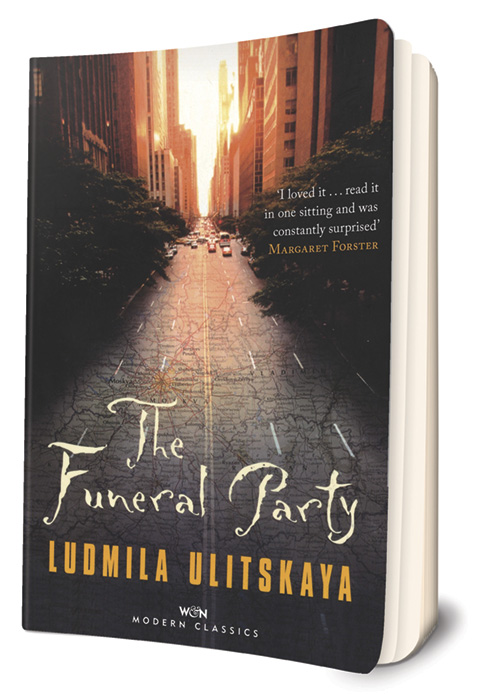 لم تكن أوليتسكايا معجبة بالسلطة الروسية في أي مرحلة من حياتها، إلا أنها انتقدت علنًا سياسة الرئيس بوتين بعد استيلائه على شبه جزيرة القرم ونشر القوات الروسية في المناطق الشرقية الأوكرانية من دونيتسك ولوغانسك في عام 2014م. وهي تعتقد أن بوتين ليس لديه عقيدة أيديولوجية، بل يهتم في المقام الأول بالمال، ويحلم باستعادة الإمبراطورية السوفييتية. وعندما سُئلت عن موقفها من الكرملين؛ قالت: «من الطبيعي أن يكره المثقف الروسي سلطة الدولة الروسية». في عام 2012م، شاركتْ في الاحتجاجات ضد بوتين، واليوم تنظر إلى الحرب في أوكرانيا بشعور من الرعب: «إن هوس رجل واحد وأتباعه المخلصين هو الذي يحدد مصير البلاد. لا يسعنا إلا تخمين ما ستقوله كتب التاريخ عن هذا في غضون الخمسين سنة المقبلة. الألم والخوف والخجل، هذا ما أشعر به اليوم».
لم تكن أوليتسكايا معجبة بالسلطة الروسية في أي مرحلة من حياتها، إلا أنها انتقدت علنًا سياسة الرئيس بوتين بعد استيلائه على شبه جزيرة القرم ونشر القوات الروسية في المناطق الشرقية الأوكرانية من دونيتسك ولوغانسك في عام 2014م. وهي تعتقد أن بوتين ليس لديه عقيدة أيديولوجية، بل يهتم في المقام الأول بالمال، ويحلم باستعادة الإمبراطورية السوفييتية. وعندما سُئلت عن موقفها من الكرملين؛ قالت: «من الطبيعي أن يكره المثقف الروسي سلطة الدولة الروسية». في عام 2012م، شاركتْ في الاحتجاجات ضد بوتين، واليوم تنظر إلى الحرب في أوكرانيا بشعور من الرعب: «إن هوس رجل واحد وأتباعه المخلصين هو الذي يحدد مصير البلاد. لا يسعنا إلا تخمين ما ستقوله كتب التاريخ عن هذا في غضون الخمسين سنة المقبلة. الألم والخوف والخجل، هذا ما أشعر به اليوم».
غادرت أوليتسكايا روسيا إلى ألمانيا بعد أسابيع من الغزو الروسي لأوكرانيا. ترى أن الشعب الأوكراني شعب شقيق يربطه بروسيا علاقات تاريخية واجتماعية وثقافية عميقة، وأن الحرب المدمرة خلقت شرخًا واسعًا وجرحًا بليغًا لا يندمل حتى بعد مئة سنة. وهي تعيش الآن مع زوجها وأولادها في شقتهم في مدينة برلين، وتحظى أعمالها المترجمة إلى الألمانية باهتمام الكتّاب والنقاد والقراء الألمان على حد سواء. وقالت في لقاء صحفي مع جريدة «بيلد» الألمانية: «شاهدت مشهدًا حزينًا إلى حد ما حيث غادر البلاد شبابها المتعلم القادر على العمل في العالم». لقد نشأ جيل من الناس لم يعودوا مستعدين لإظهار الطاعة والعبودية.

جودت هوشيار - كاتب و مترجم عراقي | سبتمبر 1, 2022 | ثقافات
لم يقتصر الصراع الروسي- الأوكراني على ميادين القتال، بل امتد إلى مجال الثقافة، وهناك اليوم نزاع بين البلدين السلافيين على عدد من عباقرة الأدب الروسي من ذوي الأصول الأوكرانية: (نيكولاي غوغول، فيودور دوستويفسكي، أنطون تشيخوف، ميخائيل بولغاكوف، إسحاق بابل، آنّا أخماتوفا، وغيرهم). هل هم أدباء أوكرانيون أم روس؟ تحاول كل جهة أن تعزز أقوالها بالرجوع إلى سيرهم الذاتية والغيرية، ومذكرات المقربين منهم، والاستشهاد بمقتطفات من أعمالهم الأدبية. الحجج الأوكرانية بهذا الشأن ضعيفة بالنسبة لمعظم هؤلاء الأدباء الكبار؛ لأن الأصول العرقية وحدها لا تحدد هوية الكاتب. لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى غوغول الأوكراني الروح، الروسي الإبداع.
يقول الباحثون الأوكرانيون: إن نيكولاي غوغول كاتب أوكراني، وإن كتب بالروسية، ويرد الباحثون الروس «إن صاحب «المعطف» و «أمسيات في قرية بالقرب من ديكانكا» و«المفتش العام»، و«الأرواح الميتة» وغيرها من الروائع الأدبية، هو كاتب روسي، على الرغم من أصوله الأوكرانية؛ لأن هذه الروائع الأدبية كُتبت باللغة الروسية».
نشأة غوغول
نشأ غوغول في أسرة أوكرانية تتحدث اللغة الأوكرانية الشائعة. وكانت لغته الأم عزيزة عليه، أما اللغة الروسية فقد تعلمها خلال دراسته في الجمنازيوم. اللغة الروسية كانت لغة النخب السياسية والثقافية، ولغة التعليم والمخاطبات الرسمية والتجارية في أوكرانيا. وكان الاعتقاد السائد، بأنها اللغة اللائقة الوحيدة للإبداع الأدبي، وقد استخدمها غوغول ببراعة في إبداعه لاحقًا.

ميخائيل بولغاكوف
عرفت روسيا وأوكرانيا الازدواجية اللغوية مدة طويلة، ونعني بذلك التعايش بين لغتين في المنطقة نفسها، التي يستخدم المتحدثون بهذه اللغة أو تلك، بناءً على موقف معين. فعلى سبيل المثال، كانت تتعايش في روسيا القيصرية لغتان هما الفرنسية والروسية: استُخدمت الأولى في المجتمع الراقي والمراسلات التجارية، والثانية في الحياة اليومية، وبخاصة بين عامة الناس. لُحِظَت هذه الظاهرة في أوكرانيا أيضًا؛ حيث كانت اللغة الروسية لغة الأدب الجاد والمراسلات عمومًا، في حين اقتصر استخدام الأوكرانية على التواصل اليومي، وبعض الأعمال الأدبية الكوميدية الخفيفة؛ لذلك، كان من المستحيل أن تنطلق إلى النور، وتصبح كاتبًا جادًّا من خلال أعمال أدبية باللغة الأوكرانية، وكانت كتابة الشعر مثلًا بالأوكرانية شكلًا سيئًا. هذا هو السبب في أن العديد من الكتاب الأوكرانيين كتبوا بالروسية، أو باللغتين الأوكرانية والروسية: الأوكرانية للكتابات المسلية الخفيفة، والروسية للأعمال الكبيرة الجادة.
ماذا يقول معاصرو غوغول؟
قال الكاتب الموسوعي الأوكراني بانتيليمون كوليش، أول من كتب سيرة غوغول: «إن إحدى المصادفات المحظوظة في حياة مؤلف «أمسيات في قرية بالقرب من ديكانكا» أن اللغة الروسية، وليست الأوكرانية، هي التي أصبحت لغة الإبداع لديه». ويعتقد كوليش أن الشاب غوغول تلقى من والده الأديب «الدافع الأول لتصوير الحياة الأوكرانية، ولكنه لم يستطع إتقان اللغة الأوكرانية لدرجة تمكنه من الكتابة بهذه اللغة، بحرية إبداعية كاملة».
أما ميخائيل مكسيموفيتش، الذي عرف غوغول شخصيًّا، فيقول: «إنه كان يعرف الأوكرانية، ولكنه لم يرغب في ذلك، واتبع المسار المقبول عمومًا». غوغول، بالطبع، كان يعرف اللغة الأوكرانية؛ تشهد على ذلك السمات المعجمية والنحوية والدلالية والإيقاعية لكتاباته الإبداعية باللغة الروسية. إذن لماذا لم يكتب باللغة الأوكرانية؟

آنا أخماتوفا
كان غوغول مدركًا لحقيقة أن كلًّا من النقص في لغته الأوكرانية و«التخلف» في اللغة الأدبية الأوكرانية ذاتها آنذاك سيصبحان حاجزين في طريق نشاطه الأدبي، من شأنه أن يعرقل تلك المهام الإبداعية التي حددها هو لنفسه منذ البداية، وأن استخدام الأوكرانية يحد من مجال تأثير أعماله الأدبية في روسيا.
في الوقت نفسه، لم يكن الموقف المهين من اللغة والثقافة الأوكرانية عامة، في الإمبراطورية الروسية، سرًّا لغوغول. كان هناك هجوم مباشر من السلطة القيصرية على المدرسة الأوكرانية، والكتاب الأوكراني، واللغة الأوكرانية؛ حتى إنكار حقيقة وجود مثل هذه اللغة. ولم يقتصر هذا الإنكار على المستوى الرسمي فقط، بل شمل أيضًا العديد من النقاد وفي مقدمتهم ناقد روسيا الكبير فيساريون بيلينسكي الذي جادل، بأن اللغة الأوكرانية حافظت عليها آثار الشعر الشعبي فقط، وأنه «لا توجد لغة أوكرانية أدبية، ولكن هناك لهجة روسية صغيرة (أي أوكرانية) إقليمية، إلى جانب اللهجات السلافية الأخرى. إن اللهجة الروسية الصغيرة مناسبة فقط للقصص الهزلية القصيرة».
لكن غوغول لم يتجنب على الإطلاق «القصص الهزلية» والحكايات والطرائف الأوكرانية. كان ذلك أساسًا تكريمًا للموضة السائدة في سانت بطرسبرغ في ذلك الحين لكل ما هو أوكراني. لكن غوغول كان يفكر في أهداف أخرى عالية يرى استحالة تحقيقها من دون اللغة الروسية. كان هذا في زمن ليس بوسع أي كاتب أن يهمل اللغة المستخدمة على نطاق واسع، ويبدأ الكتابة بلغة أقل شيوعًا بكثير من دون أن يبدو غريب الأطوار. فاختار غوغول اللغة الشائعة الاستخدام.
عندما بدأ غوغول، نشاطه الأدبي، كان لديه معرفة باللغة الروسية، بعيدة من الكمال، وقد تعرض بسبب ذلك إلى نقد لاذع من الأدباء والنقاد الروس الذين قالوا: إن لغته الروسية ركيكة. قال الكاتب أندريه بيلي: «إن غوغول يشعر أحيانًا كأنه أجنبي. أصبحت اللغة الروسية مألوفة له، ولكنها لم تكن لغته الأم. فقد كان يفكر بالأوكرانية ويكتب بالروسية، وحاول طوال حياته أن يدرس الروسية ويتقنها بعمق قدر الإمكان. وقد حقق نجاحًا مذهلًا في هذا المجال». يرى بعض النقاد الروس أن الزعم أن غوغول كاتب أوكراني هو مثال حي على سوء فهم أو إنكار لحقيقة أن الأدب الوطني لا وجود له خارج اللغة الوطنية. وهذه اللغة ليست مجرد منظومة أو مجموعة علامات ميتة وخاملة، بل تعبير عن الروح البشرية بكل عمقها وتنوعها غير المتناهي، بما في ذلك الروح الوطنية.
«أوكرنة» غوغول
ظهرت في السنوات الأخيرة دراسات أوكرانية كثيرة حول حياة غوغول وأدبه، التي تهدف إلى «أوكرنة» غوغول استنادًا إلى الأصل العرقي للكاتب ومسقط رأسه وقضاء نحو نصف عمره في أوكرانيا. إذا عددنا هذا الرأي صحيحًا فإنه يشمل العديد من الكتّاب الروس الكبار، من ذوي الأصول الأوكرانية. يزعم بعض النقاد الأوكرانيين أن غوغول كان يؤدي مهمة خاصة في الأدب الروسي، يتلخص جوهرها الخفي في أن يظهر للعالم كله، من خلال اللغة الروسية، أن روسيا بلد النفوس الميتة، حيث لا يوجد شيء مشرق، ولا يسمع فيها سوى الشتائم فقط. ويزعم بعض النقاد الأوكرانيين، أن اللغة ليست «العامل الحاسم في انتماء عمل ما إلى هذا الأدب الوطني أو ذاك، ويؤكدون أن الخصائص الوطنية وسمات الشخصية الوطنية يمكن التعبير عنها بلغة شعب آخر. يمكن للكاتب حقًّا أن يعبر بلغة أجنبية -ضمن حدود معينة- عن «النظرة الوطنية إلى الحياة والعالم» لشعب آخر، وبخاصة الشعب الذي ينتمي إليه عرقيًّا، ويمكن أن «ينتمي» إلى ثقافته الروحية أيضًا. وغوغول مثال على ذلك. حيث يؤدي المكون الأوكراني دورًا مهمًّا وأساسيًّا في اللغة الروسية لغوغول مثل سمات الشخصية الوطنية، ورؤيته للعالم، والذاكرة التاريخية، والتقاليد العرقية الأدبية المتأصلة في الكاتب، وفي الوقت نفسه يحتل غوغول مكانة خاصة في الأدب الروسي بوصفه الكاتب الذي دشن الفن القصصي الروسي.
من المستحيل تحديد البلد الذي يجب أن ينسب إليه غوغول؛ لأن أعماله الأدبية أثرت إلى حد كبير في تطور الثقافتين الروسية والأوكرانية. بالطبع، يمكن القول: إن غوغول أوكراني، ولكن ليس من الصحيح القول: إنه كاتب أوكراني فقط وليس كاتبًا روسيًّا. كان غوغول قادرًا على الجمع بين الحب الشديد لوطنه أوكرانيا واعتزازه بالدولة السلافية الكبرى، روسيا القيصرية.
أقوال غوغول عن نفسه
تكتسب آراء غوغول حول انتمائه الوطني والروحي والثقافي أهمية خاصة في الجدل الدائر حاليًّا حوله بين الجانبين الروسي والأوكراني، ومحاولة كل طرف انتزاعه من الطرف الآخر. كتب غوغول: «بشكل عام، تصبح روسيا أقرب فأقرب إليَّ بمضي الزمن، إنها أكثر من وطن، وفيها ما هو أعلى من الوطن، كما لو كانت هذه الأرض هي الأقرب إلى الوطن السماوي». لم يكن غوغول في حاجة إلى معرفة ما إذا كان أوكرانيًّا أم روسيًّا؛ فقد دفعه أصدقاؤه إلى الجدل حول ذلك. في عام 1844م استجاب لطلب ألكسندرا أوسيبوفنا سميرنوفا حول تحديد هويته الثقافية على النحو الآتي:
«سأخبرك بكلمة واحدة عن نوع الروح التي أمتلكها، أوكرانية أم روسية؛ لأنه، كما أرى من رسالتك، كان هذا في وقت من الأوقات موضوع تفكيرك ونزاعاتك مع الآخرين. لهذا سأقول لك: إنني شخصيًّا لا أعرف أي نوع من الروح لديَّ، أوكرانية أم روسية. أنا أعرف فقط أنني لن أعطي أي ميزة بأي حال من الأحوال لأوكرانيا على روسيا، أو لروسيا على أوكرانيا. فهما هبة من الله، وكما لو كان كل منهما تحتوي عن قصد في حد ذاته على ما لا يوجد في الأخرى… روسيا وأوكرانيا هما روحان توأمان تكمل الواحدة منهما الأخرى، وهما أصيلتان وقويتان بالقدر نفسه. ومن المستحيل إعطاء الأفضلية لإحداهما على حساب الأخرى».
في الوقت نفسه، أكد غوغول -من دون التقليل بأي شكل من دور الثقافة الأوكرانية- ضرورة دعم وتطوير اللغة الأدبية الروسية قائلًا: «نحن بحاجة إلى الكتابة باللغة الروسية. يجب أن نسعى جاهدين لدعم وتعزيز لغة أدبية واحدة لجميع قبائلنا الأصلية. يجب أن تكون السمة الغالبة للروس والتشيك والأوكرانيين والصرب شيئًا مقدسًا واحدًا- لغة بوشكين، وهي الإنجيل لجميع المسيحيين».

مكانة غوغول في الأدب الروسي
تكمن قوة وسحر لغة كتابات غوغول في مرونتها المذهلة، والقدرة على التكيف مع آلية «إعادة الضبط» اللغوي، واختيار الوسائل الأسلوبية للحل الأمثل لمهمة فنية معينة، وفي هذا المزج الغريب بين الواقعي وغير العقلاني، وهو أمر غير نمطي بالنسبة للأدب الروسي بشكل عام، وأكثر من ذلك بالنسبة لأدب القرن التاسع عشر. ليس لدى غوغول سيرة شخصية مثيرة للاهتمام- لم يقاتل في الحرب، ولم يشارك في المعارك الأدبية، ولم يقهر الفتيات والزوجات، ولكنه خلد اسمه في الأدب بروائعه الأدبية، التي أصبحت البداية الحقيقية لولادة القصة الروسية الفنية.
كتب فيساريون بيلينسكي الذي كان يتابع التطور المذهل للغة غوغول وأعماله الأدبية: «ظهر عهد جديد في الأدب مع غوغول: وأصبحت أعماله بداية للقص الروسي، تمامًا كما بدأ الشعر الروسي الحقيقي مع بوشكين». وكتب الشاعر والناقد الأدبي كونستانتين أكساكوف: «هوميروس وشكسبير وغوغول فقط يمتلكون سر الفن العظيم. وهذا هو السبب في أن كل ما يبدعه غوغول عظيم، ونحن ننظر بسرور إلى نشاطه الإبداعي، الذي يمضي قدمًا بقوة إلى الأمام. وقد أعطانا بالفعل الكثير. إلى جانب قصصه الخيالية، المألوفة جدًّا لكل روسي متعلم. وبغض النظر عن كل شيء آخر، قدم لنا كوميديا حقيقية لا يمكن العثور عليها لدى أي كاتب آخر، وبوسعه أن يعطينا قصيدة ملحمية، كما يمكنه أن يعطينا مأساة».
بعد قرن ونصف، لم يُحَلّ بعدُ لغز إبداع غوغول، وهو لا يزال حتى اليوم يسحر ملايين القراء حول العالم؛ لذا أعتقد أن الخلاف اليوم حول هويته لم يعد له معنى. لقد تغيرت أشياء كثيرة منذ زمن الكاتب، ولكي نفهمه يجب أن ننظر إلى سياق حياته وليس إلى الوقت الحاضر. ولكل من روسيا وأوكرانيا الحق في عدّه كاتبها الوطني.

جودت هوشيار - كاتب و مترجم عراقي | يوليو 1, 2019 | ثقافات
قلّما نجد في تأريخ الأدب العالمي أديبًا عظيمًا حظي بحب امرأة قريبة من عالمه الروحي، وتدخل البهجة إلى حياته في زمن عصيب وكئيب. وكان بوريس باسترناك محظوظًا حقًّا في السنوات الأربع عشرة الأخيرة من حياته، حين التقى وأحب بعمق امرأة فاتنة الجمال، راجحة العقل، بادلته حبه العظيم، ووقفت إلى جانبه في أحلكِ الظروف، وألهمته خيرة أعماله الشعرية والنثرية، وهذه المرأة هي أولغا إيفينسكايا، التي ضحت من أجله كثيرًا، واعتُقلت بسببه مرتين، وقضت سنوات طويلة في معتقلات العمل الإجباري، فقدت خلالها حملها. المرأة التي أصبحت نموذجًا لـ(لارا) بطلة رواية «دكتور زيفاغو»، وقصة الحب بين لارا ودكتور زيفاغو، في الكثير من جوانبها، تجسيدٌ لقصة حب أولغا وباسترناك. العديد من قصائد يوري زيفاغو في نهاية الرواية، هي قصائد باسترناك عن حبه لأولغا.
كانت أولغا فخورة لأنها تحب شاعرًا عظيمًا يبادلها الحب. وقد أدى لقاؤهما إلى تغيير حياتهما، وإلى إحساسهما بسعادة غامرة، رغم المخاطر التي رافقت علاقتهما، والتي واجهاها معًا بكل رباطة جأش وشجاعة. التقى بوريس باسترناك أولغا إيفينسكايا في صبيحة يوم جليدي في أكتوبر عام 1946م، في مجلة «نوفي مير» الأدبية حيث كانت تعمل. رأته فجأة واقفًا أمام طاولتها. لم تصدق من فورها أن الشاعر الذي حلمت به منذ مدة طويلة، وتحفظ بعض قصائده عن ظهر قلب، يقف أمامها مأخوذًا بجمالها. وفيما بعد وصفت أولغا هذا اللقاء الأول بينهما، بعيون أنثوية:«كانت نظرته الأولى، نظرة تقييم متفحصة، من المستحيل أن تخطئها العين. جاء الرجل الذي كنت أحلم به دائمًا، وبحاجة إليه حقًّا. وهذه معجزة مذهلة».
حدثها الشاعر الكبير عن مشاريعه الإبداعية ووعدها بتقديم نسخة من دواوينه الشعرية لها. وقد وفَّي بوعده في زيارته اللاحقة لمكتب المجلة.
أولغا كانت خريجة المعهد الأدبي، ولها محاولات في الشعر، وتحرص دائمًا على حضور لقاءات باسترناك الشعرية في موسكو. وكانت عند لقائهما قد ترملت مرتين، وتبلغ من العمر 34 عامًا، وتعايش أمها مع ابنتها إيرينا، وابنها ديمتري، في شقة صغيرة. في حين كان بوريس باسترناك في السادسة والخمسين، ويعيش مع أسرته (زوجته الثانية زينائيدا وابنيه يفغيني من زوجته الأولى، وليونيد من زوجته الثانية) في منزله ببلدة الأدباء «بيريديلكينو» قرب موسكو.
ولأن كليهما كانت لديه أسرة فقد كانا يلتقيان في وسط المدينة ويتجولان لساعات عديدة في شوارعها، وينشغلان في كل مرة في حديث لا ينتهي. وفي نهاية كل لقاء كان يوصلها إلى مسكنها في زقاق بوتابوفسكي.
في أحد لقاءاتهما المبكرة في ميدان بوشكين -عندما كانت أولغا، لا تصدّق اعترافه الغامض بحبه لها خلال كلامه السريع المخنوق- قال لها: أنت لا تصدقينني ولكنني كنت -كما ترينني الآن عجوزًا، غير وسيم، بذقن بارز- سببًا في الكثير من الدموع النسائية.
لم تفصح أولغا عن حبها له، ولكنها حين عادت مساءً إلى بيتها كانت قلقة، ولم يغمض لها جفن، فجلست لتكتب له عشرات الصفحات عن ماضيها الصعب. وكان لديها الكثير لتكتب عنه. تحدثت عن المصير التراجيدي لزوجها الأول الذي مات منتحرًا، وعن زوجها الثاني الذي وشى بأمها، ماريا نيكولايفنا، لدى أجهزة الأمن، فحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الدعاية المعادية للسوفييت، وهو ما جعل حياة أولغا الزوجية معه مستحيلة، فانفصلت عنه، ليموت كمدًا وقهرًا.
وفي لقائها التالي بباسترناك، عندما قدمت إليه الدفتر الذي كتبت فيه اعترافاتها، تأثر كثيرًا لسذاجتها. لارا في الجزء الثاني من رواية «دكتور زيفاغو» مدينة بالكثير لهذا الدفتر. وفي تلك الليلة نفسها، بعد أن قرأ باسترناك ما كتبته أولغا، قال لها على الهاتف: «أنا أحبك، وأنت الآن حياتي كلها». إلا أنه لم يفكر في الطلاق من زوجته زينائيدا، رغم أنهما لم يعودا يعيشان كزوجين. كانت زينائيدا تفتقر إلى الرومانسية والرقة والجاذبية. ولا تحاول فهم عالمه الروحي، ولا تهتم بما يفكر فيه أو يكتب عنه، ومختلفة تمامًا عن أولغا الرقيقة، المُحِبّة للأدب، ذات الجاذبية الطاغية.
كان باسترناك يدرك بوضوح ما تنطوي عليه علاقته بأولغا، من تداعيات سلبية على حياتهما. ربما لهذا السبب في 3 إبريل 1947م، حاول قطع العلاقة معها. وفي وقت لاحق كتبت أولغا تقول: «قال ليونيد: إنه ليس لديه الحق في الحب، فكل الأشياء الجيدة ليست له الآن، إنه رجل مسؤول، ولا ينبغي أن أشغله عن مسار حياته وعمله. ولكنه سيعتني بي دائمًا. وكان الفراق حزينًا ومؤلمًا».
ومع ذلك، في فجر اليوم التالي بعد «الانفصال» وفي الساعة السادسة صباحًا، رنَّ الجرس في شقة أولغا. خلف الباب كان يقف بوريس باسترناك. تعانقا وضمها إلى صدره في صمت. الآن أصبحت لقاءاتهما دائمة. كانت أولغا تستقبل حبيبها برداء علوي من الحرير الأزرق، وهو الرداء الذي خلَّده الشاعر في وقت لاحق في قصائد الدكتور زيفاغو: «حين تعانقينني في رداء علوي من الحرير». ويقول باسترناك في متن الرواية: «آه، كان هذا حبًّا فريدًا لم يسبق له مثيل، ولا يشبه أي شيء آخر. كانا يحبان بعضهما؛ لأنّ كلّ ما حولهما أراد ذلك: الأرض تحت أقدامهما، والسماء فوقهما، السحب والأشجار. حبهما كان يروق لمن يقابلهما في الطريق، أكثر مما يروق لهما».
مؤشر الساعة الناعس الكسول
يتباطأ في الدوران
واليوم يدوم أكثر من قرن
ولا نهاية للعناق
لم يكن بوسع الحبيبين إخفاء قصة الحب التي شاع أمرها بين الأقارب والأصدقاء. ولم يحاول باسترناك إنكار علاقته بأولغا. وتذكر الفنانة التشكيلية أولغا بوبوفا -وكانت صديقة مشتركة لهما- في مذكراتها: «ذات مرة ركع باسترناك على ركبتيه أمام أولغا في بولفار غوغل، فشعرت بالحرج الشديد، وطلبت منه الكف عن هذه التصرفات الغريبة». فقال لها: «دعيهم يعتقدون أن هذا مشهد في فِلْم سينمائي» لم يكن ينتابه أي إحساس بالخجل من مشاعره، ولا يخشى أن يبدو مضحكا، أو ضعيفًا.
بداية المتاعب
ذات مرة عندما كانت زينائيدا، زوجة الشاعر، تقوم بتنظيف مكتب زوجها، عثرت على رسالة من أولغا. وكتبت زينائيدا في مذكراتها لاحقًا، أنها أدركت أن زوجها يهيم حبًّا بأولغا. واعترفت بأنها مذنبة في كل شيء: «بعد وفاة ابني من زوجي الأول، التي هزتني، كنت منهمكة بالعمل الاجتماعي، وانشغلت عن زوجي، وتخلَّيت عن مسؤولياتي كرَبَّة بيت وزوجة».
المقربون من الشاعر انهالوا على أولغا باللوم والتأنيب، واتهموها بالغدر والخبث، ومارسوا الضغط على باسترناك، وطالبوه، بوضع حد لهذه العلاقة (المشينة). ولكن باسترناك اعترف لأحد أصدقائه: «أنا بكُلِّيّتي، بروحي، وعملي، ملك لأوليوشا (اسم التحبب لأولغا). أما زينائيدا زوجتي، فليس لديها سوى العلاقة الشكلية، لا بد أن يبقى لها شيء؛ لأنني مَدين لها أيضًا». لكنّ زينائيدا لم تفكر بالاستسلام. وكتبت في مذكراتها «شعر بوريس بالخجل وطلب المغفرة. وجلس من فوره إلى مكتبه، وكتب رسالة إلى هذه السيدة، قائلًا: إن من الضروري إنهاء علاقتهما، وعدم اللقاء مجددًا. أعطاني الرسالة لنقلها إليها. وهذا ما فعلته بسرور».
وكتبت أولغا بوبوفا – التي كانت في هذا الوقت حاضرة في شقة أولغا إيفينسكايا – تقول في مذكراتها: «كانت زينائيدا لا ترحم منافستها. طلبت من إيفينسكايا التوقف عن ملاحقة زوجها، قائلة: إنها ستقاتل من أجل أسرتها وسعادتها. وردت عليها أولغا: إن زوجك لا يحبك، بل يحبني، وهو ينوء بعبء الزواج منذ مدة طويلة». لكن زينائيدا كانت مصرَّة على موقفها وبعد رحيلها، أخذت أولغا عدة أقراص مهدئة دفعة واحدة فتردت صحتها ونُقلت إلى المستشفى، وقيل: إنها حاولت الانتحار.
ولكن العلاقة لم تنقطع بين باسترناك وأولغا رغم ما أحاط بهما من متاعب. لم تكن الحياة سهلة لهما، وبخاصة أولغا، التي كانت تعيش مع طفليها وأمها في شقة صغيرة من غرفتين. وكانت أمها تدين علاقة ابنتها برجل متزوج يكبرها بنحو ثلاثة وعشرين عامًا، وترى هذه العلاقة غير معقولة وطائشة. وكانت أولغا غالبًا ما تجهش بالبكاء
في الليل بغرفتها.
تعذيب باسترناك باعتقال حبيبته
كانت السنوات الخمس التي سبقت وفاة ستالين صعبة في الاتحاد السوفييتي، وكان خطر الاعتقال والسجن حتى التصفية الجسدية محدقًا بكل من له أقارب في الخارج، وعلى اتصال معهم، ومن ضمنهم باسترناك الذي كان له اتصال وثيق بشقيقتيه (جوزفين وليديا) اللتين تعيشان في أكسفورد بإنجلترا، ولهذا كان تحت المراقبة السرية الدائمة من جانب الأجهزة الأمنية. وذات مرة عندما كان باسترناك وأولغا جالسين على إحدى المصاطب في حديقة عامة لاحظت أولغا رجلًا يراقبهما عن قرب.
في السادس من أكتوبر عام 1949م، أُلقِي القبض على أولغا بسبب علاقتها بباسترناك المشتبه باتصاله بالإنجليز، ووُجِّهت إليها تهمة التخطيط للهرب مع باسترناك إلى الخارج، وأن عشيقها على اتصال بالمخابرات البريطانية، كما أن الرواية التي يكتبها معادية للسوفييت، وطلبوا منها في أثناء التحقيق أن تعترف يذلك. قضت أولغا عدة أشهر في زنزانة باردة ورطبة، وكان يُحَقَّق معها يوميًّا تحت التهديد والوعيد -رغم أنها كانت حاملًا من باسترناك وفي شهرها السادس- من أجل انتزاع اعترافات منها تدين باسترناك. وأدى التحقيق الخشن إلى إسقاط الجنين، إلا أنها صمدت، ورفضت أن تدلي بأي شيء قد يدين باسترناك أو يسيء إليه.

أولغا إيفينسكايا
وفيما بعد كتبت أولغا تقول: «وجاء اليوم الذي أبلغني فيه ملازم مفوه بصدور الحكم عليَّ بخمس سنوات أقضيها في معسكرات الاعتقال والعمل الإجباري؛ لأنني قريبة من الأشخاص المشتبه في قيامهم بالتجسس». أُرسِلت أولغا إلى معتقل بوتما في جمهورية موردوفيا، حيث قضت ثلاث سنوات ونصف السنة، وكانت تتلقى أحيانًا رسائل من باسترناك. وقالت: إن مجرد توقع هذه الرسائل ساعدها على الصمود، في خضم الإذلال والتعامل غير الإنساني. بذل الشاعر جهودًا حثيثة لدى الجهات المختصة لإطلاق سراح حبيبته لكن دون جدوى. الشيء الوحيد الذي كان بمقدوره أن يفعله لمساعدة أولغا هو الاعتناء بطفليها وأمها ماريا نيكولايفنا طوال سنوات سجنها، وكان يقدم لهم مبالغ نقدية لتأمين متطلبات الحياة. كتبت إيرينا إميليانوفا -ابنة أولغا من زوجها الأول- تقول: «إننا مدينون لباسترناك لأن طفولتنا رغم المصاعب كانت إنسانية بفضل مساعداته المالية ورعايته لنا».
أُفرِج عن أولغا في عام 1953م بعد قضاء نحو أربع سنوات في السجن وشمولها بالعفو العام -الذي صدر عقب وفاة ستالين ببضعة أشهر- عن الذين تقل أحكامهم عن خمس سنوات. وعادت مرة أخرى إلى باسترناك، الذي كان قد أصيب بأول جلطة في القلب، وكان يبدو أنه قد شاخ لسنوات. ولكن حبه لأولغا أصبح أقوى من ذي قبل، وعلاقته بها تبدو أكثر حنانًا ورِقَّة. وجاء في رسالة مؤرخة في الأول من نوفمبر عام 1957م، كتبها باسترناك بالإنجليزية إلى شقيقته ليديا في إنجلترا: «يجب أن أقول عن الدور الذي لعبته أولغا إيفينسكايا في حياتي على مدى السنوات العشر الماضية. إنها (لارا) روايتي. وهي الإنسانة الوحيدة، التي أناقش معها عبء الزمن، وما ينبغي القيام به والتفكير فيه وكتابته».
وفي رسالته المؤرخة في مايو عام 1958م، إلى صديقته رينات شوايزر في ألمانيا كتب يقول: «بعد الحرب الثانية التقيت امرأة شابة – أولغا إيفينسكايا. إنها (لارا) روايتي التي بدأت كتابتها في ذلك الوقت. إنها تجسيد للبهجة والتضحية، ولا يبدو عليها ما عانته في حياتها وهي على علم بحياتي الروحية، وبكل شيء عني». وأبدى باسترناك إعجابه بشجاعة أولغا في لقاء مع صحافية أجنبية: «لقد سُجِنتْ بسببي كأقرب شخص لي، لكي تعترف من خلال استجوابات مؤلمة تحت التهديد، وتكون لديهم أسباب كافية لمحاكمتي. وقد أنقذتني ببطولتها وصمودها، وأنا مدين لها بحياتي. ويعود لها الفضل في بقائي طليقًا في تلك السنوات». ثم أضاف: «لارا حبي المحفور في قلبي بدمها وسنوات سجنها».
استأجرت أولغا في قرية أسمالكوفا -القريبة من بلدة الأدباء (بريديلكينو) حيث يسكن باسترناك- غرفة صغيرة تطل على شرفة في منزل يعود إلى أحد سكان القرية. وكان باسترناك يقطع المسافة غالبًا من منزله إلى أسمالكوفا مشيًا على الأقدام. وكانت أولغا وابنتها إيرينا يتعرفان إليه من بعيد لدى قدومه. فقد كان يأتي دائمًا وهو يعتمر قلنسوة، ويرتدي حذاءً مطاطيًّا، ومعطفًا خشنًا. في هذه الغرفة البسيطة كانت أولغا تطبع مخطوطة رواية «دكتور زيفاغو» على آلة طابعة رديئة من طراز «موسكفا».
في نهاية إبريل عام 1960م، تدهورت صحة باسترناك، وكاد يفقد وعيه، واضطر أن يلازم الفراش، وأدرك أن أيامه معدودة، وطلب عدم السماح لأولغا بزيارته تحاشيًا لأي مشاجرة بينها وبين زينائيدا، ولجأ إلى كتابة رسائل قصيرة إلى حبيبته. وكتب في إحدى هذه الرسائل قبيل وفاته بمدة وجيزة: «عزيزتي أوليوشا، لقد كتبت اليوم إليكِ وها أنا أكتب إليك مرة أخرى، أنا معك طوال اليوم. أشعر أنك جزء مني، وكأننا كائن واحد، وأبعث رسائل لنفسي. أكتب وأموت من الحنين إليكِ». وقال في رسالة أخرى: «جميلتي الذهبية، رسالتك هدية ثمينة. إنها وحدها التي يمكن أن تشفي، وتلهم، وتبعث الحياة في كياني».
على الرغم من التوقعات المتفائلة للأطباء، تردت حالة الشاعر الصحية بسرعة. كان يردد وهو طريح الفراش، أن السبب في تدهور صحته ليس مرض القلب، بل مرض خبيث ورهيب، ولكن الأطباء استمروا في معالجة قلبه. وكان تشخيص باسترناك لمرضه صائبًا، وتأكد ذلك حين قام الأطباء بعد عدة أيام بإجراء فحوصات له بالأشعة السينية وتبيَّن أنه مصاب بسرطان الرئة. عندما علمت أولغا، أن حالة حبيبها تتدهور بسرعة، حاولت زيارته، ولكن زينائيدا منعتها من دخول المنزل، فجلست على مصطبة قريبة وأجهشت بالبكاء، غير أنها لم تكن تستطيع أن تقول له وداعًا.
قبيل وفاته، أخبر الكاتب أقاربه أنه يسره أن يموت؛ لأنه لم يعد بوسعه أن يرى خِسّة البشر، وأنه يرحل من دون أن يتصالح مع الحياة. تُوفِّي باسترناك في 30 مايو 1960م. وكان وقعُ وفاته شديدًا على أولغا ومؤلمًا لها جدًّا، فاستسلمت إلى الهمّ بعد فجيعتها في حبيبها. الأصدقاء المقربون منها -الذين كانوا يتوددون إليها خلال حياة الشاعر– لم يكتفوا بالإعراض عنها وتركها وحيدة، بل أخذوا بالتشهير بها، وفَبْركة الأكاذيب حولها. أما أقرباء الشاعر فقد وصفوها بأكثر النعوت ابتذالًا. وأخذوا يشيعون عنها روايات مفبركة، ومع ذلك فإن الأسوأ ما كان ينتظرها في قابل الأيام.
الدولة لا تعترف بوصية باسترناك
أوصى باسترناك بأن تقسّم حصته من أرباح نشر مؤلفاته في الخارج مناصفة بين زوجته زينائيدا وحبيبته أولغا. وعندما أرسل الناشر الإيطالي -الذي يحتفظ بموجب عقد مع باسترناك بحقوق نشر «دكتور زيفاغو» في خارج الاتحاد السوفييتي، أول دفعة مالية من حصة أولغا إلى موسكو عن طريق مبعوث خاص في صيف عام 1960م. أرسلت أولغا ابنتها إيرينا لاستلام النقود أمام بناية البريد المركزي في شارع غوركي بموسكو، وبعد عدة ساعات اقتحمت مجموعة مسلحة من الأمن السري شقة أولغا وصادروا، ليس الأموال فقط، بل كل رسائل الشاعر إليها، ومخطوطة أحدث أعماله غير المكتملة «الحسناء العمياء»، وكل مخطوطات أولغا نفسها، وأُلقِيَ القبض على أولغا وابنتها إيرينا، بتهمة تسلُّم أموال مهربة. وحُكم على أولغا بالسجن ثماني سنوات مع الأشغال الشاقة، وأُرسلت إلى أحد المعتقلات في موردوفيا، كما حُكم على ابنتها إيرينا بالسجن أربع سنوات وأُرسلت إلى معتقل آخر. وبعد مطالبة الأوساط الثقافية الأجنبية بالإفراج عنهما قامت الإذاعة السوفييتية الموجهة إلى الخارج بالتشهير بهما.
أُطلِق سراح أولغا وابنتها في عام 1962م قبل انتهاء مُدَّتَيْ حُكميهما. وعلى الرغم من إعادة الاعتبار إليهما في عام 1988م فلم تستردّ أولغا رسائل باسترناك التي صُودرت عند اقتحام شقتها. عندما تُوفي باسترناك كانت أولغا في الثامنة والأربعين من عمرها، ولم تزل جميلة وجذّابة، لكنها لم تتزوج، ولم تعقد أي علاقة عاطفية مع أي رجل آخر قط؛ لأن الحب فَقَدَ بالنسبة إليها معناه بعد حبيبها العظيم.
في أوائل التسعينيات، كتبت أولغا تقول: «أبلغُ من العمر 82 عامًا، وأتعرض إلى موجة من القذف والافتراء، ولا أريد أن أغادر الحياة وأنا مهانة ومظلومة». لذا سعت إلى نشر مذكراتها في وطنها لإطلاع الجميع على خبايا الحب الحقيقي والكبير والنادر بينها وبين باسترناك.
مذكرات أولغا
بين عامي 1972- 1974م كتبت أولغا إيفينسكايا مذكراتها تحت عنوان: «في أَسْر الزمن. سنوات مع بوريس باسترناك». تحدثت فيها عن الزمن السوفييتي العصيب، وعن شخصية الشاعر وعن شعره ورسائله إليها، وعن حياتهما المعذَّبة وحبِّهما العظيم، وعن الأحداث المأساوية المتعلقة بتأليف رواية «دكتور زيفاغو» ونشرها؛ العمل
الأدبي الرئيس في حياة باسترناك، وعن الضجة التي أُثيرت حول فوزه بجائزة نوبل، وإرغامه على رفضها، وعن رسالة باسترناك إلى نيكيتا خروشوف وجريدة «برافدا».
كان من الواضح أن هذه المذكرات لن تنشر في الاتحاد السوفييتي. وقد قام الشاعر يفغيني يفتوشينكو –الذي كان يكنُّ احترامًا كبيرًا لباسترناك ولأولغا إيفينسكايا– بتهريب المذكرات، إلى فرنسا حيث نُشرت في باريس عام 1979م، وسرعان ما تُرجِمت إلى أكثر من عشرين لغةً أجنبية. لا توجد في هذه المذكرات أي نرجسية، ولا أي محاولة لتلميع صورتها، أو مبالغة في تصوير عِشق باسترناك لها. ربما ثمة بعض الدَّلَال الأُنثوي الخفيف لا أكثر وهذا أمر مفهوم ومسوَّغ من امرأة كانت محطَّ أنظار الرجال لجمالها وأناقتها ولباقتها.
أولغا كانت تدرك المسافة بينها كمحررة ومترجمة وشاعرة متواضعة الموهبة، وبين شاعر وروائي عالمي. وكتبت بوضوح وعمق عن معاناة باسترناك وتمزقه الرُّوحيّ في ظروف بالغة التعقيد. واختتمت مذكراتها بالقول: «حبيبي! ها أنا أُنهِي كتابة مذكراتي عنك وحياتي معك. اغفر لي؛ لأنني لم أتمكن ولن أتمكن أبدًا من الكتابة على المستوى الذي تستحقه. عندما التقينا أولَ مرةٍ في «نوفي مير» كنت بالكاد أبلغ من العمر أربعة وثلاثين عامًا. لقد كرَّستُ معظم حياتي الواعية لك، وسأُكرِّس لك أيضًا ما تبقى منها. أنت تعلم -أن الحياة لم تكن رحيمةً بي، ولكنني لا أشتكي، فقد أعطتني سعادة عظيمة في الحب والعلاقة معك. ولن أنسى ما حييت وصيَّتك: لا يجب عليكِ أبدًا، في أي حال من الأحوال، أن تشعري باليأس. فالأمل المقرون بالعمل هو واجبنا في التعاسة».
تُوفِّيت أولغا في الثامن من سبتمبر عام 1995م عن عمر يناهز 83 عامًا. ونشرت عدة صحف وقنوات تلفزة خبر وفاتها، كما لو كانت نجمة سينمائية أو مغنية شهيرة.

جودت هوشيار - كاتب و مترجم عراقي | يناير 28, 2018 | ثقافات
في شتاء عام 1916م وصل العاصمة الروسية القديمة «بطرسبورغ» كاتب ناشئ اسمه إسحاق بابل، في الحادية والعشرين من عمره، قادمًا من مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود. كان متوسط القامة، ممتلئ الجسم، يرتدي نظارات طبية دائرية سميكة. وكان قد نشر عدة قصص في المجلات المحلية في أوديسا، لكنها لم تلفت إليه الأنظار، وأدرك أن الشهرة الحقيقية، إنما تنطلق من عاصمة الإمبراطورية لا من أطرافها، هنا في بطرسبورغ تصدر المجلات الأدبية الشهيرة، وتتصارع فيها شتى التيارات الفنية والأدبية، حيث يعيش ويعمل كبار الكتّاب والشعراء الروس. أخذ الشاب يتجول في أنحاء المدينة، ويرتاد مقاهيها الأدبية الصاخبة، حيث يقرأ الأدباء على الحاضرين قصائدهم وقصصهم القصيرة أو مقاطع مثيرة من رواياتهم، ويزعم كل واحد منهم أنه مؤسس ورائد مذهب أدبي حداثوي جديد. كان شتاء ذلك العام قارس البرودة، لكن الشاب القادم من مدينة الشمس -التي يطلق عليها كتّابها وشعراؤها اسم مرسيليا الأوكرانية– لم يكن يحفل بالبرد ويشق طريقه في شوارع العاصمة الغارقة تحت أكوام الثلوج من دون أن يلبس أي معطف. كان لديه مثل هذا المعطف، لكنه لم يكن يلبسه عن عمد. يحمل معه نصوصَ عدةِ قصصٍ قصيرة جريئة واستفزازية للذائقة الأدبية السائدة إبان العهد القيصري المتأخر. هذا ما يحدثنا عنه بابل نفسه في سيرته الذاتية المعنونة: «البداية».
قصص جديدة في مضامينها وأسلوبها الاختزالي، وإيقاعها. نثر فني أشبه بالشعر باستعاراتها الجميلة، وصورها الفنية النابضة بالحياة. تخترق التابوهات، التي لم يكن كاتب آخر يتجرأ على الاقتراب منها. قصص حب لا تخطر على البال، ولا تشبه قصص الحب عند الكُتاب الروس الكلاسيكيين منهم والمحدثين. كان الشاب الأوديسي يطرق أبواب المجلات الأدبية لكن من دون جدوى. لم يكلف أي رئيس تحرير نفسه عناء إلقاء نظرة على قصص كتَبَها شاب أوديسي مغمور، وإن فعلها كان يشعر بالاشمئزاز منها؛ لأنها تتناول ما هو مستور في المجتمع، لا ينبغي للأدب أن ينتهكه. رئيس تحرير إحدى المجلات أرسل له مع (البواب) روبلًا واحدًا. وقال رئيس تحرير مجلة أخرى: إن هذه القصص محض هراء، وإن حماه يمتلك مخزنًا للحبوب، وعرض على بابل العمل في هذا المخزن بصفة كاتب مبيعات. لكن الشاب الباحث عن المجد الأدبي رفض هذا العرض بإباء، وقال لنفسه: «من الأفضل أن أتشرد وأجوع أو أدخل السجن من أن أقبع عشر ساعات في اليوم في مكتب للقيام بأعمال روتينية مملة. حكمة أجدادي راسخة في ذهني: لقد خلقنا –نحن البشر– للاستمتاع بالعمل الخلاق، والكفاح، والحب».
لا خيار سوى غوركي
أدرك بابل أن لا خيار له سوى الذهاب إلى مكسيم غوركي الذي كان يصدر مجلة ثقافية معارضة باسم «ليتوبيس» أي «الوقائع»، وتضم هيئة تحريرها نخبة من الأدباء والنقاد والفلاسفة والمفكرين الروس المعروفين. كانت مجلة رصينة اكتسحت السوق خلال أشهر عدة، وأصبحت أكثر المجلات انتشارًا وتأثيرًا. توجه الكاتب الأوديسي الشاب إلى مقر المجلة، بقلب واجف وقد تملّكته الرهبة من لقاء الكاتب الشهير.
في غرفة الانتظار تجمع جمهور غير متجانس من شتى الفئات الاجتماعية، لا يجمعهم سوى عشق الأدب: سيدات المجتمع الراقي، والصعاليك، وموظفو التلغراف، ورجال الدين الرافضون للطقوس الأرثوذكسية، وعدد من العمال البلشفيك، حيث كان من المقرر أن يلتقي الجميع مكسيم غوركي. وما إن حلت الساعة السادسة حتى فتح الباب ودخل غوركي بقامته الفارعة. كان أشبه بهيكل عظمي ضخم، نحيفًا وقويًّا. عيناه زرقاوان، ويلبس بدلة أجنبية واسعة بعض الشيء، لكنها تبدو أنيقة ورائعة على جسده الممشوق. جاء غوركي كعادته في الوقت المحدد تمامًا، فقد كان طوال حياته وفيًّا لهذا الانضباط والدقة. قُسِّم جمهور المنتظرين إلى مجموعتين: الأولى: تضم أولئك الذين جاؤوا لاستلام أعمالهم وعليها ملاحظات غوركي وقراره النهائي بصدد مدى صلاحيتها للنشر في المجلة. والثانية الأشخاص الذين جلبوا معهم مخطوطات أعمالهم لغرض تسليمها إليه. توجه غوركي في البداية إلى المجموعة الأولى. كانت خطواته خفيفة ورشيقة، وهو يحمل بيده دفاتر كتب على بعضها ملاحظات أكثر من نص المؤلف نفسه. تحدث طويلًا مع كل واحد منهم. كان يُصيخ السمع إلى كلام محدثه، ويعبر عن رأيه على نحو مباشر وصارم، مختارًا الكلمات التي عرف هؤلاء قوتها في وقت لاحق، عندما قطعت طريقًا طويلًا إلى قلوبهم، وظلت راسخة في أذهانهم طوال حياتهم.
عندما انتهى غوركي من الوجوه المعروفة له من المقابلة السابقة، توجه إلى المجموعة الثانية، التي كانت تضم أصحاب النصوص الجديدة. وأخذ يجمع المخطوطات. ويقول بابل: «تطلع إليّ غوركي للحظة خاطفة. كنت في ذلك الوقت فتًى يافعًا، ممتلئ البدن، خليطًا غير مختمر من أفكار تولستوي والاشتراكي– الديمقراطي. لم أكن أرتدي معطفًا، لكنني كنت مسلحًا بالنظارات… كان ذلك في يوم الثلاثاء. أخذ غوركي الدفاتر الجديدة، وقال: «تعالوا يوم الجمعة لاستلام الإجابات». وأثار ذلك دهشة بابل، فقد كانت المخطوطات تبقى لدى إدارات المجلات، شهورًا عدة، وربما للأبد».
عاري القدمين يسير فوق المسامير
في يوم الجمعة كانت هناك مجموعة جديدة في الانتظار، مثلما في المرة السابقة. وكانت تضمّ أميرات، ورهبانًا، وضباط بحرية، وطلابًا. حين دخل غوركي الغرفة، ألقى على بابل نظرة عابرة، لكنه تركه ينتظر للأخير. غادر الجميع وبقي غوركي وبابل، الذي شعر –كما يقول– كأنه سقط من كوكب آخر. دعاه غوركي إلى مكتبه. الكلمات التي سمعها هناك قررت مصيره الأدبي. قال له غوركي: «هناك مسامير صغيرة، وأخرى كبيرة بحجم إصبعي –ولوّح بسبابته قريبًا من عيني بابل– إصبع طويل، وقوي، لطيف الطراز -مسار الكاتب مليء بالمسامير الكبيرة غالبًا. وعلى الكاتب أن يسير فوقها عاري القدمين وهو ينزف دمًا غزيرًا. ومن سنة إلى أخرى يزداد تدفق الدم على نحو أقوى. أنت إنسان ضعيف– سيشترونك ويبيعونك. سيضعون أمامك عقبات، وسيخدعونك، إلى أن تتلاشى، لكنك ستتظاهر أنك شجرة مزهرة. عبور هذا المسار للإنسان الصادق، وللكاتب الصادق، وللثوري الصادق، شرف عظيم. أباركك على هذا الطريق سيدي».
ويقول بابل: «حقًّا لم يكن ثمة في حياتي، ما هو أكثر أهمية من تلك الساعة التي قضيتها في مقر مجلة (ليتوبيس). وعندما خرجت من البناية، فقدت الإحساس الجسدي بكياني. ركضت في البرد الحارق. ومضيت ثملًا، وتائهًا، أهذي في شوارع العاصمة الفسيحة الخضراء المفتوحة على السماء المظلمة البعيدة. ولم أسترجع رشدي إلا عندما تركت ورائي النهر الأسود والقرية الجديدة في أطراف المدينة». مضى نصف الليل قبل أن يرجع الشاب الأوديسي الحالم، إلى غرفته في شقة تعود إلى أحد المهندسين. كان بابل قد استأجر الغرفة من زوجة المهندس، وكانت امرأة شابة قليلة الخبرة. وحين عاد زوجها من عمله ونظر إلى الشاب الغريب، أمر زوجته أن تأخذ من المدخل المعاطف والقبعات، وأن تقفل الباب بين غرفة المستأجر المشبوه وغرفة الطعام. رجع بابل إلى الشقة ليلًا، وعندما دخل رأى المشجب في مدخل الشقة خاليًا من المعاطف والقبعات التي تعلق عليه في العادة. كانت روح بابل تغلي وتسكب عليه حرارة الفرح وتستبد به مطالبة بالخروج. لم يكن أمامه من خيار سوى أن يقف في المدخل مبتسمًا لشيء ما، ثم فتح فجأة باب غرفة الطعام. كان المهندس وزوجته يشربان الشاي. وعندما رأياه في هذا الوقت المتأخر اصفرّ وجهاهما. توقع المهندس الشر من القادم الجديد، واستعد أن يبيع حياته غاليًا. خطا بابل خطوتين نحوه، وقال للزوجين: إن مكسيم غوركي وعد بنشر قصصه في مجلته الشهيرة. وأدرك المهندس أنه أخطأ حين اعتبر الشاب الغريب شخصًا شريرًا. جلس بابل أمام المائدة، وسحب نحوه كوب شاي ساخن، وقال: سأقرأ لكما بعض قصصي، تلك التي وعدني غوركي بنشرها.
الثورة البلشفية تنقذهما من المحاكمة
 ظهرت قصتان لبابل على صفحات المجلة في عدد نوفمبر عام 1916م، وهما: «إيليا إيساكوفيتش ومرغريتا بروكوفيفنا» و«ماما، ريما، آلا». أثارت القصتان اهتمام القراء والسلطة القضائية، التي وجّهت إلى بابل وغوركي ثلاث تهم في آنٍ واحد. وهي: نشر البورنوغرافيا، وانتهاك المقدسات، ومحاولة قلب نظام الحكم القائم. ولكن ثورة فبراير 1917م أنقذتهما من المحاكمة التي كانت ستجري في شهر مارس. ويقول بابل عن تلك المحاكمة متهكمًا: «إن المحاكمة لم تُجْرَ لأن الشعب ثار من أجلي، وأحرق ليس ملف قضيتي فقط، بل بناية المحكمة بأسرها». اجتذبت القصتان اهتمام القراء والنقاد، وأصبح اسم بابل معروفًا إلى حد ما. وواصل الكاتب الشاب كتابة قصص جديدة، حيث كان يكتب قصة واحدة كل يوم ويعرضها على غوركي، الذي كان يقرأ القصة بتمعن، ثم يقول: إنها غير صالحة للنشر. وتكرر ذلك مرات عدة. وأخيرًا تعب كلاهما. وقال غوركي بصوته الجهوري الأجش: «إنك تتخيل أشياء كثيرة تقريبية؛ لأنك لا تعرف الحياة بعد. عليك التوجه إلى الناس، ومعرفة الواقع، واكتساب تجربة ذاتية تساعدك في فهم الحياة، قبل أن تكون قادرًا على كتابة قصة جيدة».
ظهرت قصتان لبابل على صفحات المجلة في عدد نوفمبر عام 1916م، وهما: «إيليا إيساكوفيتش ومرغريتا بروكوفيفنا» و«ماما، ريما، آلا». أثارت القصتان اهتمام القراء والسلطة القضائية، التي وجّهت إلى بابل وغوركي ثلاث تهم في آنٍ واحد. وهي: نشر البورنوغرافيا، وانتهاك المقدسات، ومحاولة قلب نظام الحكم القائم. ولكن ثورة فبراير 1917م أنقذتهما من المحاكمة التي كانت ستجري في شهر مارس. ويقول بابل عن تلك المحاكمة متهكمًا: «إن المحاكمة لم تُجْرَ لأن الشعب ثار من أجلي، وأحرق ليس ملف قضيتي فقط، بل بناية المحكمة بأسرها». اجتذبت القصتان اهتمام القراء والنقاد، وأصبح اسم بابل معروفًا إلى حد ما. وواصل الكاتب الشاب كتابة قصص جديدة، حيث كان يكتب قصة واحدة كل يوم ويعرضها على غوركي، الذي كان يقرأ القصة بتمعن، ثم يقول: إنها غير صالحة للنشر. وتكرر ذلك مرات عدة. وأخيرًا تعب كلاهما. وقال غوركي بصوته الجهوري الأجش: «إنك تتخيل أشياء كثيرة تقريبية؛ لأنك لا تعرف الحياة بعد. عليك التوجه إلى الناس، ومعرفة الواقع، واكتساب تجربة ذاتية تساعدك في فهم الحياة، قبل أن تكون قادرًا على كتابة قصة جيدة».
أفاق بابل في صباح اليوم التالي ليجد نفسه -بمساعدة غوركي بطبيعة الحال- مراسلًا لصحيفة لم تولد بعد، مع مئتي روبل في جيبه. لم تولد الصحيفة قط، لكن الروبلات المنعشة كانت ضرورية له. استمرت رحلة بابل في خضم الحياة سبع سنوات (1917: 1924م) كان في أثنائها جنديًّا في الجبهة الروسية – الرومانية إبان الحرب العالمية الأولى، ومراسلًا حربيًّا في فرقة «الفرسان الحمر»، وموظفًا في مفوضية التعليم، ومديرًا لدار نشر في أوديسا، ومندوبًا لبعض الصحف في بطرسبورغ وتبليسي. قطع كثيرًا من الطرق، وشاهد كثيرًا من المعارك. وكان طوال تلك السنوات يكتب ويطوّر أسلوبه. ويجرب التعبير عن أفكاره بوضوح واختصار. وبعد تسريحه حاول نشر نتاجاته، وتسلّم من غوركي رسالة يقول فيها: «ربما الآن يمكنك أن تبدأ».
كان غوركي مفعمًا بالحماس للإبداع البشري والزيادة المستمرة مهما يكن الأمر في عدد الأشياء الجميلة والمنشودة في الحياة، ويبحث عن الموهوبين. يتابع محاولاتهم في الكتابة الإبداعية، ويقرأ نصوصهم بصبر وتمعّن، ويشير إلى نقاط الضعف فيها، ويرشدهم ويرعاهم بالنصح والإرشاد، سواء في أثناء اللقاءات المباشرة أو من خلال الرسائل المتبادلة معهم، وهي حالة نادرة إن لم تكن الوحيدة في تاريخ الأدب العالمي. كان يتعذب عندما يرى الإنسان الذي كان يتوقع منه كثيرًا يخيب ظنه. وكان سعيدًا يفرك يديه من الفرح، ويغمز للعالم، وللسماء، وللأرض، عندما تتحول الشرارة إلى شعلة ملتهبة. ولولا غوركي لَما عرف الأدب الروسي والعالمي عشرات الكتّاب المبدعين. وفي مقدمتهم إسحاق بابل، أحد أنبغ أساتذة فن القصة القصيرة في القرن العشرين.

جودت هوشيار - كاتب و مترجم عراقي | مارس 1, 2017 | قضايا
كان البلاشفة قبل استيلائهم على السلطة في روسيا ينادون بحرية الرأي والتعبير، وينددون بالرقابة المفروضة على المطبوعات، واضطهاد الكتاب والشعراء والمفكرين. ولكنهم بعد وصولهم إلى السلطة تناسوا شعاراتهم الديماغوجية، ومارسوا أعتى أنواع الرقابة على المطبوعات، واضطهدوا كل مفكر ومبدع لا يخضع لمقاييس الحزب الحاكم الأيديولوجية. واتخذ العلماء والأدباء الروس المعروفون مواقف متباينة من النظام الجديد. هاجر عدد كبير منهم إلى البلدان الأوربية، أما معظم الباقين فقد اتخذ موقف التوجس والانتظار. ولم يؤيد الثورة البلشفية إلا عدد قليل من المفكرين والأدباء.
في عام 1922م قامت السلطة السوفييتية بترحيل نخبة من خيرة المفكرين والفلاسفة والأدباء الروس الرافضين للحكم الجديد إلى الخارج، في باخرة سميت فيما بعد بـ«باخرة الفلاسفة» تضم 160 شخصًا، وأعقبتها بواخر أخرى مماثلة. وقد برّر تروتسكي -وكان لا يزال أحد القادة الكبار في النظام البلشفي- هذا الترحيل الجماعي قائلًا: «إننا نرحل هؤلاء الناس؛ لأنه ليس ثمة مبرر لإعدامهم، ولكننا لا نحتمل بقاءهم».
آلة القتل الستالينية
بعد وفاة لينين في أوائل عام 1924م استطاع جوزيف ستالين، الذي كان أحد قادة السلطة الجديدة، تشديد قبضته على الحكم تدريجيًّا بالقضاء على منافسيه وتصفيتهم، الواحد بعد الآخر. كان النظام الشمولي يرى في كل زاوية عدوًّا، وفي كل كلمة حق مؤامرة إمبريالية. وكان مصير كل كاتب أو شاعر ينتقد النظام هو الإعدام أو الاعتقال والنفي إلى أقاصي سيبيريا. في 15 أغسطس 1934م أرسل ستالين تعليمات سرية إلى لازار كاغانوفيج أحد أقطاب النظام السوفييتي حول كيفية التعامل مع الأدباء يقول فيها: «ينبغي التوضيح لكل الأدباء، أن اللجنة المركزية للحزب وحدها هي صاحبة الأمر والنهي في الأدب، كما في المجالات الأخرى، وينبغي عليهم الخضوع لها من دون مناقشة». لكن ستالين كان في حاجة إلى واجهة ثقافية أمام العالم، ولم يجد خيرًا من غوركي –الذي كان قد غادر روسيا عام 1921م، بعد خلافه مع لينين- للقيام بهذا الدور، واستطاع إقناعه بالعودة إلى روسيا. لم تكن صحة غوركي في سنواته الأخيرة على ما يرام، وتوفي عام 1936م؛ مما شكل صدمة كبيرة للكتاب والشعراء المستقلين، لأن غوركي -بشخصيته الكاريزمية ونفوذه المعنوي وعلاقته بستالين- كان حاميًا لهم من الاضطهاد. وحدث ما كان يخشاه الكتاب المستقلون؛ إذ طحنت آلة القتل الستالينية في السنوات التالية خبرة الكتاب والشعراء والفنانين. وحظرت السلطة نتاجاتهم وأزالت أسماءهم أينما وردت.
فترة ذوبان الجليد

نيكيتا خروتشوف

ليون تروتسكي
بعد وفاة ستالين ببضع سنين حلت فترة «ذوبان الجليد»، وهي الاسم غير الرسمي للسنوات العشر (1954-1964م) التي تولى فيها نيكيتا خروتشوف (1894- 1971م) الحكم في البلاد. وكانت فترة قصيرة شهدت انعقاد (المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي) عام 1956م، وخطاب خروتشوف الشهير الذي كشف فيه النقاب عن جرائم ستالين.
تميزت هذه الفترة في الحياة الثقافية بإعادة الاعتبار إلى معظم ضحايا العهد الشمولي ومن ضمنهم الشعراء والكتاب، وإطلاق سراح المعتقلين منهم، وتخفيف الرقابة على المطبوعات والمسرح والسينما والفنون الأخرى؛ إذ أصبح ممكنًا تسليط بعض الضوء على الجوانب السلبية للواقع السوفييتي.
وأصبحت مجلة «العالم الجديد» الأدبية المنبر الرئيس للكتاب الأحرار؛ حيث نشرت المجلة العديد من الأعمال الأدبية المتميزة؛ منها: رواية «ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان» لفلاديمير دودنتسوف، ورواية ألكسندر سولجينتسين «يوم واحد في حياة إيفان دينيسوفيتش» اللتان ترجمتا إلى العديد من لغات العالم. وفي عام 1957م نشرت في ميلانو رواية بوريس باسترناك «دكتور جيفاغو» الذي نال عنها في العام التالي جائزة نوبل للآداب. كان بعض المتزمتين في القسم الأيديولوجي للحزب الشيوعي يحرّض خروتشوف ضد الأدباء الأحرار، وينتهز كل هفوة لهم للنيل منهم، وجاءت الفرصة الذهبية لهؤلاء حين اتخذوا من نشر الرواية في الخارج ذريعة لشن حملة شعواء ضد باسترناك، وإرغامه على رفض الجائزة. ولكن التيار الليبرالي في الآداب والفنون كان يكسب مواقع جديدة كل يوم؛ إذ برزت في بداية الستينيات نخبة موهوبة من الكتاب والشعراء الشباب الذين شكلوا ظاهرة أدبية جذبت الأنظار. وقد أطلق عليهم النقاد اسم «جيل الستينيات» وأصبحوا منابر إبداعية للتعبير عن آمال الشباب السوفييتي وتطلعاتهم، رغم اختلاف مشارب هؤلاء الأدباء وأساليبهم الأدبية. وقد أسعدني الحظ أن أحضر العديد من اللقاءات الأدبية الجماهيرية في القاعات والمسارح والملاعب الرياضية التي كانت تغصّ بآلاف الشباب الذين جاؤوا من كل حدب وصوب للاستماع إلى قصائد هذه النخبة المبدعة من الشعراء الشباب (يفغيني يفتوشينكو، وروبرت روجديستفنسكي، وأندريه فوزنيسينسكي، وبيلا أحمدولينا) وقصص فلاديمير تيندرياكوف، وفاسيلي أكسيونوف، وفيكتور أستافيف.
ولم تخل هذه الفترة من تدخل الكرملين في الشؤون الثقافية، فقد جمع خروتشوف الأدباء الشباب بحضور جمع كبير من أبرز الأدباء السوفييت في إحدى قاعات الكرملين عام 1963م؛ لتهديدهم إن لم يلتزموا بمدرسة الواقعية الاشتراكية. وقد اعترف خروتشوف لاحقًا في مذكراته التي نشرت في أوائل السبعينيات في الخارج، بأن المسؤول الأيديولوجي في الحزب قد حرَّضه ضد الأدباء الشباب، وأنه يأسف لذلك. ظلت الرقابة الحزبية والحكومية على الأعمال الفكرية والإبداعية مستمرة وإن كانت على نحو أخفّ. فعلى سبيل المثال حذفت الرقابة فقرات كثيرة من مذكرات إيليا إهرنبورغ: «الناس والأعوام والحياة» ومن كل الأعمال التي تعبر بصدق عن الواقع السوفييتي المرير.
ركود وأدب سري

ليونيد بريجينيف

ميخائيل غورباتشوف
في أكتوبر 1964م، عُزل خروتشوف عن السلطة وتولى ليونيد بريجينيف (1906-1982م) مقاليد الأمور. دشن بريجينيف عهده بالتضييق على حرية التعبير. وجرت بين خريف 1965م وشباط 1966م محاكمة الكاتبين سينيافسكي ودانيل؛ إذ حكم على الأول بالسجن سبع سنوات وعلى الثاني خمس سنوات بدعوى تهريب بعض أعمالهم الأدبية المحظورة، ونشرها خارج البلاد. شهدت هذه الفترة نوعين من الأدب: أولهما – الأدب العلني الملتزم بقواعد الواقعية الاشتراكية. وثانيهما: الأدب السري المتداول في الخفاء والمطبوع أو المستنسخ بوسائل بدائية، حيث لم تكن أجهزة الاستنساخ الحديثة والكمبيوتر قد شاعت بعد. ومن أشهر المطبوعات السرية في تلك الفترة مجلة «ميتروبول» التي صدر أول عدد منها عام 1970م وكانت مجلة فكرية وأدبية غير دورية.. وقد أثارت المجلة سخط السلطة، فلجأت إلى طرد بعض المشرفين أو المساهمين فيها إلى الخارج، وزجّ بعض آخر في المصحّات العقلية والنفسية.
ولم يقتصر الاضطهاد على جماعة «ميتروبول»، ففي عام 1972م حكم على الشاعر جوزيف برودسكي (1940 – 1996م) بالنفي إلى قرية نائية في أقصى الشمال الروسي. وبعد انتهاء مدة نفيه نُزعت الجنسية السوفييتية منه وطُرد من البلاد. كانت السلطة تحاول محو الآثار السلبية الناجمة عن النشر السري بعقد ندوات جماهيرية (تثقيفية) في المصانع ومؤسسات الدولة للتنديد بالكتاب المتمردين، والتشهير بهم. والطريف في الأمر أن هذه الندوات شكلت دعاية مجانية للأدباء المتمردين. وكان كل من لم يقرأ أعمالهم يحاول الحصول عليها بأي ثمن.
البريسترويكا ونشر المحظور
كان ميخائيل غورباتشوف الذي تولى السلطة عام 1984م، يدرك أن حظر نشر نتاجات أي كاتب أو شاعر يؤدي إلى تعظيم دوره وزيادة تأثيره في مجتمع يعشق قراءة الأعمال الأدبية مثل المجتمع الروسي، ولهذا خُفِّفت الرقابة الحكومية على المطبوعات ثم أُلغيت. خلال فترة البريسترويكا نُشرت أهم الأعمال الأدبية المحظورة في الحقبة السوفييتية السابقة للكتاب والشعراء الذين قتلهم ستالين أو قضوا أجمل سنوات أعمارهم في معتقلاته. كما عاد إلى القارئ الروسي، كل النتاجات الإبداعية لأدباء المهجر الذين كانت السلطة في الفترات السابقة تستخف بهم، وتمنع تداول كتبهم داخل البلاد.
أراد بوريس يلتسين بعد وصوله إلى قمة السلطة عام 1991م أن يستنسخ التجربة الغربية في الانتقال إلى الليبرالية واقتصاد السوق من دون توافر المقدمات الضرورية لذلك، فدبَّت الفوضى في مفاصل المجتمع والدولة. وشملت الفوضى الحياة الثقافية أيضًا، ولم يعرف عن يلتسين اهتمامه بالآداب والفنون. وكان الأدب الأميركي الجماهيري أو الشعبي في مقدمة اهتمامات دور النشر الروسية، التي كانت ترفض نشر الأعمال الروسية الجادة بدعوى أنها لا تجد إقبالًا في السوق. وأصبح الطريق سالكًا أمام كل من يعرف اختلاق القصص الهابطة فنيًّا ونظم الشعر الرديء. وجرى إلغاء الدعم الحكومي للاتحادات الأدبية والفنية. وكانت فترة انتقالية صعبة يتذكرها الروس بمرارة.
بوتين يضيق الخناق على الكتاب
منذ تولي فلاديمير بوتين زمام السلطة تراجعت حرية التعبير وأخذت تضيق شيئًا فشيئًا. وأصبحت كل وسائل الإعلام اليوم خاضعة للتوجيهات الرسمية. ولم تبقَ أي قناة تلفزة خاصة أو مستقلة في البلاد، وباتت كلها حكومية، وتُفرَض على برامجها رقابة سياسية صارمة. وتمارس هذه القنوات تضليلًا إعلاميًّا واسع النطاق للرأي العام، وتدغدغ مشاعر البسطاء عن طريق التغني بالدولة العظمى والمجد الإمبراطوري للأجداد، والقسم الأكبر من برامجها ترفيهيّ، وإن كانت تقدم بين حين وآخر لقاءات مع كتاب موالين للسلطة، أو تنقل الاحتفالات الخاصة بمنحهم جوائز الدولة التقديرية.
الجيل الجديد الذي ترعرع بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، لم يعد يهتم كثيرًا بالكتب الجادة، بل يتابع بشغف البرامج التلفزيونية المعادية للغرب، والمسلسلات، والمنافسات الرياضية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والوسائط المتعددة. وتراجع دور الكاتب أو الشاعر في المجتمع.
ثمة عدد كبير من دور النشر والصحف والمجلات ومن ضمنها المجلات الأدبية (السميكة) التي تدعي الاستقلالية، ولكنها تتجنب نشر ما يغضب السلطة، فثمة عشرات السبل لخنق دار النشر أو الصحيفة أو المجلة، أو تهميش الكاتب، وأهمها قانون المطبوعات بموادّه المطاطية التي يمكن تفسيرها على هوى الحكومة، وهناك الجوائز الأدبية التي لا تمنح إلا مَن كان ظلًّا للحاكم ومتملّقًا له. وهذا لا يعني أن ثمة قيودًا مباشرة على الكاتب. فأي كاتب يمكن أن يكتب ما يشاء، ولكن عمله قد لا يرى النور، أو يطبع في أضيق الحدود، ولا يصل إلى معظم أنحاء البلاد.

بوريس يلتسين
يعقد بوتين، بين حين وآخر لقاءات -ينظمها مكتبه الإعلامي– مع عدد مختار من الكتاب المعروفين لمناقشة بعض القضايا الأدبية، من قبيل كيفية الحفاظ على نقاوة اللغة الروسية من التشويه والابتذال، أو تطوير المقررات الخاصة بالأدب في المدارس، أو مشاكل اتحاد الأدباء -الذي انشطر إلى اتحادات عدة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي- والعقبات التي تحول دون نشر الأعمال الأدبية. وفي العادة توجه الدعوات لحضور مثل هذه اللقاءات إلى الكتاب الموالين للسلطة، وإلى بعض الكتاب المعارضين؛ لإضفاء جوّ من الحيوية على اللقاء، لأن عدم وجود أي صوت معارض يحوّل أي لقاء من هذا النوع إلى حوار السلطة مع نفسها. ويرفض معظم الكتاب الأحرار الدعوة الموجهة إليهم للقاء رئيس الدولة، خشية توجيه الاتهام لهم بالتعاون مع السلطة. ويرى بعض الكتّاب المعارضين (بوريس أكونين، وإدوارد ليمونوف) ضرورة انتهاز مثل هذه الفرص النادرة لطرح القضايا الملحّة التي تهم الرأي العام؛ مثل: الرقابة السياسية المفروضة على التلفزيون، وانتهاك حقوق الإنسان، ومحاكمة بعض الكتّاب، منهم (يوري بيتوخوف، وتريوخليبوف، وميرونوف) وسحب كتبهم من السوق ومصادرتها لاحتوائها على آراء قومية أو دينية متطرفة.
إجابات بوتين عن أسئلة الكتّاب تكون في العادة شافية وتتسم بالهدوء، وأحيانًا مراوغة، ونادرًا ما تكون قاطعة، لكن ينبغي أن يقال: إنه لا ينزعج من أي سؤال، ولا يرفض الإجابة عنه. بعض الكتاب المعارضين يعتقد أن الغرض من عقد هذه اللقاءات، قبيل كل دورة انتخابية، ليس الاهتمام بالأدب والأدباء، بل لأغراض دعائية لكسب الناخبين. ونصح كاتب جريء بوتين بالتقاط الصور ليس فقط على خلفية صاروخ (توبول) ولكن أيضًا على خلفية أرفف الكتب أو ما له علاقة بالأدب.
معظم الجيل الجديد من الكتاب الروس يلهث وراء التقليعات الشائعة في الآداب الغربية الحديثة. وليس في روسيا اليوم سوى عدد محدود جدًّا من الكتاب المجيدين. ويتساءل النقاد في الغرب: «هل مات الأدب الروسي؟» ولماذا لم يعد في روسيا اليوم كتّاب عمالقة بمستوى تولستوي ودوستويفسكي؟ ويذهب هؤلاء النقاد في تفسير ذلك مذاهب شتى. لكننا نرى أن السبب الرئيس لتخلف الأدب الروسي المعاصر، لا يرجع فقط إلى ظهور وسائل جديدة لنشر المحتوى الأدبي، أو أن السوق أخذت تفرض نوعًا معينًا من النتاجات الخفيفة، التي تشبه الـ«فاست فود» يلتهمها الإنسان بسرعة وينساها بسرعة أكبر، بل يكمن أساسًا في تضييق نظام بوتين الخناق على حرية الرأي والتعبير. ولا يوجد أدب حقيقي وعظيم من دون حرية الكلمة.

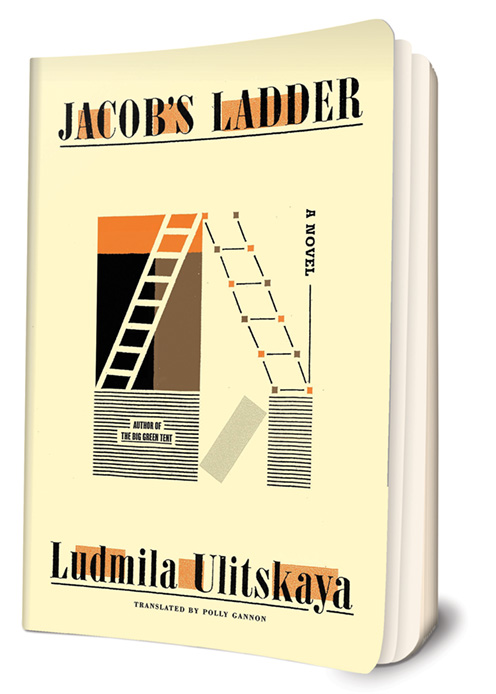 ظلت أوليتسكايا من دون عمل مدة طويلة فلم يكن بوسعها الالتحاق بأي عمل جديد من دون موافقة جهاز الأمن السري. وفي عام 1979م تمكنت بشق الأنفس من الالتحاق بمسرح الدراما في موسكو وأصبحت رئيسة للقسم الأدبي. وكانت مهمتها الرئيسة اجتذاب الكتّاب المسرحيين ومراجعة نصوصهم وإعداد برنامج المسرح. وهي ترى عملها في مسرح الدراما مهمًّا جدًّا؛ فقد ساعدها فيما بعد في كتابة العديد من الأعمال الدرامية للمسرح والسينما والتلفزيون. عملت هناك ثلاث سنوات، وعندما تركت العمل في عام 1982م كانت تعرف على وجه اليقين أنها تريد أن تكون كاتبة ولن تمارس أي مهنة أخرى. بعد نحو عام نشرت كتابها الأول بعنوان «مئة زر»، وهي مجموعة قصصية للأطفال ولم تلق هذه المجموعة أي صدى في روسيا، ثم نشرتْ مجموعة كبيرة من القصص القصيرة في المجلات والصحف الأدبية الروسية من دون أن تلقى اهتمامًا كبيرًا من النقاد، لكن في الوقت نفسه أخذت أعمالها تترجم وتنشر في أوربا الغربية.
ظلت أوليتسكايا من دون عمل مدة طويلة فلم يكن بوسعها الالتحاق بأي عمل جديد من دون موافقة جهاز الأمن السري. وفي عام 1979م تمكنت بشق الأنفس من الالتحاق بمسرح الدراما في موسكو وأصبحت رئيسة للقسم الأدبي. وكانت مهمتها الرئيسة اجتذاب الكتّاب المسرحيين ومراجعة نصوصهم وإعداد برنامج المسرح. وهي ترى عملها في مسرح الدراما مهمًّا جدًّا؛ فقد ساعدها فيما بعد في كتابة العديد من الأعمال الدرامية للمسرح والسينما والتلفزيون. عملت هناك ثلاث سنوات، وعندما تركت العمل في عام 1982م كانت تعرف على وجه اليقين أنها تريد أن تكون كاتبة ولن تمارس أي مهنة أخرى. بعد نحو عام نشرت كتابها الأول بعنوان «مئة زر»، وهي مجموعة قصصية للأطفال ولم تلق هذه المجموعة أي صدى في روسيا، ثم نشرتْ مجموعة كبيرة من القصص القصيرة في المجلات والصحف الأدبية الروسية من دون أن تلقى اهتمامًا كبيرًا من النقاد، لكن في الوقت نفسه أخذت أعمالها تترجم وتنشر في أوربا الغربية.
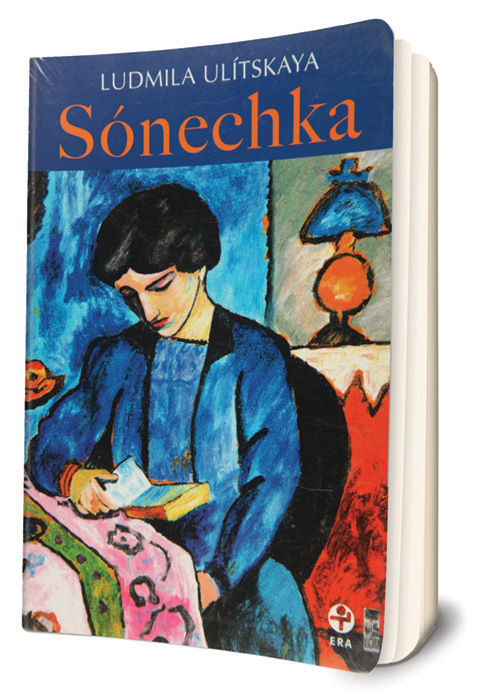 «ميديا وأطفاها»: رواية صدرت في عام 1996م وعُدّتِ الحدث الأدبي الأهم لذلك العام في روسيا وفي إيطاليا. نالت هذه الرواية جائزة جوزيبي أتسيربي، وحصلت أيضًا على جائزة ميديسي لعام 1996م. رواية عن القدر والمصير. ميديا منديس سينوبلي امرأة يونانية من القرم تحملت في حياتها كل مصاعب الأوقات العصيبة وأفراح سنوات الهدوء النادرة. في حياة البطلة وعائلتها كان هناك كل شيء: الحرب والخيانة والقتل والغيرة والحب العظيم. يجد القارئ ميديا في وحدة وهمية: ليس لديها أقارب بالدم لكن منزلها مليء دائمًا بالأشخاص الذين حلوا محل أقاربها. هذه قصة عما يمكن للشخص أن يختاره بنفسه في الحياة وما ليس لديه سلطة عليه.
«ميديا وأطفاها»: رواية صدرت في عام 1996م وعُدّتِ الحدث الأدبي الأهم لذلك العام في روسيا وفي إيطاليا. نالت هذه الرواية جائزة جوزيبي أتسيربي، وحصلت أيضًا على جائزة ميديسي لعام 1996م. رواية عن القدر والمصير. ميديا منديس سينوبلي امرأة يونانية من القرم تحملت في حياتها كل مصاعب الأوقات العصيبة وأفراح سنوات الهدوء النادرة. في حياة البطلة وعائلتها كان هناك كل شيء: الحرب والخيانة والقتل والغيرة والحب العظيم. يجد القارئ ميديا في وحدة وهمية: ليس لديها أقارب بالدم لكن منزلها مليء دائمًا بالأشخاص الذين حلوا محل أقاربها. هذه قصة عما يمكن للشخص أن يختاره بنفسه في الحياة وما ليس لديه سلطة عليه.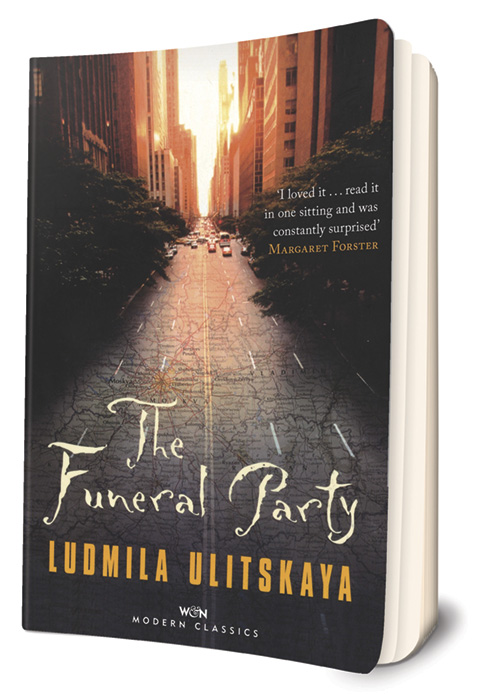 لم تكن أوليتسكايا معجبة بالسلطة الروسية في أي مرحلة من حياتها، إلا أنها انتقدت علنًا سياسة الرئيس بوتين بعد استيلائه على شبه جزيرة القرم ونشر القوات الروسية في المناطق الشرقية الأوكرانية من دونيتسك ولوغانسك في عام 2014م. وهي تعتقد أن بوتين ليس لديه عقيدة أيديولوجية، بل يهتم في المقام الأول بالمال، ويحلم باستعادة الإمبراطورية السوفييتية. وعندما سُئلت عن موقفها من الكرملين؛ قالت: «من الطبيعي أن يكره المثقف الروسي سلطة الدولة الروسية». في عام 2012م، شاركتْ في الاحتجاجات ضد بوتين، واليوم تنظر إلى الحرب في أوكرانيا بشعور من الرعب: «إن هوس رجل واحد وأتباعه المخلصين هو الذي يحدد مصير البلاد. لا يسعنا إلا تخمين ما ستقوله كتب التاريخ عن هذا في غضون الخمسين سنة المقبلة. الألم والخوف والخجل، هذا ما أشعر به اليوم».
لم تكن أوليتسكايا معجبة بالسلطة الروسية في أي مرحلة من حياتها، إلا أنها انتقدت علنًا سياسة الرئيس بوتين بعد استيلائه على شبه جزيرة القرم ونشر القوات الروسية في المناطق الشرقية الأوكرانية من دونيتسك ولوغانسك في عام 2014م. وهي تعتقد أن بوتين ليس لديه عقيدة أيديولوجية، بل يهتم في المقام الأول بالمال، ويحلم باستعادة الإمبراطورية السوفييتية. وعندما سُئلت عن موقفها من الكرملين؛ قالت: «من الطبيعي أن يكره المثقف الروسي سلطة الدولة الروسية». في عام 2012م، شاركتْ في الاحتجاجات ضد بوتين، واليوم تنظر إلى الحرب في أوكرانيا بشعور من الرعب: «إن هوس رجل واحد وأتباعه المخلصين هو الذي يحدد مصير البلاد. لا يسعنا إلا تخمين ما ستقوله كتب التاريخ عن هذا في غضون الخمسين سنة المقبلة. الألم والخوف والخجل، هذا ما أشعر به اليوم».






 ظهرت قصتان لبابل على صفحات المجلة في عدد نوفمبر عام 1916م، وهما: «إيليا إيساكوفيتش ومرغريتا بروكوفيفنا» و«ماما، ريما، آلا». أثارت القصتان اهتمام القراء والسلطة القضائية، التي وجّهت إلى بابل وغوركي ثلاث تهم في آنٍ واحد. وهي: نشر البورنوغرافيا، وانتهاك المقدسات، ومحاولة قلب نظام الحكم القائم. ولكن ثورة فبراير 1917م أنقذتهما من المحاكمة التي كانت ستجري في شهر مارس. ويقول بابل عن تلك المحاكمة متهكمًا: «إن المحاكمة لم تُجْرَ لأن الشعب ثار من أجلي، وأحرق ليس ملف قضيتي فقط، بل بناية المحكمة بأسرها». اجتذبت القصتان اهتمام القراء والنقاد، وأصبح اسم بابل معروفًا إلى حد ما. وواصل الكاتب الشاب كتابة قصص جديدة، حيث كان يكتب قصة واحدة كل يوم ويعرضها على غوركي، الذي كان يقرأ القصة بتمعن، ثم يقول: إنها غير صالحة للنشر. وتكرر ذلك مرات عدة. وأخيرًا تعب كلاهما. وقال غوركي بصوته الجهوري الأجش: «إنك تتخيل أشياء كثيرة تقريبية؛ لأنك لا تعرف الحياة بعد. عليك التوجه إلى الناس، ومعرفة الواقع، واكتساب تجربة ذاتية تساعدك في فهم الحياة، قبل أن تكون قادرًا على كتابة قصة جيدة».
ظهرت قصتان لبابل على صفحات المجلة في عدد نوفمبر عام 1916م، وهما: «إيليا إيساكوفيتش ومرغريتا بروكوفيفنا» و«ماما، ريما، آلا». أثارت القصتان اهتمام القراء والسلطة القضائية، التي وجّهت إلى بابل وغوركي ثلاث تهم في آنٍ واحد. وهي: نشر البورنوغرافيا، وانتهاك المقدسات، ومحاولة قلب نظام الحكم القائم. ولكن ثورة فبراير 1917م أنقذتهما من المحاكمة التي كانت ستجري في شهر مارس. ويقول بابل عن تلك المحاكمة متهكمًا: «إن المحاكمة لم تُجْرَ لأن الشعب ثار من أجلي، وأحرق ليس ملف قضيتي فقط، بل بناية المحكمة بأسرها». اجتذبت القصتان اهتمام القراء والنقاد، وأصبح اسم بابل معروفًا إلى حد ما. وواصل الكاتب الشاب كتابة قصص جديدة، حيث كان يكتب قصة واحدة كل يوم ويعرضها على غوركي، الذي كان يقرأ القصة بتمعن، ثم يقول: إنها غير صالحة للنشر. وتكرر ذلك مرات عدة. وأخيرًا تعب كلاهما. وقال غوركي بصوته الجهوري الأجش: «إنك تتخيل أشياء كثيرة تقريبية؛ لأنك لا تعرف الحياة بعد. عليك التوجه إلى الناس، ومعرفة الواقع، واكتساب تجربة ذاتية تساعدك في فهم الحياة، قبل أن تكون قادرًا على كتابة قصة جيدة».





