
الكاتبة السعودية ملحة عبدالله: لا أكتب من أجل جائزة أو أن يصفق لي الجمهور إنما كي أسجل اسمي في تاريخ الفن
حين تقرر عمل لقاء مع من يطلق عليها سيدة المسرح السعودي الكاتبة والناقدة الدكتورة ملحة عبدالله، التي كرمها مهرجان المسرح التجريبي الدولي بالقاهرة في دورته الأخيرة، فلا بد أنك ستفكر في العودة إلى أعمالها كي تعد أسئلة تليق بهذا المشروع الكبير الممتد لأكثر من ثلاثين عامًا. لكن من أين تبدأ، هل من نصوصها المسرحية التي تزيد على ستين نصًّا مسرحيًّا، أم من كتبها النقدية التي تزيد على خمسة وثلاثين كتابًا؟ هل تحدثها عن أثر البداوة على المسرح السعودي، أم عن أثر الهوية الإسلامية فيه؟ عشرات الأسئلة التي ستدور في خلدك وأنت متجه إلى بيتها في حي الدقي بمدينة القاهرة، وما إن تصل إلى مكتبها حتى تباغتك مكتبتها العظيمة التي تحتوي على مئات الكتب والمؤلفات، وبينها صف خاص بمؤلفاتها.
ستباغتك أيضًا ترسانة الدروع والتكريمات التي حصلت عليها طيلة سنوات عملها بالمسرح، فتقف حائرًا إن كنت ستهنئها على تكريمها مؤخرًا من قبل مهرجان المسرح التجريبي الدولي بالقاهرة، أم ستعتبره واحدًا من ضمن عشرات التكريمات التي حصلت عليها.. لكنها حين ترى الدهشة في عينيك ستباغتك هي قائلة: «أنا لا أكتب المسرح كي أحصل على جائزة أو أن يصفق لي الجمهور، فهناك ما يسمى بتاريخ الفن، وهو مادة أساسية كنا ندرسها من العام الأول في أكاديمية الفنون، وهو تاريخ لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا يرصدها ويتحدث عنها، يتحدث عن الناس والرواد والتاريخ والتأثير والتأثر، ويحلل الواقع الثقافي والسياسي والاجتماعي والأيديولوجي من خلال النصوص، فنعرف كيف كان الناس يعيشون في هذا الوقت، ماذا كانوا يرتدون ويأكلون ويشربون، ومن ثم فأنا أعرف جيدًا أهمية تاريخ الفن، وأعمل من أجله، وليس من أجل الجوائز، وحديثي هذا لا يقلل من أهميتها».
صعاليك المسرح
● وهنا أسألها، متى بدأتِ كتابة المسرح وإنتاجه؟
■ أنا لم أكتب نصًّا مسرحيًّا إلا بعد التخرج من أكاديمية الفنون، حينها شعرت أنني صرت مؤهله لأن أكتب نصًّا يحتوي على الدعامات والأعمدة الأساسية في الكتابة المسرحية، فكتبت مسرحية «أم الفأس» و«المسخ». وقد نالت «أم الفأس» جائزة «أبها» الثقافية، وفي الوقت نفسه كانت «المسخ» تعرض على مسرح الشباب. وقد شاركت المسرحية في مهرجان المسرح التجريبي، وفي المهرجان العربي للمسرح. وكانت من إخراج أشرف عزب.
بعدها كونا فرقة «صعاليك المسرح»، وكونا شركة إنتاج قدمنا من خلالها العديد من العروض المسرحية، ومن بينها مسرحية «الليبرو»، بطولة سعيد صالح وحسن الأسمر وشمس ومحمد محمود وغيرهم من الفنانين الكبار. كان هذا العرض العملاق يعرض على «مسرح كوتا»، الذي طلب منا سعيد صالح أن نعرض عليه؛ لأنه عرض عليه مسرحية «مدرسة المشاغبين»، ويريد أن يختتم حياته على المسرح نفسه. استأجرناه لمدة خمس سنوات من المحافظة، وجددناه وعرضنا عليه «الليبرو»، ثم أنتجنا أعمالًا أخرى وعرضناها على مسارح أخرى مثل: «روابط»، و«الطليعة».
● كيف يمكن تحقيق النجاح في هذا المجال الصعب؟
 ■ لا بد أن تقوم الأمور على تأسيس جيد، لا بد أن تعرف أين تضع قدمك، وكيف تكتب وكيف تخرج؛ لأن المسرح من أصعب الفنون، وبخاصة في الكتابة، لأنك تستحضر العالم كله على المسرح، ولا بد أن تحصل على تصديق الجمهور، أي أن تجعل العالم الوهمي أو الخيالي أمامهم حقيقة لا خيال، وإذا حدثت هنة وانتبه الجمهور أن هذا العالم غير حقيقي فإنه يفقد الثقة بك، ومن ثم ينصرف عن المتابعة، مما يفسد العرض ككل. ومن ثم فالمسرح يتمتع بخاصية هنا والآن، أي أن كل ما يجري عليه يحدث هنا والآن، حتى لو كانت الأحداث في العصور الوسطى، وهذا صعب في الكتابة والإخراج. والحمد لله، فقد أوليت الكتابة المسرحية، والدراسة المسرحية، بكل أبعادها، اهتمامًا كبيرًا. اهتممت بدراسة التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها من العلوم، فإذا لم يكن الكاتب على معرفة بالتاريخ والجغرافيا ولديه معرفة موسوعية بكل ما يدور حوله فلن يتمكن من كتابة المسرح، أي أنه لا بد أن يكون مفكرًا جيدًا كي يكون كاتبًا جيدًا. لكن متى يمكن أن نقول عن كاتب المسرح: إنه مفكر؟ يحدث ذلك بالتراكم، وهذا لا يحدث من أول نص ولا اثنين ولا حتى ثلاثة، ولكن حين نجد مشروعًا أو اتجاهًا خاصًّا.
■ لا بد أن تقوم الأمور على تأسيس جيد، لا بد أن تعرف أين تضع قدمك، وكيف تكتب وكيف تخرج؛ لأن المسرح من أصعب الفنون، وبخاصة في الكتابة، لأنك تستحضر العالم كله على المسرح، ولا بد أن تحصل على تصديق الجمهور، أي أن تجعل العالم الوهمي أو الخيالي أمامهم حقيقة لا خيال، وإذا حدثت هنة وانتبه الجمهور أن هذا العالم غير حقيقي فإنه يفقد الثقة بك، ومن ثم ينصرف عن المتابعة، مما يفسد العرض ككل. ومن ثم فالمسرح يتمتع بخاصية هنا والآن، أي أن كل ما يجري عليه يحدث هنا والآن، حتى لو كانت الأحداث في العصور الوسطى، وهذا صعب في الكتابة والإخراج. والحمد لله، فقد أوليت الكتابة المسرحية، والدراسة المسرحية، بكل أبعادها، اهتمامًا كبيرًا. اهتممت بدراسة التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها من العلوم، فإذا لم يكن الكاتب على معرفة بالتاريخ والجغرافيا ولديه معرفة موسوعية بكل ما يدور حوله فلن يتمكن من كتابة المسرح، أي أنه لا بد أن يكون مفكرًا جيدًا كي يكون كاتبًا جيدًا. لكن متى يمكن أن نقول عن كاتب المسرح: إنه مفكر؟ يحدث ذلك بالتراكم، وهذا لا يحدث من أول نص ولا اثنين ولا حتى ثلاثة، ولكن حين نجد مشروعًا أو اتجاهًا خاصًّا.
● ماذا عن جيل الأساتذة؟
■ تتلمذنا على أيدي عباقرة الثقافة والفكر والمسرح في أكاديمية الفنون. لا أنسى ذات مرة في أثناء عرضي لمشروع تخرجي، مسرحية «الدنجوان» لموليير، وكانت بتكليف من الدكتور فوزي فهمي. كان الدكتور فوزي أسفل في «البنش»، وأنا أمام «السبورة» أشرح رؤيتي الإخراجية كما طرحتها في البحث، وكانت أيامها حرب الخليج، وكنت أرى أنها غزوة دنجوانية سينهزم فيها جورج بوش «الأب». أخذت أتحدث عن التوترات التي تحدث في العالم، ونقاط الصراع على الخريطة الأرضية، فإذا بالدكتور فوزي يستوقفني قائلًا لي: اتركي كل هذا وارسمي لي خريطة العالم. فتركت الشرح وقمت برسم الخريطة.
المقصود أنه لا بد أن تكون خريطة العالم في ذهن ووعي الكاتب بأحداثها وشخوصها واقتصادها وسياساتها، حتى لو كان النص عن بقعة صغيرة منها، فلا بد أن يعرف ما الذي يكتبه، فكل بلد له فنونه وكتاباته وتاريخه وثقافته.
غول المغول
● ما الجديد لديك؟
■ أكتب نصًّا اسمه «موكب الجوع» عن «قطر الندى» ابنة خمارويه. وأنا مهتمة بأن أجمع كل شيء عن هذا العصر، فإذا لم أعرف ما الذي أكتب عنه بدءًا من اللغة والملابس والألقاب وكل شيء، فلن أتمكن من كتابة نص جيد. وبالمناسبة، لي نص مسرحي تاريخي آخر بعنوان: «غول المغول»، عن سقوط الخلافة الإسلامية في العراق، ودخول هولاكو مدينة بغداد، كنت قد أسقطت أحداثه على الواقع المعاصر، فالكاتب حين يكتب لا يحلق في السماء فقط، ولا بد أن تلامس أقدامه الأرض، حيث الواقع وقضاياه، ومن ثم فحين كتبت «غول المغول» رأيت بغداد وصدام حسين والعرب جميعًا في مجريات الوضع القديم نفسها، فأخذت من خلالها في معالجة هذا الحدث التاريخي الكبير.
● ماذا تقولين في واقع المسرح الآن؟
■ أقول: إن لدينا كُتابًا مسرحيين كبارًا في العالم العربي، لكن عددهم قليل، فضلًا عن أن الإنتاج المسرحي مكلف جدًّا، وكان لدينا عمالقة كبار في المسرح، قدموا أعمالًا عظيمة. لكنْ لدينا الآن أناس يستسهلون الأمور، حيث نجد فرق هواة همها الأول هو الإضحاك، وهذه مشكلة أساسية، فلا بد من البحث عن كتاب حقيقيين، وعن مكان حقيقي وجاد لتقديم العروض، وذلك من أجل إنقاذ الوعي العام. ولا بد من إثارة القضايا، ومعرفة العلاقة بين الوعي العام، والوعي المحتمل، والوعي الممكن، والوعي المتاح. فكل نوع منها يحتاج إلى مجلد كامل للكتابة عنه.

● ما هدفك أو اهتمامك الأساس في المسرح؟
■ أنا مهمتي الشارع، أنا أكتب من أجل أن أصنع وعي الناس في الشارع، وليس من أجل أن يصفق لي الجمهور، أو أن يعرض لي عملًا على مسرح لمدة أسبوعين أو ثلاثة. أكتب من أجل الشارع، حتى لو اعتمد فقط على قراءة النص أو الحوار، فلا بد للكاتب أن يكون صانعًا للوعي. وهذا النوع من الكتاب قليل، وبخاصة في ظل الهجوم المتزايد على الوعي العربي من لجان التضليل واللعب بالبيضة والحجر على محو الهوية العربية، وجعل الانتماء خارج الإنسان، وليس محليًّا. هذه اللجان وما شابهها تسعى إلى تقزيم الشخصيات الكاريزمية، وهذا جزء من بنود العولمة، وهي بنود موجودة في دساتير مكتوبة بالفعل، وهي تنص على محو الكاريزما، وأن يكون الانتماء للإنسان في العموم، وليس الوطن أو القومية أو الهوية. وقد كتبت عن هذه البنود في موسوعتي «نقد النقد»، وخصصت لها فصلًا خاصًّا تحت عنوان: «نقد العولمة». هذه البنود تخاطب نصوصًا وكتابًا بعينهم، وتسعى إلى تشكيل واقع سياسي جديد في الشرق الأوسط.
● من أين أتيت بالوقت لتقديم كل هذا الإنجاز من المؤلفات والعروض والدراسات؟
■ حين دخلت عليّ وجدتني وحدي في غابة من الكتب وثلاثة أجهزة كمبيوتر، وهؤلاء هم أهم أصدقائي وأحبائي، فأنا بعيدة من غريزة القطيع التي تحب التجمعات. ويمكنني القول: إن سطرًا واحدًا في كتاب أو جريدة يمكنه أن يجعلني أكتب نصًّا مسرحيًّا أو مقالًا طويلًا؛ لأنك حين يكون لديك مخزون ثقافي واسع، فإن ذهنك يظل متقدًا بشكل دائم، وأنا لو جلست أسبوعًا من دون عمل فمن الممكن أن أمرض، ومن ثم فأنا أعمل طيلة ثلاثين عامًا ما بين الكتابة المسرحية والنقدية والصحفية وتحكيم الجوائز والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات.
● أنجزت كتابًا عن «أثر البداوة في المسرح السعودي»، فما علامات هذا الأثر؟ وهل تنتج البداوة مسرحًا؟
 ■ كان مشروعي للتخرج هو «أثر الهوية الإسلامية على المسرح السعودي»، وكنت أبحث في الهوية الإسلامية على أساس أنها التي أثرت في المسرح وكبلته، أي أنها كانت الفرضية الخاصة بالبحث. عملت بشكل أكاديمي تمامًا، أي بعيدًا من أي تأثير أو عاطفة، وحللت نحو عشرين نصًّا من المسرح السعودي، ورأيت العديد من العروض، وكانت النتيجة التي توصلت إليها أن البداوة هي التي أثرت في المسرح السعودي وكبلته، وليست الهوية الإسلامية. فقد يعتقد بعضٌ أن وجود الإسلاميين هو السبب، لكن الحقيقة أن العادات والتقاليد وأعراف القبيلة هي التي كبلت المسرح في السعودية والخليج. كان مفهوم المسرح في السعودية مثل مفهومه في بدايات المسرح في كل مكان، سواء في مصر أو سوريا أو حتى في أوربا القرون الوسطى أو اليونان في العصور القديمة. كان الرجال هم الذين يقدمون شخصيات المرأة، ومن ثم فهذه طبيعة خاصة بالمسرح وليس عيبًا خاصًّا بمكان معين، وكانت هناك ضراوة من العادات والتقاليد تجاه المسرح، وحين قررت نشر الكتاب وجدت أنه أصبح بحثًا أكاديميًّا ثقيلًا على القارئ العام، ومن ثم اختصرته بشكل يمكن للقارئ أن يتعامل معه، ووضعت له عنوانًا: «أثر البداوة على المسرح السعودي».
■ كان مشروعي للتخرج هو «أثر الهوية الإسلامية على المسرح السعودي»، وكنت أبحث في الهوية الإسلامية على أساس أنها التي أثرت في المسرح وكبلته، أي أنها كانت الفرضية الخاصة بالبحث. عملت بشكل أكاديمي تمامًا، أي بعيدًا من أي تأثير أو عاطفة، وحللت نحو عشرين نصًّا من المسرح السعودي، ورأيت العديد من العروض، وكانت النتيجة التي توصلت إليها أن البداوة هي التي أثرت في المسرح السعودي وكبلته، وليست الهوية الإسلامية. فقد يعتقد بعضٌ أن وجود الإسلاميين هو السبب، لكن الحقيقة أن العادات والتقاليد وأعراف القبيلة هي التي كبلت المسرح في السعودية والخليج. كان مفهوم المسرح في السعودية مثل مفهومه في بدايات المسرح في كل مكان، سواء في مصر أو سوريا أو حتى في أوربا القرون الوسطى أو اليونان في العصور القديمة. كان الرجال هم الذين يقدمون شخصيات المرأة، ومن ثم فهذه طبيعة خاصة بالمسرح وليس عيبًا خاصًّا بمكان معين، وكانت هناك ضراوة من العادات والتقاليد تجاه المسرح، وحين قررت نشر الكتاب وجدت أنه أصبح بحثًا أكاديميًّا ثقيلًا على القارئ العام، ومن ثم اختصرته بشكل يمكن للقارئ أن يتعامل معه، ووضعت له عنوانًا: «أثر البداوة على المسرح السعودي».
● هل المناخ مهيأ الآن لنهضة حقيقية في المسرح السعودي؟
■ قدم الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030، وهي شاملة وعالمية تهتم بكل عنصر من عناصر التقدم الحضاري والبيئي والاقتصادي والثقافي، وتأخذ بكل المحاور التي تشكل شخصية الإنسان في هذا البلد، ومن ثم فهو صانع هذه النهضة الحديثة، وبخاصة في المسرح، وأنا الآن عضو في مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية، ومن ثم فأنا أول امرأة في مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية.
جزر منعزلة
● من خلال دراستك عن المرأة والمسرح في شبه الجزيرة العربية، كيف تمكنت المرأة من المشاركة في فن جماعي مثل المسرح؟
■ تناولت هذا الموضوع في كتاب «إبداع الجزر المنعزلة»، كنت أرى أن للكاتبات شأنًا مهمًّا، لكن غياب التواصل بينهن يفقد هذا الشأن حضوره، فكان هذا الكتاب الذي صدر عن دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، وقد أطلقت عليه هذا الاسم؛ لأن كل امرأة كانت تعمل وحدها، ولا يوجد تماسّ بينهن. لكن الدراسة الثانية لي في هذا الشأن نشرتها في جامعة الملك عبدالعزيز، بعنوان: «المسرح والأثر القبلي للمرأة». من خلال دراسة النصوص وتحليلها وجدت أن المرأة لها حضور كبير في المسرح السعودي، وقد رصدت فيه تطور علاقة المسرح بالمرأة. في البدء كان حضورها عن طريق ضمير الغائب، لكنها كانت محركًا للحدث. ثم في مرحلة تالية صرنا نسمع صوتها ولكن من وراء ستار أو من خارج المسرح، وفي مرحلة تالية بدأت تشارك بالفعل، كأن تلقي بالعصا أو الشوكة أو غيرها، دون أن نراها. وكان أول ظهور لها على هيئة تمثال، ففي تلك السنين العجاف شارك المخرج راشد الشمري في المهرجان التجريبي للمسرح، فأشرك المرأة في عمله المسرحي، ولكن على هيئة صنم أو تمثال. لم يكن أمرًا لطيفًا، لكن الرجل حاول أن يجد حلًّا. ثم تطور الأمر فيما بعد بظهور المسرح النسائي، وكل من فيه من النساء، بدءًا من التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج والجمهور. وفي المقابل كان هناك مسرح للرجال، وكل من فيه من الرجال حتى الجمهور. وقد كتبت كتابًا لم ينشر بعد بعنوان: «مسرح الرجل ومسرح المرأة»، حللت فيه المعطى الثقافي في كلا المسرحين. وقد ظهرت فيما بعد العديد من العروض النسائية التي أدى الزحام فيها إلى حالات اختناق وحضور الإسعاف. وهذا جزء من تاريخ المسرح السعودي. بعدها أتت وزارة الثقافة، وكانت فيما قبل إدارة تابعة لوزارة الإعلام، وتكونت من إحدى عشرة هيئة، من بينها هيئة المسرح والفنون الأدائية التي أشرف بعضويتي في مجلس إدارتها الآن.
● ما علاقة المسرح السعودي بالتراث الشعبي؟
■ المسرح السعودي قائم على التراث الشعبي، حتى العروض التجريبية منه تستلهم هذا التراث، سواء الأمثال أو القصص أو الشخصيات، مثل طرفة بن العبد الذي كتب عنه عبدالعزيز السماعيل، وأنا كتبت «أم الفأس» وهي حكاية شعبية، لكن بها فلسفة، وفيها استلهام للسامري والدبكة وغيرهما من الطقوس. وفي مهرجان الرياض للمسرح 2024م رأيت عملًا مسرحيًّا بعنوان: «بحر»، من إعداد وإخراج سلطان النوة. تدور أحداث المسرحية عن الصيادين في المنطقة الشرقية، وفيها كل طقوس الصيادين من خلال النوخذة. والفلسفة في هذا العمل أن النساء ينتظرن ستة أشهر رجالًا لا يعرفن إن كانوا سيعودون أحياءً أم موتى. ومن ثم فصراعهن ليس مع السلطة ولا النوخذة، ولكن مع البحر الذي يأخذ رجالهن، وقد فاز العمل بأربع جوائز منها جائزة الإخراج.

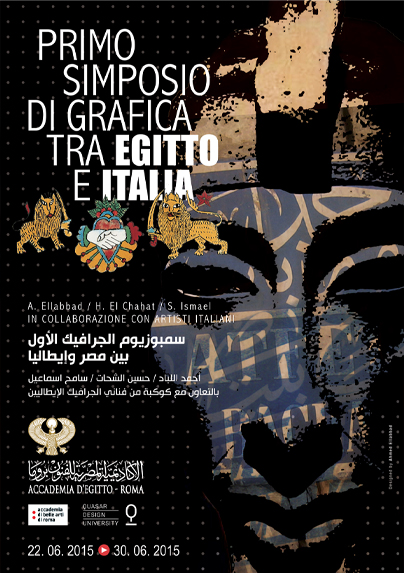 ● كيف كنت تنظر إلى فن تصميم الأغلفة قبل دخولك إليه؟
● كيف كنت تنظر إلى فن تصميم الأغلفة قبل دخولك إليه؟
