
إيمري كيرتيس: بدأتُ العيش حقًّا منذ اليوم الذي عرفتُ فيه ما الذي أريدُ كتابَته
إيمري كيرتيس هو أول كاتب مجري يفوز بجائزة نوبل في الأدب عام 2002م، «لكتاباته التي تمجد تجربة الفرد الهشة إزاء الحكم المطلق الوحشي» بحسب تنويه الأكاديمية. تتناول أعماله موضوعات الدكتاتورية والحرية الشخصية والهولوكوست؛ لكونه أحد الناجين من معسكرات الاعتقال الألمانية في أوشفيتز وبوتشِنفالد. بعد تحرير معسكره في عام 1945م، عاد كيرتيس إلى بودابست، وتخرج من المدرسة الثانوية ثم واصل البحث عن العمل صحفيًّا ومترجمًا، وعمل مدة قصيرة عاملا في مصنع، ثم في قسم الصحافة في وزارة الصناعات الثقيلة، ثم عمل صحفيًّا مستقلًّا، وترجم العديد من الأعمال إلى المجرية، بما في ذلك فريدريك نيتشه وسيغموند فرويد ولودفيغ فيتغنشتاين وإلياس كانيتي. وتوفي في 31 مارس 2016م، عن عمر يناهز 86 عامًا، في منزله في بودابست، بعد معاناته لسنوات من مرض باركنسون.
هنا حوار معه:
● نُفِيتَ في سن الرابعة عشرة. وأعلنتَ لاحقًا: «لقد تمكَّنتُ من النظر إلى أوشفيتز كَمكسَب». كيف يمكن أنْ يصبح هذا ممكنًا؟
■ من الواضح أن ترحيلي ثروة، فَبِفَضله أصبحتُ كاتبًا. لقد فتح عيني: ما عاينتُه حطَّم تصوُّري للحضارة الأوربية. في أوشفيتز وبوتشينفالد، رأيتُ ما يمكن للإنسان أن يراه: ما هي الحياة في تفاصيلها الأكثر تفاهة، وكيف يتعلَّم المرء تذوُّق أبسط شعاع من أشعة الشمس بين لحظات المعاناة. أولًا وقبل كل شيء، لم أكن أعرف ما كنتُ في الماضي. ثم بعد ذلك، ومن خلال معايشتي لتعاقب الأنظمة الدكتاتورية في بلدي هتلر وسيلاسي والصليب الآري، وراكوسي، وقادير (تعاقب الدكتاتوريات النازية والفاشية والستالينية) فهمتُ كيف تعمل الدكتاتورية، وما الذي يصبح عليه الإنسان في ظلِّ هذه الأنظمة: شخصٌ ثانوي.
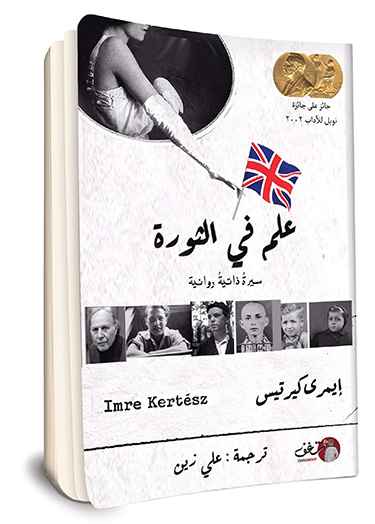 ● بين عامي 1945- 1948م عشتَ في هنغاريا مرحلة ديمقراطية قبل الدكتاتورية الشيوعية. ما الذكريات التي تحتفظ بها؟
● بين عامي 1945- 1948م عشتَ في هنغاريا مرحلة ديمقراطية قبل الدكتاتورية الشيوعية. ما الذكريات التي تحتفظ بها؟
■ في تلك السَّنوات الثلاث كنتُ فقيرًا. لم يكن لديَّ أي شيء. مات أبي، لم يعد من المعسكرات. كنتُ أعيش مع والدتي التي سرعان ما تزوَّجتْ مرَّة أخرى. عشتُ معها لمدَّة سنتين أو ثلاث، ثم جاء دوري للزَّواج والمغادرة. كانت لديَّ أنا وأمي حياة مختلفة جدًّا: بين سنتي 1956- 1962م، في ظل الدكتاتورية، كانتْ دبلوماسية في يوغوسلافيا. لقد كرهتُ ما تُـمثِّله. لكن في السنوات الثلاث التي سبقتْ تأسيس الدكتاتورية، كانت لديَّ حياة فكرية غنيَّة جدًّا. وكنتُ أُومِنُ بفكرة الاشتراكية. لقد قرأتُ، وتحدَّثتُ إلى مؤلفين وفنانين.
● هل اكتشفت فرويد والتحليل النفسي في هذا الوقت؟
■ لا. حدث ذلك في وقت لاحق؛ في ظل الدكتاتورية، في وقت كان فيه هذا النوع من القراءة ممنوعًا. كنتُ في الخامسة والعشرين من عمري عندما قرأتُ في الخفاء «علم النَّفس المرضي في الحياة اليومية» [بايوت]. بعد سنوات، ترجمتُ من الألمانية إلى الهنغارية «Le Moise de Michel-Ange) Points)»، «موسى مايكل أنجلو»، النص الذي يهتم فيه فرويد بهذا التمثال الذي أذهله. ومع ذلك، لم تُبهرني استنتاجاته وتفسيراته لعمل النحات.
● هل قادتْكَ هذه القراءات، وترجماتُك وتاريخك إلى التحليل؟
■ لا. لكنني تعلَّمت كثيرًا عن الآثار النفسية لما يحدث لي في المدة من 1985-1986م، بالتواصل مع طبيبة نفسية للأطفال تريز فيراج. لقد اكتشفَتْ أنَّ العنف النفسي الذي يعانيه الناجون من الـهولوكست كان نقطة البداية لمشكلات الهويَّة لأحفادهم. كانتْ أول من تعرَّف إلى «متلازمة الهولوكوست» عند أحفاد العائدين من المعسكرات. كانت عندهم أعراض مشتركة: اضطرابات في العلاقة مع الآخرين، واضطرابات في تصوّر الجسد الذي أساء إليه كثيرون، أو الذي استُكشِفَتْ حدوده إلى درجة الإرهاق. والنتيجة هي اضطرابات خطيرة في «الذات» [صورة الذات]: المجروحة والـمُتضرِّرة والـمُفجَّرة والعائمة، والمحرومة من الأساسيات. الـمُحمَّلة بالقلق أو الخوف أو الشعور بالذنب أو العدوانية.
● في «قادش من أجل الطفل الذي لم يُولد بعد»، يرفض البطلُ «بي»، الناجي من المعسكرات إنجاب أطفال. أنتَ لم يكن لديك أطفال. هل هذا بسبب أوشفيتز؟
■ إنَّه نصٌّ تعمل فيه القوى الهدّامة بشكل كبير. يرفض «بي»، الذي دمّرَته تجربة معسكرات الاعتقال، الإنجاب من جوديث، المرأة التي يحبها، ثم يُكفِّر عن ذلك بإعفائها خاصة من مسؤولية انفصالهما؛ سيموت حتى تتمكَّن من العيش. لكنها رواية! وبطبيعة الحال، ستستمر البشرية. صحيح، لم يكن لديَّ أطفال، لكن زوجتي لديها أربعة، وأنا كتبتُ كتبي. هكذا أحاول المشاركة في المستقبل!
العيش في الكتابة/ أن تعيش لتكتب
● هل بَنيْتَ نفسك من خلال الكتابة، وقاومتَ بها عوالم الاعتقال والدكتاتورية؟
■ نعم، بالتأكيد. انتقلتُ من رعب إلى آخر، من النازية إلى الشيوعية. قرَّرتُ أنْ أصبح كاتبًا في سنِّ الخامسة والعشرين، عام 1954م، في ظلّ نظام راكوسي الشيوعي. تعمل المعسكرات والدكتاتورية ضد البناء الشخصي للفرد. إنها تحاول معارضتَه وتخريبه. لقد جاهدتُ محاولًا عدم الاندماج في المجتمع الذي كنت محسوبًا فيه؛ خلال النهار، كنتُ أتنكَّر في صوت كاتِب مشهورٍ ومُسلٍّ، أكتب الأوبِيرِيتات. هذا ما جعلني أعيش ماديًّا. ثم في الليل، في المنزل، كنتُ أختبئ وأكتبُ «لا مصير». بدأتُ العيش حقًّا منذ اليوم الذي عرفتُ فيه ما الذي أريدُ كتابَته.
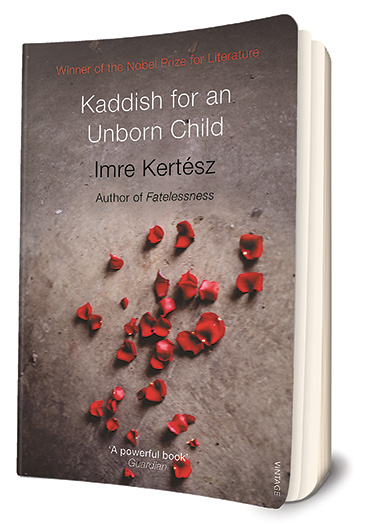 ● هل تتذكَّر اللحظة التي قرَّرت فيها تأليف رواية؟
● هل تتذكَّر اللحظة التي قرَّرت فيها تأليف رواية؟
■ أعتقد أنني ولدتُ كاتِبًا. لكنني أتذكر اللحظة التي جاءني فيها الإلهام، ذلك الصباح من سنة 1954م. كنتُ أنتظر في ممرٍّ طويل وضيِّق. سمعتُ وَقْع خطوات قوية جدًّا. في تلك اللحظة، أدركتُ جاذبية الخطوات على الحَشْد. جاذبية تدفع الإنسان إلى التخلي عن فَرْدانيتِه. أردتُ مقاومة ذلك وقلتُ في نفسي: «أريد أنْ أبقى في هذا الـمَمرّ، لكنني أريد أن أعيش حياتي الخاصة». وجودي كله هو نتيجة هذه اللحظة. ثم سمحتْ لي الكتابة أنْ أبقى على قيد الحياة. استغرق الأمر مني ثلاثة عشر عامًا، من 1954 إلى 1967م، لأكتب هذه الرواية الأولى. عندما قرَّرت في سنة 1960م أنْ أركّز على قصَّتي الخاصة، لم أرغب في كتابة سيرة ذاتية، فأنا لا أصدِّق ذلك: فمنذ اللحظة التي تُقرّر فيها الكتابة، فأنتَ تدخل في الخيال. في هذه السنوات الثلاث عشرة من النضج، صنعتُ فلسفتي الخاصة. كان عليَّ أنْ أرى بوضوح ما أريده، وأنْ أتعرَّف إلى حالة الفن وإلى طبيعته وإلى طبيعة الدكتاتوريات، وإلى طبيعتي الخاصة… هذا الأمر الذي لم ينجح قط! [يضحكُ].
● تنتهي قصص الحب في نصوصك بشكل سيّئ. لكن، هل سمح لك الشعور بالحب -أنْ تُحب وأن تكون محبوبًا- بأنْ تعيش وتبدع وتشعر بالوجود؟
■ ربّما، نعم… وأما الحب في رواياتي، فالوَضْعُ ليس ميؤوسًا منه إلى هذا الحد. خُذْ حالة جوديث، بطلة «التصفية». إنَّها تُحب زوجها الثاني ويحبُّها. ولقد انهار كل شيء لأنه يطرح كثيرًا من الأسئلة الحميمة. بالمناسبة، كل شخص لديه حياة سرّيّة، التي تكون أحيانًا الحياة الحقيقية. ومن لا يحترم هذه السرية يدخل بالضرورة في صراع مع الآخر. ومع ذلك، أرفضُ تقديم قواعد عامة.
● ماذا يعني لك أن تكون يهوديًّا؟ عندما نقرأ مؤلَّفاتِك، فهذا أمرٌ غير واضح حقًّا…
■ اليهودية صعبة. وقد تغيَّر كل شيء منذ الهولوكوست ووجود إسرائيل. ليست لديَّ ثقافة يهوديَّة، ولستُ مرتبطًا بشكل خاص بالدِّين أو الدولة. في الواقع، عندما ذهبتُ إلى هناك، أدركتُ أنَّني لستُ جزءًا من هذا المجتمع. لكن هذه اليهودية موجودة، حتى لو كنا لا نعرف ما إذا كان يجب أنْ نفتخر بها أو نخجل منها. على أي حال، لا يمكنني تحرير نفسي منها. يجب تحمّل المسؤولية من دون الاختباء ومن دون إنكار الذات. لم أكُنْ على علم بكوني يهوديًّا قبل نَفْيِي، لكن كان عليَّ أنْ أفهم أنني أتيتُ من اليهودية. وبِوصْفي كاتِبًا، فأنا أتعامل معها كموضوع. قصَّتي هي قصة النزول إلى الذات، نحو الحقيقة، في عالَم حيث كل شيء مجرَّد مظاهر.
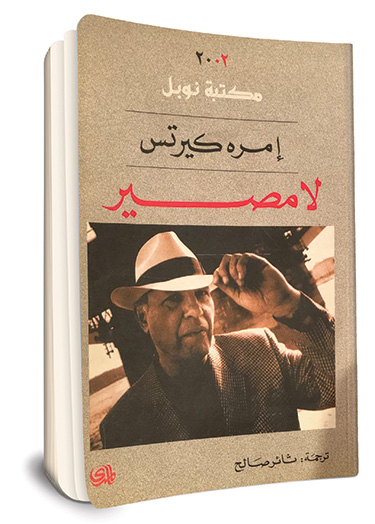 وصية أخيرة
وصية أخيرة
● ما الذي توَدُّ نقله؟
■ آمُل أن يصبح الإنسان على طبيعته تجاه كل شيء، وضد كل شيء. نحن محاطون اليوم بأفراد «وَظيفيِّين» لا يعيشون حياتهم. إنهم يعيشون «وظيفتهم». وعندما تتغيَّر هذه الأخيرة فإنهم يتغيَّرون. هذا كل شيء، ما من أناس مأسويين، أو أن هناك القليل منهم؛ أي كائنات لها مصيرها الخاص، وتقوم بتأسيسه لنفسها. أتمنى أن يرفض الإنسان أن يصبح قطعة من آلة عظيمة من دون روح. وأعتقد أن علينا أن نحاول بناء أنفسنا، بغض النظر عن النظام من حولنا، من خلال النظر إلى ذواتنا، بأكبر قدر مُمكن من الوضوح.
أدركتُ نفسي في عالَم زائف أحاول أنْ أكون مُسْتَبصرًا عن نفسي. أشعر أنني نجحتُ في ذلك، على الرغم من أنني لستُ متأكدًا من أن هذا هو الحال، ومن أن كل شيء قد تَم حتى لا أستطيع فعل ذلك. في الأساس، المهمة هي نفسها لكل واحد منا. من الواجب أن نكون مُنْصِفين وصادقين مع الذات في مواجهة النفاق الجماعي. إنه أمرٌ صعبٌ، إن لم يكن مستحيلًا، لكن هذا ما يهدف إليه عملي. علاوة على ذلك، إذا رفضتُ استخدام مصطلح السيرة الذاتية، وأَكَّدتُ الكتابة باعتماد الخيال، فذلك أيضًا لأنني أعرف أنه من الصعب أن يرى المرء نفسه كما هو. الاهتمام بالحقيقة هو مفتاحي.
المصدر: مجلة Psychologies الفرنسية، عدد خاص (Hors-Série) 59، نوفمبر-ديسمبر 2020، ص:84-85-86-87
