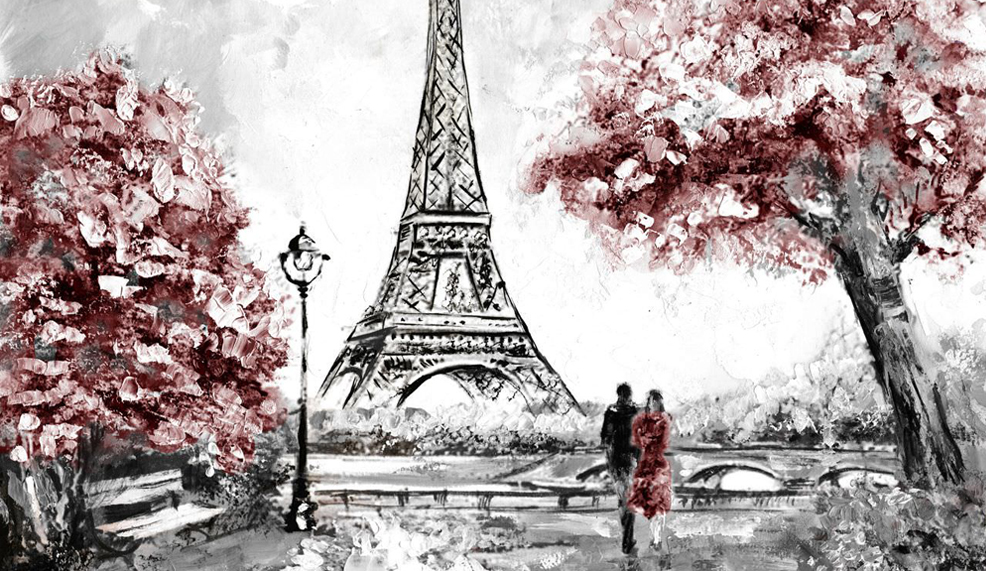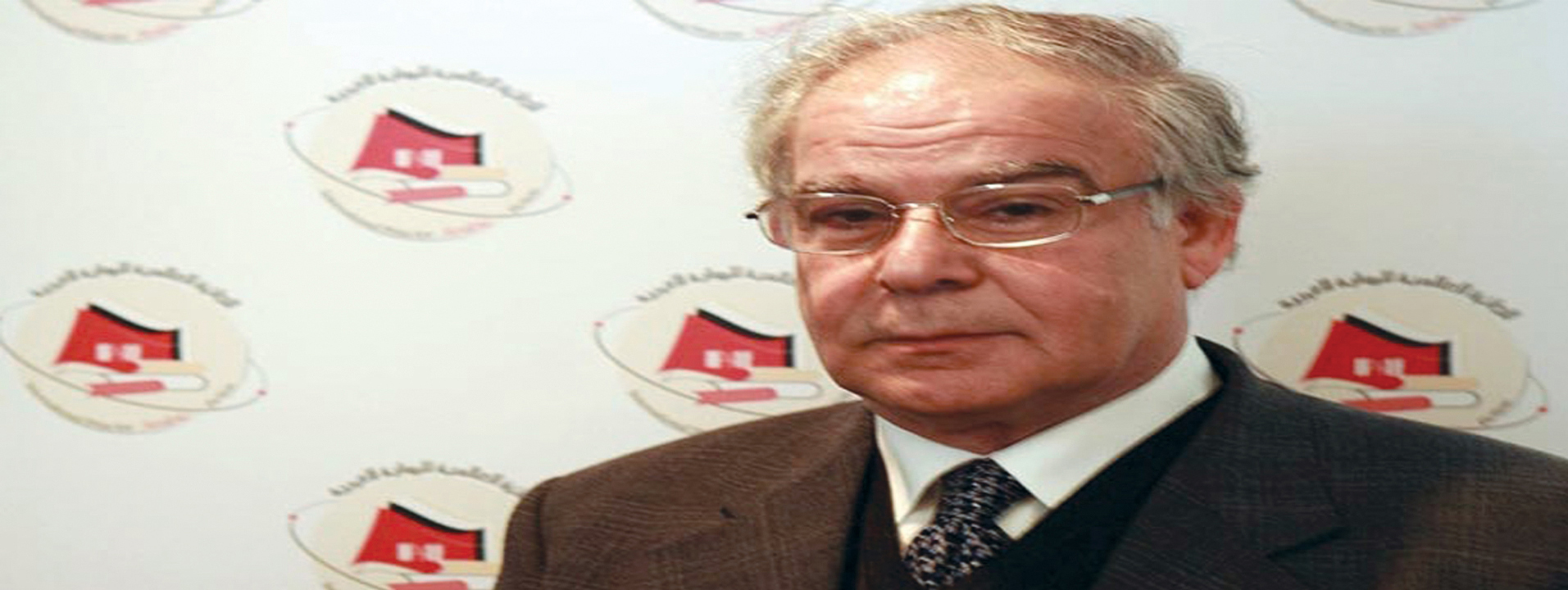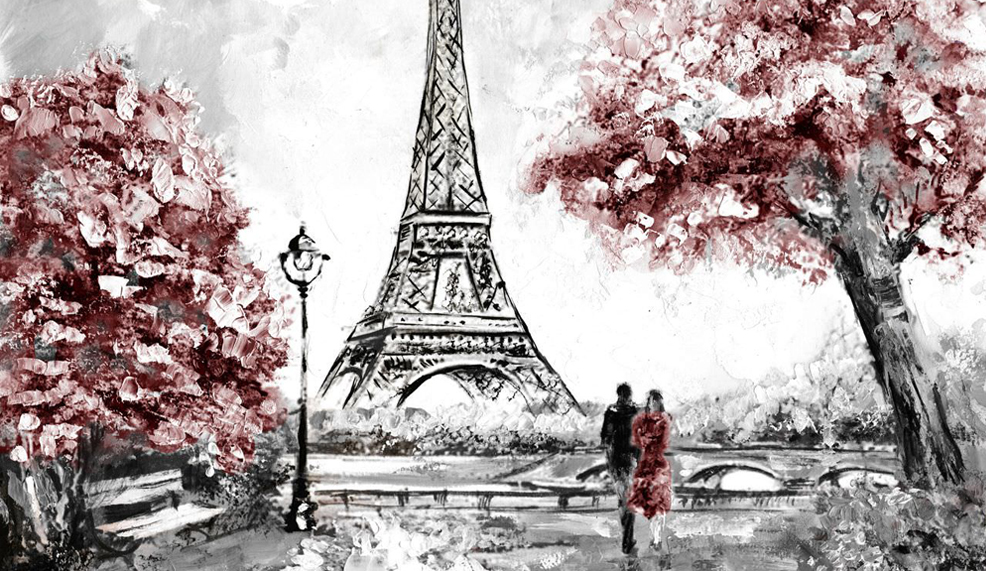
فيصل دراج - ناقد فلسطيني | يناير 1, 2020 | سيرة ذاتية
كيف نمت فينا أسطورة مدينة درس فيها أساتذتنا الجامعيون، وعاش في إحدى كنائسها إنسان شائه الخلق وصفه فيكتور هوغو في روايته «أحدب نوتردام»؟ كيف تجوّلنا في شوارعها قبل أن نزورها، وأنصتنا إلى محاضرات جامعتها الشهيرة ونحن طلاب في جامعة صغيرة بعيدة؟ أجاءت أخيلتنا من شهرة مدينة عاشت أكثر من ثورة، أم من شباب حالم ألغى المسافة بين الحاضر والمستقبل؟
كانت باريس، في ذاك الزمان، أسطورة متعددة الوجوه، ترسلنا إليها أسماء رفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني وبلزاك، وصفة «مدينة النور» التي استقرت في أكثر من كتاب. وكنا، في ذاك الزمان، طلابًا جامعيين نعشق الروايات ويؤنسنا فضاؤها الرحيب، ونرى أنفسنا أبطالًا روائيين، نلوذ بكتب فلسفية صعبة الأسلوب، ونعتقد أن القراءات الصعبة من علائم الحكمة، ومدخل إلى روايات جميلة الأسلوب سنكتبها ذات يوم.
قرأت في سَنَتِي الأخيرة بقسم الفلسفة، في جامعة دمشق، رواية «أديب» لطه حسين، تخيّلته طالبًا يتعكز عماء مبصرًا، يقوده من محاضرة إلى أخرى، يتعلّم الفرنسية واللاتينية، ويعوّض قصور العينين بجمالية التعلّم وتعاليم الإرادة. نظر أستاذي الدكتور عبدالكريم اليافي إلى عنوان الرواية وقال: «جميل أن تتعلّم من أعمى علّم غيره وغدا عَلَمًا، وجميل أكثر أن تتعلّم الصبر ومبادئ الأمل». كنت شابًّا قليل الصبر، يأمل الدراسة في جامعة فرنسية.
اخترت رواية طه حسين، وانكبّ طالب آخر قومي الهوى على قراءة رواية سهيل إدريس «الحي اللاتيني»، التي سجّل فيها ما عاشه في العاصمة الفرنسية. كان الطالب شغوفًا بأناقة مضطربة الألوان، عريض الشاربين قروي الأصول يتمسّك برباط العنق، كما لو كان الرباط امتدادًا لأنفه وشاربيه العريضين، ويحسد السارد على صدفه السعيدة المتوجة بالجميلات.. وكان كسارده الأثير يؤمن بانبعاث عروبي قريب، سيجبر الطلبة الفرنسيين على التعلّم في جامعات عربية. وعلى خلافه كان ثالث يساري الميول، يمسك بقلم رصاص ويقرأ رواية السوفييتي إيليا إهزنبورغ «سقوط باريس»، ويناجي نفسه أن أكثر من مدينة عربية سقطت، تنتظر روائيين يكتبون عنها، وأننا كعرب نعدُّ السقوط مقدمة للانتصار، واشتداد الأزمة شرط انفراجها الوشيك. وهو الوحيد بيننا الذي كان طالبًا احترافيًّا، تابع درسه بهدوء ودرس علم الاجتماع، أزاح الأحلام وارتضى بمهنة ثابتة… وكم كنا نفرح، نحن الثلاثة، بالصفحات الأولى من رواية إرنست هيمنغواي «الشمس تشرق ثانية» 1926م، التي تصف «بارات» باريس الليلية المتجاورة، وليلًا كأنه نهار، وبائعة هوى ترنو إلى عشاء مع جاك بيرنز، بطل الرواية الذي أعطبته الحرب. وحين تحوّلت الرواية إلى فِلْم هوليودي رأيناه أكثر من مرة، لا انجذابًا إلى بطلته «آفا غاردنر»، «أجمل حيوان على وجه البسيطة»، كما كان يقال، بل إلى شوارع «مونمارتر» المكسوّة بظلام شفيف.
رابعنا، وهو الأكثر تفوقًا، كان زاهدًا في الروايات، مستهزئًا بها، يرى المتخيل الفلسفي أرقى من المتخيل الروائي، مستشهدًا «بأنا ديكارت العاقلة»، وبالفكرة المطلقة عند هيغل، وبالوازع الأخلاقي عند كانت، ويختصر الخطاب الروائي إلى فُلكلور فلسفي فقير. يرى الفلسفة مهد الحكمة وعلمًا للعلوم والباعث الفكري على الثورة، بينما الرواية شخصيات وحكايات، تقنع بها العقول الكسولة،… وأن علينا «كفلاسفة شباب» أن ندفن الماضي، وأن نستقدم المستقبل من موروث فلسفي كوني، وأن نتمسك بصبر الأنبياء.
الناظر إلى ركن هامشي في مقهى جامعة دمشق، صيف 1969م، كان يرى طلابًا أربعة تحلّقوا حول طاولة، يحرّكون أيديهم ويرفعون أعناقهم كأنهم يتصايحون، يقلّبون صفحات كتب ويطلقون قهقهات راضية. لو مرّت عين الناظر على عناوين الكتب لقرأ: «تأملات ديكارتية» لهوسرل، الزمان الوجودي لعبدالرحمن بدوي، ماركسية القرن العشرين لروجيه غارودي، وفصوص الحكم لابن عربي تحقيق المصري أبي العلاء عفيفي. كانت الكتب، في شبابنا، كيانًا هائل القامة، أثيريّ القوام، مضيئًا، أليف الصوت، نسأله أن ينعم علينا بسره المتعالي الذي توسلناه طويلًا، وبقي سرًّا.
سيقول ثمانينيٌّ، لا يُقنع أحدًا، عرفتُه مصادفة في طور الشيخوخة: «الحمد لله الذي وقاني فتنة الكتب» ضحك وقال: قرأت هذا في كتاب. لم أكن أدري أنه قرّر أن يقرأ في سن متأخرة، بعد أن اقتنع طويلًا أن المعرفة تأتي من الأناقة الرسمية وتوسّل رضا المسؤولين الكبار.
طلبة أوكلوا الكلام إلى حركات رؤوسهم
الطلبة الذين أوكلوا الكلام إلى حركات رؤوسهم كنا «نحن»، أربعة من قسم الفلسفة، أنهوا دراستهم، وقرّروا دراسة عليا في فرنسا، تعطيهم لقبًا يساويهم بأساتذتهم. الأكثر تفوقًا وضجيجًا، وهو من بلدة خارج دمشق (كان يتضاحك ويقول: «سأقف على كتفَيِ الخرّيج الأعلى قامة»). كان كل منا يعلن عن موضوع «أطروحته» القادمة. ضبط صاحب الضجيج ربطة عنقه وقال بكبرياء: «المنطق المتعالي بين هوسرل وكانت»، وأكمل أن المتعالي هو «الترانسندنتالي»، بلغة أهل الاختصاص، وهو موضوع عويص اختص به قليلون. سألته عن دراسته بعد أربع سنوات على وصوله إلى «مدينة النور»، كما كان يقول، أجاب: ما زلت في حيثيات الموضوع، أتعلّم الألمانية، ضرورة البحث الجاد كما تعلم. ومرّت عشر سنوات بعدها، وقال: أتقدّم في الدراسة رويدًا رويدًا، وتعلّمت الإنجليزية. عرفت بعد أربعة عشر عامًا أنه يعمل في جنوب باريس مراقبًا في مدرسة ثانوية، بفضل إتقانه للغة الفرنسية وحصوله على الجنسية.
الطالب القومي الهوى اختار «أطروحة» عنوانها: «فكرة الحرية عند جان بول سارتر وأثرها على الفكر القومي العربي المعاصر». استلهم الموضوع من رواية سهيل إدريس، التي «قرّرت» عالمًا متحوّلًا، يدحر الشرقُ فيه الغربَ، ويأخذ العربُ موقعَ الصدارة. وقع بعد عامين من وصوله إلى باريس في غرام فتاة إنجليزية، وارتحل معها إلى لندن، أقنعته بأطروحة عن «مجنون ليلى وروميو وجوليت»، أقلع عنها بعد أن هجرته الفتاة، وانقطعت أخباره.
رابع الطلبة الأربعة، أي أنا، كان مشدودًا إلى موضوع: الاغتراب، الذي ظنّه محدودًا، جاهلًا أنه يفترش الفلسفة الحديثة كلها وإلى صورة الإنسان المغترب الذي انتزع منه، قسرًا، جوهره، وتطلّع إلى استعادة جوهره المفقود، في لحظة انبثاق قادمة. لم أكن أدري أن المغترب، يضلّه الطريق ويرمي عليه باغتراب متوالد لا شفاء منه. الثالث، كما أشرنا، غدا عالم اجتماع مطمئن.
كنا نهندس مستقبلًا فوق أرض رخوة، يحوم فوقها زمن مخادع، وتنتظرها أكثر من كارثة، تحوّل رغباتنا إلى مفاجآت جارحة. كانت تلك الرغبات بريئة رغم كلمات متبخترة وأذرع مرفوعة، تحاكي بوعي، أو من دونه، أساتذة جامعيين لهم هيبة العلماء، وأخلاق تبعث على التبجيل، كما لو كانوا أبطال رواية تحضّ على الفضيلة.
زمن يعبث بالأرواح
كنا فخورين بأساتذة ممتازين وننتظر أن ينظروا إلى تلامذتهم بِفَخَارٍ، لولا اختلاف الزمن الذي يعبث بالأرواح ويغيّر الأحوال. التقيت أستاذي الجليل الموسوعي الدكتور عبدالكريم اليافي بعد ثمانية عشر عامًا من سفري وقد دخل شيخوخة متصوّفة، قال مرحبًا: «إن كنت تحسن الترجمة فلك عندي أكثر من مساعدة، فأنا مسؤول في دار نشر نشيطة، وضعت تحت تصرفي وحدي سيارة. يمكن أن تترجم وتتبقى لك فلسفة الاغتراب في أوقات الفراغ». التمعت عيناه الزرقاوان الصغيرتان، وسأل: هل ما زلت تقرأ المعرّي وروايتي ألدوس هكسلي «العالم الطريف الجديد» وجورج أورويل «1984»؟ كان قد أعارني الروايتين أيام الجامعة. غمغم، وقال: إنك قرأتهما قبل الأوان وشدّ معطفه العريض ومضى. أمَّا لماذا تصوّف وبقي يكره «ربطة العنق» فشأن من شؤون الزمن، الذي يضيق بالأسئلة.
الأستاذ الشهير الآخر كان الدكتور بديع الكسم، الذي وزّع دراسته العليا على جنيف وباريس، ونشر كتابه «البرهان في الميتافيزيقا» عند «دار المطبوعات الفرنسية» في باريس، وكتابًا صغيرًا بالعربية عن «رامبو»، ربما نشره في دمشق. كان يبدو لتلاميذه دائم التجهُّم، يلقبونه «ماليبرانش» نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي الصعب الأفكار الذي كان يدرّس له بين آخرين. طلبنا منه المشورة قبل السفر، فأجاب: «الفلسفة هي الميتافيزيقا؛ تتأمل أسئلة الموت والزمن والموت واللانهائية، وما خلا ذلك علم اجتماع». وكم فرحت بحضوره مستمعًا إلى محاضرتي عن «نهاية التاريخ» بعد ثلاثين عامًا في أسبوع قسم الفلسفة في جامعة دمشق. سألني بوجه متقشّف الحركات عن الفارق بين هيغل وكوجيف وفوكوياما. لم يكن بحاجة إلى إجابة، بل كان يوجه تحية إلى تلميذه القديم. سرت معه، فقال: مكتبتي متاحة لك، الكتب كثيرة وزمن قراءتها غير متاح، وفيها شيء من سراب يخذل العينين. نظرت إليه وخمّنت أن قامته زادت قصرًا، وقد تخلى عن حقيبة الكتب التي كانت تلازمه. بعد مدة قليلة رحل.
قال الدكتور بديع ونحن نحاذي حديقة السبكي، يصادفني هنا الأستاذ أنطون، يعمل قريبًا في وزارة الثقافة، جعل من قراءة أفلاطون طقسًا يشبه العبادة. أذكر هذا الأستاذ يتحدّث فرحًا عن باريس، وفرحًا أكثر وهو يتحدّث عن مكتباتها، وكثيرًا ما كان يعطف عليها أسماء عرفها وهو يدرس في السوربون غدت، لاحقًا، أعلامًا في حقل الفلسفة.
قال لي وأنا بصحبة طالب آخر التمس منه رسالة إلى الفيلسوف بول ريكور: إن كنت مثقفًا «كتبيًّا» تبدأ من ساحة سان ميشيل، تنظر وراءك إلى نهر السين لترى باعة الكتب بصناديقهم المعدنية المستندة إلى جداري النهر منذ زمن طويل، مكشوفة بكتب قديمة وجديدة ومجلات مختلفة العهود، باعتها لا يساومون ولا يتأففون، إن تصفح المارَّة الكتب وأطالوا.
إذا صعدت باتجاه بولفار سان ميشيل كان عن يمينك مباشرة «ماسبيرو» ناشر الكتب اليسارية، إن أكملت الطريق وانعطفت يمينًا تصل إلى دار «بايّو» على مسافة قصيرة منها دار جاليمار، التي كان فيها مكتب لجان بول سارتر وآخر لألبير كامو، وربما ميرلو بونتي، والأخير أكثر عمقًا من غيره. وإذا تابعت السير صعودًا، ولم تنعطف إلى بولفار سان جيرمان، وصلت إلى شارع المدارس، الذي يتفرّع منه ممر ضيّق فيه مكتبة صغيرة لمنشورات جامعة السوربون، تنفتح نهايته على ساحة الجامعة، حيث عن اليسار مباشرة «دار فران»، المختصة في الدراسات الفلسفية «الثقيلة»، التقيت فيها ريكور أكثرمن مرة، حيث كنا طلابًا. في الساحة الواسعة المضيئة توجد «المطبعة الجامعية الفرنسية»، حين يطبع غاستون باشلار، كتبه المتعددة الاختصاصات.
كان وجه الأستاذ أنطون مقدسي، الذي حافظ على سيجارته بعد التسعين، يشرق وهو يذكر باريس، يزداد إشراقًا إن مر على دور النشر والمكتبات، حيث يستذكر جاليمار ولوسيان غولدمان صاحب «نحو نظرية في علم اجتماع الرواية»، الذي كان في الصف متكتّم الحضور، كما قال، واليوناني الضاحك كوستاس أكسيلوس، ويصمت قليلًا ويردد: كان من أصحابي، يعيد القول ثلاث مرات، نشر في دار «مينوي» كتابه الجديد: «ماركس مفكّر التقنية»، ويذكر المصري الراحل أنور عبدالملك ويثني على كتابه: «أيديولوجيا النهضة الوطنية»، ويكمل: نشره عند «دار أنتروبوس» القائمة في شارع راسين، القريب من ساحة السوربون. كان مقدسي، بعد أن اقترب من التسعين، يتذكّر شبابه وطموحه العلمي وتغيم عيناه، راجعًا إلى ذكريات عزيزة ليمنع عنها الجفاف. حين زرته مرة أخيرة في بيته، وقد جاوز التسعين، تحدّث بشغف عن ترجمة جديدة لكتاب أفلاطون: الجمهورية، واشتكى من
ارتفاع الثمن.
لم أدرِ، في البداية، كيف استقرت أسطورة باريس في خيال طلاب أربعة لكنني عرفت، في النهاية، كيف تمزَّقت داخل السفر الأول أكثر من سفر. بعضٌ ودَّع وطنه واستقر في جامعة إفريقية، وآخر ضاق به الحال وسقط في الطريق، وثالث اقتصد في أحلامه واغترب، ورابع أدرك أن شغف المعرفة يأتي من حرمان دائب التناسل، وأن مدن الفضيلة لا وجود لها، فالمتخيَّلُ الفلسفيُّ يَنبعِثُ من كتاب ويَندفِنُ في كتاب آخر. يتراءى بين البداية والنهاية غَبَشٌ وتجربة في المعرفة تجدِّد الإنسان وتغيِّره، حتى لو ظن غير ذلك.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | نوفمبر 1, 2019 | سيرة ذاتية
ما تاريخ الفقراء إلّا حكايات تسرد معيشهم، وما معيشهم إلا انتظار يخالطه الأمل. بيد أن للاجئ الفلسطيني المحاصر في مخيم حكاية أخرى، تشير إلى نقص وغربة. يبلغ الفرق ذروته حين يفاجأ المخيم بمجزرة تحسم وجوده، حال مخيم تل الزعتر، الذي حوصر ستة أشهر، ودافع عن نفسه إلى أن سقط وعاش معنى المجزرة. كان ذلك في أغسطس عام 1976م.
كان مخيمًا على هامش بيروت، يخنقه مكانه فيكاد لا يرى، كما لو أن قبضة حديدية غرست بيوته الطينية في الأرض، إن رفع رأسه عاجلته قبضة يقظة. تكدّس فيه فلسطينيون غدوا بلا وطن منذ عام 1948م. لم يكن في حياتهم ما يسر واستمروا في الحياة، وتأقلموا مع خيارات ضيقة وتابعوا أيامهم، وحملوا السلاح، ذات مرة، وحلموا بالعودة، دون أن يعلموا أن سلاحهم «الكافر» سيقودهم إلى قبور جماعية.
لماذا قُتِل المخيمُ وكيف؟ حديث يطول، يعرف السياسيون منه وجهًا، ويعرف المطّلعون على «بواطن الأمور» أكثر من وجه، لكنّ الطرفين اتفقا على أن «الآخرين» قتلوا من أهل المخيم أربعة آلاف وأكثر. والحقيقة أن حقيقة الضحايا لا يعرفها غيرهم، تجيء متفرقة على لسان اليتامى والثكالى والناجين المتقدّمين في العمر، ويغمغم بها أفراد قاسموا الضحايا، ذات يوم، الطعام والكلام. تظل حكايات المغلوبين مؤجلة الوضوح وتبقى كتابتها الأخيرة في مهب الريح، وإن كان هناك من يسافر بعيدًا كي يسرد أكثر من حزن وأقل من حقيقة.
عرفتُ صاحب الحكاية الأولى قبل المجزرة، والتقيته بعدها مصادفة. استوقفني بجلوسه اليومي على صخرة، يعطي للناس ظهره وينظر إلى البحر، لا يميل يسارًا أو يمينًا لكأنه صخرة أخرى.. كسرت عزلته متوقعًا الجفاء، ضيّق عينيه ونظر إليّ وعلت وجهه ابتسامة مستحيلة. بدا أنه جاوز الستين منذ ستين عامًا، في وجهه بقايا إلْفَة، وأسى افترش وجهه. تفحص وجهي وقال: «ألجأني إلى هذا المكان ابني الذي خسرته، اقطع النهار معتذرًا منه. طلب مني، حين كان الخروج من المخيم لا يزال متاحًا، أن يذهب إلى بيت عمه في دمشق، ورفضت، إلى أن شاهدت طلقات تستقر في صدره. نظر إليّ ابني عندها نظرة غائمة، لا أدري، إلى اليوم، هل هي نظرة عتاب أم نظر وداع. استقرت نظرته لعنة في روحي دائمة الضجيج. استرحمت «الآخرين»، رجوتهم، توسلت إليهم، ركعت وبكيت وتوسّلت. قالوا: إنه شاب قادر على القتال، وربما كان يقاتلنا، «أكملوا عملهم»، وبقيت أنا وعجزي وحيدين. لم أشفق على عجزي ولم تشفق روحي عليّ. أخرج صورة من جيبه، كان مراهقًا مبتسمًا واسع العينين.. التقيته مرة واحدة حصد الحصار المتعدد الجنسيات الصبي وأباه. افتقدت الرجل بعد أسابيع، قالت امرأة أخذت مكانه قالت: «لازم المسكين الصخرة ليلًا ونهارًا، أقلع عن الحركة والطعام، امتنع عن الكلام وتكوّم فوق ذاته ومات، حكى مع صورة ابنه طويلًا ومات، استغفر ربه كثيرًا وسأل الرحمة ومات، بكيته وبكيت ابنه، الذي كان يصغر ابني بخمس سنوات».
أنا وابني الجريح والعتمة ورسائل الموت
كانت المرأة كهلة مترهلة حاسرة الرأس تلبس مما يلبسه الذين لا ملابس لهم، قالت: «مصيبتي مثل مصيبة الشيخ المسكين. ابني عمره عشرون سنة. كان يحارب كل يوم. عندما اشتد القتال، طلبت منه أن يبقى في البيت، قال: لا يجوز أنا فدائي، عيب ألّا أكون مع أصحابي، عيب أن يقاتلوا ولا أكون معهم. في الأسابيع الأخيرة أصبحت حياتنا لا تحتمل. بقي معي في البيت. يا ليته لم يبقَ. كان النهار موتًا ورصاصًا وغبارًا. أراد الخروج، أصابته شظية قاتلة وهو واقف على عتبة البيت. بقينا معًا أنا وابني الجريح والعتمة ورسائل الموت. في الصباح «فصل»، استشهد، لم أجرؤ على طلب المساعدة من أحد دفنته، الله يرضى عليه، في صحن الدار جانب الليمونة، «قلت لحالي الله يرضى عليه يبقى جانبي». «كنت ألقي عليه تحية الصباح والمساء وأسمعُه يكلمني، الله يرضى عليه، يطلب مني الحذر، أن أنتبه إلى نفسي ولا أذهب إلى بئر الماء – المصيدة، حيث دلو الماء يساوي عدة ضحايا. أصبحت الآن مولعة بأشجار الليمون، أسقيها وأرويها، وأصبحت أعرف أن قبور الشهداء في كل مكان، وأن أرض الدار يمكن أن تكون مقبرة». كانت تتكلّم، وتفتش في جيوبها عن شيء لا وجود له.
عبّرت تلك المرأة الثكلى عن بطولة اليأس التي جعلتها تنام مع جثة ابنها في دار واحدة، وأملت عليها أن تقاسمه الكلام بعد ما رحل. وأن تعتقد أن الابن الشهيد ينصح أمًّا تسمعه، لن يشارك في جنازتها، ولن يرجعا معًا إلى فلسطين، لكنه يحدثها باستمرار. كان في تلك البطولة اليائسة جنون عاقل يأمر المرأة بمتابعة الحياة وبمراقبة أشجار الليمون، كما لو كان في الأشجار ظلال من روح الولد الفقيد. عندما قالت لي: «مصيبتي من مصائب الشهداء…». كانت تستنجد بروح الجماعة، وبمتواليات الشهداء، التي أقنعتها أنها ليست الثكلى الوحيدة، وأن الأحزان التي تتوزّع على مجموع تغدو أقل وطأة، لولا أن كل واحد منهم يعيش حزنه الثقيل!! «لو كان لكل فلسطيني حزن أقل لطلبت شربة ماء، ولحكيت له عن شهامة ابني قبل أن يقف على عتبة البيت». تذكّرت جملة إميل حبيبي في «المتشائل»: «الحمد لله أنه صار هيك وما صار غير هيك»، قالتها أم دهست سيارة ابنها لأم أخرى، ذهب وحيدها إلى بحر حيفا ولم يرجع.
سألتها خجلًا ومستغربًا كيف: هل هناك أكثر من مصيبة عجوز دفنت ابنها الوحيد؟ لم أنتظر جوابًا، لكنها قالت: حالة جارتي تصعب على الرحمن والشيطان، رحل ابنها ولم تستطع أن تعثر على جثته. أنا الحمد لله، مات ابني أمامي، غسلت وجهه ومسحت دماءه، وانتقل إلى جوار ربه طاهرًا ونظيفًا. جارتي تقتات بالأمل تسأل كل النهار، الذي تعرفه ولا تعرفه، عن ولدها وهل لمحه أحد، وتقول: «كان يلبس قميصًا أزرق، ترك البيت دون أن يودّعني، لم أزعجه في شيء، هل صادفتم شابًّا أسمر في العشرين من عمره اسمه أحمد؟» تستمر في السؤال وتهذي مكررة ما تقول، طالبة من ربها الرحمة ومن غيرها من المساكين المساعدة إلى أن يهدّها التعب وتقع على الأرض وتجتاحها إغماءة طويلة.
من أين تأتي الحكايات؟
أضاء الخارجون من مخيم تل الزعتر، وهم أطفال وصبية وأسرار وشيوخ وعجائز وقبور لا تشبه القبور ودموع وقدر ثاكل جملة تولستوي الشهيرة: «المسرّات جميعها تختزل في حكاية واحدة ومآسي البشر تتوزّع على حكايات». أجاب بشر كالظلال عن السؤال المطمئن: «من أين تأتي الحكايات» وأجابوا عنه ببساطة فادحة تأتي الحكايات من أب عاجز قتله ندم عاجز، ومن أم يائسة رأت في أغصان شجر الليمون ملامح فقيدها، ومن أم أنفقت عزمها في البحث عن ولد خرج ولم يعد…!!
«ليست النائحة كالثكلى تقول العرب. فدموع الأم التي فقدت ولدًا تختلف عن دموع مستعارة، تتساقط تعاطفًا أو غضبًا أو حزنًا مأجورًا يمسحها صاحبها ويمشي… بقيت مدة طويلة، إلى اليوم ربما، أهجس بجملة العجوز الذي قتله الندم: «حين أصاب الرصاص ابني شعرت أن روحي لعنتني، وأنها لا تزال تلعنني إلى اليوم!!». ما الذي كان بإمكان عجوز اشتعل رأسه شيبًا، أن يفعل؟ تأكل روحُه روحَه ويشكو مصابُه إلى القدر ولا ينتظر جوابًا، فصوتُ القدر كخطواته لا ينتبه إلى أحد.
بعد مدة لمحت في الطريق عجوزًا في «كوفيّته وعقاله» شيء من الفلسطينيين، وفي مشيته المتثاقلة ورأسه المنحني ملامح من ذلك العجوز النادم الذي قهره ندمه ورحل. دفعني الفضول واقتربت منه، كلمته فلم يجب. كان يمسك بيد صبي جاوز العاشرة. أعدت الكلام بلهجة أهل صفد من الجليل الأعلى في فلسطين، توقف العجوز ونظر إليّ وقال: الحمد الله. أعدت الكلام وأعاد الكلمتين بلا زيادة. مشيت إلى جانبه فقال الصبي: جدي لا يتكلم منذ أن قتل «المهاجمون» أبي في تل الزعتر.
الصبي الذي كان ذاهبًا مع جده إلى بلدة «الدامور»، التي تجمعت فيها «بقايا» المخيم القتيل هو الصبي الذي سألتقيه بعد أشهر في «حديقة الصنايع» في بيروت وهو يبيع «اللبان» -علكة باللغة الدارجة- تبادلت معه كلمات قليلة فأجاب: الحمد الله، سألته عن جده فأعاد: الحمد الله. بعد صمت قال: أبي مات وارتاح، وبقي جدي بعده ولم يعرف الراحة. يجلس صامتًا يعاتب القدر، يغرق في صمت ويستغفر ربه ويقول: لا أحد يعاند القدر. سألت نفسي: ما الذي يدفع صبيًّا فلسطينيًّا في العاشرة إلى معرفة كلمة القدر؟ إنها أقدار الفلسطينيين، التي انتزعت فلسطينيًّا من أرضه وقذفت به إلى مخيم بائس خفيض الجدران وسقطت عليه جملة مهينة: «باع أرضه لليهود»، وأمطر قائلوها المخيم بنيران متقاطعة رافعين إشارة نصر أقرب إلى الأحجية: ما معنى النصر على لاجئين حلموا بالعودة إلى أرض أجدادهم؟ ومن أين تأتي كراهية مستضعفين جديرين بالرحمة؟ يجيب اللاجئ: حاولت ما حاولت وفقدت ما فقدت، لكن «الدهر أبى»، بلغة الشاعر حافظ إبراهيم في قصيدة رثت جنديًّا يابانيًّا، أخلص لتعاليم «الميكادو»، وأخفق مسعاه. قاتل الفلسطينيون منفاهم وسقطوا في الدم والصمت. والصمت ما يسبق الخوف ويتلوه، عنوان حقيقة «قتيلة»، وهو تعطيل بعض الحواس في انتظار الفرج.
الأمل الذي تخالطه الخديعة أحيانًا
آمن «الآخرون» أن سقوط مخيم تل الزعتر أغلق الحكاية: «كانوا هنا ولم نرغب بوجودهم فدفناهم في أرض ليست لهم». ولكن لماذا؟ ما الذي جعل الفلسطيني الفقير الذي لاذ بأرض قريبة متهمًا؟ وما معنى تناسل الضحايا؛ إذ للصبي أذى يعلق به، والأب ضحية لأنه أنجب أولادًا يذكرون فلسطين، والجد ضحية وهو الذي استنشق هواء الجليل العليل وزار القدس غير مرة وانتهى إلى مخيم خفيض ورأى أولاده يذبحون. لاذ الفلسطينيون بالأمل الذي تخالطه الخديعة أحيانًا.
لا خديعة في اللغة، فالفلسطيني هو المدافع عن حقه، والشهيد الفلسطيني هو الذي ذبحه الصهاينة و«آخرون» انتماؤهم معلق في الفضاء. لا تخدع اللغة العربية أحدًا، فالمخادع هو «الآخر» الغامض الذي يعرف اللغة العربية ويذبحها. إنها خديعة السياسة أو «سياسة المتاجرة»، التي تحصل على مكافأة إن تناقص عدد الفلسطينيين، وكفّوا عن الذهاب إلى المدارس وعن التمسّك بالكرامة.
كان أستاذنا يسألنا: من أين تأتي الأحزان، وكنا صغارًا؟ ونجيب: من المرض والفقر وموت الأقرباء، فيسأل من جديد: إلى أين تذهب الأحزان؟ فلا نجيب. لم نكن آنذاك نعرف كلمة الذاكرة، ولا نعرف أن الأحزان تشبه بثورًا حمراء تنتشر حارقة فوق سطح الجلد وتتحوّل، إن طالت، إلى بقع سوداء لا تزول، تستقر وتنغرس في الذاكرة، التي من دونها لا يوجد تاريخ.
حين تحدّث عالم اللغة الأميركي اليهودي عن هجوم الجيش الإسرائيلي على بيروت، صيف 1982م، كتب منددًا بالهجوم: «إنهم يصطادون العصافير بالمدافع». كان لقتلة «مخيم تل الزعتر» مدافع متعددة الجنسيات، ولم يكن أهل المخيم سربًا من العصافير.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | سبتمبر 1, 2019 | سيرة ذاتية
«مدينة أقرب إلى الحلم، لا سلطة تراقب الناس، ولا مخبرون يحفرون في قلوب البشر، ضيقة واسعة، ومحاصرة مفتوحة». كلمات قالها الروائي غالب هلسا، ونحن نمشي في زقاق، قطعت عنه الكهرباء، في مدينة بيروت. كانت الحرب التي عطّلت السلطة لا تزال قائمة، وغالب قادمًا من بغداد التي رُحِّل إليها من القاهرة عام 1976م عاش فيها ثلاث سنوات.
لم أكن التقيت غالبًا، الذي بدا طفلًا كبيرًا، نسي لغته الأولى واعتنق اللهجة المصرية. كنت قرأت روايته الأولى «الضحك» التي ترجم فيها الاغتراب أكثر من مرة، وروايته «الخماسين» التي وصفت معتقلًا سياسيًّا، استجار من التعذيب بالسماء، وأطلق صراخًا نفذ من الجدران والنوافذ ومرّ بساحة السجن وتسلق الهواء مستعطفًا قمرًا ساطعًا في ليلة باردة. لم أكن أذكر غالبًا، قبل أن أراه، وبعد أن رأيته، إلا تذكّرت «سجينه المعذب» الذي ضاقت به الأرض وانفتح على الفضاء. سألته بعد اللقاء عن سجينه، أجاب: عرفته شخصيًّا، خرج من المعتقل ودخل في صمت طويل، لازمه حيث ذهب.
كان لهلسا وجه طفولي مليء، حافظ على قسماته الأولى، وشعر أقرب إلى الحمرة، ومشية مندفعة تصدم الهواء وتتطلع إلى فوق، يدعمها كتفان عريضان يلازمهما، صيفًا وشتاء، معطفٌ لا يتغيّر.. له صوت هادئ لا يرتفع إلا مصادفة، وسيجارة عصية على الانطفاء، وجهه البشوش وجملته الأليفة: «نشرب القهوة معًا!!»، التي تتبعها بعد ابتسامة عابرة، إشارة إلى الروائي الفرنسي أندريه بلزاك، الذي «قتلته أربع مئة ألف فنجان من القهوة»، كما لو كان غالب قاسم بلزاك كتابة الرواية والتآلف مع الموت في آن.
دخل الجامعة الأميركية في بيروت والقاهرة، وحافظ على براءة لا تغيب، وعرف السجن وشغف بالسياسة واختلف إلى منافٍ عربية متعددة، ولم يغادره وجهه الطفولي. ولعل هذه الطفولة المستقرة زرعت فيه محبة للناس وخشية منهم، يؤثر الصمت ويخاصمهم كتابة ويوغل في الخصام ولا يتجاوز الكتابة، حال موقفه من جبرا إبراهيم جبرا وحنا مينة و«أدب المقاومة»، وهو الذي مايز بين «الأدب الثوري» و«الثورة في الأب»؛ إذ الأول شعارات تذوي قبل غروب الشمس وفي الثاني عمل في الأشكال وسجال مع النصوص المبدعة.
غالب هلسا مشاء يوغل في التذكار

غالب هلسا
كان في تجواله الطويل، وهو مشّاء بامتياز، يوغل في التذكار، يبدأ بماعين حيث ولد عام 1932م، ويتوقف ويذكر أمه بجملة مبتورة، ويمر على امرأة جميلة العينين، لاعبته طفلًا، وغازلها شابًّا، وحلم بها كهلًا، كأنها امرأة الأحلام يراها القلب ولا تبصرها العينان. وقد يوغل في الحديث عن بيت مهجور عبث فيه صبيًّا، ويمر على بائع مصري بسيط يساهر النيل ويسهر معه غالب ويتساهران مستذكرين فتاة جامعية تجلس نهارًا وحيدة على شاطئ النيل، ربما كان في الفتاة المستوحدة شيء من شخصية «نادية»، التي داعبها في روايته «الضحك».
أفسح للذكريات مكانًا في روايته «البكاء على الأطلال»، واستدعى في مجموعته «وديع والقديسة ميلادة وآخرون» طفلًا فضوليًّا يمتعه الكلام ويتأذى من الصمت. كان يبدو، إن بسط يديه على ركبتيه ونظر إلى البعيد، إنسانًا من ذكريات يحلم بما كان ويجعل حاضره حضنًا لما تولّى مناجيًا «سلطانة»، عنوان روايته الأثيرة، الشابة الفاتنة التي تصد الزمن. كان يمشي معنا ويعد بأنه سيعيش «مئة وعشرين عامًا»، وهو الذي لم يبلغ الستين، توفي في 18/12/1989م. ربما عذوبة الذكريات هي التي دعته إلى أن يقول بشجن ذات مرة: حين أرجع إلى أمي أصبح شابًّا.
ومع أن الذي تسكنه طفولته يرغب عن المخاطرة، كان غالبًا عاشقًا لمواقع الخطر مؤمنًا، ربما، أن الموت لا يحسم الأطفال. كان يمر ببيتي، خلال الهجوم الإسرائيلي الواسع على بيروت صيف 1982م، في عز الظهيرة، مرتديًا معطفه، يمسح عرقه ويطلب ماء ويردّد بلهجته المصرية: الطقس حرّ قوي. إذا سألته: أين كان؟ استكمل عفويته، وأجاب: «أتفقد الشوارع، فارغة تمامًا، خوفًا من الطائرات»، ويتهيأ للخروج قائلًا: «أريد أن أتفقد الرفاق المرابطين على البحر». وكان رفاقه «شعراء» مقاتلين، لا يعرفون عن السلاح إلى القليل، اختاروا هامش الحياة وندّدوا «بالقيادة الرسمية»، أشرف معهم على «مجلة الرصيف» التي تثني على الحرية وتسخر من الانصياع. لست أدري إن كان يتفقّد أمكنة الخطر أم يفتقد طمأنينة تساوي بين الحياة والموت. والأرجح أنه كان يحدّق في الطائرات المغيرة ويحاور قلبه هازئًا بعالم آثم لا سبيل إلى إصلاحه.
المنفى يسلب غائب طعمة سهولة الكلام

غائب طعمة فرمان
ما ذكرتُ غالبًا إلا وذكرت روائيًّا عراقيًّا أَلِفَ البساطة والمنفى يُدعَى: غائب طعمة فرمان. حين زار بيروت عام 1981م أردنا، أنا وسعد الله ونوس، أن نجري معه مقابلة لصحيفة السفير كان سعد الله مسؤولًا عن قسمها الأدبي، فوجئ الرجل وقال مدهوشًا: «مقابلة معي، معي أنا، هل أنا جدير بلقاء أدبي، ناقد ومسرحي كبير؟». التف بأعضائه وبدا خجلًا، كأنه لم يكتب رواية: «النخلة والجيران»، التي حظيت بتقدير كبير، قبل زمن، ولا رواية «خمسة أصوات»، التي احتفى بها الفلسطيني غسان كنفاني، ولا أنجز ترجمة رائقة لأعمال أنطون تشيخوف وغيره من الأدباء الروس. كان أديبًا حقيقيًّا، تصرفت حياته به ولم يتصرف بها كما أراد، وسلبه المنفى المتواتر سهولة الكلام.
طلب قبل الحوار أكثر من كوب ماء، ومسح نظارته وقال: «جاهز عيني، بس أبغي أن لا تكون الأسئلة صعبة». بدا بأناقته الرسمية عجوزًا يدخل مسابقة لم يتهيّأ لها. سأله أحدنا: كيف تقرأ علاقة الأيديولوجيا ببنية العمل الروائي؟ أذعره السؤال وأجاب بعد حيرة: «أيديولوجيا، أيديولوجيا! أن لا أفهم الكلمات الكبيرة، أكتب ما تهمس بي روحي وأترك قلمي يكتب كما يريد». كان قد أصدر حديثًا عن دار الآداب روايته «ظلال على النافذة»، استعاد فيها بغداد قديمة ورسم «ظلالها»، مدركًا أن المنفى أقام بينها وبينه ستارًا كثيفًا. سأله سعد الله: «كيف تكتب عن مدينة لم ترَها منذ زمن؟» أجاب: لا أصف وجوه البشر وضوضاء الشوارع إنما أكتب، أولًا، عن روح المدينة التي تسكن روحي، وتخاطب الأرواح خاصة أن بعض الذين عرفتهم ما زال على قيد الحياة، ولا يبخل علي بالرسائل والصور. غابت عني أشياء كثيرة، أكتفي اليوم بالشميم». اختلج صوت العراقي الطريد وطلب «ما يبلّ به الريق».
كان الرجل يتذكّر، وقد وهن بصره، يدرك أن مواقع الصبا خالطتها الأطلال، ويسكب على الأطلال ألوانًا معتمة. وكإنسان مرت به غفوة قال: «أكتب عن أصوات بغداد كما استقرت في الذاكرة، لا أتخيل الأطلال، بل عما أرغب أن يظل هناك». نسي، ربما، أن وراء الرغبة المقموعة يتمادى الاغتراب، وأن تصوير العسل لا يجلب الحلاوة إلى الفم. سألته: «كيف تكون روائيًّا واقعيًّا، وتتمسك بماضٍ اجتاحه التحوّل؟». غضب عندها وقال: «إن كل الأدب الكبير أدبٌ عن الزمن المفقود». لكنه ما لبث أن ابتسم مستسلمًا وقال: «ربما لم أعد واقعيًّا، كما كنت، ربما دفعني المنفى إلى واقعية جديدة. انتظرا، على أية حال، روايتي القادمة: «المشتهى والمؤجّل». لم يدرك أن المشتهى هو المؤجّل، وأن المؤجّل يوافيه الأجل قبل أن يصل، وأن الضباب سيكون بطل رواية قادمة دعاها: «المركب».
سألناه عن شخصيات أحبها في روايتين قديمتين «النخلة والجيران» و«القربان». أجاب: «العجوز الخبازة التي توقظ الديكة قبل أن تستيقظ ماتت في الواقع، ولم تمت في الذاكرة»، أما الحائرون في الرواية الثانية فحيرتهم القديمة أهون من حيرتي القائمة. لا يوجد عندي أبطال منتصرون والأدب الصادق موضوعه الخيبة». ترجم كلام «غائب» شقاء منفى متوالد، وضع رغباته خارجه، وطوّح بخارجه إلى مكان مجهول وعبّر، في الحالين، عن اغتراب ينهش جسد الإنسان المغترب. كان غالب هلسا كلما التقى أنثى في بيروت عاجلها بدعوة خجولة: «إيه رأيك في فنجان قهوة»، وكان غائب يشرب قهوته وحيدًا.

الطاهر وطّار
تقاسم غائب وغالب أطيافًا بغدادية وهدوءًا متواضعًا، على خلاف الروائي الجزائري الطاهر وطّار، الذي يبدأ مبتسمًا ويخلّف وراءه رمادًا. التقيت الأخير مع غالب في «دار ابن رشد» ـ كانت في نهاية كورنيش المزرعة ـ لصاحبها السوري سليمان صبح الناحل البشوش الذي ينسى الأسماء ويستعيض عنها جميعًا بكلمة «هذا الواحد». ويطلق ضحكة صاخبة. سلم غالب وانصرف، وترك وطّار يتحدث عن روايته «الحب والموت في الزمن الحراشي»، ويسلم مخطوطته للناشر السوري، ويتابع الحديث بعربية فصحى مبرأة من اللهجة الجزائرية.
قال وطّار: إن روايته الجديدة جزء ثانٍ لروايته: «اللاز» التي حظيت بانتشار واسع، واستكمال لروايتيه: «الحوات والقصر»، وهي أسطورة شعبية و«الزلزال» التي ناصرت «الثورة الزراعية» وانتصرت لها، وامتداد لمجموعته القصصية «الشهداء يعودون هذا الأسبوع». حاورته بعد قراءة روايته الجديدة، بدا ممتلئًا بذاته فخورًا بما أنجز، يتقبّل المديح بمسرّة، ولا يقبل النقد إلا على مضض.
سألته هل يعتبر «اللاز»، ويعني «الآس» عند لاعبي الورق، بطلًا إيجابيًّا، بلغة ذاك الزمان، أجاب مسرعًا: بكل تأكيد. قلت: لكنه لم ينتصر وظهر مهزومًا بين مهزومين، ردّ قائلًا: «إن ما يبدو مهزومًا في لحظة، يرجع منتصرًا بعد حين، ومثال ذلك ظاهر في روايتي «الزلزال»، التي سجّلت انتصار الثورة الزراعية وهزيمة الأعداء الطبقيين هزيمة أخيرة». لم أدرِ، حينها، إن كان يتحدث باسم «حتمية تاريخية مجردة»، أم باسم سلطة سياسية حاكمة، ترى في انتصارها الذاتي نصرًا للجزائريين جميعًا. بدا الروائي مقتنعًا بما يقول، موقظًا في ذهني أسئلة عن الفارق بين الوهم والتخييل، وعن سطوة «الأيديولوجيا الحزبية»، التي تسبغ على المتوهم أبعادًا حقيقية، وتلك الحتمية التي كانت، في ذاك الزمان، «فلوكلورًا» يرضي قدرية فقيرة.
دفعتني «إيمانيّته الذاتية» إلى مواجهته بنرجسيته المفرطة الساخرة في روايته إلى جانب «الحب والموت في الزمن الحرّاشي»، التي كتب فيها أن «التاريخ سيعطي اسمه مكانًا إلى جانب أراغون وإيلوار وماركس وأنجلس….». قلت له: هذا استكبار لا يجوز، فأجاب محتدًّا: «يجب أن تقرأ روايتي من وجهة نظري، ونظر الجزائريين جميعًا، لا من وجهة نظر برجوازية…». تساءلت في سري حينها: إن كان الانتساب إلى السلطة يفضي إلى العماء؟ وهل في هذا الانتساب ما يمحو المسافة بين روائي ومسؤول بيروقراطي محوّط بالعسكر والعسس؟ وهل هناك من مثقف حقيقي لا تلازمه الكآبة والشعور بالإخفاق؟ بعد إخفاق «الزلزال الوهمي» واقتراب الجزائر من حرب أهلية جاء وطّار برواية جديدة: «الشمعة والدهليز»، خلع فيها تفاؤله واكتفى بضباب الفكر والكتابة.

حيدر حيدر
يُفسد اختراع الواقع النظرَ والكتابةَ، ويملي على المثقف معادلات فاسدة الحلول، ويزيحه من عزلة نبيلة إلى عراء عالي الضجيج، ابتعد منه الروائي السوري حيدر حيدر، الذي عاش في الجزائر وعرف أهلها، وأدرج ما عاش وما عرف في رواية متشائمة المنظور: «وليمة لأعشاب البحر»، أغلقت صفحاتها بوحش أسطوري الأذى يدعى: السلطة القامعة. اختار حيدر، المثقف الساخر العصبي الطباع، أُنس البحر ليلًا، وامتلأ بصمته وضجيجه، وأدرك أن في الصمت حقيقة، وأن الائتلاف معه يستقدم ما هو حقيقي. بعيدًا من الغبطة كان، يلتف بعزلته ويسعى إلى تجويد الكتابة، وينتقل من كتاب إلى آخر موسعًا حواره الذاتي. ويكرر جملة عن الفقد والاغتراب: «ذهب الذين أحبهم، وبقيت مثل السيف فردًا». ولم يكن الفرد الذي يشبه السيف، إلا صديقًا كريمًا وروائيًّا حالمًا يمشي وراء كتابة، لا تشبه غيرها، كما كان يقول.
عاد حيدر، بعد سنوات إلى قريته وبنى مسكنًا بسيطًا على البحر، وعاجل الموت غالب هلسا في دمشق، ودفن غائب فرمان في ضواحي موسكو، واستقر وطّار في أرض بلاده. لكلٍّ كان حلمه وطبعه، والطبائع تتغير، والأحلام تتحوّل إلى أثير.
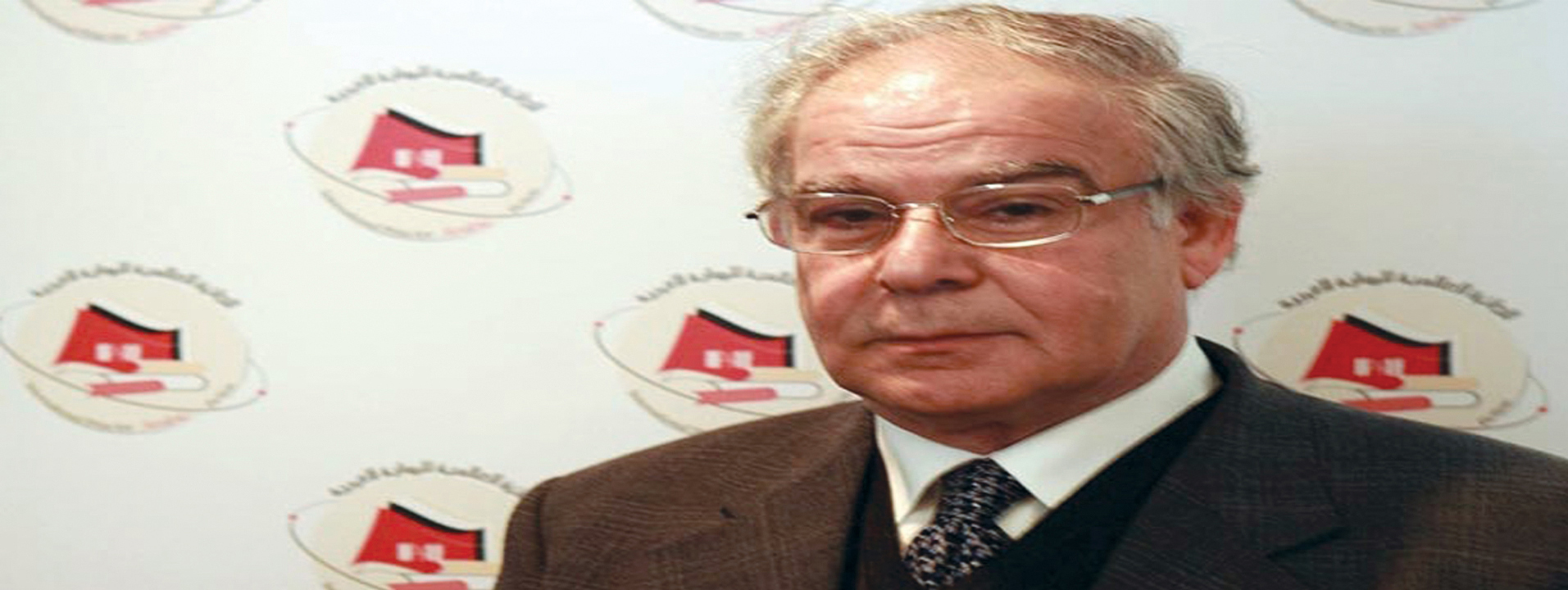
فيصل دراج - ناقد فلسطيني | يوليو 1, 2019 | سيرة ذاتية
في ماضٍ ابتعد، كنا نذهب أيام الجمعة إلى بوابة الصالحية في دمشق، نلتقي باعة كتب قديمة، ونتصفح مجلات تفترش الأرصفة. كان صديقي الكردي، الناحل الذي يميل إلى الصمت، يحدق في المجلات طويلًا إلى أن تقفز يده إلى مجلة متقشّفة الغلاف، صفراء الورق كأنها بالية تدعى: الطريق. يخون عندها صمته ويردّد فرحًا: «الشمس تشرق يا رفيق!». ويشتري أعداد المجلة المنزوعة الغلاف، ويهدينا عددًا. أسس هذه المجلة المهندس اللبناني أنطون ثابت 1941م، وحملت على عاتقها الهجوم على الفاشية والدفاع عن الاتحاد السوفييتي وتبني شعار الاشتراكية. وكان يكتب فيها بأسلوب أنيق أديب ذائع الصيت يدعى: رئيف خوري، كان عليه أن يختار عام 1948م بين الولاء لفلسطين ورفض موقف الاتحاد السوفييتي، واختار فسلطين مواجهًا «أممية مفترضة».
حين وصلت بيروت عام 1974م، بحثت عن مكتب مجلة الطريق استقبلني إنسان أنيق متعثّر الكلام، كما لو كان يعتذر عن فعل مسيء لم ينتبه إليه. قال: أنا نزار مروّة «مسؤول المجلة إلى حين»، أعطاني عددًا أخيرًا، قفزت إليه يدي مثلما فعلت يد صديق راحل، ذات مرة. كان الغلاف مختلفًا شكلًا وإخراجًا وورقًا عمّا كان، لا صفرة في أوراقه ولا ما يشير إلى «البلى». تحدث رئيس التحرير «المؤقت» عن انفتاح المجلة على قضايا الأدب والفن والثقافة ودخل، وهو المربِك المرتَبك، إلى عالم الموسيقا العربية والغربية، كما لو كان من أهل الاختصاص. سألته: «هل هناك من موسيقا ملتزمة، وكيف يكون دارسها ملتزمًا؟»، قال: «الفن قيد، وأهم شروط الفن ليس الحرية بل القيد؛ إذ من دون ضوابط ومن دون قواعد لا وجود للفن». لمح في وجهي دهشة، فتابع: «أتحدث عن قيود الصنعة، أما الالتزام الحقيقي فلا يعرف القيود». عرفت لاحقًا أن نزارًا عالِم في الموسيقا، ترك بعد رحيله المبكر دراساتٍ متعددةً، أشرف على إصدارها المفكر السياسي كريم مروّة، الذي بذل جهدًا متواترًا كي تبقى مجلة الطريق على قيد الحياة. وعرفت أيضًا أنه ابن المفكر الشهير حسن مروّة.
حوار القيد والحرية
أعادني حديث نزار مروّة عن حوار القيد والحرية إلى قول الإيطالي أنطونيو غرامشي: «الفن معلم من حيث هو فن لا فن معلم». حين طرحت سؤال دور الأدب والفن على «والد نزار»، بعد أن زرته في بيته أجاب بصوت هامس: «شعاري دائمًا وحدة المعرفة والصالح العام». كان البيت، القريب من «الرملة البيضاء» المحاذية للبحر، مزيجًا من التقشف والأناقة، أخذني إليه محمد دكروب الذي أشرف مع الأستاذ حسين مروّة، في نهاية خمسينيات القرن المنطوي، على مجلة قصيرة العمر، واسعة الأثر عنوانها: «الثقافة الوطنية»، عبّرت عن «توصيات مؤتمر الأدب العربي»، الذي انعقد في دمشق عام 1954م.

حسن مروّة
كان مروّة الأب، حين التقيته المرة الأولى، جاوز السبعين، وراؤه تاريخ كتابي في لبنان والعراق، معتدل القامة وأنيق من غير متكلّف، يضع نظارة طبية، يشي وجهه بعمره، حنون الملامح كعجوز قرويّ كثير الأحفاد، وله دراسات شهيرة عن الواقعية. سألته: «هل يبدأ الأديب من الواقع أم من الواقعية»؟ كان في كلامه البسيط ينفي ما هو أحادي ونهائي، وفي صوته الخفيض ما ينكر الإجابات المغلقة، يتكئ على كلمات مختصرة تستهل بفعل «أظن»، تتبعه ربما، ويتلوها «من الجائز»، ويكملها «من المحتمل…» إلى أن ينفجر محمد دكروب ضاحكًا ويقول: «لعل وعسى أو لعسى»، وينظر إلى نزار مروّة، الذي يتأبط خجله صامتًا، ويقول: «من الأرجح»…. لم يكن هؤلاء المثقفون يؤمنون بالاختلاف، بقدر ما كانوا يردون عن أنفسهم تهمة «الانغلاق»، أو ما كان يدعى: الدوغمائية.
أذكر اليوم عن حسين مروّة الذي اغتاله الفكر المتعصب في ربيع عام 1989م، صفتين: التهذيب الفائق الذي يحض على السلوك المهذب، والتسامح إلى حدود الإحراج، كما لو كان يقول: لا يتعرّف المثقف بثقافته، واسعة كانت أم محدودة، بل بسلوك مثقف. وفعل «ثَقُفَ» يعني صقل بلغة العرب. من حق الأديب الراحل عليَّ أن أسرد حكايتين: نشر في جريدة النداء، في شتاء 1978م، ربما، مقالًا عنوانه: العلم والأدب، فصل فيه بينهما فصلًا متعسفًا، أو فصلًا لم أرضَ عنه، دفعني إلى الرد عليه. كان في ردي شيء من الحقيقة، وكان فيه أكثر أشياء من التطاول والادِّعاء، حمل بعض «الأنصار» على رد عنيف أقرب إلى التنديد. في مقابل ذلك اتصل بي الأستاذ مروّة وقال: «في مقالك طزاجة فكرية جديرة بالحوار والاعتراف». نقدت بعد ذلك، مفهومه للواقعية في دراسة نشرت في مجلة «الكرمل» ـ 1981م – اتصل بي بعدها، وقال: «طلب مني معهد الإنماء العربي دراسة عن الواقعية، واقترحتك بديلًا عني، فأنت تحمل أفكارًا جديدة». تعامل حسين مروّة معي بمعيار الأبوَّة والخبرة والمسؤولية والرضا المرتاح عن الذات. كان قد أنجز كتابه الكبير «النزعات المادية في الإسلام»، الذي أثار حوارًا واسعًا، وأعطاه موقعًا رائدًا في مجاله.
ضوضاء ضاحكة الكلمات
كانت ابتسامته تسبقه إنْ اقترب غدت قهقهةً، فإن وصل أصبحت ضوضاءَ ضاحكة الكلمات، أو «ضحكًا من الروح مليئًا بالعافية»، بلغة رئيف خوري. كان دائم الضحك ومستقر الهموم ويدعى: محمد دكروب. ربطتني به صداقة منذ أن أصبح مسؤولًا عن مجلة الطريق في منتصف السبعينيات الماضية حتى فارقها، أو فارقته. «استكتبني» كثيرًا، مرة بإلحاح ومرات «بالموْنة»، بلغة اللبنانيين. وتآلفت مع نقده وتقويمه وصرت أسأله: «كيف المقالة يا أبونا»، ويجيب: «ستصبح يومًا أبًا لي ولكن أكثر وسامة، ولا أنصحك بالعمل في مجلة فقيرة، فالعمل فيها يكسر الظهر ويرهق العينين».
وُلد محمد دكروب عام 1929م في مدينة صور، وترك المدرسة قبل نهاية المرحلة الابتدائية، وأصبح كاتبًا معروفًا. دعاه أهل بلدته «ابن صور العصامي»، زاول مهنًا عديدة مثابرًا على القراءة، ودعا نفسه وهو يعمل في مجلة الطريق «سمكري الأدب»، يقوم بالقراءة والتصحيح والتنقيح والإخراج ومتابعة المطبعة والاستكتاب ومتابعة مستكتبين «متبرعين»، يلبُّون، «السمكري الأنيس» قبل رسالة مجلته. بدأ حياته «سمكريًّا» في دكان أخيه، يصلح كل شيء ويقرأ في أوقات الفراغ كتب مصلحين أقنعوه برسالة الأدب، سرد حياتهم حين أحسن الكتابة في كتب متعددة: «خمسة روّاد يحاورون العصر، شخصيات وأدوار، الذاكرة والأوراق، وجوه لا تموت»… كان يكتب ويتذكر «وجوهًا» حاورها، لا تبدأ برئيف خوري ولا تنتهي بمهدي عامل، تسعفه رسائل قديمة من زمن «الثقافة الوطنية»، أرسلها إليه: يوسف إدريس ونجيب سرور ومحمود أمين العالم…، ولقاءات مع محمد مهدي الجواهري ولطيفة الزيات وغسان كنفاني و«شعارات حسنة الضوء والقيافة»،… وكثيرًا ما كان يستعيض عن فعل «نلتقي» بفعل «نتياءس»، وكان رغم ضحكه المتدفق محقًّا في يأسه. أدمن على ضحك خارجي وأسًى داخلي حتى رحل عام 2013م.

محمد دكروب
كان مثل كثيرين منا دائم الحديث عن «مشاريع جليلة» قادمة، أجهدته وأرهقت غيره وسقطت في سبات عميق. حدثني أكثر من مرة عن مشاريعه الروائية: «أنا الآن بصدد إكمال رواية بدأها صديقي محمد عيتاني قبل أن يموت»، «وأنا الآن بصدد رواية عن ازدهار وموت ساحة البرج في بيروت»، «وأنا الآن ألملم ذكرياتي في صور في رواية قبل أن تغيب الذاكرة…». كانت وراءه أزمنة واضحة وأمامه زمن من غبار أحنى ظهره وأضعف بصره وأبطأ خطوه، وأبقى أوراقه عن طه حسين قريبة من الشلل. حين كنت أشاكسه عجوزًا سائلًا: «الشمس تشرق يا رفيق؟»، كان يجيب بضحك هامد ويقول «الله يسامحهم». وتظل «هم» الشاكية معلقة في الفضاء. وبقيت هذه المعابثة قائمة بيننا حتى رحل. كانت تطارده قضايا الحياة اليومية، الموزعة على المرض والإحباط، وكان يطاردها بسخرية مريرة.
حكاية وحده بأسمائه الثلاثة
كانت ابتسامة دكروب تحتجب إن مرّ على اسم صديقه مهدي عامل، وجه آخر من وجوه مجلة الطريق ودعاة «ثقافة الصالح العام». كان الأخير حكاية وحده، غريبة مميزة غرابة أسمائه الثلاثة: مهدي يضعه على كتبه ودراساته، وحسن حمدان لتلامذته في الجامعة، وهلال بن زيتون، يوقع به قصائد متأملة يكتبها بعد عناء النهار واعتدال الليل، كما كان يقول. أراد في أسمائه المتعددة أن تكون له أكثر من حياة: حياة لمعرفة نظرية تضبط حركة الكون، وحياة لتلاميذ ثائرين يدفنون القديم، وحياة للورد والأغاني ومؤانسة الأصدقاء. استعاض دكروب عن فعل التقى بفعل تياءس، وجعل مهدي عامل من اللقاء مؤانسة، كما كان يقول، قبل أن تنهي حياته رصاصة أخرى، في مايو 1989م، وهو يركض صباحًا على شاطئ البحر. كان قد جاء إلى دمشق قبل شهرين وشيّع حسين مروة بكلمات مدوِّية: «استنصرته قضيته فنصرها، وسننصر قضيته كما نصرها». ولم ينتصر في النهاية إلا الموت، الذي تسلل إلى حسين مروّة في بيته وسابق مهدي على شاطئ البحر وأخذ مكانه في السباق.
أنجز مهدي دكتوراه في الفلسفة من جامعة ليون، وحمل معه لحية سوداء ورجع إلى بيروت، كتب وساجل وانتقل من اجتماع إلى آخر بلحية رمادية، وخرج بكتاب مقاتل: «نمط الإنتاج الكولونيالي»، وحَّد فيه بين التحررين الوطني والاجتماعي، وآمن «بصناعة التاريخ». كان ممتلئًا بسحر النظرية، التي تشرح الواقع وتروّضه وتعيد صنعه، وتقيم علاقة دافئة بين المثقف الإيماني والتاريخ، كما لو كان الأخير مثقفًا متمردًا بدوره.

مهدي عامل
كأن يأتي قلقًا، يجلس ويمسح نظارته، ويقول بنبرة لبنانية جنوبية: «عندي كلمتيْن»، تتناسلان في حديث طويل ينقد إدوارد سعيد ويعرّج على أدونيس ويثني على صديقه المسرحي الجزائري كاتب ياسين، ويحاور الدكتورة يمنى العيد في قضايا النقد والرواية والأدب ويعد بدراسة شاملة عنها، ويعرض أفكارًا صائبة عن الطائفية والقومية والقضية الفلسطينية وقلق الأسلوب. فإن أجهده الحديث ترك اللغة العربية جانبًا وانزاح إلى فرنسية طليقة، تترجم شعر محمود درويش و«مصائب» حركة التحرر في العالم العربي ويقف، واعدًا، باستثناء الحديث مرة قادمة. ينظر إلينا ضاحكًا ويعتذر عن ضيق الوقت ويدعونا لتناول «الفراكة» في بيته، وهي طعام لبناني جبلي، قوامه برغل، كان يحسنه ويفتخر بإتقانه. سألت مهدي مرة: «هل ستشرق الشمس يا رفيق؟» وكانت الماركسية في أفول فأجاب: «النظرية تقول بذلك ولا تكذب».
حين دخلت مكتب مجلة الطريق للمرة الأولى عرّفني نزار مروة، في نهاية اللقاء، على وافد جديد، متميّز الصوت والنحافة، ضامر الملمح كثيف الشعر يدعى: إلياس شاكر أشرف على «الطريق» ذات مرة، وأشرف عليها في طورها الأخير، في مطلع الألفية الثالثة… قال في لقائي الأول معه: «سأعرفك على تحولات بيروت الثقافية»، وسار معي طويلًا في اللقاء الأخير وقال: «سأعرفك على تحولات بيروت التجارية». بقي كما كان، ثابت النحافة والالتزام، طلب مني دراسة عن رئيف خوري، وقال: احتفظت لك في مكتب المجلة بكتابين جديدين عن «رئيف». وأظن أن هذا الإنسان الرقيق المخلص لنحافته وأفكاره هو الذي أشرف على طباعة كتاب رئيف: «ثورة الفتى العربي»، الذي وجّه تحية إلى ثورة فلسطينية قديمة (1936 – 1939م)، اختنق صوتها بين أصوات أخرى. كان هؤلاء جميعًا، من دكروب إلى حسين مروّة ومهدي عامل، يرون في رئيف نموذجًا للفكر الحر وثبات الموقف، سقطت عليه، في الحقبة الستالينية، تهم كثيرة، رجمت رفيقًا للحقيقة.
تظل الذكريات الحالمة عزيزة على قلوب المهزومين. تعبر هذه الكلمات خاطري كلما تذكرت تلك المجلة المنزوعة الغلاف، التي أخذتها من صديق كردي ذابت عظامه في التراب. بعد غياب طويل عن دمشق، حملتني قدماي إلى بوابة الصالحية، باحثًا عن أطياف وصور وحقائق، نظرت حولي طويلًا، بقيت يدي ساكنة في جيبي، ولم أرَ إلا الأرصفة.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | مايو 1, 2019 | سيرة ذاتية

فيصل دراج
كان أهل بيروت يدعون ذلك المكان الضيق «بالفاكهاني»، والفلسطينيون المشدودون إلى الأمل يسمّونه: «مركز القيادة»، والساخرون منهم يلقون سجائرهم في الفضاء ويقولون: «إمبراطورية الفاكهاني». كنا ندخله من جهة تطلّ على البحر «دوّار الكولا»، ونتجه إلى مكتبة «دار الطليعة»، التي افترشت واجهتها مجلة «دراسات عربية»، وكتب نظرية تمجّد التمرد، وترسل تحيات إلى ثورات منتصرة وأخرى «مغدورة». وعلى مسافة قليلة من المكتبة، كان يقوم «مقرّ الاتحاد العام للكتّاب والصحفيين الفسطينيين»، يتردّد عليه مثقفون شباب يتأبطون الأوراق والأفكار، وأدباء عرب انجذبوا إلى شعارات «الإمبراطورية». كان «الزائر»، إن خلّف المكتبة وراءه، يصل إلى مخيم صبرا، بجدرانه الطينية العامرة بالشعارات، وبصور سوداء الأطراف، تحيي شبابًا ذهبوا إلى فلسطين واستقروا في ترابها.
في مقر الاتحاد، وفي ربيع 1975م، قابلت للمرة الأولى الأديب جبرا إبراهيم جبرا، بدعوة من رئيس الاتحاد يحيى يخلف. كان الأديب متوسط القامة، أقرب إلى الطول، بسيط الأناقة، رحب الوسامة، في عينيه لمعان يصرّح بالاختلاف. كنت مرتبكًا محاصرًا بالحرج؛ بسبب دراسة عنوانها: «فلسطيني جبرا بين الوهم والواقع»، نشرتها آنذاك في مجلة «شؤون فلسطينية»، تعاملت مع الروائي بلغة من خشب اختصرها ناقد مغربي بصفة «مشانق الأيديولوجيا».
وقفت منكمشًا مقموع الكلام، متوقعًا جفاءً وتجاهلًا أو عتبًا، غير أن الروائي، الذي ولد في بيت لحم 1920م، فاجأني بضحكة مجلجلة قائلًا: «أنا برجوازي، يا صاحبي، ولا أعرف عن حياة اللاجئين شيئًا؟ خدعتك صوري، ربما، فأنا عشت طفولتي وصباي في «الخُشَش»؛ هل تعرف معنى «الخُشّة»؟ إنها الغرفة الصغيرة البائسة التي تعافها الروح». لم يكن الأديب قد كتب سيرته الذاتية «البئر الأولى»، المستهلة بعائلة فقيرة، تؤويها «خُشّة»، يتلكأ الضوء في الدخول إليها، وتنفذ الشمس إليها على استحياء، ويجتاح المطر سقفها ويجبر قاطنيها على الانزواء في الزوايا. «أنا برجوازي يا صاحبي؟». وضع جبرا الجملة في وجهي، مازجًا بين الضحك والحقيقة.

جبرا إبراهيم جبرا
بعد أن غادرنا المكان وغادرني الإحراج سألت جبرا: «ألا تعتقد أن أبطالك الروائيين بطل واحد، يتشبّهون بك أو ترسمهم على صورتك؟» طلب سيجارة ومشى متمهلًا وأجاب بابتسامة لا تفارق وجهه: «إنني لا أحاكي أبطال رواياتي، هم ربما يقلدونني»، وتابع: «الإنسان في النهاية محصلة حياته: نحن الرومانسيين، وأنا رومانسي، نقلّد آباءنا ويقلدنا أبناؤنا. وعلمتني الحياة أن أكتب ما أنا…» أقنعتني ابتسامته أكثر من كلماته. وسألته: لماذا يلتبس بطلك الروائي بالإنسان الكامل، يسعى إليه الانتصار قبل أن يسعى إلى الانتصار؟ غادرته ابتسامته، وقال:«اسمع، الفلسطيني محاصر في الوطن والمنفى، عدوّه قادر وأنصار عدوّه أكثر قدرة، وعيشه حيثما كان لا تسامح فيه. كيف سيقاتل هذا الفلسطيني، المتروك لأقداره، إن لم يكن إنسانًا يمتد من القدس إلى السماء، وكيف سيرجع إلى فلسطين إن لم يكن مزيجًا، غير مسبوق، من صفات الأنبياء ومزايا الإنسان المتفوق؟». قلت متباطئًا: هذا بطل تجود به الأحلام، لا الواقع، أجاب حاسمًا: لا أعتقد. رأيت في جبرا، الذي سألتقيه مرات في مدينة عمّان، التواضع الأنيق وجمالية التسامح والاحتفاء بمسرات الحياة البسيطة، حال مطر يهمي في الربيع، وأنثى جميلة العينين تلتفت إلى الوراء. لم أستطع أن أقنع نفسي بإيمانيّته المحدثة عن فلسطيني يشبه الأنبياء، وقدس لا تتخلّى عن أهلها، وقرأت روايته «السفينة» عدة مرات.
أذكر منه حديثه الدامع عن «كلية النجاح» في القدس، حيث الأساتذة مرايا لبطله «وليد مسعود»، لا تنقصهم الوسامة والأناقة وسرعة البديهة، ولا الكلام الهادئ الذي يروّض ما يبدو صعبًا. كان معه في الكلية تلميذان، لهما عمره تقريبًا، أحدهما بارع في الرياضيات اسمه إميل حبيبي، سيجذبه الأدب ويشهره «متشائله»، العمل الروائي الساخر الأقرب إلى الفرادة في الأدب العربي الحديث، وثانيهما الدكتور إحسان عباس، الذي أصبح ناقدًا ومؤرخًا مرموقًا للأدب، وأشهرته ترجمته لرواية هنري ميلفل:«موبي ديك».
قوي البنية أقرب إلى قصر
لم ألتقِ الدكتور عباسًا في مقرّ الاتحاد، همس لي أحدهم مرة أنه لم يفز في انتخابات «الاتحاد» الأولى، فأقلع عن المحاولة. كان في الهمس كلام مريض لا يليق بمؤرخ للأدب. زرته في منزله القريب من «حديقة الصنايع». كان آنذاك رئيس قسم اللغة والأدب العربي في الجامعة الأميركية في بيروت. قوي البنية أقرب إلى القصر، أشقر الشعر مضيء الوجه. إنسان ذهبي اللون أقرب إلى الحمرة، كما وصفه صديق محبّ. بشوش له قهقهة كأنها صهيل، تلازمه بديهة سريعة تداخلها سخرية فرحة، لا تؤذي أحدًا.
بدا وهو جالس في غرفة عمله إنسانًا من كتب، باحثًا جلودًا يأنس إلى مخطوطات قديمة، ويسائل كتبًا لم تصل بعد. سألته: لماذا اختار الأدب مهنة ورفيقًا في الحياة؟ قال متمهلًا: «الأدب الحقيقي يغسل الروح، واللغة البليغة تنفذ إلى القلب والعقل. ترجمتُ «موبي ديك»؛ لأنها تتسع لكل هذا وتزيد، وترجمتها أيضًا لأنها رسمت بحذق بالغ ربّانًا عصابيًّا مستبدًا قاد بحّارته إلى الهلاك». تابع: «كانت ترجمة الرواية إجهادًا ممتعًا، أتاح لي أن أقرأ ثراء اللغة العربية في مرآة رواية أميركية، وأن أنظر إلى بلاغة الإنجليزية في مرآة اللغة العربية».
إنجازه الكبير الثاني، قبل ترجمة ميلفل أو بعدها، كان كتابه الجامع: «تاريخ النقد الأدبي عند العرب»، حين سألته عنه ابتسم، وقال: «سأعطيك سرًّا. بعد جهدي البحثي الطويل وجدت أن العرب لا نقد لديهم. بل إن صميم كتابي كشف عن ذلك…». قلت: كيف وأنت العارف بتاريخ الأدب العربي كله؟ أجاب سريعًا: «لم يعرف العرب الفلسفة، أو لم يعترفوا بها. ولا نقد من دون نظر فلسفي معه».

إحسان عباس
كنت أعرف أن كنفاني كان مقرّبًا إليه، فسألته ما مواقع القوة في شخصية غسان ومواطن ضعفه؟ قال بعد أن شرد قليلًا: «قوته في قلقه المسؤول، وكان ضعفه في اندفاعه وراء كل جديد. حين أعطاني «رجال في الشمس»، قبل طباعتها، شعرت بالرضا وقدمت ملاحظات قليلة. رد على ملاحظاتي بصمته وحمل روايته ومضى. عاد بعد أسبوعين بقلق مستريح، وقرأت الرواية من جديد، ولم أجد ما أقوله. رأى غسان في الكتابة، من البداية قضية حياته، وعطفها على قضيته الوطنية، وهجس بأدب يخص الفلسطينيين دون غيرهم، فما عرفوه لم يعرفه غيرهم. كان إنسانًا من أعصاب ونباهة وتعب، ورغبة في بناء أدب يختلف عن المألوف….، هجس بأدبه القادم طويلًا وبحث عن أدوات تصيّره واقعًا…».
أذكر الدكتور إحسان، اليوم، عجوزًا نبيلًا جالسًا في شرفة ضيقة في عمّان، بشوشًا، علا وجهه التعب، يترجم خفقان عينيه ما لا يريد قوله، وقد اطمأن إلى وصف غريب: «أنا جوّال في جغرافيا المعرفة، نظرت هنا وهناك سريعًا، وانتظرت لحظة موائمة لم تأتِ». كان في كلامه تواضع وتعب وزهد صريح، وهو الذي أثرى المكتبة العربية وختم حياته بسيرة ذاتية «غربة الراعي»، يضيء عنوانها روحه الجميلة المتقشفة، تحدث فيها عن «رموز الأمان» في قريته الفلسطينية «عين غزال».
المؤمن بصراع الطبقات
الفلسطيني الثالث: الذي ألتقيته في بيروت: معين بسيسو، الشاعر والمسرحي والإعلامي، المؤمن «بصراع الطبقات» وباقتراب «المدينة الفاضلة». صادفته قرب «اتحاد الكتّاب» في يوم مطير، ألجأني إلى زاوية تعصم من البلل. جاءني صوته خشنًا غزّاويّ اللهجة: «أين أنت يا خال، لا نراك إلا صدفة؟». كان يقف جانبي، واسع الطول، تناثر شعره الغزير على جبهته، زاده معطفه الرمادي الطويل طولًا، رفع شعره المبتل وقال: «بيتي قريب».
أشهره، مبكرًا، كفاحه الوطني في غزة. كان يقود، وهو المنتمي إلى عائلة عريقة، مظاهرات في السابعة عشرة من عمره، يوزّع الهتافات وينشد قصائد تحريضية جمعها، لاحقًا، في ديوانه: «الأشجار تموت واقفة»، استلهم عنوانه من بابلو نيرودا أو ناظم حكمت، أو من هؤلاء الذين «أسسوا القصيدة المقاتلة»، كما كان يقول. ووطّد شهرته بترحال قسري أخذه من غزة إلى القاهرة، حيث عرف «السجن الناصري»، ومن الأخيرة إلى بغداد، فغزة من جديد، والكويت فدمشق فبيروت، وأكثر من سفر إلى موسكو أنهاه بكتاب غريب العنوان: «الاتحاد السوفييتي لي».
تخيلته وقد غسله المطر قامة ـ شجرة أوراقها التحدي والكلمات الغريبة، يقول صارخًا: «إن لم تقلها تَمُتْ، وإن قلتها مُتّ، قُلْها وَمُتْ». بعد الوصول إلى بيته قال ممازحًا: «أنت على مائدتي، والشعراء يستضيفون الإنسانية على موائدهم، تفعل ما أفعل، والشاعر لا يعصي كلامه أحد». كشف عن كرم جاوز حدّه، وعن قهر مكتوم وروح بعيدة من الرضا، تريد عالمًا آخر. مات في لندن، بعد أن غادر بيروت مع غيره في خريف 1982م موتًا غامضًا، ولم يبلغ الستين. تساءلت وأنا أرصد حركاته إن كان غضبه قاده إلى الشعر، أم إن صورة الشاعر في وجدانه توقظ الغضب وحسًّا بالكبرياء. سألته: ما معنى الشاعر عند معين بسيسو، فأجاب: «الشعر نور العالم من دونه تصبح البشرية عمياء»، وأكمل «الشاعر حامل الحقيقة يمقتها الجلّادون والمتكسّبون والعملاء والمتاجرون ببلاغتهم»، «هو صوت الشعب النقي ورفيق المطر وأنيس حقول البرتقال…».

معين بسيسو
بعد أن كسا وجهه رضا طارئ استظهر كلامًا أقرب إلى الشعارات: «إن الشعراء من عائلة واحدة، وإن القتلة من عائلة واحدة»، «ينظر الشاعر إلى القمر وهو يشير إلى الرغيف»، وأكمل: «إن الأرانب لن تكتب الشعر»، كما لو كان الشعر من اختصاص الأسود. كان يحتفي بقصائده الغاضبة ويهجو شعراء يعرف أسماءهم، ويطردهم من عوالم القصيدة إلى حظائر الأرانب والدجاج، ويرفع بيده ديوانه «فلسطين في القلب».
قلت له: بين قصائدك وروايات جبرا تشابه في البداية والنهاية والمنظور: منفى فشقاء فوقوف فاستعداد للعودة إلى الوطن. ردّ بانفعال «ما الخطأ في ذلك، ما دام لنا حكاية واحدة وهدف مشترك ونتقاسم الأمل وتآمر العملاء وأنصاف العملاء وظلم ذوي القربى،… لا مشكلة في تشابه الموضوع، بل في تناوله، أنا مع الكلام الصادر عن العين والأيام القادمة، المؤسس على كتابة مقاتلة»… عليك أن تقرأ قصيدتي الجديدة التي عنوانها: «القصيدة». ألمح إلى قصيدة فريدة، يحسن كتابتها وحده من دون الآخرين ولم تنشر بعد.
أمام مكتبة الطليعة كان يقف «شعراء الرصيف»، المتمردون على العادات و«السلطة»، من بينهم شاعر أشيب الشعر طويل يميل وجهه إلى الشحوب يدعى: علي فودة، قاوم الهجوم الصهيوني صيف 1982م، وأصيب، وقرأ نعيه قبل أن يفارق الحياة ثم أخذه الموت ويده على صحيفة تمجّد الرصيف وترثي «طائرًا» رحل.
على سطح لقاءات الفسطينيين كان يطفو ظلم عابث ينظر حوله ويحدق في الظلام: فلسطيني ولد في الجاعونة وأهله في دمشق يلتقي، سعيدًا، في بيروت، بروائي وسيم وُلد في بيت لحم، ويرجع إلى بغداد، ويزور ناقدًا وُلد في عين غزال ومرّ بالسودان والعراق، وانتقل لاحقًا من بيروت إلى عمان، ويحاور شاعرًا طويل القامة، أضناه الترحال واحتفظ بلهجة غزَّاويّة لا غشَّ فيها، ومات في لندن.