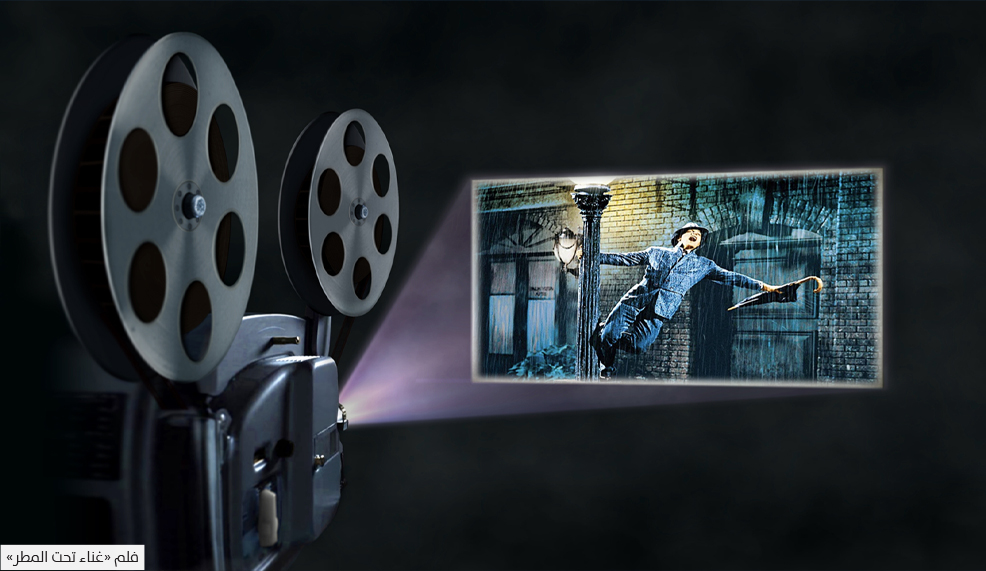فيصل دراج - ناقد فلسطيني | يوليو 1, 2022 | سيرة ذاتية
ما زلت أذكره واقفًا في بقعة شحيحة الضوء يتّقي المطر بمعطف مطري وتمسك يده حقيبة مدرسية، ستبدو امتدادًا ليده أو تبدو يده من دونها مبتورة. يعود ذلك المساء إلى سبعينيات سعيدة من القرن الماضي. وأذكره في وداع أخير متلعثم الكلمات في «مصحة» في مدينته مونستر شاحب العينين مخذول الصوت منكمش القامة. بين اللقاء الأول والوداع الأخير صور وفرح وبوح وأحلام وعشرون عامًا، وأكثر من حوارٍ ولقاءٍ وفراق.
كان المطعم الجامعي، المجاور لجامعة تولوز، يغلق أبوابه في الثامنة، تقف على بابه عجوز أليفة الوجه أنيسة الوجود، تستعجل تلاميذ متباطئين؛ كي لا تفوتهم وجبة المساء. كان مطعم «الكلو»، هكذا يُدعى، يقبل بأرقام مزدوجة: تلميذان أو أربعة على طاولة واحدة، تشرف عليه أربع نساء شاركن في مقاومة الاحتلال النازي، قبل ثلاثين عامًا، يعاملِنَ التلاميذ بأمومة دافئة، ويُقدِّمنَ طعامًا كريم المذاق.
اقترب مني وقال بنبرة مبتلّة: يمكننا تقاسم طاولة أخيرة. على الطاولة مسح نظارة طبيّة، عدستاها دائريتان ضيّقتان، وقال: أنا ألماني اسمي: فيرنرغلنغا وأضاف بابتسامة متلكئة: فيرنر بالألمانية معناه «المحارب». بدا أشقر الشعر أقرب إلى الطول عريض الوجه بفم بارز نظيم الأسنان افترش وجهًا واضح الشحوب، يكمل قامة ناحلة، استقرت في منتصف أنفه ندبة ظاهرة، كأنها أثر لعراك أو صدمة غير متوقعة. حين رفع نظارته أعلن عن عينين حزينتين مسكونتين بزرقة عميقة هادئة، وبحيرة غامضة الأسباب. أعاد نظارته، التي مسحها أكثر من مرة، وقال: عندي منحة دراسية فرنسية وأعدّ دراسة عن: «النقد الأدبي في المنهج البنيوي». كان ينطق الفرنسية بنبرة باريسية خالصة.

رولان بارت
أجبته: أنا من فلسطين وأحضّر دكتوراه عن: «الاغتراب بين ماركس وهيغل»، أسأل عن الإنسان الذي فقد جوهره ويعمل على استعادته وأرى معنى «الجوهر»، في الحالين، غائمًا. صرّح وجه الصديق الألماني بالرضا، وقال: «كنتُ في جامعة مونستر عضوًا في تجمع طلابي يدعم «اتحاد طلبة فلسطين»»، واختصر الأخير في حروفه الأولى U.P.S. أكمل: لم أفهم المشروع الصهيوني إلا على ضوء فلسفة الاستعمار الإنجليزي، الذي يعتقد سادته «أن الكذب بلاغة الأقوياء في الإقناع»، فلا يكذب بطلاقة إلا ذو ظهر متين، و«أن البلاغة قهر الضعيف بالحد الأدنى من السلاح». كانت قوة الصهاينة من قوة البلاغة الإنجليزية، وكان أهل فلسطين عراة من الكذب والبلاغة معًا.
قلتُ: إن مراجعي في دراسة الاغتراب هما ماركس وهيغل، لا موقع فيها لثقافتي العربية إلا إذا رجعت إلى «المتصوفة»، الذين يغسلون قلوبهم ويتطلّعون إلى الله، والدليل في دراستك أوربي الهيئة والأصول، صوته الأعلى: رولان بارت، الذي بدأ وانتهى ماركسيًّا منقوصًا. جاء صوته هادئًا: نرمّم دائمًا نقصًا بنقص ترميمه أكثر صعوبة. النقص الإنساني متفاوت الأزمنة، قال: فمقامات الحريري ترجمت إلى الألمانية من زمن بعيد، وقرأ ماركس، أو إنجلس، سيرة «عنترة العبسي» العبد المقاتل الحالم بالحرية، وتعرّف «غوته» على الآداب الشرقية وكتب «ديوانه الشرقي»، وعرّفتني القضية الفلسطينية على مأساة الحقيقة، التي تولد بين البشر وتنتهي إلى المنفى.
حياة بلا مذاق
حين سألته عن فلاسفة الاغتراب الذين يكتبون بالألمانية اليوم أجاب ساخرًا: لوكاتش هنغاري يكتب بالألمانية بأسلوب متجهم، اختصر حياته في العمل واستبقى للحياة فتاتًا بلا مذاق. حَلَّلَ الاغتراب في كتابه «التاريخ والوعي الطبقي». وهناك إرنست بلوخ له رأس كجذع شجرة سنديان وصوت زائر كالأسد، وتأمل الاغتراب في كتابه ميراث من زمننا. أما إرنست فيشر، وهو نمساوي، أقرب في شكله إلى ضفدع مبحوح النقيق. تعرفه طبعًا في كتابه «ضرورة الفن». ختم كلامه بإشارةٍ إلى دراسته «تاريخ النقد الأدبي الألماني»، بمنحة من الحكومة الألمانية، يرى فيها الأدب مزهرًا والفلسفة معاناة قاحلة، ونظر إليَّ معتذرًا. الحياة ملوّنة، كان يقول، تصرّح بجمال يخطئه محترفو الكتابة ويستشهد طويلًا بفالتر بنيامين منتهيًا إلى مفارقة لم يقصدها. مارس بنيامين جمالية المساءلة وعاش تعيسًا.
حمل بنيامين في مساره مفارقات متعددة، لم يسبح مع التيار وما أفلح في السباحة ضده. عشق مرتين وتزوّج مرتين وطلق مرتين وندب حظه مرات. اجتهد في أطروحة دكتوراه عن الدراما الألمانية، نشرت بعد موته باحتفاء كبير. رفضتها في حياته جامعات ثلاث حتى عاف المرافعة عنها واستجار بالمكتبات، مكتفيًا بحياة متقشفة، «بائسة»، كما قال غير مرة. أجبرته النازية على الانتقال من برلين إلى باريس، ولم يرتح إليه الفرنسيون وزجّوه في «معسكر للمهاجرين الألمان»، وانتقل مجددًا منها إلى تولوز. ولأنه كان يرى الشر في كل مكان تابع إلى مارسيليا، حيث التقى سريعًا ابنه الوحيد ونسي توديعه، مسرعًا إلى الحدود الإسبانية، حيث لم يسمح له القائمون على شؤونها بالعبور. وصل إلى «بورت- بو» البلدة الإسبانية وقد نزف جهده وأمله وأغلق أبواب الحياة، فابتلع يأسًا قاتلًا، وانتحر في السادس والعشرين من سبتمبر عام 1940م، وله من العمر ثمانية وأربعون عامًا. دُفن بعد يومين في مقبرة كاثوليكية، استؤجرت لمدة خمس سنوات، ولم يعثر على رفاته أحد. كان موته تعليقًا شاملًا على حياة تبدأ بالحلم وتنتهي بعذاب يقترب من الجحيم.
مخطوطات بنيامين الأخيرة
تذكر ليزا فتكو، في مذكرات نشرت عام 1980م، أن حقيبة «بنيامين الأخيرة» كانت تحتوي على أوراق ومخطوطات لم يعثر عليها أحد. وتذكر صديقته الآنسة «غورلاند»، التي اقتفت مساره الحزين، أن ما تركه وراءه من أوراق ومخطوطات حُرِقَت كي لا يضع «الجوستابو» يده عليها. ويعرف دارسوه أن دار النشر الألمانية «تسور كامب» أصدرت أعماله عام 1992م في أربعة عشر مجلدًا، أنجزها فقيرًا شحيح الاستقرار. واعترفت الشرطة الإسبانية أنها عثرت في محفظته على قدر قليل من المال غطى «تكاليف قبر مؤقت» في منطقة غريبة لا يعرفه فيها أحد.

جورج لوكاتش
لازمته مفارقاته المتجهمة حتى النهاية، ولفظ أنفاسه في بقعة نائية، وهو الإنسان المديني وعاشق المدن، التي كرّس لها نصوصه الأكثر جمالًا وإدهاشًا، بدءًا بـ«صور الأفكار»، وصولًا إلى أخرى عن: «برلين، موسكو، مارسيليا، فايمار، وبداهة باريس» العاصمة الثقافية، التجارية، والسياسية للقرن التاسع عشر…»، التي خصصّ لها أعماله الفلسفية ابتداءً من 1928م حتى اللحظة الأخيرة من حياته. رأى بنيامين في المدن تكثيفًا كاملًا للحياة في وجوهها المتعارضة، إذ الشاعر يحدّق في الجموع، والرسام يلتقط صورًا متحركة، وللبَطَر مكانه ولجامع الأسمال موقعه أيضًا، وفي جوار النهر مكتبات متعاقبة، والمخازن محتشدة بسلع «تغمز» الناظرين إليها. كما لو كانت المدينة تُؤَنْسِنُ الأشياء وتُحوِّل البشر إلى بضائع. ولعل علاقات المدينة، القائمة على البيع والشراء، هي التي اقترحت على بنيامين دراسته: «العمل الفني في زمن الاستنساخ»، حيث «الصور المفردة» تتكاثر بأدوات تقنية.
«على العقل أن يكون مفيدًا، أن يعقل الحاضر والماضي وما سيأتي». هكذا قال بنيامين، دون أن يدري أنّ موظفًا إسبانيًّا فاسدًا يبحث عن «رشوة» سيدفعه إلى الانتحار، ويقضي على عقله أن يكفَّ عن التساؤل.
فالتر بنيامين عليل النجم معتّل الأقدار، طارده مآلٌ مفترس كمخبرٍ كاسر يتلهّى بتكسير أصابع الأطفال وإلقاء المتفجرات على الحدائق والمكتبات. هجس طويلًا بإنقاذ التاريخ من الهلاك وأهلكه التاريخ المستبد عندما أراد. ربما كان القلق الذي يقطر دمًا هو ما شدّ إليه صديقي الألماني الذي اقتلعه مرض السرطان من الحياة وهو في الرابعة والأربعين.
آثار صديق
كان فيرنر يحتفي بجديده من لباس وطعام وآمال ويقول بالألمانية: (دي موتر): الأم التي أرسلت إليه ما احتفى به. هذه الأم، التي جاءت من برلين إلى مونستر، عند وفاته، حملت قمصانه وورثت كلبه «يوكو» وعادت إلى برلين. انفصلت أمه عن أبيه وهو في الخامسة من عمره، آثر الأب البقاء في برلين الشرقية وتعاليم ماركس، واختارت الأم برلين الغربية واصطحبت معها ابنها النجيب. كان الابن يهمس باسم الأب همسًا يخالطه العتاب، ويرفع صوته باسم الأم كأنه نشيد، وينطق باسمه «المحارب» ناظرًا للسماء.
عشق فيرنر الحياة والصداقات وتنوّع المعرفة وحلم بمستقبل أكاديمي «متأخر»، متين الأركان. فبعد الطالب «الممنوح» ودراسة النقد الألماني، درس النقد الفرنسي بمنحة جديدة، استكمله ببحث عن «دانتي»، بمنحة إيطالية ثالثة قادته إلى أخرى في لندن مع موضوع جديد: «صور تشكّل الرواية في العالم الثالث». لم يشأ منحة «خامسة»، قصد صديقه «روجيه» في الكاميرون ودرس ثقافة بلده، وجاء من إفريقيا إلى دمشق مع زوجته الألمانية «كريستيانا»، أكبر منه عمرًا، اعتبرها السعادة المنشودة في طورها الأعلى، بعد أن طلق زوجته الإنجليزية -الشابة التي فتنه جسدها- وارتاح إلى جملة متفائلة: «الحب الحقيقي يعيد بناء الأزمنة».
حين بدأ التدريس في «جامعة بايرويت» الألمانية كان قد أكمل الحادية والأربعين، واستكمل «معرفة أدبية ضرورية»، كما قال. بعد عامين من التدريس غزاه «المرض القاتل» وهو لاعب الكرة المحترف، العدّاء الغطّاس متسلّق المرتفعات، المقتصد في الطعام والشراب والكاره التدخين والسهر…، القائل: «إن جمال الحياة عصيّ على التعريف»، وإن دور المثقف إقلاق «الأرواح الميتة».

شارل بودلير
خلّف بنيامين وراءه مخطوطات ضائعة وأحلامًا محترقة ودراسات تبحث عن نهاية. وأنجز دراسته الشهيرة: شارل بودلير «شاعر غنائي في ذروة الرأسمالية»، أدرج فيها تصوّره عن «الإنسان المتسكع»، الذي هو إنسان غُفْل ذاب في الجموع، حال السلعة التي يحولها السوق إلى متسكع آخر. وقصد إلى عمل واسع عن باريس قوامه «استشهادات» مأخوذة من دراسات مختلفة، أراد توليد قوله مما قاله الآخرون وترك وراءه عملًا واسعًا غير مكتمل عنوانه: «الممرات». استغرقته شوارع وحواري ومكتبات مدينة الحداثة، وعطف عليها حداثة «بودلير»، وقال: «باريس قاعة للقراءة هائلة، كأنها مكتبة يخترقها نهر السين».
كان قد أسرَّ إلى صديق أيام الشباب: «أريد أن أصبح الناقد الألماني الأكثر أهمية والأعلى مقامًا». أخذ حلمه بجديّة، وسقط عليه مكر الوجود، حاصره ومزّق دروبه وتركه منتحرًا في بلدة مهجورة. «ها أنا ألفظ أنفاسي الأخيرة بعد أن غدوت عاجزًا عن المسير». كلمات في رسالة وصلت متأخرة.
الصديق الألماني، قبل رحيله بعشر سنوات، كان يضيق بذاته، يوبّخها قائلًا: «على الذين يريدون أن يتركوا آثارًا أن ينجزوا ما يدل عليهم بنظرية تحمل اسمهم. أراد بناء نظرية الكتابة بعامة، وفي الأدب والنقد الأدبي خاصة. دار طويلًا، وسهر كثيرًا، وبحث عن نظرية في الكتابة مؤكدًا أن الكتابة ضرورة للأرشيف الرسمي الذي جعل الكتابة ذاكرة سلطوية يسجل ما قاله كل مواطنٍ وما سيقوله. على خلاف القول الشفهي القابل للتأويل، فهو كلام حر لا تقبل به «الأقبية المغلقة» وينفتح على المستقبل.
ترك فيرنر وراءه مكتبة بلغات متعددة، وملاحظات على صفحات الكتب كانت واعدة. رجع بعض كتبه إلى أمّه، قارئة الروايات، واختار والده بعض كتب ماركس وبريشت، أودعها في حقيبة وخرج حزينًا، وحمل كاتب هذه السطور كتابًا ثقيلًا صفحاته من أثير عنوانه: تأسي الصديق الحي على الأصدقاء الراحلين.
استهل المخرج الياباني أكيرا كوروساوا فلمه «دورسو أوزالا»، وقد شاهدناه أنا وفيرنر معًا، بإنسان روسي يفتش عن آثار صديق. «هنا كان قبره» قال، «مسوّرًا بالأشجار»، وكانت الأشجار عاليةٌ خضراء… ردّ عليه عابر طريق: الأشجار التي كانت هنا احترقت، ورمادها توازعته الريح ونشرته على الجهات الأربع.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | مايو 1, 2022 | سيرة ذاتية
هذه مدينة يُلحقها جمالها بالسماء، نَضِرة الوجه نبيلة المحتوى. قال جملته المطمئنة ومضى، وختم اللقاء بقهقهة كأنها النشيد. كان صديقًا في أيام الشباب، تقاسمت معه الاجتهاد والأحلام وكتبًا حنونة الملمس تهجو الرأسمالية وتمدح الاشتراكية، تبدأ بكتاب أوستروفسكي: «والفولاذ سقيناه»، الذي أصمته الزمن، ولا تنتهي «بالعقب الحديدية» لجاك لندن، وتخلق من الفولاذ والحديد انتصارات قادمة. أذكر اليوم من تلك المدينة «دانوبها الأزرق»، ولغة قريبة إلى التركية لا تغوي بتعلمها، وصديقًا عراقيًّا متقشف المعيش منضبط الأناقة، وأسماء هنغارية يستثقلها اللسان، ومفارقة تقول: الذي يأنس كثيرًا إلى «بداية» الطريق تداهمه الوحشة بعد سير قصير.
كنت أتأمل النهر المتجمّد شتاء وأحدّث نفسي عن الماء المعتقل، الذي يحرّره الربيع ويعود الشتاء ليعتقله من جديد، وفي الربيع كنت ألاحق كتلًا جليدية تتدافع فوق سطح النهر، ذاهبة إلى حيث لا أعرف كأنها أحزان مهاجرة، وأتذكر معلمي القديم، الذي كان يَظْلَع في مشيته ويسألنا فرحًا: متى نحمل الماء في الغربال؟ وأشفق على طيبة المعلم وبراءة السؤال.
كان صديقي العراقي يفاجئني، شتاءً، ساعة الغروب ويسأل: هل ما زلتَ تحاور الماء المعتقل وأجيبه: أنتظر تحرّره، فليس بين دورة الفصول وسجون أنصار الظلام علاقة. يُكمل كلامه بصوت أسيان شعرًا: «هي الأمور كما شاهدتها دُوَلٌ..»، يترحّم على الشاعر الأندلسي ابن زيدون ويتابع: كنا نرفض، شبابًا، النظام الملكي، ونتضاحك مساء على ضفة دجلة. ونستعجل الثورة وافتقدنا، في زمن الكهولة، دجلة وعبث بنا المنفى، وأدركنا، في زمن الشيخوخة، أن عراقنا رحل ونحن راحلون إلى قبور مجهولة.
كان الصديق الراحل علي الشوك، الذي مات في لندن، يجمع بين العلم والأدب، أوغل في الدراسات اللغوية وعلم الأساطير، ونشر رواية «السراب الأحمر» 2007م أشبه بالسيرة الذاتية. التقيته في بودابست، لمدة عامين، بعد رحيلي عن بيروت في صيف 1982م، وحصولي على منحة من أكاديمية العلوم لدراسة «مثقف عالم الثالث». اعترض «علي» على العنوان ضاحكًا وقال: «مثقف عالم لا يكفّ عن التقهقر». كان ثالثًا وهو اليوم رابع ومستقبله خامس حافي القدمين.
قال الصديق العراقي، الذي عرف بودابست قبلي وبقي فيها بعدي: يمكن أن تنخفض درجة الحرارة في الأيام القادمة إلى ثلاثين تحت الصفر، وفي بودابست «يا معوّد» -مؤكدًا عراقيته- بيت الناقد الماركسي الشهير جورجي لوكاتش، يمكن أن تزوره. ويعود فيمزج العربية بالإنجليزية ويكمل: المدينة قسمان بودا وبست، أحدهما أكثر حداثة من الآخر، ويمكن أن تذهب إلى مكتبة الأكاديمية أو أن ترتاح في «جزيرة مارغريت»، الأشبه بغطاء أخضر مكسو بالهدوء، واسم الشارع الذي تقطنه «تشا لاغونية أوتسا»، أي: شارع العصافير…. وفي بودابست «يا معوّد» متحف الأفلام، سترى فيه ما تريد، وتوقف ليقول: يعرض الآن فلم «شارع الغروب»، فلم لطيف شاهدته by the way حين كنت أدرس الرياضيات في جامعة بيركلي، نهاية الأربعينيات، يلعب فيه وليم هولدن الممثل الوسيم الغريب الأطوار، مات في شقته السرية، ولم يكتشف موته أحد إلا بعد أيام.
كنتُ أقصد «متحف الأفلام» مشيًا، لم يكن بعيدًا من «شاعر العصافير»، تستغرقني فيه ملصقات الأفلام القديمة، كان صديقي يقول «الأشرطة»، تتراصف تباعًا، باعثة في الذاكرة أزمنة، أكثرها دفئًا «زمن المراهقة» الذي يقنع المراهق أن حكايات «الأشرطة» تتحقق في أيام مشمسة قادمة. أذكر ملصق فِلْم «جسر واترلو»، لروبرت تايلور وفيفيان لي، وأقوم بتبديل نهايةٍ تباعد بين العشاق، وملصق فِلْم «كاري» وجملة لورانس أوليفييه الموجعة: «النفاذ إلى العشق الحقيقي يجعل عذاب العاشقين تجربة سماوية جديرة بالسجود».
قاعة واسعة مغمورة بالضوء
لم تكن مكتبة الأكاديمية بعيدة من «سكني»، أقطع جسرًا فوق نهر الدانوب فأكون أمام بناء له أبهة، وقاعة القراءة واسعة مغمورة بالضوء تجلس في مدخلها سيدة لطيفة سميكة النظارة الطبية، تختلف إلى غرفة المدخنين وتخرج منها مع ابتسامة معتذرة. في مواجهتها قسم صغير خاص بالكتب العربية، قرابة ثلاثين وأكثر من قاموس، ودعوة هامسة إلى تصفحها. من بينها «أيام طه حسين» التي وصفت تلميذًا يرعبه اجتياز الطريق، و«حصاد الهشيم» لإبراهيم عبدالقادر المازني، الذي أوجعه خروج الفلسطينيين من ديارهم، و«الشراع والعاصفة» لحنا مينه، إهداء منه بلا صورة متوجه «بوقفة عز» وسيجارة لا تنطفئ، و«سارة» العقاد، روايته الوحيدة، هجا مكر النساء وأثنى على ذكورته المتفلسفة.
شكرته في داخلي لأنه وضع في خمسينيات القرن الماضي مقدمة لكتاب «بروتوكولات حكماء صهيون» في طبعة تونسية،… كنت أشعر وأنا أتصفح الكتب العربية القليلة بأنفاس آخرين ألقوا عليها السلام ورحلوا، وأن الكتب تقاسمني غربتي وأقاسمها ألفة متبادلة وأشعر بالرضا… على مقربة من السيدة السميكة النظارة طاولة زجاجية، افترشت سطحها كتب لجورج لوكاتش، بالفرنسية والإنجليزية ولغات أخرى، مختلفة العناوين، تتراصف أنيقة الأغلفة، يتوسطّها: «تحطيم العقل»، في جزأين غلافهما أزرق كامد، وأكثر من طبعة لكتابه الرومانسي المعادي للرأسمالية: «نظرية الرواية»، وكتاب من شبابه الأول «الروح والأشكال» الذي قرأ بعضٌ فيه فلسفة لوكاتش الجمالية.

علي الشوك
السيدة التي تعتذر إلى نفسها إنْ لم تدخن، وتعتذر، ابتسامًا، من الآخرين إذا دخنت، تعودت على ما أقوم به: المرور على الكتب العربية عند الدخول، وإلقاء نظرة على كتب لوكاتش لحظة الخروج. قالت لي ذات صباح أقل برودة من غيره: لماذا لا تزور بيت الناقد الكبير؟ أعطتني العنوان مع جمل مشجعة. تذكرت بيت كارل ماركس في لندن، الذي زرته في اليوم الثاني لوصولي في منطقة كأنها مهجورة، أمامه تمثال كُسِر الأنف فيه وأعيد إلى مكانه على عجل، فبدا مهجورًا ومهملًا. لا يزال على حاله ولم يلحق بفكر ماركس الإهمال. فقد تسقط التماثيل ولا تسقط الأفكار الصحيحة، التي لا تحتاج إلى تماثيل.
موائد متلاصقة في غرفة واسعة، ولا أقول قاعة، عليها كتب لوكاتش في ترجماتها المختلفة في طبعات قديمة وحديثة وأغلفة رسائل من أسماء شهيرة وأوراق كتبها بالهنغارية أو الألمانية، وبعض الصور، وصفحات من كتاب لم يتح له المرض أن يكمله ذكرتني بقوله: «على الإنسان أن يغسل ملابسه الداخلية بيديه، وألا يدع سيجاره ينطفئ، وألا يبدأ بعمل إلا وأنهاه».
بدت الغرفة الواسعة باردة، لا أصداء فيها ولا أطياف، رقدت فيها كتب متباينة اللغات أشبه بأكوام من حبر وورق، وهدوء منضبط الأطراف ولا زوار وثلاث نساء، كأنهن «واحدة» تكوّمن قرب نافذة أمامهن دفتر وقلم وحيد. اقتصدن في الكلام ثم أفرجت أفواههن عن ابتسامة أمام زائر يسأل بالفرنسية وزادت الابتسامة اتساعًا بعد عطف اللغة على جامعة فرنسية. تراجعت الابتسامة حين عَرَفْنَ المكان الذي جاء منه الزائر، الذي هو أنا، ومحت إجابات تالية الابتسامة كما لو كانت «اللغة المتحضّرة» لا تشفع لإنسان جاء من بلاد «البداوة»….
آلة من كلمات
واجهتُ سيدة النظارة، في اليوم التالي، بصمت متجهم فأجابت: وقعتَ يا سيدي على حزبيات لا على شيوعيات. أَصلَحَتِ استغرابي بإيضاح طريف: كان الرفيق بريشت، أظنك تعرفه، يفصل بين الحزبي والشيوعي؛ إذ الأول آلة من كلمات يثني على ما يعرفه وما لا يعرفه، وينفق الثناء على مشترياته اليومية، وكلما أوغل في الثناء الحزبي تنوعت مشترياته، دائم الحزبية وتسلق الكلام، بينما الثاني يدرك «صعوبات الحقيقة» كلما اقترب من الحزب ابتعد الحزب منه وابتعد بدوره من حزبه المتخيل. قالت: ربما السيدات الثلاث من جماعة «آغنش هيلر»، تلميذة لوكاتش «السابقة» التي أتقنت في السنوات الأخيرة السياحة الفكرية «الديمقراطية». أكملتُ: الحزبيون يهدمون ما قمنا ببنائه ويدفعوننا إلى «تقاعد مبكّر».
قابلني عالم الاجتماع الشهير إمري مارتون، الذي تقاعد مبكرًا، وبين يديه طفل غامق السمرة، ابتسم وقال: «ابن ابنتي المتزوجة من طبيب إفريقي». أكمل بفرنسية جميلة النطق: ما أخبار أنور عبدالملك، هل عاد من اليابان؟ قطع معابثته: كتابه «الديالكتيك الاجتماعي» عمل نظري لم يقابل بما هو جدير به من اهتمام. سوّى من جلسته واستأنف لهجة ساخرة: نظامنا الاشتراكي صحح أفكار ماركس قليلًا: فبدلًا من دكتاتورية الطبقة العاملة جاء بدكتاتورية على الطبقة العاملة، ووسّع نظرية «فائض القيمة» إلى نظرية «استباحة القيمة»، «والمثقف ضمير الشعب»، بلغة غرامشي، أصبح عندنا ضمير الصاعدين إلى مواقع السلطة، يختصرون فكر ماركس في جمل جاهزة منقطعة عن المعيش اليومي. تابع بعد توقف: يبدأ المجتمع بالانحلال حين يعامله المستفيدون منه بكراهية جاهلة. هذا لا يعني أنني متشائم فهناك، كما ترى، براءة الأطفال، والتضامن بين إنسانين من بلدين مختلفين، وفي هنغاريا كثير من النساء الجميلات اللواتي لا تتوقف «الدراسات النظرية» أمام شعورهن السوداء وعيونهن الخضراء….
قال وهو يودعني، رافعًا يد الطفل الأسمر: نصيحة لك: بلادكم فاتها قطار التاريخ، فلا ترهق روحك بأمور عقيمة المردود. تأملت، لاحقًا، جملة «مارتون» عن المجتمعات التي يعاملها المستفيدون منها بكراهية، وسألت: متى تصبح المجتمعات وطنًا، لماذا يستبيح إنسان أرضًا أعطته قيمة وألقابًا وثروة وهل هو صمت الأرض أم تسفّل الذي يقتلعون أشجارها؟
ترددت في بودابست على «مطاعم العمّال» الجيدة المستوى الزهيدة الأسعار، ومشافٍ مجانية تعاين جهات المريض الأربع، ومترو ودور للسينما وكتب زهيدة الأثمان وترددت على مسامعي أشواق هنغارية كثيرة إلى «سلع جميلة»، أكانت وهمية أم حقيقية. وسألت: هل هو طمع البشر أم فقدان النظام لمصداقيته أمام الناس؟ أم إنه الاهتمام السلطوي بالأشياء وعدم اعترافه بالبشر؟
ولعل عدم الاعتراف الذي يدع المواطنين مع أسئلتهم المخنوقة هو الذي يجعل من علبة البيبسي كولا وسامًا، يتباهى به المتفوقون، ويحشر البشر في صفوف طويلة لشراء «هامبرغر» من مكان صغير في زقاق ضيق سيئ الرائحة، ويحوّل الكلام باللغة الإنجليزية إلى سلعة ناعمة الملمس أو هدية يلاحقها الشباب والشابات، ويضمن صحة الكلام من حيث جاء.
لم يكن الصديق علي الشوك يفاجأ بشيء، احتفظ بصور عراقه القديم وعدّ «المجتمع الاشتراكي» حلمًا مؤجّلًا، بعيد الوصول. وكان الشاعر مريد البرغوثي، الذي عاش سنوات طويلة في «حي الزهور»، ينصرف إلى شعره ويردّد ضاحكًا: «سأظل صغيرًا وجميلًا»، ويُفْرِج عما كتب في شتاء بودابست حين تحضر زوجته رضوى عاشور صيفًا مع ابنها الموهوب: تميم. التقينا مرة في بيت مريد مع رسّام الكاريكاتير ناجي العلي الفلسطيني النقي الناصع في نقائه، كان ذاهبًا إلى مصرعه في لندن، كان اللقاء به وداعًا…
أذكر اليوم من بودابست أحلامي وأنا ذاهب إليها، وألوان الأحلام من دورة الفصول، وغرفة في «شارع العصافير» يحطّ على نافذتها حمام لا يخلف الميعاد، وطفلًا أسمر اللون يحاور عالم اجتماع شهير، وسيدة قرأت بريشت شغوفه بالتدخين والدفاع عن القيم، ونهرًا يفرج عن مائه في فصل الربيع، وبيت فيلسوف تعلمت منه وتمنيت لو أني لم أزر بيته، وقطع جليد يحملها «الدانوب» كأنها أحلام ذاهبة إلى مصب مجهول.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | مارس 1, 2022 | بورتريه
من الناس مَن يرحلون وتظل أصواتهم معنا. لها أصداء محملة بالصور والذكريات، إن كانوا أصدقاء، لمدة تطول أو تقصر، ومن هؤلاء: جابر عصفور. ولكل صديق كان معنا ورحل مدخل واضح العبارة، يقودنا إلى عالميه الداخلي والخارجي، كأن نذكر ابتسامته وطريقة كلامه وصورته وهو يصرخ بآخرين أو يُلقي عليهم برقة تحية الصباح. لم يكن جابر من هؤلاء، كان مفردًا بصيغة الجمع، تتزاحم في شخصه عوالم مختلفة: الأستاذ الجامعي، رئيس تحرير مجلة ثقافية مرموقة، صاحب القلم الموزع على صحف وكتب متعددة، المترجم المشغول بقضايا أدبية راهنة، يحاور زمانه وقضاياه وهو الليبرالي الكاره للتعصّب، المسؤول الثقافي الرسمي الرفيع المقام، وزير الثقافة الذي يخاصمه التوقيت السليم، الصوت الثقافي الشهير النافذ تتساقط عليه الجوائز ويحاط بأكثر من تكريم، وينظر إليه كثيرون بحسد لا اقتصاد فيه….
كان جابر متعددًا في أصواته ونفوذه وصوره الإعلامية…. والمتعدد يختصم حوله الآخرون، يُرضي بعضًا ويثير سخط بعض آخر، والمتعدد يدفع إلى أكثر من تأويل ومقارنة، يوقظ التجريح أو الرضا، والمثقف المتعدد تتوزّع عليه أكثر من صفة، أكثرها صدقًا وتهذيبًا: المثقف الإشكالي، أو الخلافي، المحاصر بنقد مشروع وباتهامات تنقصها النزاهة…
آثار واضحة القسمات
بعض المثقفين يحمل اسمًا يتلوه فراغ، وبعض مثل جابر عصفور، له آثار واضحة القسمات، كأن يكون إداريًّا واسع الفاعلية، يجمع المثقفين العرب ويقترح «جائزة القاهرة للرواية العربية». ويحقق مشروعًا طموحًا «للترجمة»، أو يختصم مع مراجع دينية نافذة ويُدرج اسمه بين «ضالين» جديرين بالعقاب، ويتعهّد بالرعاية مجلة أدبية تعمّر طويلًا تدعى: فصول. بدأ «ناقدًا أدبيًّا» وصار علمًا ثقافيًّا واسع الانتشار، يعرفه العاملون في النقد، ويتعرّف الإنسان العادي إلى صورته في الأجهزة الإعلامية. كان جابر متعددًا له آثاره، عرفَت جامعة القاهرة محاضراته وعرفت مقالاتِهِ جريدةُ الأهرام وصُحُفٌ ومجلات عربية عديدة، وحاضر في العواصم العربية جميعًا، أو كاد، وفي الجامعات الغربية، وبينه وبين النقاد، أعربًا كانوا أو غير عرب، أواصر متينة… أسهم في التعريف بالثقافة التنويرية المصرية وانتسب إلى طه حسين ويحيى حقي وسهير القلماوي ونصر حامد أبو زيد ومحمد مندور، وأضاء الشعر المصري الحديث وأنجز أكثر من دراسة وازنة….
 التقيته للمرة الأولى في مؤتمر، أشرف عليه، عن: طه حسين عام 1989م. كان موزعًا على أكثر من حوار ولقاء ومكان، ينظم في حضوره وغيابه «المحاضرات» وما يحتاج إليه المؤتمرون، ويكرّم الحاضرين بكياسة رسمية و«بلطف شعبي»، ويحجب إرهاقًا يستبد به بين حين وآخر.
التقيته للمرة الأولى في مؤتمر، أشرف عليه، عن: طه حسين عام 1989م. كان موزعًا على أكثر من حوار ولقاء ومكان، ينظم في حضوره وغيابه «المحاضرات» وما يحتاج إليه المؤتمرون، ويكرّم الحاضرين بكياسة رسمية و«بلطف شعبي»، ويحجب إرهاقًا يستبد به بين حين وآخر.
قالت لي آنذاك الراحلة المصرية رضوى عاشور: «يتعَب أكثر من اللازم وعنده مرض القلب»، وقال الراحل سيد البحراوي: «يعمل مع غيره ويوزّع المسؤوليات ويتابع العمل كما لو كان وحيدًا»، وقال الراحل نصر حامد أبو زيد: «الصديق جابر ينجز عمله وعملنا وعمل الذين يعملون معه بإخلاص…». كان ذلك قبل «تكفير» أبي زيد وذهابه إلى المنفى، وقبل أن يحكي لي، في ركن من دمشق، بشجن يطول، عن صداقة طويلة مع جابر.
كان جابر ينظم ويتكلم ويصغي ويساوي بين الحضور، أكان المتحدث يوسف إدريس الذي بدا في مؤتمر مفرط الأناقة، أو أنور عبدالملك الذي اكتفى بتعليقات مفيدة، أو أستاذًا جامعيًّا يفرط في الكلام ويطلب منه جابر، حازمًا، أن يتوقف عن رغاء لا نفع منه.
كنتُ قد تواصلت معه قبل اللقاء به، إذ اقترحنا عليه، سعد الله ونوس وعبدالرحمن منيف وأنا، أن يكون معنا في هيئة تحرير الكتاب الثقافي الدوري «قضايا وشهادات»، ووافق بلا تردد. كان اللقاء في المؤتمر الخاص بطه حسين مناسبة ليشرح منظوره للعمل ويقترح «برنامجًا تصاعديًّا»، كما قال، يجمع بين موضوعات «الحداثة العربية» وحداثة الفكر الغربي، وعودة محسوبة إلى «التراث»، وأكد دور الترجمة مستشهدًا بطه حسين. رسم ما دعاه «سياسة ثقافية متوازنة»، دفعه حسّه العملي إلى الابتعاد من «أحلام المثقفين»، وغادرنا بعد «العدد الأول».
الشعبي والوطني والبيروقراطي
أتاح لي لقائي الأول مع الدكتور جابر عصفور التعرّف إلى جوانب من شخصيته المركبة المتعددة الأبعاد. اصطحبني إلى مطعم على النيل «سي هورس» قائلًا بشيء من السخرية: «هذا مكان يرضي الرومانسيين». لم يبدُ رومانسيًّا، ولم يكن فيه ما يمت إليهم بصِلة، بدا مصريًّا عفويًّا يعشق الحياة ويتبسط في الكلام مع البسطاء. وحين أعادني إلى «الفندق» مساءً كشف عن «وجه فلاحي كريم»، إذ اشترى ما أحتاجه وما لا أحتاجه مرددًا «ما تنساش أننا إخوات». أما في المساء، وكما سيفعل في مرات لاحقة، فأخذني إلى «الحسين والسيدة زينب»، بصحبة ابنته الوحيدة، التي سيبكيها طويلًا إثر مصادفة عاثرة، وصديقة عمره الدكتورة هالة فؤاد. في منطقة «خان الخليلي» تنفس «الروح الشعبية» بلا اقتصاد، مازحًا منطلقًا عفوي الحركات، بعيدًا من «موظف بيروقراطي» يسوس «موظفيه» بشدة يبرّرها «بضرورة إنجاز العمل»، بحرص وبلا نقصان.
من اللقاء الأول إلى اللقاء الأخير، الذي كان في القاهرة قبل ثلاثة أعوام، تقريبًا، استقرت في حافظتي شخصية مركبة، تحتفي بالمتاح وتنظر إلى ما يجب أن يكون، امتزج فيها، بأقساط مختلفة، الشعبي والوطني والبيروقراطي وفتنة بالسلطة، لا فرق إن كانت ثقافة تفضي إلى سلطة أو سلطة خالصة تثني عليها الثقافة وتداعبها بصوت هامس أو بكلام جهير.
 ولعل الافتتان بالسلطة، سواء احتاج إلى تعريف أو بقي خارج التعريف، هو الذي أقام فصلًا لا يقبل التجسير بين ما كانه طه حسين وما أراد أن يكونه جابر عصفور، وهو الذي كان يزيّن مكتبه في المجلس الأعلى للثقافة بصورة كبيرة «للسيد العميد». فقد رأى حسين في سلطة الثقافة مرجعًا لفرض الثقافة على السلطة، بينما آثر جابر عصفور أن يطرق، بنعومة، أبواب السلطة بأصابع مدثرة بقماش ثقافي. والفرق بينهما قائم في «السياسة»، أو «قضايا الشأن العام»، كما كان يفضل جابر أن يقول، فالأول كان يعاين السياسة في قضايا الحياة جميعًا وينقد ويهاجم ويشتبك، وكان الثاني يتلمّس السلطة في قضايا الحياة جميعًا، فينقد ويهاجم ولا يضير السلطة في شيء، إن لم يعتقد أنه يقف معها، ويكتب مدافعًا عنها، حال حديثه، في المؤتمر الأخير للرواية العربية في القاهرة عن «الإرهاب»، واقتراحه أن يكون: «الرواية والإرهاب» موضوع المؤتمر القادم، دون أن يشير إلى معنى الرواية، التي تبدأ بالإنسان اليومي وتنتهي به، ولا أن يقرأ العلاقة الضرورية بين الإرهاب وعِلل الواقع المستعصية.
ولعل الافتتان بالسلطة، سواء احتاج إلى تعريف أو بقي خارج التعريف، هو الذي أقام فصلًا لا يقبل التجسير بين ما كانه طه حسين وما أراد أن يكونه جابر عصفور، وهو الذي كان يزيّن مكتبه في المجلس الأعلى للثقافة بصورة كبيرة «للسيد العميد». فقد رأى حسين في سلطة الثقافة مرجعًا لفرض الثقافة على السلطة، بينما آثر جابر عصفور أن يطرق، بنعومة، أبواب السلطة بأصابع مدثرة بقماش ثقافي. والفرق بينهما قائم في «السياسة»، أو «قضايا الشأن العام»، كما كان يفضل جابر أن يقول، فالأول كان يعاين السياسة في قضايا الحياة جميعًا وينقد ويهاجم ويشتبك، وكان الثاني يتلمّس السلطة في قضايا الحياة جميعًا، فينقد ويهاجم ولا يضير السلطة في شيء، إن لم يعتقد أنه يقف معها، ويكتب مدافعًا عنها، حال حديثه، في المؤتمر الأخير للرواية العربية في القاهرة عن «الإرهاب»، واقتراحه أن يكون: «الرواية والإرهاب» موضوع المؤتمر القادم، دون أن يشير إلى معنى الرواية، التي تبدأ بالإنسان اليومي وتنتهي به، ولا أن يقرأ العلاقة الضرورية بين الإرهاب وعِلل الواقع المستعصية.
كان بذكائه الخارق قادرًا، إذا أراد، أن يضع الظاهر خارجًا وأن يمضي إلى الجوهري، كأن يعتبر يحيى حقي ناقدًا أدبيًّا متميزًا، ويستذكره باحترام كبير، وأن يضع دراسة سعيدة عن محمد مندور، أفضل ما كُتب في هذا المجال، وأن يرتاح إلى فوز عبدالرحمن منيف بجائزة القاهرة للرواية العربية، في الدورة الأولى، وأن يطلب في اليوم الأول من زيارته لدمشق أن يزور بيت «نزار قباني»، وأن يقول: «إن شهرته الإعلامية جنت على قيمته الإبداعية»، وأن يعترف بأن قصائد محمود درويش الأخيرة «شَهْدٌ مقَطّر»، وأن يثني على حداثة الروائي الراحل إدوار الخراط…..
بيد أن ذلك الذكاء الخارق لن يمنع عن جابر جملًا تائهة كأن يقول: «أنا أصرف على منصبي بدلًا من أن يصرف منصبي عليّ». إذا كان منصب الإنسان لا يغطي نفقات حياته فما الحاجة إليه؟ أو أن يقول: «السلطان الحقيقي هو البعيد عن السلطان» ناسيًا، ربما، أن بين المثقف التقليدي والسلطة أكثر من علاقة، وإلا لما غدا وزيرًا! ربما كان فيه توق إلى مثقف مستقل يحاور الحياة والكتب ويخرج على الناس بأفكار تثير الحوار، وهو الذي حدثني طويلًا عن رغبته في إنجاز دراسة عن «بلاغة المهمشين» وأخرى عن لغة الأكاديميين الاحترافية المتيبسة. ولهذا أثنى كثيرًا على دراسة وحيدة نشرتُها في مجلة «فصول» عنوانها: «ثقافة الاستبداد واستبداد الثقافة»، أعلن لي مرتاحًا: «إن دراستك عاملة الهوايل»، سألته مدهوشًا لماذا؟ أجاب: إنها تنقد السلطات والمثقفين الذين يظنون أنهم سلطات وتسخر من «المبدع الصانع الذي يظن نفسه إلهًا».
الطفل والصبي والشاب
لست أدري ما الذي جعل هذا المثقف اللامع القوي الشخصية الشديد الذكاء قريبًا من «المثقف الريفي»، الذي تحدث عنه الإيطالي أنطونيو غرامشي، والذي له صفتان: التجمّل الاجتماعي والسعي إلى الشهرة بين الناس، وبناء جسور مع السلطة لها طابع القداسة، تقنع الناس بأنه يقف فوق غيره وآية ذلك موقعه في جهاز السلطة. تحدث الإيطالي عن «مثقف الجنوب الإيطالي» القريب من الفلاحين، ومايزه من مثقف الشمال في المدن الصناعية. بيد أن تساؤلي تراجع حين تذكرت «ابن خلدون»، الذي أضفى على العلم «حيادًا رصينًا» وطه حسين الذي غدا «وزيرًا» مرتين لتحقيق مشروعه الشهير القائل: «العلم للناس كالماء والهواء» لم يهادن السيد العميد السلطات الحاكمة ولم يعبأ بعقوباتها، واضطر إلى الجوع والتقتير في زمن «حكومة صدقي» الكاره للحريات… بقي موقف ابن خلدون، العالم النبيه، يثير الحيرة والتساؤل لدى بعض، ويقيّم بعض آخر «علمه الجديد» ولا يذكر غيره. وكان لجابر مشروعه الثقافي وطريقة الدفاع عنه.
 في وجه الإنسان وجوه، يقول الرومانسيون، ولو أكملوا لقالوا: خير الوجوه تعشق الأطفال والزهور. في زيارة لجابر إلى عمّان خرجت معه وعائلتي قال: أريد منطقة بلا ضوضاء لا تجذب المارة. وما إن تلامح شارع ضيق استقرت في نهايته أشجار بيضاء الورود حتى قال جابر: هناك، ومشى سريعًا وقطف «قبضة من الياسمين» وتبادل معها همسًا طويلًا، ذكرني بزيارته إلى بيت نزار قباني في دمشق، الذي جذبه فيه جماله القديم وأريج ياسمين انتشر في الفضاء. وعندها أخرج من جيبه حافظة أوراق وأخذ يقول لابنتي، بوجه فرح، هذه «صورة حفيدي».
في وجه الإنسان وجوه، يقول الرومانسيون، ولو أكملوا لقالوا: خير الوجوه تعشق الأطفال والزهور. في زيارة لجابر إلى عمّان خرجت معه وعائلتي قال: أريد منطقة بلا ضوضاء لا تجذب المارة. وما إن تلامح شارع ضيق استقرت في نهايته أشجار بيضاء الورود حتى قال جابر: هناك، ومشى سريعًا وقطف «قبضة من الياسمين» وتبادل معها همسًا طويلًا، ذكرني بزيارته إلى بيت نزار قباني في دمشق، الذي جذبه فيه جماله القديم وأريج ياسمين انتشر في الفضاء. وعندها أخرج من جيبه حافظة أوراق وأخذ يقول لابنتي، بوجه فرح، هذه «صورة حفيدي».
ما زلت أتذكره «مقرفصًا» ينظر إلى صورة حفيد، أو حفيدة، كما لو كان الحفيد إنجازه الأكثر جمالًا. تقلّص عندها حجمه في ناظري، وغادر الألقاب وأوامر «المجلس الأعلى» واختُصر في طفل بريء، ضاق بالشهرة والعادات البيروقراطية. تذكرتُ عندها حكايته عن جابر الشاب النحيل الذي قابل يحيى حقي في مجلة «المجلة» وأثنى على ما كتب، وعُدت وراءً إلى صبي وسيم يسأل بركة الوالدين.
كان جابر وفيًّا لأصدقائه، قدر المستطاع، عادلًا مع مثقفين لم يكونوا جميعًا عادلين معه، قفز بعضهم إلى مناسبات عارضة (رفْض صنع الله إبراهيم لجائزة الرواية)، وأغلظ عليه القول بلا سبب. لم يكن جابر يقوم إلا بعمله، يساعد الذين يستطيع مساعدتهم، ويلبي ما يتيح له منصبه حينًا، وينساق إلى ما يريده طموحه حينًا آخر، شارد الحسبان مفتونًا بلقب لن يضيف إلى «مزاياه العلمية» الشيء الكثير. بل إننا إذا تجردنا في الحكم والتمسنا بعضًا من موضوعية تحدثنا عن عظمة جابر عصفور ومأساته؛ عظمة تتراءى فيما أنجز وأراد تحقيقه، ومأساة تصدمه بالطريق ولا يستطيع حيالها شيئًا، وذلك في بلد احتَلت فيه السلطة، منذ أيام الفراعنة، فضاءً واسعًا، كما قال لي جمال الغيطاني، ذات مرة، مسهبًا في توصيف «رؤساء مصر» وصورهم في الذاكرة الشعبية.
يستطيع المثقفون، أعربًا كانوا أو مصريين، أن يتوقفوا أمام: تناقضات جابر عصفور، التي ترفعه إلى مقام النسر أو تهبط به إلى مستوى العصفور الدوري. غير أنه من المحقق أن أحدًا منهم، مهما تكن حمولته الثقافية، لن يمثّل في الحياة الثقافية العربية ما مثّله جابر، أو يقدر على إنجاز ما أنجزه. في غياب جابر عصفور، يخسر بعضٌ صديقًا وأنا منهم، ويفقد تلاميذه أستاذًا طليق اللسان جميل البيان، وتفقد الحياة الثقافية العربية عقلًا فاعلًا متواتر النشاط.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | يناير 1, 2022 | سيرة ذاتية
ما الفرق بين غريب اختار غربته سعيًا وراء جديد في عالم وجوهه الاختلاف والتنوع والثقافات المتعددة، وغريب رُحّل عن عالمه الأليف وقُذف به إلى فضاء يجهله؟ ما وجوه الاختلاف بين إنسان ضاق بالحرمان في وطنه وآثر هواءً نظيفًا في مكان آخر، ولاجئ أُخرِج من وطنه على غير إرادة منه؟ ما معنى الغريب الواقف فوق هامش عالم لا عدالة فيه، انتظر، طويلًا، عدلًا لن يأتي؟

نجيب محفوظ
أسئلة متشكّية فاجأني بها، ذات خريف، إنسان رقيق الحال، ناحل واسع العينين، شاحب له وجه ملاك، فتح عينيه على آخرهما منتظرًا إجابات تطفئ قلقًا في صدره. أربكني عن غير قصد، ووضع روحي أمام ما تعرفه وتتقي الحديث عنه، وأيقظ أطيافًا تحاشيتها في خريف العمر. لماذا أخشى حديث الغربة وأهاب النزول داخلي وأبتعد من زيارة ذكريات لها طعم تجارب صدمتني غير مرة؟
اقتصدْتُ الإجابة وقلت للسائل: لك أن تقرأ رواية نجيب محفوظ «اللص والكلاب» التي سردت مآل غريب باحث عن العدل صيّره زمنه المريض ضحية، طُورِدت طويلًا. ولك أيضًا أن تعرف رواية ألبير كامو عن: «الغريب» الذي ضاق بكلام الآخرين وزهد بإلقاء نظرة أخيرة على وجه أمه الراحلة. والأقرب إلى سؤالك رواية غسان كنفاني «رجال في الشمس» عن لاجئين فلسطينيين تاهت خطاهم وبحثوا عن نعمة مفتقدة أوْدت بهم إلى الهلاك.
نظر السائل إليَّ باحتجاج عاتب وقال: ما قصدت بأسئلتي الاغتراب في الرواية، قصدت أحاسيسك الذاتية المباشرة التي لا تتخفّى وراء مهنة الكلام. أجبت وقد تخفّفت من ارتباكي: إن الغربة تنهش بعنف هيئة الغريب، يخاف وينكمش وينزوي ويتضاءل ويتقلّص وينحسر ويلوذ بما لا يرى. فلا غريب إلا بالخوف الذي يلازمه، ولا غريب إلا وحمل اتهامه وصمت، ولا غريب إلا باستضعافه واستغفاله واستقواء آخرين عليه، لا فرق إن تمتعوا بوطن حقيقي ودولة وعلم، أم كان لهم ما يشبه الوطن والعلم ودولة تلقّنهم فصاحة الصمت قبل قليل الكلام.
لا تاريخ للغريب!
الغربة تجربة طفولة سقطت في الطريق، والغريب الجوهري، الذي طالت غربته، فقير المفاجأة، فما عاشه كهلًا عرفه صبيًّا، وما ذاقه شابًّا لاحقه إلى بدايات الشيخوخة، كأن الزمن فراغ لا وجود له. والغريب الحقيقي، يا سيدي، يخشى المجهول قبل وصوله إليه، لا يمنع عن ترحيله أحد واستقراره احتمال واللاإقامة مرجعه الأكيد، ولهذا انتشر الفلسطينيون في أنحاء الدنيا. لا بلد قريبًا كان أو بعيدًا إلا وتعثر فيه على فلسطيني يسرد حكايات رحيله الأخير.

ألبير كامو
ومع أن للغريب إيمانه الخاص فبينه وبين اليقين قطيعة، وبين ما يرغب وما لا يرغب فجوة حفرتها متواليات الأسئلة: ماذا تفعل في هذا البلد؟ من أين جئت، وهل هذا وصولك الأول إليه، ما عدد أقربائك فيه، ما اسمك الخماسي، وهل كنت في منظمة أو تنظيم؟… وناظم الكلام الغريب مع الغريب اتهامه، ودليل اتهامه نبرة زاجرة، إنِ اعتدلت غدت شفقة جارحة، أو مواساة تباطنها اللعنة، فإن خلعت قناع الشفقة تزيّنت بالحزم والإنذار والوعيد. ولإيذاء الغريب نبرة قاحلة تخنق الروح: «على أية حال أهلًا وسهلًا، وما عليك إلا مراعاة أصول الضيافة، أحضر معك، بلا تقصير، صورة عن مكان إقامتك، وصور وثيقة سفرك في العشرين سنة الأخيرة». يتلو الكلام المالح، الذي يلهب العينين، ابتسامة متخابثة تعادل «طعنة نجلاء» بلغة العرب،…
ما يعبّر عنه موظف قصير الأخلاق تكرار لما تعلّمه من مرؤوس أعلى مقامًا، اتكاء على مبدأ المحاكاة؛ إذ من لا قيم له ولا معرفة يغويه عري اللاجئ ببطولة الوهم أو بوهم البطولة. والطرفان في علاقتيهما مع الغريب، وفيّان لتعاليم «رسمية» والغريب، في علاقته معهما، يكرّر دروس الغربة: ضرورة التكيّف مع الشروط المستجدة، أكانت من مطالب «الأمن الوطني» أو من مجموعة بشرية يجهل عاداتها، والاعتراف بالجميل وحسن الضيافة والالتزام بالأعراف وقواعد النظام… ينطوي التكيّف، لزومًا، على تحمّل الاتهام الآتي من جهات مختلفة.
يتوّج وضع الغريب بقاعدة لا هرب منها: «الغريب لا تاريخ له»، بلغة عالم الاجتماع النمسوي ألفرد شوتس في كتابه الصغير: «الغريب وعودة الغريب إلى بيته»، وإن كان الشطر الثاني من العنوان لا يعني «اللاجئ» في شيء؛ لأنه لن يعود إلى المكان الذي رُحّل عنه. يفضي تغييب تاريخ الغريب إلى اختراعه، فربما يكون في جسده زوائد لا يعرفها «ابن البلد» أو أن له طعامًا يخصه، أو طريقة في الاستحمام غير مألوفة، ناهيك عن اختلاف اللهجة في الكلام، التي قد تصبح اتهامًا يستدعي: رصاصة.
ولعل اختراع تاريخ الغريب هو ما دفع جبرا إبراهيم جبرا إلى الغضب الشديد، حين قال في مقابلة معه: «إذا علا صوت في منتصف الليل قالوا: إنه صوت الغريب، وإذا كُسر زجاج بيت قالوا: إنه من أفعال الغريب، وإذا اشتبك طرفان في شجار مع ثالث كان السبب هو الغريب». و«لكن فَلْيعلموا أن هذا الغريب كان في بلده أكثر منهم أدبًا وثقافة وأحسن سلوكًا». قال جبرا، وهو المثقف الرومانسي النبيل، بما عاينه في معيشه اليومي. ويغدو الأمر أكثر تجريحًا إن اجتمع فيه الجهل وفقر الخُلُق: «لو كان فيكم خير ما تركتوا بلادكم وأتيتم إلى بلادنا»، «ولو كنتم تعرفون معنى الوطن لدافعتم عنه…». اللاجئ متهم في وطنيته، متهم إن بقي في وطنه أو خرج منه، في الحالة الأولى «خاضع جبان»، وفي الحالة الثانية متطفل لا يريد العودة إلى وطنه. وواقع الأمر أن غربته خطيئة جاء بها عنف التاريخ، ومأساة صدرت عن عماء الوجود. لذا قال لي الموظف الفرنسي: إنني آسف فلا وجود على خريطة العالم لبلد له اسم بلدك!!!
مأساة بلا عقاب
غربة اللاجئ من عماء التاريخ، أو من عتمة في الوجود، لا فرق، ما دام الظلم الواقع عليه جاء من إنجليزي يدعى «بلفور» أو من «أقارب» يشعلون النار بأطراف المخيم في منتصف الليل أو في عزّ الظهيرة. تحوّل الكلمات المعلّبة «القضية الفلسطينية» إلى تزييف حاد الأطراف، وكذا ما دعي «بالمسألة الفلسطينية»، بلغة متفاصحة، فهي في جوهرها مأساة فريدة: كان الفلسطيني، في زمن مضى، يمتد في زيتونه وبرتقاله، وغدا، لاحقًا، امتدادًا للاتهامات المتجددة. مأساة لا يُعاقب عليها أحد، لازمته طفلًا، وسارت معه شابًّا، ورافقته في خريف العمر. في كل مرحلة حكاية، وفي كل حكاية حكايات علّمتني الخشية من النزول إلى داخلي واسترجاع الذكريات الخانقة. حكايات متنوعة ممتدة من مسؤول يثير الرهبة إلى موظف صغير تتعثّر به الحياة اليومية ولا تراه.

غسان كنفاني
كان المسؤول المهيب يطارد ذبابة، إن غفا عنها قليلًا حطّت على كتفه، يطردها وتدور حوله فيطردها ثانية. بعد أن رفع رأسه رحّب وأثنى على المثقفين الذين يدافعون عن الأخلاق ولا ينسون كرم الضيافة. أطال النظر في أوراق أمامه، استعان بقلم ونظر إلى رزمة أخرى من الأوراق وهزّ رأسه مبتسمًا: «طلبك بإذن الله مقضيّ»، وداهمني فنجان قهوة جديد. بدت الذبابة معلّقة في الهواء، وكفّ السيد المسؤول عن النظر إلى كتفيه.
بعد صمت وتحديق في الفراغ تهيأت للوقوف، لكن السيد المسؤول عاجلني بسؤال لطيف وبكأسٍ من الشاي: هل زرت مكتبي سابقًا؟ وبعد النفي قال: هل تعرّفت على أحد في هذا البناء صدفة؟ قلت لنفسي هذا طور الاتهام الخفيف، وحين سأل: أصلك من أي بلد؟ قلت جاء طور الاستغفال المتسلّط، فالسيد يعرف اسمي واسم أبي ومثوى جدي الأخير ووالد جدي الذي جاء من الجزائر إلى فلسطين في منتصف القرن التاسع عشر. اتسعت ابتسامته قليلًا، والذبابة كفّت عن مطاردته، وأيقنْتُ أنه أفرج عني لولا طلب جديد: «إمضاءك ثلاث مرات على هذه الورقة». تنفّست الصعداء ووقفت استعدادًا للانصراف. استأنف ابتسامة وأضاف: أنتظر منك في المرة القادمة صورًا، مجرد صور، لجوازات سفرك التي حملتها في العشرين سنة الأخيرة، الأخيرة فقط. غمرت البشاشة وجهه وبقيت الذبابة هاجعة على كتفه الأيمن. بعد الاستغفال المتسلّط يأتي الاستضعاف، ليس بإمكاني أن أرفض أو أن أحتج.
أيقظت المقابلة صورة الكهل القديم في اليوم الأول من عامي الدراسي الأول حين قال ببساطة رحيمة: «التلميذ الذي من خارج البلدة يرفع إصبعه!» داخلني شعور بالرضا الصغير والمهانة. فبعد فضول معلّم ابتدائي بسيط الهيئة واللباس ها هو يستقبلني مسؤول كثير الهواتف في قاعة تستهل بسجاد فاخر طويل وتنتهي بمأمور رفيع المقام. تلا «رفع الإصبع» القديم نبرة آمرة تسأل عن اسم: «جدي السابع». كنت في الحالة الأولى صبيًّا في السادسة من عمره، وفي الثانية كهلًا يقترب من السبعين. وكنت، في الحالين، متهمًا يطارده اسم البلد الذي رُحِّل عنه صبيًّا. بعد الاستغفال والاستضعاف جاء دور «التصغير» الذي يصيّر المتهم إلى شيء بين الأشياء.
طابور الغربة الطويل
في مطار البلد «المضيف» المحتشد بقادمين مختلفي الأقدار كنت أنطلق مسرعًا حد اللهاث لأكون أول الخارجين. ألقي التحية بأدب وأضع الدعوة الرسمية في جواز السفر وألتفتُ يَمْنةً ويَسْرةً وأنتظر الإجابة، وأصطدم بما يجب أن أصطدم به. ما إن يتعرّف موظف الجوازات على اسمي ورسمي حتى يقول كلمة واحدة: «هناك»، ويشير إلى ركن قصيّ تبعثرت فيه مقاعد وركاب قليلون. أنتظر استجوابًا أو رقيبًا يريد صورًا من جواز سفري في «المئة سنة» الأخيرة. لا شيء من هذا فمشيئة الموظف صاحب الكلمة الواحدة لا تختلف عن مشيئة سابقيه. بعد مرور أربع ساعات يسقط عليّ اسم عائلتي، وقد فقد «الشدّة» الملازمة له وكُسِر حرفه الأول: «دِراج». ينتهي الحجز المؤقت وأخرج وأسال نفسي: لماذا هذه العقوبة؟
بعد سنين جاءت إجابة سعيدة: لقد بلغت الخمسين، ومن يبلغ الخمسين لا خطر منه، لكن زوال الخطر لا يتضمن زوال الاتهام. وقلت لروحي ساخرًا: ها هو تقدّم العمر يحرّرك من العقوبة، وأعد نفسي في الستين بمعاملة أفدح كرمًا.
لا تكتمل حكايات الاتهام إلا بحكاية موظف يتبجّح بلغتين، يقول بعربية صلبة لحظة الاستقبال: أهلًا وسهلًا في وطنك العربي الثاني، وكيف حال الإخوة هناك، وأسخر من هناك وأقول: تقصد بهناك البلد الذي جئت منه، بلد محتل منذ عقود وأخذ اسمًا آخر!! عندها يقفز الموظف ويدور حول نفسه ويكاد يشد شعره ويتكدر وينتقل من العربية إلى الفرنسية زاعقًا: «يا ولد، هات «الباجاج»، لا دخول، أرجِعْ «الباجاج»»، وأسأل الموظف بهدوءٍ اختلط بالقهر واللامبالاة: «جواز سفري» فأنا راجع مباشرة إلى الطائرة، وسأقدّم شكوى إلى جامعة بلدك التي لا تميّز بين «الأكاديميين المحترمين» وآخرين مجهولي السيرة. الموظف الغليظ الشاربين الذي سيطرد شعبه الكريم حاكمه -الذي قال لقد هَرِمنا- عاد وقال: إنها إجراءات، مجرد إجراءات روتينية- وكان وجهه يفضح كذبه. سألته وأنا خارج: «ما معنى كلمة «بَغَاج» أو «الباغاج» باللغة العربية؟» أجاب. هل هناك كلمة بديلة أخرى لا أعرفها؟

ألفريد شوتز
صور «عملية» ثلاث للغريب: غربة الصبي احتاجت إلى «عزل أولي»، ولحق به في طور الشباب «طرد محتمل»، وفي طور الشيخوخة أحاطت به «رقابة شديدة الحراسة» ترجمتها الدقيقة: «ابتذال اللامعقول وبذاءة الحسبان».
مرّ شرطي على لاجئ في ساحة عامة رخيصة، عرفه، ربما، من حركاته القلقة، سأله عن هويته الشخصية فأجاب: نسيتها في قميصي الآخر، من دون أن يدرك أن قوله سيخرج الشرطي الفقير الملامح عن طوره، فيقول: «لاجئ، لاجئ، وله قميصان، تصوّروا، تصوّروا؟». لو كان هناك المرحوم صلاح جاهين، المصري الجميل الروح لقال: عجبي، تعبيره الشهير في «رباعياته».
يحتفظ الغريب بصور حياته كي لا تصدمه التجربة، يرى الحياة في وجوهها المتنوعة، الممتدة من شرور الحياة المكسوّة بالذباب إلى بشر آخرين، قلوبهم مضيئة لهم غربتهم أيضًا، فالغريب بالمعنى الحقيقي لا يوجد بصيغة المفرد، و«العَسَس» الذي يضطهده له صيغة الجمع أيضًا، في كل زمان ومكان. ينتمي الغريب، في تصور نجيب محفوظ، إلى عماء الوجود، وتنتشر مكاتب «المحقّقين» المتعددة الهواتف، في كل مكان، ولولا الظلام الخانق لَمَا كان للنور وتأمل السماوات معنى.
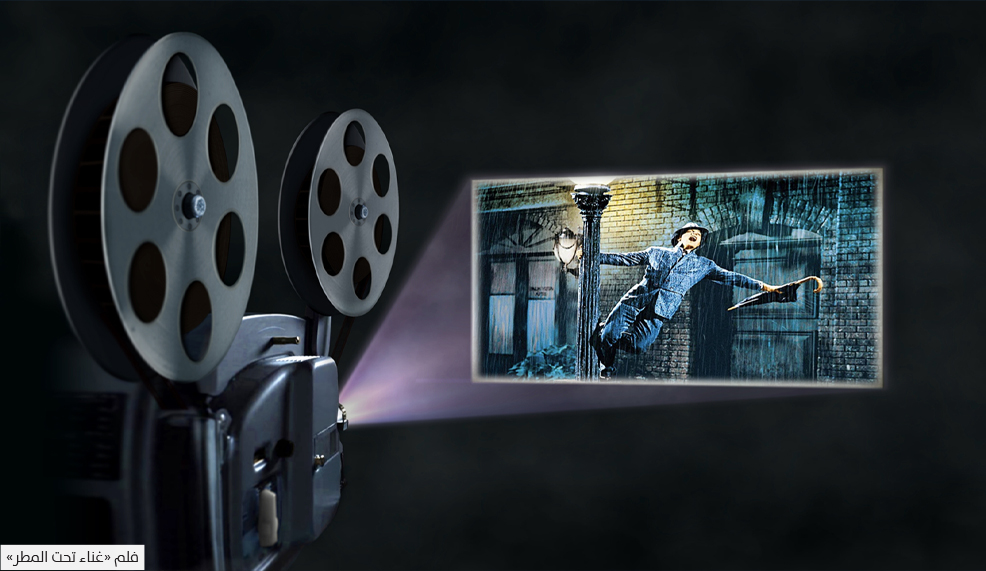
فيصل دراج - ناقد فلسطيني | نوفمبر 1, 2021 | سيرة ذاتية
أذكر من فِلْم إنغمار بيرغمان «التوت البريّ»، الذي رأيته قبل أكثر من خمسين عامًا، عجوزًا يتكئ على عصا يطوف بين صِبْيَة يمسّد شعرهم ويغدق عليهم حنانًا دامعًا، ويتوقف أمام صبي سيحمل، لاحقًا، عصا وشيخوخة مرهقة. كان العجوز يستذكر ذاته، يوقظ متخيله ويعود صبيًّا، يداعب شعر إخوته في بيت العائلة القديم. أشعر الآن، وأنا أستعيد سينما الصبا، أني أشارك عجوز بيرغمان زيارته المتخيّلة، أستعيض عن الأخوة بالأفلام، وأمسّد شعر أيام خلت كان للسينما فيها مذاق الأحلام. الغرفة القديمة كانت صالة أنيقة، تجاور مقهى الهافانا، تدعى: سينما الكندي اختصت، ذات يوم، بعروض «أفلام النخبة» التي كانت تبدأ، بأفلام أيزنشتين ولا تنتهي بسينما فيتوريو دي سيكا.
المدينة التي بلغتها صبيًّا، وافدًا من قرية سورية يتقاسمها الشركس والتركمان، بدت لي، ذات مرة، مسقوفة بالرضا مكسوة بملصقات سينمائية بهيجة الألوان، افترشَت «باصات عامة» تجوب معها شوارع المدينة، تستقر في واجهات المكتبات وجدران الساحات وتتسلق أعمدة الكهرباء، وتجد مكانًا في حارات شعبية تتعالى فيها أصوات صبية لم يختبروا شقاء الحياة بعد.
المدينة التي بلغتها صبيًّا، ذات يوم، كان عدد سكانها يتجاوز ربع مليون نسمة بقليل، كما قال معلم التاريخ، الذي علّمنا أن للمدينة أكثر من اسم: جِلّق والفيحاء، وثالث نعرفه: دمشق، يعطف عليه بفخار: عاصمة الأمويين، ويضيف إليها بردى ودمّر والهامة ويذكر أحمد شوقي ويقول: شاعر مصري عظيم، أرسل «سلامًا» إلى المدينة حين أحرقها الفرنسيون عام 1945م، ورحلوا. كان مطلع قصيدته: سلامٌ مِنْ صَبَا بَرَدَى أرقُّ،… حين سألته، عن الملصقات السينمائية التي تجوب أنحاء المدينة أجاب: اقتربت عدد صالات السينما، قبل زمن قصير، من ثلاثين وتراجعت الآن إلى العشرين، تزداد عددًا صيفًا، بعضها تنفتح سقوفها على السماء – سينما الرشيد الصيفي – وتغلقها في موسم الأمطار. كان ذلك في العام الدراسي 1951 – 1952م، والاستعمار الفرنسي قد ولّى، يحتفل بيوم رحيله، في يوم شهير: عيد الجلاء.
كانت المدينة متعددة الألوان، تتجدد بتبدّل الفصول وتتباهى بألوانها؛ إذ تعددية الألوان من خصائص الجنة، كما قال المعلّم واعتبر دمشق، ضمنًا، امتدادًا للجنة، حتى اعتقدنا، نحن الصبية، أن ما يتعدّد لونه قريب من السماء؛ وأن الألوان توسّع الروح وتطلق في الإنسان شهوة المسير. كان في الملصقات المتعانقة الألوان ما يدعو الجمهور إلى الحضور ويكاثر وجوه الأفلام، فلقصص العشّاق السعيدة المآل زرقة ناطقة، و«أمير الانتقام» له لون انتصاره ورماد ضحاياه، وللجلّاد العتيد لون له نشع القبور وبكاء الأظافر المقلّعة.
وكثيرًا ما ذكرت أفلامًا بسبب ألوانها: طفولة إيفان الروسي أندريه تاركوفسكي المنسوجة من الصقيع والأسى والحرمان وطفل عاش طفولته في الأحلام. وأحلام أكيرا كوروساوا، المتداخلة الزرقة والبياض وحزن القائد الذي يناجي جنودًا دفنتهم «المعركة». وفِلْم البولوني أندريه فايدا «غابة البتولا»، الذي أرشدني إليه الصديق محمد ملص حيث خضرة الأخ الصغير المريض المتفائل تواجه ألوان الأخ السليم المجبولة من الصمت والرماد وعتمة لا ترى. الألوان الجميلة لا تضاف إلى الطبيعة فهي منها، للبحر زرقته وللغابة خضرتها وللعشق كما نقرؤه أريج يميل إلى الازدهار، وتكلّف الألوان الصناعية تخذله الطبيعة وتسخر منه العيون التي تحسن القراءة. أذكر لون العاشقة اليائسة في «جسد واترلو» الذي ابتلع جمال «فيفين لي»، وإشراق وجه عاشقة في «جين أير» أضاءه وجه «أورسون ويلز» المعشوق الذي أعطبته الصدفة وفقد البصر، وما زلت أذكر وجه عاشق مقوّض، جسّده لورانس أوليفييه، في فِلْم مأخوذ من رواية الأميركي ثيودور درايزر «مأساة أميركية»، عاشق يشكر ما دمّره وجعله متسوّلًا: «لولا شقاء العشق المبارك لما بلغت قلب الحب وعرفت أنه جدير بالفداء والفناء».

صحبة ضيعتها السنون
لا أستعيد سينما الصبا إلا مصحوبة بالمطر، مطر بعثه متخيّل سرّه ما رأى، خايله نقاء الأيام الراحلة واحتفى بأمطار طيبة الرائحة دافئة الملمس، ماؤها من صور تناءت وأشواق تلاشت ورغبات انطفأت وصحبة ضيّعتها السنون. ولعل هالة الأمطار المنقضية هي التي حفظت في ذاكرتي عناوين سينمائية مبلّلة بالرذاذ: «ليلة ممطرة» لعميد المسرح العربي يوسف وهبي الشغوف بالوعظ والإرشاد. و«جاءت الأمطار» فِلْم أميركي من الأربعينيات عن حب مستحيل بين الشرق والغرب، قام بالدور الأول فيه «تيرون باور» الذي رحل قبل الأوان، و«غناء تحت المطر» جمع بين طموح فنان رهيف -جين كيلي- ورقص «سيد تشاريس» المخلوقة من نسيم وأجنحة مرتاحة، و«مسافر تحت المطر»، لا أعرف إن شاهدته في دمشق أو «تولوز» الفرنسية، وإن كنت أذكر أنني كنت بصحبة عزيز لم يعمّر طويلًا. أراد أن يكون صديقًا في الأيام الممطرة، وفي أجواء الصحو والسعادة.
الصداقة الحقيقية لون آخر من المطر، مرآة لجماليات الحياة ونبل القيم، توسّع الروح وتجرج الذاكرة إنْ رحل الصديق. كان اسمه فيرنر غلينغا، بشوش الوجه أقرب إلى النحول، توزّع على النقد الأدبي وكراهية الظلم والعنصرية. أنهى دراسته العليا وفارق الحياة واعتبر السينما طقسًا حياتيًّا ودرسًا في التأمل وتبادل الأفكار. شاهدت معه في خريف 1971م فِلْم كلود سوتيه «أشياء الحياة» وسأل: هل جاء الموت إلى حياة «ميشيل بيكولي»، بطل الفلم، في شكل صدفة قاتلة، أم إن الأخير قصد الموت بسيارة مجنونة السرعة وعطف عليه مآل «غاتسبي العظيم»، رواية ف. سكوت. فيتز جيرالد، التي نُقلت إلى السينما أكثر من مرة، أخذ بطولتها في سبعينيات القرن الماضي روبرت ريدفورد…. قال لي فيرنر: «السينما فيلليني ولويس بونويل وأكيرا كروساوا والباقي أشرطة».
شاهدنا أفلام هؤلاء جميعًا في نوادي «المدن الجامعية»، في تولوز وباريس وبقي فلم فيلليني «أنا أتذكّر» نتقاسمه قدر ما نستطيع. كان فيه صور عن رعونة المراهقة وأسطورة المرأة والحنين المترسّب وحريق الزمن الذي لا يقتصد أحدًا. وكنّا في ساعات الرضا نتنافس في تلخيص مواضيع الأفلام شرط ألا نتجاوز جملتين ودقيقتين وألّا نخطئ في اسم مخرجيها، فأسماء الممثلين ووسامتهم وفتنة الممثلات الذي هو من شأن «الطلبة الصغار».
كنت أختلف معه في النقطة الأخيرة، ذلك أن الوجوه مرايا الأرواح وأن بعضها هدايا سخية من الطبيعة، كان فيرنر يسخر من الجملة الأخيرة فأصدّه بوجه «آفا غاردنر»، «أجمل حيوان في العالم» كما كان يقال، أو آتي على ذكر «لورين بكول» الأميركية ذات الأصل البولوني وزوجة همفري بوغارت. كان فيرنر يصمت إعجابًا بموقفها من «الحملة المكارثية» المعادية للفنانين الديمقراطيين خلال الحرب الباردة، وبفلمها «أن تملك أو لا تملك»، المأخوذ عن قصة لإرنست هيمنغواي وإخراج هوارد هوكس. كان يقلّد بوغارت بإنجليزيته الأميركية التي تبدو مسحوبة من الأنف أو خارجة منه على مضض.

قلق الإنسان المغترب
علّمني فيرنر المقارنة بين الأدب والسينما، قولان مبدعان بتقنيات مختلفة، يترجمان ما يُرى وترهقهما خفايا الروح المرهقة، كأن نسأل: هل تلتقط كاميرا السينمائي قلق الإنسان المغترب الذي «جوهره» خارجه وعيناه محلقتان في فراغ شريد لا تلمسان خارجهما إلا لتنفر منه ولا ينطق بجملة واضحة؟ وكيف تنفذ الكاميرا إلى دخيلة إنسان بحثَ عما أضاعه وعثر عليه، وَمْضًا، وأضاعه من جديد؟ هل تحسن استنطاق عينَيْ طفل فقدَ أمّه في الصباح أو شاب ارتدى التشاؤم ولم يسر في جنازة أمه؟ أسئلة تترافد كان يبعث بها مارشيللو ماستروياني في فلم «الغريب» إخراج فيسكونتي وفضاء الفلم المعتم «المغامرة» لأنطونيوني أو العزلة الروحية الشاملة لآلان ديلون في «ساموراي» هنري مليفل. كان الناقد السينمائي السوري سعيد مراد، الذي رحل على أبواب الخمسين، يرمّم الإجابة بمصطلح «المناخ الفني»، يضيف إلى الوجه مكانًا تبعثرَ في إشارات صوتية- سمعية تستدعي اللباس وترتيلًا موسيقيًّا موائمًا و«مونتاجًا بديعًا».
ما زلت أذكر اغتراب العجوز الإقطاعي في فلم «الفهد»، الذي أخرجه فيسكونتي أيضًا وأنطقه، متأسيًا، برت لانكستر وهو ينهر متسلقًا ضحل الروح ارتفع مقامه في زمن مريض: «كنّا في زمننا الفهود، أما أنتم فضباع وبنات آوى». كان الاغتراب واضحًا ولا يزال في الفلم السياسي حال فلم اليوناني كوستا غافراس «Z»، حيث ضحية الفاشية جسّدها الممثل- المغني «إيف مونتان» الفرنسي الجنسية الإيطالي الأصول. ودلالة الاحتلال القاتلة حتى «لو بدا أنيقًا»، كما هو حال النازي في فِلْم «صمت البحر»، المأخوذ عن فيركور، الذي أخرجه، باقتصاد مدهش، بيير ميلفل. وهناك «اللص والكلاب» رواية محفوظ التي رسمت، بألم، فقيرًا سرق مكرهًا، طاردته سلطة من اللصوص والقتلة أطلقت النار على البراءة وعلى «الصدفة» أيضًا. لبس الراحل شكري سرحان الدور الأكثر إتقانًا في مساره السينمائي، إضافة، طبعًا، إلى أدائه الرهيف في فلم «البوسطجي» المأخوذ عن قصة قصيرة ليحيى حقّي.
لم أكن من مريدي «الفلم التاريخي»، وما زلت كما كنت، ذلك أن التاريخ مِزَق من الحكايات يصنع منها «القوي» الثوب الذي يريد، ولا أفلام المغامرات التي نرى فيها «أبطالًا»، فلا أحبّ الأبطال ولا الذين يكتبون عنهم. كان لنا أفراحنا أيضًا الآتية من ضواحي الفن والغناء والرقص والهوى السعيد: وليم هولدن يراقص كيم نوفاك في فلم «نزهة»، و«قصة الحي الغربي» المحتشد بالتنافس والحب والرقص وتبادل الاتهامات الضاحكة و«سيزار وزلي» لكلود سوتيه ورومي شنايدر ومخلوقان طيبان يتقاسمان عشق أنثى وتقاسمهما العاطفة والمودة. وأذكر بالضرورة فلم جون فورد: «الرجل الذي قتل ليبرتي فالانس» وقدّم صورةً عن ظلم الحياة الذي يختلس من إنسان لا يعرف القراءة والكتابة شجاعته، ويضيفها إلى متعلّم يحسن الكلام والبلاغة، وجعل منه نجمًا اجتماعيًّا وشجاعًا «لا يشق له غبار».
حين رجعت إلى دمشق عام 1978م وسألت عن الصالات التي عَرَضت «أمير الانتقام، وغرام وانتقام، والوردة البيضاء»، الفلم الأول لمحمد عبدالوهاب، أجاب الرجل ساخرًا: يبدو أنك لست من هذا الزمن، جميعها أغلقت، و«بائع الساندويش» الذي أشرت إليه ترك «المحل لأولاده واشترى محلًّا لبيع الملابس المستعملة». عرفتُ أنني أنتمي إلى زمن آخر وأنا أسأل عن صالات ترددت عليها في زمن مضى. أول فِلْم شاهدته في حياتي كان «أمير الانتقام»، أرضى طفولةً تُسعدها الأحلام، أبهجها العدل المنتصر وفارسٌ ينصف المظلومين. ما زلت أذكر منه السجن والصحراء المحيطة به ولقاء بين الفارس وعجوز عادل يلفظ أنفاسه الأخيرة «قام بالدورين أنور وجدي وحسين رياض رحمهما الله».
السينما الحقيقية ترصدُ سياقات الزمن، تُسرّعه كما تشاء، كأن تبكي جين أير -1944م- طفلةً في ميتم وترتسم على شفتيها شبه ابتسامة بعد دقيقة واحدة. أو أن نصاحب «رجل الطيور في سجن الكاتراز» (لبِرت لانكستر) من شبابه إلى شيخوخته في ساعتين. سجين واسع الكبرياء والفضول والكرامة، قتل بعدلٍ وحُوكم بلا عدلٍ وقاوم عادلًا وغدا في سجنه «عالمًا بأنواع الطيور وأمراضها وسُبل شفائها حتى اشتهر في مجاله».
الفيلسوف الفرنسي الشهير ألان باديو في كتابه «سينما» الذي نشرته Polity في لندن عام 2013م كتب: «السينما فن الأشكال، ليست فقط أشكال المكان، أو أشكالًا من خارج العالم، بل أشكال الإنسانية العظيمة في الحياة. إنها أشبه بمسرح الفعل الكوني. إنها معقل الأبطال الوحيد اليوم». ص:211. لم يقصد الفيلسوف السينما الرخيصة المشغولة بالعنف والجنس وتذليل الذاكرة، إنما قصد فنًّا، قوامه الدفاع عن الحق والجمال والقيم الإنسانية الخالدة، التي لا مكان فيها لبطولات زائفة ولا لأشكال تتنفس الخراب كما الهواء ناظرةً إلى بشر لا يرفعون رؤوسهم.







 التقيته للمرة الأولى في مؤتمر، أشرف عليه، عن: طه حسين عام 1989م. كان موزعًا على أكثر من حوار ولقاء ومكان، ينظم في حضوره وغيابه «المحاضرات» وما يحتاج إليه المؤتمرون، ويكرّم الحاضرين بكياسة رسمية و«بلطف شعبي»، ويحجب إرهاقًا يستبد به بين حين وآخر.
التقيته للمرة الأولى في مؤتمر، أشرف عليه، عن: طه حسين عام 1989م. كان موزعًا على أكثر من حوار ولقاء ومكان، ينظم في حضوره وغيابه «المحاضرات» وما يحتاج إليه المؤتمرون، ويكرّم الحاضرين بكياسة رسمية و«بلطف شعبي»، ويحجب إرهاقًا يستبد به بين حين وآخر. ولعل الافتتان بالسلطة، سواء احتاج إلى تعريف أو بقي خارج التعريف، هو الذي أقام فصلًا لا يقبل التجسير بين ما كانه طه حسين وما أراد أن يكونه جابر عصفور، وهو الذي كان يزيّن مكتبه في المجلس الأعلى للثقافة بصورة كبيرة «للسيد العميد». فقد رأى حسين في سلطة الثقافة مرجعًا لفرض الثقافة على السلطة، بينما آثر جابر عصفور أن يطرق، بنعومة، أبواب السلطة بأصابع مدثرة بقماش ثقافي. والفرق بينهما قائم في «السياسة»، أو «قضايا الشأن العام»، كما كان يفضل جابر أن يقول، فالأول كان يعاين السياسة في قضايا الحياة جميعًا وينقد ويهاجم ويشتبك، وكان الثاني يتلمّس السلطة في قضايا الحياة جميعًا، فينقد ويهاجم ولا يضير السلطة في شيء، إن لم يعتقد أنه يقف معها، ويكتب مدافعًا عنها، حال حديثه، في المؤتمر الأخير للرواية العربية في القاهرة عن «الإرهاب»، واقتراحه أن يكون: «الرواية والإرهاب» موضوع المؤتمر القادم، دون أن يشير إلى معنى الرواية، التي تبدأ بالإنسان اليومي وتنتهي به، ولا أن يقرأ العلاقة الضرورية بين الإرهاب وعِلل الواقع المستعصية.
ولعل الافتتان بالسلطة، سواء احتاج إلى تعريف أو بقي خارج التعريف، هو الذي أقام فصلًا لا يقبل التجسير بين ما كانه طه حسين وما أراد أن يكونه جابر عصفور، وهو الذي كان يزيّن مكتبه في المجلس الأعلى للثقافة بصورة كبيرة «للسيد العميد». فقد رأى حسين في سلطة الثقافة مرجعًا لفرض الثقافة على السلطة، بينما آثر جابر عصفور أن يطرق، بنعومة، أبواب السلطة بأصابع مدثرة بقماش ثقافي. والفرق بينهما قائم في «السياسة»، أو «قضايا الشأن العام»، كما كان يفضل جابر أن يقول، فالأول كان يعاين السياسة في قضايا الحياة جميعًا وينقد ويهاجم ويشتبك، وكان الثاني يتلمّس السلطة في قضايا الحياة جميعًا، فينقد ويهاجم ولا يضير السلطة في شيء، إن لم يعتقد أنه يقف معها، ويكتب مدافعًا عنها، حال حديثه، في المؤتمر الأخير للرواية العربية في القاهرة عن «الإرهاب»، واقتراحه أن يكون: «الرواية والإرهاب» موضوع المؤتمر القادم، دون أن يشير إلى معنى الرواية، التي تبدأ بالإنسان اليومي وتنتهي به، ولا أن يقرأ العلاقة الضرورية بين الإرهاب وعِلل الواقع المستعصية. في وجه الإنسان وجوه، يقول الرومانسيون، ولو أكملوا لقالوا: خير الوجوه تعشق الأطفال والزهور. في زيارة لجابر إلى عمّان خرجت معه وعائلتي قال: أريد منطقة بلا ضوضاء لا تجذب المارة. وما إن تلامح شارع ضيق استقرت في نهايته أشجار بيضاء الورود حتى قال جابر: هناك، ومشى سريعًا وقطف «قبضة من الياسمين» وتبادل معها همسًا طويلًا، ذكرني بزيارته إلى بيت نزار قباني في دمشق، الذي جذبه فيه جماله القديم وأريج ياسمين انتشر في الفضاء. وعندها أخرج من جيبه حافظة أوراق وأخذ يقول لابنتي، بوجه فرح، هذه «صورة حفيدي».
في وجه الإنسان وجوه، يقول الرومانسيون، ولو أكملوا لقالوا: خير الوجوه تعشق الأطفال والزهور. في زيارة لجابر إلى عمّان خرجت معه وعائلتي قال: أريد منطقة بلا ضوضاء لا تجذب المارة. وما إن تلامح شارع ضيق استقرت في نهايته أشجار بيضاء الورود حتى قال جابر: هناك، ومشى سريعًا وقطف «قبضة من الياسمين» وتبادل معها همسًا طويلًا، ذكرني بزيارته إلى بيت نزار قباني في دمشق، الذي جذبه فيه جماله القديم وأريج ياسمين انتشر في الفضاء. وعندها أخرج من جيبه حافظة أوراق وأخذ يقول لابنتي، بوجه فرح، هذه «صورة حفيدي».