
فيصل دراج - ناقد فلسطيني | يوليو 1, 2024 | مقالات
لست أدري لمَ أقبلتُ، مبكّرًا، على قراءة ما هو متاح من كتب الهنغاري الماركسي جورج لوكاتش، الذي يصبح في الهنغارية: لوكاش جورجي. أذكر أنني بدأت بكتابه «الرواية التاريخية»، الذي تُرجم في العراق، وتلاه آخر عن «الرواية الروسية» تُرجم في القاهرة. ولم تأتِ ترجمة كتابه الشهير: «نظرية الرواية – 1914» إلا متأخرة، قام بها مترجم مغربي حصيف، رغم صعوبة اللغة، وكنت آنذاك لست بحاجة إليها، بعد قراءته بالفرنسية.
وعلاقتي بالكتاب الأخير أشبه بالحكاية، واضحة البداية لطيفة الانغلاق؛ ذلك أنني استعرت منه العنوان وبعض الأفكار في فترة محددة، وزهدت بها لاحقًا. فقد ارتكن لوكاش «نظريته في الواقعية» إلى مفهوم: الصراع الطبقي في الأدب، جعله مركزيًّا، وقرأ به توماس مان وبلزاك، وأغفل: «الصراع الطبقي في القيم الجمالية»، مفترضًا أن الشكل الروائي ثابت يصيبه تغيير قليل، وأن هناك شكلًا فنيًّا مرجعيًّا لا يصحّ تجاوزه، هو ذاك الذي جاء به تولستوي وبلزاك، وكان نظره هذا «أرسطويًّا» ولم يكن ماركسيًّا. وعندما انتقل في مرحلته الستالينيّة، والأرجح أنه كان ستالينيًّا طيلة حياته، إلى ما دعي «بالواقعية الاشتراكية» لم يغيّر في نظره شيئًا، منتظرًا «تولستوي أحمر» أو «بلزاك اشتراكي المنظور».
وواقع الأمر أن دوراني الطويل حول كتاب «نظرية الرواية» يعود إلى سببين: كتبه لوكاش شابًّا، وبقي الأشهر بين أعماله الفلسفية والنقدية الأدبية. وثانيهما أنني قرأته غير مرة. لا فرق إن كنت قد نفذت إلى ما يريد أن يقول، أو بقيت «أتعيّث»، كلمة مستعارة من الأستاذ الراحل حسين مروّة، وتعني: الوضوح المجزوء، أو المتوهّم، أو ذاك القصور الذهني الذي يقنع صاحبه أنه فهم ما يقرأ دون أن يكون، لزومًا، فهم فعليًّا ما قرأه.
تعرّفت إلى كتاب «نظرية الرواية» للمرة الأولى، في منتصف ستينيات القرن الماضي في عرض سريع له في «مجلة المعرفة»: السورية، قام به السوري فؤاد أيوب، تأكدي من الكنيّة لا يساويه يقيني عن الاسم العَلَم. جذبني إليه طويلًا لغته الأدبية- الفلسفية، وكنت آنذاك طالبًا في كلية الفلسفة في جامعة دمشق، وأنصتُّ إليه لاحقًا وأنا أقرأ «لوسيان غولدمان»، ناقدًا أدبيًّا وفيلسوفًا بدوره، أشهره كتابه: «الإله المحتجب»، درس فيه أعمال الفيلسوف الفرنسي باسكال. اطمأن غولدمان اليهودي الفرنسي الروماني الأصل إلى الكتاب المذكور، طوّر أفكاره، واتخذ منه دليلًا نظريًّا لدراساته الأدبية التطبيقية، وعن أندريه مالرو خاصة.
والأساسي، في الحالين، كلمة: «نظرية» التي تعني نسقًا من المفاهيم و«الكلية»، تسرد وتشرح وتوحّد بين بداية القول ونهايته. إضافة إلى إضاءة إلى التاريخ الاجتماعي- الثقافي الذي يتيح ظهور الرواية وتغيّرات البنية واللغة. وما كان احتفائي بمفهوم النظرية إلا حلمًا «شبابيًّا» عارضًا «هجس ببناء نظرية شاملة» في الرواية العربية، عاش فترةً وطواه الزمن.
دفعني شغفي بكتاب لوكاش الشاب إلى محاولة الكتابة عنه (شبه دراسة) في سبعينيات القرن الماضي في مجلة شؤون فلسطينية. تحدّث عنها بتحفّظ الصديق محمد برّادة حين التقيته، آنذاك، في بيروت. ولعل شعورًا بالعجز الحقيقي عن تملّك «نظرية الرواية» أملى عليّ إعادة كتابتها حين نشرتها في كتاب «قديم» عنوانه: «في دلالة العلاقات الروائية» قبل أن أعود إليها، مرة أخيرة، بوضوح نقدي في مطلع كتابي: «نظرية الرواية والرواية العربية».
تعرّفت إلى عمل لوكاش الشاب بمحاولات متعددة، ودفعني بدوره، إلى التعرف إلى مساهمات ذات صلة به، حال كتاب الفرنسي بيير ماشريه: «نحو نظرية في الإنتاج الأدبي»، استلهم فيه نهج أستاذه لوي آلتوسير، أخذني إلى اجتهادات الإنجليزي تيري إيجلتون، التي اتكأت على دراسات آلتوسير وماشريه معًا، قبل أن يتحرّر منهما، جزئيًّا. بيد أن الإنارة النقدية الأكثر اتساعًا جاءت مع الروسي باختين في دراساته عن آحادية وتعددية الأصوات عند تولستوي ودوستويفسكي.
عبث البحث عن نظرية
سواء كانت المراجع فعلية أو متخيّلة، فالأساسي ماثل في أمرين يُكمل أحدهما الآخر: إمكانية قول متسق عن نظرية في الرواية العربية، كما عبث البحث عن نظرية لا وجود لها، ولا لزوم. قادني إلى الأمرين، ومنذ زمن، قراءات قديمة أكّدتها قراءة بعض الروايات العربية الحديثة الصدور، أولها رواية: زهران القاسمي: «تغريبة القافر» التي حظيت باهتمام كبير، تثير أسئلة حول نظرية الرواية العربية المفترضة، أو المزعومة! فالنظرية تقول مدرسيًّا: إن الرواية ابنة المدينة، وأنها محصلة لعلاقات اجتماعية حداثية، بدءًا بالفرد وليس انتهاءً بتعددية العلاقات الاجتماعية، بعيدًا من المراجع الضيقة كالعشيرة والقبيلة، وأنها أثر للعلوم الاجتماعية الحديثة مثل الفلسفة وعلم النفس والممارسات السياسية.

زهران القاسمي
بيد أن القراءة، أسريعةً كانت أو متأنية لرواية زهران القاسمي، تبدأ بالقرية والجبل والوادي والبئر والبراري والأمكنة المهجورة والعائلة الضيقة… حتى لو أدخلنا عنصر: «المتخيّل الروائي»، فهذا لا يضير القراءة في شيء، فهو متخيّل يبدأ من القائم المحدود، يتوسّع محدودًا دون أن يسيء إلى السرد، ويأخذ بلغة دائرية، لا تحتاج إلى التنوّع والحرية وتنتهي، مهما تكن أبعادها، إلى نص إبداعي كثيف تكمل فيه اللغةُ المتخيّلَ، ينتجان، في النهاية، خطابًا سرديًّا، لا فرق إن تعددت شخصياته، أو أخذت فيه الطبيعة الأقرب إلى التجانس، مكان المجتمع في طبقاته المتعددة، كما يفترض المنظور الروائي (النظري) في شكله المدرسي، ذلك الشكل الذي يحرّره المؤلف ويدعه طليقًا.
والسؤال الأساسي: إن كانت الرواية «امتدادًا» للمدينة، فكيف تكوّنت وهي ترسم واقعًا لا علاقة له بالمدينة؟ جعل نجيب محفوظ من القاهرة، على سبيل المثال، المرجع الأساسي لروايته المتوالدة، مضيئًا بوضوح العلاقة بين الرواية والمدينة، واتخذ القاسمي من القرية متكأً لمتخيّله الروائي، وانتهى إلى عمل إبداعي يعيد النظر في دلالة «الفضاء الروائي»!
اللبناني رشيد الضعيف، الذي راكم نتاجًا روائيًّا نوعيًّا، كتب، بدوره، مؤخرًا رواية: الوجه الآخر للظل، الأقرب إلى حكايات متخيّلة تحيل، طليقة، على ألف ليلة وليلة و«كليلة ودمنة» وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وغيرها. يتلامح في عمله الروائي، المشار إليه، وجوه المتخيّل واللغة؛ العنصرين الروائيين الأساسيين، انتهى إلى «نثر كلاسيكي» بديع يرسم تعددية العوالم الطبيعية والإنسانية. إذا قفزنا فوق ما هو متعارف عليه في الكتابة الروائية، نلاحظ تأملًا فلسفيًّا لامعًا، تأملًا فلسفيًّا للوجود، لا تتضمنه «الرواية التقليدية» إلا نادرًا. كأن ينهي عمله بفصل أخير عنوانه: «دوران الأرض» تتوجّه جملة أخيرة غامضة: الأرض مدارية بما تحتضنه.

رشيد الضعيف
كاد رشيد أن يقترح للرواية تعريفًا جديدًا يقول: الرواية فضاء تكاملي طليق «تخلق الوجود وتضيف إليه أكثر مما هو موجود». نقرأ في الفصل ما قبل الأخير «ثورة العناصر» نثرًا تحرّر من «المرجعية الموضوعية»: «وإذ خرجت السماء عن صوابها، ازداد جنون الأرض وباتت مكشوفة على المفاجآت» و«أكثر ما فقد صوابه الشجر، فثار على شرطه، وثار على صمته وثباته في المكان ذاته مدى الدهر، وهجر أرضه…» أو: «ثم هدأ الكون واتضح، وسعت الطرقات إلى مآلاتها…» لا قد يهجُس القارئ هنا بتعددية العوالم، ويحاور «نثرًا أقرب إلى الشعر» وشعرًا يَتَفَلْسف يحتاج إلى أكثر من قراءة.
من المحقق أن رشيد الضعيف في عمله: «الوجه الآخر للظل» تقدّم بعمل روائي عربي لا يمكن مقارنته بغيره، نثره شعر وشعره نثر متقطع السرد وغائم الزمان والمكان، ينكر كل تعريف مسبق للرواية ويؤكد أنها كتابة تستعصي على التعاريف الجاهزة، كما لو كانت الرواية هي الحرية المطلقة القريبة من الشعر الصوفي، وأن للإنسان الحق في العيش، حرًّا، في حياته اليومية، وله حريته في أن يكتب كما يشاء. تغدو الكتابة في هذا المنظور تجسيدًا «مضمرًا» للحرية في إمكانياتها الفعلية المحتملة. كتابة تواجه كل القيود المعيشة والمحتملة، وهو ما يجعل «الوجه الآخر للظل» ظلًّا متعاليًا ينفتح على «حرية منشودة لا يمكن القبض عليها» لكأن «الظل» لدى الضعيف صورة أخرى عن «المثال» عند «أفلاطون» يلامس أطرافه الإنسان ويظل محتجبًا.
تعددية العوالم الممكنة
لا تطرح رواية الضعيف أسئلة حول «نظرية الرواية»، ولا تَعِدُ بنظرية جديدة، أو تشير إليها، بقدر ما تسائل «تعددية العوالم الممكنة»، تتخذ من «الفضاء الروائي» تجسيدًا متخيلًا لها، يبدأ بفضول الذهن وينفتح بلا نهاية، على قلق الروح، هذا القلق الذي تؤنسه الرواية، بلا شروط، ولا تقترح له بداية ولا نهاية. إن حرية «التذهين الروائي»، إن صح القول، تحرير للغة من استعمالها اليومي، ومن قيود الوجود الصغيرة والكبيرة معًا. إنها الحرية- المثال، المتطلعة إلى فضاء لا تفضي إليه السُّبل المعروفة ولا المجهولة أيضًا.

أمين الزاوي
كسرت رواية القاسمي المبدأ النظري القائل بأن الرواية انعكاس لفضاء مديني، وأظهر رشيد الضعيف أن الرواية فضاء لتأمل طليق لا ينصاعُ إلى النظريات، متحرر من بداهة: أن الرواية مزيج من التخيّل والواقع. فالأخير عند رشيد كلما تلامع تلاشى مؤكدًا أن ما يدعى بالواقع لا وجود له داخل الكتابة ولا خارجها. أما الجزائري أمين الزاوي فسلك في روايته الجديدة: «الأصنام» طريقًا آخر، يؤكد الرواية فعلًا نظريًّا حداثيًّا ومتخيلًا تضمنه اللغة، كما لو كان التخييل أثرًا للغة، تقترحه وتنشده وتبنيه.
يندفع القارئ الروائي إلى إبداع أمين الزاوي محرَّضًا بأمرين: جهده المتراكم النوعي السائر من رواية وازنة إلى أخرى أكثر إتقانًا وتجديدًا. لا مجال عند الزاوي للمراوحة والإنتاج الكمّي، فهو مشغول بكيفية الكتابة والوفاء للسؤال الصعب: لا تقوم الدلالة في اجتراح الأفكار إنما تتعين بطريقة كتابتها التي تستولد أفكارًا جديدة. كما لو كانت الكتابة تستنطق الأفكار وتستولدها في آنٍ.
الأمر الثاني، الذي يستكمل الأول، ماثل في ثقافة الروائي أو الثقافة التي تعلن عنها الرواية، موحّدة بين المأثور العربي وقوة المعيش اليومي والكونية الثقافية التي تجسّر المسافة بين بول إيلوار الشاعر الفرنسي، وكاتب ياسين، الأديب الجزائري المهجوس بتثوير الكتابة والمجتمع معًا.
وثيقة نظرية
قد يكون في روايته الجديدة: الأصنام، الصادرة هذا العام، ما يجعل من الرواية وثيقة نظرية- سياسية معًا، تبدأ من السلطة السياسية وتعود إليها، شارحة معنى الاستبداد والديمقراطية، وكاشفة عن مآل الشعوب المستبدّ بها وعن هشاشتها التي تأتي بمستبد لا قيمة له يَعُدّ ذاته كيانًا نجيبًا متعاليًا. ولهذا انطوت رواية «الأصنام»، التي جمعت بين ألق الأسلوب ووحدة المفاهيم النظرية، على ثنائيات تختصر علاقة «الرعية» بالسلطة: التحرر الوطني/ الاستقلال الوطني؛ إذ في عِثَار الثاني وتداعيه ما يعطّل معنى الاستقلال ويلغي دلالة التحرر. وهناك ثنائية العقل الطليق/ والفكر المعتقل؛ إذ الأول يشرح قيمته بممارساته، وإذ الثاني علاقة اجتماعية تتسع فيها الخرافات ويتسيّد عليها «حرّاس الضمائر» الذين يحوّلون الحياة، اعتمادًا على بلاغة متدينة زائفة، إلى جملة عادات مستبدّة تغلق المستقبل.
وهناك أيضًا المواجهة بين التعصّب الصادر عن تراتب اجتماعي محكوم بالمصلحة والتسامح الذي يأخذ به بشرٌ لم يفقدوا عقولهم ولا ضمائرهم. وأخيرًا الفرق بين المرأة كشيء لا قيمة له وككيان له الحق في التصرّف بعقله وجسده ومقدّراته، كأن الفكر المظلم ينتزع من الإنسان إنسانيته مقابل عقل حواري يؤنسن البشر ويحضّهم على التفتّح والانطلاق.
يقال نظريًّا، عادة: يُنتج كل عمل روائي أيديولوجيا خاصة به، واضحة أو مضمرة. شَخْصَنَ أمين الزاوي الأيديولوجيا الروائية، ووزّعها على بشر اعتُقلوا قبل ولادتهم، وتمرّدوا على الموروث بخيار حر يُردي التربية الجاهزة، وتلك المحروسة بمتواليات من العسس والمخبرين، ومراجع دينية تختصر الدين في الربح والخسارة، وفي «ثقافة أدعية» تقاتل الحياة.
اتكاءً على ما سبق فإن القول بنظرية روائية ادعاء أكاديمي لا يستطيع الوقوف، ذلك أن كل عمل روائي جدير بالقراءة يقترح منظورًا خاصًّا به. وتنتمي تلك النظرية غالبًا إلى التطورات الفلسفية أكثر منها إلى النقد الأدبي أي أنها لا تفيد الرواية بشيء.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | مايو 1, 2024 | مقالات
يقال: إن دور المثقف تغيير الواقع. والقول لا دقة فيه، فدوره، كما دور الثقافة عامةً، تغيير وجهة النظر إلى الواقع. الأفكار لا تغير إنما الذي يغير هو حامل الأفكار التي قد تكون نسبية؛ تنقد معيش البشر وأفكارهم، أو قد تكون قطعية، حاسمة؛ تؤكد «حتمية التحول»، مساوية بين رغبات الإنسان وأفكاره. يحيل ما سبق إلى عنصرين: مقولة: النظرية التي هي جملة مفاهيم عقلانية تتكئ على نسق من المفاهيم التاريخية، تمايز بين الصواب والخطأ، ومقولة: الأيديولوجيا التي هي مزيج من الوهم والحقيقة، ترسم غالبًا منظورًا شموليًّا يمس الحاضر والماضي والمستقبل وتخترع «مثقفًا رَغَبيًّا».
قيد الحقيقة المطلقة
عرف تاريخ الفكر العربي الحديث أيديولوجيات ثلاث: القومية والإسلام والماركسية، التي لا وجود لها في صيغ نقية خالصة. فالأولى منها امتزجت بعناصر دينية، ولم تتحرّر من الدين، تقريبًا، إلا في شكلها العلماني القلق. والأيديولوجيا الإسلامية، لا وجود لها في صيغة المفرد، فتأويلات الإسلام كانت، ولا تزال، متعددة، تنوس بين الثبات والتطور. أما الماركسية، التي تبدو اليوم بُقْيَا من زمن مضى، تقريبًا، فاختلطت بالعلم وسقطت في تعصّب أعمى، الدوغمائية، أي التكلّس المنقطع عن الحياة والممارسة. وواقع الأمر أن لكل أيديولوجيا دوغمائية خاصة بها، وإن كان المسيطر فيها الدينية والماركسية، فكل منها آمنت بالحقيقة المطلقة.
يفضي التصور القائل بالحقيقة المطلقة إلى نتائج مجردة: أولية الأفكار على الواقع المعيش، كما لو كان الفكر خالقًا للواقع وسيدًا عليه، أولوية «الفكر الدوغمائي» على تاريخ الأفكار، ما يساوي بينه وبين الحقيقة، وإعلاء الفكرة الثابتة على الممارسة ما يلغي فاعلية العقل، ويحوّل «النظرية المفترضة» إلى لغو ذهني لا نفع فيه. وفي الحالات جميعًا تبدو الحقيقة، المطلقة قيدًا يقدّس الحتمية، كما لو كانت تعاليم إيمانية ومقدسة. ولهذا يمكن تسمية المثقف المرتبط بها: المثقف الإيماني المقيّد على خلاف المثقف العقلاني المشدود إلى نسبية الوقائع والأفكار.
اطمأن ساطع الحصري، المفكر القومي على سبيل المثال، إلى قومية عربية خالصة لا تحتاج إلى برهان، فإن كان من برهان، أو ما يشبهه، كان مجزوءًا «غائم التاريخ» فهو معطى دفعة واحدة؛ لذا عثر الحصري على «قوميته» في ماضٍ بعيد -معركة ذي قار قبل الإسلام- ومع أن القومية معطى حديث يعود إلى القرن الثامن عشر -بالمعنى الأوربي- وإلى بدايات القرن العشرين بالمعنى العربي، اعتبرها الحصري فاعلة في جميع الأزمنة: فهي جزء من الإسلام، والإسلام جزء منها، وهي أساس الوحدة العربية القادمة بقدر ما أنها مرجع الدولة القومية الراهنة، بل إن لا اختلاف بين القومية التي سبقت الإسلام وقومية دولة العرب في الأندلس.

ساطع الحصري
تساوي الفكرة القومية عند الحصري القومية العربية المتحققة، ما دامت الفكرة تتعين بالإيمان بها، وتصدر الفكرة وتجسيدها عن اللغة والثقافة العربيتين اللتين بدورهما لهما تاريخ أثيل و«مجيد»، وتذهبان إلى مستقبل لا يختلف عن ماضيهما، أي تتصفان بصفة الخلود. كأن القومية العربية من «خارج التاريخ»، يحتاجها الأخير ولا تحتاجه، وتنبثق حيث «يأمر» الداعمون لها بذلك، تحتجب ولا تغيب، كالأصل الذي صدرت عنه، وهو ما ألمح إليه القومي سهيل إدريس في روايته: «الحي اللاتيني»، حيث الحضارة الأوربية تولد وتنطفئ مرة واحدة، بينما الحضارة العربية قديمة وقادمة، ولا تغيب إلا لتعود.
وإذا كان مآل القومية من مآل القائل بها، يخترعها ويتصرف بها ويتحكم بأقدارها، فإنه يبدأ بوهم وينتهي إلى أوهام. رأى الحصري أن ما يعطل مسار القومية ماثل في الاستعمار، وما إن يرحل حتى تنطلق بلا قيود، تخلق الدولة القومية وتمتد إلى الأمام؛ كي تبني الوحدة العربية وتوطد كيانها وتقتلع الاستعمار، وتبني ما تشاء من «قصور الرمال».
الفصل بين الفكر والواقع
لم تختلف الماركسية العربية عن القومية العربية، شاركتها مراحلها الثلاث: التحرر من الغبن والاستغلال، صعود الطبقة العاملة الحتمي، الذي هو اختراع نظري في عالم عربي لم يعرف الثورة الصناعية، السير المطمئن إلى «المجتمع الاشتراكي»، أي المدينة الفاضلة، التي تعادل نظريًّا: تحقق الوحدة في الفكر القومي. والتصور في الحالين شكل من «التذهين المتفائل» يقرر ما يرغب فيه صاحبه؛ لذا توهم الفكر القومي أن الوحدة ممكنة في جميع الأقطار العربية، لا فرق إن تمتع المجتمع بثقافة قومية أو كان شبه أمي يتلعثم أمام اللغة العربية السوية. ولذلك أيضًا ظهرت دراسات عن «مستقبل الاشتراكية في الهلال الخصيب» وآفاق الاشتراكية في الصومال!
آمن «المثقفون العرب» الداعون إلى الوحدة والاشتراكية بقوة الأفكار المرغوبة قبل أن يتعرفوا إليها، وحرروا الأفكار المتحررة من العوائق الاجتماعية… وواقع الأمر، كما دللت الوقائع فقد فصلوا بين الفكر والواقع، وبين الواقع والتاريخ، وبين الأخير والسياسة على اعتبار أن السياسة حرفة لا تستدعي، الطبقات وتكوين المجتمع، وأنها، في الفكر الرغبي، تُختصر في أحزاب «نخبوية»، لا فرق إن كانت مدنية مثقفة أو عسكرية تحتفي بالإخضاع والانصياع، ولا تعنيها مبادئ السياسة في شيء. وهكذا نرى أن قومية الحصري مكتفية بذاتها، إن اعتورها نقص «عارض» جاء من الخارج -الاستعمار- وما إن يطرده العرب حتى تعود إليهم قوميتهم «بلا دنس»، فتنصرهم وينتصرون بها.
الماركسي اللبناني مهدي عامل، الذي اشتهر عربيًّا وترجم إلى الفرنسية، قاسَم الحصري مبدأ التبشير، القائل بالحقيقة المطلقة، حيث الماركسية علم دقيق كأنها الفيزياء، والطبقة العاملة علمية القياس والمنظور، والحزب الشيوعي خلّف، الفكر البرجوازي وراءه وجاء بحقيقة أخيرة بلا خطأ. لا مجال للاختبار والتجريب، ما دامت القومية تبدأ من الصواب والماركسية علم كعلوم الطبيعة والمجتمع الشيوعي حتمي الوصول حال الوحدة العربية التي هي قدر العرب جميعًا!
الموقف من الديمقراطية
المفكر المصري طه حسين اقترب من الديكارتية، أي فلسفة الفرنسي ديكارت القائمة على الشك، فلا وجود لحقيقة جاهزة ولا لفكرة صحيحة قبل البرهنة عليها، وأن الشك مبتدأ للمعرفة، وأن الحقائق يأتي بها التاريخ ويمحوها التاريخ. فبين القدماء والعقول الجديدة مسافة واختلاف، وأن جديد المجتمعات سيرورة قوامها العقل والديمقراطية. ولهذا اعتبر العقول في وسط اجتماعي لا ديمقراطي فيه عقيمة بائرة تخالطها الأكاذيب، وأن ديمقراطية لا تحتكم إلى قواعد العقل فارغة المضمون، وهو ما شرحه وأسهب في شرحه في كتابه: «مستقبل الثقافة في مصر»، حيث كلمة المستقبل تحدّد الحاضر وتصحّح ما جاء به القدماء، وتعاين ما يجري سائرًا إلى الأمام. يسير الإنسان إلى الأمام ولا يستغرقه الماضي إلا إذا كان معطّل المحاكمة والحواس.

بريخت
لم يكترث الحصري بالديمقراطية، كما لو كانت القومية العربية في ذاتها «تتجاوز» الديمقراطية وتلغيها. واعتبرها مهدي عامل «بدعة برجوازية» تعمي الأبصار وتحرف البشر عن السعي إلى مصالحهم، بينما أقام طه حسين وحدة عضوية بين الأفكار والديمقراطية، وعيّن الشك المنهجي درجة من درجات المعرفة. كان في منظوره، وهو الأعمى- البصير، يحتفل بالأنا المفكرة، أي بالمفرد الذي يقوده عقله ويقود عقله. فلا وجود لعقل فاعل إلا بإنسان مفرد يتمتع بالعقل والمعرفة ويختبرهما بالفعل والتجربة.
نفى طه حسين اليقين الأعمى واعتنق الشك المنهجي، ووضع المثقف الإيماني بين قوسين، وأنتج معرفة جديدة بالتاريخ والسياسة. أما المفكر الكوني إدوارد سعيد فقال بما دعاه: المثقف الهاوي الذي يتكئ على معارف مختلفة، ويجسد المسافة بين المعارف المتنوعة وتوحدها. فلا وجود لمعرفة مفردة مكتفية بذاتها ولا لمثقف يرتكن إلى معرفة وحيدة. كان أستاذًا جامعيًّا يكره الاختصاص ويعيّن المعرفة فعلًا ديمقراطيًّا، ويوكل إلى المثقفين دورًا نقديًّا ينكر الاستبداد واحتكار المعرفة المختصة. ولعل مبدأ: المثقف الهاوي هو الذي مر به الإيطالي أنطونيو غرامشي الذي قال: «إن جميع البشر فلاسفة ومثقفون ومربّون». وإن التلاقي ممكن بين الثقافة الشعبية والأكاديمية.
كشف طه حسين عن «حداثته»، مؤكدًا أنه لا معرفة إلا بمفرد «يتسلّح بعقله» وينكر الجماعة المتجانسة؛ ذلك أن التجانس سكون ودفاع عن «عادات التفكير الجامدة». وأعلن سعيد عن حداثته الفكرية في حوار الأفكار والنظريات الكونية، في تلك «البينية» الرافضة لاختلاف الأفكار والمفكرين. قال المفكر القومي الحصري بالقومية وأجهض ما هو حديث فيها، واستبسل مهدي عامل في الدفاع عن الماركسية كأنها دين آخر. ناصَر طه حسين وإدوارد سعيد التعددية الفكرية التي تترجم دلالة الحداثة في الحياة الاجتماعية والحياة العقلية، فالتعدد أساس الحياة والوجود.
المعرفة والذات العارفة
من المحقق أن المثقف الإيماني يضيف إلى موضوعه ما ليس فيه، كما لو كان بدوره علاقة معرفية.. هو في هذا ينكر موضوعية المعرفة، ويصيّر العلم إلى علم زائف وذاتي الأبعاد، يتداعى علم التاريخ وعلم الاجتماع والاقتصاد وغيرهما… يتحول الأول إلى مجموعة من القصص والحكايات، والثاني إلى تصورات ذاتية، والثالث إلى أرقام مجردة. ينتقل المثقف، حينئذ من حالة الإيمان بالمعرفة إلى المتسلط عليها، إلى مثقف يضع معتقده الذاتي فوق قوانين المعرفة، وهو حال المثقف الحزبي والطائفي والعشائري…

كارل بوبر
فصل المسرحي الألماني بريشت بين المثقف الحزبي والمثقف المتحزب، فالأول يعطل محاكمته الذاتية ويردد بداهات جاهزة، في حين أن الثاني يجعل من إعمال عقله جزءًا من معارفه، مؤكدًا العلاقة بين العقل النقدي والمعرفة، وبين الاستقلال الذاتي للعملية المعرفية والإبداع الذي يحيل إلى تاريخ المعارف لا إلى الأشخاص.
أكد كارل بوبر، الفيلسوف اليهودي المعادي للصهيونية، ضرورة الفصل بين المعرفة والذات العارفة، واعتبر أن الإيمان بالصهيونية يطرد المعايير الموضوعية وينبذ، تاليًا، المعايير الأخلاقية، فلا يقبل بالمساواة ولا بالعدالة ولا الاعتراف بالآخر «غير الصهيوني». بل إن الانغلاق الأيديولوجي، الذي يهمّش معطيات الحياة، يترك آثاره على اللغة أيضًا، فتتجمد وتتكلس وتعارض التطور. ولهذا عزا الشيخ محمد عبده جمود اللغة العربية، أحيانًا، إلى رجال الدين المتعصبين الذين يحتفون بالثبات والسكون. ويظنون أن الشباب فعل مقدس. على اعتبار أن اللغة العربية مقدسة، وأن مراعاة تقديسها يقضي بثباتها. لا غرابة أن يتطير بعض رجال الدين من «الرواية» والمسرحية وغيرهما من الفنون المرتبطة بوقائع الحياة. أكثر من ذلك أن التصور الخاطئ لعلاقة الدين الإسلامي باللغة «يحرض» العقول «الاستشراقية» على التهوين من شأن اللغة العربية، واعتبارها غير ملائمة للكتابة الروائية مثل الجزائرية آسيا جبار، وعلى سبيل المثال المصري عادل كامل صاحب روايته «مليم الأكبر».
وأخيرًا تقضي الثقافة بالاعتراف بجديد الحياة وتطور الحاجات الإنسانية، وهو ما يؤكد ديمقراطية المثقف الهاوي، وقصور وعجز المثقف الإيماني حتى لو كان نبيل الأهداف.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | مارس 1, 2024 | مقالات
تتوزع حياة الإنسان على وضعين: وضع أول يدعوه الفلاسفة: الاغتراب، يتسم بالنقص والحرمان، ووضع ثان يحلم به ويتطلع إليه وهو: عالم التحقق أو: اليوتوبيا.
يتعرف الاغتراب، فلسفيًّا، بفقدان الإنسان لجوهره، وتوقه إلى استعادة جوهره المفقود بعد أن يتغلب على العوائق التي تشوه حياته. وما الجوهر المفترض إلا العمل الذي يبذله الإنسان في بناء ذاته. ولهذا يقال: يساوي الإنسان جملة ممارساته العملية والنظرية، كما لو كان يبني ذاته وهو يبني موضوعات حياته، ويتطور وهو يطور حاجاته، على اعتبار أن تطور الحاجات الإنسانية يقاس به تقدمه.
إذا كانت ماهية الإنسان من رغباته المتحققة أو المقموعة فإن اغترابه مما انتهى إليه، ما يعطي الاغتراب مراتب متعددة تنطوي على: المغترب، الغريب، المنقسم، اللاجئ،… الهامشي، المهاجر،… مع أن لكل مرتبة من الاغتراب ما يميّزها، نسبيًّا عن غيرها، تظل الفروق بينها ملتبسة ومبتورة، بل إنها تتداخل أحيانًا وتلغي الحدود بينها، نسبيًّا؛ إذ في كل مغترب غريب، وفي كل مغترب غريب إنسان منقسم غائم التعريف، ولكل واحد منها أقداره الممتدة من شقاء الروح إلى المجاهدة والمطاردة إلى عبث لا أفق له.
ولعل غربة الإنسان المتعددة، كما انقسامه الصادر عن شروط اجتماعية متنوعة، تفرض عليه غربة عن ذاته، فيعرف ذاته ولا يعرفها، يسيطر على وجه منها ويضطرب وهو يبحث عما تبقى. ذلك أنه لا يسوق حياته إلا إذا تعرف إلى إمكانياته الواضحة- الغامضة. ولهذا بدأ سقراط فلسفته بسؤال شهير: «اعرفْ ذاتك»، حيث الذات غموض يتكشّف منقوصًا دائمًا، يتوهّم الإنسان معرفتها، لكنها تَفِرُّ منه ذاهبة من زاوية عمياء إلى أخرى.
لا يختلف سؤال «اعرف نفسك بنفسك» عن عين تريد أن تبصر ذاتها، كما لو كانت تحتاج إلى عين أخرى. نعود إلى سقراط مرة أخرى حين يقول: «إن عينًا تتطلع إلى ذاتها تحتاج إلى عين أخرى وإلى تعريف معنى الرؤية»، وهو الأمر الذي يعني أن الغريب يتعرف إلى ذاته وهو ينظر إلى غريب يجاوره دون أن يصل إلى ما يريد. فالغريب، كما يقال، لا تاريخ له، يرى الآخرون خارجه ويظل داخله مستترًا. كما لو أن أحوال الغريب لا يلمسها إلا الغريب.
يساوق التعرف إلى أحوال الغريب شيء من العَمَاء تضيئه شروطه ولا يتمثلها إلا هو، فهي تستدعي المعاناة والسياق، وهو ما يجعل من الرواية مرآة ضرورية تعكس أحوال الغريب، أكان ذلك غريب نجيب محفوظ في «اللص والكلاب»، أو لاجئ غسان كنفاني في «رجال في الشمس»؛ فالأول تطارده السلطة السياسية حتى ترديه قتيلًا، والثاني يطارده لجوؤه إلى أن يتبدّد، أو يقضي بعد سقوطه ويذهب إلى اتجاه جديد.
والسؤال: ما ماهية اللاجئ الفلسطيني، في وضعه الإنساني الاستثنائي؟ كيف يكتب الروائي اللاجئ غسان كنفاني عن شخصياته التي هي لاجئة بدورها؟ لا جواب إلا برؤية روائية تضيء الروائي وشخصياته. تناول غسان موضوعه بمقولة: العار الذي لاحق فلسطينيًّا «فرّ من أرضه»، استحق التوبيخ والعقاب. ولهذا أمعن غسان في العقاب، وحكم على شخصياته بالموت، ألقى بها على قارعة الطريق وتركها بلا قبور.
عَمَاء الوجود
بيد أن «عَمَاء الوجود» الذي يجعل لاجئًا يوغل في عقاب لاجئ آخر يطرح سؤالين: لماذا انتقل غسان من شكل روائي إلى آخر؟ وهل أخذ غيره من الروائيين الفلسطينيين بمنظوره؟ تضمن مسار غسان ما يشبه (النقد الذاتي)، فبعد العنف الشديد الذي تعامل به مع شخصياته الروائية في روايته الأولى، عاد وقال: أريد أن أكتب رواية فلسطينية مئة بالمئة، وانتقل مباشرة إلى شكل روائي مختلف، كما هي الحال في «ما تبقى لكم»، و«أم سعد»، و«عائد إلى حيفا»… راسمًا الشرط الفلسطيني في «وجوهه المختلفة» الذي يحتمل الفرح والحزن والنبل والخديعة والتكسّب والتضحية بالذات…إلخ. لم يكتفِ بفكرة العار أضاف إليها بُعد المقاومة في الرواية الثانية، وصورة الهامشي في الثالثة، والذاكرة وخطاب العدو الصهيوني في الرابعة. وما إن وصل إلى مطلع «برقوق نيسان» حتى اقترح شكلًا روائيًّا جديدًا، جمع فيه بين الحاضر والماضي… وصل إلى نتيجة تقول: إن هوية اللاجئ من فعله المقاتل ضد اللجوء، ومستعيرًا ما قاله أندريه مالرو عن معنى الإنسان الذي هو محصلة لأفعاله المختلفة، مدركًا أيضًا الفرق بين وضع اللاجئ الاستثنائي ووضع الإنسان المغترب الذي بقي في أرض له.
الأرض/ الوطن أو الموت، على الإنسان أن يموت واقفًا، وعلى اللاجئ أن يعود إلى حيث كان، والهامشي لا وجود له، والمنقسم لا يعرف معنى الكرامة، والمهاجر إنسان ضل الطريق… أدرج غسان في رواياته قصدية مقاتلة لا يتحملها «السياق الفلسطيني»، المحاصر بأكثر من حصار؛ لذا بدت مقولاته مزيجًا من الشعر والإرادة الحائرة، ذلك أن الاستثنائي لا يصبح قاعدة إلا إذا اخترع «وجودًا مستحيلًا» لا تقبل به إلا رواية مستحيلة لها شروطها العادية المعيشة وزمنها الذي لم تعبث به الأقدار.
الرواية الفلسطينية المستحيلة، مزيج من الرغبة والحنين، تؤالف بين ما كان وما سيكون، ولهذا كتب حسين البرغوثي، وهو مبدع قصير العمر، عن أطياف فلسطين الغاربة في روايته «سأكون بين اللوز». واجتهد إميل حبيبي في رواية «إخطيّة» في وصف فلسطين «أيام العرب»؛ ذلك الأمن الدافئ الذي تداعى. أما جبرا إبراهيم جبرا «في البحث عن وليد مسعود» فاحتفى بفلسطيني «طوباوي»، تستولده الذاكرة ويمنع تحققه الواقع.

اشتق جبرا إنسانه الفلسطيني من مدينة القدس، وعطف ابن المدينة المقدسة على السيد المسيح، وصاغ من الطرفين شخصية تُسلّم قيادتها إلى الخير والجمال وتستعصي على الأرواح الشريرة. احتضنت رواياته فلسطينيًّا مقدسيًّا وسيمًا ذكيًّا عاشقًا للشعر والموسيقا، متفوقًا يحاكيه غيره ولا يحاكي أحدًا، فهو «ابن ذاته» وسيد حياته. طرد جبرا مأساة الفلسطيني بالأحلام، واعتبر الأحلام قوة منتصرة.
كتب جبرا رواية حالمة «متوهمة»، ليس بينها وبين الرواية الممكنة علاقة، فالأخيرة لها فضاء مكاني موحد وزمن موحد ونهاية واضحة، خلافًا لرواية جبرا التي عبّرت عن بطولة الثقافة والجمال والانتصار الخالص، وأنجبت بطلًا أثيريًّا لا علاقة له بحياة العاديين من البشر الذين تمتزج فيها حياة المأساة والملهاة، وواقع الأمر أن المكان الفلسطيني بعد اللجوء جملة من الأمكنة، وأن زمنه جملة من الأزمنة. وأن الفلسطيني الموحد لا وجود له بعد الشتات.
الاغتراب المقاتل
ظلّلت المأساة الرواية الفلسطينية «الحقيقية»، وهي جملة من الاحتمالات الدامية، آيتها مدينة غزة التي لا تتقي البرد إلا إذا راهنت على وجودها، تنتزع بطولتها الإعجاب والتحية وتعامل مستقبلها بمنطق الرهان والاحتمال. تقاتل ولا تعرف إلى أين تسير، وتنظر إلى المستقبل وتكاد لا تتذكّر الماضي إلا كلحظة سعيدة لن تعود. لكأنها تلتبس بصورة «سعيد مهران» بطل محفوظ في روايته «اللص والكلاب»، الذي يسير إلى حيث يرغب وتعبث بخطواته الدروب الشائكة.
غزة في صورتها الأولى مرآة «للاغتراب المقاتل»، وهي في صورتها الثانية دمار وشرف، وفي بعدها الأخير «يوتوبيا الانتصار»، الذي يتبخر إن أشرقت الشمس. هويتها رغبة وموت ومقبرة ونشيد، أي مأساة تغرقها الأماني والدموع. بطولة مغتربة مسكونة بالانقسام تساوي نواياها ولا تجسد أفعالها المباشرة، كما أراد أندريه مالرو الذي قال: «صورة الإنسان من أفعاله»؛ ذلك أنها تبني صورتها مشرقة يمحوها الاغتراب، فعلى الإنسان أن ينجز ما يستطيع ويدع الرواية تسردُ معادلات واقعية وغير واقعية في آنٍ.
ما يجب التذكير به أن الغريب واللاجئ والمنفي، ولكل منهم اغترابه، تلاحقهم صفات ثلاث: الاستثنائي والاتهام والخوف الذاتي. فليس للغريب حقوق المواطنين الذين يعيش بينهم، فغير مقبول أن يحتل وظائفهم، ولا أن يتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، ولا أن يشاركهم احتجاجهم و«مظاهراتهم»: إنه داخل القانون وخارجه، يعاقبه إن أخطأ كالآخرين، ولا يسامحه إن سامحهم أو خفّف عنهم الأحكام. تغذي فيه استثنائيته الاجتماعية شعوره بالنقص وتملي عليه حياة إنسانية ناقصة. ألمح إلى ذلك جبرا إبراهيم جبرا في روايته: «صيادون في شارع ضيق»، حيث الوافد الفلسطيني موضوع للنقد والنكد والاستبعاد.
يأخذ اتهام اللاجئ شكل البداهة، فهو ليس في وطنه ولا حق له في وطن الآخرين وعليه أن يخفض رأسه ليتقي أشواك الاتهام. عالجت سميرة عزّام حيرة اللاجئ في قصتها القصيرة «فلسطيني»، حيث الضفة لا تشير إلى وطن مفقود أفقر اللاجئ إنسانيًّا ومعنويًّا، بقدر ما هي إعلان عن: النقص يدفع به إلى شراء هوية «لا تشترى»، فنقصه يلاحقه من الصباح إلى المساء. وقالها غسان في روايته «عائد إلى حيفا» التي استنكر فيها اللواذ بالذكريات، فهي حفنة من الصور المتقادمة، أكبر في عدوه استعداده للقتال، واتخذ منه «معلّمًا» جديرًا بالاحترام. ربما تكون هذه الرواية فريدة في جرأتها ومنظورها ووحيدة في حوارها الشجاع مع اليهودي الذي احتل فلسطين؛ ذلك أن معظم الروايات الفلسطينية اكتفت بتسخيف اليهودي دون الاعتراف بإمكانيته الإنسانية المقبولة والمرفوضة.
الغريب المسورة حياته بالخوف صورة يلتقطها الأدب مجزوءة، وتتضح أبعادها في الحياة كائنًا متهمًا تلاحقه الأسئلة، مشكوكًا في وجوده وإنسانيته، عليه أن يتذكّر أمام مخبر بليد اسم جدّه الخامس، والبيوت التي سكنها، والمواقع التي مرّ بها، وأسماء أصدقائه الأحياء والأموات والذين سيموتون قريبًا.
استولد كابوس الغربة وشقاء الاتهام وتهافت «الأجهزة الأمنية المتسلطة» صورة الوطن المفقود، وخلق «يوتوبيا» الغريب الراجع إلى وطنه. تعني «يوتوبيا» حرفيًّا المكان الذي لا وجود له، فهو أمنية ورغبة، وهو في الحلم متجانس وشامل ولا انقطاع فيه وغريب اللغة. وإذا كان القرن الثامن عشر في أوربا خلق اليوتوبيا من العلم والفضيلة والأنوار، فإن يوتوبيا الغريب/ اللاجئ/ المنفي، الذي سقطت عليه أكثر من مجزرة عالم لا تنقصه العدالة، يعرف القانون ويطبقه على الجميع، لا يحوّل البيوت إلى سجون ولا يملأ الشوارع بالمخبرين ولا يصيّر مدينة محاصرة فقيرة إلى «مقبرة للأطفال».
إذا كانت يوتوبيا عصر التنوير التاسع عشر مهجوسة «بالتقدّم»، فإن يوتوبيا اللاجئين مهجوسة بهواء نظيف لم تدمره القذائف والطائرات، تقدمه رحمة وأنواره عدالة مشتهاة.
لا غرابة أن يكون بين السعادة والرواية مسافة واسعة. فلا وجوه حقيقية تخفق في نهايتها رايات الانتصار منذ أن ابتلع «موبي ديك» البحار العصابي «إيهاب»، وصولًا إلى مصري فقير وشجاع يدعى «سعيد مهران» قتل قبل أن يداعب طفلته «سناء»، انتهاء بمتشائل إميل حبيبي؛ حيث التشاؤل مناورة متقشفة تسمح للوجه أن يبتسم شرط ألا يختلج، وللعينين التمتع بالربيع وهما مغلقتان، وتعد مدينة غزة الفلسطينية بشتاء لطيف القنابل.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | يناير 1, 2024 | مقالات
يحتمل المثقف، كما تصوره الكتابات المتعددة، صفات متنوعة: فهو المرشد والهادي والمتعلم والمعلِّم النوعي والثوري والناقد، وغيرها من صفات ممتدة، كما لو كان «كاتبًا» لا تعريف له يُختصر، ضرورة، في بعدين: الكتابة والمعرفة؛ إذ في الكتابة ما يوحي «بمهنة» وفي المعرفة ما يحيل على اختصاص… بيد أن البعدين لا يأتيان بتعريف بقدر ما يؤكدان «هشاشته»؛ ذلك أن المهن متعددة والاختصاصات كثيرة.
كتب إدوارد سعيد في «صور المثقف»: «لكأن في أقدار المثقفين ما يشبه خصائص الأنبياء…». وخصائص الرسل تنطوي على الإصلاح والهدى والإرشاد والتهذيب وتوليد أرواح جديدة، كما لو كان عالم المثقفين آية على عالم القيم والأخلاق الكريمة.

مهدي عامل
أما المفكر القومي ساطع الحصري فذهب إلى فضاء القيم من باب أكثر تحديدًا حينما كتب: لا تقوم القوميات إلا بمثقفين نوعيين. يشرحون معنى القومية ويكشفون عن ضرورتها ودلالتها، فالشعوب بلا قومية واهنة مريضة، والقوميات بلا مثقفين جماعات ضائعة. أعلن الحصري عن ذاته مثقفًا قوميًّا صريحًا يبشر بتاريخ عربي جديد، قوامه الوحدة والتضامن واستلهام أرواح الأجداد وتفعيل الذكريات البعيدة المنتصرة. المفكر الماركسي اللبناني مهدي عامل، في كتابه الكبير «نمط الإنتاج الكولونيالي»، اطمأن إلى مصطلح: «المفكر الثوري»، الذي ينحاز إلى طبقة اجتماعية صاعدة، ويندد بطبقة أخرى تأتي بالتبعية والاضطهاد. نسب الحصري إلى مثقفه دورًا محددًا، يتجاوز الطبقات جديدًا ويلتزم «بروح الأمة التليد»، واكتفى عامل بمثقف وطبقة وأسبغ عليهما صفة: الثورية، التي تنقل المجتمع من مرحلة «ما قبل التاريخ» إلى ما بعده وتستولد تاريخًا غير مسبوق.
المثقف الجمعي
تقاسم مثقفو إدوارد سعيد والحصري ومهدي عامل صفة عامة مشتركة، تقوم على عارف، يرشد غيره، وآخر -«أقل مرتبة»- يحتاج إليه ويختلف عنه في الغاية والهدف. وإذا كان في المثقفين ما ينسبهم إلى «الأنبياء»، بلغة سعيد، فإن دورهم، الصريح والمضمر الارتقاء، «برعيتهم» من طور إلى آخر أكثر علوًّا… يخالط الدور، على رغم نبله، سلب يثير الارتباك؛ ذلك أن هذا الرسولي والقومي والثوري يكتفي بفرديته، ما يجمع بين المثقف و«الفرادة»، على اعتبار أن «الفردية» في ذاتها، قيمة إيجابية أكيدة.

إدوارد سعيد
ولعل الاحتفاء بالفرد العارف، المتميز عن الذين يتوجه إليهم، يفرض الانتقال من صفة الفرد إلى معيار أكثر اتساعًا هو: الثقافة الاجتماعية التي تستدعي «الجماعة». كتب الإنجليزي ريموند ويليمز في بحث طويل: الثقافة نمط شامل من الحياة يأخذ به أفراد المجتمع جميعًا. يُشتق المثقف، والحال هذه، من ثقافة مجتمعه، ولا يكون مفردًا، تصوغه ممارسات المجتمع الذي يعيش فيه، التي تتضمن القراءة والكتابة والإقبال على الفنون الحديثة، والتعرف إلى الحياة السياسية وإلى الفرق بين الدكتاتورية والديمقراطية والانفتاح على الثقافة العالمية…. وكما يربّي المجتمع مثقفه، فهو ينتج مثقفين تخرجهم الجامعات وتدعم ثقافتهم المجلات والكتب وإصدارات دور النشر ويشاركون في حوار اجتماعي، مجتمعي، يسهمون فيه ويوسعون آفاقه، ولذلك تتصف المجتمعات المتطورة بظواهر ثقافية متنوعة، يقترحها أفراد، وتشارك فيها ممارسات اجتماعية واسعة: المسرح، السينما، معارض الفنون… ومن هنا جاء قول أشبه بالقاعدة؛ يتذوق الفنون فرد تربى في مجتمع شهد تربيات فنية…
يفضي الحوار الثقافي المجتمعي، في «المجتمع المفتوح»، إلى ظاهرة: مثقفون كبار لهم مشروعات اجتماعية، «يشاركون فيما يتجاوز اختصاصهم»، ويمثلون أنواعًا متعددة من المثقفين «محددي الصفات»: المثقف العضوي عند غرامشي الذي يدافع عن مصالح طبقة وينقض مصالح أخرى وينتهي، في الشروط الديمقراطية، إلى «المثقف الجمعي» الذي يوحد بين الثقافة والسياسة وينفتح على مشروع اجتماعي. دعا جان بول سارتر إلى «المثقف السياسي». الذي يأخذ موقفًا نقديًّا من الظواهر الاجتماعية جميعها، ويتدخل فيما يتجاوز اختصاصه. ودعا إدوارد سعيد إلى «المثقف الهاوي»، البعيد من المثقف ذي الاختصاص المغلق، القريب من السلطة… كان الفرنسي هنري لوفيفر قد تحدث عن «المثقف النوعي» الذي يتكئ على معرفة تدعم المصالح الجماعية المدافع عنها، وتسهم هذه المصالح في تطوير ثقافته وتجديدها.
تميل الثقافة التبسيطية البعيدة من التحديد إلى مثقف مجرد الصفات: تدعوه: المثقف الثوري، التي لا تعني صفته شيئًا، أو المثقف الطبقي التي لا تأتي بمفيد، وكذلك المثقف الحزبي الذي صلاحه من «حزبه»، وهو كلام أجوف. تنوس هذه الصفات بين الاختراع و«الأيديولوجيات الفقيرة». فالثورة مشروع اجتماعي متخيل لا يوكل إلى فرد يحسن القراءة والكتابة، والطبقات الاجتماعي محض لغة مستحيلة التجسيد: فلا وجود «لثقافة عمالية» إلا في الإنشاء الفقير، وقيم الرأسمالية لها وجود في الاقتصاد لا في غيره وفي مدارسها المختصة… والبرجوزاية الصغيرة، التي عاشت بالكلام ردحًا من الزمن ظهرت في الدعاوي السياسية العارضة ودفنت خارجها.
وبسبب استبداد البداهة التي تساوي بين الكلمات والموضوعات، ارتاح تلاميذ محمد عابد الجابري إلى مصطلح: «المثقف الهادي» حيث «الإبستمولوجيا» تنير «طريق الثوار» على اعتبار أن المثقفين «البرَرَة» من الثوار، يشير إلى الانتصار بيد ويحمل مراجع المعرفة بيد أخرى. ولكأن التزود «بالنظرية» «يسوغ» وجود الفقر ويحقق الكرامة المنشودة ويسيس جموعًا من المضطهدين حرمت طويلًا من الحرية والسياسة وعفوية الحركة والتنظيم. ينتهي هذا الزعم الفاسد، في النهاية، إلى قول مستبد يمحو مبادئ السياسة ويحتفي بالانضباط والعقول المنضبطة، يستعيض عن المتسلط التقليدي بمتسلط دقيق الكلام يؤمّن «للمخْضَعين» سبل الرشاد والهداية. ومع أنه يزجر «العفوية الشعبية» رافعًا رايات المعرفة، فهو يكرر، بشكل مختلف، قولًا قديمًا زهيد التكلفة: «من لا شيخ له شيخه الشيطان»، ألمح إليه طه حسين في كتابه «الأيام»؛ إذ المثقف الهادي، الشيخ الجديد، مرتبة معرفية- اجتماعية «تبجّل» الثورة العارفة وتدعو الخاضعين إلى الالتحاق بالأساتذة و«الأكاديميين».

هنري لوفيفر
ارتضى «بعضٌ» مصطلح «المثقف الهادي»، حيث الهداية من الثقافة والثقافة من الهداية وممارسة الحياة لا معنى لها، و«التجربة اليومية»، تاليًا، لا تفيد الإنسان في شيء. تتلاشى في الهواء بداهة معروفة: «شخصية الإنسان من أفعاله»، ويتداعى قول أندريه مالرو الشهير: «يساوي الإنسان مجموع أعماله»، الذي يعتبر الفعل المشخص للإنسان المشخص بداية المعرفة، وأن الإنسان البنّاء يتعلم البناء وهو يبني، تاركًا «جمالية الكتب» لأصحاب الاختصاص، الذين هم افتراضيًّا «جنس كتابيّ من البشر» يسترشد بالنظرية ومشتقاتها. يعلم «تلاميذ الفقراء» القراءة والكتابة والبناء والمظاهرات منطلقًا من النظريات المتعالية.
بعض آخر من مثقفي الاختصاص ينادي «بالمثقف الإيماني»، محتفلًا بالثقافة القلبية، حيث المعرفة الحقة تتكون في «القلب المؤمن» ولا تحتاج إلى الفعل واليدين. تنتقل المعرفة الصالحة، والحال هذه من «النظرية» إلى القلب، الذي يصبح، أحيانًا، «قلبًا ثوريًّا» لا علاقة له بالحاجات المادية والتجريب. وقد يصدر عن هذا القلب «إيمان ثوري» مغلق، لا يفيد الأغراض اليومية ولا تفيده في شيء أيضًا.
المثقف بصيغة المفرد
ولعل في توزع المثقف على وجهات نظر مختلفة ما يعفيه من التعريف، ويمنع عنه صيغة الجمع، ويضع تعريفه في الناظر إليه، اتكاءً على عمومية: العمل اليدوي والعمل الذهني، التي تصلح للأفكار الكتبية وتتعثر في الحياة العملية. فلا وجود لعمل يدوي متحرر من «تفعيل الذهن» حتى لو كان هامشيًّا، كما أن العمل الذهني، الذي يشتق منه: «المتذهّن» يصطدم بالمعيش اليومي حتى لو لم يسعَ إلى ذلك. وواقع الأمر أن بين «صفات المثقف» والسياق الاجتماعي التاريخي علاقة عضوية، كما أن السياقات المتعددة تقترح «صفات متعددة». فللمثقف «الثوري» سياقه الأيديولوجي الأكيد، فلولا سياق ساطع الحصري لما طلع بمثقفه القومي، ولولا صعود «اليسار» في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لما تكاثر «المثقف العضوي»، ولولا تراجع الطرفين لما ظهر ثالث يستضيء بالمثقف المصري «سيد قطب». ولو لم تنطفئ النزوعات الأيديولوجية المختلفة لما غدا المثقف العربي أثرًا من الماضي.
قلنا اتكاءً على ما سبق: لا وجود للمثقف بصيغة الجمع، فهو كلمة يأتي معناها من «القائل بها»، يستدعيها سياق ويطردها سياق آخر. ويمكن مراجعة القول في أحواله المتحولة، عربيًّا، الوصول إلى نتيجة أخرى: كل الناس مثقفون لا انطلاقًا من المساواة التي احتفى بها غرامشي إنما لأمر آخر مرآته: تراجع القراءة والكتابة وانطفاء السياسة و«التحزّب» الفاعل؛ ذلك أن كل ما يعمم الجهل يجهض معنى الكلمات. فكل الناس أميون في مجتمع كل الناس فيه متعلمون، وكل الناس مربون في مجتمع حسن التربية.
تتأتى من مستويات التعليم المتفاوتة مقولة: تبادلية العلاقات المعرفية؛ إذ المعرفة الأرقى تفعل في معرفة محدودة التطور، وكذا الأمر في العلاقات الثقافية المختلفة المراتب التي تضع «المثقف» في سلسلة تاريخية «متنوعة». فقبل المثقف يأتي «الفقيه»؛ إذ حقل الأول الموضوعات الدنيوية، يقرؤها وينقدها ويتخذ منها موقفًا، وإذ الثاني يقرر ويشرع وينشغل بالأحكام الدينية، مع فرق أساسي بين الطرفين: يتعين المثقف بموقفه من السلطة السياسية، يقومها، ويقترح بديلًا، بينما يظل الفقيه مشدودًا إلى السلطة. يظل الفقيه قائمًا بين حدين: السلطة كما يقبلها الناس والناس كما تريدهم السلطة وترضى عنهم. بيد أن هذين الحدين يضطربان في زمن «السديم الاجتماعي»، فلا الفقيه جليّ الصورة، ولا أتباعه واضحو القيم. آية ذلك ما ازدهر في عقود أخيرة وأخذ صفة: الداعية.

محمد عابد الجابري
إذا كان زمن خطاب الداعية سلطويًّا، يتداخل فيه الحاضر والماضي بلا تمييز، يفيد منه الداعية والسلطة، فإن زمن المثقف، تاريخيًّا، يرنو إلى المستقبل ينشد، نظريًّا، مصالح «الشعب» ويدافع عنها. المثقف مقولة حديثة، والداعية وما يشبهه لا زمن له، حده الأول مصلحة «متدينة» أو «تأويل ديني» نفعي النزوع.
ظهر المثقف العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وما تلاه، وتوالد الفقيه في جميع الأزمنة. ارتبط مسار الأول، صعودًا وهبوطًا وتجددًا وتداعيًا، بالحوار الاجتماعي ومساحة الحرية الاجتماعية والقول الحر، وحايثت حركة الثاني اتجاهات السلطة التي تمجد الثبات وتميل إلى «التأبّد».
هل على المثقف أن يعترف أولًا بعلاقات القراءة والكتابة، أم إن عليه قراءة الظواهر الاجتماعية المعيشة التي هي قوّامة على المجردات الثقافية؟

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | نوفمبر 1, 2023 | مقالات
لماذا بدأت الرواية العربية الأولى باسم امرأة؟ وما الذي أعطاها حضورًا متوالدًا في روايات لاحقة؟ وهل كانت فكرة «فاضلة» مجردة أم كيانًا مشخصًا واضح الحركة والفعل؟
جاءت شرعية السؤال من «زينب»، التي كتبها محمد حسين هيكل في نهايات العقد الأول من القرن العشرين واعتبرها بعضٌ الرواية العربية الأولى، ولحقت بها أنثى تشبهها في رواية توفيق الحكيم «عودة الروح»، في انتظار أخرى أوسع حضورًا وغموضًا في «دعاء الكروان» لطه حسين… أخذت «زينب» ملامح الأصل، بالمعنى النظري: فهي بداية ما لحق بها من روايات، وامتداد للريف المصري، أصل الشخصية المصرية الموزعة على النيل والأهرامات، ومرآة «لعبقرية المكان» بلغة الجغرافي النبيه جمال حمدان. وهي روح غامضة مشبعة بالجمال وسريعة الرحيل… ولأنها أصل فهي تنفتح على الماضي والمستقبل وتحرض في ديمومتها على التأويل، وهي في الحالات جميعًا «رمز» وطبقة من الرموز المتعددة الدلالات.
أنثى هيكل
ما يميّز زينب، كما رسمها هيكل الشاب، أمران: جمال هادئ وروح مستقرة، ورحيل عن الحياة في زمن الشباب واضح وغامض في آن. الأصل، نظريًّا، لا يموت، له ماضٍ أثيل، تمتد فيه «طبيعة مصر» سرمدية الوجود. زينب من خضرة الأرض وأريج الظلال، لصيقة بأرضها، بها تبدأ وإليها تنتهي، بعيدة من أنثى توفيق الحكيم القريبة من المدينة وعالم الطلبة والمظاهرات الوطنية، لكنها كالأولى تقاسمها جمالها وأنس حضورها ولها روحها الجماعية، تعشق الكل ويعشقها الكل، تجسّد «الواحد في الكل والكلّ في واحد»، يتساند فيها الحاضر والماضي معًا. كأن وجودها «لا زمني»، تعبره جميع الأزمنة ويظل شابًّا.
يلفّ التساؤلات السابقة سؤال «صغير»: لماذا دفع هيكل زينب إلى موت مبكِّر واستبقى الحكيم أنثاه المشرقة صامدة منتصرة؟ لماذا اختلف مآل «مصريتين» مرتبطتين «بالأرض» في منظورين روائيين يذكران بجمال الريف و«بجيوش الشمس» الفرعونية؟ يصدر الجواب عن منظور أول عامر بالارتباك، يعشق الريف المصري وسماءه، و«يعطف على فلاحين طيبين»، ويستنكر استبداد العادة الذي يحكم حياتهم، يختصر الفرد في خضوعه والفلاح إلى جوعه. ولهذا تحضر زينب كموضوع وإشارة، فهي عاشقة مضطهدة، تكون كما أرادت لها العادات المستبدة أن تكون، وهي «روح مصر القديمة الخالدة»، صورة عن «جمال فرعوني» وآية له، تفتقر إلى حرية تدعها طليقة الرغبات. وإذا كانت صورة زينب في جمالها الباذخ من صورة مصر الأصلية، فإن مآلها الحزين أثرٌ لمجتمع متخلّف، الجمال العميم رحمة لكنه لا يرحم. تفتقر الصورة الأولى إلى «العقد الاجتماعي»، المأخوذة عن جان جاك روسو التي تدع البشر متساويين أحرارًا، بينما يترجم المآل الحزين أحوال مجتمع يسوسه «بشر بلا مدارس» وعقول لا تُحسن القياس.
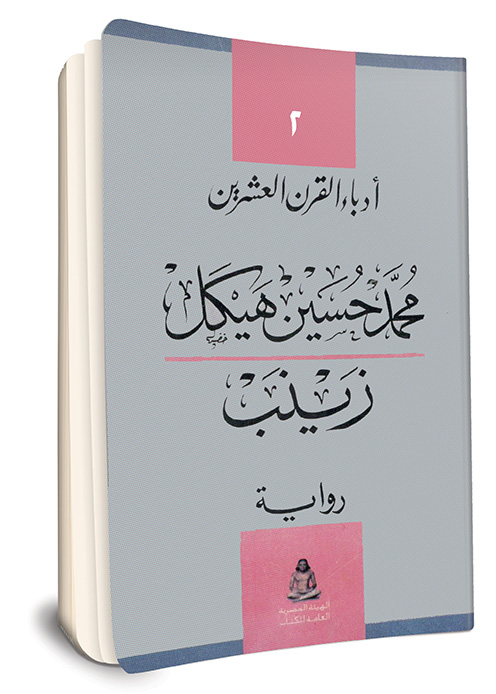 الريف والعشق المحرّم والوجه الجميل الذي يلامسه الموت مقولات رومانسية تضيء رواية هيكل وفكره وتناقضاته في آن. تتجلّى المقولات في نظر «حامد» الصبي الواعد المبشّر بالتقدم، يرى الريف في قوام زينب ويعشقها كتلميذ طموح أكمل دراسته، يهندس «مستقبلًا» لن يصل إليه. يضطرب نص هيكل أكثر من مرة: فالصبي الواعد يكتفي برغباته، يفلت منه المستقبل يلاحق الفتاة الجميلة إلى قبرها. و«للفلاحين المتآزرين» اشتراكية غامضة، توزّع الفقر عليهم بالتساوي، ولمقولات «روسّو» ليس لها مكان، كما لو كانت زينب فرعونية الجمال سقط جمالها وهي تنصت إلى عشقها المستحيل ذلك أن مجتمع العادات يجهض كل جميل قبل أن يولد.
الريف والعشق المحرّم والوجه الجميل الذي يلامسه الموت مقولات رومانسية تضيء رواية هيكل وفكره وتناقضاته في آن. تتجلّى المقولات في نظر «حامد» الصبي الواعد المبشّر بالتقدم، يرى الريف في قوام زينب ويعشقها كتلميذ طموح أكمل دراسته، يهندس «مستقبلًا» لن يصل إليه. يضطرب نص هيكل أكثر من مرة: فالصبي الواعد يكتفي برغباته، يفلت منه المستقبل يلاحق الفتاة الجميلة إلى قبرها. و«للفلاحين المتآزرين» اشتراكية غامضة، توزّع الفقر عليهم بالتساوي، ولمقولات «روسّو» ليس لها مكان، كما لو كانت زينب فرعونية الجمال سقط جمالها وهي تنصت إلى عشقها المستحيل ذلك أن مجتمع العادات يجهض كل جميل قبل أن يولد.
تتعيّن رواية زينب خطابًا حداثيًّا، آيته أنثى لها طبيعة مصر، عشقها تصادره الأعراف، وصبيها الواعد يتأمل الجمال ويقف عاجزًا. ولهذا يكون السارد المتمرد قناعًا فكريًّا، يشهد على بيئة «جميلة مستبدة»، تعارض قواعدها الحاجات الطبيعية، وعلى تفاؤل كسيح، ينظر إلى مجد قديم لن يعود، وإلى مجتمع يعترف بالحرية والمساواة، يشفق على فلاحين يعتاشون بآفات يظنونها فضائل، يقدسون ذكورة فارغة ويرجمون أنوثة جديرة بالحياة.
يتجلّى البعد التبشيري في نظر الصبي المفتون بجمال زينب، الذي يقنعه بأنها لا تموت، فإن ماتت بعثت من جديد. يأخذ عندها المثقف الشاب دور «المبشّر»، يقتات برغباته ويحملها ويسير إلى لا مكان. كما لو كان مصيره شكلًا آخر من المصير الذي انتهت إليه زينب.
أنثى الحكيم
ارتاح هيكل إلى رومانسية فلسفية متأثرة بأفكار فرنسية، واطمأن الحكيم في «عودة الروح» 1923م، إلى رومانسية صوفية، تضع الكلّ في واحد وتضع ذاته فوق الجميع. نسب الحكيم فلسفته إلى موروث مصري قديم، يساوي بين العقل والقلب والزمن والروح. قاسم هيكل مجاز «الصبي الواعد»، والقول بأصل فرعوني عظيم، مجلاه الفلاح المصري الذي يجتمع فيه الصبر والتضامن والتسامح، وتقاسم معه صورة الأنثى الفاتنة، التي هي من روح مصر وآية لها، وغالى في تجميلها حتى تفرّدت. أراد هيكل أن يواجه التخلّف بثقافة حديثة، تحرّر الفرد من استبداد الجماعة، لا فرق إن كان ذكرًا أو أنثى. رأى الحكيم في الجماعة كيانًا فاضلًا، عبقري القلب، يحايثه الكمال في جميع الأزمنة. وبسبب عمومية سمتها الخلود، تتساوى فيها الأنثى والذكر، ويرشدان إلى المستقبل بلا خطأ.
شاء الحكيم مصر مبدعة متجددة، اشتقها من ميتافيزيقا ساذجة؛ إذ المصري من جوهر فلاحي، مفعم بالنقاء كالأرض التي يمشي فوقها، يعيش بإحساسه و«الإحساس هو علم الملائكة»، لا يحتاج إلى «لغة العقل» الغريبة عن مصري مندمج بالكون، يأتلف مع جميع المخلوقات: «إن مصر الملائكية القلب ذات القلب الطاهر ما برحت مصر، وقد ورثت -على مرّ الأجيال- عاطفة الاتحاد مع الوجود دون أن تعلم…».
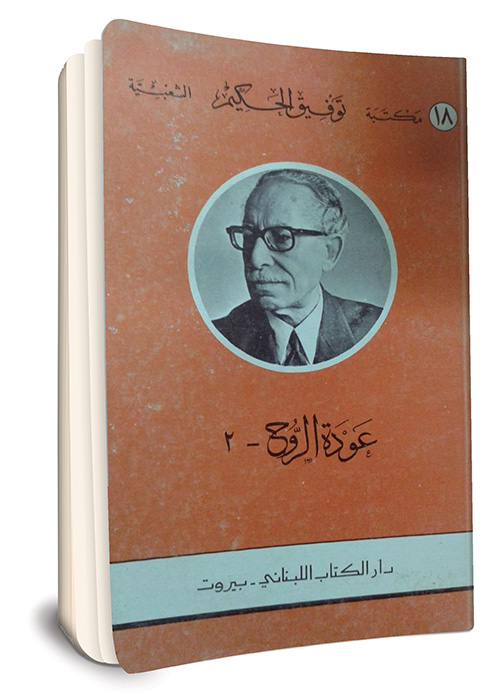 لن تكون الأنثى في «عودة الروح» إلا روح مصر المضيئة مجلاها الروائي: «سنيّة»، «لها رأس جميل ذو شعر أسود لامع وعينان سوداوان كعيني الغزال ذواتي الأهداب السود الطوال، عينان خلّابتان، فمها وأسنانها كالكأس السحرية، لها نحْر عاجي غاية في البياض يعلوه رأس جميل يلمع كأنه قمر من الأبنوس وهي الظبية الجميلة تضاف إلى جمال الجسد والهيئة والروح…». خلق الحكيم أنثاه المصرية من جمال الوجود وفتنة الكائنات جميعًا، قريبة هي من الظباء والغزلان والقمر وشجر الأبنوس… صورة هي عن «إيزيس القديمة» ذهبت إلى الجامعة وزادت جمالًا. «تحسن القراءة والكتابة وتعزف على البيانو وتحب الغناء وتقص شعرها بشكل حديث…». تضمن الرومانسية المتصوفة الخلق والابتكار ما يتيح استعادة روح أثيلة، بقدر ما تضمن «سنيّة» التجدد المفتوح الذي يذود الأذى عن الأهرام، ويوائم بين مصر القديمة ومصر الجديدة.
لن تكون الأنثى في «عودة الروح» إلا روح مصر المضيئة مجلاها الروائي: «سنيّة»، «لها رأس جميل ذو شعر أسود لامع وعينان سوداوان كعيني الغزال ذواتي الأهداب السود الطوال، عينان خلّابتان، فمها وأسنانها كالكأس السحرية، لها نحْر عاجي غاية في البياض يعلوه رأس جميل يلمع كأنه قمر من الأبنوس وهي الظبية الجميلة تضاف إلى جمال الجسد والهيئة والروح…». خلق الحكيم أنثاه المصرية من جمال الوجود وفتنة الكائنات جميعًا، قريبة هي من الظباء والغزلان والقمر وشجر الأبنوس… صورة هي عن «إيزيس القديمة» ذهبت إلى الجامعة وزادت جمالًا. «تحسن القراءة والكتابة وتعزف على البيانو وتحب الغناء وتقص شعرها بشكل حديث…». تضمن الرومانسية المتصوفة الخلق والابتكار ما يتيح استعادة روح أثيلة، بقدر ما تضمن «سنيّة» التجدد المفتوح الذي يذود الأذى عن الأهرام، ويوائم بين مصر القديمة ومصر الجديدة.
تجسّر «سنيّة» المسافة بين ما مضى وما سياتي، بين الفلَّاح القديم وثورة 1919م، وبين مصر فرعونية: «عنقها غابة من البياض»، وفضاء روائي حديث يقتات بالواقع ولا يتعامل مع المعجزات. تجتمع المتناقضات في نص مجرد موحّد الزمن، يحتفي بثورة 1919م ويعد إلى الوراء إلى زمن أخناتون، كأن الرواية جنس أدبي تقبل به جميع الأزمنة.
أنثى طه حسين
استُهلت الرواية العربية بأقلام غير روائية، فرنسية الثقافة، وتتصرف بالرواية كما تشاء. عُني هيكل بالفلسفة والرواية ووقف إلى جانب الحرية، وكتب الحكيم عن ذاته وميوله وكتب الرواية في «أوقات الفراغ». انشغل طه حسين بقضايا التخلّف والتقدم وحاول الرواية في مجتمع مسكون «بثقافة الأدعية»، وأنجز رواية أولى عام 1934م عنوانها: «دعاء الكروان»، سردت رغباته الفكرية الذاتية واقتفت مسار «حب مشؤوم» يثير السخرية، يجب أن ينتصر.
ما حديث التخلّف والتقدم في عقل نقدي عنيد كعقل طه حسين إلا الحديث الصعب عن قيم جميلة منتصرة في مجتمع يسكنه الكراهية. ذلك أن طه حسين لا يرضى بأنصاف الحلول ويؤمن بقوة المعرفة إيمانًا مطلقًا. والأرجح أنه حين كان يكتب «دعاء الكروان» كان يهجس بمسيرته الذاتية، كما ساقها في «الأيام»؛ إذ الإرادة تروّض الوجود والأرجح أيضًا أنه انتصر للحب المثالي مثلما انتصرت إرادته على «عماه»، وانتقل من وضع إنسان يُرفع كالمتاع إلى وضع آخر مستقل، مرفوع الرأس، ينصاع إلى إرادته ولا يخضع لأحد.
أقام حسين روايته «دعاء الكروان» على مجاز الانتقال الوهمي: انتقال مكاني، اجتماعي، نقل فتاة من البادية إلى الريف، من حياة خشنة بائسة الحاجات إلى حياة في بيئة ميسورة من الريف، وانتقال على مستوى الوعي صدر عن اختلاف البيئة، فعرفت الفرق بين القراءة والأميّة واستمعت إلى صوت البيانو الذي لم تراه من قبل، وتبدلت كلامًا وملبسًا، كأنها حظيت بأكثر من ولادة. وانتقال الثالث على مستوى العاطفة، جاءت كارهة مملوءة بروح الانتقام وانتهت متسامحة، قلقة، عاشقة.
طرح المؤلف في روايته موضوعه الأثير والمحدّث عن التعلم والتعليم، وغالى فيه واستحضر ثقافته المدنية- الفرنسية، فنقل الفتاة من الريف إلى المدينة. ومن تعلّم القراءة والكتابة إلى تهجّي «الثقافة الفرنسية»، فكأنها انتقلت من فضاء الرمال إلى ضفاف نهر النيل. ونقلت معها «المعشوق» من لا مبالاة مؤذية إلى قلب رقيق هذّبته العاطفة المتبادلة والحوار بين عقلين متساويين في التساؤل والمحاججة.
تساوي شروط الحضارة بين فتاة من البادية وأخرى من المدينة، فإن كان لها حظ من الاجتهاد تفوقت على الأخيرة، تفوقًا «يمكن» أن يجعلها من «النخبة المتعلمة». اختصر حسين إيمانه بقوة المعرفة في حكاية متعددة الأبعاد.. الإيمان بالمساواة بين البشر، إمكانية التحضر وتوليد شروطه، وحق الأنثى في التعلّم «الراقي»، ليكون لها حقٌّ في الحب والاختيار الحر والمساهمة في تطوير المجتمع. ليست صعبة المقارنة بين الصبي الضرير في «الأيام» والبدوية النجيبة في «دعاء الكروان»: سيرتان لإنسانين نبيهين، لهما شروطهما الصعبة، يقتحمان الصعاب ويبلغان السلامة.
اللجوء إلى الرواية
سؤال يثير الفضول: لماذا لجأ المثقفون الثلاثة (هيكل والحكيم وحسين) إلى الرواية وهم الذين انشغلوا بصياغة «الأفكار الاجتماعية»؟ محاكاة الثقافة الفرنسية «ربما»، فجان جاك روسو، الذي أخلص الشاب لأفكاره، كتب رواية عن الحب -هولويز الجديدة- والحكيم انشغل بالمرأة والحب في «عصفور من الشرق»، روايته الأولى التي كتبها في باريس، وعرف حسين بدوره «قيمة المرأة»، عاشها حسين حين كان بدوره طالبًا في باريس. اعتنق الثلاثة معًا، بأشكال متفاوتة: فكرة التقدم واعتبروا الرواية، كما الدفاع عن المرأة، وجهًا من وجوهها. حرّض على ذلك «المتخيل الروائي»، الذي يقبض على وجوه من الحياة المعيشة، ويضيف إليه «أوهامًا جميلة»؛ ذلك أن «فكرة التقدم» اتكأت على فكر «رَغَبي» عريض قوامه «المستقبل المنتصر» والكمال الاجتماعي ومصر الخالدة.
مازج الفكر الرغبي تجريدًا واسعًا أدمن عليه «المحرومون» الذين يفصلهم عن نقائضهم مسافة واسعة، كما لو كان لا يستوي إلا بإضافة -ضرورة- تعترف بالمعيش وتعيد خلقه كما يجب أن يكون. لهذا تأتي المرأة في الروايات الثلاث، رحيبة الجمال والنباهة، سبقها زمن مغترب وعقبها زمن منتصر آخر.
كان فرح أنطون، المثقف السياسي التنويري المنفتح على الثقافة الأوربية يقول: «الرواية فن تأخذ به الشعوب الراقية»، والرواية عندنا «كتابة تدعى الرواية على سبيل التساهل». سيطرت الرغبة المضمرة، أو الصريحة، بمحاكاة «الآخر المتقدم» على الروايات الثلاث، ما يسمح بالقول: كان هيكل والحكيم وطه حسين روائيين على سبيل التساهل ويتصرّفون بالأفكار تصرّفًا مريحًا: الفلاحون عند هيكل يعيشون «الاشتراكية» بشكل عفوي، وأنثى الحكيم تقارب الشمس ضياءً، توحّد بين الجامعة الحديثة والأفكار الفرعونية القديمة، والأنثى في «دعاء الكروان» أقرب إلى المعجزة. أدرج الحكيم في نصه «صبيًّا ملائكيًّا»، وساوقت الملائكة «المرأة الروائية» في الروايات الثلاثة؟
جاءت الرواية العربية؛ في بداياتها، معوّقة، صاحبتها أفكار تقدمية لا تنقصها الإعاقة، منّت النفس بامرأة مصرية من حرية وذهب، يضيق به الواقع المعيش وتحتفي بها الكتابة المجردة.
















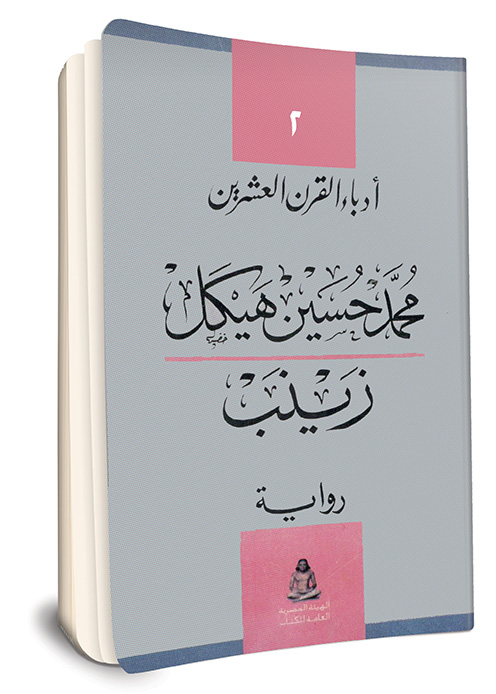 الريف والعشق المحرّم والوجه الجميل الذي يلامسه الموت مقولات رومانسية تضيء رواية هيكل وفكره وتناقضاته في آن. تتجلّى المقولات في نظر «حامد» الصبي الواعد المبشّر بالتقدم، يرى الريف في قوام زينب ويعشقها كتلميذ طموح أكمل دراسته، يهندس «مستقبلًا» لن يصل إليه. يضطرب نص هيكل أكثر من مرة: فالصبي الواعد يكتفي برغباته، يفلت منه المستقبل يلاحق الفتاة الجميلة إلى قبرها. و«للفلاحين المتآزرين» اشتراكية غامضة، توزّع الفقر عليهم بالتساوي، ولمقولات «روسّو» ليس لها مكان، كما لو كانت زينب فرعونية الجمال سقط جمالها وهي تنصت إلى عشقها المستحيل ذلك أن مجتمع العادات يجهض كل جميل قبل أن يولد.
الريف والعشق المحرّم والوجه الجميل الذي يلامسه الموت مقولات رومانسية تضيء رواية هيكل وفكره وتناقضاته في آن. تتجلّى المقولات في نظر «حامد» الصبي الواعد المبشّر بالتقدم، يرى الريف في قوام زينب ويعشقها كتلميذ طموح أكمل دراسته، يهندس «مستقبلًا» لن يصل إليه. يضطرب نص هيكل أكثر من مرة: فالصبي الواعد يكتفي برغباته، يفلت منه المستقبل يلاحق الفتاة الجميلة إلى قبرها. و«للفلاحين المتآزرين» اشتراكية غامضة، توزّع الفقر عليهم بالتساوي، ولمقولات «روسّو» ليس لها مكان، كما لو كانت زينب فرعونية الجمال سقط جمالها وهي تنصت إلى عشقها المستحيل ذلك أن مجتمع العادات يجهض كل جميل قبل أن يولد.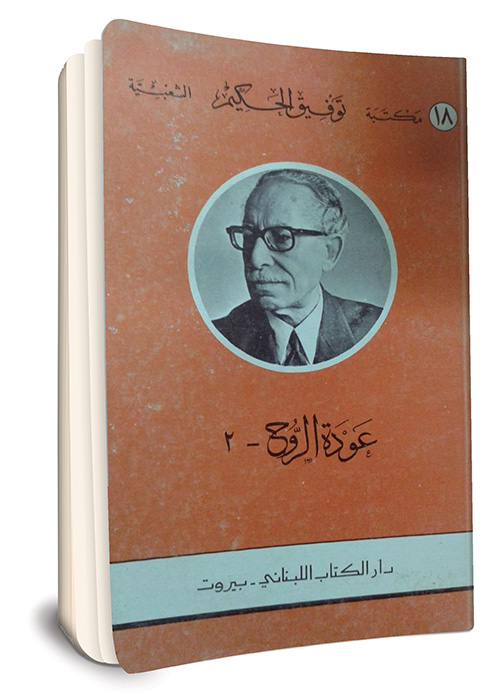 لن تكون الأنثى في «عودة الروح» إلا روح مصر المضيئة مجلاها الروائي: «سنيّة»، «لها رأس جميل ذو شعر أسود لامع وعينان سوداوان كعيني الغزال ذواتي الأهداب السود الطوال، عينان خلّابتان، فمها وأسنانها كالكأس السحرية، لها نحْر عاجي غاية في البياض يعلوه رأس جميل يلمع كأنه قمر من الأبنوس وهي الظبية الجميلة تضاف إلى جمال الجسد والهيئة والروح…». خلق الحكيم أنثاه المصرية من جمال الوجود وفتنة الكائنات جميعًا، قريبة هي من الظباء والغزلان والقمر وشجر الأبنوس… صورة هي عن «إيزيس القديمة» ذهبت إلى الجامعة وزادت جمالًا. «تحسن القراءة والكتابة وتعزف على البيانو وتحب الغناء وتقص شعرها بشكل حديث…». تضمن الرومانسية المتصوفة الخلق والابتكار ما يتيح استعادة روح أثيلة، بقدر ما تضمن «سنيّة» التجدد المفتوح الذي يذود الأذى عن الأهرام، ويوائم بين مصر القديمة ومصر الجديدة.
لن تكون الأنثى في «عودة الروح» إلا روح مصر المضيئة مجلاها الروائي: «سنيّة»، «لها رأس جميل ذو شعر أسود لامع وعينان سوداوان كعيني الغزال ذواتي الأهداب السود الطوال، عينان خلّابتان، فمها وأسنانها كالكأس السحرية، لها نحْر عاجي غاية في البياض يعلوه رأس جميل يلمع كأنه قمر من الأبنوس وهي الظبية الجميلة تضاف إلى جمال الجسد والهيئة والروح…». خلق الحكيم أنثاه المصرية من جمال الوجود وفتنة الكائنات جميعًا، قريبة هي من الظباء والغزلان والقمر وشجر الأبنوس… صورة هي عن «إيزيس القديمة» ذهبت إلى الجامعة وزادت جمالًا. «تحسن القراءة والكتابة وتعزف على البيانو وتحب الغناء وتقص شعرها بشكل حديث…». تضمن الرومانسية المتصوفة الخلق والابتكار ما يتيح استعادة روح أثيلة، بقدر ما تضمن «سنيّة» التجدد المفتوح الذي يذود الأذى عن الأهرام، ويوائم بين مصر القديمة ومصر الجديدة.