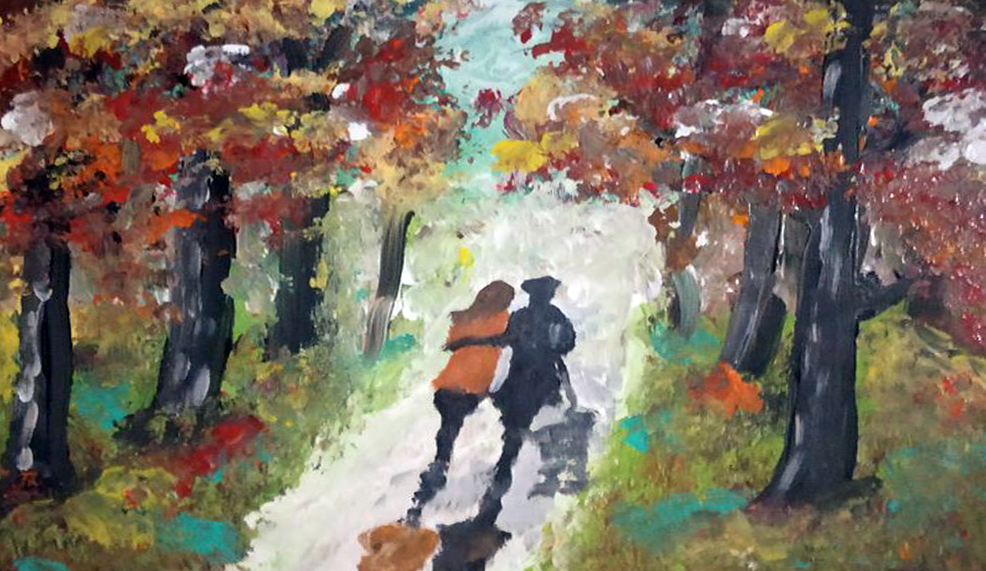
«إخضاع الكلب» لأحمد الفخراني اشتغال احترافي في بنية ما بعد حداثية
يقدّم أحمد الفخراني نفسه وشخوصه في مستهلّ روايته الجديدة «إخضاع الكلب» (دار الشروق 2021م) من خلال سارد متماهٍ بمرويّه، استيقظ على حلم رأى فيه كلبًا مقيدًا إلى شجرة في فناء منزله، وما بين الحلم واليقظة يخال أنها مزحة ثقيلة من صديقته (أسما) فهي تعرف مقدار رهابه من الكلاب. ثم يحدد المكان والزمان فيشير إلى أن ذلك حدث بعد بضعة أشهر من انتقاله للإقامة في مدينة (دهب) جنوب سيناء، وهي مدينة صيادين تحوّلت إلى منتجع سياحي يعجّ بالسياح الأجانب، وتطلّ على خليج العقبة في البحر الأحمر.
ولعل السؤال يتجه أولًا إلى سبب اختيار هذا المكان المسمى «دهب»؛ فالأمكنة الروائية لا تسمى اعتباطًا، وقبل أن يتجه التفكير نحو بعد رمزي أو إسقاط سياسي، يسارع السارد للكشف عن السبب قائلًا: «عندما اخترت دهب للإقامة لم أكن أبحث عن الهدوء وجمال الطبيعة، بل الضجر ورتابة الألوان، ظننت فيهما علاجي من تلاحق الصور وغواية الانتحار، فكل شيء هنا واضح وأساسي».

أحمد الفخراني
وبعد حين نعرف أنه مصور موهوب سابق ورسام دأبه السير في الطرقات متأملًا وجوه الناس ثم يعود إلى منزله ليرسم ما علق منها في ذهنه، لكنه لا يستطيع إكمال لوحته، ولعل الأمر عائد إلى الضجر المرتبط بحالته النفسية الحادة، وبقلقه المتصاعد، لكن كما يبدو من هذا الاستهلال الأولي فقلقه ناجم عن رهاب الكلاب التي يراها في مناماته الكابوسية وفي لحظات شروده الذهني، وبينما هو في رعبه ذاك تأتي «أسما» لإنقاذه كدلالة عن حكاية «الأنوثة المنقذة» التي أنسنت أنكيدو، وما انفكت حاضرة في اللاوعي الجمعي، فجعل منها الكُتاب والشعراء رمزًا إنسانيًّا بالغ الدلالة، وبلا شك فإن حضور أسما كمنقذة بمنزلة استعادة لهذه الذاكرة لأجل العناية بـ«هارون»؛ الشخصية القلقة والسارد الذي نأى بنفسه عن الناس في هذه المدينة القصية: «كان الحصار كاملًا والرعب محيطًا، لولا أن بزغت أسما من العدم، لتشق الظلام بعينين لهما بريق عرّافة أو ساحرة أطلقت تعويذة لتفك طلاسم الهلوسة والذعر، فهدأت الكلاب وعادت لهيئتها العادية».
بهذه العلاقة المركّبة تنطلق أحداث الرواية ضمن حكاية إطارية كبرى تتحدد بالعلاقة المضطربة مع «ونيس» الكلب الذي تركته له أسما لغاية علاجية، ثم تتفرع عنها حكايات متلاحقة حتى نهاية الرواية من جانب سارد وضع خطة اشتغال للتمكن من قارئه والدفع به عبر حبكات مدروسة تنطلق من الغموض الكلي إلى الكشف التدريجي بتقنيتي التقطير والإيهام، والرواية الجديدة في النهاية ليست حكايتها وتلاحُق أحداثها، فالإيهام بدأ بتحديد العناصر السردية الأساسية من زمكان وشخوص ورهاب من الكلاب كي تنطلي لعبة الواقعية، والإيهام بأن الأحداث التي سيرويها حقيقية.
هذا الاشتغال بتعبير منظّري الرواية هو العملية الإبداعية ذاتها، فمن جهة يشوّق القارئ لأجل المتابعة، ومن جهة ثانية يدفع به لتقبّل الجوانب السحرية/ العجائبية التي سيوردها بعد حين مثل حواراته مع الكلبة البيضاء المرقّطة التي ستبدو للقارئ كلبة حكيمة مثقفة وتقرأ نيتشه، فضلًا عن حضور أسما وإنقاذها له بتعويذة سحرية، وهي إلى ذلك امرأة غامضة «بزغت كشمس من البحر» وتعرفت إليه ثم عملت على إنقاذه في الحلم، بمعنى آخر تلخصت مهمتها في حراسته من كوابيسه بل ربما من نفسه المريضة. وبذلك يذهب الفخراني في بناء متخيّله السردي مستثمرًا الحكايات الفرعية والوصف المتقصي بلغة إخبارية بسيطة، ما تلبث أن تتجه نحو شعرية فائضة بالألم والحزن والمعاناة من الخيانة والحب، وتأتي في بنية سيَرية في حين ومونولوج طويل يعبّر عن ذات موجوعة. كما أن هذا الاشتغال برأيي مرتبط بتجربة الفخراني كروائي موهوب تُلزمه خبرته السابقة بتجاوز أعماله السابقة وموضعة روايته في المكانة التي تستحقها للتنافس الخلاق مع رموز الرواية العربية.
عتبات النص
في صدد التناول النقدي لهذه الرواية اللافتة لا بد من الوقوف أولًا عند العتبات النصية: فنتساءل عن سبب التسمية «إخضاع الكلب»؟ فإخضاع واضحة المعنى معجميًّا ودلاليًّا وتفضي إلى الانكسار والاستسلام الكلّي، والاستجابة لمختلف رغبات صاحب السلطة والنفوذ لأسباب سوف تتوضّح من خلال عملية الإخضاع الطويلة، والمفارَقة هنا أن الكلب «ونيس» لم يستجب لكل إغراءات الطعام والمأوى، فهو بدوره له شخصيته المستقلة ولا يستجيب إلا عندما يريد.
أما العناوين الداخلية للفصول فإنها لافتة بغموضها ودلالاتها، بمعنى أنها تخييل يستوجب التحليل المعمّق لفهم الانتقالة السريعة من أسلوب الواقعية إلى التخييل الناهض على كثافة رمزية تترك العديد من الأسئلة في ذهن المتلقّي. وقد جاءت هذه الفصول في خمس تسميات: صفير الريح، جوف الحوت، خطوة الأعمى، غبار الذئب، هتاف الغول. وكما يتضح من هذه العناوين ومن تسميات الشخوص: هارون، آدم، ونيس، رحيم، سمير بربارة، أن ثمة مقصدية رمزية اشتغل عليها الفخراني، وهذا ما كنا لمسناه في روايته «بياصة الشوام»، مع حضور مسميات تاريخية ودينية
وواقعية شعبية.
ومن هنا فإن تقصي إستراتيجية التسمية ومدى علاقتها بالمتن سيغدو ضروريًّا وكمثال على ذلك فإن التسمية «صفير الريح» تذهب نحو وجهة نفسية ترتبط بقلق الشخصية، فصفير الريح طقس خريفي يتكاثف غالبًا في الذاكرة الإبداعية بأسطورة (احتضار الإله) وما يتركه من أحزان وبكائيات فضلًا عن أنه يجلب الكآبة ويبعث على الخوف والاضطراب النفسي حيث تكون الشخصية في حالة انتظار لمجهول قد يأتي أو لا يأتي فيما إذا اعتبرنا هذا المجهول مخلّصًا كـ«غودو» صموئيل بيكيت، وغالبًا ما تتعزز هذه المشاعر عند الإنسان الوحيد المنعزل، واشتغال الفخراني في هذا الجانب نفسي بحت إذا ما ربطنا الصفير بالكوابيس التي تعاود هارون في اليقظة والمنام لندرك أنه يعاني شيئًا ما انعكس على حياته، وأن الروائي بدءًا من هذه اللحظة السردية شرع في حياكة حبكاته الشائقة ليدفع القارئ لمتابعتها بحثًا عن إجابات لجملة الأسئلة المثارة حول الشخصية وأسباب توترها وعن علاقتها بـ«أسما» وما إذا كانا سيعيشان قصة حب؟ وهذا ممكن إذ إن الاستهلال انطوى على مشهد استباقي على شاطئ البحر:
«جلست بجواري، بشعرها وجسدها المبتل كدوامات من السحر، ثم طلبت سيجارة، اكتسب سرابها بغتة لحمًا حقيقيًّا كأنه تشكل للتو بداخلي، هزني ذلك، أعطيتها واحدة، انحنت بالقرب من صدري المرتجف لأشعلها، لفحتني أنفاسها الساخنة، انفتح ثقب ما في روحي الخشنة، المجعدة، المكسوة
بصدأ اليأس».
تدرك أسما أن صديقها القديم المصوّر ومدير ورشة التصوير التي حضرتها في القاهرة منذ سنين يعيش الآن أزمة نفسية حادة ارتبطت بخيانة زوجته مع صديقه الأثير سمير فانعكست كـ«تسونامي» عصف بقلبه ومشاعره ولينعكس ذلك على سلوكه الذي تعزز بقراءاته الفلسفية التي يتقصّد ذكر أسمائها كمتفاعلات سردية تؤدي دورها في الكشف عن آرائه ونظام تفكيره من مثل رواية «السيد بالومار» التي تتحدث عن رجل قرر أن يتصرف كميت ليرى كيف يسير العالم من دونه، إلى جانب قراءاته لفيلسوف «إرادة القوة» فريدريك نيتشه، ويبدو أن هارون تشبع بتعاليمه، بل قد تماهى به كشخصية إشكالية لها رؤيتها للبشر والقيم والحياة.
ومن هنا، فإن المتلقي قد يتقبل هذ الانزياح نحو الفكر والفلسفة الذي نستعرضه في ضوء منهج تحليلي لنص يتجه وجهة ما بعد حداثية تتداخل فيها الفلسفة بالأدب والتاريخ وباجتراح تقنيات مناسبة تنهض على التناص ومهارة الاستلهام من ثقافة تعززت بوسائل التواصل ومحركات البحث والهواتف الذكية.
نزعة الانتقام
فلنقل إذًا إن الرواية برمتها هي عملية تخييل كبرى ساهم التخطيط المنظم في بنائها إلى فصول وكل فصل انطوى على وحدات سردية عدة، تشتمل الحكاية الإطارية من جهة، وتضيء جانبًا مما عاشته الشخصية بالكشف المتدرج الذكي الذي أسميته نظام التقطير، ولعل الشخصية الرديفة أسما كانت تأتيه من أعماق اللاشعور لتعمل على إنقاذه وفق ما جاء على لسانها: «لا أرغب في لفت انتباهك أو الانتقام، بل أن أشفيك من ألم الخيانة والخداع».
ثم اختفت أسما «كعرافة أو ساحرة»، بعدما تركت له الكلب ورسالة ترجوه الاعتناء به ريثما تعود بعد ثلاثة أسابيع، فتنطلق حكايته مع ونيس على شكل يوميات يتابع المتلقّي خلالها تحوّلات هارون من الكراهية المطلقة إلى الحب الجارف، بما يعني أيضًا أنه أحب أسما بالرغم من تصريحه لها بأنه لا يتذكرها. والتخييل إلى ذلك تطلب تقنيات تنبثق من الحالة الإبداعية ذاتها فاتخذ السرد أبعادًا مختلفة. فهارون كشخصية روائية يمتد بين جوانحه بحر متلاطم الأمواج في مدّه وفي جزره، قوتان متكافئتان تستوي من خلالهما الأشياء وبشكل خاص الحياة والموت نتيجة صدمة خيانة زوجته وصديقه الأثير في القاهرة.
ومن هنا فإن الصراع في الغالب داخلي ما بين إرادتي الحياة والموت وما بينهما، أسما والكلب ونيس، اللذان عززا إرادة الحياة فيتغلب على الموت، بمبرر أسما تارة أو بوجود الشابين مصادفة لدى محاولة انتحاره في البحر أو عن طريق حورية البحر السحرية، فكل تلك المحاولات انتهت إلى الفشل؛ لأن إرادة الحياة التي تتجذر في أعماق اللاشعور هي المنقذة الحقيقية تمامًا مثلما غزت أسما منطقة أوهامه بمنطقها العقلاني، بدفعه لاسترجاع بعض ماضيه للدفاع عما استجد في مشروع عزلته، وبذلك بات الكشف ضروريًّا لتسليط الضوء على ماضيه.
أين أبدع الروائي؟
جاء الروائي بهارون إلى «دهب» لغرض محدد خلاصته «نسيان كامل ونهائي» لحياته السابقة في القاهرة بمعنى أنه يريد مسح ذاكرة (القرص الصلب) ناشدًا ولادة جديدة أو موتًا خلاصيًّا، والنسيان لمثل هذا النوع من الشخصيات الحساسة القلقة أمر صعب تحققه حتى لو أقام في «دهب» أو غيرها، إذ ثمة ما يتوغل عميقًا في ملفات اللاشعور وما يلبث أن يعاوده خلال قراءة ما أو مقابلة صديق قديم مثل أسما، وعلى حد تعبيره: «فلكي يُمحَى الألم لا يكفي أن تَنسى بل أن تُنسى، فالثقل الأكبر لا يأتي من ذاكرتك بل من تذكر الآخرين لك».
 في هذا المستوى من صدمة الخيانة ومستتبعاتها في الذات تغدو الحياة بلا معنى، وكل ما لقيه من شرور وعنف جسدي أو رمزي يرتبط بدوره بالتربية الأولى ما بين المنزل والمدرسة، وهذا موضوع كان بيير بورديو قد تناوله في دراسة معمقة بالعنوان ذاته، لكن الفخراني هنا سوف يتابع آثار هذه التربية في سلوك هارون في التعامل مع كلبه ونيس، وهو الأب الذي حرم من رعاية ابنه آدم بسبب اكتشاف زوجته الألمانية بربارة لمدى عنفه الكامن تحت مظلة الحب، بمعنى حب عارم مشروط بالخضوع التام لرغباته أو لأوهامه الكثيرة ظنًّا منه أنه محقّ، وهذا الكشف يمكن استخلاصه من علاقة هارون بالكلب ونيس واستعانته بمحركات البحث والكتب المعنية بتربية الكلاب التي سوف تساعده على إخضاع الكلب.
في هذا المستوى من صدمة الخيانة ومستتبعاتها في الذات تغدو الحياة بلا معنى، وكل ما لقيه من شرور وعنف جسدي أو رمزي يرتبط بدوره بالتربية الأولى ما بين المنزل والمدرسة، وهذا موضوع كان بيير بورديو قد تناوله في دراسة معمقة بالعنوان ذاته، لكن الفخراني هنا سوف يتابع آثار هذه التربية في سلوك هارون في التعامل مع كلبه ونيس، وهو الأب الذي حرم من رعاية ابنه آدم بسبب اكتشاف زوجته الألمانية بربارة لمدى عنفه الكامن تحت مظلة الحب، بمعنى حب عارم مشروط بالخضوع التام لرغباته أو لأوهامه الكثيرة ظنًّا منه أنه محقّ، وهذا الكشف يمكن استخلاصه من علاقة هارون بالكلب ونيس واستعانته بمحركات البحث والكتب المعنية بتربية الكلاب التي سوف تساعده على إخضاع الكلب.
ومن هنا فإن كل انتكاسة مع الكلب أو مع أسما سوف تعيده إلى المربّع الأول: تجدد الكوابيس وتصاعد نزعتي الكراهية والانتقام من بربارة، ومن ثم الانطواء درءًا لتدخّل الآخرين في حياته حتى لو كان مجرد فضول اعتيادي من الجوار أو لمن يعرض عليه خدمات بغرض ابتزازه. ونجد مقولة سارتر: «الآخرون هم الجحيم» متمثلة في مواقف هارون المطعون في شرفه من المحيط والناس، وفي الغالب هي أزمة مثقفين بحساسية عالية حين يحمّلون الآخرين أكثر مما يمكن تحمّله، والمشكلة برمتها ترتبط بسوء الفهم أو بسوء الظن أو بالصمت وعدم الاكتراث، فالناس عادة يعيشون حياتهم في مشتركاتهم بما يرونه طبيعيًّا مع شيء من التسليم، وأن من يشذ عن سلوك الجماعة فهو متمرد أو مجنون، وكان ميشال فوكو قد تناول الجنون بالتحليل المعمق في كتابه «تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي»، حتّى لو كان هذا الفرد فنانًا مبدعًا أو كاتبًا كبيرًا.
ما حكايته إذًا؟
أعتقد أن وصول القارئ لمثل هذا السؤال إنما ينمّ عن مهارة سردية تحسب للفخراني، فالتشويق بلغ مداه ولا بد من نقلة جديدة تؤكد براعة الروائي في الاشتغال على مستوى لغة السرد والاهتمام بالهوامش والتقاط التفاصيل. كناقد أرى أن حضور هذه التفاصيل جاء بمنزلة إضافة جمالية للمتن السرديّ بكامله وربما على طريقة بورخيس في الجمع ما بين الحقيقي والتاريخي والخيالي: «أدخلت إصبعها في جوفي لأفرغ جالونات من الماء، الدماء، الخطايا، ملايين الومضات، الأرواح التي التهمتها عبر الكاميرا، الظلال، الأفاعي، طيور الفزع. لم تنته إلا وقد بصقت من جوفي الشمس الجحيمية وضفدعًا يسكن حنجرتي، لأتنفس شيئًا شهيًّا كالحياة، لتصدح من جوفي الموسيقا والأضواء وظباء ملونة في حجم الكف».
ختامًا، رواية «إخضاع الكلب» فريدة في موضوعها، وهذه الفرادة رافقتها أساليب ووسائل تعبير تناسبها، سواء في اللغة السردية أو الشاعرية الحافلة بالصور المبتكرة في الاستعارة والمجاز والتشبيه، إلى جانب اللوحات المشهدية الناجمة عن اشتغال حقيقي ودأب يستحق الإعجاب والثناء.
