
أروندهاتي روي: إياكم وقراءة رواياتي!
عقب روايتها الأولى «إله الأشياء الصغيرة» (1997م)، لم تنشر أروندهاتي روي رواية أخرى طيلة عشرين عامًا، إلى أن أصدرت روايتها الثانية «وزارة السعادة القصوى» في عام 2017م. ومع ذلك، لم تنقطع عن الكتابة على مدار العقدين الفاصلين: مقالات عن سدود وعن تهجير سكان وعن الديمقراطية، نُشرت في صحف ومجلات مثل مجلتي «أوتلوك» و«فرونتلاين» الهنديتين وصحيفة «الجارديان» البريطانية، وهي المقالات التي صدرت لاحقًا في عدد من الكُتب فاقَ عددُها ما أصدرته من روايات، قبل أن يصدر أغلبها في كتاب واحد بلغ عدد صفحاته إضافة إلى الحواشي ألف صفحة تقريبًا، وحمل عنوان «قلبي المُشاغب» في عام 2019م، وبعدها بأقل من عامٍ واحد أصدرت تسع مقالات جديدة في كتاب بعنوان «آزادي».
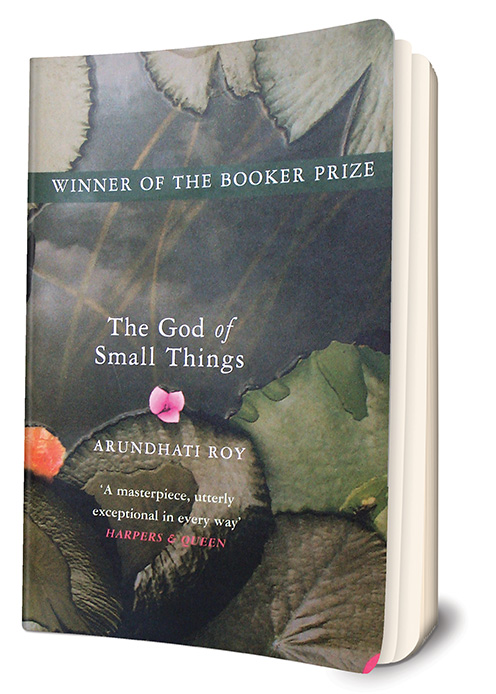 تحمل النظرة إلى العقدين الفاصلين بوصفهما فجوة، أو عدّ الكتابة غير الروائية انفصالًا عن الرواية، إساءة فهم لمشروع «روي»، وهي تُقرّ بأن وصفها بـ: «كاتبة- ناشطة، حسب الدارج في القرن الحادي والعشرين» يُصيبها بالجفول (والإحساس بأنها تُشبه أريكة وسريرًا في آن واحد)؛ ذلك أن المقالات التي كتبتها بين الروايتين ليست جدارًا بل جسرًا، حيثُ يظل مدار اهتمام وهاجس روي الدائم هو السلطة: من يمتلكها (ولم؟)، وكيف تُستخدم (وكيف يُساء استغلالها؟)، والطرائق التي يُقاوم بها من لا يمتلكون السلطة من يملكونها، والأهم من ذلك هو اكتشاف الجمال والمرح وسط هذه النضالات.
تحمل النظرة إلى العقدين الفاصلين بوصفهما فجوة، أو عدّ الكتابة غير الروائية انفصالًا عن الرواية، إساءة فهم لمشروع «روي»، وهي تُقرّ بأن وصفها بـ: «كاتبة- ناشطة، حسب الدارج في القرن الحادي والعشرين» يُصيبها بالجفول (والإحساس بأنها تُشبه أريكة وسريرًا في آن واحد)؛ ذلك أن المقالات التي كتبتها بين الروايتين ليست جدارًا بل جسرًا، حيثُ يظل مدار اهتمام وهاجس روي الدائم هو السلطة: من يمتلكها (ولم؟)، وكيف تُستخدم (وكيف يُساء استغلالها؟)، والطرائق التي يُقاوم بها من لا يمتلكون السلطة من يملكونها، والأهم من ذلك هو اكتشاف الجمال والمرح وسط هذه النضالات.
فسواء في روايتها الأولى «إله الأشياء الصغيرة» التي تدور حول أسرة واحدة، أو روايتها الثانية «وزارة السعادة القصوى» ذائعة الصيت، تظل الروايتان -فيما تطرحانه من تساؤلات أو تتصدى له من موضوعات- سياسيتين بامتياز شأنهما شأن أي من مقالاتها، كما أن الأخيرة بدورها مكتوبة بقوة وحب مثل روايتيها، وبقلق النقاء والاكتمال والحكايات البريئة نفسها.
وُلدت روي في مدينة «شيلونغ» شمال شرق الهند في عام 1959م، ونشأت في ولاية «كيرالا» على الساحل الجنوبي الغربي. التحقت بمدرسة التخطيط والعمارة في «نيودلهي» عام 1976م، وظلت تعيش في العاصمة منذ ذلك الوقت من دون أن تمارس الهندسة المعمارية. حصلت على كثير من الجوائز منها جائزة «البوكر» في عام 1997م عن رواية «إله الأشياء الصغيرة»، وجائزة «لانان للحرية الثقافية»، وجائزة سيدني للسلام، وجائزة «نورمان ميلر» للكتابة المميزة، وجائزة محمود درويش في عام 2017م.
الدعوة لتعزيز وعي القارئ
● تلفت كتاباتك الأنظار للتفاصيل والعموميات وتمزجهما معًا عن عمد، أو تسلِّط عليهما الضوء من قريب حينًا، أو من مسافة بعيدة حينًا آخر.
■ لا يجري الأمر على نحو واعٍ من جانبي، لكنّي أظن أن له علاقة وطيدة بالكيفية التي يتموضع بها المرء ثقافيًّا داخل الهند، حيث يتوقع كل فرد أن يعيش داخل شبكة نمطية تضم الطائفة والجماعة والدين والانتماء العرقي، حيث تُسفر الانتهاكات عن الآثام كافة، ابتداءً من جرائم «الشرف» حتى الطرد من المجتمع، أما إن أصبحت خارج تلك الشبكة مثلي -أي لا تنتمي إلى طائفة أو جماعة بعينها مثلًا- فمآلك آنئذ أن تُصبح غريبًا بين أهلك. سأشرح لك؛ إذْ لا يعني ما قلته أنّي أنحدر من طائفة أو جماعة مُضطهدة تعرضت للاستغلال على مدار أجيال، بل على العكس، تنتمي أمي إلى نخبة المجتمع وهم مجتمع المسيحيين السوريين(١) المُغلق في «كيرالا»، مثل «آمو» في «إله الأشياء الصغيرة». وجاء أبي الذي كان مدمنًا والذي هجرته أمي بعد عامين اثنين من ولادتي، من البنغال.
كانت عائلته مُفرطة التفرنج لكنها ليست مسيحية، وعلى مدار ثلاثة أجيال تحول جدي الأكبر وجدي وأبي إلى المسيحية كل منهم على حدة. ولديَّ قريب اعتنق الإسلام، وآخر اليهودية. وأبي مدفون في مقبرة مسيحية في ضواحي «دلهي». لكن المفارقة أن أمي محرومة كنسيًّا ولن تُدفن في مقابر السوريين المسيحيين؛ لأنها تزوجت من خارج جماعتها ثم طُلِّقت. من دون أن يعني ذلك أن هذه رغبتها. وعلى الرغم من ذلك، ومن ذلك العداء الذي تعرّضت له من طائفتها، فإنها لا تزال تعيش وتعمل في «كيرالا». أما أنا فهربت وجئت إلى «دلهي» ودرست الهندسة المعمارية، وأنا الآن ضمن عالم خاص شيدته لنفسي -فأنا كاتبة من دون «أهل»، لكن كتابتي استحدثت جماعتي الخاصة… وصارت جواز سفري لأماكن لا تحتفي دائمًا بالآخرين- إلى جُزر «براهمابوترا» في ولاية «آسام» حيث يعيش كثيرون مِمَن شطبهم «السجل الوطني للسكان»، وإلى وادي «كشمير» المضطهد حيث يعيش ويعمل أعز أصدقائي، أو إلى غابات وسط الهند حيث تُشنّ حروب العصابات.
أذهب إلى تلك الأماكن لأني أعلم أني ما لم أذهب إليها وأتكلم مع سكانها، فلن أتمكن أبدًا من فهم الأنماط والخصوصيات والتفرد والشمولية وكذلك التعقيد الجنوني في العالم الذي أرغب في الكتابة عنه. إن أعظم مكافأة للكاتب هي الدعوة لتعزيز وعي القارئ- ليس بالمعنى الصحافي حتمًا لأني لا أزعم الحيادية. والوقت الذي أمضيته في التنقل بين وسائل النقل، وفي أماكن غريبة برفقة بشر يعرفون مجتمعاتهم وقراهم وبيئاتهم كما يعرفون أنفسهم… هذا الوقت هو «أهلي» على نحوٍ ما. هذا ليس مجتمعًا جهويًّا، بل مُجتمعًا يُشبه السير فوق وسائد من الزنبق تطفو فوق سطح بحيرة، أو السير فوق حجارة لعبور نهر متدفق. أو ربما نكون نحن وسائد الزنبق وحجارة العبور.

تحول في اللغة الدارجة
●تولين أيضًا اهتمامًا كبيرًا في كتاباتك القصصية باللغة «الرسمية» أو السياسية- لائحة الشرطة في «إله الأشياء الصغيرة»، وأسلوب استعمال «أنجم» في رواية «وزارة السعادة القصوى» لاصطلاح «الهيجرا»(٢) في حين تتبنّى سعيدة مصطلحات مثل «أنثى متحولة جنسيًّا» و«رجل متحول جنسيًّا» و«متوافق الجنس»، إضافة إلى ملصقات مثل «ممنوع اللمس» أو «طائفة موقوتة».
■ لكم أدرك قدر أهمية هذا الأمر بالنسبة لي كلما أمعنت التفكير فيه- أعني الانتباه للغة الدارجة جنبًا إلى جنب البحث عن لغتي الخاصة. فعلى سبيل المثال، شهدت اللغة الدارجة تغييرًا كاملًا في الهند حين أُجريت التجارب النووية إبان التسعينيات؛ ذلك أنه بعد أن أعلنت الهند عن نفسها بوصفها قوة نووية، أصبحت أغلب التعليقات ذات الصلة بقومية هندوسية عدوانية جديدة تَعمِد إلى نعتِ المواطنين بالهنود «الحقيقيين» أو «الخالصين»، وتنميط الأقليات الدينية؛ وبخاصة المسلمون، ووصمها بالعار، شيء لا عيب فيه، وصار رُهاب الإسلام عاديًّا.
هذا التحول في اللغة هو ما حملني على كتابة «نهاية الخيال»، مقالي عن تجارب الهند النووية. ثم سافرت إلى وادي «نارمادا» وكتبت عن حركة مناهضة بناء السدود ووجدت لُغة مُغايرة، حيث يصف السكان هناك أنفسهم بعبارة «المتضررين من المشروع». هل أنتِ متضررة؟ كلا، اسمي ليس على اللائحة. والآن في ولاية «آسام» تبرز مفردات جديدة بسبب «السجل الوطني للسكان»؛ حيثُ يستعمل صائدو الأسماك في الجُزر البعيدة كلمات مثل «ناخبين مُريبين» و«أجانب مُعلنين» و«مواطن أصلي»، وتشغلهم كيفية تنظيم «وثائق التركات». وفي «كشمير» أثمر الاحتلال العسكري مفرداته الخاصة التي رتبتها «تِلو» في معجمها «الكشميري- الإنجليزي» برواية «وزارة السعادة القصوى». وهناك لغة الطائفة- باستعمالاتها التقليدية الممقوتة، واصطلاحاتها الرسمية النابية.
تُرى كيف أشرح لك كل هذا؟ فالقصة بالنسبة لي هي الحياة نفسها، ورواية القصة هي قصة في حد ذاتها، واللغة التي تُروى بها القصة هي قصة كاملة أخرى في حد ذاتها؛ لأنه في هذا الجزء من العالم تُصبح اللغة مُحيطًا تتزاحم فيه أسراب من أسماك اللغة وأسماك الكلمات.
● أظن أنك استعملت عبارة «اللغة هي الجلد الذي يكسو تفكيري» في إحدى مقالاتك.
■ لم يكن مقالًا، بل شيئًا كنت أردده في أثناء الحديث عن «إله الأشياء الصغيرة»؛ ذلك أن ثمة من يظن أحيانًا أن اللغة شيء نُشيده أو نختاره. لكن الحقيقة خلاف ذلك بالنسبة لي؛ فهي تأتي مُصفّاة لتروي القصة التي تنتظر أن تُروى. تأتيني كأنها مقطع صوتي، موسيقي في الغالب. لهذا عندما أكتب لا أسترسل في الكتابة ثم أعيد الصياغة وألقي ما كتبته، بل يبدو الأمر كأني أسمع النص، ثم تأتي مرحلة التحسين لكن من دون قدر كبير من إعادة الصياغة. وكنت أقوم مؤخرًا بترتيب خزانة ثيابي حين عثرت على أوراق كثيرة بها أجزاء من «وزارة السعادة القصوى»، كُتبت منذ ثمانية أعوام. ووجدت أوراقًا وفقرات كاملة لم تشهد أي تغيير، كأن تلك الجُمل والعبارات تتبدى مثل خيوط ملونة تنتظر حبكها في نسيج واحد.
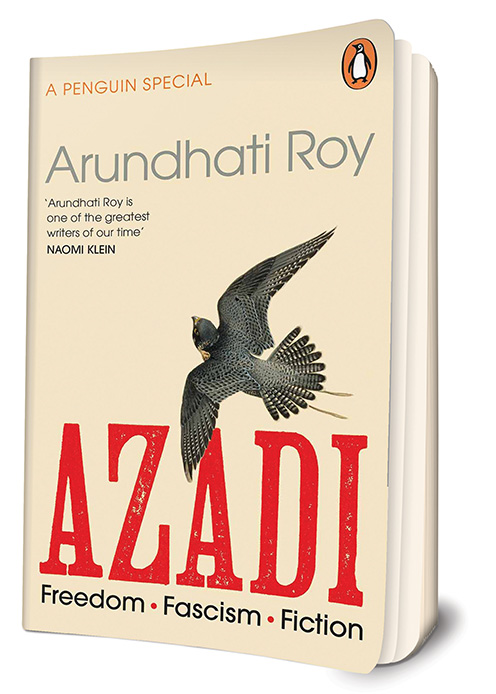 ثورة في مقبرة
ثورة في مقبرة
● في كتابتك يتكرر ما يُشبه ثورة في مقبرة- ثمة تناقض أو فجائية تتعلق بالأماكن والاستعارات أيضًا. ففي بداية «إله الأشياء الصغيرة» تصفين نزول المطر على حديقة باستعارة شديدة العنف؛ إذْ يحرث الأرض «كأنه إطلاق نار»، وفي «وزارة السعادة القصوى» تُشبهين جُرحًا نجم عن رصاصة بـ«زهرة صيفية مُبهجة». وكأنّ الأشياء تخالف ما قد نتوقعه منها، وبخاصة من حيث العنف أو الرفق.
■ لم أفكِّر من قبلُ قطُّ في هذه المسألة بالطريقة التي أشرت إليها؛ أي تراصف هاتين الاستعارتين. لكن بلى، أظن أن الأشياء قلما يتطابق جوهرها مع ما تبدو عليه، وعلينا أن ننزع عنها قشور الدعاية… السلام والحب والموت والمطر وشروق الشمس وما استقر لدينا من أفكار عن الحالة السوية والأمومة والأسرة. لكم كان مسكن الأسرة بالنسبة لي شخصيًّا مكانًا بالغ القسوة والترويع. كل انكساراتي وقعت هناك، وأتوجس شرًّا كلما رأيت إعلانًا يحمل رؤية لمنزل مثالي تعيش فيه أسر سعيدة. ما انتشلني كان الصداقة- صداقات وثيقة ومشاعر حُب عظيمة، ليس السلالة ولا «العائلة».
ثورة في مقبرة هي ثيمة «وزارة السعادة القصوى» حرفيًّا لا مجازيًّا؛ ذلك أن المقابر في «كشمير»؛ حسبما يكتب موسى لابنته المتوفاة الآنسة «جِبين»، هي حيث يحيا الموتى وحيث الأحياء موتى يزعمون أنهم أحياء. وفي إحدى مقابر دلهي تُشيّد «أنجوم» (دار الجنة للضيافة) حيث تضم كل غرفة فيها قبرًا. وحيثُ يغدو الجدار الفاصل بين الأحياء والموتى شديد المسامية، وسترى إنْ أعَرْت انتباهك لمن يعيش أو يموت أو يُدفن هناك، وللصلوات التي تُتلى، أنّها حقًّا ثورة. ومن ثم هاكم تحذيرًا- إياكم وقراءة رواياتي على أمل أن تروا المقابر ملأى بالموتى وبيوت العائلات يسكنها الأحياء.
السعادة سلاح النساء في الهند
● تتصف حبكتا روايتيك بالقتامة الشديدة، لكنهما بالغتا الجمال أيضًا، وعامرتان بكثير من المرح والثراء، وكلا الكتابين ينتهيان في مكانٍ بهيج. هذا نوع آخر من التوتر كنت آمل أن تتمكني من الحديث عنه.
■ التوتر جزء مما كنا نتحدث عنه آنفًا؛ تغيير المسارات والعبث بأنظمة السير المجازية، لا في المجال العام فقط، بل داخل النفس البشرية أيضًا. ثمة مقطع في «إله الأشياء الصغيرة» أتحدث فيه عن «الكاثاكالي»؛ وهي رقصة من «كيرالا»- وشكل غنائي بديع من أشكال الحكي أعتقد أنه أكثر ما أثّر فيَّ بِصِفَتِي حكواتية. وأصف في المقطع قدرة راقص «الكاثاكالي» على أن يُظهر لك قَدْرَ الأسى الذي تنطوي عليه السعادة؛ أو سمكة الخزي المخبوءة داخل بحر الجاه والمجد.
وفي «نهاية الخيال» أيضًا ثمة بيان يدعو إلى: «التماس البهجة في أكثر الأماكن حزنًا، وإلى تحرّي الجمال في مخبئه». أحيانًا ما أشعر أن السعادة سلاح بالنسبة للنساء في الهند؛ إذْ لا يتوقع أحد أن نكون سعداء، بل ينتظرون مِنا أن نضحي وأن نعاني وأن نخدم. لكم كان الإحساس بالمرارة يتملك أمي حيال الرجال وكثير من الأشياء إبان نشأتي في «كيرالا»، لكن لَشَدَّ ما كانت مدرستها تنبض بالحيويّة؛ ذلك أن النساء والفتيات داخل المدرسة ما كن يشعرن قط بأنهن أقل من الأولاد في أي شيء، ويظهر ذلك في أسلوب حديثهن وسلوكهن وثقتهن العفوية.
● أريد أن أنهي حديثنا بسؤالك عن رقصة «الكاثاكالي» التي حظيت بمكانة مهمة في رواية «إله الأشياء الصغيرة»، عندما زار «إستا» وراحيل المعبد. هذا شكل آخر من أشكال الحكي أو رواية قصة. كيف عثرت على هذا الشكل؟
■ في «أيمنام» ثمة مجتمع كامل لراقصي «الكاثاكالي»، والشخص الذي كنت أفكِّر فيه عندما وصفت الرقصة في «إله الأشياء الصغيرة»، كنت أعرفه منذ صغري. كان أشد الرجال وسامة، وقد صارحني بأنه كان يحلم منذ كان طفلًا أن يُصبح راقصًا، لكن أسرته كانت فقيرة.
وقد اصطحبته أمه لزيارة الأستاذ أو المُعلِّم. كان يومًا ممطرًا مشى خلاله طفل صغير برفقة أمه إلى منزل المعلِّم، يستظلان بورقة شجر عريضة لأنهما لا يملكان مظلة. ولا يملكان المال اللازم لدفع نافلة المُعلِّم؛ وهي الهبة التي يحصل عليها الأخير لقاء احتضان الطالب وتعليمه. وهكذا انتحى المعلّم بالأم جانبًا وأعطاها خمس روبيات وطلب منها أن تردها إليه على أنها نافلة المُعلِّم، وهكذا بهذا السخاء والصنيع الجميل، بدأ واحد من أكثر من الحكائين العظماء الذين عرفتهم تعليمه.
بالنسبة لي، كل ما أراه يشغلني وأسخّره لغايتي وهي رواية القصص. لكن ما أغرب أن تكون كاتبًا يستلهم الجانب الأكبر من أفكاره من الرقص! لكن هذا حقيقي، فكلمة «كاثاكالي» تتألف من مقطعين؛ الأول «كاثا/ Katha» ويعني قصة، والثاني «كالي/ Kali» ويعني يمثِّل دورًا؛ لذا فراقص «الكاثاكالي» يُصبح القصة لا مجرد روايتها فحسب، ويمُكنه أن يتبدّل في لحظة من ملك شديد البأس إلى مُجرّد تفصيلة دقيقة حميمة. يُمكنه أن يُصبح سماءً أو عربة يجرها الخيل أو حربًا أو عاشقًا أو أيلًا أو قردًا في غابة أو ملكًا ضاريًا أو ملكة متواطئة. وأنا أحب ذلك. أحب الكتابة بجسدي؛ بجلدي وعينيَّ وشعري.
لطالما أشعر أن جدارة حكّاء القصص هي تمكّنه من أداء تلك القفزات من دون أن تلهث أنفاسه، ومن دون أن يبدو أنه بذل جهدًا. تمكّنه من الانتقال؛ لا من الملحمي إلى الحميمي فقط، بل من المزاح إلى الحزن إلى الفجيعة إلى القسوة إلى الابتذال. أحيانًا ما أقرأ كتابة جميلة تُحرِّك المشاعر لكن تخلو من المزاح أو السوقية، وبالنسبة لي هذان جانبان مهمان جدًّا فيما أكتبه. يجب أن ينطوي ما نكتبه على كل شيء- أو بلغة الموسيقا الهندوستانية الكلاسيكية، أن تكون لحنًا يضم سائر النغمات داخل جواب واحد(٣).
هوامش الحوار:
(*) المصدر: «الباريس ريفيو» صيف (يونيو- أغسطس) 2021م، العدد 237. https://www.theparisreview.org/interviews/7814/the-art-of-fiction-no-249-arundhati-roy
(١) كان القديس توما الرسول (ابن إقليم الجليل شمال فلسطين) قد ارتحل إلى الهند في عام 52 ميلادية حيث قضى أكثر من عقدين من الزمن يُبشِّر بالمسيحية، وفي عام 345 ميلادية هاجرت اثنتان وسبعون عائلة سورية مسيحية واستوطنت الهند، وكوّنت مع الهنود السريان الأرثوذكس، مجتمع المسيحيين السوريين.
(٢) تسمية محلية شائعة في شبه القارة الهندية تصف الذكور الذين يتقمصون الهوية الجنسية للإناث.
(٣) الجواب Octave اسم يُطلق على ثامن درجة في السلّم الموسيقي الذي يتألف من سبع درجات تتكرر، بحيث يكون تردد كل درجة في الدورة الجديدة ضعف ترددها في الدورة التي سبقتها، وتختلف من حيث الجواب صعودًا وهبوطًا.
