
شهلا العجيلي - ناقدة وروائية سورية | سبتمبر 1, 2021 | قضايا
صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب منذ عام 1980م، في الحقبة الساداتيّة عن (العربي للنشر والتوزيع) في القاهرة، ويشير كامل الزهيري في مقدمة الطبعة الأولى إلى أن ظهور الكتاب كان نتيجة رحلة البحث الطويلة في الوثائق التي اقتضاها الإعداد لكتابه السابق «مزاعم بيغن. الرد عليها بالوثائق» الذي صدر عام 1978م، فظهر «النيل في خطر» الذي يحاول «كشف وتفنيد مشروع صهيوني خطير هو مشروع شراء مياه النيل وتحويلها إلى صحراء النقب»، ويؤكّد أن الكتاب الأخير أخطر من الأول؛ لأنه لا يتعلق بتصحيح حقائق التاريخ فحسب، بل يتعلق بالخطر على المستقبل. يمكن القول: إن الكتاب بحث معمّق في الجغرافيا السياسية، وفي الوثائق التاريخية فضلًا عن لمحات من الخصائص الأنثروبولوجية، برؤية علمية قانونية، ومنهج استقصائي جادّ.
يعود الزهيري الحقوقي والكاتب اليساري الكبير، ونقيب الصحفيين صاحب الشعار المعارض «إسقاط عضوية نقابة الصحفيين كإسقاط الجنسية» إلى أحداث عام 1903م لحظة وصول تيودور هيرتزل إلى القاهرة يوم 23 مارس، ومعه كل ما يلزم لمشروعه التاريخي، المتضمن توطين اليهود في شبه جزيرة سيناء، بوصفها الجسر الواصل إلى فلسطين، وجرّ مياه النيل إليهم، لتكون سبب الحياة في موطنهم الجديد، وكان ذلك كله تحت عباءة الإنجليز، حيث تمكن هيرتزل، بكتمان شديد من تمرير المشروع، على الرغم من الصراع بين الخديو عباس الثاني وكرومر، وبين مصطفى كامل والإنجليز، وبين الإنجليز والفرنسيين، وبعيدًا من أعين الصحافة المصرية، حيث كانت أحداث أقل أهمية بكثير، تحظى بانعكاساتها في جريدتي اللواء والمؤيد.
هيرتزل يبحث في المدوّنات
لم يوفّر هيرتزل جهدًا لتحقيق مشروعه، ومشروع إسرائيل برمّتها، فاستعان برجال الدين، وبالصحفيين، وبالكتّاب والباحثين مثلما استعان بالسياسيين والعسكريين وأصحاب رؤوس الأموال. وقد اعتمد في معارفه حول المنطقة على رحلات المستشرقين، ومدوّناتهم، ولا سيما على كتاب البريطاني براملي «صحراء التيه» الذي كتبه بعد استكشافه ربوع سيناء وصحراء التيه، قبل الاحتلال البريطاني ببضع سنوات، ونشرته كامبردج 1871م. تكمن خطورة مشروع هيرتزل في أن اللجنة أخفت أنه لتوطين اليهود، كما أنها قللت جدًّا من عدد السكان في سيناء، وثمّة تقارير خاصة به لا تزال غائبة، وهو على الرغم من عدم تحققه الفعلي، شكّل نواة للمشاريع المائية، ثم الحيوية كلها التي لها علاقة بأطماع إسرائيل في الماء العربي، التي كانت العامل الأساس لبناء كيانهم الاستيطاني على أرض فلسطين العربية.
انبثق مشروع جونستون من تلك الفكرة الصهيونية؛ إذ استند جونستون إلى كتاب للمهندس الأميركي لودر ميلك «فلسطين أرض الميعاد» 1945م، الذي يعلن فيه إيمانه بضرورة إنشاء إسرائيل، وإعادة إحياء الحضارة الزراعية التي أقامها الأنباط، الذين سكنوا سيناء وجزءًا من الأردن، وكانت عاصمتهم البتراء، وعلى الإسرائيليين القيام بهذه المهمة.
مغامرة السادات وتسويغاتها
بُعثت فكرة هيرتزل من جديد في عهد السادات 1974م، الذي اتخذ لها أكثر من تسويغ أيديولوجيّ، فقد وعد بتحويل مياه النيل إلى صحراء النقب عبر سيناء، عبر ترويج إشاعات تقول: إنّ مياه النيل تفيض عن حاجة مصر، وإنّنا «نقذف إلى البحر المتوسط بأكثر من ستة مليارات متر مكعّب من المياه العذبة». ويبتدع السادات تسويغًا آخر، لكنه ديني هذه المرة؛ إذ يتعلّل بسقاية الحجيج إلى القدس، ثم يأتي إلى التسويغ السياسي، فيقول: «ونحن نقوم بالتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، سنجعل هذه المياه مساهمة من المسلمين تخليدًا لمبادرة السلام…».
لقد وعد السادات مدّ إسرائيل بالمياه إلى القدس مرورًا بالنقب، مقابل وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وغزة، وإزالة المستوطنات القائمة، وإسكات المستوطنين في النقب. جاء ذلك بالاتساق مع فكرة إليشع كالي، خبير المياه الإسرائيلي، ورئيس تخطيط هيئة المياه في إسرائيل، الذي اقترح لحلّ أزمة المياه القائمة، والقادمة في إسرائيل، شراء مياه النيل بعد السلام، ولا شك في أن فكرة كالي التي أطلقها عام 1974م، تستند تمامًا إلى أفكار هيرتزل التي وضعها عام 1903م.
ظهرت بعد صدور الطبعة الأولى للكتاب مجموعة من المقالات لخبراء وإعلاميين مصريين تؤيد وتضيف إلى ما جاء فيه، ضمت إلى الطبعتين الثانية والثالثة، وفيها مقال آخر للزهيري بعنوان: «النيل في خطر، ومصر أيضًا»، نشر في صحيفة الشعب في 16 سبتمبر 1980م، يقول فيه كاتبه: إنّ هذا الموضوع لا يقلّ خطورة عن موضوع اتخاذ قرار حفر قناة السويس في مصر… وإن موضوع النيل، «ستكون له جوانب عسكرية في المدى البعيد»، ونحن نتساءل بقلق: هل أصبح المدى البعيد قريبًا؟
«نهر النيل في المكتبة العربية»
دفاع عن حق تاريخي بشهادة التاريخ والعلماء وحكام دول وإمبراطوريات
سمير مُندي – ناقد مصري

صدر كتاب «نهر النيل في المكتبة العربية» لمؤلفه محمد حمدي المنياوي عن الهيئة العامة لقصور الثقافة- القاهرة 2021م، وكان الكتاب قد صدر في طبعته الأولى عام 1966م عن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب (المجلس الأعلى للثقافة حاليًّا). والآن تعيد سلسلة «ذاكرة الكتابة» طباعته، في ظل أوضاع تاريخية استثنائية يمر بها النهر، وسط صراع على مياهه بين دولة المنبع (إثيوبيا) ودولتي الممر والمصب (السودان ومصر).
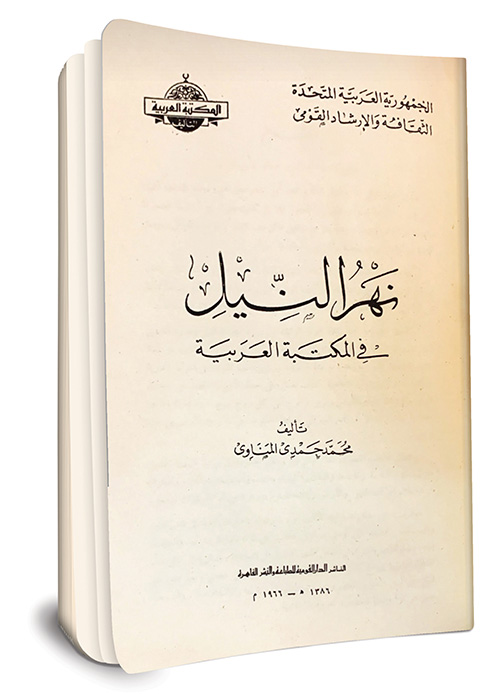 هذه الأوضاع حاضرة في الكتاب، سواء من خلال المعاني التي تحملها إعادة الطبع، ثم إعادة قراءة الكتاب في ضوء أوضاع مغايرة. أو من خلال إشارة مُقدم الكتاب إلى «فترة حساسة» يمر بها النيل في تاريخه، وتاريخ مصر معًا، «فترة تحاول فيها بعض الدول تهديد الأمن القومي المصري من بوابة نهر النيل، ومن نافذة الأطماع التي تريد الاستئثار بمياه النهر الخالد، وتعريض دولتي المصب (مصر والسودان) لأخطار الجفاف والجدب». وبخلاف هذه الإشارة المقتضبة والغامضة إلى سياق الصراع الحالي، فإننا لا نعثر، في مقدمة الكتاب، على تفاصيل تربطه بلحظته الحاضرة المصيرية. كما أننا لا نعثر، في متنه، أيضًا، على صراعات شبيهة في الماضي نقرأ في ضوئها مجريات هذه اللحظة. إذن فما موضوع هذا الكتاب الذي تُعاد قراءته في سياق أحداثٍ لم تجر له في حسبان، ولم تكن ضمن أولوياته وموضوعاته التي تناولها؟ وكيف يمكن أن نقرأه في ظل هذه الأحداث الآن؟
هذه الأوضاع حاضرة في الكتاب، سواء من خلال المعاني التي تحملها إعادة الطبع، ثم إعادة قراءة الكتاب في ضوء أوضاع مغايرة. أو من خلال إشارة مُقدم الكتاب إلى «فترة حساسة» يمر بها النيل في تاريخه، وتاريخ مصر معًا، «فترة تحاول فيها بعض الدول تهديد الأمن القومي المصري من بوابة نهر النيل، ومن نافذة الأطماع التي تريد الاستئثار بمياه النهر الخالد، وتعريض دولتي المصب (مصر والسودان) لأخطار الجفاف والجدب». وبخلاف هذه الإشارة المقتضبة والغامضة إلى سياق الصراع الحالي، فإننا لا نعثر، في مقدمة الكتاب، على تفاصيل تربطه بلحظته الحاضرة المصيرية. كما أننا لا نعثر، في متنه، أيضًا، على صراعات شبيهة في الماضي نقرأ في ضوئها مجريات هذه اللحظة. إذن فما موضوع هذا الكتاب الذي تُعاد قراءته في سياق أحداثٍ لم تجر له في حسبان، ولم تكن ضمن أولوياته وموضوعاته التي تناولها؟ وكيف يمكن أن نقرأه في ظل هذه الأحداث الآن؟
ربما تكون «حياة» النهر هي المناسبة الوحيدة المشتركة التي تجمع بين طبعتَيِ الكتاب، الأولى والثانية. فإذا كان الكتاب هو احتفاء بسيرة النهر وتاريخه في المؤلفات العربية التي كتبها رحّالون وجغرافيون ومؤرخون عرب، فإن هذا الاحتفاء هو بمنزلة دق لجرس الإنذار حول «حياة» النهر، الذي لولا حياته، ما كانت حياة مصر وشعبها. طالما أن الكتاب يسلط الضوء على هذه «الحياة» بوصفها مصدر وأصل حياة بلد وُصف بأنه «هبة النيل».
فبخلاف الحضارات المتعاقبة التي ازدهرت على ضفافه على مر القرون، وبخلاف الدور الذي يؤديه من الناحية الاقتصادية، فإن النيل يُعَدّ سببًا قويًّا من أسباب قيام وحدة سياسية واجتماعية في مصر. يقول المؤلف: «لقد كان نهر النيل خيرًا وبركة على كل مصر في جميع نواحي حياتها. فإلى جانب أنه وهبها جزءًا كبيرًا من الأرض كانت من قبل تغمره مياه البحر، وهو الدلتا، فهو قد ربط بين أجزائها مما ساعد على قيام وحدة سياسية واجتماعية، كما كان من الناحية الاقتصادية العامل الوحيد في ازدهار اقتصادها الذي ظل إلى اليوم يقوم على الزراعة، وهذه بدورها تتوقف كلية على ماء النيل لندرة المطر بها». إلى ذلك فإن الكتاب، بما هو عليه من استعراض لمؤلفات ترصد علاقته التاريخية بمصر، هو بمنزلة دفاع عن حق تاريخي في النهر بشهادة التاريخ، وبشهادة علماء وحكام دول وإمبراطوريات تعاقبوا على حكم مصر.
منابع النيل
وفيما يبدو، لم تكن «منابع» النيل، يومًا، حجة في إثبات هذا الحق التاريخي أو نفيه. ليس أدل على ذلك مما يسوقه المؤلف من أن منابع النيل، على أهميتها، لم تُكتشف إلا في منتصف القرن التاسع عشر. قبل ذلك تخبط المؤرخون والرحّالون والجغرافيون العرب في تفسيرات شتى جانَبَها الصوابُ؛ اللهم إلا في مرات نادرة وعلى نحوٍ غامض. ولم تكن هذه المرات النادرة، في أحسن أحوالها، إلا نقلًا لرواية «بطليموس» اليوناني الذي تحدث عن «خروج النيل من جبل القمر».
حتى إن بعض حكام مصر قديمًا لم يستطيعوا أن يقيّموا، على نحوٍ صحيح، مدى صحة تهديدات قد تُستخدم فيها منابع النيل كسلاح سياسي، جراء جهلهم بالمنابع الأصلية للنيل. يقول المؤلف في واقعة تاريخية تلتقي، وإن بطريق الخطأ، مع ما يمكن أن يمثله استخدام هذه المنابع سياسيًّا: «وعندما علم الإسكندر أن أردشير الثالث (358-337) ق. م أحد ملوك فارس فكر في تجفيف نهر السند، الذي كان يعتقد أنه المنبع الحقيقي للنيل، حتى يؤدب بذلك العصاة المصريين أمر الإسكندر قائد أسطوله نياركوس أن يبني أسطولًا ليعود به إلى مصر عن طريق السند والنيل، كما أنه كتب إلى أمه أنه اكتشف منابع النيل. ولكنه سرعان ما علم أن نهر السند وهداسيس يصبان في المحيط، وأنه لا علاقة لهما بالنيل».

حافظ إبراهيم
أما الشعراء فلهم رأيهم الخاص في «منابع» النيل وفي فيضانه. فهذا حافظ إبراهيم «شاعر النيل»، مثلًا، ينظر إلى النيل بوصفه مِلكًا لمصر من «المنبع حتى المصب». فهو القائل: «النيل منبعه لنا ومصبه/ ما إن له عن أرضه تحويل». أما أحمد شوقي فقد تساءل عن «منابع النيل»، مرجحًا التفسير الديني الذي يرى أن النيل ينبع «من الجنة من أصل سدرة المنتهى»، على نحو ما تناقل بعض المؤرخين العرب؛ يقول شوقي:
«من أي عهدٍ في القرى تتدفق
وبأي كف في المدائن تُغدق
ومن السماء نَزَلْتَ أَمْ فُجِّرتَ مِن
عليا الجِنان جداولًا تَترقرق».
تحذير من العواقب الوخيمة
سوف يبدو الباب الثالث الذي خصصه المؤلف، بالكامل، للحديث عن «فيضان النيل» وأثره بالزيادة أو النقصان على حياة شعب مصر، بمنزلة تحذير من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن المساس بمنسوب النيل. فإذا ما نقص منسوب النيل عن الزيادة السنوية المعروفة تاريخيًّا ﺒ«وفاء النيل»، فإن الجدب والقحط والمجاعات تصبح خطرًا يهدد مصر وشعبها.
فكيف، يا تُرى، يمكن أن يكون عليه فيضان هذا العام، بعدما قامت إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة أوائل يوليو الماضي؟ هل ينقضي العام، من دون أن نشهد «وفاء» النيل، فيكون عامًا استثنائيًّا، في تاريخ النهر، وتاريخ مصر «هبة النيل»، كما قال هيرودوت؟

شهلا العجيلي - ناقدة وروائية سورية | نوفمبر 1, 2020 | مدن وأمكنة
بعد توقّف استقبال مجموعة من القنوات الفضائيّة، ومنها القنوات اللبنانيّة، عبر لاقط منزلي لمدّة سنتين، حاولت إعادة تنزيلها بعد تفجير مرفأ بيروت الذي حدث في 4 أغسطس الماضي، لكن لم أفلح إلى 14 سبتمبر، وحين ظهرت شاشة MTV، كانت تبثّ القدّاس السنويّ لمقتل أو لاستشهاد الزعيم بشير الجميّل، وذلك وفقًا لأدبيّات الخطاب الأيديولوجيّ. فكّرت: لا شيء يتغيّر في لبنان، فهذا البلد الذي يشبه (صندوق الدنيا) عَصِيّ على الحلول الجذريّة.
كنت في إحدى مراحل حياتي مولعة بوثائقيّات الحرب اللبنانية التي نشأت في عقابيلها المباشرة، ربّما كانت لديّ رغبة في التوصّل إلى مفاتيحها أو فكّ طلاسمها، وقد تتبّعت منذ زمن ما تسنّى لي الحصول عليه لمقاطع من خطابات بشير الجميّل، صاحب شعار لبنان 10452 كم2، الذي لم يكن في مرمى ذكرياتي بقدر ما كان شقيقه الشيخ أمين الجميّل الذي استقرّ على كرسيّ الرئاسة، وكان وقتها نجم الشاشة ببدلته البيضاء وبلفظ الشيخ الذي يصاحب اسمه، فيحدث في ذهن الطفل مفارقة بين الدينيّ التقليديّ والحداثيّ الشبابيّ، الذي لا يترافق ذكره بوصم العمالة لإسرائيل، أو ارتكاب المجازر.
ترافق حضور بيروت لدى جيلي، الذي صاقبت طفولته الواعية مرحلة الثمانينيّات، بالتفجيرات، والعمليّات الانتحارية في الجنوب، وبالاستشهاديّين ببيانات ما قبل العمليّة أو ما قبل الموت، حيث الجلال والرعب والإعجاب، وتمثّلات الأحلام، فتحضر رموز مثل: أنطوان لحد، وسهى بشارة، وسناء محيدلي، وحميدة الطاهر ابنة مدينتي الرقّة، التي علّقنا صورها على جدران البيوت، وحاكينا شخصيّتها في المسرحيّات المدرسيّة، وعاشت في وجداننا.
قبل ذلك كانت أصداء اختفاء موسى الصدر، ثمّ كان حادث اغتيال رينيه معوّض، ثمّ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فحرب تمّوز، ثمّ خروج القوّات السوريّة… إنّها صور متلاحقة، تمحو إحداها الأخرى أو تبدّد ألق ألوانها، ولعلّ سيرة الصورة هنا تشير بوضوح إلى سلطة الإعلام، ودورها في صناعة الخريطة الفرديّة لكلّ منّا.
يترافق ذلك الواقع المرعب والقلق مع الجمال والتحرّر بما فيه التحرّر اللغوي، فـ«بيروت» التي تختصر لبنان تقع خارج سجن اللغة؛ ذلك أنّ المفردات التي تتعلق بالحزب، وبالطائفة، وبالأيديولوجيا عامّة، التي كانت تستوجب الاعتقال في سوريا الثمانينيّات، ستصير على بعد أقل من مئة كيلو متر، من قبيل المباح الذي يتفكّه به الجميع، في الصحف والتليفزيونات والمقاهي والسهرات. تصبح سبيلًا للتندر والضحك، في حين هناك تكون في سوريا سبيلًا إلى حبل المشنقة، مثلها مثل الدولار.
عنت لنا بيروت، الموز، وبنطلونات الجينز، وكاسات البلور الفرنسيّ، وعلب النسكافيه، وشراب «تانج»، وأحذية الرياضة ذات الماركات العالميّة، والأدوية الأجنبيّة الفعّالة، والساعات، والغسالات، والثلاجات، وكروزات سجائر (كنت ومارلبورو)… وكلّ البضائع المفقودة في سوريا، التي نجدها في القرى والبلدات الحدوديّة، حيث أماكن التهريب: مضايا والعريضة، وقد نتمكّن من الوصول إلى شتورة.
كان البيت في الحي أو في الأحياء القريبة الذي يضمّ ابنًا أو أبًا جاء فرزه في الخدمة العسكريّة إلى لبنان، يحوّم حوله شبح الموت، وكذلك أمارات الرزق المتأتّي من تجارة التهريب في الوقت ذاته، تلك هي بيروت: صورة لاجتماع المتناقضات.
كان ثمّة مقابل أدبيّ لتلك الحياة اليوميّة، الاجتماعيّة- السياسيّة، فمن المفاجآت بالنسبة لي هي أنّ صاحب ديوان «الهوى والشباب»، الذي كان رفيق طفولتي، هو بشارة الخوري أو الأخطل الصغير، الذي ظننت لوقت طويل أنّه رئيس الجمهوريّة، وقد عشت المفارقة بين أن يكون شاعرًا يكتب «يا لور حبك»، و«كيف أنساك يا خيالات أمسي»، وأن يكون ذلك السياسيّ المتخشّب الذي يصدر الفرمانات ويزجّ الناس في السجون، كما هي صورة الرؤساء في إدراكي.
جنة المحبين
صوّر عالم الروايات الكلاسيكيّة بيروت على أنّها جنّة المحبّين، وكان ذلك، لا شكّ، من متطلّبات المصداقيّة أو الواقعيّة؛ إذ تمثّل بيروت المساحة القريبة والحرّة للقاء رجل وامرأة من دمشق أو حلب، أو الفضاء المناسب لانتقال بطلة الرواية من حلب لتدخل عالم الكتابة والنشر… وهكذا كان اللقاء الحميم بين سليمان وباسمة في رواية عبدالسلام العجيلي «باسمة بين الدموع» في فندق في بيروت، وهكذا أيضًا سافرت لبنى آل أمير إلى بيروت ناشدة الشهرة الأدبيّة، فتصدّرت صورها الصحف ليغتاظ منها حبيبها في حلب (رامي حسام الدين)، الذي ساعدها في الدخول إلى عالم الكتابة، في رواية «رياح كانون» لفاضل السباعي.
أصيب سليمان في رواية العجيلي في حادث في «ظهر البيدر»؛ حيث هوت سيّارته في الوادي. علمت فيما بعد أنّ الواقعة حدثت مع الكاتب فعلًا، وأنّها تسببت في ضرر في فقرات ظهره، وأنّ عريشة بيت في كتف الوادي حمته من الموت، فصرت كلّما مررت بـ«ظهر البيدر» في الطريق من دمشق إلى بيروت، أخفي وجهي بكفي حتى نتجاوز المنطقة، وكنت أعرض عن السفر شتاءً مهما كان السبب!
ما حدث عقب تفجير المرفأ هو استعادة طفولتنا المفعمة بالحرب، بما فيها تلك اللغة التي دخلت معاجمنا الفرديّة، بالتعبيرات السياسيّة والعسكريّة: زعيم استثنائيّ، الخاصرة الرخوة، الوجود المسلّح، احتواء المقاومة… وصارت الذاكرة المتعلّقة ببيروت أداة قياس لكلّ من الصورة، وفعل العنف، فحين سألتني زميلتي في حديثنا عن «فلسفة الصورة» أن أستحضر صورًا من ذاكرتي، فأوّل ما خطر لي صورة أنقاض بيوت في مدينة مدمّرة، تظهر بينها صورة فوتوغرافيّة ناجية في إطار ذهبيّ مزخرف، لعروسين في حلل زفافهما، والعروس تحمل باقة ورد. هذه الصورة اختزنتها من اجتياح بيروت، كانت دائمًا تعرض على شاشة التليفزيون.
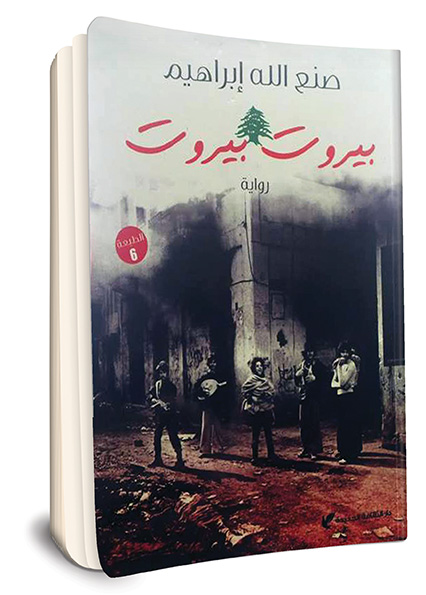 المانفيستو الأدبي لبيروت
المانفيستو الأدبي لبيروت
لعلّ المعادل الروائيّ لهذه الذكريات أو ما يمكن تسميته بـ «المانفيستو» الأدبيّ لبيروت/ الحرب الأهليّة هو رواية صنع الله إبراهيم «بيروت بيروت» (1984م دار المستقبل العربيّ، القاهرة). أعدت قراءة «بيروت بيروت»، ونصحت بها بعض الأصدقاء، وحاولت مشاهدة أفلام لم أحضرها من قبل لجوسلين صعب، فلم أجد أكثر من مقاطع على يوتيوب، لكنّي تابعت حوارًا معها، وكنت رجّحت بإسقاطاتي مرّة أنها إحدى شخصيّات رواية صنع الله، متمثّلة في المخرجة (أنطوانيت فاخوري)؛ إذ يحمل الفِلْم الوثائقيّ الذي انبنى عليه نصّ «بيروت بيروت» رؤيتها الصحفيّة، والتسجيليّة، والنسويّة أيضًا.
هي تشبه صنع الله، بيساريّته، وبعلاقته بالمخيّمات، وبالوجود الفلسطيني المحاط بالدماء، وبتصويره لذلك بكاميرا حرّة. كتبت رواية «بيروت بيروت» بوثائقيّة موجعة، وهي تشكّل تحدّيًا حقيقيًّا للناقد؛ إذ تضعه أمام اختبار المنهج والأداة، فالنصّ وحدة مريحة للدراسات البنيويّة، أي بنية متكاملة مكتفية بذاتها، تحفز العناصر اللغويّة والمشهديّة فيها السرد، ويقوم على تقنية الحكاية داخل الحكاية، أو على سرد بصريّ داخل سرد لغويّ يشكّل الأخير إطارًا حكائيًّا، لكنّ الفصل الجائر للنصّ عن سياقه التاريخيّ الديناميكي والغنيّ موجع للناقد، ولا سيّما ذاك الذي انتمى إلى تلك المرحلة التاريخيّة، حيث سيقسر ذاكرته على الغياب من أجل المنهج!
تعمل المناهج السياقيّة هنا بشكل فاعل أيضًا، لكنّ النصّ بفعل الوثائقيّة من جهة، والحسّ الواقعيّ العميق من جهة أخرى يستنسخ السياق التاريخيّ، بحيث لا يبقي مساحة للتأويل؛ إذ تطغى الوثيقة على كل شيء، والوثائق هنا متضاربة، بحيث تمنح الموضوعيّة، فليس ثمّة مسافة بين اللغة والدلالة، فيظهر البعد التقريريّ ويغيب البعد الإيحائيّ بتعبير سعيد بنكراد، بحيث سنسأل لا بدّ عن موقع المعنى.
تبدو البؤر السرديّة أيضًا متساوية في عمقها، ودرجة انعكاسها، وصفاء العدسة الموجّهة إليها. ذلك كلّه لغز من ألغاز صنع الله إبراهيم، ولعلّ الخطاب الروائيّ المعتمد على الكولاج الإعلاميّ: المقروء، والمسموع، والمرئيّ خطاب جيليّ، فهو بالنسبة لقرّاء الماضي نصّ سياقيّ، وبالنسبة لقرّاء المستقبل نصّ بنيويّ ديستوبيّ، وبكلّ الأحوال فإنّ الوثيقة، أو مجموع الوثائق «تتحوّل إلى مضمون قصصيّ ترقد فيه كلّ الحكايات القابلة لتجسيد هويّة منتوج ما، فهي قد تحيل على قصّة فرد أو تروي قصّة عائلة أو مؤسّسة» حسب بنكراد، وإذا كان البنيويّون يرون أنّه لا شيء يقع خارج اللغة، فإنّنا نقول لا شيء يقع خارج الثقافة أيضًا، فلكلّ فرد علاقة ما بحرب ما، وسيقوم النصّ بإيقاظ هذه العلاقة، بحيث تصير الحرب المرسومة في كولاج الوثائق حربًا كنائيّة عن أيّة حرب أخرى.
تعقيدات الوضع اللبناني
أعتقد أنّ صنع الله كتب هذه الرواية أولًا لنفسه، ليرسم خريطة يستطيع من خلالها أن يفهم تعقيدات الوضع اللبنانيّ منذ سبعينيّات القرن العشرين، أي منذ انطلاق إشارة الحرب الأهليّة، ومن ثمّ يمكن للعالم أن يفهمها: «على أنّي كلّما تتبّعت أحد الخيوط، انتهى بي إلى الانقسام الطائفيّ الشامل، الذي ينفرد به لبنان بين البلاد العربيّة…» ص57؛ لذا سيذهب الراوي الذي يمكن لنا بحريّة أن نجعل المسافة بينه وبين الروائيّ صفرًا، إلى الحفر في التاريخ بحثًا عن المنطلق البعيد للحرب: «في ضوء التاريخ، بدت الحرب الأهليّة التي اشتعلت في إبريل 1975م، وسقط فيها 75 ألف قتيل و140 ألف جريح (ليس بينهم واحد يحمل اسم إحدى العائلات التي تؤجّج القتال وتجني ثمن الضحايا)، حلقة في سلسلة طويلة من الفتن والحروب. أمّا البداية فهي موزّعة بين اللحظة التي اكتشفت فيها العشائر المتنازعة بالمنطقة مأوى مثاليًّا في جبل لبنان يحميها من أعدائها، وتلك التي رست فيها سفن الغزاة الصليبيّين تحت أقدام الجبل العتيد» ص58.
يبدأ الإطار الحكائيّ كالآتي: «فتّشوني مرّتين: الأولى عند الحاجز الجمركيّ، والثانية أمام البوّابة المؤدّية إلى أرض المطار…» ص7، وذلك بعد عتبتين: خريطة لبنان العسكريّة أثناء الحرب، وخريطة بيروت العسكريّة أثناء الحرب.
يظهر الراوي بوصفه كاتبًا مغادرًا بوابة الجمارك في مطار القاهرة باتجاه بيروت، لينشر كتابه في عاصمة النشر، وسيقيم في شقّة الصحفيّ (وديع مسيحة) الذي تغيب زوجته وأولاده في زيارة إلى القاهرة، ووديع هو زميل المدرسة في القاهرة، وصديق المعتقل في معركة عبدالناصر مع اليسار، وهو المتدرّج في الإدارات الصحفيّة ليصل إلى مرتبة متقدّمة حيث كان عالم الصحافة متحكّمًا بقوّة في جينيالوجيا الحرب، ولأقطابه ثقل أيديولوجي دوليّ، وتمويلات ضخمة من محرّكات عدّة للحرب، بالتوازي مع تمويل الميليشيات، وسنجد بشكل رئيس الوزن الماليّ للعراقيين والسعوديين والليبيين.
سيستثمر الراوي تفاصيل رحلته التي لا تتجاوز الأسبوع ليقدّم لنا تاريخًا يعود إلى مطلع القرن التاسع عشر، مرورًا بتعقيدات العلاقة اللبنانيّة السورية الفلسطينيّة، إلى ما بعد ثلاث سنوات على سيطرة قوّات الردع العربيّة؛ إذ تبدأ أحداث الرواية كما يشير تاريخ الصحيفة التي تناوله إيّاها المضيفة في الطائرة بـ 7 تشرين الثاني 1980م.
حافزات سردية
يوظّف تفاصيل الرحلة بدءًا من جلوسه بجوار المستثمر السعوديّ أو متعهّد العمّال المصريّين، إلى عناوين الصحف التي سيزجي بها الوقت، إلى وضع السوق الحرّة، وسعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الجنيه فالدولار… تلك كلّها حافزات سرديّة تجعل المتلقّي يقيس أوضاع اليوم على الأمس. فضلًا عن طلبه البيرة والجبن اللذين يحدّدان انتماءه الأيديولوجيّ بلا مقولات نظريّة أو إخلال بعمليّة التخييل. سنعيش في بيروت تفاصيل الحياة في عقابيل الحرب الأهليّة ودخول قوّات الردع؛ إذ لا تزال الأبنية مثقّبة بالرصاص والشوارع مدمّرة من آثار القذائف، والحواجز العسكريّة الميليشياويّة في كلّ مكان، وسائقو التاكسي تمرّسوا بالخرائط الوقائعيّة لشبكة المواصلات، و«البودي غاردات» والسائقون الخاصّون في خدمة من يدفع لهم، والتهديد يطول الجميع، فلا يعرف المرء صديقه من عدوّه حيث الجميع عميل لجهة ما: «وقبل أربعة شهور من مذبحة النمور، انفجرت شحنة متفجّرات، تعمل بالتحكّم النائي، في سيّارة بشير الجميّل، فأودت بحياة ابنته مايا (3 سنوات) التي ولدت عشيّة هجوم آخر دبّره أبوها على القصر الصيفيّ للرئيس السابق سليمان فرنجيّة، في بلدة إهدن، راح ضحيّته ابنه الأكبر طوني (36 سنة) وزوجته فيرا (32 سنة) وابنتهما جيهان (3 سنوات)» ص13، و«في يوم السبت 6 كانون الأول 1975، وبعد فترة من الهدوء النسبيّ، أطلقت ميليشيا الكتائب عناصرها… فقاموا بمهاجمة المكاتب الحكوميّة وخاصّة شركة الكهرباء حيث اغتالوا أكثر من مئتي مسلم، كما هاجموا المرفأ وأطلقوا النار على عمّاله، ثمّ ألقوا بجثثهم في البحر» ص112.
إنّ وثائقيّة صنع الله هي ضدّ الصفح كما يشير دريدا، لكنّه سينقلنا بخفّة إلى الوجه الإنسانيّ للمرحلة عبر الإطار السرديّ التخيليّ لعلاقات الرجال بالنساء، ولا سيّما علاقة الراوي بـ(لميا الصبّاغ) زوجة الناشر الشهير الذي ينتظر منه نشر مخطوطه. يقدّم هنا مفهومًا خاصًّا لجغرافيا الجسد تصنعه العلاقة اليوميّة مع الموت، واحتماليّة الفناء في كلّ لحظة، بهذا يتجاوز التابو الذي تعيشه الثقافة العربيّة العرفيّة؛ إذ بين انفجار متوقّع للغم كامن في المصعد أو عبوة ناسفة في سيّارة، لا وقت للمقدّمات والأخذ والردّ، فكلّ على دراية بهدفه المباشر، ومتعته الآنيّة، وإنّ عروض العلاقة الجسديّة مع الآخر، لا تستدعي تبعات لا في القبول ولا في الرفض، فذلك هو منطق الحياة الذي تعلّمه الحرب الأهليّة: يوتوبيا داخل ديستوبيا أو العكس.
التقنية الثانية التي استعملها صنع الله ليحاول أن يفكّك «كبكوبة» الصوف المعقّدة هي الكولاج الذي تصنع منه المخرجة أنطوانيت فاخوري، التي سيعرّفه إليها وديع مسيحة، فِلْمًا تسجيليًّا عن الحرب ومخيمات الفلسطينيين، حيث سيكتب الراوي سيناريو مناسبًا للصور (الوثيقة) التي جمّعتها المؤلفة/ المخرجة، من عناوين الصحف اللبنانيّة، والإسرائيليّة، والعربيّة، والعالميّة، فضلًا عن كليبات لزعماء الطوائف، وللزعامات الرسميّة والشعبيّة العربيّة من حكّام وعسكريّين، ولمسؤولين أجانب، إلى جانب كليبات للمخيمات، والشوارع، والحواجز، والأبنية في بيروت، وفي العالم كله حين تتعلق بالحرب: الرئيس حافظ الأسد يصعد سلّم الطائرة، والشيخ أمين الجميل يهزّ يده، والعماد عون يحدّق في الأفق، والسيارات تتفجّر… ثمّ تحضر شهادات الناجين من تلّ الزعتر وصبرا وشاتيلا، ولا سيما النساء… ليس علينا مع هذا الكمّ من الوثائق سوى أن نحتجّ على كوننا نعيش المأساة ذاتها مرّتين!
لعلّ ذلك هو المعنى الذي ينتجه النصّ معتمدًا على شعريّة الحياة اليوميّة التي تقول بها التاريخانيّة الجديدة؛ حيث تكمن قوّة النصّ في الشكل، أو في الكاميرا، أو في تجميع الوثائق التي تصنع سوداويّة لا فكاك منها، وتُقرأ الخطابات التاريخية في ضوء مقاربة جديدة، ننتقد من خلالها المؤسسات السياسية القديمة التي لا تزال مهيمنة، والتي لم تفلح سيرورة التاريخ في تقويض المقولات المركزية السائدة حولها، وهذا من منظار سياقيّ.
تنشئ هاتان البنيتان المتضافرتان التخيليّة والوثائقيّة، في قراءة بنيويّة، محاولةً قطيعة مع الماضي، بنية جديدة لـ(بيروت)، تبدو فيها معزولة عن العالم ومكتفية بذاتها، منتجة للمعنى، ومحمّلة به، ومحيّدة عن التاريخ الكلاسيكيّ ومتجاوزة له، هي «بنية بارزة… كمثل معمار مدينة غير آهلة، أو عصفت بها عاصفة، واختزلتها كارثة طبيعيّة أو فنيّة إلى هيكلها وحده. مدينة لم تعد مأهولة ولا مهجورة ببساطة، بل هي بالأحرى مسكونة بالمعنى وبالثقافة. هذه المسكونية التي تمنعها هنا من العودة إلى الطبيعة» ( دريدا/ الكتابة والاختلاف ص136،) وهنا تصير الواقعة الأدبيّة إبداعًا وخلقًا، لا تعبيرًا. تبقى في كلتا القراءتين، فضلًا عن الأحداث الوقائعيّة، فاعليّة العبارة التي كانت تطلقها الإذاعات اللبنانيّة آنذاك، والتي ما زال صداها يتردّد في الذاكرة والمعنى: «كلّ الطرق غير آمنة».


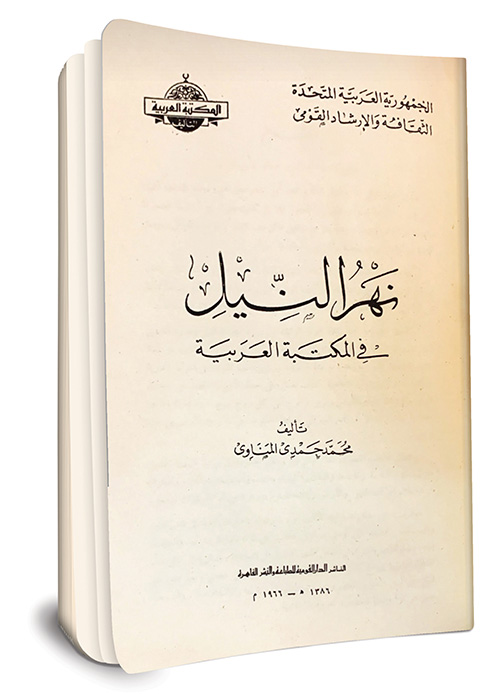 هذه الأوضاع حاضرة في الكتاب، سواء من خلال المعاني التي تحملها إعادة الطبع، ثم إعادة قراءة الكتاب في ضوء أوضاع مغايرة. أو من خلال إشارة مُقدم الكتاب إلى «فترة حساسة» يمر بها النيل في تاريخه، وتاريخ مصر معًا، «فترة تحاول فيها بعض الدول تهديد الأمن القومي المصري من بوابة نهر النيل، ومن نافذة الأطماع التي تريد الاستئثار بمياه النهر الخالد، وتعريض دولتي المصب (مصر والسودان) لأخطار الجفاف والجدب». وبخلاف هذه الإشارة المقتضبة والغامضة إلى سياق الصراع الحالي، فإننا لا نعثر، في مقدمة الكتاب، على تفاصيل تربطه بلحظته الحاضرة المصيرية. كما أننا لا نعثر، في متنه، أيضًا، على صراعات شبيهة في الماضي نقرأ في ضوئها مجريات هذه اللحظة. إذن فما موضوع هذا الكتاب الذي تُعاد قراءته في سياق أحداثٍ لم تجر له في حسبان، ولم تكن ضمن أولوياته وموضوعاته التي تناولها؟ وكيف يمكن أن نقرأه في ظل هذه الأحداث الآن؟
هذه الأوضاع حاضرة في الكتاب، سواء من خلال المعاني التي تحملها إعادة الطبع، ثم إعادة قراءة الكتاب في ضوء أوضاع مغايرة. أو من خلال إشارة مُقدم الكتاب إلى «فترة حساسة» يمر بها النيل في تاريخه، وتاريخ مصر معًا، «فترة تحاول فيها بعض الدول تهديد الأمن القومي المصري من بوابة نهر النيل، ومن نافذة الأطماع التي تريد الاستئثار بمياه النهر الخالد، وتعريض دولتي المصب (مصر والسودان) لأخطار الجفاف والجدب». وبخلاف هذه الإشارة المقتضبة والغامضة إلى سياق الصراع الحالي، فإننا لا نعثر، في مقدمة الكتاب، على تفاصيل تربطه بلحظته الحاضرة المصيرية. كما أننا لا نعثر، في متنه، أيضًا، على صراعات شبيهة في الماضي نقرأ في ضوئها مجريات هذه اللحظة. إذن فما موضوع هذا الكتاب الذي تُعاد قراءته في سياق أحداثٍ لم تجر له في حسبان، ولم تكن ضمن أولوياته وموضوعاته التي تناولها؟ وكيف يمكن أن نقرأه في ظل هذه الأحداث الآن؟

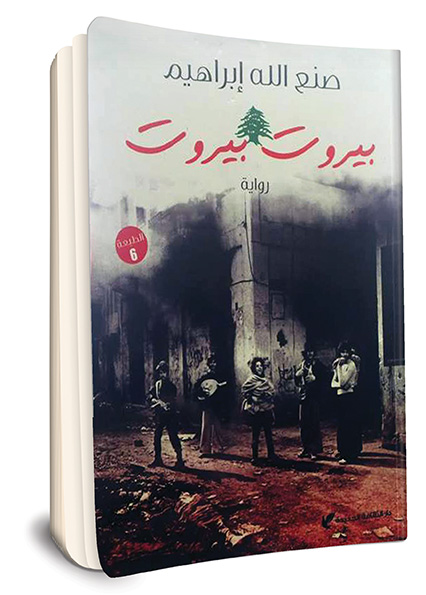 المانفيستو الأدبي لبيروت
المانفيستو الأدبي لبيروت