
محمد أدهم السيد - كاتب سوري | مايو 1, 2025 | عمارة
يعتقد كثير من الخبراء أن المعايير التقليدية التي حكمت مفهوم وتصميم المشروعات المعمارية أصبحت اليوم موضع جدل، وتحتاج إلى نظرة شمولية جديدة تتماشى مع الواقع الحالي. في حقبة ما بعد جائحة كورونا، أصبح لدينا تصور مختلف حول البيئة المبنية والطريقة التي نتفاعل معها، في الوقت الذي بدأ فيه كثير من الناس اليوم يتساءلون حول طبيعة ووظيفة المنازل التي نعيش فيها وأماكن العمل التي اعتدناها لسنين طويلة. بل إننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الناس يفكرون مليًّا في أفضلية الاختيار بين الحياة الحضرية أو الريفية، وبمعنى آخر المنازل الواسعة في الأرياف مقابل الشقق المتواضعة في المدن المزدحمة.
ولا نبالغ بالقول: إن الشمولية أصبحت اليوم في عالمنا المترابط أمرًا مفروغًا منه، كما يؤكد المعماري فرّخ درخشاني، مدير جائزة الآغا خان للعمارة ذائعة الصيت، في مقدمة كتاب «العمارة الشمولية»، الذي نشرته مؤخرًا دار النشر الألمانية «أركي تانغل بَبْليشرز»، وحررته باللغة الإنجليزية سارة م. وايتنج، إلى جانب مشاركة عدد من المعماريين والباحثين المرموقين في العالم. يقول درخشاني في مقدمة الكتاب: «ربما للمرة الأولى في تاريخ البشرية، يتشارك الناس اليوم في جميع أركان العالم الأربعة الآمال والمخاوف نفسها من أجل مستقبل أفضل». ويضيف قائلًا: «لم تعد المشاكل العالمية مقصورة على سياق جغرافي محدد، بل يجب أن ننظر إلى العالم من منظور جديد».
 في هذا المشهد المتغير والصعب، يسعى المهندسون المعماريون وصناع القرار والبناؤون والمستخدمون إلى الاستفادة من المشروعات المعمارية النموذجية التي تعالج القضايا الحالية وتعزز جودة الحياة، والتي يمكن أن تكون أمثلة يحتذى بها في مناطق أخرى من العالم. يشدد كتاب «العمارة الشمولية» على هذه الحاجة من خلال تسليط الضوء على عشرين مشروعًا رائدًا اخْتِيرَت ضمن القائمة القصيرة للمشروعات المرشحة لجائزة الآغا خان للعمارة، ومن ضمنها المشروعات الستة التي فازت بالمحصلة بالجائزة، في دورتها الأخيرة لعام 2022م. ومن المهم الإشارة هنا إلى أننا لا نتحدث عن «العمارة الشمولية» التي تعني نوعًا من العمارة التي أنشأتها الدول الشمولية، بل نتحدث عن المشروعات المعمارية التي تتخذ من مفهوم الشمولية أساسًا لها في عملية التصميم والتنفيذ.
في هذا المشهد المتغير والصعب، يسعى المهندسون المعماريون وصناع القرار والبناؤون والمستخدمون إلى الاستفادة من المشروعات المعمارية النموذجية التي تعالج القضايا الحالية وتعزز جودة الحياة، والتي يمكن أن تكون أمثلة يحتذى بها في مناطق أخرى من العالم. يشدد كتاب «العمارة الشمولية» على هذه الحاجة من خلال تسليط الضوء على عشرين مشروعًا رائدًا اخْتِيرَت ضمن القائمة القصيرة للمشروعات المرشحة لجائزة الآغا خان للعمارة، ومن ضمنها المشروعات الستة التي فازت بالمحصلة بالجائزة، في دورتها الأخيرة لعام 2022م. ومن المهم الإشارة هنا إلى أننا لا نتحدث عن «العمارة الشمولية» التي تعني نوعًا من العمارة التي أنشأتها الدول الشمولية، بل نتحدث عن المشروعات المعمارية التي تتخذ من مفهوم الشمولية أساسًا لها في عملية التصميم والتنفيذ.
توضح المشروعات المعمارية المدرجة في الكتاب، الذي يقع في 327 صفحة من الحجم المتوسط، كيف يمكن للعمارة أن تؤدي دورًا حيويًّا في تعزيز التنوع والتسامح، وتأكيد الهوية الثقافية والجذور، والحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، وإعادة استخدام الأماكن والمرافق العامة، والاستجابة للاحتياجات والتحديات المتزايدة الهائلة داخل المجتمعات وخارجها، وإعادة تأهيل العمارة الحضرية، والترميم كوسيلة لإحياء التقاليد والتكيف معها، والاندماج في المجتمعات التي يعيش فيها المسلمون، كوسيلة لتوحيد بيئات منفصلة، حضرية أو ريفية، وأخيرًا البحث عن التميز في التصميم ضمن إمكانيات متواضعة أو ميزانيات مالية منخفضة.
كما يركز الكتاب أيضًا على العديد من الموضوعات المهمة الأخرى، بما في ذلك دور العولمة في تصميم العمارة اليوم، ونظرة عامة على الممارسات والعمليات الشمولية، وإعادة تصور الواقع، والعمارة المحلية كمشروع إنساني راديكالي، والحوار في العمارة، وأخيرًا إعادة النظر في مفهوم الحداثة.
الحاجة إلى نقلة نوعية
يذهب كتاب «العمارة الشمولية» إلى أبعد من مفهوم العمارة ويطرح بداية فكرة جريئة مفادها أنه بعد أكثر من عقدين من الترابط العالمي غير المحدود، الذي صاحبته ثورة تقنية غير مسبوقة بداية من وسائل التواصل التقليدية والهاتف المحمول، ومرورًا بوسائل التواصل الاجتماعي التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، وانتهاء ببرامج التقنية التي سُخِّرَت لخدمة المشروعات المعمارية الصغيرة منها والكبيرة، أصبح من الضروري اليوم إعادة النظر في هذا الترابط ووضعه ضمن سياقات واضحة وسليمة.
بالنسبة لكثيرين، يحوّل هذا الترابط العالمي التعاريف والحدود الوطنية إلى فكرة قديمة، ويحل محلها مواطنون عالميون يشكلون بشكل جماعي «أهدافًا اجتماعية يُعَاد تحديدها باستمرار من خلال الحوار الذي ينشأ عن طريق استخدام التقنية الحديثة للحصول على مدخلات منتظمة من طيف كامل من المواطنين». هذا الأمر كما تقول سارة وايتنج في مستهل الكتاب لم يأتِ من دون ثمن «ولم يكن تدفق المعلومات مجانيًّا أو من دون عواقب».
تشير سارة إلى تشابه العمارة إلى حد كبير على الرغم من اختلاف السياقات والبيئات الخاصة بها، في ظل استخدام التقنية الحديثة في التصميم. وتقول: «أدى التوسع العالمي السريع والمتطرف في العقود القليلة الماضية إلى إنشاء مبانٍ ومواقع مناظر طبيعية ومدن بأكملها لا تعترف بموقعها من حيث الشكل أو المادة، ولا تلقي بالًا إلى الاعتبارات المناخية والثقافية»، وتضيف قائلة: «من الواضح أن التفاؤل الجامح فيما يتعلق بإمكانيات الترابط العالمي في بداية القرن الحادي والعشرين جاء في الواقع مصحوبًا بقيود مرتبطة به. وبعد ربع قرن تقريبًا، حان الوقت بالنسبة لنا لتحديد كيف يمكننا استعادة عالمنا.»

من أجل استعادة عالمنا واحتضان الشمولية حقًّا، نحتاج إلى إعادة تقييم نهجنا في التصميم. قد يكون من المهم الاستفادة من التقانة والبرمجيات الحديثة التي تسهل من عملية التصميم المعماري، ولكن يجب ألّا يكون ذلك، في أي حال من الأحوال، على حساب الإبداع أو الاعتماد على البيئة المحلية. كما يجب ألا تركز العمارة الشمولية على الترابط العالمي فحسب، بل يجب أن تأخذ في الحسبان أيضًا ديناميكيات القوة الكامنة والتفاوتات الاقتصادية التي تشكل بيئتنا المبنية. لتحقيق هذه الغاية يجب على المهندسين المعماريين والمصممين إعطاء الأولوية للحساسية الثقافية والاستدامة البيئية والخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لكل موقع.
من الضروري الاهتمام بتنوع الهويات والتراث داخل المجتمعات، والاعتراف بأن الممارسات الحديثة تؤدي دورًا حيويًّا جنبًا إلى جنب مع الثقافات التقليدية. كما يجب على العمارة الشمولية أن تحتفي بالتنوع، من حيث الجماليات والوظائف؛ إذ يقوض توحيد التصميم في جميع أنحاء العالم الطابع الفريد لكل موقع ويقلل من ثراء الاختلافات الثقافية والفنية. وبعبارة أخرى يجب أن تكون الأماكن المرغوبة خاصة بما يكفي لتكون ممتعة، وعامة بما يكفي لتكون في متناول الجميع. يمكن أن يخلق هذا التوازن بين الخصوصية والعالمية مساحات شمولية جذابة وأصلية.
يجب على المهندسين المعماريين والمصممين أيضًا مراعاة تأثير مشروعاتهم في البيئة؛ إذ يمكن أن تساهم ممارسات التصميم المستديمة، مثل دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين الإضاءة الطبيعية والتهوية، واستخدام المواد من مصادر محلية، في الاستدامة الشاملة للمشروع. إضافة إلى ذلك، تتطلب العمارة الشمولية نهجًا تعاونيًّا متعدد التخصصات. يجب على المهندسين المعماريين والمخططين الحضريين ومهندسي المناظر الطبيعية وواضعي السياسات وأعضاء المجتمع المحلي العمل معًا لإنشاء بيئات مبنية عادلة ومستديمة ويمكن الوصول إليها بسهولة.
أخيرًا يجب أن تولد العمارة الشمولية حوارًا مستمرًّا، وأن تتطور باستمرار وتتكيف مع التغيرات الاجتماعية والثقافية والبيئية، وهذا الأمر يتطلب فهمًا عميقًا للسياق المحلي، وتقديرًا للتنوع، والالتزام بالعدالة الاجتماعية. من خلال تبني مبادئ الشمولية، يمكن للمهندسين المعماريين والمصممين إنشاء مساحات تحتفي بالهويات الخاصة بالمجتمعات، وتعزز التماسك الاجتماعي، وتحسن نوعية الحياة للأفراد جميعهم ضمن المجتمع.
أمثلة ملهمة من العالم العربي
ينطلق كتاب «العمارة الشمولية» من المفاهيم الأساسية السابقة في اختيار المشروعات العشرين التي يستعرضها عبر صفحاته. كما تعكس هذه المشروعات النموذجية -التي اخْتِيرَت من بين مئات المشروعات التي رُشِّحَت لجائزة الآغا خان للعمارة- عملية اختيار طويلة وشاملة ومعقدة. وتُراوِح هذه الأمثلة الملهمة بين المشروعات الحضرية واسعة النطاق والمخططات الريفية، وهو ما يسلط الضوء على الأساليب المتنوعة للعمارة الشمولية.
اللافت في الكتاب أن قائمة المشروعات المدرجة تضمنت مشروعات متميزة من سبع دول عربية هي البحرين، لبنان، الكويت، المغرب، فلسطين، تونس والإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى مشروعات أخرى من بنغلادش، الرأس الأخضر، الهند، إندونيسيا، إيران، النيجر، السنغال، سريلانكا، وتركيا. ونسلط الضوء في السطور التالية على المشروعات العربية السبعة المدرجة ضمن الكتاب.
البداية من مشروع «إعادة تأهيل مكتب بريد المنامة»، الذي نفذه أستوديو آن هولتروب في المنامة بالبحرين، حيث بُني مكتب البريد في عام 1937م، وأُعيد تأهيله مع مراعاة المحافظة على شكله الأصلي واستمراره في تقديم خدماته البريدية، فضلًا عن إضافة جناح جديد للمبنى الحالي. أما المشروع الثاني فهو «تجديد دار نيماير للضيافة» في طرابلس بلبنان، الذي نفذه «أستوديو الشرق للهندسة المعمارية». وهذا البناء من تصميم المعماري البرازيلي أوسكار نيماير، ولكن جرى التخلي عن البناء عندما اندلعت الحرب الأهلية في عام 1975م، قبل أن تُحَوَّل دار الضيافة اليوم إلى منصة تصميم ومنشأة لإنتاج وصناعة الأخشاب المحلية.

المشروع الثالث هو «برج الرياح في الوفرة» بمدينة الكويت، الذي نفذته «المجموعة المعمارية الدولية»، حيث يتألف المبنى من 13 طابقًا، وصُمِّم كبرج للرياح لإيجاد حل طبيعي لمشكلة المناخ الحار، إضافةً إلى تمتعه بفناء مركزي عمودي يوفر تهوية طبيعية لكل وحدة سكنية. بينما المشروع الرابع هو «تحسين وادي إيسي» في بلدة آيت منصور بالمغرب، الذي نفذته المهندسة المعمارية سليمة الناجي، حيث حُسِّنَت بساتين النخيل وخزانات المياه، إضافةً إلى تحسين وترقية الممرات والمرافق المخصصة للسياح في المرحلة الأولى ضمن مشروع أكبر يستهدف منطقة الوادي.
المشروع الخامس هو بناء «محكمة طولكرم» في مدينة طولكرم بفلسطين، الذي نفذه مكتب «إيو أناستاس، ويضم مبنيين؛ الأول مخصص للمرافق الإدارية، والآخر يحتوي على 10 قاعات محكمة. يرتبط المبنى الرئيس مباشرة بالفضاء العام الأمامي، بينما يرسخ المبنى السياق الحضري المباشر للمكان، ويقدم لمواطني مدينة طولكرم مساحة للتجمع.

المشروع السادس هو «حديقة إفريقيا» في مدينة جرجيس بتونس، التي أسسها الفنان التشكيلي الجزائري رشيد القريشي وهي عبارة عن مقبرة لضحايا الهجرة غير الشرعية الذين غرقوا في مياه البحر الأبيض المتوسط، حيث توفر هذه المقبرة ملاذًا أخيرًا ومكانًا كريمًا للراحة الأبدية لمئات الضحايا والجثث التي انْتُشِلَت من مياه البحر في أثناء رحلتهم للوصول إلى الشواطئ الشمالية. أما المشروع السابع والأخير فهو «إعادة تأهيل مبنى الطبق الطائر» في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، الذي نفذه أستوديو «سبيس كونتينوم» للتصميم المعماري، والذي تديره المهندسة المعمارية منى المصفي، حيث استمد مبنى الطبق الطائر تصميمه من مزيج من تأثيرات الهندسة الوحشية، ورُمِّم بالكامل كمساحة فنية مجتمعية، إضافةً إلى أنه يسهم في إنعاش الذاكرة الثقافية الجماعية في الشارقة.
من خلال المشروعات الرائدة المدرجة والموضوعات التي طُرِحَت، يخلص الكتاب إلى أنه في عالم ما بعد الجائحة، ستستمر أهمية العمارة الشمولية في النمو، وستتحول إلى أداة قوية لخلق مساحات تلبي الاحتياجات والتطلعات المتنوعة للأفراد والمجتمعات. ومن خلال اعتماد نهج يركز على الناس، ومعالجة التحديات المرحلية، واحتضان التنوع الثقافي، ومعالجة الاحتياجات الاجتماعية والبيئية، يمكن للمهندسين المعماريين تشكيل مستقبل أكثر شمولية واستدامة. وبينما نمضي قدمًا نحو الأمام، من الأهمية بمكان بالنسبة للمهندسين المعماريين والمعنيين بشؤون العمارة إعطاء الأولوية للشمولية، وتصميم الفضاء الذي يحتفي بإنسانيتنا المشتركة مع احترام اختلافاتنا الفردية، فمن خلال العمارة الشمولية فقط يمكننا إنشاء مساحات تنتمي حقًّا للجميع وتلبي احتياجات الجميع.


محمد أدهم السيد - كاتب سوري | نوفمبر 1, 2021 | عمارة
«يتجلى الاختلاف الرئيس في حياتنا اليوم، بالمقارنة مع حياة أجدادنا، ليس من خلال الوتيرة المتسارعة للتغيير ضمن المجتمع فحسب، بل وبمدى قبولنا به أيضًا. إذ يقبل معظمنا التغيير السريع في المجتمع، سواء كان ذلك نتيجة لانتقال الناس من المناطق الريفية إلى التجمعات الحضرية، أو الهجرة بين القارات، أو إدخال تقنيات جديدة، أو الأخطار البيئية والطبيعية، أو حتى التغيير الناتج عن الحروب والصراعات المؤسفة التي يتجاوز تأثيرها حدود الدولة الواحدة».
بهذه الكلمات يفتتح السيد فرّخ درخشاني، مدير جائزة الآغا خان للعمارة، الكتاب الذي صدر مؤخرًا عن دار النشر الألمانية أرك تانجل (ARCHI TANGLE) بعنوان «عمارة التعايش…بناء التعددية»، والذي قامت بتحريره المعمارية أزرا أكشاميا، إلى جانب عدد من المعماريين والخبراء الرائدين في مجال العمارة والفلسفة في العالم، من بينهم محمد الأسد، وناصر الرباط، وولفغانغ ويلش، وهيلين والاسيك، وأميلا بوتروفيش، وآمر حجي محمدوفيتش، وآخرون.
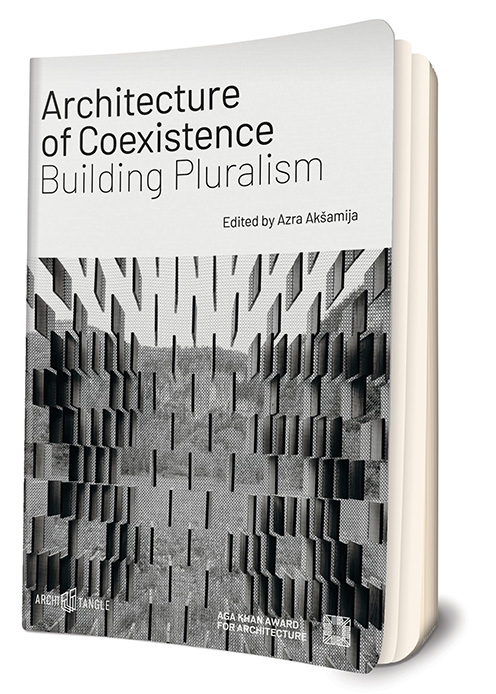 من خلال مجموعة من الآراء الشخصية والتجارب المتميزة التي تم اختيارها من مناطق مختلفة من العالم، يسلط الكتاب الضوء على دور العمارة في التصدي لعدد من القضايا الحساسة التي تتعلق بشكل أساس بموضوعات التعايش والتعددية، وكيفية تقبل الآخر، والتكيف مع التغيرات ضمن المجتمع، واحترام الاختلاف بين الثقافات والشعوب، والاحتفاء بهذا الاختلاف وتسخيره في خدمة المجتمع، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم، والتي تدفع إلى مزيد من موجات الهجرة والنزوح للأفراد والمجتمعات.
من خلال مجموعة من الآراء الشخصية والتجارب المتميزة التي تم اختيارها من مناطق مختلفة من العالم، يسلط الكتاب الضوء على دور العمارة في التصدي لعدد من القضايا الحساسة التي تتعلق بشكل أساس بموضوعات التعايش والتعددية، وكيفية تقبل الآخر، والتكيف مع التغيرات ضمن المجتمع، واحترام الاختلاف بين الثقافات والشعوب، والاحتفاء بهذا الاختلاف وتسخيره في خدمة المجتمع، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم، والتي تدفع إلى مزيد من موجات الهجرة والنزوح للأفراد والمجتمعات.
ويؤكد الكتاب على أن عملية التغيير ضمن المجتمعات لطالما انعكست بشكل واضح وملموس في البيئة المبنية والهندسة المعمارية التي تشكلها أيضًا، وخاصة في المدن والتجمعات الحضرية الكبيرة. ولكن، هذا التغيير كان ولايزال يصاحبه في الوقت نفسه مجموعة كبيرة من التحديات والصعوبات، كما يشير السيد فرّخ درخشاني، الذي يضيف قائلًا: «مع تعدد الثقافات والأعراق على نحو متزايد في المدن الكبيرة، بدأ ظهور تناقضات صارخة في التعليم والثروة والرفاهية. وبالتالي، فإن التحدي أصبح يكمن في تقدير التنوع والتوسط بين انقساماته».
ولفهم هذه المعادلة الصعبة ولتسليط الضوء على عدد من الأمثلة والنماذج العالمية المتميزة التي تبرز دور العمارة والهندسة المعمارية في دعم وتعزيز مفهوم التعايش والتعددية، يركز الكتاب في صفحاته بشكل خاص على ثلاثة محاور رئيسة، وهي: دور العمارة في الحفاظ على الهوية العرقية والدينية وخاصة في دول الاغتراب أو التجمعات الحضرية التي تتميز بتنوع سكانها وتعدد مشاربهم العرقية وانتماءاتهم الدينية؛ وقدرة العمارة على دعم الديمقراطيات وتسهيل دمج الأقليات في الفضاء العام؛ وأخيرًا دور العمارة في تحقيق التقارب بين الثقافات واستكشاف جمالياتها ودلالاتها الثقافية في عملية البناء.
بناء التعددية
ينظر الكتاب بدايةً إلى الماضي الأوربي الحديث، ويقدم أفكارًا ملفتة حول العمارة التي بناها المهاجرون المسلمون في المناطق التي تطورت تاريخيًّا من الناحية المعمارية من قبل السكان ذي الأغلبية غير المسلمة. يقدم المؤرخ المعماري محمد الأسد في الفصل الأول من الكتاب لمحة عامة عن الديناميكيات الاجتماعية المعقدة وراء هذه المباني، والتي غالبًا ما يتعين عليها إنجاز عدد من المهام الصعبة، مثل تمثيل الخلفيات العرقية المختلفة لمجتمعات الأقليات ضمن سياق ثقافي جديد، والتعبير عن تنوعها واختلافاتها، وفي الوقت نفسه، التوسط لتعزيز علاقة هذه المجتمعات مع المجتمع المحيط الذي يشكل الأغلبية.
بينما يتحدث الدكتور ناصر الرباط في مشاركة له عن عمارة المقابر والأضرحة في التاريخ والثقافة الإسلامية، وكيف ساهمت في التعبير عن الهوية الإسلامية وتعزيزها وإغناء العمارة المحلية مستشهدًا بمجموعة من الأمثلة من حقب زمنية ومناطق مختلفة في العالم.
وتركز المعمارية أزرا أكشاميا على هذا الموضوع أيضًا، من خلال سرد تجربتها الشخصية مع أحد المشروعات التي يقدمها الكتاب كنموذج غير تقليدي لدور المقابر الإسلامية في تعزيز مفهوم التعددية في العالم الغربي، فتقول: «لن أنسى أبدًا يوم افتتاح مقبرة ألتاش الإسلامية في فورارلبيرغ (النمسا). في صبيحة ذلك اليوم، تم تقديم جولة إرشادية للجمهور. كنا نتوقع حضور حوالي خمسة عشر أو عشرين شخصًا على الأكثر.. ولكن العدد تجاوز توقعاتنا بكثير، حيث جاء المئات من الزوار من الأماكن القريبة والبعيدة، والمثير للدهشة أن معظم الضيوف كانوا من مجتمع الغالبية غير المسلم».
وتضيف أزرا أكشاميا أنه بينما كانت المناسبة تعني بالنسبة للجاليات الإسلامية الاحتفال بافتتاح مساحة مهمة تجمع بين المجتمعات المسلمة المختلفة التي تعيش في هذه المنطقة، إلا أنها بالنسبة للعديد من السكان المحليين وأعضاء المجتمع ذي الأغلبية غير المسلمة، كانت فرصة جيدة للتعرف على «الآخر».
يسهب الكتاب في الحديث عن هذه المقبرة الإسلامية التي تقع في منطقة فورارلبيرغ، وهي مقاطعة تقع في أقصى الغرب من النمسا وتشتهر بالصناعة، ويشكل المسلمون نسبة تزيد على 8% من تعداد السكان فيها. ويشير الكتاب إلى أنه على رغم أن مجتمع المسلمين في النمسا يملك تاريخًا ضاربًا في القدم في البلاد، إلا أنهم لم يتمكنوا من دفن موتاهم وفقًا للشعائر الإسلامية حتى حقبة قريبة من الزمن. قبل ذلك، اعتاد المسلمون، وخاصة من الجيلين الأول والثاني، على إرسال جثامين موتاهم إلى بلدانهم الأصلية، أو دفنهم في مساحة إضافية ضمن إحدى المقابر الموجودة أصلًا من دون تطبيق الشعائر الإسلامية في عملية الدفن. ولكن الحال تغير مع بناء هذه المقبرة الإسلامية الخاصة.

ويبدو الإلهام في هذا الموقع من خلال تصميمه الحدائقي، وأقسامه الرئيسة وجدرانه الإسمنتية الوردية التي تفضي إلى خمس مساحات متتالية للدفن تم توجيهها نحو الكعبة المشرفة. ويشكل التصميم البسيط والمتقن للمقبرة، وتناغمها الرائع مع الطبيعة المحيطة، مكانًا هادئا مناسبًا للتأمل الروحي، وإقامة مراسم الدفن، والحداد؛ الأمر الذي أهَّلها في عام 2013م للفوز بجائزة الأغا خان للعمارة، وهي واحدة من أهم وأقدم الجوائز المرموقة في مجال العمارة في العالم.
ويخلص الكتاب إلى أن الاهتمام الكبير بالمقبرة الإسلامية في ألتاش أوضح دورها المهم كجسر يجمع بين الأقلية المسلمة والمجتمع المضيف ذي الأغلبية غير المسلمة، كما مثلت المقبرة تحولًا مهمًّا في مفهوم الانتماء بالنسبة للجيلين الثاني والثالث من المسلمين في النمسا، وبالتأكيد محطة أخيرة للمهاجرين العرب والمسلمين في هذه المنطقة.
الحفاظ على الهوية العرقية والدينية
يتحدث الكتاب في الفصل الثاني عن وجود الإسلام منذ أكثر من خمسة قرون في أوربا، وكيف تم التعبير عنه ضمن المشهد المعماري في البوسنة والهرسك على وجه الخصوص. يؤكد الكتاب على عراقة وقدم وجود الإسلام في أوربا على رغم كل الادعاءات بعكس ذلك، ويقول ضمن هذا السياق: «تتصدى المساجد والمدارس الدينية والأحياء السكنية والمكتبات والمقابر، التي شيدت العديد منها خلال الإمبراطورية النمساوية-المجرية، للادعاءات التي تسوقها بعض المبادرات الشوفينية الأوربية، مثل «مدن ضد الأسلمة»(١)، التي تعتبر الحضارة الإسلامية غريبة عن أوربا. توفر هذه الأمثلة القديمة للعمارة الإسلامية في البوسنة، جنبًا إلى جنب مع تلك الموجودة في إسبانيا وتركيا، أدلة مادية لدحض مثل هذه الادعاءات الكاذبة».
ويركز الكتاب أيضًا على سياسات الذاكرة والحنين إلى العودة في دول البلقان، ويبحث في دور العمارة كوسيلة لخلق هوية عرقية ودينية أو قومية من خلال ترسيخ الذاكرة الثقافية في منطقة محددة. ضمن هذا الإطار، يسلط الكتاب الضوء بشكل خاص على المسجد الأبيض في فيسوكو، في البوسنة والهرسك، الذي أعيد بناؤه في عام 1980م، ويعرف أيضًا باسم مسجد شرف الدين الأبيض. يستعرض الكتاب أهمية هذا المسجد وتاريخه العريق ودوره في تعزيز الوجود الإسلامي في المنطقة من خلال مجموعة من الصور والمقالات والمقابلات التي أجراها الفنان فيليبور بوجوفيتش مع عدد من المهندسين المعماريين والأئمة والأشخاص الذين يترددون بانتظام إلى المسجد أو يعيشون على مقربة منه.
صمَّم المسجدَ المهندسُ المعماري زلاتكو أوغلجين، ويعكس تصميمه المعماري الحديث رؤية متجددة وعصرية للمسجد الإسلامي القديم الذي بني في عام 1477م، ولايزال يحتفى به كواحد من أفضل الأمثلة عن العمارة الدينية في أوربا. يعود مشروع بناء المسجد الأبيض في العصر الحديث إلى الحقبة التي أصبح فيها النظام الشيوعي في يوغسلافيا أكثر تقبلًا لفكرة التعبير عن الهويات المميزة لمواطنيه الذين ينحدرون من عرقيات مختلفة، وبالتالي السماح لهم ببناء الصروح الدينية الخاصة بهم مجددًا.

وفي الوقت الذي تم فيه بناء المسجد الأبيض، كانت يوغوسلافيا عضوًا قياديًّا في حركة عدم الانحياز، واستخدمت الأقلية المسلمة كوسيلة لمغازلة الدول الإسلامية من أجل تعزيز تحالفاتها السياسية. ومع ذلك، على الصعيد المحلي، استمرت في ممارسة الضغط السياسي على المجتمعات المسلمة وقمع هويتها الدينية. ولكن، في عام 1968م، تم الاعتراف أخيرًا بمسلمي البوسنة كجنسية مكونة ليوغوسلافيا، وكان بناء المسجد الأبيض في فيسوكو تأكيدًا على هذا التحول السياسي المهم.
ويضيف الكتاب أنه مع تحول يوغسلافيا من النظام الاشتراكي إلى النظام الديمقراطي متعدد الأحزاب، اندلع صراع عنيف في البلاد وازدادت حدته في أوائل التسعينيات ليمزق النسيج الاجتماعي الذي كان يجمع لسنوات طويلة بين أهلها تحت شعار «الأخوة والوحدة». ضمن هذا الإطار، تستكشف مقالات هيلين والاسيك وآمر حجي محمدوفيتش العلاقة بين العمارة الدينية، المساجد على وجه الخصوص، ومفهوم التعايش، وكيف تغير معناها عبر التاريخ الحديث. كما تبحث هيلين والاسيك في أسباب استهداف التراث الثقافي والعمارة الدينية في حرب التسعينيات في البوسنة والهرسك، مؤكدة على أن تدميرها المنهجي قد استخدم أيضًا كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
ولكن، على رغم أن المجموعات العرقية المتنوعة في البوسنة والهرسك لاتزال تعيش اليوم، بعد أكثر من عشرين عامًا على الحرب، حالة من الغربة المتبادلة التي تغذيها القومية والتعصب الديني، إلا أن هذا الأمر لا ينفي قرونًا من التاريخ والعيش المشترك والتعايش السلمي فيما بينها. وهو ما تؤكد عليه أزرا أكشاميا مستشهدة بالعمارة الدينية في المنطقة، حيث تقول: «تمثل المساجد والكنائس والمعابد وشواهد القبور التي وقفت جنبًا إلى جنب لعدة قرون دليلًا على التعايش في المنطقة، ويوضح عددها وحده أن التعايش بين المجموعات العرقية المختلفة في المنطقة لم يكن ممكنًا فحسب، بل كان سائدًا أيضًا».
العمارة في وجه الكراهية
يستكشف الفصل الثالث من الكتاب قدرة العمارة على دعم الديمقراطية وتسهيل دمج الأقليات في الفضاء العام ضمن دول المغترب، ويبحث على وجه الخصوص في حالة الكراهية المتزايدة والعداء البغيض والتحيز الثقافي تجاه المهاجرين والمسلمين في الدول الإسكندنافية، من خلال التركيز على متنزه سوبركيلين الحضري في مدينة كوبنهاغن في الدنمارك. يبلغ طول هذا المتنزه كيلومترًا واحدًا ويقع في منطقة «نوريبرو» التي تتميز بتنوعها الاجتماعي والثقافي، حيث يتحدر سكانها من ثقافات وأصول مختلفة، ولكنها تشهد في الوقت نفسه العديد من التحديات الاجتماعية والثقافية.
صُمِّمَ المتنزه بالتعاون مع المجتمع المحلي الذي يشكل فيه المسلمون الأغلبية، ويستقي أفكاره التاريخية من الثقافات الخاصة والمتنوعة للسكان ويترجمها ضمن سياق حضري معاصر، كما يلقي الضوء على الأبعاد الإيجابية للتعددية الثقافية ويدعو الناس صغارًا وكبارًا للعب والمشاركة والتعايش مع الآخر. وتبدو خطوط العرق والدين والثقافة واضحة من خلال مجموعة كبيرة من الأثاث والعناصر التي تدخل في تصميم هذا المتنزه وتعزز الشعور بالانتماء إلى الوطن الأم، ولكن في الوقت نفسه بالاندماج والتعايش السلمي مع السكان والثقافات الأخرى في المنطقة.
ففي زاوية من زوايا المتنزه نجد مقعدًا جميلًا من بغداد، وفي بقعة أخرى نافورة على شكل نجمة من المغرب، ومربطًا للحبال من غانا، وتمثالًا ضخمًا منحوتًا لثور من إسبانيا، وتربة فلسطينية، وطاولات شطرنج من صوفيا، وأطواق كرة سلة من مقاديشو، وهذه أمثلة بسيطة من بين 108 من عناصر المتنزه التي أُحضرِت من 62 بلدًا أصليًّا للسكان المحليين. ولا شك أن هذه المجموعة الفريدة من العناصر تشكل مجتمعة معرضًا عالميًّا فريدًا ومفتوحًا للعموم على مدار العام لأفضل الثقافات والتصاميم من جميع أنحاء العالم، وترمز في الوقت نفسه لملكية السكان للمتنزه.
يبحث الكتاب في نظرة المجتمع المحلي للأشكال والتصاميم الخاصة بالحديقة، ويتضمن سلسلة من المقابلات مع السكان المحليين أجرتها عالمة الأنثروبولوجيا الدنماركية تينا جودرون جنسن، التي تناقش أيضًا في مقال آخر آليات الإقصاء والاندماج في الدنمارك من خلال الأماكن العامة ومشروعات الإسكان. في حين تحلل المؤرخة المعمارية جنيفر ماك إدراج المهاجرين كعنصر معماري متكامل في عدد من الأماكن والمساحات العامة الجديدة في الدول الإسكندنافية، مثل متنزه سوبركيلين، في ضوء تنامي مشاعر الكراهية نحو الأجانب، خاصة بعد أزمة اللاجئين السوريين الأخيرة في أوربا.
ويخلص الكتاب إلى أنه على الرغم من المبادرات والمشاعر القومية القوية والمتزايدة في الدنمارك وعدد من الدول الإسكندنافية الأخرى، والتي ترمي إلى خلق مجتمع ثقافي متجانس وموجّه من خلال سياسات الهجرة التقييدية التي تحد من التنوع في البلاد، إلا أنه في الوقت نفسه يتم تمكين أشكال التعايش المشترك بين الأعراق والأجناس المختلفة من خلال إطلاق مشروعات معمارية مثيرة تسمح بإجراء لقاءات غير رسمية وتعزيز الحوار بين الأفراد والمجموعات من خلفيات عرقية واجتماعية ودينية مختلفة، كما هو الحال في متنزه سوبركيلين.
هامش:
(١) مدن ضد الأسلمة (CAI): هي مبادرة معادية للمسلمين أطلقها فيليب ديوينتر من حزب فلامس بيلانج في مؤتمر في مدينة أنتويرب في 17 يناير 2008م. وتضم المبادرة ممثلين من النمسا والدنمارك وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وإنجلترا، الذين وقعوا ميثاقًا ضد الأسلمة المتزايدة في المدن الأوربية.

محمد أدهم السيد - كاتب سوري | نوفمبر 1, 2020 | عمارة

إيمانويل موريو
عندما وصلت «إيمانويل موريو» الطالبة الفرنسية في كلية الهندسة المعمارية إلى طوكيو، في رحلة قصيرة لمدة أسبوع في عام 1995م لإشباع رغبتها في الاطلاع من قرب إلى الأدب والثقافة اليابانية المعاصرة، فاجأتها هذه المدينة بلوحة فنية مذهلة وغير متوقعة من الألوان التي كانت تميز شوارع وفضاءات العاصمة اليابانية الشهيرة، وولدت في نفسها شغفًا عارمًا بسحر الألوان.
ربما تساءلت الشابة الصغيرة ذات الأربعة والعشرين ربيعًا في هذه اللحظة بالذات: كيف يمكن لهذه الألوان أن تولد في النفس شعورًا أكثر عمقًا وتماسكًا، وكيف يمكن أن تلعب دورًا أكثر حضورًا وأهمية في حياتنا، إضافة إلى دورها الجمالي بطبيعة الحال؟ هذا السؤال الافتراضي، وأسئلة أخرى كثيرة بدأت تتزاحم في مخيلتها، ربما كانت السبب الذي قادها للتعلق بمدينة السحر والألوان ودفعها للاستقرار على نحو دائم في مدينة طوكيو.
لم تستطع «إيمانويل موريو» مقاومة هذا الشعور العارم بالدهشة والانبهار الذي تولد في مخيلتها كما تتحدث في كلمة لها واصفة لحظتها الاستثنائية بالقول: «استحوذ على مشاعري وانتباهي عدد كبير من لافتات المتاجر، والكابلات الكهربائية المتطايرة في الشوارع، وشظايا السماء الزرقاء الداكنة التي كانت تطل بين كتل المباني المختلفة الأحجام والارتفاع. كان تدفق الألوان المذهل الموجود في كل شبر من الشارع هو الذي بنى هذا المزيج الرائع من العمق والكثافة في المكان، وحول شوارع وفضاءات مدينة طوكيو إلى مجموعة من الطبقات ثلاثية الأبعاد. شعرت بالكثير من الأحاسيس عندما رأيت كل هذه الألوان، وفي تلك اللحظة خاصة قررت الانتقال للاستقرار في هذه المدينة».
في الواقع، ما إن حصلت إيمانويل موريو على إجازتها الجامعية في الهندسة المعمارية من فرنسا حتى انتقلت في عام 1996م إلى طوكيو، لتبدأ مسيرتها الفنية والعملية في رحلة فريدة وممتعة مع عالم الألوان. في البداية كان عليها أن تتعلم اللغة اليابانية والحصول على مؤهلات معترف بها في اليابان، وهو ما يعني أن تبدأ الدراسة مجددًا، تقريبًا من مرحلة الصفر. وبعد سنوات من الدراسة والبحث المستمريْنِ، تمكنت الشابة الموهوبة من تحقيق حلمها، وأسست مكتبها المعماري الخاص في عام 2003م، وأطلقت عليه اسم «إيمانويل موريو للعمارة + التصميم».
من هذا المكتب الخاص بدأت إيمانويل رحلتها المهنية والفنية، وعملت على مجموعة واسعة من المشاريع والتصاميم المعمارية، بما في ذلك البنوك، والسكك الحديدية، والعديد من المشاريع والنصب الفنية التي تستخدم اللون كعنصر أساس في عملية التصميم. هذه التجربة الفريدة قادتها فيما بعد لاكتشاف وطرح مفهوم تصميمي خاص بها يمزج بين الفن والعمارة، وأطلقت عليه اسم «شكيري»، ويعني حرفيًّا باللغة اليابانية «تقسيم المساحة باستخدام الألوان»، وهي مقاربة فريدة تستخدم بطريقة فنية وجمالية مبدعة ما يقارب 100 درجة مختلفة من الألوان لتحديد وتقسيم المساحات والفضاءات بطريقة ثلاثية الأبعاد.
«شكيري» يحول المساحات إلى ألوان
تصف إيمانويل موريو رحلتها الخاصة والطويلة مع مفهوم «شكيري» بالقول: «استجابة لتجربتي الرائعة التي لا تنسى مع الألوان والطبقات في طوكيو، توصلت إلى مفهوم تصميمي أطلقت عليه اسم «شكيري»، ويعني باللغة اليابانية تقسيم المساحة باستخدام الألوان. لقد استخدمت الألوان كعناصر ثلاثية الأبعاد، مثل الطبقات؛ لإنشاء وخلق مسافات بين الأسطح، وليس كلَمْسة نهائية تضاف على الأسطح».
شكلت العناصر والأشكال اليابانية التقليدية مثل الأبواب والنوافذ المنزلقة، التي تشتهر بها اليابان، مصدر وحي حقيقي في البداية لإيمانويل موريو لاستكشاف مفهوم شكيري «السطحي»، وتطور هذا المفهوم بعد ذلك كما تقول على نحو تدريجي لتصل إلى مفهوم شكيري «الخطي». وتعلق المصممة الفرنسية على هذا التطور في المفهوم بالقول: «تدرج استكشافي لمفهوم تطبيق اللون على السطوح والخطوط ضمن رحلة طويلة باستخدام مقاييس مختلفة، من قطعة فنية صغيرة إلى كتلة معمارية ضخمة».

ويبدو هذا المفهوم حاضرًا بطريقة واضحة جدًّا في تجربة إيمانويل موريو، فهي استخدمت العصي كعنصر مكاني جزئي في مشروع «كرسي العصي» الذي قدمته في عام 2007م، قبل أن يتحول بعد ذلك إلى عنصر مكاني كامل في مشروع «العصي» الذي قدمته في عام 2010م، وهي لم تقف عند هذا الحد، بل تخطط حاليًّا لترجمته وتحويله إلى مشروع هيكل معماري ضخم في المستقبل.
في عام 2013م، وفي الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق مكتبها المعماري الخاص، أماطت إيمانويل موريو اللثام عن مشروعها الأول من نوعه في طوكيو، وهو نصب فني جميل حمل عنوان «100 لون». ركز هذا النصب على إظهار مجموعة كاملة من الألوان للتعبير عن المشاعر التي شعرت بها بعد رؤيتها لطبقات الألوان المتزاحمة في طوكيو. كان هذا النصب هو بداية سلسلة معارض «100 لون»، التي بدأت بها وتخطط لإقامتها في مدن مختلفة حول العالم ضمن مشروع يحمل الاسم نفسه، كما تقول.
وانطلاقًا من تجربتها الفريدة مع الألوان والفضاءات، أطلقت إيمانويل موريو في عام 2017م، ضمن مشروع «100 لون»، تحفتها الفنية الفريدة التي حملت اسم «غابة الأرقام»، وعرضتها في المركز الوطني للفنون في طوكيو، احتفالًا بالذكرى العاشرة على تأسيسه. رُكِّبَ هذا النصب على مساحة واسعة تزيد على 2000 متر مربع من دون أي جدران فاصلة، وكان يرمز من خلال 60 ألف قطعة ملونة مُعَلّقة ضمن شبكة ثلاثية الأبعاد إلى رحلة المركز المستقبلية، خلال السنوات العشر التالية، من عام 2017م إلى عام 2026م.
كان النصب مميزًا، وخلق لدى زواره شعورًا عارمًا بالعاطفة وحافلًا بالخيال، وهذا بالضبط ما تسعى إليه المصممة الشابة التي تقول حول تجربتها مع شكيري: «أريد أن أمنح العاطفة من خلال الألوان، سواء كان ذلك عبر العمارة أو القطعة الفنية. من خلال أعمالي، أريد أن يرى الأشخاص الألوان، كما أريدهم أن يلمسوا الألوان وأن يشعروا بها بكل أحاسيسهم. إن التأثير العارم للألوان في الفضاء سوف يؤكد أن الألوان يمكن أن تكون أكثر من مجرد فضاء، بل فضاء يزخر بطبقات إضافية من المشاعر الإنسانية».
تحولت إيمانويل موريو وأسلوبها التصميمي الخاص الذي أطلقت عليه اسم «شكيري» خلال مدة قصيرة إلى محور اهتمام النقاد الفنيين والصحف والمجلات المعنية بالفنون والعمارة في العالم، وجعل من صاحبته في سنوات قليلة فقط شخصية فنية ومعمارية مذهلة، ليمتد صيتها من طوكيو مرورًا بباريس وصولًا إلى لندن، التي استضافت واحدة من أعمالها الأخيرة اللافتة، التي تحمل عنوان «شرائح الزمن».
شرائح الزمن
في تحفتها الجديدة التي تستضيفها «غاليري الآن» (NOW Gallery) في شبه جزيرة غرينتش، تسافر إيمانويل موريو بعيدًا مع الزمن في رحلة تعكس محطاتها مجموعة ساحرة من الأرقام الملونة، التي يزيد عددها على 168 ألف قطعة صغيرة بحجم لا يتعدى 7 سم ثُبِّتَتْ، على مدى أسبوعين، باستخدام خيوط دقيقة ملونة تتدلى من سقف الصالة. تتدلى هذه القطع الرقمية بطريقة مذهلة، مثل الأجنحة الطائرة، وتتدرج ألوانها باستخدام 100 درجة مختلفة من الألوان، لتستولي على مشاعر ومخيلة الزائر في لوحة ثلاثية الأبعاد أقرب ما تكون إلى مشهد خيالي غير مألوف من أفلام الخيال العلمي.
وما يزيد النصب الجديد جمالًا وسحرًا، هو هذه الأشكال الدائرية والكروية التي تتوزع ضمن محيطها بطريقة جميلة ومتناسقة مجموعات القطع الصغيرة الملونة، في تصميم يرمز بشكل واضح للكرة الأرضية والعالم، بينما ترمز الأرقام فيه للوقت والزمان. ولعل وجود المعرض في شبه جزيرة غرينتش التي تعد مرجعًا عالميًّا لتحديد الوقت منذ عام 1884م، تيمنًا بخط الطول الذي يمر بالمدينة، كان له أثر كبير في التصميم الجديد الذي تقدمه إيمانويل موريو في مسيرتها الفنية؛ إذ يحمل النصب عنوان «شرائح الزمن»، في تمثيل واضح للزمن، بالأمس واليوم والغد، كما تقول «جيميما بوريل» المنسقة الثقافية في «غاليري الآن».
وتضيف جيميما قائلة: «الشريحة، والدائرة والكرة الأرضية، هي جميعها رموز عالمية ذات معنى لا نهائي، وتعد تمثيلًا لمفاهيم الشمول، والكمال، والخلود، وكل حركة دورية في الوجود. في هذه الحالة، يمثل العالم كل هذه الأشياء، وهو يعني الماضي والمستقبل والوقت الحالي. ضمن هذا الإطار، معرض «شرائح الزمن» هو لحظة للتفكير في المكان الذي كنا نعيش فيه والذي سوف نذهب إليه في المستقبل».

من معرض شرائح الزمن
ولكن، ما يميز هذا المعرض من كل المعارض الأخرى التي سبقته، الطريقة التفاعلية التي يقدم بها نفسه. فقد حرصت إيمانويل موريو أن تقدم للزائر أكثر من مجرد زيارة عابرة وتصميم جميل يرضي ذائقته الجمالية، بل تطبيقًا تفاعليًّا يشارك فيه كل زائر بإغناء التصميم النهائي من خلال مشاركته الخاصة. ولتحقيق هذه الغاية، يُمنَح كل زائر ورقة دائرية ملونة لكتابة تاريخ يختاره ويحدده بنفسه باستخدام قلم ملون بارز. بعد ذلك، تُوضَع هذه القصاصات الملونة ضمن جدول زمني محدد على نافذة المعرض لتضيف إلى التصميم الأصلي مشهدًا غير مُتناهٍ من الألوان والتواريخ، التي تعكس كل واحدة منها تاريخًا هو الأكثر أهمية لكل زائر من زوار المعرض.
في المحصلة، تعزز تحفة إيمانويل موريو الجديدة «شرائح الزمن» من دون شك شغف المصممة الفرنسية المهاجرة بالألوان وتأثرها المستمر بالثقافة والبيئة والطبيعة اليابانية الساحرة، وهي تمثل تجربة فريدة تضاف إلى تجاربها الجميلة السابقة، وتعكس من دون شك هذا المزيج الرائع والفريد الذي يجمع بين سحر الطبيعة وجمال الألون في اليابان مع العبق الفرنسي الأصيل الذي تحمله برُقِيٍّ وأصالة بين جوانحها. وهي من خلال هذا العمل والعديد من الأعمال الأخرى التي قدمتها في الماضي، أو التي سوف تقدمها في المستقبل، تسعى لتحقيق حلمها وغايتها في الحياة التي تلخصها في القول: «رغبتي أن يكون لدينا حياة غنية بالألوان».

 في هذا المشهد المتغير والصعب، يسعى المهندسون المعماريون وصناع القرار والبناؤون والمستخدمون إلى الاستفادة من المشروعات المعمارية النموذجية التي تعالج القضايا الحالية وتعزز جودة الحياة، والتي يمكن أن تكون أمثلة يحتذى بها في مناطق أخرى من العالم. يشدد كتاب «العمارة الشمولية» على هذه الحاجة من خلال تسليط الضوء على عشرين مشروعًا رائدًا اخْتِيرَت ضمن القائمة القصيرة للمشروعات المرشحة لجائزة الآغا خان للعمارة، ومن ضمنها المشروعات الستة التي فازت بالمحصلة بالجائزة، في دورتها الأخيرة لعام 2022م. ومن المهم الإشارة هنا إلى أننا لا نتحدث عن «العمارة الشمولية» التي تعني نوعًا من العمارة التي أنشأتها الدول الشمولية، بل نتحدث عن المشروعات المعمارية التي تتخذ من مفهوم الشمولية أساسًا لها في عملية التصميم والتنفيذ.
في هذا المشهد المتغير والصعب، يسعى المهندسون المعماريون وصناع القرار والبناؤون والمستخدمون إلى الاستفادة من المشروعات المعمارية النموذجية التي تعالج القضايا الحالية وتعزز جودة الحياة، والتي يمكن أن تكون أمثلة يحتذى بها في مناطق أخرى من العالم. يشدد كتاب «العمارة الشمولية» على هذه الحاجة من خلال تسليط الضوء على عشرين مشروعًا رائدًا اخْتِيرَت ضمن القائمة القصيرة للمشروعات المرشحة لجائزة الآغا خان للعمارة، ومن ضمنها المشروعات الستة التي فازت بالمحصلة بالجائزة، في دورتها الأخيرة لعام 2022م. ومن المهم الإشارة هنا إلى أننا لا نتحدث عن «العمارة الشمولية» التي تعني نوعًا من العمارة التي أنشأتها الدول الشمولية، بل نتحدث عن المشروعات المعمارية التي تتخذ من مفهوم الشمولية أساسًا لها في عملية التصميم والتنفيذ.




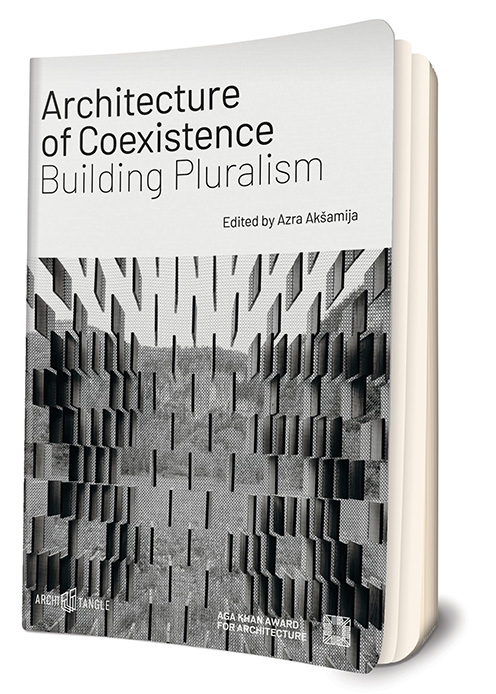 من خلال مجموعة من الآراء الشخصية والتجارب المتميزة التي تم اختيارها من مناطق مختلفة من العالم، يسلط الكتاب الضوء على دور العمارة في التصدي لعدد من القضايا الحساسة التي تتعلق بشكل أساس بموضوعات التعايش والتعددية، وكيفية تقبل الآخر، والتكيف مع التغيرات ضمن المجتمع، واحترام الاختلاف بين الثقافات والشعوب، والاحتفاء بهذا الاختلاف وتسخيره في خدمة المجتمع، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم، والتي تدفع إلى مزيد من موجات الهجرة والنزوح للأفراد والمجتمعات.
من خلال مجموعة من الآراء الشخصية والتجارب المتميزة التي تم اختيارها من مناطق مختلفة من العالم، يسلط الكتاب الضوء على دور العمارة في التصدي لعدد من القضايا الحساسة التي تتعلق بشكل أساس بموضوعات التعايش والتعددية، وكيفية تقبل الآخر، والتكيف مع التغيرات ضمن المجتمع، واحترام الاختلاف بين الثقافات والشعوب، والاحتفاء بهذا الاختلاف وتسخيره في خدمة المجتمع، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم، والتي تدفع إلى مزيد من موجات الهجرة والنزوح للأفراد والمجتمعات.





