
أحمد عزيز الحسين - ناقد سوري | يناير 1, 2023 | قراءات
«زهر القطن» لخليل النعيمي (المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت- 2022م) نص روائي عن المكان، وعلاقة الذات معه، وهو، في الوقت نفسه، رحلة تلاحق تفتح الذات في علاقتها مع هذا المكان، وتكْشِف عن آلية تكونها وصيرورتها على المستويين العقلي والجسدي، وقد قدم لنا النص نموذجين يجسدان ذلك: نموذجًا تماهى مع المكان، وتكيف معه، وأمسى جزءًا منه هو (أبو الصبي)، ونموذجًا آخر انفصل عنه، وحلق فوقه، وتغلب على صعوبات الحياة فيه بعد أن تعلم (الحكْيَ) أو(الكلامَ)، هو (الصبي)، وقد أمسى المكانُ، الذي انتقل إليه الصبي (وهو الشخصية المحورية في النص)، بما فيه من سلطةٍ مهيمِنةٍ حائلًا بينه وبين تكشف ذاته على الوجه الأمثل؛ ولذلك اضطر إلى مغادرته إلى حيز آخر بغية تحقيق ذاته، من دون أن يكشف عن اسم هذا الحيز.
احتضن الحمادُ الشاسِعُ «أبا الصبي»، وأمسى عشه وقوقعتَه، وكان الحيزَ الذي ساعده على إعالة أسرته، وإنقاذها من الموت، رغم أنها بقيتْ جائعةً ومُهمشة في الرواية، وكان الحمادُ، رغم شُح موارده، الملاذَ الحميمَ الذي أتاح للأب أن يحافظ على ذاته من التبدد، وعلى أسرته من التشظي، لذا لم يشعر إلا في لحظات قليلة بأنه هش أو ضعيف أمام شظف الحماد وقحطه، بل إن الرواية تُقدمه لنا في مشاهد عديدة ممتلكًا طاقةً داخلية كبيرة على التوازن والصمود، وعلى الاستمتاع بما يكتنزه الحمادُ من خيرات ونِعَم مُخبأة، أتاحت للأب وزوجته وابنه أن يصمدوا، ويحافظوا على ذواتهم من الهلاك في أرض صحراوية قاحلة تفتقر إلى أسباب الحياة، بل إن النص قدم لنا (أبا الصبي) وهو مشدوهٌ أمام جماليات الحماد وروعة ما فيه من كائنات وعناصر طبيعية تأخذ بالألباب، حتى إن (الكمأ) الذي يعثر عليه الأبُ بالمصادفة في أحد الأيام يُصور على أنه لقية نادرة، في مشهد بصري وجمالي يختزن كثيرًا من الإبهار والشاعرية والرهافة.
لقد بقي الأبُ في الرواية محتفظًا بكامل توازنه العقلي والنفسي في مواجهة الحماد الشحيح المكتظ بالعجاج، وما أكثرَ ما اضطر إلى أكل الجرابيع وغيرها، كي يقاوم الموت، ولم يجد ضَيْرًا في ذلك، بل إن الحماد الشاسع منحه رحابةً في رؤية العلاقة بين الدين والحياة، وقدرةً على التكيف؛ ولذلك لم يهجره رغم ما فيه من شُح وقسوة في المناخ، بل وجد في رحابته مجالًا لتحقيق الذات، والشعور بالحرية والأمان والاطمئنان، فهو قادرٌ على التنقل فيه من دون خوف، وهو مهيمِنٌ عليه، وليس خائفًا منه، وقد انتقل هذا الشعور إلى الصبي، فلم يتغير موقفه إزاءه عندما غادره إلى الدرباسية وعامودا في شمالي سوري، وفيما بعد إلى دمشق؛ وظل يحن إليه مع أنه أدرك أنه عاش حياة ضنك وحرمان فيه، وقد تحدث عن معاناته هذه في ديوان شعر عندما انتقل إلى دمشق، وهو ما أفضى إلى غضب السلطة عليه، ومصادرة الديوان، وتحذيره من العودة إلى الكتابة عن ذلك مرة أخرى.
كان أبو الصبي يعيش حرًّا في الحماد الشاسع، وكان يشعر بأنه قادر على التنقل فيه أنى شاء، لأن الحماد كله «بيتُه»، كما كان يعتقد، وهو قادر على الحركة فيه من دون أن تكون هناك قوة تحول بينه وبين ذلك، وكان الناس من حوله يشعرون، أيضًا، بأن الكون كله تحت أقدامهم، و«يمكن لأي كان أن يتصرف على هواه، وأن يذهب إلى هناك، أو يصل إلى هنا» (نفسه، ص151)، ومع ذلك توصل الأبُ ذات يوم إلى أن الحمادَ ليس له كما كان يعتقد، وأن عليه أن يرحل عنه باستمرار، وأن ثمة قوة تحول بينه وبين البقاء فيه، وتأمره بالرحيل دومًا، و«كان يحسب أن البر جزءٌ منه، وأن باستطاعته أن يدعي امتلاك بعض الخروق والأتربة والأحجار فيه» (ص130)، إلا أنه أدرك ذات يوم أنه «لا يملك منه شيئًا، وكل ما عنده يعود بكليته إليهم» (ص130)، وقد «تساءل بامتعاض وتوجس: ولكنْ منْ هم؟» (ص130)، دون أن يعثر على جواب، وتوصل إلى أن «المكان هو الذي يستعبدنا وليس الآخرين» (ص142)، ووجد الحل في الابتعاد من الأمكنة التي يسلكها الناسُ الذين يغضب منهم. وقد ألِف الصبي منه ذلك، ومع أنه تعلم منه أن «الكلامَ بحرٌ يمكن للمرء أن يغرق فيه، ويمكن أن يجد في ثناياه ما يريد» (ص29)، إلا أنه اكتشف أيضًا أن دمشق ليست جزءًا من العالم الحميم الذي تحدث عنه أبوه، وأنه لا يستطيع أن يتحرك فيها كما يشاء، ولا أن يقول فيها ما يصبو إليه، كما تبين له أن لكلامه سقفًا وحدًّا لا يستطيع أن يتعداه، وأن ثمة قوى تملك القدرة على إسكاته، ومنْعِه من (الحَكْي)، مع أن (تعلم الحَكْي) كان هدفَه في الحياة، وهو ما همس به في أذن طفلة في مثل عمره ذات يوم (ص 41)، وما صرح به لأبيه عندما طُلِب منه الالتحاقُ بالمدرسة (ص36)، ولما كان الاعتداءُ على (كلامه) يوازي الاعتداءَ على (كينونته) شأنه في ذلك شأن أهل الصحراء الذين «كان كلامُ المرء عندهم جزءًا منه، وكان اعتداءُ أحدٍ على كلامهم يوازي الاعتداء على كيانهم» (ص33)؛ ولذا قرر الهرب ومغادرة دمشق عندما طُلِب منه أن يتوقف عن الكلام فيما يرغب فيه، مع أن الكتب والقراءة ساعَدَتاه في اكتشاف هُويته وتنامِي وعيه، كما جعَلتاه يستجيب لنداء جسده بحرية، وهو ما غير من آلية استجابته للعالم من حوله، ولا سيما بعد قراءته لرواية (الإخوة كارامازوف) في دمشق، وازدياد خبرته الجسدية؛ إذ تغير موقفُه الأخلاقي من العالم، ورفض أن يبقى ضحية (ص223)، وقرر أن يتمرد على العالم من حوله، ويغير آلية حياته ومصيره بشكل حاسم، كما قرر أن يكسر الدائرة التي بدأت تنغلق عليه من جديد؛ بعد أن أدرك أن فتحها هو الذي سيفتح له آفاق الكون، ويتذوق طعم الحرية التي كان يتوق إليها.
وجود أصيل لذات واعية
بحث الصبي، الذي أصبح فتى، في النص، عن الوجود الحقيقي الأصيل لذات واعية تقرر تحقيق وجودها الإنساني بمنجى عن الخوف والاستلاب الذي يقبله غيرُها، ويتكيف معه، ويعده جزءًا من حياته، وقدرًا ينبغي قبولُه، ودخَل في مواجهة مع واقعه، وعبر عن رفضه له من خلال الكتابة؛ فاصطدم بسلطة مُهيمِنة رأتْ في محاولته خطرًا عليها، وبعد أن اكتملت المواجهةُ بين الطرفين قرر الصبي (الذي أصبح شابًّا وكاتبًا) الهربَ خوفًا من السلطة التي استجوبتْه، وحرص على ألا يتنازل عما يتمسك به، ويعده هُوية له؛ ذلك أن البقاء في دمشق كان سيُفضي به إلى التنازل عن هذه الهُوية؛ ولذلك آثر الهرب منها إلى مكان آخر صونًا لذاته من التشظي، ورغبة في عدم تقديم أي تنازل عما يؤمن به، ولا سيما بعد أن أصبح الخوفُ جزءًا من وجوده فيها.
 وقد اكتشف في دمشق، بعد أن تنامى وعيُه بسبب القراءة، قسوة العوز والحرمان الذي عاشه مع أهله في الحماد، وعاشه أضرابُه من الصبيان مع أسرهم، كما تبين له أن هناك قوة عاتية تُمسِك بدفة القدر، وتُوجهها لمصلحتها الخاصة، وسعى للخلاص من الشبكة التي كان يتخبط فيها، وكادت تُطبِق عليه، وتبين له أن السبيل الوحيد للخلاص مما هو فيه أن يعبر الحدود إلى بيروت، التي كانت وجهتَه الممكنة للوصول إلى الحرية، وبناء الهُوية، وتحقيق الذات، والخلاص من إسار القهر والظلم والحرمان الذي كان يرسف فيه.
وقد اكتشف في دمشق، بعد أن تنامى وعيُه بسبب القراءة، قسوة العوز والحرمان الذي عاشه مع أهله في الحماد، وعاشه أضرابُه من الصبيان مع أسرهم، كما تبين له أن هناك قوة عاتية تُمسِك بدفة القدر، وتُوجهها لمصلحتها الخاصة، وسعى للخلاص من الشبكة التي كان يتخبط فيها، وكادت تُطبِق عليه، وتبين له أن السبيل الوحيد للخلاص مما هو فيه أن يعبر الحدود إلى بيروت، التي كانت وجهتَه الممكنة للوصول إلى الحرية، وبناء الهُوية، وتحقيق الذات، والخلاص من إسار القهر والظلم والحرمان الذي كان يرسف فيه.
وفي بيروت ظل يحس بالتوجس والخوف، فقرر الهربَ منها «إلى العدم، إلى عدم العدم إنْ كان موجودًا» (ص 247)، وحين شعر بالتردد في الرحيل قرع نفسه قائلًا: «إنه إنْ لم يسافر سيكون من الموتى/ الأحياء الذين يقبلون بأي حياة تُتَاح لهم، ولا يسعَوْن إلى تغييرها، وأن أقصى ما يمكن أن يقع له إنْ عاد إلى دمشق هو أنْ يقدم التنازل تلو التنازل، ويرضى بما هو مرسوم له من قبل القوة التي تُحكِم الرقابة عليه، وتطلب منه الالتزام بما هو مطلوب منه، وعندئذٍ سيُتاح له العملُ، وسيعيش كغيره، وإنْ كان سيُضطر إلى إهدار بعض «كيانه الذي كونه حبةً حبة»، والذي هو جوهر وجوده، ومبرر هذا الوجود، وقد يُفضِي به ذلك إلى أنْ يهوي مثل حصوة في بئر بلا قعر» (256)، وقد يخسر عندئذٍ وجوده ذاته؛ لذا بدا له بابُ الباخرة البيضاء التي نوى استقلالها هو «بابَ الكون» الجديد الذي سيلِجُه (ص 256)، ومع أنه استطاع دخول الباخرة بنجاح، وأفلت من قبضة ضابط الشرطة الذي كان يراقب المسافرين فإنه بقي مترددًا في العودة إلى مكانه «القديم الذي فر منه قاتمًا، ومحتقنًا بالشر مثل قلعة سوداء» (ص 261)، لكن الباخرة البيضاء حسمت الأمر؛ إذ «أغلقت أبوابها السميكة، وتعالى صفيرُها القاسي يُعلن المسير» (ص262)؛ وهكذا غدا «البابُ السميكُ» و«الصافرةُ القاسيةُ» رمزين للانفتاح على عالم مجهول لا يعرف عنه شيئًا، وإنْ كان النص قد ترك علامة تدل على التفاؤل من خلال استخدامه اللونَ الأبيضَ للسفينة، وهو لونٌ يدل على التفاؤل، ويرشح بمستقبل وضاء قادم.
الاحتفاءُ بالجسد بوصفه تجليًا لتشكيل الهُوية
سعى الصبي، في الخطاب الروائي، إلى تشكيل هُويته من خلال القراءة التي أسهمت في تشكيل وعيه، كما سعى إلى إشباع رغباته الجسدية من خلال علاقاته بالفتيات والنساء من حوله، وقد لاحقت الرواية تجاربَ الصبي العاطفية، وتنامِيَ خبرته الجسدية مع النساء، وجعلتْ إصغاءه لنداء جسده جزءًا من تشكيل هُويته، وعدت استمرارَ إصغائه لجسده وتلبيتَه لندائه متابعةً لآلية هذا التشكل؛ إذ لا انفصالَ في الرواية بين تشكيل الهُوية والاستجابة لنداء الجسد، فالذاتُ تجد هُويتها في تنامي وعيها وإدراكها لكينونتها، وعلاقتها بالفضاء الموار من حولها، كما تجد هُويتها في الاستجابة لنداء جسدها وليس في قمعه؛ ولذا فإن الاحتفاء بالجسد في الخطاب الروائي هو تجلٍّ للاحتفاء بالهُوية، وتأكيدٌ أن الهُوية لا تتحقق من خلال المعرفة والوعي وحسب بل لا بد لها من إرواء الجسد، لأن في قمع الجسد ورفض الاستجابة لندائه بضغط (التابو الاجتماعي) أو (الديني) حيلولةً بين الذات وهُويتها التي لا يمكن أن تكتمل إلا بإشباع حاجتها إلى الجنس، فضلًا عن حاجتها إلى المعرفة وامتلاك الوعي الجمالي في الوقت نفسه.
تشكيل الخطاب الروائي
في ظني أن من يقرأ هذا النص البديع لا بد له من الاحتكام إلى حاسة البصر في تلقيه؛ لأن الكاتب حشد فيه مجموعة من المشاهد البصرية الفاتنة سواءٌ في وصف المكان والشخصيات، أو في وصف الأفعال التي تجترحها هذه الشخصياتُ في مواجهتها للواقع، أو في استجابتها لنداء الجسد. وقد اعتمد الكاتب في تشكيله لصوره السردية على حاسة البصر، وجعلها أداةً في تعرف شخصيته المحورية إلى العالم من حولها، وكون من عالم الصحراء المحدود جمالياتٍ رهيفة ارتقت بصورة الصحراء في النص إلى ذرى بديعة من ذُرَى الجمال والتألق والإبهار.
كما أعاد بناء المكان بما يتناسب مع تشكيل بنية النص كله، ومنحه دلالةً جديدة تتوافق مع الدلالة العامة للنص نفسه، فجعله مفتوحًا في بداية النص ومفعمًا بالرحابة، ومناسبًا لتشكل ذاتٍ لا تواجه محظوراتٍ قاهرةً أو تابواتٍ ضاغطةً تحول بينها وبين تحقيق ذاتها وبناء هُويتها، وإنْ كان قد لمح إلى وجود قوة خفية تتحكم بهذه الرحابة، وتُهيمِن عليها، غير أن هذه القوة لا تُضيق الخناق على الناس، ولا تتدخل بشكل سافر في صياغة حياتهم اليومية، وإنْ كانت آثارُها قد بدأت تظهر في إفساح المجال لشريحة اجتماعية محددة كي تُثريَ وتُصابَ بالتخمة على حساب شريحة أخرى كانت تعيش في فقر مدقع، وهو ما شاهده الصبي حين غادر الحماد مع أهله إلى الدرباسية وعامودا بقصد إكمال دراسته، وقد بدأ المكانُ في النص يضيق بالناس، وينغلق عليهم، ويتحول إلى حيزٍ مكتظ بالمحظورات مع انتقال الفتى إلى دمشق لإكمال دراسته، وظل يضيق باستمرار إلى أن تحول إلى حيز قاهر أحكم قبضته على عنق الفتى، وحال بينه وبين قول ما يريد، وهو ما أجبره على الهرب إلى بيروت ومنها إلى الخارج.
وعلى الرغم من كثرة العجاج في الصحراء فإن اللونين الرمادي والأسود ظلا نائيًين عن مشاهد الكاتب البصرية، وظل احتفاء الكاتب بالألوان مهيمنًا على مشاهد القسم الأول من الرواية، وهو ما جعلنا نحس بالبهجة تعتمل في دواخل الشخوص وهي تواجه فضاء الحماد، وتنعم بما يشتمل عليه من مشاهد ضوئية وجمالية باهرة.
وقد حرص الكاتب على جعل الحماد موشحًا بالنور ومفعَمًا بالضوء والبهجة، واستخدم اللون والضوء بوصفهما عاملين من عوامل تشكيل الذات والهُوية في حياة الصبي وأبيه، وحين أحاط المكانُ بالفتى، وأمسى كالكماشة، وكثرت المحظوراتُ في حياته استُثمر غياب الضوء (أو نور القمر) لتأكيد وجود محظور يحول بين الشخصية وإرواء عطشها للجنس والحياة، وأمسى عائقًا يمنعها من تحقيق ذاتها على الوجه الأمثل. كما حرص الكاتب أيضا في تشكيل لغته السردية على توشيتها بالتشابيه الحسية الملتقطة من البيئة (الرواية، ص 57)، كما استعان بالملفوظ الشعبي الذي أفسح المجال للشخصيات كي تتحدث بلغتها ومنطوقاتها العفوية الطازجة (نفسه، ص200)، وأتاح المجال لسارده العليم كي يستخدم الحذف غير المعلن بغية التخلص من الفجوات الميتة في زمن السرد (ص202)، وبذلك أبعد روايته عن الإطناب والترهل، وأكسبها نعمة التكثيف والادخار والشفوف معًا.

أحمد عزيز الحسين - ناقد سوري | سبتمبر 1, 2022 | مقالات
خطيب بدلة كاتبٌ متعدد المواهب، بدأ حياته الأدبية قاصًّا ساخرًا، ثم انصرف إلى الدراما الإذاعية والتلفزيونية، وأنتج فيهما أعمالًا معروفة وناجحة، وأصدر خلال حياته الأدبية، المستمرة منذ ثلاثة عقود ونيف، خمسة عشر كتابًا في فن القصة القصيرة، والمقال الصحفي، والدراما الإذاعية والتلفزيونية، وهو، إلى ذلك، كاتبٌ مرِحٌ، وخفيفُ الظل، وقريبٌ إلى قلب القارئ وروحه، ويمتلك القدرة على مراقبة الواقع، والنفاذ إلى جوهره وأعماقه، كما يستطيع إضحاكَ مُتلقيه من التصرفات الغريبة لشخصياته، والسخرية من سلوكها الشاذ والمفارق للمألوف، وهجاءِ ما تواضعَتْ عليه هذه الشخصيات من ولعٍ بالنفاق والوصولية والانتهازية، والركض وراء كل ما يساعد على التسلق إلى سطح الحياة الاجتماعية، واهتبال الفرص للفوز بالشهرة، والرغبة في اجتناء المتعة، وتكديس الثروات الطائلة، وتحقيق النفوذ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
يتميز عالمه بتعدد الأنماط والشخصيات والدلالات، وتكاد شخصياته تعبر عن الفسيفساء الاجتماعية لوطنه الصغير سوريا، بكل ما تحمله من تنوع وخصوبة وثراء على المستويين الاجتماعي والدلالي، مع إمكانية تعميم ما يكتبه ليطول بلدانًا عربية أخرى لها الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية نفسها، مثل: العراق ومصر والجزائر وتونس والمغرب ولبنان وغيرها.
أبطال في زمن التفاهة
 يرصد خطيب بدلة التشوهات التي أصِيبَتْ بها شخصياتُه، ويضع يدَيْ قارئِه على الزيف الذي غدا سمة جوهرية لها، والمآلِ الذي وصلتْ إليه من خلال تسفلها، وقَبُولِها بأنْ تكونَ منحطةً ومُتحللة، وسعيدةً بما وصلت إليه من تفسخ وتعفن، أو جنونٍ وتهميش، فضلًا عن أنه يتابع بدأب وتقصٍّ ما لحِق بها من ندوب اجتماعية، وانحرافات أخلاقية، ويُلاحِق انعكاسَ ذلك على تصرفاتها وتقويماتها الجمالية للواقع، وكيف أفضى بها ذلك إلى أن تقبل بالتلون والنفاق و«تمسيح الجوخ» على أنه شكل من أشكال تكيفها مع واقعها، وآلية لتماهيها معه، ولو أفضى بها ذلك إلى إحداث تبدلات جوهرية في سماتها، وهُويتها، وآلية استجابتها لواقعها.
يرصد خطيب بدلة التشوهات التي أصِيبَتْ بها شخصياتُه، ويضع يدَيْ قارئِه على الزيف الذي غدا سمة جوهرية لها، والمآلِ الذي وصلتْ إليه من خلال تسفلها، وقَبُولِها بأنْ تكونَ منحطةً ومُتحللة، وسعيدةً بما وصلت إليه من تفسخ وتعفن، أو جنونٍ وتهميش، فضلًا عن أنه يتابع بدأب وتقصٍّ ما لحِق بها من ندوب اجتماعية، وانحرافات أخلاقية، ويُلاحِق انعكاسَ ذلك على تصرفاتها وتقويماتها الجمالية للواقع، وكيف أفضى بها ذلك إلى أن تقبل بالتلون والنفاق و«تمسيح الجوخ» على أنه شكل من أشكال تكيفها مع واقعها، وآلية لتماهيها معه، ولو أفضى بها ذلك إلى إحداث تبدلات جوهرية في سماتها، وهُويتها، وآلية استجابتها لواقعها.
وقد عرَّى أبطالَه، وهجَا حبهم للتفاهة والنذالة والاسِتزْلام، وسلط الضوءَ على خوائهم الروحي والوجداني، وكشف ما أصابهم من انحطاط وتسفل، وسخِر من ميلهم إلى الخلاص الفردي، وعده شكلًا من أشكال الهروب من الواقع، وانتقد ميلَهم إلى العيشة الراضية القانعة بالحصول على لقمة العيش، وسلط الضوءَ على نمط حياة مقيتٍ لديه، وعده خطرًا اجتماعيًّا وقانونًا أخلاقيًّا مُهيمِنًا ينبغي الحذرُ منه ومواجهتُه بلا هوادة كما في قصته «وقت لطلاق الزوجة» التي يقبل فيها المتشرد (زياد) بأن يكون زوجًا شكليًّا لامرأة عاهر لقاء حصوله على مسكن دافئ، ولقمة طيبة («وقت لطلاق الزوجة»، دمشق، 1998م، ص163)، وكما في قصتيه «برتقان» و«زهرة التفتا» تلجأ فيهما الشخصية المحورية إلى السرقة لمواجهة واقعها الصعب («عودة قاسم ناصيف الحق»، وزارة الثقافة بدمشق، 1989م، ص91)، مسوغة ذلك بأن ذلك أمسى الوسيلة الممكنةَ الوحيدة للعيش في واقع مأزوم ابتلع مُهمشيه، ورمى بهم إلى هوة القاع الاجتماعي بعد أن كانوا يحظون بحياة كريمة وشريفة.
لا شك في أن التفاهة التي يدِينُها خطيب في بعض قصصه، تتعلق بفقر الحياة الوجدانية والروحية التي تعيشها شخصياتُه، وهي التفاهة الناجمة عن هيمنة حياة استهلاكية أرختْ بثقلها على مجتمعه المُتخيل، ولذلك وجدتْ شخصياتُهُ ذواتَها في الإقبال على الحياة التافهة أو الرتيبة، والانغماس في شؤونِ الحياة اليومية، والاستجابةِ لها بوصف ذلك شكلًا من أشكال تحقيق حاجاتها الحيوية، وبناء ذواتها، وقبول استمراء العيش في حياة خالية من المثل العليا، أو مفتقرة إليها؛ ففي قصته «الكرسي البرام» تجد الشخصيةُ المحوريةُ ذاتَها، وتحقق كينونَتها من خلال الحصول على كرسي برام، مما يدلل على ما تعانيه من خواء روحي وفقر وجداني في سياق يحثها على الاستجابة لذلك. (وقت لطلاق الزوجة، ص 113).
سردية المهمشين
الشخصية المحورية عند خطيب لا تجترح أفعالًا عجيبة، أو خارقةً للمألوف في حياتها اليومية، بل تستنيم إلى حياة رتيبة ككل الناس من حولها، وقد تقبل البقاء في حياة أدنى من ذلك بكثير، وتتأتى موهبته من قدرته على جعل حياتها صالحةً لأن تُنمذِج آلية حياة الإنسان المُهمش والمُقصَى إلى هوة القاع وظلمته الأبدية، وهذه الشخصية تُكرر، في الأغلب الأعم، ما يجترِحُه الإنسانُ البسيطُ من أعمال مألوفة، ولا تنهض بأفعالٍ مغايرةٍ لما يقوم به من نمطِ حياةٍ مُسئِمٍ، وباعِثٍ على القرف والضجر، ومع ذلك فقد ارتقى خطيب بهذا النمط من العيش الذي اعتادتْهُ شخصياته، وبـ(نثر الحياة اليومية) الذي يُغلفه، ويتلفع به، ويُلمعه… إلى مستوى فني جديرٍ بأن يُقرَأ، ويُنصَت إليه بمتعة ورهافة.
وفي ظني أن التفاهة التي يدِينُها في بعض قصصه تتعلق بفقر الحياة الوجدانية والروحية الذي تعيشه شخصياتُه، وهي التفاهة الناجمة عن هيمنة حياة استهلاكية على المجتمع المُتخيل الذي تُحِيل إليه هذه القصص، ولذلك وجدتْ هذه الشخصياتُ ذواتَها في الإقبال على الحياة التافهة أو الرتيبة، والانغماسِ في الحياة اليومية الباعثة على الملل، وقبلتْ بأنْ تعيش حياةً خاليةً من المُثل العليا، أو مفتقرةً إليها إلى حد كبير، فهو يدِين في قصته «الكاتب والشرطي» تعهيرَ الثقافة والكتابة، وعدمَ احترامِ العلم ورجاله، ويقدم متنًا حكائيًّا ينهض على المفارقة، ويرثي تسفل الثقافة، وما آل إليه حالُها في بنية اجتماعية تنهض على تعميم التفاهة والجهل، وإشاعة الفكر الخرافي الذي يُعزز الإيمان بالغيبيات، ويحتقر التفكير العلمي ورجاله. (نفسه، ص 91).
الشخصية المعطوبة
تُعاني شخصياتُ خطيب بدلة عطبًا يمنعها من العيش كما تتمنى وتحلم، وهذا العطبُ قد يكون بيولوجيًّا أو نفسيًّا كامنًا داخل الشخصية نفسها، وقد يرجع إلى الظروف الموضوعية التي تواجهها، أو إلى السياق الذي يحتضنها، وفي الحالتين: تبقى عاجزةً عن تحقيق أحلامها، ويبقى هناك بَونٌ شاسعٌ بين ما تحلم به وتسعى إليه، وبين ما تستطيع تحقيقه على أرض الواقع من إنجازاتٍ أو أحلامٍ تعدها مثلًا أعلى لها، وسبيلًا لتحقيق ذاتها على الوجه الأمثل؛ لذلك نجد هناك مفارقة ومسافة بين واقعها المعِيش وما تملكه من إمكانيات، وبين ما تستطيع إنجازه وتحقيقه على أرض الواقع من أفعال جديرة بأن ترتقي بها إلى مستوى ما هو إنساني وسامٍ؛ ولذلك تستثمر تقنية الحلم كوسيلة ممكنة للخلاص مما تواجهه في الواقع، ثم تكتشف استحالة ذلك فتقرر مواجهة مشكلته في الواقع لا في الحلم.
والشخصية عنده تسعى إلى التحرر من النقائص التي تحول بينها وبين الحياة، كما تسعى إلى التحرر من الظروف الموضوعية التي تمنعها من تحقيق ذاتها، ولذلك تندغم في حياتها بشكل كامل، وتتماهى مع ظروفها وفق الآلية التي تُملى عليها، لا التي تطمح إليها، وتحاول أن تجد سبيلًا مغايرًا لما هو سائد ومألوف بغية تحقيق النجاح وتجاوز المُنغصات، واكتشاف الوسائل والأساليب التي تسمح لها بالاستمرار في العيش، والتسامي فوق الآلام، وتحمل الظروف الصعبة التي تواجهها.
التهكم في مواجهة الابتذال
يرصد خطيب بدأبٍ ووعيٍ التشوهَ الأخلاقي الذي أصاب شخصياتِه، ويتقصى النتائجَ التي أفضى إليها في حياتهم، ويضع يديه على الظروف الموضوعية التي شكلت هذا التشوهَ، وجعلته سمةً قارة لهم، ومُسوغًا لعثورهم على ذواتهم في بحر من التفاهة والتلذذ بصغائر الأمور، ففي قصته «عودة قاسم ناصيف الحق» يتابع صعود شخصيته من القاع، وكيف استطاعت تبوؤ مكانةٍ مرموقةٍ في مجتمعها بعد أن كانت موضع سخرية واستهجان فيه، وكيف ارتقتْ إلى شخصية ذات مرتبة دينية واجتماعية سامقة بعد أن كانت تحوز لقبًا يدل على وضاعة مرتبتها الاجتماعية واستصغار الآخرين لشأنها، وقد عبر العتال (مسطرين) في القصة عن ذلك متعجبًا: «شوفوا (مطيط) الصرماي، صار له بيت في ضبيط، وصار الحاج قاسم ناصيف الحق، ومتعهدًا يلعب بالمصاري لعبًا. تفوه عليك يا زمان».
 يستقي خطيب شخصياته ممن عاشوا في القاع، ويلاحق حياتهم اليومية، ويرصد صراعهم في سبيل حياة كريمة، مُتِيحًا لنا الفرصةَ لنستمع إليهم، وهم يتكلمون بلغتهم الشعبية الحارة الطازجة، راصدًا من خلال ذلك أنماط سلوكهم، وآلية مواجهتهم للحياة، والسبل التي انتهجوها في سبيل ذلك، كما أنه يُحسِن تسليط الضوء على الحياة المُبتَذلة لهذه الشخصيات، وعلى ما تعانيه من فقر روحي ومعرفي، وخواء وجداني وعاطفي، ويدفع بالقارئ إلى الضحك منها، والتهكم عليها، كما في قصته «الشيخ شادي» التي يُضطر فيها البطلُ إلى أن يكون قارئَ رملٍ ومنجمًا لكي يستطيع العيش في مجتمعٍ قاهرٍ لا يترك لشرفائه مجالًا لحياة كريمة تنهض على الصدق والعمل النزيه، ويجعلهم يسلكون سبلًا ملتوية لفعل ذلك. (وقت لطلاق الزوجة/ 207-212)
يستقي خطيب شخصياته ممن عاشوا في القاع، ويلاحق حياتهم اليومية، ويرصد صراعهم في سبيل حياة كريمة، مُتِيحًا لنا الفرصةَ لنستمع إليهم، وهم يتكلمون بلغتهم الشعبية الحارة الطازجة، راصدًا من خلال ذلك أنماط سلوكهم، وآلية مواجهتهم للحياة، والسبل التي انتهجوها في سبيل ذلك، كما أنه يُحسِن تسليط الضوء على الحياة المُبتَذلة لهذه الشخصيات، وعلى ما تعانيه من فقر روحي ومعرفي، وخواء وجداني وعاطفي، ويدفع بالقارئ إلى الضحك منها، والتهكم عليها، كما في قصته «الشيخ شادي» التي يُضطر فيها البطلُ إلى أن يكون قارئَ رملٍ ومنجمًا لكي يستطيع العيش في مجتمعٍ قاهرٍ لا يترك لشرفائه مجالًا لحياة كريمة تنهض على الصدق والعمل النزيه، ويجعلهم يسلكون سبلًا ملتوية لفعل ذلك. (وقت لطلاق الزوجة/ 207-212)
وهو يدين التصورات المُتحجرة لهذه الشخصيات، وكيف منعها ذلك من أن تتفاعل مع الحياة والناس بشكل تلقائي، وكيف أمسَتْ أسيرة قوالب فكرية وتنميطات أيديولوجية حالت بينها وبين التصرف بشكل صائب، وغدت بسبب ذلك أضحوكةً بين الناس، ومُضغةً في أفواههم، وشخصيات كاريكاتيرية جوالة، لا تُحسِن التواصُل مع الآخرين بشكل عفوي، أو تنظر إلى الحياة من منظور السلطة المهيمِنة فحسب.
وقد اعتاد كثيرٌ من أبطاله عيشَ حياتهم الرتيبة من دون أمل بإصلاحها، وهم يسعون لإحداث تغيير فيها أحيانًا لكن أحلامهم تتحطم على صخرة الواقع الصلبة، فإما أن يستسلموا لها مُكرَهين، أو يتابعوا المحاولة من دون أمل بإحداث ما ينشدونه من تغيير. وفي كثير من الأحيان يتخبط كثيرٌ منهم في محاولتهم للخلاص مما يعانونه، وحين يُخفِقون تجدهم قد عثروا على طريقة للتأقلم مع ظروفهم؛ إذ يحتضنون آلامهم، ويتحملون معاناتهم، ويقبلون بحياتهم الرتيبة بعد أن أخفقوا في تبديلها نحو الأحسن.
ثمة سخط على الواقع عند بعض هؤلاء الأبطال، وثمة احتجاج على ما يُبقيهم قانعين بظروفهم، واجدين أنفسَهم في محدودية الحياة المتوافرة بين أيديهم، كما نلحظ أن ثمة ضجرًا ورغبة عارمة في التفلت من الظروف التي تحيط بهم، ولكن كل ذلك يبقى في طور الممكن، ولا يتحول إلى واقع مُتحقق بسبب افتقار السياق الذي يحتضنهم إلى الظروف التي تساعد على ذلك.
مفهوم البطل
من الملحوظ أن البطل يكتسب في تجربة خطيب القصصية مفهومًا مُحددًا؛ إذ لم يعد البطل عنده هو البرجوازي الصغير، أو المتوسط، أو ما اصطُلِح على تسميته في الأدبيات الكلاسيكية بـ«الفرد الصغير»، بل غدا البطلُ هو المجنون، أو العاطل عن العمل، أو البائع، أو المزارع الجائع، أو الأجير، أو السائق، أو الوصولي، أو الانتهازي، أو الفهلوي، وبكلمةٍ مختصَرة أصبح المُهمش هو المحور في هذه التجربة، وشرع هذا البطلُ ينغمس في الحياة، ويتكيف مع الظروف الموضوعية مضطرًّا، ولم يعد صاحبَ أحلام عظيمة أو مثلٍ عليا، وإنما أصبح مجردَ شخصٍ مُحبَط، قانعٍ بواقعه، مندمجٍ مع محيطه، يُحسِن التكيف مع الظروف، ويعيش حياته يومًا بيوم، يرضى بالقليل، ويقبل ما هو مُتوافِر، يسعى وراء اللقمة فلا يجدها، ويرمح خلف السعادة فتهرب منه، يلازمه الشقاء أنى تحرك، أو حل، ويغرق في وحل الرتابة، والتفاهة، والنفاق، والكذب، والدناءة، والفجور، ويجد متعةً في الانصياع لما هو مطلوب منه؛ فيُنفذه وهو صامتٌ من دون أن يُعارِضه، أو يُبدِي رأيًا مُغايِرًا للآخرين فيه. حتى عندما يهجو خطيب البطل لقبوله بالتكيف مع الحياة، ولغرقه في بحر التفاهة والكذب والخسة والدناءة فإنه يُحسِن تحويله إلى نموذج محبوب، وهنا مكمنُ الخطر في ذلك؛ لأن الكذب يصبح عندئذٍ صفة جمالية مُستحسنَة لا مُستَقبَحة لدى القارئ كما هو الحال في مجمل القصص التي سردها في مجموعته القصصية «سيرة الحب».
في شعرية السرد
ما يُميز (خطيب) من غيره من كتاب القصة الساخرة في سوريا، أنه لا يجثم على صدور شخصياته، أو يقولها ما لا ينبغي لها قوله، ولا يُحركها كيفما يشاء إلا نادرًا، بل يُطلِقها في الحيز القصصي الذي يُشكله، ويُتِيح لها أن تتفوه بما لديها من منطوق لغوي طازَج وحار، من دون أن يُهيمِن عليها، أو يكتُم أنفاسها، بل يُتِيح لها أن تتكلم على سجيتها، كما في هذا المقبوس الذي يتحدث فيه زوج مع زوجته: «معك حق يا تقبشي عظامي، ولكن ماذا أعمل؟» (وقت لطلاق الزوجة، ص162)؛ أو هذا المقبوس الذي يستخدم فيه السارد كناية تشيع في الأحياء الشعبية: «كل واحدة فمها مثل دلو الطاحون». (عودة قاسم/72)؛ وهو لذلك ينتقي العبارات التي ترد على ألسنة شخصياته من الوسط الذي يتفاعل معه، ويتحرك فيه، ثم يُرخِي لها العِنان كي تتكلم بما تشاء، وتختار العبارات التي تريدها من دون افتعال أو إكراه، كما في هذا المشهد الحواري الذي يدور بين مجموعة من العمال حول ابن حيهم (قاسم ناصيف الحق) الذي أثرى، وتحول إلى متعهد، وصار يعاملهم باحتقار:
– شوفوا الكلب!
– العمى، ولا كاس شاي؟
– لك تفوه عليه، وعلى مصاريه معه!
ويلحظ المتلقي، في هذه القصة، أن ثمة هجاءً لاذعًا في قصص خطيب، وسخرية مُرة من كل ما يحول بين الإنسان والحياة، وتهكمًا مُبطنًا من كل ما طفا على سطح الحياة الاجتماعية، وفشَا، وهيمَن، وتسيد.
قد يعتمد خطيب في بناء قصصه على تراكم اللوحات والمقاطع، كما في مجموعته «سيرة الحب»، أو في قصص أخرى، «خالي بوفريد» نموذجًا، فضلًا عن أنه يستخدم العتبة النصية وسيلة استباقية في تشييد الدلالة التي يريد بثها في نسيج سرده، ومن أمثلتها استعارتُه بعضَ الأقوال المأثورة لـ(الأحنف بن قيس) و(أكثم بن صيفي) و(عمر بن الخطاب) في بناء المستوى الدلالي لقصتيه «عودة قاسم ناصيف الحق» و«زهرة التفتا».
 كما يستثمر الألقاب في تشكيل قصته «عودة قاسم ناصيف الحق»، ويعمد إلى اللعب بأسماء الشخصيات وتحويرها كوسيلة من وسائل بنائها، وتشكيل دلالتها؛ إذ يُمسِي اسمُ الحاج قاسم ناصيف الحق (مطيط) على سبيل السخرية والاستهجان، كما يغدو اسم تابعه (رمضان الهز)، أما العتال البسيط والفقير فيُطلق عليه في المتن الحكائي اسمُ (مسطرين) للإيحاء بدونيته وتسفله الاجتماعي. كما أن لقب (اللزقة)، الذي عُرِف به سمير عبدالحكيم في قصة «الأوراق مكشوفة»، ليس سوى دليل على أنه بقي عضوًا غير متناسِج في حزبه، وأنه لم يستطع أن يكون فاعلًا فيه، أو إيجابيًّا في أسرته شأنه في ذلك شأن (اللزقة) التي تبقى على سطح الجسد المريض أيامًا، ولكنها تبقى غريبة عنه، ولا تستطيع أن تكون جزءًا منه بسبب اختلاف نسيجها ومادتها عن نسيجه ومادته.
كما يستثمر الألقاب في تشكيل قصته «عودة قاسم ناصيف الحق»، ويعمد إلى اللعب بأسماء الشخصيات وتحويرها كوسيلة من وسائل بنائها، وتشكيل دلالتها؛ إذ يُمسِي اسمُ الحاج قاسم ناصيف الحق (مطيط) على سبيل السخرية والاستهجان، كما يغدو اسم تابعه (رمضان الهز)، أما العتال البسيط والفقير فيُطلق عليه في المتن الحكائي اسمُ (مسطرين) للإيحاء بدونيته وتسفله الاجتماعي. كما أن لقب (اللزقة)، الذي عُرِف به سمير عبدالحكيم في قصة «الأوراق مكشوفة»، ليس سوى دليل على أنه بقي عضوًا غير متناسِج في حزبه، وأنه لم يستطع أن يكون فاعلًا فيه، أو إيجابيًّا في أسرته شأنه في ذلك شأن (اللزقة) التي تبقى على سطح الجسد المريض أيامًا، ولكنها تبقى غريبة عنه، ولا تستطيع أن تكون جزءًا منه بسبب اختلاف نسيجها ومادتها عن نسيجه ومادته.
وفضلًا عن ذلك فـ(خطيب) يمتح لغته من معجم الناس اليومي، ويبتعد في ما يكتبه من الكليشيهات الممجوجة، والجمل الجاهزة المألوفة التي استُهلِكتْ من قبل غيره، وفقدت ألقَها وقدرتها على هز القارئ، وشحنه بالانفعالات الجمالية المطلوبة، كما في هذا المقبوس: «طز عليكِ يا حارة الشيخ منصور، طز على الفسفس والبق والنمل، طز على حوش الدواب المجاور لكل بيت سكن… طز على أفكارك التقدمية يا مصطفى العناد… أكنتَ تريدني أن أبقى هناك إلى الأبد؟ فشرْتَ». (عودة قاسم/58).
وهو يستقي تشبيهاته واستعاراته وكناياته ومجازاته من معجم الناس الحي، ومما يضج به الشارع والحياة من لغة طازجة حارة، ومن ذلك أيضًا هذا التشبيه الوارد على لسان الشخصية الرئيسة في قصة «الأنفاس الأخيرة»: «أخي سلطان حكى لي أن زوجته جعلته يُمضي ليلة مثل قفا الدست». (المصدر نفسه/69).
وينهج خطيب، في بناء سرده القصصي، نهجًا تقليديًّا في الأعم الأغلب، ولا يعمد إلى تكسير زمنه الحكائي، أو الخروج على عموده السردي إلا نادرًا، ولذلك لا يحدث أي انزياحٍ بين متن القصة ومبناها عنده إلا قليلًا، كما أنه يُحِيل أحيانًا في المبنى المتخيل إلى المرجع الخارجي مباشرة مما يخفف من قدرته على الأسطرة وإضفاء العجائبية على الحدث المسرود، كما يعمد، أحيانًا، إلى توشية السرد المباشر ببعض العبارات أو الكلمات العامية التي لا يجد في العربية الفصيحة ما يقابلها، أو ما يُفضي إلى التعبير عن دلالتها المقصودة بدقة، ومن ذلك هذه العبارة التي ترد على لسان إحدى شخصياته في قصته «شماتة»: «مستاهل! خرجه! الله لا يقيمه». (وقت لطلاق الزوجة/45).
ويستعين خطيب، في حواره وسرده، بكثير من الأمثال والحكم والأقوال المأثورة وأبيات الشعر والحوادث التاريخية من دون أن يُجري فيها أي تغيير، وتبقى هذه المقبوسات مجرد نصوص خارجية وعكازات دلالية يُستعان بها لتحديد المستوى الدلالي في المبنى الحكائي أو تأكيده؛ ولذلك تستعصي هذه المقبوسات على الذوبان في المبنى الحكائي للقصص، ولا تُصبِح جزءًا منه، وتبقى نافرةً في بنيته، وعصية على الامحاء في هيكليته، كما أنه يستثمر أحيانًا بعض النكات الشعبية المعروفة، أو يجعل قصصه تتعالق مع بعض حكايات جحا، إلا أن هذا التعالُق يبقى تعالُقًا شكليًّا، ولا يُفضِي إلى تغيير في بنية النكتة أو الحكاية، أو منحها دلالة جديدة تسوغ آلية التعالق التي نهضت عليها في المتن الحكائي، في حين أنه في قصة «صاحب الكشرة» أقام خطيب نوعًا من التناص مع «ألف ليلة وليلة»، واستلهمها في افتتاحيته السردية، وفي القالب السردي الذي اعتمده لصياغة قصته، واستطاع منحَ مبناه الحكائي دلالةً مغايرة للدلالة القارة في «ألف ليلة وليلة»؛ بحيث غدا تدجين المهر في قصته موازيًا لتدجين المواطن، وارتقى بالقصة إلى مصاف القصة الناجحة التي تنهض على المخاتلة والرمز.
مستويات اللغة
ومن الملحوظ أن خطيب ينهل من كنوز اللغة العامية، ويُطعم سرده بالاستعارات والكنايات والمجازات بأنواعها، ويُعِيد الاعتبار في أثناء ذلك لما أُهمِل منها أو هُجِرَ، ويُكسِبُه ألقًا ودلالة جديدة، ويحتفي بكثير مما يدور على ألسنة العامة من حِكم وأقوال مأثورة وعبارات مُغرِقة في العامية، ويجعلها تتماهى في نسيج سرده وتذوب فيه.
وعلى الرغم من أن التأمل في المشهد الحواري في قصصه يكشف عن أن اللغة التي تتكلم بها شخصياته مُوازِية للغة التي تتكلم بها في الواقع المرجعي الذي تُوهِم به القصصُ نفسُها، فإن كل ما في القصص مبني بناءً مُتعمدًا بقصد أن تكون القصصُ نفسُها مستقلة عن الواقع الذي تُوهِم به، وتُحِيل إليه، وبهدف أن تغدو قادرةً على أن تقف على قدميها من دون أن يحتاج القارئ للعودة إلى هذا الواقع نفسه بوصفه مُتخيلًا ومصنوعًا من الكلمات وليس حقيقيًّا. وهذا يعني أن الشخصيات المُصورة في قصصه تتكلم بهذه اللغة؛ لأن حياتها الفنية والسياق الذي تتحرك فيه والحافز الذي يُحركها هما اللذان أمليا عليها ذلك، وإنْ كان الكاتب قد جعلها تتكلم بلغة طازجة حارة تُنبِئ عن مستواها الاجتماعي، وتتناسب مع مستوى وعيها وفكرها، إلا أن ما تفوهتْ به ليس مُنبثِقًا من رغبة الكاتب في إنطاقها بطريقة مُعينة ووفق آلية محددة، بل إن وجودها الفني وتفاعُلها مع السياق الذي تحركت فيه هما اللذان أفضَيا بها إلى استخدام هذه اللغة دون غيرها، وهما اللذان أمليَا على الكاتب الآلية التي استعان بها لاستدعاء هذه المفردات دون غيرها أيضًا، ولا علاقة لرغبة الكاتب في الأمر؛ إذ إن عمله يتلخص في الاستجابة لما أملاه المنطق الفني وضرورة التشكيل الأدبي لا غير.

أحمد عزيز الحسين - ناقد سوري | مايو 1, 2020 | دراسات
يمكن تقسيم قصص الكاتب السوري جميل حتمل (1956- 1994م) لغاية الدرس النقدي إلى ثلاث مجموعات: تتكون الأولى من (25) قصة، وتتحدث عن وطن مفجوع ترك جروحًا غائرة وندوبًا مُدماة في نفوس مواطنيه، وجعل شخصياته المشروخة تواجه أزمات مصيرية تتعلق بكينونتها ووجودها وهُـويتها ومستقبلها، وتتكون الثانية من (29) قصة، وترصد مواقف هذه الشخصيات من هذه الأزمات، وكيف دخلت في صراع ضارٍ مع السلطة القامعة لتحقيق ذواتها، ومواجهة أزماتها، وكيف أفضى بها ذلك إلى السجن وتلقي مقادير لا تُحتَمل من العذاب النفسي والجسدي، وتتكون المجموعة الثالثة من (17) قصة، وتتناول ما آلت إليه مصاير هذه الشخصيات من خيبات وإحباطات بعد أن أفرجت عنها السلطة، وحكمت عليها بالنفي إلى أمكنة قصية وباردة وموحشة، وأفضت بها إلى الاغتراب والضياع، أو إلى الانتحار والموت.
ومن الممكن للقارئ المتمعن أن يلحظ أن ما سرده حتمل في قصصه كلها يشكل نتفًا من سيرته الذاتية، وفصولًا من حياة وطنه الصغير سوريا، ويسرد قصصًا ومتونًا مُنتقاة بعناية شديدة من مدونة اجتماعية وسياسية واقتصادية لهذا الوطن في شرط تاريخي معين، وظروف موضوعية محددة.
وحتمل يقتنص في الغالب حدثًا محددًا من الواقع، أو من التجربة التي عاشها، ثم يُدرِجه في حبكة محكمة البناء، ويمنحه بعد ذلك شكلًا محددًا يتناسب مع السياق الذي شكله، والبنية التي صاغها، ويميل في معظم ما كتبه إلى ترك نهايات قصصه مفتوحة كي يقوم المتلقي بإكمالها؛ فتغدو القصة فضاءً مفتوحًا لتعدد القراءات؛ إذ تُتيح خواتيمها السردية إمكانية الحوار المستمر مع القارئ، ومواكبة الواقع المرجعي الموار من حوله.
وقد لحظ الدكتور عبدالرحمن منيف، الذي قدم لمجموعة أعماله الكاملة، ما ينطوي عليه نتاجه من أهمية استثنائية لكونه يعطينا صورة عن طبيعة المرحلة التاريخية التي عاشها، وكتَب عنها، وهي المرحلة التي تعج بالهزيمة والأحلام المجهِضة والعذاب(١)؛ ولكونه يعكس تجربة صاحبه المريرة في الحياة، ويسجل شهادة على العصر العربي الصعب، بكل ما فيه من انكسارات وتحديات، واحتمالات أيضًا، وذكر أن جميل حتمل بمقدار ما هو فرد في تعبيره عن معاناته الشخصية، هو أيضًا نموذج لعدد غير قليل من أبناء جيله: جيل الأحلام الكبيرة والخيبات الأكبر، كما لحظ مدى علاقة هذا النتاج بالرواية، وكيف أن قصصه تُتابع عالمًا داخليًّا يكاد يكون واحدًا أو متشابهًا، وتعكس مناخات متقاربة، وتكاد تستقي مُعجمها اللغوي من مفردات تنهل من نبع واحد، وتصدر عن تجربة واحدة، وتواجه الهم نفسه في أغلب الأحيان، وسأله: لماذا لم يكتب رواية يمكن أن تعبر عن تجربته ومعاناته دفعة واحدة ما دامت الأجواء والشخصيات متقاربة إلى هذا الحد، ومسكونة بالهاجس نفسه؟ فأجاب بأن «الرواية حِمْلٌ لا أقوى عليه، ثم إن الرواية تحتاج إلى زمن قد لا أملكه!»(ح/ 10). وكان حتمل بذلك يضع الإصبع على ما آل إليه حاله من مصير مفجع وغربة قاتلة بعد نفيه عن وطنه، وكيف شكل ذلك ضربة قاصمة أصابت جسده وروحه في الصميم، وجعل إحدى شخصياته تهتف بقلب مُلتاع، وهي مُقصَاة عـن وطنها: «تعبتُ يا الله. وأريد أنْ أعود إلى مدينتي، أو إلى بيتي القديم. تعبتُ من المترو والأنفاق والوحدة، وبرد الشتاء الداهم، وحريق القلب الآخذ بالانطفاء. تعبتُ، وأريد كل مساء أن أهمس لابني بمساء الخير.
تعبْتُ؛ فأعدْني يا الله ولو جثةً…أعدني»(٢).
فكيف سرد حتمل وطنَه المعذب، وما الصورة التي قدمها لهذا الوطن؟
يلحظ القارئ المتمعن أن قصص حتمل تصور في المجموعة الأولى المشار إليها آنفًا، شخصيات هلامية مُفتتة دمرها الحزن، وقتلها اليأس؛ فاستسلمت لواقعها، وانصرفت إلى العويل والنحيب، وقد لاحق الكاتبُ تقزمَها أمام واقعها، واستسلامَها لسطوته وجبروته، وما آلت إليه من مصير قاسٍ ومؤلم، كما في قصة «درج الأيام المنفردة» التي يبوح فيها البطل بما لديه من عواطف وانفعالات معلنًا أنه يعيش «الانهيارات كاملة»، وأنه يكتب ليمنع نفسه من التلاشي، وهو يعترف بأن داخله مُنهَك ومكسور ومُمزق وبحاجة إلى حب وحنان، ولكنه لا يعثر على من يحتويه، أو يخفف من معاناته، فيبقى وحيدًا منفردًا وبلا أحد، يعاني من رماد الأيام ودخان القلب”(ح/78)، ويقرر الانتحار أخيرًا في هدأة الليل ردًّا على الضغط الذي يعاني منه، والكابوس الذي يجثم على صدره.
شخصيات تعاني الغربة
وفي قصة «لهذه الليلة فقط» ثمة شخص آخر يعاني من الغربة والوحدة والرطوبة، ويفتقر إلى حضور الآخر في حياته، ويتمنى لو يُتاح له التنعم بلقاء الآخرين، ونيل محبتهم، ولكن ذلك لا يحدث في الواقع، بل يبقى على صعيد التخيل والحلم لا أكثر. ويحلم شخص ثالث في قصة «وردة… وردة حمراء» بلقاء امرأة، وبعلاقة طيبة معها، وإهدائها وردة، ولكن هذه الأمنية تبقى حلمًا وأمنية، ولا يُتاح لها أن تتحقق؛ لأن المرأة ليست موجودة، وإنما هي مُتخيلة؛ ولأن الشخص نفسه مُفلِس، ولا يملك حتى ثمن وردة، وللتدليل على معاناته يجعله الكاتب يسكن في غرفة رمادية، وحارة موحِشة ومظلِمة، ويدل اللون الرمادي في القصة على خواء حياة البطل من العواطف والمشاعر الجياشة، ويرشح بالوحشة والغربة والوحدة، ويشير إلى حاجته إلى حبيبة تُدفئ قلبه، وإلى آخر يتواصل معه. ويُبدي الشخصُ نفسُه هنا كراهية شديدة لمدينته القانعة بحياتها الرتيبة المملة، ويهجو أناسها المحايدين غير المبالين.
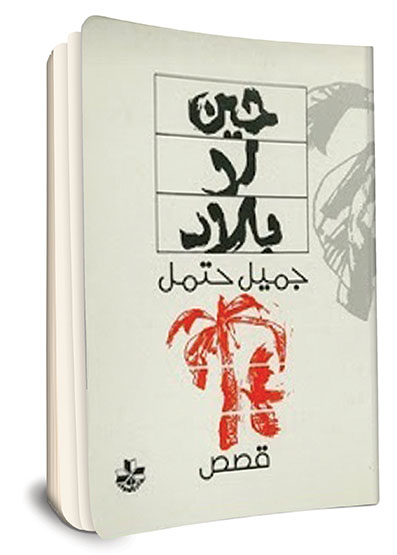 وفي قصة «جثة خامسة» ثمة إنسان شائه ضعيف، أيضًا، من دون اسم ولا عائلة ولا أصدقاء، يفتقر إلى علاقة عاطفية متوازنة مع الآخر، ويُقيم علاقة عابرة مع خمس نساء، ولكن لا يُتاح لأي منها أن تستمر، أو تنجح بسبب العطب الداخلي الذي تعاني منه النساء في القصة، ويبدو الوطن، الذي يسرده النص، عاجزًا عن إنتاج نماذج سوية ومتوازنة، ولذلك يؤول مصيرها إلى الانتحار والموت للخلاص مما تعانيه.
وفي قصة «جثة خامسة» ثمة إنسان شائه ضعيف، أيضًا، من دون اسم ولا عائلة ولا أصدقاء، يفتقر إلى علاقة عاطفية متوازنة مع الآخر، ويُقيم علاقة عابرة مع خمس نساء، ولكن لا يُتاح لأي منها أن تستمر، أو تنجح بسبب العطب الداخلي الذي تعاني منه النساء في القصة، ويبدو الوطن، الذي يسرده النص، عاجزًا عن إنتاج نماذج سوية ومتوازنة، ولذلك يؤول مصيرها إلى الانتحار والموت للخلاص مما تعانيه.
وفي قصة «انفعال» ثمة حلم ومناجاة داخلية يعبر فيها البطل عما يتمناه من خلال الاتكاء على تقنية الاستشراف، وينتقل الكاتب بمهارة من ضمير المتكلم، الذي يعتمده لعقد ميثاق مع المتلقي، والإيحاء بأنه يروي بصدق بعضًا من سيرته الذاتية، ولا يلبث بعد ذلك أن ينتقل بحسن تخلص من تقنية الاستشراف إلى السرد بضمير الغائب، وهكذا يحدث نوع من التداخل والمزج بين ما يقوله السارد المشارِك «الذي يتكئ على ضمير المتكلم لتحقيق استشرافه للمستقبل»، وما يقوله الراوي العليم، الذي يعتمد على ضمير الغائب، ليؤكد لنا أن ما يهجس به السارد المشارك مستحيل التحقيق. والقصة تخلو من أية مفاتيح سردية دالة تشي بعملية الانتقال بين المستويين السرديين، وترشح بقدرة الكاتب على الإمساك بدفة السرد وعدم التدخل في السياق. ومع أن الكاتب اعتمد على الأسلوب المباشر الحر لعرض مناجاة بطله، ووضع هذه المناجاة ضمن علامة تنصيص للتأكيد على أمانته في نقلها، إلا أنه حذف العلامة نفسها بعد الانتهاء من عرض «المناجاة»، وداخَل بين صوت البطل «السارد المشارك» وصوت الراوي العليم عندما انتقل بمهارة من موقع سردي إلى آخر، ومن صوت البطل «السارد المشارك» إلى صوت الراوي العليم. وقد أحدث انتقاله بين الموقعين السرديين نوعًا من الصدمة للمتلقي، الذي أدرك وجود مفارقة واضحة بين ما يهجس به البطل من أحلام وما يعيشه من معاناة مُرة، إذ ليس حلمه بمن يحب سوى نوع من التخيل والهذيان الذي يصحو منه بإدراك الحقيقة المرة التي يعيشها وهي أنه وحيد ومغترِب ومُتعَب، ولذلك يفتح باب غرفته الرمادية، و«يدخل متراخيًا ويرتمي على السرير القديم، ويُسنِد رأسه إلى ذراعيه النحيلتين، ويهتز في نشيج متواصل»(ح/74).
غرفة بأطراف مدينة لا اسم لها
وفي قصة «رنين» ثمة شخصية مُهمشة وضعيفة أيضًا، تُقيم في غرفة بـأطراف مدينة ليس لها اسم، مع ما لذلك من دلالة على إلغاء كينونتها وهُويتها الفردية، وتعاني الشخصية في المتن الحكائي من الرتابة والكآبة، وتستسلم بشكل آلي لقوة متعالية تتحكم بحياتها، وتجعلها عجينة طيعة في يدها تفعل بها ما تشاء، وليس لهذه القوة هُـوية اجتماعية أو سياسية محددة، وإنما هي أداة لإصدار الأوامر الصارمة ليس إلا. ومن الملحوظ أن القوة المذكورة تتحكم بحياة الناس، وأن الناس يخضعون لها من دون قدرة على المقاومة.
وفي «قصة عن فلاح… أي فلاح»، ثمة، أيضًا، نماذج مختلفة لوطن منخور تهيمن عليه سلطة شمولية عاتية، وتُفلح في تحويل إنسانه الطيب المتواضع إلى امتداد قاهـر لها، وفي «أصابعها تلك» يهجس البطل بماضٍ جميل لم يعد موجودًا، وبحبيبة هجرته عند مفترق شارع ولم تقل وداعًا. ويختلط في القصة الواقع بالحلم، والمعيش بالمتخيل، ونكتشف من الخاتمة السردية أن الحبيبة التي يتخيل البطل وجودها في حاضره للتعويض عن الحرمان الذي يعاني منه ليست موجودة، وأن الحوار الذي يُجريه معها يتم في الحلم لا في الواقع، وهذا يدل على توحد الشخصية وغربتها، وانقطاع الصلة بينها وبين الفضاء الاجتماعي الذي يُحيط بها؛ ويُحول القصة إلى مفارقة مبكية وسخرية سوداء من واقع مُر لا منجاة من سطوته، والهرب منه.
ويبدو البطل في قصة «برد الأيام الماضية… برد الأيام الآتية» عاجزًا عن الحب هو الآخر، وغير قادر على الاستمتاع بلحظة سعادة أُتِيحت له مع حبيبته، وينتهي إلى البكاء بدلًا من الفرح حين يُتاح له الاقتراب منها، ولا يبدو الحزن في القصة مُسوغًا، أو له أسباب منطقية في المتن الحكائي، وإنما يتجلى صفة ملازمة للبطل منذ أن ولد شأنه في ذلك شأن كثير من أبطال حتمل، ولعل هذا هو الذي دفع عبدالرحمن منيف إلى وصف حتمل بأنه «أمير للحزن»(ح/8): حزنه، وحزن شخصياته، وحزن الآخرين.
ويُصور الهجر والفراق في قصة «النبتة» على أنه يباس وموت، كما يغدو الآخر – أو المحبوب – هو الحياة ذاتها، ولا حياة ندية من دونه، وتنهض بنية القصة على التوازي بين النبتة المقطوعة من جذورها وبيئتها، والبطل المنبت عن جذوره ووطنه، ويغدو موت النبتة في القصة معادلًا موضوعيًّا لموت الحبيب، وترميزًا فنيًّا موحيًا لتشظي وطن، وموت كل ما يُفضِي إلى توهج المشاعـر المتأججة فيه، وتعكس قصة «ألوانه حقًّا» حضور الأب الفنان في حياة السارد الشاب الذي استعان بضمير المتكلم لجعل الواقع امتدادًا للحلم، وإلغاء الحدود الفاصلة بينهما في لعبة سردية ذكية، وقد اعتمد الكاتب في بناء تقنية الحلم على تقنية الاستشراف اللغوي للدلالة على إمكانية تحول الحلم إلى حقيقة وواقع موضوعي يمكن الإمساك به.
وتُقيم قصة «بيت طيني في حي العمارة» نوعًا من التوازي بين قطبين مُتضادين مكانيًّا واجتماعيًّا، ويتكئ الكاتب في بناء قصته على الوثيقة لتأسيس نوع من المفارقة والتضاد بين الاسم الذي يحمِله البطل في القصة وهو سعيد الفرحان، وما يؤول إليه حاله في الواقع من فجيعة ومصير مؤلم، إذ إن المتن الحكائي يؤكد أن البطل خرج من النص مقهورًا وحزينًا ومُشردًا مع أن اسمه سعيد الفرحان، كما أن اسم المكان في النص، وهو حي العمارة، يرشح بالبناء والارتقاء إلى أعلى، ويفترض أن يصل بصاحبه إلى تحقيق ذاته، ويساعده في المحافظة على كينونته، مع أنه في القصة انتهى مُهمشًا ومطرودًا، ومن دون بيت يحميه من التشظي الذي آل إليه في الخاتمة السردية للقصة.
الهلع من السلطة القامعة
وتتحدث قصة «الخال ابن ستي نصرة» عن والد لديه ابنان: واحد يُستَشهَد في سبيل الوطن، والثاني يُوضَع في السجن، ويُعذب إلى أن يموت مما يُفضِي بوالده إلى الهلوسة والجنون، وتعكس القصة هلع الشخصية من السلطة القامعة، وخوفها من حضورها الطاغي، وتشي بوجود سلطة تحولت إلى قوة قامعة تتحكم بحياة الناس، وتزرع فيهم الهلع والرعب أينما حلوا وكيفما تحركوا؛ بحيث لا يجرؤ أحدهم على التفوه بكلمة ضدها، أو بالاعتراض على ما تقوله لهم، أو تفعله بهم، وتبدو السلطة في القصة قوة قمع مفارقة للكون تتحكم بمصاير البشر، وتُسيرهم من دون أن يكون لها تجل نصي في الغالب، أو نموذج مُشخص يرمز لها، أو صوت يمثلها في المتن الحكائي.
وليس هناك مقاربة تفصيلية لحياة السجين عند حتمل، أو تصوير فني متعمق لهذه الحياة، وإنما هناك إشارة خاطفة إلى التأثيرات التي تركتها تجربة السجن في حياته على المستويين الجسدي والنفسي. ويبدو السجين عند حتمل شخصية مُسطحة تفتقر إلى العمق، أما السجان فهو آلة قمع وحسب، إنه مجرد حواس مُوظفة لخدمة السلطة التي تقتصر على مراقبة ما هي مُكلفة به من تفاصيل يومية في حياة السجين، ولا تقع عيناها إلا على ما يتطلبه عملها من دأب وحرص على المتابعة، ولا تسمع إلا ما يمكن أن يجعلها امتدادًا كابحًا للسلطة وأداة طيعة في يديها، ولذا لا يبدو لنا السجان في نصوص حتمل كائنًا بشريًّا عاديًّا يعاني ويتعذب، وله مشكلات حياتية شأنه في ذلك شأن البشر العاديين، وإنما يبدو متعاليًا فوقه، ومنتميًا إلى السلطة الضارية لا إلى الناس.
وتسرد لنا «قصة ربما كتبها آخرون» حال امرأة تُضطر على الرغم من حبها لحبيبها الشهيد، إلى التخلي عنه واستبدال آخر به بعد أن تغير كل شيء في الوطن، وجعل من استمرار حبها له غير ممكن، أو من تمسكها بالوفاء له مستحيلًا؛ فالوطن الذي واجه العدو، وهُـزِم ضده في المتن الحكائي للقصة، ما لبث أن أبرم معاهدة معه، وصار صديقًا له، وأصبح من المستحيل على الحبيبة الاحتفاظ بوفائها لحببيها الشهيد بعد أن دمر الوطن النصي معنى شهادته، وغدا من المستحيل على هذا المعنى أن يستمر في الوطن الجديد الذي عقد مصالحة مع قاتل شهدائه، وساحق مواطنيه.
وتنهض قصة «الوقت باكر جدًّا» على المفارقة المؤلمة الواخزة، وترصد مصيرًا مفجعًا لأرملة بطل استُشهِد في سبيل الوطن، لكن قادته ومسؤوليه الكبار حولوها إلى امرأة عاهر لهم، وأخذوا يلِغُـون في جسدها كل مساء، وقد رصد النص، من خلال متابعة ما آلت إليه السيدة، مصيرَ المرأة، ومن خلالها مصير الوطن في ظل سلطة لا ضمير لها ولا قِيم، وحرص الكاتب على تسمية الشخصية النسائية في القصة بـ«السيدة نهى»، لا لكي يُكسبها ذاتًا مُحددة، ويعترف بكينونتها، وإنما ليُشير إلى أن لقب «السيدة» الذي أخذت تُعرَف به في الحي الراقي الذي تقطنه، ويُطلَق عليها من قبل جيرانها، إنما هو سخرية مُبطنة من ارتقائها المريب، وأداة للنيل ممن حولها إلى عاهرة، ودليل ساطع على هجائها، وهجاء المرحلة التي جعلتها تبيع جسدها لضباط الوطن ومسؤوليه الكبار مع أنها امرأة شهيد ضحى بروحه في سبيل الوطن.
وقد حرِص الكاتب في هذا القسم من القصص على تحريك بطله ضمن فضاء محدد هو الشارع، أو المقهى، أو الرصيف، أو البيت، وجعله يسكن في غرفة تحت درج، أو في قبو، أو على سطح بناية، وأبقاه مفتقرًا إلى المكان الحميم الدافئ، ومُصطلِيًا العذاب والوحشة في الأقبية الباردة والأنفاق والغرف الصغيرة الرطبة، كما جعله يشعر بحاجة ماسة إلى أسرة وحبيبة وأصدقاء وأهل ليدفعوا عنه الشعور بالوحشة والاغتراب، ويمنحوه العواطف الجياشة الحارة التي يحتاج إليها، كما أنه أهمل في هذا القسم أيضًا رسم شخصياته من الخارج، وأبقى ملامحها غير مُشخصة، وجعلها غالبًا من دون اسم تُعرَف به للتدليل على افتقارها إلى هُـوية تميزها، وكيان يحميها من الامحاء في الآخر، فإنْ أطلق عليها، أحيانًا، اسمًا مُحددًا فإنه يُبقيها من دون عائلة تُعـرَف بها، أو جذر اجتماعي تنتسب إليه للتأكيد على غربتها وضعفها وإمكانية تعرضها للتلاشي، وهو يميل أحيانًا إلى ذكر المهنة التي تعتاش منها، أو العمل الذي تمارسه، أو الوظيفة التي تشغلها لوضع اليد على ما يساعدها في تحقيق ذاتها، وحفظ كينونتها، كما أنه يحرص في بناء قصته على وصف المكان الذي تُقيم فيه مما يساعد المتلقي على فهم مُسوغات غربتها، ووقوعها فريسة للاكتئاب والوحدة؛ فالمكان إما أن يكون طرفيًّا واقعًا في ضواحي المدينة، أو غرفة باردة على سطح بناية أو ما يماثلها، وفي كل الحالات لا يساعدها هذا المكان على الاحتماء من خطر الخارج، ولا يوفر لها الملاذ الآمن والحميم الذي يُشعرها بأنها في مكان أليف يمكن أن يحميها من التفتت.
فضاء انتقالي
فالبطل في قصة «برد الأيام الماضية… برد الأيام الآتية» يفتقد المكان الذي يوفـر له لحظة هناء وسعادة في حياته؛ لأنه مُخترَق من قبل الآخرين، ولا تتوافر فيه شروط الأمن والحماية والطمأنينة، وهو غرفة طينية يشاركه فيها نزلاء آخرون، وأما الشارع الذي يمكن أن يلتقي فيه حبيبته فهو فضاء انتقالي يسمح له بلحظة لقاء عابرة لا دائمة، وحين يلتقي البطل حبيبته في غرفتها بعد جهد ومشقة لا يستطيع استثمار اللحظة المتاحة له، والمكان المتوافر بين يديه، ويمنعه الحزن الثاوي في صدره من ذلك؛ فينصرف إلى البكاء بحرقة وحزن بدلًا من الاستمتاع بلقاء حبيبته التي كان ينتظرها.
والكاتب يُمايز في قصصه أحيانًا، بين صوت السارد وصوت الشخصية، ويجعل للشخصية ملفوظًا لسانيًّا ومنطوقًا مغايرًا للغة السارد الذي يتكئ على ضمير المتكلم أو الغائب في سرده للحدث. ويعمد أحيانًا إلى إفساح المجال لشخصياته كي تتكلم مباشرة من دون وسيط ظاهر بينها وبين المسرود له، معتمدًا في ذلك على تقنية المشهد، موهِمًا القارئ بأن ما تنطق به الشخصية قد تفوهت به فعلًا بعبارات عامية وردت على ألسنة أصحابها، وهو نوع من الوفاء لخطاب الشخصية التي توهم المتلقي بأنها تستمد لغتها من مرجع واقعي حي لا دور للكاتب في صياغته وتشكيله. ومن أمثلة ذلك هذا الحوار بين الولد وخاله في قصة «لسان أم ثلجة»:
خالي… خالي… لماذا اسمها أم ثلجة؟
العمى… اتركني أنام(ح/200).
وهذا يُفضي بنا إلى أن هناك مستويين لاستخدام اللغة في نسيج القصة عند حتمل: الأول هو لغة السارد الذي يتخفى الكاتب وراءه، والثاني هو لغة الشخصية التي تعكس في استخدامها للغة مستوى وعيها والوسط الاجتماعي الذي تتحدر منه، أو تنتمي إليه. والكاتب يُقيم نوعًا من التناوب السردي بين صوت السارد وصوت الشخصية أحيانًا، ويجعل كلا منهما يعبر عن مستوى وعي ومنظور سردي مغاير للآخر. كما أنه في أحيان أخرى يُقيم نوعًا من التماهي بين صوت البطل وصوت السارد المشارك، كما في قصة «درج الأيام المنفردة»، ومن الملحوظ أن الحمولة المعرفية لصوت السارد المشارك في هذا النص تتجاوز قدرته على المعرفة، كما تتجاوز الموقع السردي الذي يتبوؤه هذا السارد للولوج إلى وعي البطل، والنفاذ إلى ما يهجس به من أحلام، وما يكتنزه من انفعالات ورغبات. ويبدو الانتقال في القصة من موقع السارد المشارك إلى موقع الراوي العليم محكومًا بتدخل الكاتب ومعرفته وهيمنته على حركة السرد، ولا يتم هذا الانتقال بشكل عفوي بل من خلال الاستعانة بوضع ثلاثة مربعات تشكل تقنية طباعية تفصل بين صوت السارد المشارك وصوت الراوي العليم(ح/101)، في حين يتم هذا الانتقال في قصص أخرى من دون الاستعانة بمفاتيح سردية دالة، أو تقنيات طباعية، وهو تخل أملته رغبة الكاتب في تسهيل فعل القراءة والتلقي.
لقد قُدم الوطن في القصص السابقة فضاءً قامعًا للرأي، كابحًا للرغبات، قاتلا للأحلام، لا مجال فيه لحياة حرة كريمة، أو لحياة عاطفية متوازنة، وقد سرد الكاتب فيه من الوقائع ما يدل على أن المرأة فيه مُستباحَة الجسد، وأن أفراد الأسرة فيه معزولون عن بعضهم بعضًا، وأنه وطـن هـش تهيمن عليه سلطة عاتية لا تُقيم لمواطنيه شأنًا، وتعدهم رعايا وأرقامًا لا حق لهم في اختيار الحياة التي يعيشونها، أو الفكر الذي يعتنقونه؛ ولذا غدا من السهولة على هذا الوطن أن يقع فريسة للأمراض الاجتماعية والنفسية الفتاكة، وأن يُهزَم في أية مواجهة مع أعدائه المتربصين به، سواء أكانوا قادمين من الخارج أم قابعين في الداخل بانتظار الفرصة السانحة للوثوب عليه.
هوامش:
١) انظر: مقدمة لـ (المجموعات القصصية الخمس): جميل حتمل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، ط1، 1998م، ص 6، وسوف أكتفي في المتن بالإحالة إلى هذه الطبعة ورقم الصفحة مسبوقًا بالحرف (ح).
٢) المصدر السابق نفسه (المقبوس مثبت على الغلاف).

 وقد اكتشف في دمشق، بعد أن تنامى وعيُه بسبب القراءة، قسوة العوز والحرمان الذي عاشه مع أهله في الحماد، وعاشه أضرابُه من الصبيان مع أسرهم، كما تبين له أن هناك قوة عاتية تُمسِك بدفة القدر، وتُوجهها لمصلحتها الخاصة، وسعى للخلاص من الشبكة التي كان يتخبط فيها، وكادت تُطبِق عليه، وتبين له أن السبيل الوحيد للخلاص مما هو فيه أن يعبر الحدود إلى بيروت، التي كانت وجهتَه الممكنة للوصول إلى الحرية، وبناء الهُوية، وتحقيق الذات، والخلاص من إسار القهر والظلم والحرمان الذي كان يرسف فيه.
وقد اكتشف في دمشق، بعد أن تنامى وعيُه بسبب القراءة، قسوة العوز والحرمان الذي عاشه مع أهله في الحماد، وعاشه أضرابُه من الصبيان مع أسرهم، كما تبين له أن هناك قوة عاتية تُمسِك بدفة القدر، وتُوجهها لمصلحتها الخاصة، وسعى للخلاص من الشبكة التي كان يتخبط فيها، وكادت تُطبِق عليه، وتبين له أن السبيل الوحيد للخلاص مما هو فيه أن يعبر الحدود إلى بيروت، التي كانت وجهتَه الممكنة للوصول إلى الحرية، وبناء الهُوية، وتحقيق الذات، والخلاص من إسار القهر والظلم والحرمان الذي كان يرسف فيه.
 يرصد خطيب بدلة التشوهات التي أصِيبَتْ بها شخصياتُه، ويضع يدَيْ قارئِه على الزيف الذي غدا سمة جوهرية لها، والمآلِ الذي وصلتْ إليه من خلال تسفلها، وقَبُولِها بأنْ تكونَ منحطةً ومُتحللة، وسعيدةً بما وصلت إليه من تفسخ وتعفن، أو جنونٍ وتهميش، فضلًا عن أنه يتابع بدأب وتقصٍّ ما لحِق بها من ندوب اجتماعية، وانحرافات أخلاقية، ويُلاحِق انعكاسَ ذلك على تصرفاتها وتقويماتها الجمالية للواقع، وكيف أفضى بها ذلك إلى أن تقبل بالتلون والنفاق و«تمسيح الجوخ» على أنه شكل من أشكال تكيفها مع واقعها، وآلية لتماهيها معه، ولو أفضى بها ذلك إلى إحداث تبدلات جوهرية في سماتها، وهُويتها، وآلية استجابتها لواقعها.
يرصد خطيب بدلة التشوهات التي أصِيبَتْ بها شخصياتُه، ويضع يدَيْ قارئِه على الزيف الذي غدا سمة جوهرية لها، والمآلِ الذي وصلتْ إليه من خلال تسفلها، وقَبُولِها بأنْ تكونَ منحطةً ومُتحللة، وسعيدةً بما وصلت إليه من تفسخ وتعفن، أو جنونٍ وتهميش، فضلًا عن أنه يتابع بدأب وتقصٍّ ما لحِق بها من ندوب اجتماعية، وانحرافات أخلاقية، ويُلاحِق انعكاسَ ذلك على تصرفاتها وتقويماتها الجمالية للواقع، وكيف أفضى بها ذلك إلى أن تقبل بالتلون والنفاق و«تمسيح الجوخ» على أنه شكل من أشكال تكيفها مع واقعها، وآلية لتماهيها معه، ولو أفضى بها ذلك إلى إحداث تبدلات جوهرية في سماتها، وهُويتها، وآلية استجابتها لواقعها. يستقي خطيب شخصياته ممن عاشوا في القاع، ويلاحق حياتهم اليومية، ويرصد صراعهم في سبيل حياة كريمة، مُتِيحًا لنا الفرصةَ لنستمع إليهم، وهم يتكلمون بلغتهم الشعبية الحارة الطازجة، راصدًا من خلال ذلك أنماط سلوكهم، وآلية مواجهتهم للحياة، والسبل التي انتهجوها في سبيل ذلك، كما أنه يُحسِن تسليط الضوء على الحياة المُبتَذلة لهذه الشخصيات، وعلى ما تعانيه من فقر روحي ومعرفي، وخواء وجداني وعاطفي، ويدفع بالقارئ إلى الضحك منها، والتهكم عليها، كما في قصته «الشيخ شادي» التي يُضطر فيها البطلُ إلى أن يكون قارئَ رملٍ ومنجمًا لكي يستطيع العيش في مجتمعٍ قاهرٍ لا يترك لشرفائه مجالًا لحياة كريمة تنهض على الصدق والعمل النزيه، ويجعلهم يسلكون سبلًا ملتوية لفعل ذلك. (وقت لطلاق الزوجة/ 207-212)
يستقي خطيب شخصياته ممن عاشوا في القاع، ويلاحق حياتهم اليومية، ويرصد صراعهم في سبيل حياة كريمة، مُتِيحًا لنا الفرصةَ لنستمع إليهم، وهم يتكلمون بلغتهم الشعبية الحارة الطازجة، راصدًا من خلال ذلك أنماط سلوكهم، وآلية مواجهتهم للحياة، والسبل التي انتهجوها في سبيل ذلك، كما أنه يُحسِن تسليط الضوء على الحياة المُبتَذلة لهذه الشخصيات، وعلى ما تعانيه من فقر روحي ومعرفي، وخواء وجداني وعاطفي، ويدفع بالقارئ إلى الضحك منها، والتهكم عليها، كما في قصته «الشيخ شادي» التي يُضطر فيها البطلُ إلى أن يكون قارئَ رملٍ ومنجمًا لكي يستطيع العيش في مجتمعٍ قاهرٍ لا يترك لشرفائه مجالًا لحياة كريمة تنهض على الصدق والعمل النزيه، ويجعلهم يسلكون سبلًا ملتوية لفعل ذلك. (وقت لطلاق الزوجة/ 207-212) كما يستثمر الألقاب في تشكيل قصته «عودة قاسم ناصيف الحق»، ويعمد إلى اللعب بأسماء الشخصيات وتحويرها كوسيلة من وسائل بنائها، وتشكيل دلالتها؛ إذ يُمسِي اسمُ الحاج قاسم ناصيف الحق (مطيط) على سبيل السخرية والاستهجان، كما يغدو اسم تابعه (رمضان الهز)، أما العتال البسيط والفقير فيُطلق عليه في المتن الحكائي اسمُ (مسطرين) للإيحاء بدونيته وتسفله الاجتماعي. كما أن لقب (اللزقة)، الذي عُرِف به سمير عبدالحكيم في قصة «الأوراق مكشوفة»، ليس سوى دليل على أنه بقي عضوًا غير متناسِج في حزبه، وأنه لم يستطع أن يكون فاعلًا فيه، أو إيجابيًّا في أسرته شأنه في ذلك شأن (اللزقة) التي تبقى على سطح الجسد المريض أيامًا، ولكنها تبقى غريبة عنه، ولا تستطيع أن تكون جزءًا منه بسبب اختلاف نسيجها ومادتها عن نسيجه ومادته.
كما يستثمر الألقاب في تشكيل قصته «عودة قاسم ناصيف الحق»، ويعمد إلى اللعب بأسماء الشخصيات وتحويرها كوسيلة من وسائل بنائها، وتشكيل دلالتها؛ إذ يُمسِي اسمُ الحاج قاسم ناصيف الحق (مطيط) على سبيل السخرية والاستهجان، كما يغدو اسم تابعه (رمضان الهز)، أما العتال البسيط والفقير فيُطلق عليه في المتن الحكائي اسمُ (مسطرين) للإيحاء بدونيته وتسفله الاجتماعي. كما أن لقب (اللزقة)، الذي عُرِف به سمير عبدالحكيم في قصة «الأوراق مكشوفة»، ليس سوى دليل على أنه بقي عضوًا غير متناسِج في حزبه، وأنه لم يستطع أن يكون فاعلًا فيه، أو إيجابيًّا في أسرته شأنه في ذلك شأن (اللزقة) التي تبقى على سطح الجسد المريض أيامًا، ولكنها تبقى غريبة عنه، ولا تستطيع أن تكون جزءًا منه بسبب اختلاف نسيجها ومادتها عن نسيجه ومادته.
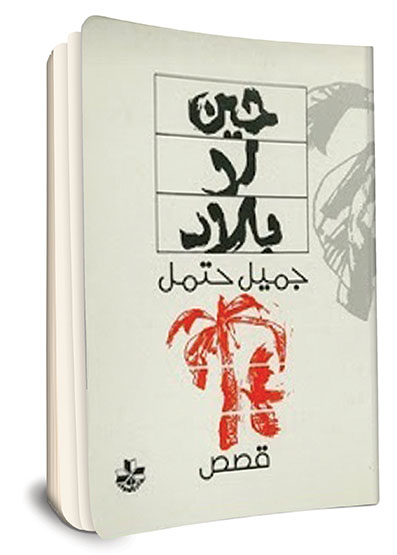 وفي قصة «جثة خامسة» ثمة إنسان شائه ضعيف، أيضًا، من دون اسم ولا عائلة ولا أصدقاء، يفتقر إلى علاقة عاطفية متوازنة مع الآخر، ويُقيم علاقة عابرة مع خمس نساء، ولكن لا يُتاح لأي منها أن تستمر، أو تنجح بسبب العطب الداخلي الذي تعاني منه النساء في القصة، ويبدو الوطن، الذي يسرده النص، عاجزًا عن إنتاج نماذج سوية ومتوازنة، ولذلك يؤول مصيرها إلى الانتحار والموت للخلاص مما تعانيه.
وفي قصة «جثة خامسة» ثمة إنسان شائه ضعيف، أيضًا، من دون اسم ولا عائلة ولا أصدقاء، يفتقر إلى علاقة عاطفية متوازنة مع الآخر، ويُقيم علاقة عابرة مع خمس نساء، ولكن لا يُتاح لأي منها أن تستمر، أو تنجح بسبب العطب الداخلي الذي تعاني منه النساء في القصة، ويبدو الوطن، الذي يسرده النص، عاجزًا عن إنتاج نماذج سوية ومتوازنة، ولذلك يؤول مصيرها إلى الانتحار والموت للخلاص مما تعانيه.