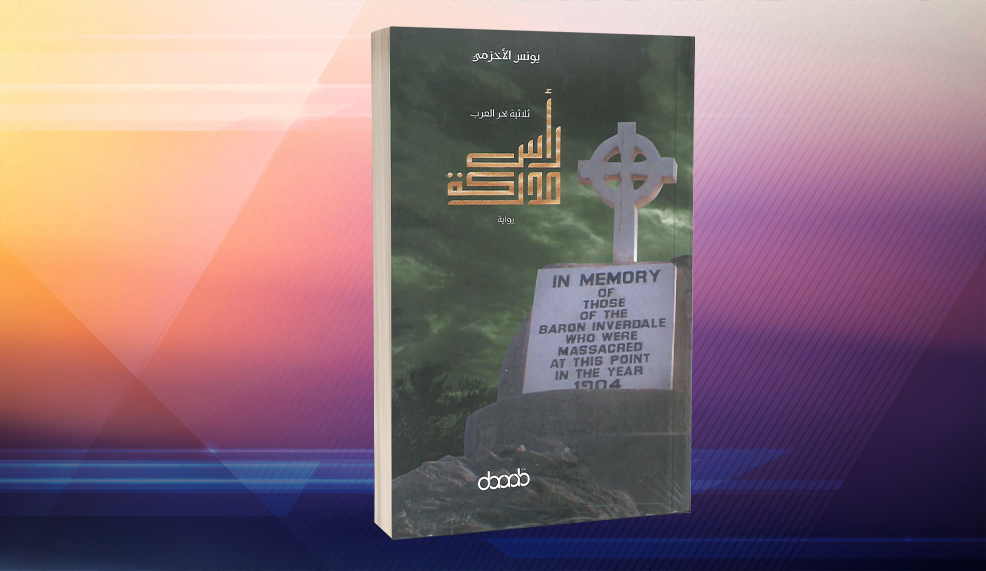هيثم حسين - كاتب سوري | يناير 1, 2023 | مقالات
يحكي الروائي النمساوي بيتر هاندكه في روايته «عن عاشق الفطر» حكاية شخص يعشق الفطر ويبحر في ثنايا شغفه الذي يقوده في رحلته الحياتية، ويرسم له ملامح أيامه ومعالم أمكنته، بحيث لا يتخيل لنفسه وجودًا من دونها، وكأنها كائنات تعيش معه وبداخله، يقترب منها وينسج معها علاقات غرائبية.
الراوي العليم في رواية هاندكه القصيرة (ترجمة علا عادل، دار صفصافة، القاهرة) يسرد حكاية صديقه عاشق الفطر الذي كان معه منذ طفولته حتى حين أصبح محاميًا وربًّا لأسرة صغيرة، وكيف أنه بقي أسير شغفه بالفطور وعشقه السحري لها. هي حكاية صداقة متعددة الوجوه والجوانب، صداقة الإنسان مع الطبيعة من جهة ومع عصره من جهة ثانية، صداقات عابرة للأزمنة والأمكنة، قوامها الشغف والجنون.
بحثًا عن كنز مفقود
يقول الراوي غير المسمّى: إن صديقه كان عاشقًا للفطر منذ وقت طويل للغاية، حتى وإن كان بمفهوم آخر عن أعوامه اللاحقة أو المتأخرة، لم ترد عنه حكاية بوصفه مهووسًا وتلفت الانتباه إلا مع بلوغه الكِبر. يتساءل: لِمَ يُكتَب عدد قليل عن حكايات عُشاق الفطر بصفة عامة أو حتى بشكل استثنائي؟ ويلفت إلى أنه لم تلعب أنواع الفطر دورًا يُذكر في أي كتاب في الأدب العالمي في القرن التاسع عشر تقريبًا، وإن حدث فإن دورها كان صغيرًا يمر مرور الكرام ومن دون علاقة بالبطل أيّما كان، حيث كانت موجودة لذاتها مثلما الحال لدى الكاتبين الروسيين دوستويفسكي وتشيخوف.
يعود الكاتب براويه إلى الزمن الجديد، أو ما يسميه «زمننا»، حيث يبدو أن الأعمال الروائية تتراكم بشكل ملحوظ، ولا سيما تلك التي يزداد فيها ظهور أنواع الفطر في دور كائنات مخيفة في العالم سواء كأدوات للقتل أو وسائل لما يصفه بتوسيع الإدراك. ويقول: إن الحكاية بدأت بالمال قبل وقت طويل عندما كان الذي سيصبح عاشقًا للفطر لا يزال طفلًا صغيرًا.. بدأت بالمال الذي كان الطفل آنذاك في حاجة إليه حتى وهو نائم حيث كانت العملات المعدنية تلمع طوال الليل بكل السبل، ليتبين بعد ذلك أنها لم تكن مالًا، وبدأ بالمال الذي لم يملكه في الليل أو النهار كالمعتاد. وحقيقة أنه كان ينظر إلى الأرض في أَسًى وحزنٍ طوال اليوم وأينما ذهب أو وقف لم يكن لها تفسير سوى أنه كان يحدق نحو قدميه بحثًا عن شيء له قيمة.. عن كنز مفقود.
يمضي في التساؤل عن واقعه المأزوم، وهو يعكس واقعَ كثيرٍ من الأطفال في أزمنة وأمكنة مختلفة من العالم، ويذكر أن صديقه كان يسعى للمال وهو طفل؛ لأنه من المؤكد كان يريد شراء شيء ما. والإمكانية الوحيدة للحصول على وسيلة الدفع الضرورية تلك كانت وفقًا للشروط التي نشأ فيها في زمنه هي جمع الثمار، ثمار الغابات مثل أنواع التوت البري وجمع أنواع الفطر ومنها الأصفر تحديدًا، الذي كانت أسماؤه تختلف من بلد لآخر، حيث كانت أنواع الفطر هي السلعة التجارية الوحيدة وقتها إلى حد ما. ثم يسرد بعض التطورات التي تطرأ على حياة عاشق الفطر التي تتسم بالاختفاء والظهور، وكيف أنه في لحظة ما كان قدره منذ أن كان صغيرًا هو البحث عن الكنوز أو أنه خُلِق لذلك، بحسب تعبيره.
يسترسل هاندكه في روايته ليشرح كيف أن شغف بطله فجأة شَفاه مما أطلق عليه «مرضي بالوقت» ويبدو أن شفاءه لم يكن ظاهريًّا فحسب، فقد انتقل الشعور بالزمن المتعافي بفضل الشغف لمدة إلى حياة يومية كانت بالنسبة له سابقًا عبارة عن ساعات تأبى على النهاية.. حياة متعبة ومقفرة تمامًا في لحظات بعينها. جعله هذا الشغف يشعر أن وقته على الأرض لم يعد طويلًا أو إذا كان كذلك ذات يوم فصارت رغبته في مروره أقل. لم يجعل الشغف الوقت بالنسبة له يمر أسرع أو أكثر إمتاعًا بل جعله مثمرًا لمدة محسوسة.
ثمن الشغف والمعرفة
يصف هاندكه آلية الزمن وتأثيرها في بطل روايته وكيف أنه صار الوقت شيئًا مادهيثيًّا بالنسبة له في تلك الآونة وبدأ يتعلمه من جديد. فقد كان يحب التعلم في مرحلة طفولته وشبابه ثم أخذت رغبته الأولية في التناقص أكثر فأكثر. ويصور كذلك كيف داهمته المعرفة دون أي نية، وأنه في البداية المعرفة بالفطر والبحث والأماكن والتمييز بينها والخلط بين الأنواع والهوس بها.. ويتساءل: لكن ما المعرفة الكبيرة التي أسفر عنها البحث عن الفطر أو الذهاب إلى عالم الفطر؟ ليقول: إن ما كسبه (وليس المقصود المال) هو الانتظار والترقب.
 يصور الروائي حالة الشغف المصحوب بمعارف تثري عالم المرء، كحالة بطله الذي شعر أن الظواهر المصاحبة لعمليات البحث قد أثرته بقدر أكبر عن اكتشافاته. حيث صار قادرًا في أثناء الصيف على التمييز بين صوت أشجار البلوط وصوت أشجار الزان التي كانت أقرب للأزيز، وصوت أشجار القضبان التي كان صوتها أقرب لحفيف الأوراق عن هديرها. أما في الخريف فقد اكتسب معرفة كيف تسقط أوراق مختلف الأشجار.
يصور الروائي حالة الشغف المصحوب بمعارف تثري عالم المرء، كحالة بطله الذي شعر أن الظواهر المصاحبة لعمليات البحث قد أثرته بقدر أكبر عن اكتشافاته. حيث صار قادرًا في أثناء الصيف على التمييز بين صوت أشجار البلوط وصوت أشجار الزان التي كانت أقرب للأزيز، وصوت أشجار القضبان التي كان صوتها أقرب لحفيف الأوراق عن هديرها. أما في الخريف فقد اكتسب معرفة كيف تسقط أوراق مختلف الأشجار.
تتغير حياة عاشق الفطر بطريقة حادة، فقد تحول الشغف إلى إدمان، إلى عبء، وفقدت زوجته روحها المرحة. هجرت بيتهما بين عشية وضحاها مصطحبة طفلها. هربت من الرجل ومن «الهدايا التي من المفترض أن تكون لها»، والتي كان يحضرها معه يوميًّا والمتزايد أعدادها في البيت، بل لم تعد وحدها مكدسة هناك وأصابتها العفونة.
بنوع من التوصيف الأقرب للحياد يقول الراوي: إنه إذا كانت صورته عن نفسه أنه صار شخصية هامشية -بسبب صحوة شغفه- فقد صارت فيما بعد صورة من يلعب دورًا أساسيًّا في لعبة الحياة الشاملة بينما يلعب الآخرون أدوارًا مكملة متساوية. ورأى نفسه شخصًا كان يحمل الصولجان في زمنه، وهو شخصية ثانوية طفولية يستمع إلى صوت الرياح ويشاهد سقوط الأمطار وهبوب العواصف على أطراف الغابة.
يسأل الروائي على لسان راويه: كيف هذا، هل كباحث عن الفطر؟ نعم، كباحث عن الفطر وجامع له وعالم به. ويخلق بذلك أسئلة كثيرة منها: هل أراح الشغف صاحبه أم إنّه أسره؟ هل حرّره أم زاد في تقييده؟ هل سلّحه بالمعرفة أم جرّده من أسلحته؟ هل جمّل حياته أم نغّصها بطريقة لا يمكن إصلاحها؟
يختم هاندكه روايته بمشهد يتساءل فيه: لكن أليست هذه نهاية قصة خيالية؟ ويضيف أنه ربما.. في القصة الخرافية شُفي. لكن في الواقع.. يقول الإلهام عن ذلك أو أي شيء أو أي شخص: الخرافي في هذه الحالة هو أكثر الأشياء الواقعية والضرورية. إذا كانت عناصر الكون الأربعة هي الهواء والماء والأرض والنار. فإن لحظة الخيال هي العنصر الخامس، العنصر الإضافي. فبالنسبة لحكاية -على الأقل حكاية من عالم الفطريات- فإن الخيال مع كل النميمة السامة اليومية وكل أيام الأمطار السامة صيفًا وخريفًا وكل الاتصالات الهاتفية لكل مراكز السموم الدولية وفي كل المطابخ السامة التي لا تهدأ أبدًا، وفي النهاية كما يقال كان هذا هو مكانه المناسب.
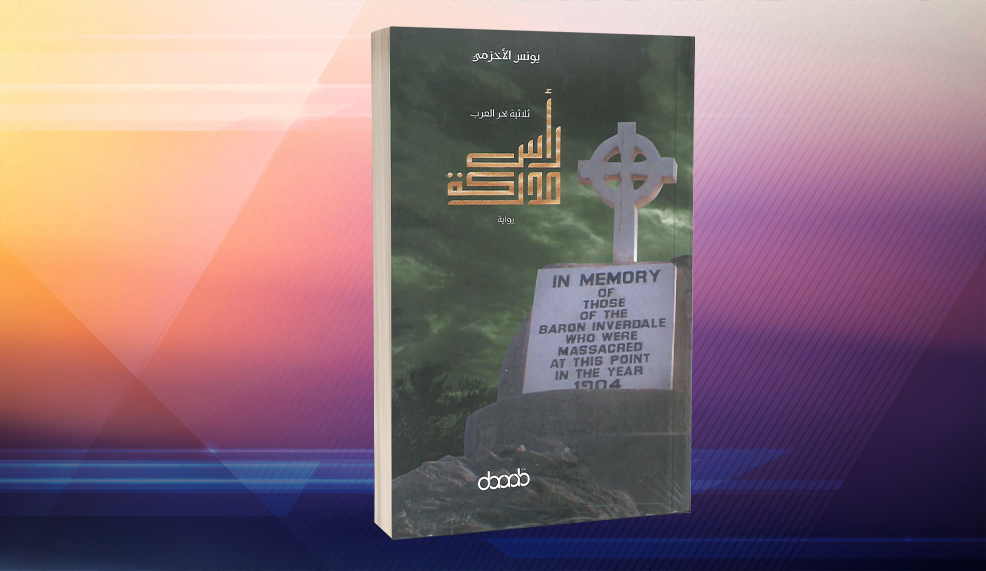
هيثم حسين - كاتب سوري | يوليو 1, 2022 | كتب

يونس الأخزمي
يستعيد العُماني يونس الأخزمي في روايته الجديدة «رأس مدركة» مشاهد وحكايات عن جنوح بعض السفن والعبَّارات وتحطمها على صخور بحر العرب، وما أثير عن علاقة البدو، من أبناء المنطقة، بها وبطواقمها، والأساطير التي نسجت عن بعض الأحداث التي صاحبتها، وكيف جرى العبث بالحكايات التاريخية من خلال تدوينها من جانب آخرين ممن امتلكوا سطوة التدوين والتوثيق، فكانوا كتبة التاريخ وراسمي معالمه ومحطاته كما يتقاطع مع مصالحهم ورواياتهم. في الرواية (دار عرب، لندن، ٢٠٢٢م) – التي تعد الجزء الثالث من ثلاثية بحر العرب، التي نشر جزأيها؛ الأول بعنوان «برّ الحكمان» والثاني «غبّة حشيش»- يكون الاتصال والانفصال بين الأجزاء جليًّا، اتصال فيما يتعلق بتفاصيل المكان وأساطيره، واستكمال للرحلة الزمنية التي بدأها في الجزء الأول، بحيث يصل إلى الأعوام القريبة الماضية، ويقف عند سنة ٢٠١٨م، ثمّ يكون الانفصال بصياغة عالم روائي مختلف من حيث التفاصيل والشخصيات.
يبرز الروائي كيف أنّ بدو البحر؛ البحارة البدو، أبناء الصحراء وأبناء البحر المحاذي لهم في الوقت نفسه، كانوا سادة تلك المناطق المهمة على طريق التجارة العالمية، وكيف أنّهم نسجوا بطولاتهم التي سردها خصومهم وحوّلوها إلى قصص تسعى للنيل منهم، بحيث إن تاريخهم الشفاهي وقع ضحية تاريخ مدوّن على ألسنة آخرين تصارعوا معهم أو أرادوا الإساءة إليهم بطريقة أو بأخرى.
ضحايا السرديات المهيمنة
من ليدز في بريطانيا إلى كثير من القرى والمناطق في عمان، ومنها: محوت وخلوف وبنتوت وصراب ونفون والدقم وشوعير ورأس مدركة واللبيتم والكُحل وصوقرة، يمضي الأخزمي برفقة شخصياته التي يسبر أغوارها، ويفسح لها المجال لتعبّر عن نفسها بشكل مقنع، بحيث يشكّل كل واحد منها بطولته الخاصّة وسرديّته المختلفة المتناغمة مع الحكايات المتجاورة والمتداخلة فيما بينها. يقتفي الروائي آثار الحكايات المنسوجة والمتناقلة التي تداولها الرواة عن الحادثة التي يستعيدها؛ إذ يقول الإنجليز: إنّ جماعة من البدو ارتكبت مجزرة بحقّ قبطان إنجليزي وعدد من رجاله، ويقومون بشيطنة البدو الذين يتمّ تصويرهم على أنهم متوحّشون لا يتوانون عن اقتراف الجرائم. في حين تكوت الحكاية المضادة التي لم تُوَثَّق، وهي حكاية أبناء المنطقة الذين اتُّهموا بالقتل، وانتُقِم منهم، وكيف أنهم دافعوا عن أنفسهم، بعد أن قتل الإنجليز شيخهم وبضعة رجال من رجاله، فلم يكن منهم إلا أن دافعوا عن أنفسهم ضد القتل والعدوان.
لأية حكاية هي السطوة والقوة والاستمرار؟ لأي رواة وأية سرديات تكون الغلبة؟ مَن ينتصر للمغدورين والمهمّشين الذين يُلعَنوا في تاريخ يكتبه خصومهم؟ متى يكتب ضحايا السرديات المهيمنة رواياتهم عساهم ينصفون أنفسهم وتاريخهم؟ هذه الأسئلة وغيرها كثير يثيرها يونس الأخزمي في روايته «رأس مدركة» ويفسح المجال لشخصياته المنحدرة من خلفيات مختلفة متباينة التصريح بآرائها والتعبير عن أفكارها بحيث تكون أصداء للإجابات المفترضة، والنقائض التي تتداخل فيما بينها مشكّلة ألغازًا تاريخية ومُضفية عليها مزيدًا من الغموض والبلبلة والشكوك.
الإنجليزي ديفيد يقتنع بحديث زوجته صوفيا التي تخبره عن حكاية جدته روز التي كتبت يومياتها ومذكراتها، ووثقت فيها أنها حين أبحرت برفقة زوجها القبطان الذي لقي مصرعه في منطقة قريبة من رأس مدركة على ساحل بحر عمان، وقد خبّأ كمية كبيرة من الذهب تحت الصخور في قاع البحر، كي لا يسطو عليها البدو.
على الرغم من تردّد ديفيد والوساوس التي تسكنه فإنه يذعن لمحاولات زوجته إقناعه بضرورة خوض المغامرة والبحث عن الكنز الإنجليزي المدفون بين صخور ساحل رأس مدركة الصخري، والارتحال إلى تلك المنطقة النائية الغريبة عنه؛ كي يستخرج الذهب ويعود به إلى بلاده، وينتقم لجدته وزوجها القبطان المقتول.
إغراء الذهب المتخيّل يعمي بصر ديفيد وبصيرته، يقوده للتضحية ببيت أحلامه وبيعه ثمّ مشاركة أحدهم في مزرعة بحرية، وذلك كي يوجد لنفسه غطاء بالتنقل في المنطقة، والغوص في أعماق البحر بحجة ممارسته هوايته بالغطس والغوص والتصوير. انسياق ديفيد الأعمى لإلحاح زوجته صوفيا واقتناعه بحكايات جدته روز المكتوبة بدقة كبيرة وتوصيف لافت ألقى به في عالم الصحراء والبحر، من دون أن يعرف خلفية الناس الذين ذهب للعيش بينهم، وهو يتسلّح بتكتمه وسريته بحثًا عن تنفيذ مآربه التي لا يجد سبيلًا إليها.
الكنز الحقيقي
الرحلة هنا تغدو الغاية بحدّ ذاتها، واكتشاف المكان وروعته وما يلفّه من جمال وغموض وسحر يصبح الكنز الحقيقي الذي كان ديفيد يبحث عنه في حياته، ويجده في راحة البال في تلك الأرجاء ومع أبناء المنطقة الذين أكرموه وأحسنوا استضافته، ولم يتعاملوا معه بمنطق العدو أو الغريب الطارئ بشكل فجّ. يكتشف ديفيد نفسه ويصل إلى مأربه وغايته بالتصالح مع الذات، ويعشق المكان ويسكنه شغف غريب به. يلوم صوفيا التي أخفت عنه كثيرًا من التفاصيل وألقت به إلى عالم بعيد بناء على تلفيقات تاريخية، من دون أن تكون صريحة وصادقة معه، ينفصل عنها لكنه يظل مسكونًا بحبها المتجدد الذي يملأ كيانه ويترقب عودتها إليه. يصاحب ديفيد كلًّا من سند وأبي مريم، ولكل واحد منهما بدوره حكاية غريبة ضاربة في التاريخ والذاكرة، يكون الغريب للغريب قريبًا بصيغة غير مباشرة، يجمع بينهم سحر المكان وغربتهم فيه ومحاولاتهم ترويضه والتغلّب على الصعاب فيه، ويرتبط كل واحد منهم بتلك الأمكنة ويتعلق بها بشكل لا فكاك منه، ويكون التوحد والاندماج بها من أجمل ما يحدث لهم، لكن يظل لكل واحد منهم هاجسه الطاغي عليه الذي يرسم سياجًا من حوله يحيطه بها ويضعه في أتونها.
يحرّك يونس الأخزمي عددًا من الشخصيات في فضاء مفتوح على جهات مختلفة، شخصيات بنغالية وباكستانية وهندية وإنجليزية بالمحاذاة مع الشخصيات من أبناء رأس مدركة والمناطق المحيطة بها، وذلك في عوالم روائية ثرية يغوص عبرها في ثنايا التاريخ ويرتحل في طياته بالموازاة مع ارتحاله في صراعات الجغرافيا وفضاءاتها الغرائبية.
يرسم الأخزمي مصاير شخصياته التي تصل إلى نهاياتها، وتلك النهايات ليست إلا بدايات جديدة لها في عوالم وبيئات مختلفة، ويفسح لها مجالًا كي تعيد لملمة شتاتها والنظر بشكل مختلف جديد إلى ذاتها وعالمها، بحيث تعي تاريخها وجغرافيتها من منظور مختلف، بعيدًا من الأحكام المسبقة والصور النمطية التي تشكّل قيودًا على الذاكرة وتقوم بتفخيخ التاريخ وتلغيم الجغرافيا بالأوهام والسرديات المسكونة بالوساوس والهواجس واللعنات.

هيثم حسين - كاتب سوري | يوليو 1, 2021 | كتب
يعود الروائي السوري الكردي سليم بركات في روايته «ماذا عن السيدة اليهودية راحيل؟» إلى حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، ليؤرخ لبعض المتغيرات الاجتماعية والسياسية في مدينة القامشلي السورية التي أمضى فيها ردحًا من طفولته وفتوته، والتي كانت مسرحًا لمواجهات وسجالات بلورت صيغة مهمشة للهوية السورية التي تعاني التفكك والاجتزاء. يركز سليم بركات في روايته (منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأردن، عمان) على كيفية إخفاق السلطة الحاكمة الممثلة في نظام البعث في صياغة هوية وطنية جامعة بحلة معاصرة تجمع أطياف الشعب السوري ومكوناته من حولها، وواقع أنها بنيت على أساس إقصائي تهميشي عنصري تجاه الآخر المختلف، الذي صور على أنه مصدر تهديد للدولة التي اختصرها الحزب في تفكير بائس يشيطن الآخر ويستعديه.
يوثق سليم بركات لواقع تلك السنوات من زاوية الفتى المراهق كيهات الذي يعبر عن حالة الحلم المنكسر، والإحباط الذي بثته السلطة الحاكمة في ثنايا المجتمع الكردي ليقصيه عن هويته الوطنية، ويلغي انتماءه التاريخي، ويحاول تغريبه عن واقعه ومستقبله، بذرائع عدوانية تفتقر للمسؤولية والحس الوطني المزعوم، ويحول البلاد إلى أوطان طاردة لأبنائها، ومبددة لهوياتهم ومضيعة لأحلامهم.
مَن السيدة اليهودية راحيل التي يسأل عنها سليم بركات، والتي يضع السؤال عنها عنوانًا لروايته؟ هي امرأة يهودية أرملة، استلمت حانوت زوجها المتوفى في الحي اليهودي في القامشلي، وكانت لديها ابنتان؛ إحداهما مراهقة اسمها لينا تعيش معها في بيتها، والأخرى بعيدة منها، أحبت شابًّا مسيحيًّا وهربت معه. وتكون راحيل متصدرة العنوان وجامعة خيوط الأحداث، من حيث تعبيرها عن النقائض في مدينة كانت مقبلة على متغيرات تاريخية كبيرة. أوسي الجابي في دائرة مصلحة الكهرباء، وزوجته هدلا، يعكسان خيبة ابنيهما كيهات وموسى، أوسي الذي يصفه سليم بركات بالقول: إنه فاتته الجنسية السورية، كآلاف الأكراد لم يستحصلوها مذ تجاهلهم التشريع في اعتراف الدولة ببشرها القاطنين أرضها. ويشير بركات كيف كان عنصر المخابرات يسخر من كيهات وانتمائه وهويته، يسأله أسئلة محرجة حين يصادفه في الحي اليهودي في القامشلي، يبادر إلى تخليصه من ارتباكه بالإمعان في السخرية منه، ويقول: إنه قد يكون كرديًّا يهوديًّا، ويتجاهل قوله: إنه مسلم، ويتمادى في السخرية منه بالسؤال إن كان هناك أكراد يهود، وما إن كانوا كلهم يهودًا؟ وحين يحتج كيهات بأنه ليس يهوديًّا يقرعه رجل المخابرات وينهره بالقول: أنا أقرر، يا حمار، ماذا تكون؟ (ص 40).
مدينة التعايش والتنوع

سليم بركات
يعيد سليم بركات رسم معالم الحي اليهودي في القامشلي التي كانت مدينة للتنوع والتعايش بين الأديان والأعراق في سوريا، ويورد أسماء تاريخية معروفة لأبناء المدينة، كاليهودي العطار عزرا صاحب الحانوت الشهير، حيث يتخيل بطله كيهات حين يمر بالحي اليهودي أن يتجه إلى حانوته، أو يدعوه عزرا إليه، وكيف سيعرض العطار عليه مجانًا بعض سلعه التي كانت تثير الشبهات حول إمكانية استخدامها لأعمال السحر، أو قيامه هو نفسه بإعداد السحر لزبائنه. يزور كيهات، الذي يعني اسمه بالكردية «مَن جاء»، حانوت راحيل التي تبيع اللحم، ويصادف هناك ابنتها المراهقة لينا التي يقع في حبها، وينسج أحلامه وخيالاته حولها، وكان في الرابعة عشرة، وبضعة شهور من عمره. يستذكر سليم بركات في روايته تأثير نكسة 1967م السلبي الكبير في النسيج الاجتماعي في القامشلي، وكيف أن حرب الأيام الستة شكلت منعطفًا عنصريًّا خطيرًا تجاه الآخرين جميعًا في دولة البعث التي نحت نحو العنصرية بسرعة واطراد، وجسدت في الآخر مصدر الشرور وجعلته مثار الشكوك، المتهم الذي يجب عليه أن يحاول إثبات براءته من جرم لم يقترفه.
يعبر بركات عن حالة التخبط الرسمية والشعبية حينها، وكيف انعكست على اللغة والواقع والتاريخ، ويمضي في السخرية بوصفه لحالة كيهات، وأنه لم يرجع إلى منزل راحيل في السبت التالي على سبت نهاية الحرب، التي أدرجها العرب على مرتبة خفيضة من ذل المعنى، فأسموها «نكسة» تقدر ممحاة طفل أن تمحوها محوًا لا يخلف أثرًا في ورقة التاريخ الخشنة. يصف سليم بركات ولع موسى؛ أخي كيهات، بالسينما وببطله شارلي شابلن الذي أصبح على اللائحة السوداء للبعث بوصفه أميركيًّا وداعمًا لإسرائيل والصهيونية، وذلك بعد الهزيمة التي وضعت الجميع في خانة الاتهام والتواطؤ، إلا الذين تسببوا بها، والذين وجهوا بنادقهم وأسلحتهم إلى صدر الشعب والدولة لينكلوا بهما سنة وراء أخرى.
يصف صاحب «الريش» الأرمنَ في القامشلي بأنهم «رعاة المعادن في حقول عافية المعادن واعتلالها». (ص 169)، ويروي أن بطله كيهات حين يتحدث مع صديقه بوغوس ويفكر في أوضاعه وأوضاع الأرمن، لا يفهم معنى أن تقبل دولته من الأرمني، وليس من سواه، طلب الهجرة على نحو عادي، كأنه معار تسترده دولة العرق الأرمني. يتحدث عن العنصرية التي كرسها حزب البعث بسياساته الإقصائية والعدوانية تجاه الآخرين، وكيف كان ذاك الحزب يسفه من قيمة الآخرين، ويحطّ من شأن لغتهم ودينهم وعرقهم بالزعم أن العربي هو العرق المتفوق. ويكمل سليم بركات طريقة تفنيد الأكاذيب التي دبجتها السلطة الحاكمة في سوريا بالسخرية، من دون أن يوليها اعتبار الحقائق.
مرتشون وجواسيس
يحكي سليم بركات عن رحلة خروج اليهود السوريين من القامشلي، وكيف كان مهربون تابعون للنظام ينسقون مع المخابرات، ويسهلون خروجهم وعبورهم الحدود إلى تركيا، ويكتب أن كيهات كان يسأل والده أين يذهب اليهود الذين يختفون؟ فيرد عليه والده بأنهم يوصلهم مهربون إلى تركيا، عبر الحدود. ويوصلهم مرتشون إلى لبنان، ومن لبنان إلى قبرص، ومن قبرص إلى دولة اليهود.
ويكتب عن تلك المرحلة بأنه لن يتمكن التاريخ الشفهي من رسم معالم للوقائع في اختفاء يهود من مدينة القامشلي. كما يتحدث عن الجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين؛ كامل أمين ثابت، الذي يقول عنه: إنه جاء من الأرجنتين ثريًّا، يحفظ آيات من القرآن، ويتحصن بتعاليم الدين الإسلامي، والهدايا. مهد لنفسه -بزعمه أنه من أصول سورية مسلمة- الدخول إلى أبراج السلطة بوساطة المآدب الفاخرة، أسبوعًا بعد أسبوع، للدبلوماسيين السوريين في بوينس آيريس، قبل اجتياحه دمشق بمآدب موائدها أوسع، فاتنة الأطعمة والأشربة، أبهى صحافًا وصحونًا وأقداحًا. (ص 328 – 329).
لعل المشهد الأخير الذي يختتم به سليم بركات روايته هو الأكثر تعبيرًا عن حالة سوريا الراهنة، ترميزًا إلى مآلها المستقبلي المفترض، ولا سيما أنه يختصر التقسيم وتقطيع الأوصال، حيث يصف بطله كيهات يدندن كلمة «سوريا» مقطعة على نغم مرتجل: «سو. ري. يا». ثم يصف حالته بأنه «شهق شهيقًا خفيفًا أعقبه بزفير حاد». وينهي بعدها الرواية بالقول: «بكى كيهات». (ص 562). والبكاء هنا تأسٍّ ورثاء على ما كان وما يكون من خراب ودمار.

هيثم حسين - كاتب سوري | سبتمبر 1, 2020 | كتب
تستهلّ السورية ديمة ونّوس روايتها «العائلة التي ابتعلت رجالها» (دار الآداب، بيروت، 2020م)، ببوح راويتها المتماهية معها، بالحديث عن حلم يراود أمّها، وكيف أنها كانت تنتظر ما يشبه الحلم، وتكون صباحاتها متشابهة كأنّها تكرر مشاهد حلمية، أو من حيوات سابقة مستعادة عبر الحلم. تختفي الراوية التي لا تصرّح باسمها خلف شخصية الأمّ الحاضرة بقوّة، وكأنّها تعويض عن الوطن، والأهل جميعًا، تعطيها المركزيّة وتتمحور حولها الحكايات والأحلام، تمنحها الحيّز الذي يليق بدورها في الواقع، وتعيد رسم حياتها البديلة في الرواية، حياتها التي فقدتها، أو تلك التي تتخيّلها وتعيد رسمها بطريقتها الحكائية المثيرة.
تكشف الراوية أنّها توقّفت عن رواية أحلامها منذ زمن، وأنّه لم يعد ثمة متّسع لها مع أحلام أمها. أنّ أحلام كلّ واحدة منهما لم يعد يكمّل بعضها بعضًا كما كانت في السابق، وتعزو سبب ذلك إلى أنّ ذاكرتيهما تعيشان في مكانين مختلفين، وأنّ الأمّ تتكئ على الماضي، مسجونة فيه، بينما تعيش الراوية يومها منتظرة، وتقول: إنّها ربما تنتظر اليوم الذي ستتحرّر فيه من حكايات أمها عن ذلك الماضي المرهق. وتنتظر أيضًا، التسلّل من الحاضر إلى المستقبل.
تكون ونّوس مأسورة لشخصية الأمّ التي تصفها بأنّها تلعب بالذاكرة، تعبث بمنطقة اللاوعي عند الراوية وعندها، وتصف كيف أنّها استبدلت بشغف التمثيل على المسرح، شغفَ تمثيل أحلامها والقصص التي ترويها، وتأثير ذلك في البيت الذي صار مسرحًا يوميًّا لا تتوقّف الحركة فيه إلا في ساعات الليل. الأمّ تمثّل والراوية التي ترصد حركاتها وتكتبها في مخيلتها وروايتها، تتفرّج، تسايرها قدر الإمكان وتحاول أن تصغي وتفكّر وتدوّن في ذاكرتها معظم ما تقول.
تقول الراوية التي تبدو صورة مرآوية؛ روائية، متقاطعة مع الروائية نفسها في محطّات كثيرة من حياتها: إنّها عاشت أربعين عامًا متّكئة على ما ورثته عن أبيها من طباع ومزاج حاد وعناد. وتشير إلى أنّ أمّها كانت تذكّرها كل يوم بمدى الشبه بينها وبين والدها المسرحي الراحل، ولفتت إلى أنّه يسهل اختراع الشبه، وأنّها تفكّر الآن في أنها اخترعت كل تلك الأمور التي تشبهه فيها، لتستبقيه معها، لتصدّق أنها لم تفقده نهائيًّا، وأنّها ربما، اخترعت الشبه، لتروي لها قصصًا كان عليها أن ترويها في حضوره، لتتقاسمها معه.
تقرّر الراوية التي تقيم في لندن مع أمها، والتي تكون مسكونة بالغربة مثلها، أن تسجن الزمن وتوثّقه، فتشتري كاميرا وتبدأ في تصوير الأيام التي تصفها بالثقيلة، وتقول كأنّها أرادت أن تتخلّص من عبء ذاكرتها، أن تجعلها حبيسة ذاكرة منفصلة عنها. هي الوحيدة تمامًا، قررت أن تستقدم من يعيش معها ويشاركها الإصغاء إلى حكاياتها. تقول بتأسّ: إنّها كانت بحاجة إلى عينين تحدّق أمها بهما، وأذنين تروي لهما، فتتقاسم معها ذلك الأسى.
التحوّل الذي يجتاح حياتهما بعد الانتقال من دمشق إلى بيروت بعد انطلاق الثورة السورية، ومن بيروت بعد سنوات إلى لندن، يتحوّل إلى ضغط يومي لا مهرب منه إلا بالحكايات والذكريات والأحلام، والسعي لبناء عالم موازٍ، أو بديل، يستحضر شخصيات نساء العائلة، ويقتفي مصايرهن، عسى أن تساهم في تخفيف حدّة الغربة القاهرة.
تقول الراوية: إنّ أمّها لم تعد تروي ذاكرتها البعيدة كما كانت تفعل، وإنّ الذاكرة القريبة باتت هي حديثها اليومي. وهي تعيشها معها مرات ومرات. تعيش الموت كل يوم، والفقدان، وتلك الأرض الواهية والطرية التي تمشيان فوقها، ضائعتين بين الماضي والحاضر. تعيش كل لحظة، الإحساس بعدم الانتماء والحنين إلى بلاط بيت تملكه، في شارع أليف.

ديمة ونّوس
تقرّ الراوية بالأمر الواقع، ولا تحاول تغييره، ترتكن للغربة وتأثيراتها القاسية، وتحاول عبر الحكايات والذكريات والأحلام ترويضها، فتراها تعيش على وقع أحلام أمّها وتخشى أن تختلط عليها الأمور بين الحلم والواقع، وأن تضيع معها في تلك الذاكرة الثالثة التي تعيش معهما. وتصف تلك الذاكرة بذاكرة الأحلام التي تبلور عالمًا متكاملًا بشتّى التفاصيل.
تخترع الأمّ زمنها الخاصّ بها، تعيد تأثيث الأمكنة والأزمنة بالشخصيات التي تستبقيها في ذاكرتها وأحلامها، تعيش زمنها المتخيل الذي يفرض نفسه على الراوية التي تتيه بين الأزمنة بدورها، وتراها تحلم دائمًا باستعارة أمور أخرى، كالطمأنينة مثلًا، إلا أن محاولاتها تتعثّر.
تستذكر حادثة بين أمها وأبيها، تقول: إنه عندما اختفى السرطان فجأة من جسد أبيها، سألته أمها بنبرتها الضاحكة وصوتها الطفولي: «وين راح الكانسر حبيبي؟»، فأجابها: «راح بطمأنينتك». تأسف أنّها لم تستطع استعارة ولو قطرة واحدة من تلك الطمأنينة. وتقول عنها: «أمي التي لا تكبر، لم تبرع بالتمثيل فقط، بل باللعب أيضًا. تلعب بنظرتنا إليها. تجعلني أتوهّم، أنها هي من تحتاج إلى الطمأنينة. وأنا لا أعرف كيف أمنحها الطمأنينة».
شغف، ماريان، هيلانة، نينار، إضافة إلى الأمّ والراوية، يمثّل أركان العائلة التي تصفها الروائية بأنّها ابتلعت رجالها، والابتلاع هنا يكون كناية عن سوء الحظّ الذي يرافقهنّ، وعن اللعنات التي كانت تحلّ على الجميع، سواء الحروب، أو الأمراض، أو الخيبات والنكسات، فتصيب نساء العائلة وتحيلهن إلى الفراق، والرحيل، والوحدة والوحشة.
تجسّد حكاية نينار ذروة الأذى النفسيّ الذي يشكّل رصاصة الرحمة التي يطلقها الزمن، القدر، على الأمّ المسكونة بالراحلين وأصواتهم وروائحهم وجميع تفاصيلهم، فتقع فريسة للأسى والقهر على نينار التي تشبهها إلى حد كبير، نينار الثورية التي تتحدّى ظلم النظام، وتخرج في المظاهرات، ثمّ ترفع صوتها عاليًا متحدية جبروت الطاغية، تقتلها الغربة، وتقضي عليها، تبتلعها بدورها وتبقيها حسرة في قلب الأمّ وقلب الراوية معًا.
الغربة التي تشعر بها الراوية جزء من غربة معشّشة في العائلة؛ إذ تذكر أنّ إحساس الغربة في روح جدّها تعزّز مع قدوم البعثيين إلى السلطة في دمشق، ورحيل صديقه خالد العظم إلى بيروت، ثمّ سجن جدها ستة أشهر بعد انقلاب الثامن من آذار على خلفية علاقته بخالد العظم، وتقول الأمّ الشاهدة على أحداث التاريخ المعاصر: إنّ الجدّ بكى صديقه كما لم تره يبكي من قبل. وتسترسل الراوية في الحديث عن زمن الانقلاب الذي شوّه تاريخ سوريا ومستقبلها، إنّه ليس وحده خالد العظم من رحل مع قدوم البعثيين، بل تبدّلت رائحة ذلك الزمان أيضًا.
وفي النهاية التي لا تخلو من تراجيدية وأسى، تصرّح الراوية بأنّ الأمّ الممثّلة دور البطولة في حياتها، وعلى خشبات المسارح، اكتشفت أنها فقدت مع الزمن قدرتها على التمثيل، تتغير بمرور الزمن، تكتسي ملامحها تأثيرات الزمن والغربة والمآسي، وتبقى الجملة الوحيدة التي لا تعرف ابنتها أين تعلّمتها، إلا أنها تنطقها بإنجليزية صحيحة وواضحة ولا يشوبها أي تلكّؤ: «فقدت كل عائلتي خلال السنتين الماضيتين».
ترمز صاحبة «الخائفون» إلى أنّ الفقدان يكون ملازمًا للراوية وأمّها، كما لغيرهما من السوريات والسوريين الذين اضطروا للخروج من ديارهم عنوة، وعيش الذكريات كأنّها واقع معيش، وأنّ الزمن يبتلع كلّ شيء، والغربة بدورها تمتلك قدرة وحشية فظيعة على ابتلاع الأحداث والشخصيات؛ لتلقي بها على قارعة الأحلام والذكريات، فتبقي الجميع أسرى للخيبات والهزائم، ونزلاء الشعور الدائم بالفقد والرحيل المتجدّد كلّ مرّة.

هيثم حسين - كاتب سوري | مارس 1, 2020 | كتب
يغوص اليمنيّ علي المقري في روايته الجديدة «بلاد القائد» في قلب بلاد متخيّلة يسمّيها عراسوبيا، يحكمها دكتاتور مهووس بجنون العظمة، يرصد المتغيرات التي تجتاحها في مرحلة مفصلية من تاريخها، حيث تنطلق فيها ثورة تحرق القائد والبلاد معًا، وتغيّر وجهها إلى الأبد بشكل غير متوقّع. يقسم المقري روايته (منشورات المتوسط، ميلانو، 2019م) إلى أربعة فصول/ فصوص: فصّ المرجوّ، فصّ المبجّل، فصّ الاكتمال، فصّ القذى، وكأن الفصوص الأربعة عبارة عن فصول أربعة لرحلة الدكتاتور من البداية حتى النهاية، وكيف تطورت شخصيته وصولًا إلى النهاية الفظيعة التي انتهت بها حياته.
يحكي كيف أنّ القائد الدكتاتور يستعين عبر رجاله بروائيّ مشهور للمساهمة في تدوين أجزاء من سيرته، حيث يُعَظَّم فيها، وإضفاء القداسة عليه، ويرضخ للمشاركة في ذلك تحت ضغط الحاجة المادية لإنقاذ زوجته المريضة سماح، ومحاولًا تبرير الأمر بصيغة ما، لكنّه يظلّ رهين الصراع الداخلي الذي يفتك به ويعكّر عليه أوقاته.
ذلّ الفضيحة: يعيش الروائيّ الذي يترك زوجته في مصر ويمضي إلى عراسوبيا مرارة القهر، وذلّ الفضيحة، يشعر بالمهانة؛ لأنّه يتحوّل إلى أداة لتمجيد طاغية، ويقوم بتسخير أدبه وعلمه من أجل صياغة حكايات تقدّس الدكتاتور، وفي الوقت عينه يواسي نفسه، أنّه يقدم على ذلك من باب التضحية لإنقاذ زوجته المريضة، ويعزّي نفسه بأنّه سيركل الفقر قريبًا ويصبح قادرًا على توفير ثمن العلاج لسماح. يشعر في الأيام الأولى لوصوله أن ما يعمله فضيحة في حياته الأدبية والشخصية، وقد ازداد هذا الشعور وهو يتخيل تصريحات لأحد النقاد عن عمله مع دكتاتور وبيع مواهبه الأدبية له، تلك المواهب التي قال من قبل: إنه قد سخرها للإشادة بالاستعمار. رأى نفسه بمنزلة فضيحة ممنوعة من الخروج إلّا بموافقة القائد وأولاده.
يجد الروائيّ المجلوب نفسه في معمعة لا يمكن الفكاك منها، يقع في مستنقع القائد وأسرته، من جهة تستدعيه الشيماء ابنة القائد، تطلب منه الزواج سرًّا، وتطالبه بإرضائها، وهو الذي يفترض به أن يكون خبيرًا باعتباره صوّر الحرمان والتمرّد وقارب مواضيع جنسية في أعمال سابقة له، وتحاول أن تظهر نفسها مظلومة وأنّ تجاربها السابقة في الزواج لم تكن ناجحة، وأنّه قد يكون المخلص الذي يعيد إليها رونقها وسحرها.
يصوّر صاحب «حرمة» بلاد القائد التي بدت هادئة ساكنة لا حياة فيها، تجتاحها رياح الثورة، تقلبها رأسًا على عقب، تغيّر الناس، بحيث ينقلبون على بعضهم بطريقة وحشية، يصبحون أشخاصًا مختلفين، تظهر وجوه كانت مخبوءة، وكأنّ الأقنعة تنزاح بطريقة فوضوية لتكشف رغبات الانتقام التي كانت متصاعدة بشكل غير معقول. كما أنّ الراوي الذي يقيم في بيت الضيافة، ويقدّم نفسه على أنّه خبير بتراث عراسوبيا، يصوّر مفارقات من الخوف الذي كان يفسد حياة الناس، والجرائم التي كانت تُقْتَرف في وضح النهار بحقّ أبناء البلاد، واستغلالهم وابتزازهم ومعاقبتهم بشتّى السبل، لتكريس قناعة لدى الجميع أنّ القائد منزّه ومقدّس ومبجّل وأيّة حركة يقوم بها تنمّ عن عبقريته وتفرّده وعظمته.
يحكي الراوي عن الأوقات التي سبقت عاصفة الثورة التي أطاحت بالقائد، وكيف كانت الأجواء تغلي، وظهر القائد في خطاب تجريميّ اتّهم الشعب بالخيانة وتوعّد بالقضاء على وصفهم بالفئران والخونة، وبدأ باستخدام القوّة المفرطة، متخيّلًا أنّه سيقضي عليهم من خلالها، وغير مدرك أنّ هناك ما يحاك من قبل قوى كبرى للإطاحة به، والاستجابة لما وصف بطلبات الثوّار بالتدخّل الدوليّ الذي زاد الطين بلّة، وتسبّب بمزيد من الانشقاقات بين القوى المحلّيّة لاحقًا.
في الرواية شخصيات عديدة، كأبي اليُمن، ومحمدين، وإسماعيل النون، والأحمد، والمحب، ونازك، والمنذر، ونادية، وأم أسعد، وسحر، والحالمة بموت الرئيس، وغيرها من الشخصيات، تحضر في سياق الأحداث المتسارعة، تؤثّث عالم القائد، وتدور في فلكه؛ لأنّه المركز الذي يتحكّم بمصايرها، وعليها الإذعان له وانتظار لحظة التغيير من أجل إعلان الانشقاق عنه، والبدء بالتنكيل به وبتاريخه. يختار المقري للراوي اسم علي، بحيث يتماهى معه في الاسم والصفة، يكون روائيًّا أيضًا، ويكون الإيحاء بتوثيق حكاية حصلت، وأنّ المسرود يحيل إلى الواقع، وإن بدا أنّه يفترق عنه بصيغة روائيّة. ويكشف أسرار القائد التي أصبحت معلنة، وكيف كانت لديه لجان متخصصة في تلبية نزواته المجنونة، وكان لديه مكتب أمينات السر المختص بتقديم الخدمات الخاصة له، وغير ذلك من التفاصيل التي تظهر حجم البؤس الذي كان يخيّم على البلد التي يتباهى القائد بأنّه بانيها وحاميها وأنّها تعرف به، ولولاه لما عرفها أحد.
رعب ويأس
يتجوّل الراوي في بلاد القائد، يحاول ألّا يلفت الانتباه، يشعر بنوع من الارتياح وهو يتطلع إلى وجوه الناس، ويقرأ يافطات المحلات، وكيف أنّ صور القائد كانت تحتلّ جميع الأماكن، واجهات المحلّات ومفارق الطرق، والساحات والأبنية العالية والكبيرة، بحيث يغطي على كلّ شيء، أو أنّ صورته هي الأهمّ في البلاد التي باتت تحمل لقبه وصفته كزعيم يرى نفسه معجزة زمانه.
يقول إنه في لقائه بالقائد، استمع إلى حديثه عن منجزاته العظيمة في البلاد التي صارت تحمل صفته؛ صفة القائد التي بدت بمنزلة اسمه، ويذكر أنّه عرف قبل سنوات طويلة أنّ عراسوبيا تعرف ببلاد الثورة، ولم يعرف إلا حين وصل إليها أنهم صاروا يطلقون عليها صفة أو اسم بلاد القائد، أما عراسوبيا، وهو الاسم الذي أطلق عليها في اليوم الأوّل للثورة، من جانب القائد نفسه، فلم يسمع أحدًا يردده، ويلفت إلى أنه بات من الواضح أنّه لم يعد متداولًا سوى في السجلات الرسمية بين البلدان. يصف الرعب الذي جثم على صدر البلاد في حياة القائد وبعد قتله والتمثيل به، وتغطية جثته بالقذى، وكيف أنّه عمّم الخراب بطريقة لا تستدلّ إلى أيّة محاولة للخلاص أو التهدئة، ونشر سموم اللعنة التي حلّت بمجيئه ورحيله، ولم تكن حياة الروائيّ علي بمنجى من ذاك الخراب؛ لأنّ زوجته المريضة بالسرطان ماتت أثناء غيابه، ولم يتمكّن من تحقيق حلمه بالثراء، وبالتمكّن من تأمين ثمن علاجها، وظلّ مسكونًا بشعور ضاغط يغرّبه عن ذاته.
ويصل إلى درجة من اليأس، ويصرّح أنّه لم يعد يهتمّ بمصيره، وما إن كان سيعود لبلاده أم سيبقى هناك، كما لم يهتمّ بمصير الشيماء التي جيء بها إلى بيت الضيافة ولم يعلن عن هويتها وأنها ابنة القائد، خوفًا عليها من الانتقام، ولا يعرف إلى أين مضت، حتى المعارك التي تدور وتطحن الجميع لم تعد تثير اهتمامه، وقد بدت أنها خرجت عن طورها، وتفشّت بين الجميع بشكل مرعب.
ولعلّ القارئ يبحث عن مطابقة بين الواقع والمتخيل، ويقترب من القول: إنّ البلاد المصوّرة التي تكون مزيجًا مركّبًا من الأحرف الأولى لكلّ من العراق وسوريا، والأحرف الأخيرة من اسم ليبيا، تكاد تستقلّ بذاتها على أنّها بلاد متخيّلة، لكنّها تمرئي الأحوال في كلّ من هذه الدول بصيغة أو أخرى، وتنحو لتركّز على الوضع في ليبيا، من دون أن يسمّي الروائيّ ذلك، لكنّ الأحداث والمتغيّرات والصفات، وحكاية القصر المبني على شكل خيمة، تميل للاقتراب أكثر من الخصوصية الليبية، كما أنّ صورة الغلاف تقترب من صورة للرئيس الليبي معمّر القذافي بشكل رمزي، ناهيك عن جوانب من التطابق في الأهواء الغرائبية والطقوس الجنونية التي كان يدأب على ممارستها وإظهارها، وطريقته في الحركة والكلام.
يلفت المقري إلى انسداد الأبواب والآفاق معًا في وجه الأدباء، وكيف أنّهم يضطرّون للرضوخ لما يملى عليهم، بحيث يناقضون ضمائرهم، ويكتبون تحت وطأة الحاجة والفقر والجوع والمرض ما لا يرضيهم، وما يكون تحايلًا على الذات والآخر، على الأدب والتاريخ، بالموازاة مع شعور اللعنة التي تطاردهم في حلّهم وترحالهم.

 يصور الروائي حالة الشغف المصحوب بمعارف تثري عالم المرء، كحالة بطله الذي شعر أن الظواهر المصاحبة لعمليات البحث قد أثرته بقدر أكبر عن اكتشافاته. حيث صار قادرًا في أثناء الصيف على التمييز بين صوت أشجار البلوط وصوت أشجار الزان التي كانت أقرب للأزيز، وصوت أشجار القضبان التي كان صوتها أقرب لحفيف الأوراق عن هديرها. أما في الخريف فقد اكتسب معرفة كيف تسقط أوراق مختلف الأشجار.
يصور الروائي حالة الشغف المصحوب بمعارف تثري عالم المرء، كحالة بطله الذي شعر أن الظواهر المصاحبة لعمليات البحث قد أثرته بقدر أكبر عن اكتشافاته. حيث صار قادرًا في أثناء الصيف على التمييز بين صوت أشجار البلوط وصوت أشجار الزان التي كانت أقرب للأزيز، وصوت أشجار القضبان التي كان صوتها أقرب لحفيف الأوراق عن هديرها. أما في الخريف فقد اكتسب معرفة كيف تسقط أوراق مختلف الأشجار.