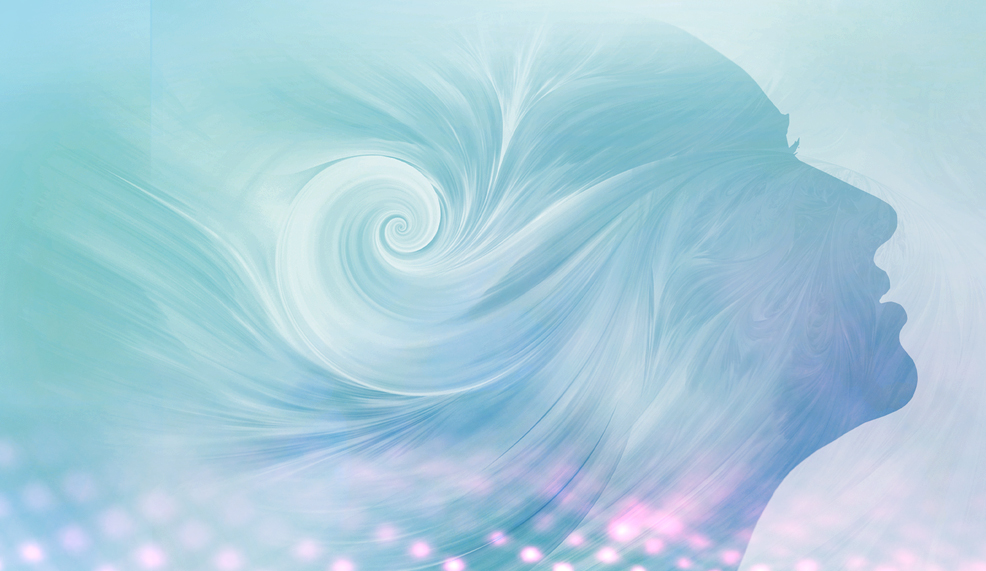
قالت إنها سمعت صوتًا
في نهار صيف عام 1972م، كنتُ بعمر ثماني سنوات أجلسُ في منزل جيراننا، عندما قالت أمهم: إنها تسمع صوتًا يناديها من داخل خزانة الملابس، في غرفتها الطينية الواطئة. امرأة ستينية -كما ترون- عجوز. لا أذكر أنها تكلّمت معي النهارات الطويلة التي كنتُ أقضيها عندهم ولا كلمة واحدة منها لي. فقط نظرات باهتة، فيها لعنة انكسار، تخفي شعرها الأحمر المُحنَّى تحت غطاء أسود بالٍ. لم يناقشها أحد في هذا الادعاء، على حد علمي، وربما فعلوا. قد يكونون اعترضوا عليها ووصموها بالجنون، لم يقل لي أحد شيئًا، كان من الغرابة أن تظلَّ تسمع صوتًا يناديها باسمها كلّما فتحتْ باب الخزانة، مما جعل بنتيها تجفلان وتبتعدان عن الخزانة عندما كانتا تقومان بدوريتهما في تنظيف غرفتها، فكانت تتكفل هي بترتيب ثيابها، حيث لم يكن يُعرَف ما إذا كانت تتجاهل النداء الذي تسمعه أو تُلبّيه، لم يكن معروفًا أيضًا عدد المرات الذي تسمع فيه النداء، وما الحوار الذي يدور بينها وبين ذلك الشبح الذي يتجشم عناء هذا العمل والذي على ما يبدو كان عملًا دائمًا.
كانت البنت الكبرى «سهام»، عمرها ستة عشر عامًا، طويلة نحيلة، ينقصها الجمال، لا تتعلّم، وتجلس في البيت، تقضي وقتها في الأعمال المنزلية وفي قراءة كتب ومجلات هزلية. البنت الثانية «شيخة» صديقتي، لها بشرة شاحبة، وخصلات شعر حمراء خشنة ترتفع على هامة رأسها مثل جبل صغير، اعتدتُ أن أذهب إلى بيتهم لنخرج معًا ونلعب في الحارة.
بيتنا كان أقلَّ حظًّا من بيتهم، جدران غرفهم وأسقفها قوية، غير مُهددة بالسقوط على رؤوسهم وهم نائمون، على خلاف بيتنا، فثمّة غرفتان فيه لا تُستعملان، سقفهما يمكن أن يهبط في أي وقت، وإحدى الغرفتين كانت مثل مخزن مهجور، فيه كل شيء لا نحتاج إليه. فكّرتُ في بعض الأحيان أن أدخل الغرفة وأستكشف ما فيها، لكنّي حين كنت أرى آثار زحف الحيّات على التراب الناعم فوق الأرضية أرتعد وأغيّر رأيي، مكتفية بالنظر إلى الداخل وأنا واقفة على العتبة. لم أرَ عندهم أفاعيَ كما عندنا، في أحد الأيام كنتُ أستحم، وشاهدتُ أفعى كبيرةً ملتفةً على المسمار الضخم البارز في الحائط الذي نعلّق عليه ثيابنا، ارتديتُ ثيابي ببطء حتى لا أثير فزع الأفعى ثم فتحت الباب وخرجت أصرخ، عندما جاء أبي ليقتلها كانت قد هربت.
ثمّة أفعى أخرى تزحف كل ليلة بجانب رؤوسنا ونحن نيام على الأرض في سطح منزلنا، نرى آثار زحفها في كل صباح، لم تؤذنا، كأنما كانت صديقة لنا، أو واحدة من أفراد العائلة.
في يوم صيفي حارّ أرادت أمي أن تأخذ بعض الرز من كيس كبير موضوع في «حوش» جانبي، وحملتْ في قبضتها مع الرز أفعى كبيرة نائمة داخل الكيس، قتلتها أمي على الفور، عندما عرف خالي قال مازحًا: لماذا قتلتها؟ كانت قد بدأت تكبر وتخرج لسانها !
ظلّت أمي تقصّ علينا طوال سنوات عن مثل هذه الأمور، قالت لي شيئًا لا يمكن أن يُصدق: إنها وجدت عقربًا ميتًا في قِماطي وأنا طفلة، ومن المثير للاستغراب أن العقرب لم يقرصني.
كنت أنا وشيخة نلعب مع بنات الجيران، ونتجنب البنات الكبار اللواتي كن يجلسن على عتبات بيوتهن، يتفرجن على الرائح والغادي. لم نكن نبتعد عن الحارة التي كان حجمها محدودًا، والتي لا يُسمَح لغريب أن يدخل إليها فكأنها منزلنا الجماعي، أذكرُ من تلك الألعاب أننا كنا نحفر حفرة صغيرة في الأرض، وكلُّ واحدة ترمي في داخل الحفرة اثنتين من كرات البلي، فإذا سقطتا كلتاهما داخل الحفرة تخسر اللاعبة، وإذا بقيت واحدة وخرجت الأخرى ربحتْ وصار من حقها أن تحصل على باقي كرات البلي المتجمعة في الحفرة، كان هذا مسلّيًا جدًّا، والوقت يمضي دون أن نشعر به.
كنا نذهب إلى بيوتنا حين يحين موعد وجبة الغداء، نأكل ونطالع التلفزيون الذي كان بالأبيض والأسود، نشاهد فِلْم «العمالقة» وكان في ذلك الوقت من الأفلام المشوقة.
في فترة العصر كنتُ أختصر المسافة وأذهب إلى بيت شيخة عبر جدار متهدم في سطح منزلنا، أنزلُ إلى الحوش عبر الدرج الطيني المتكسر، وأبحث عنها في الغرف، أحيانًا أجدها تنظف مكان البقرة، تكنس مخلفاتها، وأمها تصيح عليها من مكانها الذي تجلس فيه حيث الحصيرة ونتف شعرها المجعد ظاهره بسبب انحسار غطاء الرأس، تقول لها أن تنتهي بسرعة كي لا تضايق البقرة أكثر من ذلك، وأنا أجلس على الدكة المرتفعة، أراقبها وهي تعمل. في إحدى المرات نشب بيننا شجار لا أذكر الآن سببه، فرفضتْ أن أحضر حفل زواج أخيها الذي كان سيُقام في بيتهم، قالت إذا حضرتِ ضربتك، خفتُ وبقيتُ في المنزل. أهلي ذهبوا إلى العرس، وبقيتُ وحدي في البيت، كنتُ أسمع أصوات الغناء، إذ لا يفصل بيتنا عن بيتهم سوى الجدار الذي سحب أبي مرّة من شقّ فيه ذيل أفعى ضخمة، لكنه في النهاية تركها؛ لأن أمي خافت عليه، وظلّت تصرخ فيه أن يدعها. صعدتُ إلى السطح، ومن خلال الجدار المتهدم كنتُ أتفرّج على الحفل. في اليوم التالي تصالحنا ولم نتحدث في الأمر مطلقًا.

