
لوكليزيو: نعدُّ أفكار كونفشيوس ومينشيوس غرائبية، في حين هي أكثر حداثة من أفكار الفلاسفة اليونانيين يقول إن المقاومات القديمة تأسست على علاقة متينة بين الجسد والروح
إن ما يلفت النظر منذ الوهلة الأولى هو هذا الانطباع الذي لا يغادرنا عن الغموض المحيط بشخصية جان ماري غوستاف لوكليزيو ذي القوام الطويل إلى حد ما، والنظرة الزرقاء، والوجه الذي اخترق الزمن، كأنها ملامح كائن فضائي، كأن هذا الكاتب، المتوَّج بجائزة نوبل، آتٍ بالتأكيد من عالم آخر. علامة وعاشق لأرض، متواضع وجوّاب للآفاق، مؤثِّر وخجول. يتحدث بصوته الهادئ والرصين، عن فلسفة كونفشيوس وحياة المزارعين الصينيين البسيطة، بفنٍّ يذهب دائمًا إلى الأمور الجوهرية؛ إذ لا بد من القول: إن الروائي عاد من الصين التي اغترف منها، بلا شك، هذه القوة وهذا التواضع اللذين يضفيهما عليه مترجمه «تشو يون» في توطئة مفعمة بالإنسانية.
لقد وقع ج. م. غ لوكليزيو فعلًا على أثر بعنوان: «خمس عشرة محاضرة في الصين: مغامرات شعرية وأحاديث أدبية»، وهو ثمرة سلسلة من المحاضرات حول الأدب، ألقاها بين سنتي 2011م و2017م في شنغهاي ويانغزو وبِكِين. ندرك أن لوكليزيو رحّالة، حيث ظل يستكشف أقطارًا جديدة؛ إذ حطَّ الرحالَ بالمكسيك والولايات المتحدة الأميركية وكوريا وجزر موريس، أرض جذوره. استهوته الصين منذ زمن بعيد؛ ذلك أنه أراد أن يؤدي فيها خدمته العسكرية، ثم عاد إليها مرات عدة، وأحب ثقافتها. أحب هذا الشعب المرتبط بالعائلة، وهذه المدن حيث ما زال الناس يغنون في شوارعها، وهؤلاء الطلاب المتعطشين إلى التعلم، والعارفين الكبار بالأدب الفرنسي. لقد حدثهم عن قراءاته: كونراد، سالينغر، لوتريامون، هنري، روث… وعن كتابته «التي تمنحه الإحساس بأن يومًا زِيدَ في حياته». وهو مدين بعنايته بالآخر، بالضعفاء، وتطلعه إلى العدالة والجمال، الذي يعبر عنه في عمله كله، إلى والديه، إلى تلك الأم الرقيقة التي يجابه بفضلها مخاوف الحرب، وذاك الأب الطبيب العسكري، الذي سافر لعلاج المرضى في إفريقيا النائية والقاسية، والجذابة في الآن ذاته؛ إذ لم يفتأ، منذ روايته الأولى «المحضر»، (جائزة رونودو) التي كتبها في سن الثالثة والعشرين، يستكشف سجلات عدة، تجعله عصيًّا على التصنيف؛ منها: البحث في الهوية، والجنون، وقلق الحياة الحضرية، والصحراء، والأساطير، والتصوف. هذا ما جعل ربما هيئة جائزة نوبل تُحيي فيه كاتب القطيعة. وهو يحب، بصفته مدافعًا مقتنعًا عن البيئة، الطبيعة التي تسمح له بالولوج إلى جوهر الحكمة. كما يجد في الأدب، وهو شاعر صادق، إمكانية اللعب النهائية الممنوحة، وفرصة الفرار الأخيرة.
● في سن السابعة، على متن الباخرة التي كانت تقلك في أثناء سفرك إلى والدك، كتبت نصوصك الأولى، ومنها هذه الجملة التي تقول: «كتبت قبل أن أقرأ»؟!
■ أجل؛ لأنني لم أكن أقرأ كتبًا. وبما أني كنت أكتب، فإنني كنت أعرف القراءة؛ إذ اتبعت النصيحة التي أسديت لـ«بوال دو كاروط»: «إذا أردتَ أن تقرأ كتبًا، اكتُبْها!» كنت منجذبًا كذلك إلى الورق وقلم الرصاص، حيث كانت هاتان الأداتان تستميلانني. وما زلت إلى اليوم أكتب بالقلم، على الورق.
الطفولة والحرب
● عندما كتبتَ روايتك الأولى «المحضر»، في سن الثالثة والعشرين؛ هل كنت تفكر في القارئ؟ في أن تصير مقروءًا؟
■ لطالما راودتني رغبة كبيرة في أن أكون مقروءًا. عندما كنت طفلًا، كان أخي وأمي من قُرَّائي وقتئذ، بوصفهما جمهوري الوحيد، بل جمهوري المفضل. بل كان أخي يكتب روايات، إضافة إلى ذلك. كما كنت أُحرِّر رسائل طويلة إلى جدتي. كنت آمل فعلًا أن أكون مقروءًا، وأن أكون حاضرًا عبر الكلمات، وأن تذهب هذه الأخيرة إلى مكان ما وأن تحرك مشاعر القراء.
● أرسلت مخطوطك إلى «كلود غاليمار» عبر البريد، واستقبلت في هذه الدار الشهيرة، ونلت جائزة رونودو عن هذا الكتاب.
■ في الواقع، كنت محظوظًا جدًّا. حدث ذلك في حقبة حرب الجزائر الصعبة جدًّا، وخصوصًا للفتيان الذين كانوا مكرهين على الالتحاق بالجيش. كانوا يدربوننا من أجل نذهب إلى الحرب. وقد أجريت تدريبي العسكري، طيلة ستة أشهر، بغية الالتحاق بمدرسة ضباط الاحتياط. جعلونا نزحف ونطلق الرصاص. لكن لم نكن على علم سوى بالهدف من كل ذلك، وهو الذهاب إلى الجزائر وإطلاق الرصاص على الناس. ساد إذًا جو مخيف جدًّا طيلة تلك الحقبة. وقد شبهت هذه الحقبة بما كانت والدتي ترويه لي حول سنوات الحرب العالمية الثانية. كانت تقول لي: «كنا نستشعر أن الحرب آتية كأنها حمى تستعر». هنا، كان يحدث الأمر ذاته، حيث كنا نشعر أن تلك الحرب وشيكة، ولم نكن نرى أي طريقة لمنع وقوعها؛ لأن السلطة القائمة، وكل الهيئات، حتى الجو العام، كل ذلك كان يدفعنا للالتحاق بجبهة القتال في الجزائر. من جانب آخر، شهدت تلك الحقبة أزمة في الأدب، حيث اعتقدت أنني أردت كذلك بهذا الكتاب أن أتخذ موقفًا مناوئًا ضد الرواية الجديدة وجانبها الموغل في الفكر.
الكتابة عمر إضافي
● ومع ذلك، غالبًا ما تستشهد بـ«ناتالي ساروت»، حيث يشعر القارئ أنك متأثر بأسلوبها.
■ تُعَدُّ ناتالي ساروت واحدة من الكتاب النادرين -ربما إلى جانب كلود سيمون- الذين أحببتهم من تلك الحقبة. أما الآخرون، فلم أكن أتذوقهم البتة.
● تقول في إحدى محاضراتك: «تمنحي الكتابة الإحساس بأن أيامًا زِيدَتْ في حياتي»؛ هل هذا هو جوهرك؟
■ إنها متعة مذهلة أن تولِّدَ، في صمت الليل في غياب أي سند بصري أو وجود شعاع ضئيل جدًّا منه، بل أن تخلق أحيانًا تجارب تغذي الحياة المستيقظة، الحياة اليومية، الحياة النهارية، وأن تشعر بها تطفو لذاتها وتقبض عليها… في حين، لا يستعد الجزء النهاري من الفرد بما فيه الكفاية لهذا الأمر؛ لأن الأحاسيس وانشغالات اليومي تسترعي انتباهه.
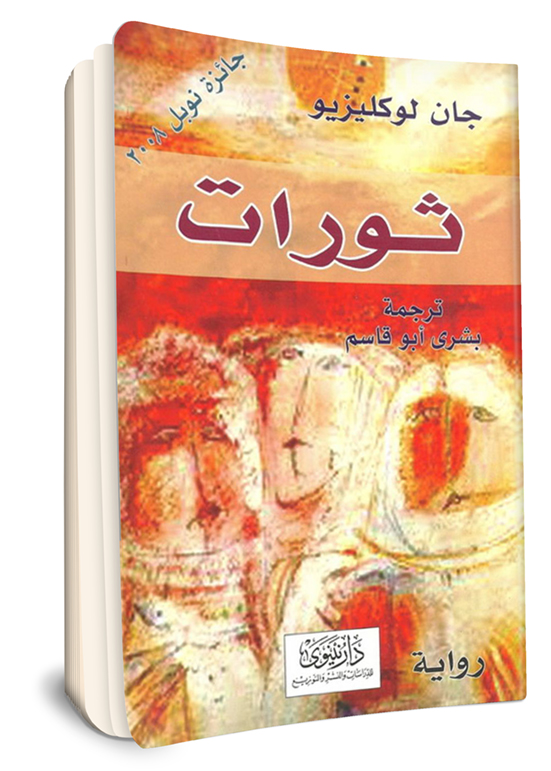 ● تقودنا كتبك إلى اللقاء بأسرتك وأصولك في جزر موريس، طبعًا، وفي الآونة الأخيرة في كوريا مع كتاب «بيتنا: تحت سماء سيول»؛ هل يعني هذا أن تكون كاتب «القطيعة»، كما وصفتك هيئة جائزة نوبل سنة 2008م؟
● تقودنا كتبك إلى اللقاء بأسرتك وأصولك في جزر موريس، طبعًا، وفي الآونة الأخيرة في كوريا مع كتاب «بيتنا: تحت سماء سيول»؛ هل يعني هذا أن تكون كاتب «القطيعة»، كما وصفتك هيئة جائزة نوبل سنة 2008م؟
■ لا أعرف لِمَ قالوا ذلك. ولا أحب أن أتحدث كثيرًا عما أكتب، كأن هذا الأمر صار بعيدًا جدًّا. يبدو لي أنني لم أختلف فعلًا عما كنتُ عليه في سن الحادية والعشرين، ولم أبتعد، على كل حال، من ذلك الذي كان يشعر بالغضب بسبب رحيله كجندي، الذي لم يرحل لحظة اجتيازه الامتحان النهائي لضباط الاحتياط. لم أكن أريد أن أكون ضابطًا. كنت أقول في قرارة نفسي: إنه لو توجب عليَّ الذهاب إلى الحرب، سأفعل كجندي عاديّ، لا كضابط، حتى لا أتحمل مسؤولية إصدار الأوامر؛ مثل: «اقتل هذا»، أو «اتخذ هذا الوضع».
● نشعر أن كتبك لم تَعُدْ، مع ذلك، قاتمةً أكثر بعد ذلك.
■ صحيح؛ لأنني سافرت، حيث علمني السفر أمورًا كثيرة. عندما غادرت فرنسا، وإنجلترا حيث عشت زمنًا طويلا في تلك المرحلة، وجدت نفسي في بلدان احتككت فيها بأناس مختلفين تمامًا، أناس يتمتعون بحرية لم أشهدها في أوربا، هي الحرية الحسية، الحرية داخل مشهد أقل تمدنًا لكنه مأهول بسكان أكثر شبابًا. عندما ذهبت إلى المكسيك، كان متوسط عمر السكان في تلك الحقبة هو 14 سنة. وعندما عدت إلى فرنسا، بدا أن متوسط العمر هو 74 سنة (يضحك).
● هل يسمح السفر بالاتجاه نحو أدب كوني؟
■ لا أدري هل نستطيع الحديث عن «أدب كوني»، حتى لو وُجِد. لا أجوب العالم لأروي أسفاري. ولا أنقل معي هواجسي وذكرياتي الطفولية وولعي غير المفهوم بجزيرة موريس التي لا أعرفها، وإن كان لها شأن كبير في تشكل طفولتي التي أحملها معي على الدوام. السفر عبء، ولا شيء غير ذلك، حيث لا أتنقل لأستشعر أحاسيس أو أغذي سيناريوهات، إنما من أجل متعة العيش في وسط آخر، من أجل هذه الحرية التي حدثتكم عنها، وهي حرية الحواس أكثر منها حرية الفكر. فالمكسيك أو الصين ليستا بالتأكيد نموذجين من نماذج الديمقراطية، لكنهما يبتكران حلولًا لكل الوضعيات المطروحة يومًا تلو الآخر، كما تفعل الطبيعة إلى حد ما. إضافة إلى ذلك، يصير البشر رائعين عندما ينقادون للطبيعة، وخطيرين عندما يحاولون معاكستها، وهو ما تسجله فرِد فارغاس، حيث أؤيد تأييدًا مطلقًا كل ما تقوله في كتابها الرائع «الإنسانية في خطر» [دار فلاماريون].
● من هم الكُتاب المعاصرون الذين تحبهم؟
■ إضافة إلى فرِد فارغاس، أحب ماري ندياي، وماري نيميي، حتى ماري داريوسيك.
حكمة صينية
● يتمحور كتابك المقبل حول كونفشيوس، الذي لم يكتب قط، لكنه خلَّف إرثًا أخلاقيًّا شفاهيًّا. بصرف النظر عن الثقافة؛ ما الذي تهتم به في الحكمة الصينية؟
■ مرت بي حقبة كانت الطاوية تفتنني. لكن ما يهمني إضافة إلى ذلك هو حقبة كونفشيوس، وبخاصة مينشيوس. أرى أنهما مفكران أصيلان، حيث عاشا في حقبة أفلاطون تقريبًا. تبدو أفكارهما أكثر حداثة من أفكار الفلاسفة اليونانيين، بل أقوى بما تتمتع به من بعد نظر، حتى إنني مندهش من أننا لا نحفل بها في أوربا، ونعدّها أفكارًا غرائبية؛ إذ يعدّ مينشيوس مبتكرَ مقولة: «الشعب أولًا، ثم الوطن، والملك أخيرًا»، التي استعادها دينغتشياوبينغ (رئيس الصين الأسبق). فالملك ليس مهمًّا، حيث يمكن تغييره، بل الشعب هو المهم. أرى أن التعبير عن هذه الأمور في سنة 600 قبل العصر المسيحي هو أمر استثنائي؛ إذ تبلبلني بصيرة بعض المفكرين في تلك الحقبة، التي كانت حقبة خرافات ودين، مثلما كان الأمر إلى حد ما في اليونان أو روما.
● هل تعتزم العودة إلى الصين؟
■ أجل. لقد دعتني الحكومة الصينية إلى دعم مشروع بناء فضاء ثقافي قرب شانغدو التي شيدت على أنقاض قرية دمرها الزلزال قبل خمسة وعشرين عامًا. كما أنوي أن ألتقي هناك الشاعرةَ «زاي يونغ مينغ»، مؤلفة نص هزّني فعلًا، عنوانه «نساء»، نشر باللغة الإنجليزية، لكنه لم يترجم حتى الآن إلى الفرنسية. ولدت سنة 1955م، لكن عاملتها الثورة الثقافية بقسوة. انتقلت إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتقيم هناك حتى التسعينيات، ثم عادت إلى الصين، حيث استقرت في شانغدو. إذا أتيحت لك فرصة السفر إلى الصين، زُرْ شانغدو! وأريد أن أتحدث أيضًا عن نهر يانغزي الرائع، وهو جزء مما يحرك مشاعري فعلًا في الصين. فالذكاء مؤثر، لكن إلى حد معين فقط.
● يضم كتاب «خمس عشرة محاضرة في الصين» سلسلة من المحاضرات التي ألقيتها حول الأدب والكتابة والقراءة، بين سنتي 2011م و2017م، بـشنغهاي ويانغزو وبيكين. وتربطك علاقة قوية بالصين منذ زمن طويل. كيف ولد هذا الشغف؟
■ أنا أنتمي فعلًا إلى الجيل الذي تأثر كثيرًا بما وقع في الصين عندما كنا في سن الخامسة والعشرين أو السادسة والعشرين. راودنا انطباع قوامه أن عالمًا جديدًا كان يبزغ، بوجود هذا الإغراء الاشتراكي الذي كان يحمّس الشباب؛ إذ يعود ارتباطي بالصين إلى هذه الحقبة.
● ارتكب بعضٌ أخطاءً كثيرة في تلك اللحظة…
■ تمامًا، لكن لا يتعلق الأمر بحالتي؛ لأنني لم أتمسك بهذا النوع من الخطاب طويلًا؛ إذ بدا ولوج ساكنة متعددة جدًّا وضاربة جذورها في التاريخ القديم، على نحو مفاجئ، إلى الممارسة الجماعية أمرًا فاتنًا في البداية. كان الأمر كأن هنود المكسيك، الذين هم اشتراكيون مذ كانوا، والذين يتشاركون أراضيهم ولا يتشاطرون مفهوم الملكية، فرضوا فجأة رؤية جديدة على العالم. فقد استهوت هذه الأفكار كثيرًا من المثقفين، حيث زاروا الصين. كنت منبهرًا ومسحورًا كذلك، فقلت في نفسي: إنه لا بد من تغيير الحياة جذريًّا. كان عَلَيَّ أن أؤدي خدمتي العسكرية في ذلك الوقت، فتطوعت إذًا لأفعل ذلك في الصين. كانت الرغبة تحدوني إلى الالتحاق ببعثة المعلمين إلى هناك، التي أنشأها أندريه مالرو، وزير الشؤون الخارجية في ذلك الوقت. قدمت ترشيحي؛ إذ كنت متحمسًا جدًّا ومقتنعًا بأنني سأسافر إلى هناك.
● لكن كلود مارتان، الذي سيصبح سفيرًا لاحقًا، هو من سيذهب عوضًا عنك. وبدلًا من الصين، وجدت نفسك في تايلاند، ثم في المكسيك. هل شحذ هذا الموعد الضائع رغبتك في زيارة هذا البلد؟
■ أجل، وما يثير الاستغراب إضافة إلى ذلك هو أنه نفسه أمل في الذهاب إلى تايلاند، بينما طلبت الذهاب إلى الصين! (يضحك). بعد هذا السفر الذي فَوَّتُّه، ذهبت إلى هناك كلما سنحت لي الفرصة، لوقت أطول في كل مرة. حاولت دائمًا أن أجد سببًا لأحلّ هناك.
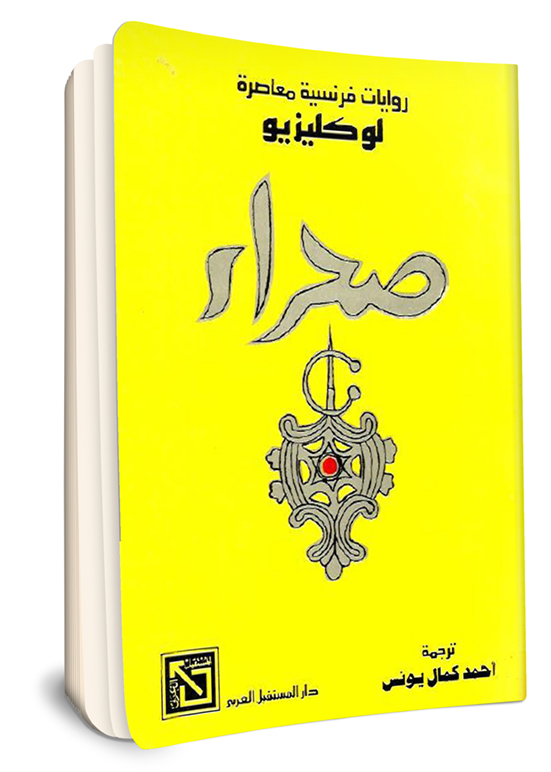 ● توجه نظرة نقدية بالطبع إلى الثورة الثقافية. تستشهد بـلاو شي، وهو كاتب صيني أعدمه الحرس الأحمر. هل يمكن القول: إن الثقافة الصينية وجدت على نحو حرّ خلال هذا النصف الثاني من القرن العشرين؟
● توجه نظرة نقدية بالطبع إلى الثورة الثقافية. تستشهد بـلاو شي، وهو كاتب صيني أعدمه الحرس الأحمر. هل يمكن القول: إن الثقافة الصينية وجدت على نحو حرّ خلال هذا النصف الثاني من القرن العشرين؟
■ بالطبع، لكننا لم ندرك، في أوربا، ما كان يعنيه ذلك. أما لاو شي، فتُفيد الرواية الرسمية أنه انتحر، حيث ما زالت الألسن تتداولها إلى اليوم إلى حد ما؛ إذ يتفادى الناس، على كل حال، الحديث عنها. لقد زرت البحيرة حيث عثر عليه غريقًا، وزرتُ أرملته، لكننا لم نتحدث كثيرًا. كان الحديث موجعًا لها. فعندما يحدث شيء ما يتجاوز الحد في بلد معين، في زمن بعينه، يحاول الجميع ألا يوقظوا الأشباح.
● ننظر، نحن الأوربيين، إلى هذا المجتمع بحيطة وحذر. كيف ترى، أنت الذي تتردد عليه، الطلبة الصينيين؟ وكيف تشتغل جامعاتهم؟
■ أولًا، إنها ضخمة، حيث يصل متوسط المعدل في الجامعة الصينية إلى خمسة وعشرين ألف طالب؛ إذ تضم جامعة بيكين، نحو مئة ألف طالب؛ أي ما يمثل كتلة ضخمة من الشباب في جميع التخصصات. ويجري الانتقاء وفق معدلات التنافس والامتحانات، ولكن أيضًا وفق قدرة الطلاب على تغيير التخصص. فعلى سبيل المثال، نظمت لقاءات أدبية، حيث كان أفضل المشاركين هم الطلبة الذين يهيئون بحوث ماجستير في علم البيئة والعلوم الطبيعية، وخصوصًا الفيزياء الفلكية. والمتفوقون في الأدب هم الفيزيائيون الفلكيون. والطلبة الصينيون قادرون على فعل أي شيء، وهم منفتحون على جميع المجالات.
بين الفرنسية والصينية!
● خلّد الصينيون الذكرى الثلاثين لمذبحة ساحة تيانانمان. وقد تحدثنا نحن عنها كثيرًا؛ هل ينطبق الأمر ذاته هناك؟
■ أجل، بإمكانهم التحدث عنها. لا وجود للممنوعات في هذا المستوى. ببساطة، ينظر الصينيون إلى هذا الأمر بوصفه ينتمي إلى الماضي.
● هل يعني هذا أن الصين في عهد رئيسها شي جين بينغ أكثر انفتاحًا؟
■ بالطبع، طالما أن الشباب يمكنهم الحديث عن كل شيء؛ إذ لا يهتم الشباب بتخليد هذه الثورة، المجهضة في نظري؛ لأنهم يعرفون أنها حصلت. فغير وارد أن يقولوا: إن الأمر قد وقع، مثلما كنا نسمع في حقبة معينة. ويعرفون أنه يستحسن، ربما، عدم الإكثار من الحديث عن ذلك، تحاشيًا لإثارة الانتباه. وما يهتمون به هو النجاح في دراساتهم، والتمكن ربما من ولوج جامعة أميركية خلال سنة أو سنتين، وتحقيق وضع أفضل بعد العودة، والاستفادة من الإيجابيات التي يمنحها التعليم. فآباء هؤلاء الشباب الذين أتحدث عنهم ليسوا أغنياء، إنما هم في الغالب فلاحون ينحدرون من القرى، رأوا النور هم أنفسهم في بلدات صغرى؛ إذ تفوق أبناؤهم؛ لأنهم نبهاء، وهو ما سمح لهم بولوج الجامعات في المدن الكبرى. لا يعني هذا أن المنبوذين ليسوا موجودين، بل هم موجودون، بالطبع، كما في المجتمع الأوربي.
● تشو يون هو مترجمك ودليلك في الصين، وهو أيضًا كاتب توطئة كتابك الأخير. وله كذلك مسار مذهل.
■ تشو يون جندي الثورة. لقد أتاحت حكومة ماو، ثم حكومة دينغ شياو بينغ، الفرصة لجميع الأشخاص الأكْفاء الذين كانوا يعيشون أوضاعًا لم يكن بمقدورهم التخلص منها قط في الحالة الطبيعية. فيما مضى، يظل المزارعون مزارعين. ثمة نظام، في الصين، يسمى بالـ«هوكو» (hukou)، حيث يولد الطفل وهو يحمل «هوكو» القرية، لا يمكنه الذهاب إلى المدينة، ولا يصبح ذلك ممكنًا إلا إذا التحق بالجيش. وإذا ارتأى الجيش أنه متفوق في عزف الكمان، فإنه يصير موسيقيًّا جيدًا، وإذا ارتأى أنه متفوق، سواء أكان ولدًا أم بنتًا، في إصلاح الدراجات، فإنه يصبح ميكانيكيًّا. من هنا، فالخدمة في الجيش هي بمنزلة وسيلة للتخلص من وضعه. الأمر أشبه بما جاء في (رواية ستاندال) «الأحمر والأسود»، في نهاية المطاف.
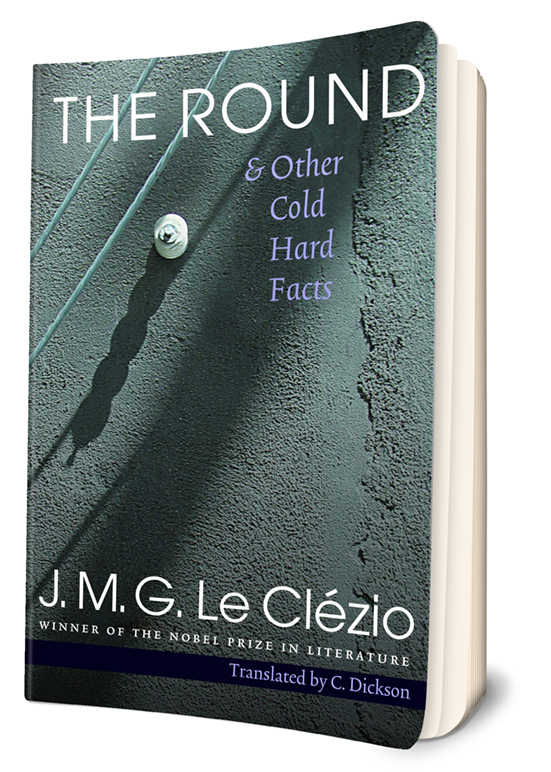 ● يرسم لك تشو يون، في توطئة كتاب «خمس عشرة محاضرة في الصين»، بورتريهًا مؤثرًا جدًّا؛ إذ يشدد على إنسانيتك واهتمامك بالآخر. من أين يتأتى لك هذا؟
● يرسم لك تشو يون، في توطئة كتاب «خمس عشرة محاضرة في الصين»، بورتريهًا مؤثرًا جدًّا؛ إذ يشدد على إنسانيتك واهتمامك بالآخر. من أين يتأتى لك هذا؟
■ تشو يون علَّامة كبير يعرف كل شيء عن الأدب الفرنسي والأوربي. وهو إنسان بسيط وبشوش، يتمتع بقوة ذهنية ترتبط بالثقافة الصينية ارتباطًا لا يقبل الجدل. وقد زرت قريته التي رأى فيها النور، وهناك أدركت مصدر تلك القوة. ذلك أن الناس الذين يعيشون هناك متحدون فيما بينهم اتحادًا قويًّا؛ إذ تشكل هذه الجماعات القروية الصغيرة عنفوان مقاومة التطور المفرط. وزرت القرية التي كانت مسقط رأس كاتب صيني أحبه كثيرًا، وهو بي فايو، الذي كان ضحية الثورة الثقافية، بعد أن رُمِيَ والداه بالرصاص، وتبناه زوجان مزارعان. وقد اشترى بي فايو، بفضل كتبه وعمله أستاذًا، بيتًا صغيرًا لوالده المتبني العجوز، حتى يعيش سنوات عمره الأخيرة في راحة واستقرار. عندما ذهبنا لزيارة هذا الأخير، كان قد انتقل للتو للإقامة في ذلك البيت. كان خارج البيت، يرتدي معطفه الصوفي القديم كعادة أي مزارع صيني، ويضع طاقية على الرأس؛ لأنه يرفض أن يمتلك جهاز تدفئة في بيته. فهو يقبل بالكثير من ابتكارات الحداثة- مثل: الهاتف، بل مشاهدة التلفزيون بين الفينة والأخرى- لكنه يرى في امتلاك جهاز تدفئة أمرًا يتجاوز الحد. ثمة شكل من أشكال المقاومة القديمة، يتأسس على متانة العلاقة بين الجسد والروح. فهذه العائلات القروية الباقية مؤثرة ببساطتها وقوتها. إنني مفتتن بتجربة أولئك الأزواج العجزة، مثل تجربة العائلات التي يشكلها والدا «تشو يون»، أو والدا «بي فايو»، أو والداي. إننا نشترك في هذا الحب الذي نكنّه لهم، رغم أن حيواتنا مختلفة.
● أنت تتحدث في الواقع عن «النمط ذاته».
■ أجل، فما أتقاسمه مع تشو يون هو أنني، أنا أيضًا، أحب والديَّ كثيرًا.
● ومع ذلك، فأنت تقدم صورة قاسية جدًّا عن والدك، في كتبك، وبخاصة في «الإفريقي».
■ أجل. لقد كان قاسيًا، لكنه كان محبًّا؛ إذ أَحَبَّ والداي بعضهما بعضًا حبًّا لم ينطفئ على امتداد حياتيهما، هذه المغامرة الطويلة التي اعترضتها عواصف السياسة وتقلبات الحرب التي فرقت بينهما مع ذلك. كان الأمر شاقًّا على والدتي التي لم تجد ما تسُدُّ به رمقنا في ذلك الوقت. وقد بقينا على قيد الحياة بفضل حليّ العجائز الثريات التي كانت تبيعها جدتي.
● في العام الماضي، اتخذتَ موقفًا مؤيدًا للمهاجرين في مقالة نشرتها جريدة لوموند، تشرح فيها أن السياسة بفرنسا كانت قمعية جدًّا، وبخاصة سياسة جيرار كولومب. في نظرك، هل ما زالت هناك دواعٍ تدفع إلى الغضب والاستنكار؟
■ نعم، هناك دواعٍ كثيرة. لكن بما أنني لا أنتمي إلى أي حزب، ولستُ مناضلًا بطبعي، فإنني أحتفظ بهذا لنفسي. ليس هناك سوى زوجتي التي تتحمل تظلماتي بين الفينة والأخرى.
عن مجلة لير الفرنسية.
