
الكتابة والـتماهي والجنون.. ما يفعله الكاتب لبلوغ ما هو كامن في عقل شخصياته
اعتراف: إنّني كاتبة أتّبعُ طريقة التّماهي في كتابتي. أعلمُ أنّ ذلك ربّما يبدو أمرًا بغيضًا على نحوٍ لا يُصدَّق، غير أنّني أبتغي الاعتراف بحقيقة ثلاثة كُتبٍ هي نتاجُ مساري المهنيّ. الأمر يُشبه روبرت دي نيرو وهو يتحصَّلُ على رخصته في فيلم Taxi Driver، أو كهال بيري وهي تقضي أسبوعين دون أن تتحمّم، استعدادًا لأداء دورها مدمنة مخدرات في فيلم Jungle Fever، كذلك هي رغبتي في مُعايشة شخصيّاتي الكتابيّة؛ إنّها تتدخّلُ عنوةً بشكلٍ عارض في عادات حياتي الحقيقية، في أذواقي، وعيي بذاتي، وفي شخصيّتي. وكثيرًا ما أستطيبُ محاولات التطفُّل تلك في غالب الأحيان. فهي تجعلني أشعرُ بأنّني على قيد الحياة. بأنّني مُتماهية في الأشياء. أفيضُ بالطّاقة والنّشاط. قادرة على فِعل أيّ شيء، بما فيها المروق من خمسة إلى تسعة أيّام عملٍ وأنا بمعدة خاوية، أكتبُ في أوقات راحتي، أعود مسافة الثمانية كيلومترات إلى بيتي مشيًا، أُكرِّرُ ألف عَدَّةٍ على آلة التجديف الرياضية، أشقُّ فوهة قنينة وأكتبُ حتى حلول موعد العَشاء، وأواصلُ الكتابة بعده.
تلك كانت طريقتي لبلوغ ما هو كامنٌ داخل عقل آخر أبطالي؛ بولينا نوفاك: طالبة بكالوريوس تعيش في نورث شور، تُعايشُ آلام أزمة أواخر العشرينيات، تنزحُ للعيش صحبة طائفةٍ تعيش على ساحل البحر، لينتهي بها المطاف لتُقتَل بشكلٍ وحشيّ. إلى هنا يبدو أنّ الأمور تجري على ما يُرام- إلى أن، ذات يومٍ بعد الظهيرة، بعد مُضيّ شهرين على تلك الحياة الرتيبة، حَلّت بي نوبةُ صَرعٍ دامت خمس دقائق، وسقطتُ في غيبوبةٍ استمرّت ثمانية أيّام.
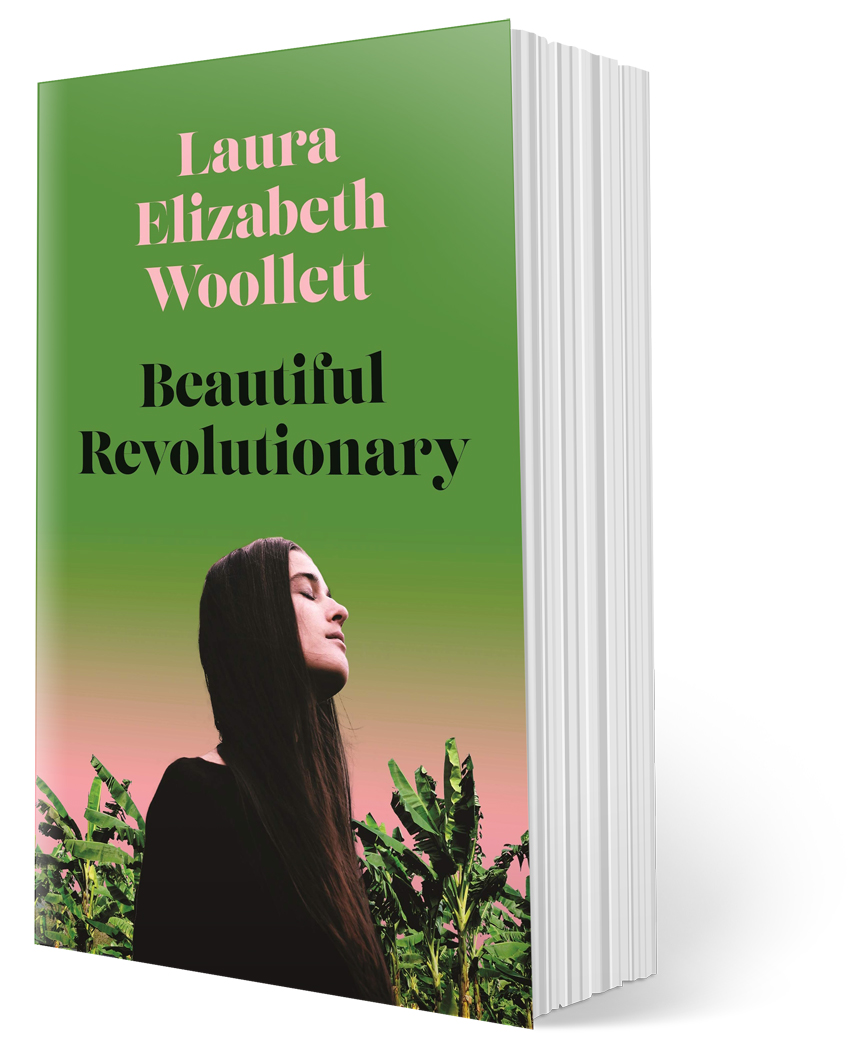 استلزمت روايتي «ثورية فاتنة» عامين ونصفًا كي أفرغ من كتابتها. فقد تطلَّبَت منّي القيام بكثير من البحث، بعض تلك الأبحاث استتبَع مني السَّفر لأجل إتمامها. الأكثر أهميّة في هذا، هو أنّ ذلك الوضع قد استلزمَ مني أن أضعَ نفسي في الحالات العقلية التي كانت تُعايشها شخصيّاتي، وكانت تلك الشخصيات من فئة الشباب الذين كانوا يعيشون في الستّينيّات والسبعينيّات، حيث كانوا قد انجرفوا في حركةٍ ثوريّة، تحوّلَت إلى حركةٍ عدوانية. النقطة المركزيّة في تعريفي هُويّتي كانت إيفيلن ليندِن: امرأةٌ ذكيّة، حديثة الزواج من أحد المشتغلين بالسياسة، وقد صارت اليد اليمنى لقائد الطائفة.
استلزمت روايتي «ثورية فاتنة» عامين ونصفًا كي أفرغ من كتابتها. فقد تطلَّبَت منّي القيام بكثير من البحث، بعض تلك الأبحاث استتبَع مني السَّفر لأجل إتمامها. الأكثر أهميّة في هذا، هو أنّ ذلك الوضع قد استلزمَ مني أن أضعَ نفسي في الحالات العقلية التي كانت تُعايشها شخصيّاتي، وكانت تلك الشخصيات من فئة الشباب الذين كانوا يعيشون في الستّينيّات والسبعينيّات، حيث كانوا قد انجرفوا في حركةٍ ثوريّة، تحوّلَت إلى حركةٍ عدوانية. النقطة المركزيّة في تعريفي هُويّتي كانت إيفيلن ليندِن: امرأةٌ ذكيّة، حديثة الزواج من أحد المشتغلين بالسياسة، وقد صارت اليد اليمنى لقائد الطائفة.
أيُّ امرئٍ كان يراني حينها بانتظامٍ وقتما كنتُ أشتغلُ على روايتي «ثورية فاتنة» ربّما لاحظ كيف أنّني بدأتُ أرتدي الآتي: بناطيل واسعة عند أطرافها، تنانير قرويّة، سُترات شعبيّة، ملابس ذات ياقات ضيّقة طويلة عند العنق، عَمَرات (خرزاتُ الحُبّ)، تيشيرتات عليها شعاراتٌ عن السلام، وعن المحبّة، والانتشاء. ومن ضمن الأمور الأكثر سِريّة، هي أنّني دخَّنتُ المزيد من الحشيش، وحدث أن تعاطيتُ المخدِّرات للمرّة الأولى. نادرًا ما كنتُ ألبس سوتيانات أو أستمع إلى موسيقا أُنتجَت بعد عام 1978م.
كان هناك ثمّة أشياء أُخرى أكثر خصوصيّة تتعلَّقُ بإيفيلن. كنتُ أعيرُ أحداث العالم مزيدًا من الاهتمام، وكنتُ أشعرُ إزاءَها بأنّني أكثر كابوسيّة. كان عندي حِسٌّ بوجود غايةٍ ما، هو تقريبًا شُعورٌ رُوحيٌّ. قلّ تَبسُّمي في وجه الغُرباء. حين كنتُ أُضفِّرُ شَعري، كنتُ أفضِّلُ جعله في جديلةٍ أنيقةٍ أو على شكل كعكة. الأشياءُ التي كانت تُعجبني عن وجهي كانت متفاوتة: الرموش، والفَكّ. كنتُ أرغبُ في أنفٍ مدبّب أكثر، وشعرٍ أملس أكثر.
وبعدها انتهت الرواية، وبالتالي كان ارتباطي بكلّ هذه الأشياء. لم أكن أعرف بعدها أيّ موسيقا كنتُ أحب، لذا كنتُ أستمعُ إلى الإذاعة. لم أكن أعرف ماذا عليّ أن أرتدي، لذا كنتُ أرتدي الملابس نفسها، بينما شعور المتعة المصاحب لذلك صار أقلّ. كنتُ أشعرُ بقلقٍ عام وبمزيدٍ من الحسد. ومع ذلك، كنتُ آكلُ بشكلٍ أفضل، وأنامُ بمزيدٍ من العُمق والاستغراق أكثرَ مِمَّا عهدتُه في نفسي منذ سنوات.
حينما تكون السِّمة المفضَّلة لديكَ عن نفسك هي مُنتجكَ الإبداعيّ؛ فإنّ شعورك عندما لا تكتبُ الكثير خلال ما يزيد على اثني عشر شهرًا يُشبه أن تفقد ذاتك. حينما يكون التوقيت هو العامُ نفسه، المفترَض أن تروِّجَ فيه لكتاب، وتأتي ردود الأفعال على كتابك على نحوٍ يبعثُ على التشتت؛ يكون وقعُ الخسارةِ أعظمَ مِمَّا هو قائم. فكلُّ مراجعةٍ سلبيّة عن الكتاب، كلُّ مهرجانٍ لم أُدَع إليه، كلُّ قائمة مهام يجب إنجازها قبل نهاية العام أعددتها ولم أُنجِزها، كلُّ ثأرٍ أخذتُ به، يتسبّبُ في أذيتي أكثر قليلًا عن ذي قبل، على رغم أنّني في الماضي عادةً ما كنتُ أستقبلُ تلك الأشياء كما هي برحابة صدر.
كانت تلك أحداث عاميْ؛ 2018م. في بواكير 2019م، كان الأمرُ كما لو أنّ القابِس أُدير في الاتجاه المعاكس. لم أعد أُبالي. جزءٌ من ذلك كان يُعزى إلى الطاقة المرافقة لحلول عامٍ جديد، لقد قررتُ ألّا أُبالي بأيّ شيء. على رغم هذا ثمّة عوامل أُخرى كانت؛ لقد كنتُ عائدةً لتوّي من إجازةٍ بمنطقة استوائيّة، وقد أدّت تلك الإجازةُ أثرها المرجوّ: لقد جعلتني أشعر بالاسترخاء. وبدأتُ في علاج متلازمة «الاضطراب المزعج السّابق للحيض». كان العلاج مجرّد حبة مانع حمل متواضعة آخذها عن طريق الفم، وهو الدواء المسمّى Yaz، غير أنّها عجّلَت بشفائي في أقصر وقتٍ ممكن.
وألفيتُني فجأةً أكتبُ مُجدّدًا، بمزيدٍ من الجلاء والغزارة أكثر من السّابق. كنتُ أدركُ أيّ سبيلٍ تسلُكها روايتي، كنتُ أستجلي التفاصيل الجديدة بوتيرةٍ أسرعَ مِمّا كان باستطاعتي أن أُثبِتها. كانت الليالي مزدحمة عن آخرها، كنتُ أفيقُ بعد نومٍ دام ساعاتٍ قلائل، تدبُّ الحيويّة في عروقي، وقلبي يطفرُ في الأنحاء كما ضفدع. حين كنتُ أغلق عينَيّ، كانت العتمة فيما وراء رموشي تتهادى، كما لو أنّني أتعافى من أثر تناول مُخدّر. وفي صباحات تلك الأيام، كنتُ أنهضُ من السرير مؤيَّدَةً بشفَقِ اكتشافٍ ما. كنتُ أسعى إلى الكتابة عن رحلة الذهاب من بيتي إلى محلّ عملي في أحد مراكز خدمة العملاء.
حين قرأتُ لأول مرةٍ عن الكاتبة ميتشل ماكنامارا شعرتُ بحِسٍّ من البصيرةِ، تلك التي قد أخطأت في التعرف على زوجها وحسِبَته مُتطفِّلًا اقتحم المكان في منتصف الليل، وجعلت تُرنِّحُ اللمبة فوق رأسه أثناء عملية استجواب «قاتل الولاية الذهبيّ». في 2016م، ماتت ماكنامارا أثناء نومها. وقد عُزِيت أسبابُ موتها جُزئيًّا إلى المستحضرات الطّبيّة التي اعتادت أن تتعاطاها كي تسيطر على نوبات الأرق والقلق التي جلبها عليها بحثُها. كتابها المبني على قصة جريمة حقيقية «سوف أتلاشى في الظلام: بحثُ امرأةٍ مهووسة عن قاتل الولاية الذهبيّ». كان أعلى الكتب مبيعًا بعد وفاة كاتبته.
عوالم سردية خيالية
نزوعُ المؤلِّفين إلى غَمر ذواتهم في عوالم سَرديّة خياليّة ما هو بسِرّ، إلى حدّ أنّهم، غالبًا ما يتجاهلون العالم من حولهم. وكذلك ليس بسرٍّ أنّ المؤلِّفين يستلهمون من أحداث الحياة الحقيقية وتجاربها. فقد قضت ستيفاني دانلر سنواتٍ في العمل في أحد المقاهي في يونيون سكوير، بينما كانت تخطُّ «المبلِّغ»، حيث تدور روايتها عن فتاةٍ ساذجة تعمل نادلة في مدينة نيويورك. فلاديمير نابوكوف ألّف «لوليتا» أثناء رحلته برًّا عبر الولايات المتحدة. وجّهت دافني دي موريه مخاوفها بشأن خطيبة زوجها السّابقة لأجل روايتها القوطيّة «ريبيكا».

هالي بيري
المنهجُ المتّبعُ في عملية الكتابة ليس بهذا القدر من التفاوت؛ إنّه نهجٌ أكثر تأنّيًا قليلًا فحسب. يتضمّنُ اختياراتٍ وقيودًا فيما يتعلَّقُ بالوسائط التي نستهلكها، الملابس التي نرتديها، الأماكن التي نسكُنها. على افتراض أنّ فيكتور هوغو أغلق خزانته على جميع ملابسه الفاخرة، ولم يكن يضع على جسده من شيءٍ سوى شالٍ رماديٍّ مغزول وهو يشتغلُ على روايته «أحدب نوتردام». مارلون جيمس، وهو يكتب روايته «تاريخ مختصر لسبع جرائم قتل»، كان يستمع إلى ألبوم بوب مارلي «الخروج» على نحوٍ متكرّر. الكاتب طومسون هودجكنسون، الذي صرّح بأنه كاتب يتّبع منهج المعايشة أثناء الكتابة، كتب معظم أجزاء روايته «مذكّرات مُطارِد» أثناء احتجازه في حجرةٍ صغيرةٍ مُظلِمة.
منذ البداية، كانت بولينا تختلفُ عن إيفيلن. فقد كانت أكثر صَخَبًا. أكثر مرحًا. أفضلُ مغازَلة. سِكِّيرة بدرجةٍ أكبر. كانت بولينا تتحدّث بلكنةٍ أكثر جلافةً من لكنتي، كنتُ أحاكي لكنتها في مكالماتي أثناء العمل وأنا أتحدّثُ إلى غُرباء. كانت ترتدي بشكلٍ أساسي سوتيانات صغيرة رياضيّة، وطِماقات، قمصان تحتيّة رجاليّة، وتهندم شعرها على شكل ذيل حصان، وتربطه بحاشية من القماش. فكّرتُ جدّيًّا في ربط شعري بحاشية على رغم علمي بأنّ هيئتي أفضل دونها. فكّرتُ في نَتْفِ حاجِبَيَّ كي تُشابه موضة الحواجب الرفيعة في العِقد الأول من الألفية الثانية. كانت بولينا ترغبُ بشدة في صُنع وشمٍ عند أسفل ظهرها؛ وبدأتُ أنا كذلك أشتهى صُنعَ الوشوم.
وبهذا كان هناك ثالوثٌ من الشعائر يجعلني أشعر أنّني مُقرَّبة من بولينا على نحوٍ خاص: الجوع، والتمرين، واحتساء الشراب. بعد عودتي إلى بيتي من عملي سيرًا على الأقدام، كنتُ أتوجّه مُباشرةً صوب آلة التجديف، كنتُ أشغّل شيئًا ما سريع الإيقاع من قائمة بولينا الموسيقيّة- أغنية «حشود» لفرقة بوهوس، «نترات الحيوان» لسوِايد، «قاتل مُختَلّ» لفرقة Talking Heads- وأتمرّن إلى أن أتصبَّبَ عرقًا. ثم آخذ حمّامًا وأفُضُّ زجاجة مشروب رخيصة، أحتسي نصفها على معدةٍ خاوية.
كانوا معتادين على تفحُّص بطاقة هُويّتي في كلِّ مرةٍ أذهبُ فيها إلى محلّ بيع الشراب. لقد توقّفوا عن فعل ذلك. في مرّة، غمزت لي الفتاة الواقفةُ على صندوق الدّفع. ماذا عن مشاعري إزاء هذا؟ كما لو أنّي بلغتُ شيئًا ما يخصُّ كلَّ بولينات العالم.
***
كنتُ أشعر في الأسبوع الذي أصابني فيه الصّرع كما لو أنّي كنتُ أتّجه نحو هلاكي قبل أن تبدأ النوبة. الأعمال الإنشائية الخاصّة بالتّرام كانت متواصلة حتى يمرّ من حَيِّنا. كانت النشرات الجوية تتنبّأ بارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع. نفد الملحُ من خزانة المؤَن. وقد طهونا دونه، واعدين أنفسنا بإعادة ملئه في اليوم التالي ثم اليوم التالي. على الأرجح، لو أنّني أزلتُ أحد عناصر الثالوث في ذاك الأسبوع- الجوع، تمارين الكارديو، الكحول- لظللتُ على ما يُرام. لكنّني أبقيتُ على ثلاثتهم جميعًا، مُسرفةً في شرب الماء كي أوازن منسوب الكحول في جسدي. واصلت أخذ Yaz، غافلة عن خطورة أحد أعراضه الجانبية لأن عندي انخفاضًا في مستوى الصوديوم، نظرًا لاحتواء خزانة المؤن على أقلّ كمية من الملح. مَن الذي يفكّر في هذه الأشياء؟ من الأكيد أنّهم ليسوا كتّابًا أصحاب طريقةٍ في الكتابة، قد بلغوا مرتبة عالية في طرائقهم.

روبرت دي نيرو في فلم «سائق تاكسي»
نوبة الأرق التي كنتُ أُعانيها كانت سيّئة ذاك الأسبوع على وجه الخصوص. صباح يوم الجمعة، لم أذهب إلى لعمل بدعوى أنّي مريضة- وهو شيءٌ غالبًا لا أفعلُه. حتّى ذلك الحين لم أكن أتصرّفُ مثل شخصٍ مريض؛ فلم أضطجع على الأريكة وأشاهد نتفيلكس. بدلًا من هذا، ذهبتُ إلى المقهى المحلّي الذي أجلسُ فيه كي أعتصر بضع ساعاتٍ من الإنتاجِ وأستخلصه من جسدِي المنهَك.
أحبُّ المقاهي المحلّية على وجه الخصوص لأنّها أماكِنَ مُهمَلَة؛ أماكن بإمكان كاتبٍ صُعلوكٍ أن يقصدَها، يطلب مشروبًا لشخصٍ واحد، ويتجرَّع ما شاء له من أباريقَ مياه بقيّة وقته. ذاك اليوم الذي بلغت فيه حرارة الجو 38 درجة، طلبتُ شرابًا باردًا، كان على الأصحّ قهوة مُثلَّجَة غنيّة بالمزيد من السعرات الحراريّة. شربتُ يومها على الأقل ثلاثة لترات من الماء، ربّما ما يقرب من الخمسة لترات. على رغم كثرة ما شربتُه، كان ذلك كفيلًا بخفضِ منسوب الصوديوم في الدم عن المستوى الطبيعي، والذي هو 140 مليللتر مكافئ في اللتر الواحد، لينزل إلى 115- وهو الذي يعرف طبّيًا بأنه هايبوناترميا Hyponatremia. واتتني نوبة الغثيان حوالي الثالثة والنصف عصرًا، فبارحتُ المقهى مسرعةً إلى البيت. تقيّأتُ في البالوعة، بعثتُ برسالةٍ على الهاتف إلى زوجي أن يترك عمله ويأتي إلى المنزل في الحال، ويأتي معه بزجاجة غاتوريد. وبفضله الأبديّ، فعل ذلك. واصلتُ التقيُّؤ. جلسنا على الأريكة نفتّش في جوجل عن دلالة الأعراض، غير أنّ سطوع شاشة هاتفي كان يؤذيني وسبّب لي صداعًا. توقّف جسدي عن نشاطه قبل الخامسة عصرًا فحسب.
بعدها مرّت ثمانية أيّامٍ عبارة عن خواء، تعجُّ بالأحلام وبالمخاط وعمليات تنظيف الأسنان الإجباريّة. أفقتُ ليلة السبت الذي تلا ذلك وفي حلقي أنبوب تنفس صِناعيّ، أهلوِسُ بأنّني أرى جِربارات ورديّةً طازجة، وجِراء استردادٍ ذهبيّة اللون- حسبما شرحت لي مُمرِّضةٌ فاتنة ما قد فعلتُه أنا بنفسي.
الكتابة هوس يفسد الحكم على الأمور
حينما بدأتُ العمل أصلًا على تلك المقالة عن التماهي في الكتابة، كنتُ أُخطِّط لاستكشاف الأمر في أوقاتِ الذروة والحضيض؛ مثل: كيف أنّ الكتابة عن طريق المعايشة- في أفضل صورها- هي عبارة عن عملية تفاعُليّة تجعلُنا أكثر قُربًا من شخصيّاتنا. الكتابة، وفي أسوأ أحوالها، تكون هَوَسًا يُفسدُ الحكم على الأمور. عندي طُرفة أرغب في روايتها: الوظيفة المؤقّتة التي طُرِدتُ منها، بعد أن تناسيتُ الكثير الكثير من نوبات العمل، حلقاتُ الفلفل المقطّعة على شكل عين طائر، تلك التي كنتُ أحرقُها، أحالت مطبخنا إلى سحابةٍ من رذاذ الفلفل. لقد كانت لديّ شكوكٌ بشأن قابليّة طرائقي للاستمرار والصمود، غير أنّه كان عندي ثقةٌ فيها كذلك، بأنّها كانت تستحقّ المخاطرة، ما دمتُ في تلك الأثناء غزيرة الإنتاج. لم أكن أعي حينها كم كانت طرائقي غير قابلة للاستمرار.
وعلى رغم ما كان، لم أكفّ عن ممارسة التّماهي في عملية الكتابة، ولستُ أنوي فِعل هذا. حتى في المدة التي لازمتُ فيها السرير، كانت الموسيقا التي تسمعها بولينا هي ما كنتُ أطلبه من الممرضات أن يُشغِّلنه لي، ملابسُ بولينا هي ما كنتُ أشتاقُ إليه، عوضًا عن عباءات المشفى. وشْمُ بولينا هو ما كان يشغلُ فِكري حين رأيتُ الكدمة الناجمة عن الحقن في الفقرة القطنيّة أسفل ظهري. كانت فكرة عيش حيوات الآخرين هي ما يشدُّ من أزري، بينما كنتُ عالقة في العناية المركزة وأنا بعمر التاسعة والعشرين.
لكنّ بولينا لم تكن هي الشخص الذي هرع إليه زوجي من عمله إلى البيت لأجله، ولا الشخص الذي طار أهلي لأجله من بيرث كي يسهروا على الاعتناء به. أتفهَّمُ كوني شخصًا مهمًّا بحكم رابطةٍ عائليّة، وليس ببساطةٍ بكوني جسدًا عائِلًا لنفس غير نفسه؛ فثمة أهمية لتلك المرأة التي تنام، وتأكل، ولا تُحسنُ الاستفادة من كلِّ ساعةٍ في ساعات يومها. إنّني أرغب لها أيضًا أن تواصل وجودها.
أحبُّ المقاهي المحلّية على وجه الخصوص لأنّها أماكِنَ مُهمَلَة؛ أماكن بإمكان كاتبٍ صُعلوكٍ أن يقصدَها، يطلب مشروبًا لشخصٍ واحد، ويتجرَّع ما شاء له من أباريقَ مياه بقيّة وقته. ذاك اليوم الذي بلغت فيه حرارة الجو 38 درجة، طلبتُ شرابًا باردًا، كان على الأصحّ قهوة مُثلَّجَة غنيّة بالمزيد من السعرات الحراريّة. شربتُ يومها على الأقل ثلاثة لترات من الماء، ربّما ما يقرب من الخمسة لترات. على رغم كثرة ما شربتُه، كان ذلك كفيلًا بخفضِ منسوب الصوديوم في الدم عن المستوى الطبيعي، والذي هو 140 مليللتر مكافئ في اللتر الواحد، لينزل إلى 115- وهو الذي يعرف طبّيًا بأنه هايبوناترميا Hyponatremia. واتتني نوبة الغثيان حوالي الثالثة والنصف عصرًا، فبارحتُ المقهى مسرعةً إلى البيت. تقيّأتُ في البالوعة، بعثتُ برسالةٍ على الهاتف إلى زوجي أن يترك عمله ويأتي إلى المنزل في الحال، ويأتي معه بزجاجة غاتوريد(1). وبفضله الأبديّ، فعل ذلك. واصلتُ التقيُّؤ. جلسنا على الأريكة نفتّش في جوجل عن دلالة الأعراض، غير أنّ سطوع شاشة هاتفي كان يؤذيني وسبّب لي صداعًا. توقّف جسدي عن نشاطه قبل الخامسة عصرًا فحسب.
بعدها مرّت ثمانية أيّامٍ عبارة عن خواء، تعجُّ بالأحلام وبالمخاط وعمليات تنظيف الأسنان الإجباريّة. أفقتُ ليلة السبت الذي تلا ذلك وفي حلقي أنبوب تنفس صِناعيّ، أهلوِسُ بأنّني أرى جِربارات(2) ورديّةً طازجة، وجِراء استردادٍ(3) ذهبيّة اللون- حسبما شرحت لي مُمرِّضةٌ فاتنة ما قد فعلتُه أنا بنفسي.
الكتابة هوس يفسد الحكم على الأمور
حينما بدأتُ العمل أصلًا على تلك المقالة عن التماهي في الكتابة، كنتُ أُخطِّط لاستكشاف الأمر في أوقاتِ الذروة والحضيض؛ مثل: كيف أنّ الكتابة عن طريق المعايشة- في أفضل صورها- هي عبارة عن عملية تفاعُليّة تجعلُنا أكثر قُربًا من شخصيّاتنا. الكتابة، وفي أسوأ أحوالها، تكون هَوَسًا يُفسدُ الحكم على الأمور. عندي طُرفة أرغب في روايتها: الوظيفة المؤقّتة التي طُرِدتُ منها، بعد أن تناسيتُ الكثير الكثير من نوبات العمل، حلقاتُ الفلفل المقطّعة على شكل عين طائر، تلك التي كنتُ أحرقُها، أحالت مطبخنا إلى سحابةٍ من رذاذ الفلفل. لقد كانت لديّ شكوكٌ بشأن قابليّة طرائقي للاستمرار والصمود، غير أنّه كان عندي ثقةٌ فيها كذلك، بأنّها كانت تستحقّ المخاطرة، ما دمتُ في تلك الأثناء غزيرة الإنتاج. لم أكن أعي حينها كم كانت طرائقي غير قابلة للاستمرار.
وعلى رغم ما كان، لم أكفّ عن ممارسة التّماهي في عملية الكتابة، ولستُ أنوي فِعل هذا. حتى في المدة التي لازمتُ فيها السرير، كانت الموسيقا التي تسمعها بولينا هي ما كنتُ أطلبه من الممرضات أن يُشغِّلنه لي، ملابسُ بولينا هي ما كنتُ أشتاقُ إليه، عوضًا عن عباءات المشفى. وشْمُ بولينا هو ما كان يشغلُ فِكري حين رأيتُ الكدمة الناجمة عن الحقن في الفقرة القطنيّة أسفل ظهري. كانت فكرة عيش حيوات الآخرين هي ما يشدُّ من أزري، بينما كنتُ عالقة في العناية المركزة وأنا بعمر التاسعة والعشرين.
لكنّ بولينا لم تكن هي الشخص الذي هرع إليه زوجي من عمله إلى البيت لأجله، ولا الشخص الذي طار أهلي لأجله من بيرث كي يسهروا على الاعتناء به. أتفهَّمُ كوني شخصًا مهمًّا بحكم رابطةٍ عائليّة، وليس ببساطةٍ بكوني جسدًا عائِلًا لنفس غير نفسه؛ فثمة أهمية لتلك المرأة التي تنام، وتأكل، ولا تُحسنُ الاستفادة من كلِّ ساعةٍ في ساعات يومها. إنّني أرغب لها أيضًا أن تواصل وجودها.
إليزابث وولنت: من مواليد ملبورن في أستراليا. كتبت القصة القصيرة والرواية، من أعمالها: “عشق رجل سيئ”، “غابة الانتحارات”. حصلت قصتها القصيرة “حبّات فول صويا” على جائزة جون ماردسن هاتشت للكُتّاب الشباب، وقد استخدمت قيمتها المالية للسفر إلى أميركا، لإجراء العديد من المقابلات مع أشخاص، كبحث، لأجل روايتها “ثوريّةٌ فاتنة”.
المصدر: https://www.killyourdarlings.com.au/article/the-method-and-the-madness/
هوامش:
(1) غاتوريد: علامة تجارية لمشروب رياضي من إنتاج شركة بيبسي.
(2) جربارة: جنس نباتي من فصيلة النجميّات، يُعدّ من نبات الزينة.
(3) كلب استرداد: كلب صيد يُربّى لاسترداد الطيور أو الفرائس، ويعيدها إلى الصياد دون إلحاق أيّ ضررٍ بها.
