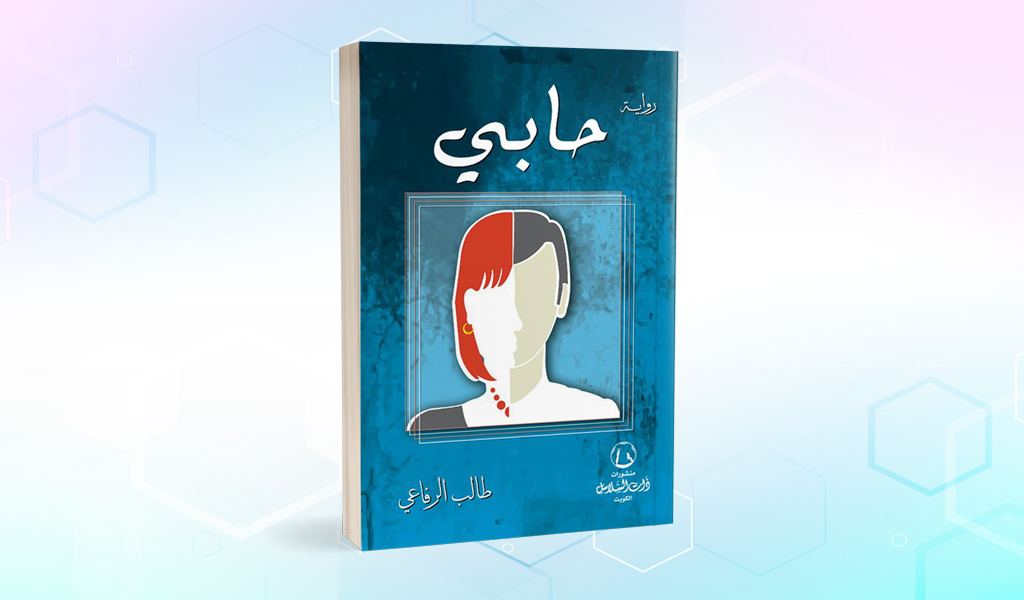علي حسن الفواز - ناقد عراقي | يناير 1, 2025 | بورتريه
تدخل أطروحة «الأسلوب المتأخر» في سياق توصيف زمني، لكنها تُشاكله، على مستوى توصيف مسار هذا الزمن، وعلى مستوى ما تُثيره من حساسية وجدل، يجعل من هذا التأخر «دافعًا عظيمًا لإبداع جماليات تختل فيها مقولات السرد، عبر جعل الكتابة تمثيلًا للمغامرة، فيكون النص المكتوب عنوانًا فارقًا للإبداع، نافيًا عنه فكرة «الموت» ودافعًا المؤلف للانخراط في لعبة الكتابة، بوصفها أسلوبًا بالمغايرة والابتكار، وعلى نحوٍ يؤدّي إلى ما يشبه انتهاك النمطي والتقليدي؛ إذ يتحوّل ذلك الأسلوب إلى رهانٍ على جدّة تلك الكتابة، وعلى مقاربة ما هو متعالٍ في أسلوبها؛ إذ يصف إدوارد سعيد فكرته عن «الأسلوب المتأخر» منطلقًا من نظرة فيلسوفه المُفضّل تيودور أدورنو، حول علاقة الأسلوب بقوة الحياة، وبالتسويغ على أن تبقى على قيد الحياة متجاوزًا المقبول والعادي». (إدوارد سعيد: «الأسلوب المتأخر: موسيقا وأدب عكس التيار»، ترجمة فواز طرابلسي، دار الآداب، بيروت 2015م، ص20).
الكتابة المتأخرة فكرة ولغة
نزع إدوارد سعيد إلى التعاطي مع فكرة «الكتابة المتأخرة» بوصفها كشفًا عن تلك «القوة»، وجعلها الشفرة التي تُبرر سيمياء رفض الموت، عبر الشغف بها، أو النفي داخلها، بوصفها محاولة في التمرد والتشظي، وفي تصوير حياة لها نصوص متعالية، ومعرفة عميقة تقارب التحولات التي تعصف بحياة الأدباء، فيصف أصحابها قائلًا: «سوف أكتب عن كبار الفنانين، وكيف اكتسى كلامهم وفكرهم في نهاية حياتهم لغة جديدة، وهو ما سوف أسمّيه بـالأسلوب المتأخر». (المصدر السابق).
 لتبدو تلك الكتابة وكأنها استفزازٌ لما هو مخبوء في الوعي، واندفاع للتجاوز، وباتجاه يجعل من لعبة الكتابة محاولة في استدعاء اللذة، وفي حيازة «فكرة البقاء على قيد الحياة فيما يتعدّى المقبول والطبيعي» (المصدر السابق). فهذا الأسلوب ليس تمثيلًا للنهايات التي يقترحها الموت أو الشيخوخة، بقدر ما هو نوع من «العناد» والانغمار في إعادة توصيف الأفكار الجديدة التي تخصّ الوجود، وسردياته حول الزمن والمكان والهوية، فيقترح لها فضاء مفهوميًّا، وبصورٍ ذهنية متعددة، مثلما يضعها في مجال نسقي يجعلها الأقرب إلى الكتابة المناوئة للتاريخ، العابرة للتجنيس والتنميط، المندفعة إلى الانخراط في «المنفى الاختياري» في اللغة أو الموسيقا بتوصيف إدوارد سعيد، حيث الذهاب إلى ما يشبه صناعة الخلود عبر النص، وممارسة الشغف الأسلوبي في «تصفية حساباته مع الهويات والإشكاليات الانتمائية والثقافوية». (فواز طرابلسي: «إدوارد سعيد في «الأسلوب المتأخر»، مجلة بدايات، العدد السابع- شتاء ٢٠١٤م).
لتبدو تلك الكتابة وكأنها استفزازٌ لما هو مخبوء في الوعي، واندفاع للتجاوز، وباتجاه يجعل من لعبة الكتابة محاولة في استدعاء اللذة، وفي حيازة «فكرة البقاء على قيد الحياة فيما يتعدّى المقبول والطبيعي» (المصدر السابق). فهذا الأسلوب ليس تمثيلًا للنهايات التي يقترحها الموت أو الشيخوخة، بقدر ما هو نوع من «العناد» والانغمار في إعادة توصيف الأفكار الجديدة التي تخصّ الوجود، وسردياته حول الزمن والمكان والهوية، فيقترح لها فضاء مفهوميًّا، وبصورٍ ذهنية متعددة، مثلما يضعها في مجال نسقي يجعلها الأقرب إلى الكتابة المناوئة للتاريخ، العابرة للتجنيس والتنميط، المندفعة إلى الانخراط في «المنفى الاختياري» في اللغة أو الموسيقا بتوصيف إدوارد سعيد، حيث الذهاب إلى ما يشبه صناعة الخلود عبر النص، وممارسة الشغف الأسلوبي في «تصفية حساباته مع الهويات والإشكاليات الانتمائية والثقافوية». (فواز طرابلسي: «إدوارد سعيد في «الأسلوب المتأخر»، مجلة بدايات، العدد السابع- شتاء ٢٠١٤م).
تجربة إدوارد سعيد في النظر إلى تقانة الأسلوب المتأخر تحولت إلى «صدمة نقدية» في مقاربة عوالم الكتّاب والموسيقيين والفلاسفة، عبر التعرّف إلى علاقة حياتهم بما هو مفارق في الكتابة والتأليف. فحين نقرأ مقاربة سعيد لأطروحات شتراوس عن أسلوبه المتأخر في الموسيقا مثلًا، وعما فيها من إبهام، يمكن لنا أن نقرأ كتابات القاص والروائي محمد خضير السردية؛ إذ تحفل نصوصه بكثير من الهواجس والتغيّرات، حتى الإبهام، وعلى نحوٍ تجعله يقيم نوعًا من التواشج ما بين السرديات والدراسات الثقافية، على مستوى المقاربة النسقية بين أدوات مدونته السردية وبين فكرته عن «الأسلوب المتأخر» بوصفه مجالًا لكتابة مغايرة، في أجناسيتها، وفي جرأتها على «الانتهاك» الفني، ليبدو الإبهام والغموض جزءًا من تلك اللعبة، ومن المغايرة في الأسلوب، ومن السيولة التي تتقوّض فيها مركزيات السرد النمطي، في سياق التعاطي مع إشكاليات الهوية والمكان، وفي سياق توظيف السرد، فتتبدى هوية النص الجديد وكأنها تمثيل لوعي جديد، يقوم على المغامرة والتجاوز في سردنة تلك الهوية، واستغوار حمولة وجودها في لا وعي المكان، وفي الجندر، وفيما تصنعه للزمن من سرديات متعالية.

القص والأسلوب المتأخر
كتابات محمد خضير المتأخرة، تبدو متوترة، غامرة بالتجاوز، وشراهة التغيير، وكأنها تمارس وظيفة لا واعية في قوتها التعبيرية لمواجهة الشيخوخة، فيعمد إلى توسيع مساحات أسلوبه «المتأخر» عبر اشتغالات متعددة، يجمع فيها مجاورات سردية مختلفة -القص، الموسيقا، الرسم، السينما، الوثيقة، الحلم، السيرة- فضلًا عن سيولته في استدعاء زمانات مجاورة، تحضر في ترسيم مسارات هذا الأسلوب المتأخر، كالزمن الحكائي والزمن الميثولوجي، والزمن السيري، والزمن النفسي، والزمن التاريخي. هذا ما يجعل نصوصه الأخيرة تميل إلى الغرابة، من حيث تشكيل سمات تمثيلها السردي، ومن حيث تداخلها الأجناسي، ومن حيث تحويل وظيفة الزمن إلى وظيفة رؤيوية، يستنطق من خلالها ما هو مخبوء ومُضمر في الحكاية واللوحة والمكان والعقد والكراسة.
سرديات محمد خضير المتأخرة بدأت مع كتابه رواية «كراسة كانون» تحوّل فيها المنظور إلى لعبة مفتوحة وخارقة للتجنيس السردي؛ إذ تفجرت تخيلات المؤلف عبر «بروتوكول سردي» يقوم على تشكيلات تشتبك فيها المزاوجة التأليفية بين «الكولاج الفني» و«الكولاج السردي» لتتشكل ملامح ما يمكن تسميتها «السردية البصرية» عبر سردية القراءة، وسردية التدوين، بوصفها سرديات تمثيلية يتبدّى فيها المكتوب/ القص من خلال ما يكشفه القارئ/ المدوّن في التخطيطات ولوحات الجرافيك والرسوم والمحفورات والمجسمات، والألوان، عبر مرموزات يدين فيها المؤلف الحرب والعنف.
فاختيار لوحة الغورنيكا لبيكاسو، ولوحة غويا المدريدية، ومنحوتات هنري مور «المستلقيات»، واختيار سرديات للتشكيل العراقي في جداريات جواد سليم وفائق حسن، يكشف عن رؤية المؤلف لفاعلية هذا الأسلوب، في التعبير عن «الذات القارئة» وعن وعيها للمختلف في الكتابة، وإلى ما يحفل به تاريخ الرافدين من علامات وحمولات رمزية، وباتجاه يجعل من هذه البنى وحدات كولاجية تؤدي وظيفة جمالية، ووظائف سياسية ونفسية، تقوم على إدانة تلك الحروب الظلامية ضد الإنسان والمدن، ومنها الحرب الملعونة على العراق، والقصف القاتل لمدينته البصرة عام 1991م.
 وفي كتابه «الحكاية الجديدة» (عام 1994م) عزز محمد خضير من إرهاصات التحول في مشغله السردي، فيرسم أفقًا لـ«التحول العميق في عملية التأليف؛ لترتقي إلى خاصية التأمل في إدراك النهاية المشتركة التي لا بد أن يصلها المؤلفون واحدًا بعد الآخر». (محمد خضير: «الحكاية الجديدة»، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمّان 1995م). يكتب عن «ذاكرة العطار» وعن «القصاص المجهول» وعن سرديات البراهين وعن «مجرات التأثير» وعن «مدينة الرؤيا» وعن «الرؤيا المرئية» فتتحول الكتابة السردية إلى أسفار في عوالم متخيلة، وفي تقصٍّ لما هو غائر في مدنه القديمة، حيث يؤدي المؤلف فيها وظيفة الرائي والمدون، والباحث في السرائر عن المخطوطات والوثائق، وكأنه يبحث من خلالها عما يشبه «عشبة الخلود» حيث يوتوبيا مدينته المُغيّبة، وحيث يتجاوز فيها إحساسه بنهايات الأشياء، ليبرهن من خلال الكتابة على وجود نواة مولدة في القص «تختفي فيه جينات الثيمات اللامحدودة» (المصدر السابق).
وفي كتابه «الحكاية الجديدة» (عام 1994م) عزز محمد خضير من إرهاصات التحول في مشغله السردي، فيرسم أفقًا لـ«التحول العميق في عملية التأليف؛ لترتقي إلى خاصية التأمل في إدراك النهاية المشتركة التي لا بد أن يصلها المؤلفون واحدًا بعد الآخر». (محمد خضير: «الحكاية الجديدة»، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمّان 1995م). يكتب عن «ذاكرة العطار» وعن «القصاص المجهول» وعن سرديات البراهين وعن «مجرات التأثير» وعن «مدينة الرؤيا» وعن «الرؤيا المرئية» فتتحول الكتابة السردية إلى أسفار في عوالم متخيلة، وفي تقصٍّ لما هو غائر في مدنه القديمة، حيث يؤدي المؤلف فيها وظيفة الرائي والمدون، والباحث في السرائر عن المخطوطات والوثائق، وكأنه يبحث من خلالها عما يشبه «عشبة الخلود» حيث يوتوبيا مدينته المُغيّبة، وحيث يتجاوز فيها إحساسه بنهايات الأشياء، ليبرهن من خلال الكتابة على وجود نواة مولدة في القص «تختفي فيه جينات الثيمات اللامحدودة» (المصدر السابق).
لا أحسب أن هناك قناعة عند محمد خضير بما هو محدد في الوظائف، ليس لأنه مهووس بالشك والمغايرة، وبحساسية التجاوز، بل لأنه أكثر هوسًا بالبحث عما يُخفيه التاريخ، وأن وظيفته تتمثل أسلوب الفضح والانتهاك، ليكون أشبه بالأركيولوجي، الذي يحفر ويبحث عبر طبقات النصوص عن ذلك المخفي والغائب، وكأنه يجد فيها محاولته في مقاومة «الفناء» وبما ينعكس على طبيعة تشكيل تلك النصوص، عبر الحفاظ على وعيه لفاعلية ووحدات السرد الرئيسة كالزمن والمكان والشخصية والثيمة، فينزع إلى تجاوزها، عبر تجدد المعالجات، وعبر الحَفْز على مزيد من الانفتاح السردي، وبما يجعل الكتابة تبدو وكأنها «حفلة تنكرية يخفي المؤلفون فيها مقاصدهم بذرائع شتى». (المصدر السابق).
التنكّر عبر السرد/ التأليف هي لعبة محمد خضير الأثيرة؛ إذ يصطنع لها أبنية متعددة، وعوالم يوتوبية، ودوستوبية، يكون فيها البطل/ الإنسان هو المقاوم الشرس لموت المكان، وتكون فيها الكتابة هي مجال التشهي، والنفي داخل الحلم كما يصفه محمد خضير، مجبولًا على ما يصنع لوجوده نصوصًا يؤدي من خلالها وظائف الكشّاف، والباحث، والحارس والحكواتي؛ إذ تُلهمه تلك الوظائف احتفاءً يوتوبيًّا بالأمكنة- البصرة، باصورا، بصرياثا- ساحة أم البروم، أبي الخصيب، الزبير- بوصفها أمكنة تحوز على قوى جاذبة، لها ذاكرتها وطقوسها ومدوناتها التي يعرفها «مؤلفه المجهول» العارف بالأسرار والأساطير والحكايات؛ لذا هو لا يكتب رثاءً لتلك الأمكنة في سردياته/ قصصه، بل يحاول أن يحتفي بها، عبر سرديات التدوين والقراءة، وعبر ما يستعيده عبرها من ميثولوجيات، تجعله ينحاز إلى ما يشبه البحث عن الخلود، بوصفه محاولة في كتابة خلوده الشخصي، بوصفه قناعًا أو أسلوبًا لذلك المؤلف الذي يعرف سرائر تلك الأمكنة.
سرديات الأسلوب المتأخر
ليس للكاتب في أسلوبه المتأخر إلا أن يُعنى باللغة، في مجالها المفهومي والاصطلاحي كما يرى فواز طرابلسي وهو يصف كتابات إدوارد سعيد المتأخرة، حيث يُعنى بالمتن المعرفي الذي يجسّد فكرة «الانتقال الصعب؛ إذ لا يمكن تسويغ الانتقال إلى فاعلية «الأسلوب المتأخر» إلا عبر ذلك المتن، في أسئلته وتناقضاته، وفي تمثلاته الوجودية والفكرية، فهذا الأسلوب ليس بريئًا، بقدر ما يعكس غموض العالم الذي يتغيّر أمامه، فيُشعره بنوع من «النهايات الصادمة» وإلى ما توحي له من بحثٍ عما يشبه عشبة الخلود، عبر الاستيهام باستحضار «عشبة اللغة» و«عشبة المكان» وكلتا الإحالتين تحضران في سرديات محمد خضير بوصفهما تمثيلًا لنظرته إلى علاقة «الأسلوب المتأخر» بمشروعه السردي، وبأن يكون مختلفًا، ونافرًا، وله طاقة حياة توحي بتقويض فكرة الموت، فما يحضر في تلك السرديات المفتوحة يكشف عن نزق تعويضي، وعن شغف بالحلم الذي يستحضر عبره الغائبين عنه، وكأن هذا الحلم الشخصي هو سرّه في كتابة ما يشبه حلم المدينة، كما كتبه في «أحلام باصورا».
 في هذا الكتاب أراد أن يوظّف تقانة الحلم لاستغوار خفايا مدينته السرية، والتعرّف إلى حالميها الكبار –محمود البريكان، بدر شاكر السياب، محمود عبدالوهاب، مهدي عيسى القر، سعدي يوسف- تحدوه كثير من الهواجس السردية؛ إذ يجسّ عبر بنية الحلم، بنيات الجسد والمكان، وكائناته الواقعية والأثيرية، مثلما يحفر في سيرة المدينة، بحثًا عن بريدها ومعجمها، ومدوناتها وطقوسها حتى عن سرائر «كشكولها السرياني» الذي يتلمّس من خلاله سيرة نشوء التحوّل في «باصورا» التي تتقنّع بميثولوجيا «بصرياثا» وواقعية «البصرة».
في هذا الكتاب أراد أن يوظّف تقانة الحلم لاستغوار خفايا مدينته السرية، والتعرّف إلى حالميها الكبار –محمود البريكان، بدر شاكر السياب، محمود عبدالوهاب، مهدي عيسى القر، سعدي يوسف- تحدوه كثير من الهواجس السردية؛ إذ يجسّ عبر بنية الحلم، بنيات الجسد والمكان، وكائناته الواقعية والأثيرية، مثلما يحفر في سيرة المدينة، بحثًا عن بريدها ومعجمها، ومدوناتها وطقوسها حتى عن سرائر «كشكولها السرياني» الذي يتلمّس من خلاله سيرة نشوء التحوّل في «باصورا» التي تتقنّع بميثولوجيا «بصرياثا» وواقعية «البصرة».
التلاقي بين الميثولوجيا والواقع هو مثال على غرائبية «أسلوبه المتأخر»؛ إذ يكشف عن شهوة المؤلف الذي يتقنعه، مثلما يعيش هوس الباحث عن المخفي، الذي أخفته الحروب والصراعات والاحتلالات، فيوحي بأن هناك عالمًا يتشظى عبر القص أو عبر الرسم والموسيقا، وأن وظيفته الواعية، وربما المتعالية هي كشف ما يتسلل من اللوحات والروايات والمعزوفات، فيجد فيها منافيه الاختيارية على طريقة ما اختاره إدوارد سعيد وهو يكتب نصوصه المتأخرة في «كامل وعيه، طافحًا بالذاكرة، ومدركًا لحاضره إدراكًا عميقًا». (إدوارد سعيد: «الأسلوب المتأخر»، ص 50).
في كتابه المتأخر «وحدة الروح» يقترح محمد خضير حوارًا حرًّا بين «السرد والرسم»، فيجد في سبع عشرة لوحة ومنحوتة للفنانة ذكاء طارق مستويات نظيرة وشغوفة بما يصنعه السرد، فكتب عنها سبعة عشر نصًّا نثريًّا، استحضر من خلالها رؤيته للعلاقة التنافذية ما بين اللون والسرد، بين التشكيل والتمثيل، فبقدر ما أشار إلى أن لوحاتها تتبدى وكأنها «صياغة»، فإنه أعادنا إلى فكرة «حياكة السرد» التي وصفه بها الناقد ياسين النصيّر.
ما بين الصياغة اللونية والحياكة السردية تتوزع رؤى محمد خضير، غائصًا في تلمّس الخلفية الرافدينية للوحات ذكاء طارق، كاشفًا عن محمولاتها لرموز الخلق والخصب والوجود والطقوس السومرية والنمنمات التي تتجوهر فيها، وكأنها مركبٌ لوني- سردي، تحوطه هالات الحروف التي تتغذّى بـ«اللغة الحلمية»، باحثًا من خلالها عن رؤيا خلوده، وعما كتبه حول «نوح المعاصر» الذي يُعيدنا إلى «رسالة الإنسان الأخير لنوعهِ المهدَّد بالانقراض في عقب كلِّ حرب أو وباء أو اختراع صناعي إلكتروني وبيولوجي رهيب». (أنس الحاج: العربي الجديد 13 سبتمبر 2022م).
الأسلوب المتأخر والاحتفاء بالنصوص
 في كتبه الأخيرة –«العشار: أساطير الميل الواحد»، «العقود»، «رسائل من ثقب السرطان»، «ما يمسك وما لا يُمسك»- لا يجد محمد خضير سوى الاحتفاء بالتفاصيل، بوصفها من بنات الحكاية، حيث تكشف عن حيوية «أسلوبه المتأخر» الأسلوب الصبياني الذي يندفع من خلاله لمواجهة الشيخوخة، بما فيها شيخوخة الجسد والمكان واللغة، فتبدو اللغة في نصوصه ضاجة بالحيوية، والبلاغة الجمالية، والسيرة الشخصية الواثبة والمُتذكِّرة، أي السيرة المُركّبة لثنائية محمد خضير في المؤلف والقارئ الذي يتعالق بالكتاب، كناية عن تعالقه بالحياة ذاتها، مدافعًا باللغة عن تلك الشيخوخة، مستحضرًا لها ما يتذكره من أسفاره الشخصية في القراءة، وفي استعادة أساطير القوة/ الفحولة في مدنه القديمة، عبر الاستغوار في حكاياتها وقصصها غير البعيدة من قصص النشوء والخلق الذي يصنعه الإنسان.
في كتبه الأخيرة –«العشار: أساطير الميل الواحد»، «العقود»، «رسائل من ثقب السرطان»، «ما يمسك وما لا يُمسك»- لا يجد محمد خضير سوى الاحتفاء بالتفاصيل، بوصفها من بنات الحكاية، حيث تكشف عن حيوية «أسلوبه المتأخر» الأسلوب الصبياني الذي يندفع من خلاله لمواجهة الشيخوخة، بما فيها شيخوخة الجسد والمكان واللغة، فتبدو اللغة في نصوصه ضاجة بالحيوية، والبلاغة الجمالية، والسيرة الشخصية الواثبة والمُتذكِّرة، أي السيرة المُركّبة لثنائية محمد خضير في المؤلف والقارئ الذي يتعالق بالكتاب، كناية عن تعالقه بالحياة ذاتها، مدافعًا باللغة عن تلك الشيخوخة، مستحضرًا لها ما يتذكره من أسفاره الشخصية في القراءة، وفي استعادة أساطير القوة/ الفحولة في مدنه القديمة، عبر الاستغوار في حكاياتها وقصصها غير البعيدة من قصص النشوء والخلق الذي يصنعه الإنسان.
وفي كتاب «رسائل من ثقب السرطان» ينحاز محمد خضير إلى حريته، وإلى أن يكون أسلوبه المتأخر تمثيلًا لوعيه بالتجاوز إلى ما يجاور السرد، فيجد في كتابة المقالة نوعًا من التكامل التأليفي، حيث تتآلف اللغة مع ما يجاورها من أشكال تعبيرية، يحضر فيه المؤلف بوصفه قارئًا متعاليًا، كاشفًا عبر القراءة عن غواية التواصل، والاغتناء، وعن صناعة التناصات التي تهب نصوصه الرامزة بعناوينها السحر وما يشبه الامتلاء، فالرسائل المتخيّلة تأتي عبر نصوص المقروء، وعبر ما تمور به المدن، الكتب، الذاكرة، اليوميات، الجهات من عوالم يتشاطر معها الحياة التي تجعله يتحسس الخلود بوصفه نصًّا مقروءًا، أو أسلوبًا متأخرًا في اكتشاف الغائب من الوجود.
وكتاب «ما يمسك وما لا يمسك» جعله محمد خضير كتابًا في التذكّر، وفي استدعاء الغائب، أو المؤلف المجهول الذي يصنعه، لكي يمارس وظيفة صاحب «الكشكول» الذي يدوّن فيه بعضًا من سيرته الشخصية، وسيرة مدنه وصانعي أحلامه، وما يتأتّى من قراءاته الواسعة، التي تمثل سر وجوده، وفيض ذخيرته المعرفية، الذخيرة التي تُديم الحياة، وتهب لعبة القص عند المؤلف شغفًا آخر، في تقصي المكتوب في السيرة، وفي الدفاتر، وفي المفكرات، وهو ذاته الشغف المتأخر الذي أراده إدوارد سعيد، على مستوى كتابة سردية نفيه الداخلي في اللغة والموسيقا، وفي أن يكون «دافعًا عظيمًا للإبداع، ولجمالية لا تُضاهى» (فواز طرابلسي: مجلة بدايات، العدد السابع، شتاء 2014م).

علي حسن الفواز - ناقد عراقي | يناير 1, 2023 | قراءات
يَعْمِد الروائي إلى كتابة نصٍّ مضاد، فيه من القصدية أكثر من العفوية؛ إذ يتقصى مقاربة أحداثٍ وشخصياتٍ وأمكنةٍ، ليصطنع عبرها سرديات فاعلة، تقترح زمنًا للحركة، وللصراع، وللتمثيل، مثلما تقترح لها أمكنة ليست بعيدة من الواقع، لكنها مسكونة بأشباح الماضي، وبسردنة التخيّل التاريخي، وعلى نحوٍ تكون فيه لعبة التدوين وكأنها الكشّاف الساحر عن تاريخٍ مُضاد، لم تستطع السلطة، أو الجماعة المهيمنة أو حتى الجماعة المعارضة كتابته؛ لذا يضع الروائي نفسه في سياق تمثيلي لراوٍ متخيّل، له قناع الثقافي، والمراقب، أو المؤرشف، لكي يتحرى عما هو مخفي في سرديات المحذوف، وعلى وفق منظورٍ ليس بعيدًا من الأيديولوجيا، أو من التأويل، ولا من فكرة تقويض «التاريخ المتراكم» بل هو الأقرب إلى فكرة من يصطنع للروائي وظيفةً متعالية، تشبه وظيفة مُحقق الوثائق، وكاتب السير والاعترافات، أو ربما الباحث في أوراق ملفات المنظمات السرية. وهو ما يعني حيازة تقانة التحبيك التي تضع عالم الرواية في سياق ما تصنعه مُخيلة ذلك المحقق، الذي يُزيح غبار الأيديولوجيا عن التاريخ، ويتلمّس خفايا النسق في «المخزن/ المتحف» ليستأنف عبرها لعبته في التخيّل السردي.
سردية المسكوت عنه
الروائي علي بدر من أكثر الروائيين العراقيين انشغالًا بسردية المحذوف. انحاز مُبكّرًا إلى مقاربة «المهمل» في وثائق ذلك المتحف، وفي مرويات الجماعات الشفاهية، وفي أحاديث العابر من المدونات السرية في الخطاب السياسي والاجتماعي والديني، فضلًا عن القصدية في مراجعة كثيرٍ من الملفات والسير و«تواريخ» الوزارات والأحزاب ومذكرات الشخصيات العراقية، ليكتب روايته، وكأنه يقترح سيرورتها عبر قراءةٍ أركيولوجية تُلامس عوالم وخفايا وحيوات ظلّت مقموعة، أو «مسكوتًا عنها» في مدونات الاجتماع العراقي، وبالاتجاه الذي يضعنا أمام فكرة غاوية لكتابة ذلك «النص المُضاد»، أي الكتابة التي يكتبها «الموكول له» من جهة ما، وأغلبها غامضة؛ لكي يكون النص مدونة أو شهادة أو تقريرًا مجاورًا، عن حدثٍ ما، أو عن شخصية ما، بعيدًا من الشائع في خطاب السلطة والجماعة، وفي «المُتخيّل الشعري» للجماعات، والأحزاب، والعصابات.
 كتابة علي بدر تسعى لإخفاء المتن الحكائي، لكنه يعمل على توظيفه في سياق استقراء التاريخ العراقي، بوصفه تاريخ صراعات، وعبر استقراء التاريخ «التدويني» و«السري» للإنتلجنسيا العراقية، وبما يجعل الأحداث، أو لعبة التحبيك فيها، مرهونة بما تصنعه القراءة، وبما يتكشّف في سرديات تاريخ الدولة والجماعة، وتاريخ صراعاتها، وتحولاتها، وعبر مقاربة سرائر حيوات أبطالها المخفيين، أو المطاردين. وهذه لعبة محفوفة بالخطر دائمًا، ليس لأنها تفضح التابو والمحذوف السياسي والطبقي والحزبي والجنسي، بل لأنها تضع القارئ أمام خفايا «التاريخ المضاد» بوصفه نصًّا مُستعادًا، يستكنه الغائر، ويتفاضح عبر غواياته، وأسئلته وأسراره، وربما عبر زيفه الموارب، الذي أراد من خلاله إدانة واقعٍ ما، أو حدثٍ ما، أو جماعة ما. وهو ما افتتح مقارباتها في روايته الأولى «بابا سارتر» تلك التي قدّم من خلالها سخرية سوداء عن مثقفي الستينيات، حملت معها إدانة للواقع الثقافي العراقي، وللأفكار التي تسكنها الأشباح والأوهام، ولنمط الترجمات التي روجتْ لوعيٍ زائف عن الأدب الوجودي، ولا سيما في الترجمات التي قدمها سهيل إدريس وعايدة مطرجي لروايات جان بول سارتر، والتي تمثلها علي بدر عبر شخصية بطل الرواية «عبدالرحمن» وهي شخصيةٌ متخيلةٌ كتاريخ، فضلًا عن كونها شخصية مضطربة وشائهة وكسيرةٍ وتعاني الهوس السارتري، ومن عقدة التلصص، والعقد السياسية، وأوهام الوعي الزائف.
كتابة علي بدر تسعى لإخفاء المتن الحكائي، لكنه يعمل على توظيفه في سياق استقراء التاريخ العراقي، بوصفه تاريخ صراعات، وعبر استقراء التاريخ «التدويني» و«السري» للإنتلجنسيا العراقية، وبما يجعل الأحداث، أو لعبة التحبيك فيها، مرهونة بما تصنعه القراءة، وبما يتكشّف في سرديات تاريخ الدولة والجماعة، وتاريخ صراعاتها، وتحولاتها، وعبر مقاربة سرائر حيوات أبطالها المخفيين، أو المطاردين. وهذه لعبة محفوفة بالخطر دائمًا، ليس لأنها تفضح التابو والمحذوف السياسي والطبقي والحزبي والجنسي، بل لأنها تضع القارئ أمام خفايا «التاريخ المضاد» بوصفه نصًّا مُستعادًا، يستكنه الغائر، ويتفاضح عبر غواياته، وأسئلته وأسراره، وربما عبر زيفه الموارب، الذي أراد من خلاله إدانة واقعٍ ما، أو حدثٍ ما، أو جماعة ما. وهو ما افتتح مقارباتها في روايته الأولى «بابا سارتر» تلك التي قدّم من خلالها سخرية سوداء عن مثقفي الستينيات، حملت معها إدانة للواقع الثقافي العراقي، وللأفكار التي تسكنها الأشباح والأوهام، ولنمط الترجمات التي روجتْ لوعيٍ زائف عن الأدب الوجودي، ولا سيما في الترجمات التي قدمها سهيل إدريس وعايدة مطرجي لروايات جان بول سارتر، والتي تمثلها علي بدر عبر شخصية بطل الرواية «عبدالرحمن» وهي شخصيةٌ متخيلةٌ كتاريخ، فضلًا عن كونها شخصية مضطربة وشائهة وكسيرةٍ وتعاني الهوس السارتري، ومن عقدة التلصص، والعقد السياسية، وأوهام الوعي الزائف.
ولكيلا يجعلها الروائي شخصية مستقرة في السياق ولا في التاريخ، فإنّه يجترح وضعها في سياق ما تتخيله الشخصيات «المحذوفة» التي يتطلب التحقق عنها جُهدًا استثنائيًّا من التحري والبحث الذي يقوم فيه السارد/ المحقق، والمكفول من جماعةٍ ما، وعلى نحوٍ تتفاضح معه وقائع الحياة الثقافية العراقية، عبر هتك كثيرٍ من أسرارها. فهو يستعين بشخصيات غامضة، تمارس وظيفة التكليف بكتابة سيرة شخصية بطله، وبقصدية واضحة تُعنى بسردنة أزمة هذه الشخصية، والتعرّف إلى عقدها وعلاقاتها وصراعاتها، مقابل العناية بالكشف عن المخفي الثقافي في عوالم الجماعة العراقية، وربما للإيهام بترسيم متخيل عن عوالم مثقفي العراق في الستينيات، واليساريين منهم بشكلٍ خاص، والذين يعيشون أوهامهم وأحلامهم عن الحرية والحب والجنس والثورة والوجود والعلاقة مع الآخر.
التاريخ وشتاء العائلة
يمكن للكراهية أنْ تولّد وجهًا آخر للتاريخ المضاد، أي التاريخ الذي يصطنع مدوناته «السارد/ المُحقق»، بوصفه اللاعب «الأنثروبولوجي» الذي يكشف عما هو مُلتبس في عقد الهوية، واللغة، والجسد، وعما هو مخفي في الصراعات الاجتماعية والسياسية. إذ تبدو لعبة السارد أكثر تماهيًا مع وظيفته في استعادة المحذوف في عوالم «الأرستقراطية العراقية» الغابرة، عبر التعرّف إلى عالم العمّة التي تعيش «شتاء العائلة» واستفزاز عزلتها التي تعيشها في المكان الرثّ، وفي الزمن النفسي. وكأنّ الروائي أراد أن يصطنع لها عبر هذا الاستفزاز وعيًا صادمًا ومفارقًا، يُعبّر عن رهاب عقدتها الطبقية، وعن كراهيتها الانخراط في الزمن السياسي والاجتماعي؛ إذ يصطنع لها تاريخًا دافئًا تتوهمه، عبر استحضار فكرة اللذة المتخيلة، وعبر اصطناع شخصية الغريب، بوصفه مجالًا دلاليًّا، يُحيل إلى رمزية فكّ عقدة شتاء الجسد، ولمواجهة شتاءات العائلة والمكان العالق بالأثر، وبالمحذوف من الزمن السياسي العراقي، الذي يؤسس فكرة تقدمه وجريانه على أساس طرد الآخر.
 القصر الأرستقراطي الغامض في بغداد، هو المكان الذي تنبعث منه رائحة الماضي، ودخول الغريب إليه يعني بدء لعبة السرد، وعبر تقانة وصفية لمشاعر مضطربة تعيشها امرأة أربعينية، وعبر حركة تكثر فيها الجمل الفعلية، في إحالة إلى المجال الدلالي والتمثيلي لعواطفها المشبوبة، وللاغتراب في المكان الغابر/ المهمل/ المنسي/ المحذوف، عبر صور توحي بالغبار، والأثاث والغرف والسجاد وخزانة الصور، و«رائحة الذكريات التي تشبه الفاكهة المخمرة» وصور الأسود والأبيض.
القصر الأرستقراطي الغامض في بغداد، هو المكان الذي تنبعث منه رائحة الماضي، ودخول الغريب إليه يعني بدء لعبة السرد، وعبر تقانة وصفية لمشاعر مضطربة تعيشها امرأة أربعينية، وعبر حركة تكثر فيها الجمل الفعلية، في إحالة إلى المجال الدلالي والتمثيلي لعواطفها المشبوبة، وللاغتراب في المكان الغابر/ المهمل/ المنسي/ المحذوف، عبر صور توحي بالغبار، والأثاث والغرف والسجاد وخزانة الصور، و«رائحة الذكريات التي تشبه الفاكهة المخمرة» وصور الأسود والأبيض.
ما يمارسه الغريب في المكان من غواية، هو لعبة إيهامية لاستدعاء فكرة الآخر بحمولاته الرمزية والإشباعية والإيقاظية، ولاستفزاز جسد العمة الذي يشبه التاريخ والبيت. لكن العودة إلى الماضي كما يقول ماركس تعني كارثة دائمًا؛ لذا يجرّ الغريب بوصفه «بطلًا ضديًّا» إلى تلك الكارثة الافتراضية، حيث سرقة الجسد مع سرقة المكان والتاريخ، وحيث يظل جسد العمة مسكونًا بالأشباح، نظيرًا للقصر «البنية الجسدانية» للمكان المسكون بالغبار والعطب والمحذوفات التي جعلها الروائي مشغله «التحقيقي» ومادته في سردنة الأنثروبولوجية العراقية.
الوليمة العارية وسردية التفكك
في رواية «الوليمة العارية» ينزع الكاتب علي بدر إلى مقاربة العوالم الصراعية للإنتلجنسيا العراقية في نهاية المرحلة العثمانية. يستكشف عبر هذا الصراع مخفياتها، عبر ما يستقرئه في السجلات والوثائق والمدونات والسير. وكأنه أراد البحث من خلالها في سيرة مدينة بغداد، وهي تعيش الصراع ذاته، والإرهاصات ذاتها التي تهجس باتجاه التحوّل والتغيير، بما ينطويان عليه من مواقف متقاطعة، ما بين النظر إلى الاحتلال الإنجليزي بوصفه تحررًا إيهاميًّا، وعلمنة للوجود، ولمحق «ذاكرة» وهوية مفجوعتين، أو النظر إلى العثمانيين بوصفهم تكوينًا إيهاميًّا للهوية الإسلامية، وللتاريخ المسكون بأشباح الماضي، وبتخيلاتهم القائمة على أساس سردنة المحذوف، رغم أن الروائي عمل على أنْ يصطنع رابطًا ساخرًا ما بين المدينة والوليمة، بوصفهما ذواتي حمولات رمزية، يُحيلان إلى شراهة الآخرين في الاستعمار والاستشراق، وإلى عُري المكان، وإلى الطابع الانتهاكي من الغرباء والعابرين.
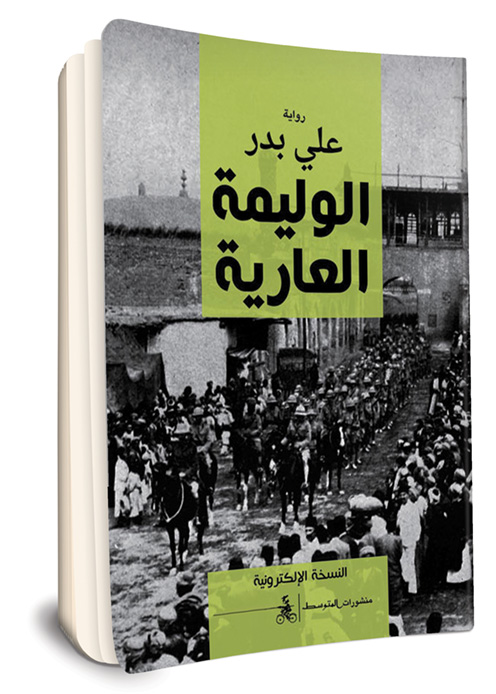 السخرية من التاريخ، هي ذاتها السخرية من تلك «النخبة» التي يمثلها «محمد بيك» المتشظي بين الروح البغدادية، والتربية الإسطنبولية، حيث تتوه، وتضطرب، وتعيش وسط العنف والجهل، وهو ما يجعل البحث عن مثقف المدينة، هو ذاته البحث عن المحذوف فيما تضمره أو تُخفيه شخصية النخبوي، الذي يمكنه تحت عوامل الزيف والخداع، التكيّف مع سرديات التحوّل التي تتضح مظاهرها عبر الجماعة والهوية؛ لمواجهة مظاهر الاستلاب والاستبداد.
السخرية من التاريخ، هي ذاتها السخرية من تلك «النخبة» التي يمثلها «محمد بيك» المتشظي بين الروح البغدادية، والتربية الإسطنبولية، حيث تتوه، وتضطرب، وتعيش وسط العنف والجهل، وهو ما يجعل البحث عن مثقف المدينة، هو ذاته البحث عن المحذوف فيما تضمره أو تُخفيه شخصية النخبوي، الذي يمكنه تحت عوامل الزيف والخداع، التكيّف مع سرديات التحوّل التي تتضح مظاهرها عبر الجماعة والهوية؛ لمواجهة مظاهر الاستلاب والاستبداد.
البحث عن صورة المثقف الغائر في الوثيقة هي هاجس علي بدر، بوصفه صورة زائفة للمنقذ، أو للمدوّن، أو للساخر من التاريخ، أو الباحث عن محذوفات التاريخ والسيرة ومدونة النص، وهو ما يجعله أكثر تمثيلًا لفكرة «شقاوة الوعي» كما يُسميها هيغل. وكأنه بهذا الوعي يعيش زيف واقعه، واغترابه، وبما يجعله شاهدًا زائفًا على ما يجري، ومدونًا متعاليًا على الواقع، وعلى الجماعات التي تعيش -هي الأخرى- وَهْمَ البحثِ عن معنى وجودها في المكان/ المدينة، أو في المجال/ الهوية، أو في العلاقة الاستلابية مع الآخر.
سرديات البحث عن الغائب
قد تكون رواية «الجري وراء الذئاب» أنموذجًا إجرائيًّا للفاعل السردي الذي يروي حكايات الجماعة المطرودة، من التاريخ، ومن الأيديولوجيا. فالبطل يلبس قناع الصحفي الأميركي الذي يعمل في إحدى مؤسسات «مردوخ» ويجد نفسه موكولًا في مهمة صحفية للبحث عن جماعة عراقية منفية! يتقصى أحوال الشيوعيين المطرودين من استبداد المدينة الدوستوبية إلى إثيوبيا، والبحث عن المحذوف في حياتهم السياسية والأيديولوجية، وعن علاقتهم المشوهة مع الآخر، ومع مكان النفي، بوصفه مكانًا لا يقلّ اغترابيًّا، أو استبداديًّا عن «المكان الوطني»؛ يتقصى بنوعٍ من التشهي عوالم المطرودين، الذين هم ضحايا المدينة المُستبدة، والعطب التاريخي، لتبدو فكرة «الغائب» هي المجال السردي لمقاربة «المحذوف» بوصفها تورية سياسية، أو أيديولوجية، أو هي لذة إشباعية يتغياها السارد/ المُحقق، للبحث عن حيوات ومدونات غائبة، وعن شخصيات تعيش غيابها عبر أقنعتها المتعددة. وهو ما نجده في رواية «حارس التبغ»، تلك التي جعلها الروائي وكأنها سردنة وثائقية عن اضطراب الحياة الثقافية العراقية، بعد عام التغيير في 2003م، وعبر ثيمة متخيلة، تستبطن استلابات داخلية للبطل الذي يعيش وسط هويات وأقنعة متعددة ومتقاطعة، فهو الموسيقي اليهودي يوسف سامي صالح، وهو الفنان العراقي كمال مدحت، مثلما هو الهارب إلى إيران بجواز سفر مزور يحمل اسم باسم كمال، وتلتقي هذه الشخصيات عند حدث قتله في بغداد في أحداث 2006م.
 ثيمة الهروب هي جوهر التحبيك في الرواية؛ إذ تحمل معها دلالة تمثل المثقف العراقي الذي يعيش عقدة الهوية، ويجد في الهروب والتقنّع خيارات لمواجهة قسوة الواقع والاستبداد والتهميش. وهي تماه مع الشخصيات المتعددة التي اختارها الشاعر فيرناندو بيسوا، حيث «شخصية حارس القطيع واسمه ألبرتو كايرو، والثانية للمحروس وهو ريكاردوريس، والثالثة للتبغجي وهو الفارو دي كامبوس».
ثيمة الهروب هي جوهر التحبيك في الرواية؛ إذ تحمل معها دلالة تمثل المثقف العراقي الذي يعيش عقدة الهوية، ويجد في الهروب والتقنّع خيارات لمواجهة قسوة الواقع والاستبداد والتهميش. وهي تماه مع الشخصيات المتعددة التي اختارها الشاعر فيرناندو بيسوا، حيث «شخصية حارس القطيع واسمه ألبرتو كايرو، والثانية للمحروس وهو ريكاردوريس، والثالثة للتبغجي وهو الفارو دي كامبوس».
هذا التلاقي والتقاطع بين الشخصيات، يعكس هواجس ثقافية وأنثروبولوجية، على نحوٍ تتبدى فيه أزمة المثقف العراقي، وكأنها غير بعيدة من أزمة المثقف في العالم وهو يواجه رهابات العنف والكراهية والاستبداد. وأحسب أن اشتغالات علي بدر في هذا السياق كانت أكثر اقترابًا من ثيمة الحفر في التاريخ العراقي، حيث الصراع الهوياتي، وحيث شعبوية الطرد الأنثروبولوجي، وحيث الخواء الثقافي الذي ظل عنوانًا لمطرودية المثقف العراقي في ظل عنف الاستبداد السياسي، والعنف الطائفي أو في ظل عنف الشعبويات التي فرضت خطابها بعد أحداث 2003م.
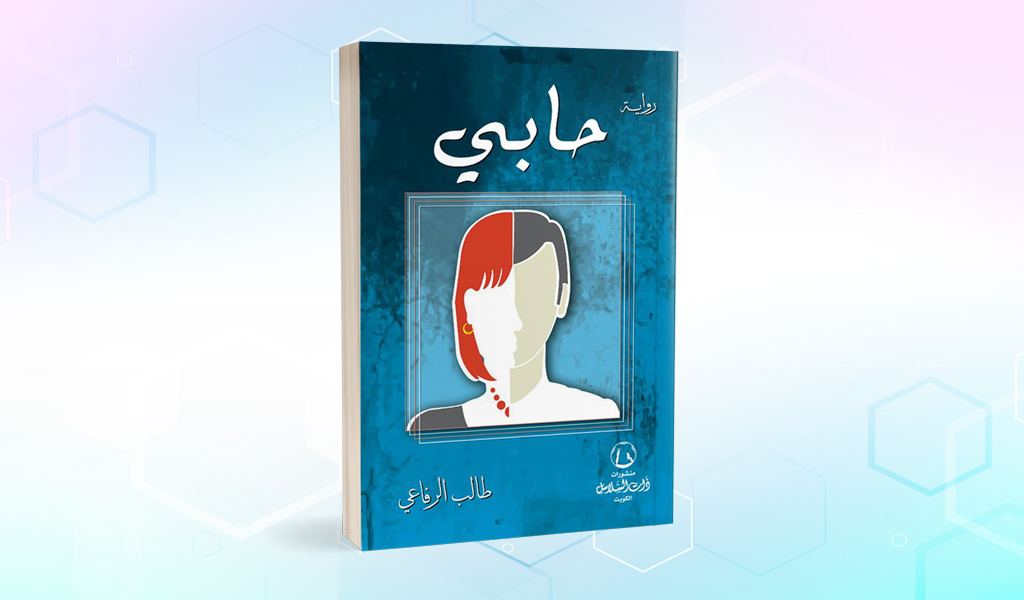
علي حسن الفواز - ناقد عراقي | يناير 1, 2020 | كتب
التنافذ بين الثقافي والجنساني قد يكون مدخلًا لقراءة التمثلات السردية في رواية «حابي» للروائي طالب الرفاعي، الصادرة عن دار ذات السلاسل (الكويت 2019م)؛ إذ تفتح هذه القراءة مجالًا لمقاربة تحولات الجسد، وتحولات الهوية، وهي موضوعات إشكالية تنطوي على مفارقات وتناقضات، لها أثرها السيميائي في البيئة العربية المثيولوجية، وفي شكل أداء الكائن في إطار تعالقه مع علاماتها، وعبر تمثيله لوجوده ولدلالتها.
تؤسس ثيمة الرواية فعلها السردي على أساس فكرة التحول البيولوجي للجسد من الأنوثة إلى الذكورة، الذي يتحول إلى موضوع نسقي يمسّ ما هو مضمر في اللاوعي الجمعي، ويتجاوز فيه الروائي أدبية النص من شكلانيته إلى دلاليته، وإلى تحوله في التمثّل الأنثروبولوجي، وفي التوصيف الجندري، الذي يثير من حوله أسئلة تخص علاقة هذا التحوّل بهوية الجسد، وبطبيعة الخطاب الذي سيُنتجه، مثلما تخصّ وظيفته التعبيرية عن طبيعة فكرته المقموعة، التي يفقد فيها مركزيته الميتافيزيقية، عبر تقويض رمزيته الوظيفية والعلاماتية في الخطاب، في السياقات الاجتماعية والدينية والقرابية، وفي أن يجعل لعبة السرد مجالًا لتأكيد فعل الهوية المتحولة، وشاهدًا عليها، بوصفها سردية تقوم على تقويض الثابت والنمطي، وكذلك لتقويض فكرة السلطة التي ينطوي عليها الجسد، ولا سيما أن العقل العربي، والمركز السلطوي/ المؤسسي يتحركان وفق مركزية ذكورية الجسد؛ تلك التي تجعل من لعبة التحوّل الجندري الذي يتعرض له الجسد نظيرًا لفعل تقويض مركز التفكير والسلطة، وهو ما يجعل البطل/ البطلة متورطًا في لعبة تقويض أنطولوجي، ومندفعًا نحو خيار يقوم على فكرة الإشباع الرمزي للجسد، وعلى تحدٍّ فاضح للسياق، الذي يطرده من بيت الأب أولًا، ومن البلاد ثانيًا، حيث يفكر في الهروب إلى الولايات المتحدة، بوصفها بيئة تتقبل لعبة تداول (التهرّب النسقي) كما يسميه النقاد الثقافيون، وعلى أساس خلخلة ثنائية الفحولة والأنوثة من خلال خلخلة سياقات التعبير عنهما في المجتمع والعائلة واللغة.
العنونة وأسطرة التحوّل
السردية الواقعية التي اعتاد الروائي طالب الرفاعي الكتابة بها في رواياته السابقة، لم تمنعه المغامرة بالتجريب في التعاطي مع الواقع، ومع معالجة إشكالاته الخبيئة برؤية نقدية، وبمقاربة تقوم على توظيف «علموية» السرد؛ إذ يتحول موضوع علمي طبيعي يخصّ التعقّد الجيني والهرموني إلى موضوع سردي له أقنعته الاجتماعية والنفسية، لكنه في هذا السياق يجعل منه فضاء أكثر انغمارًا في الواقع، وعبر الكشف عن شخصيات مأزقية كما يسميها محمد بوعزة، تلك التي تحمل معها تشوهات عميقة، جنسية ونفسية، ورمزية، وأن اعترافها بهذا التشوه لا يعني نزوعها للتطهير، بقدر ما يعني ذهابها نحو تعرية تورطها بالمأزق التابوي، حيث يفقد الجسد الموصوف جندريًّا واجتماعيًّا صفته الإشهارية/ السياقية، ليتقنّع بتوصيفٍ نسقي مضمر من الصعب القبول بتحوله في السياق الاجتماعي والعائلي.
عنونة الرواية تأخذ من أسطورة الآلهة المصرية القديمة شفرتها في التعبير عن الفكرة المقدسة للكائن الخنثي، الذي يحتفظ بطاقة الأنوثة والذكورة، كنظير لطاقة الماء في النيل، ولطاقة الشمس في نظم العبادة المصرية، التي تتجوهر حول فكرة الإخصاب المقدس، أي الإخصاب الذاتي.

طالب الرفاعي
فضاء العنونة هو أفق للاحتمال الذي يتعالق فيه الجندري بالأسطوري، مثلما هو إضاءة لمجال تسريد الأحداث في الرواية، وللتعبير عن مأزق الشخصية المتحولة، وعن طبيعة علاقتها مع ذاتها في الجسد أو في الهوية، أو حتى في الميل والإحساس الرغبوي إزاء الآخر«أكونُ وحدي في البيت، فأسرع أغلق باب الحمام، أقف عارية أمام المرآة أنظر إلى جسدي، كأني أطلب من جسدي أن ينطق؛ ليُعينني على معرفة نفسي؛ هل أنا فتاة أم ولد؟»
الإحساس الرغبوي تجسده العلاقة الحميمة مع «جوى» التي تشاطرها/ تشاطره الاغتراب الوجودي، ليس بوصفها شخصية مرآوية فحسب، بل بوصفها شخصية «نسقية» تتبدى عبرها تلك العلاقة، في مُضمرها، وفي طبيعة الاستيهام الذي تعيشه/ يعيشه معها أولًا، وفيما يُهدد الشخصيتين وجوديًّا من محوٍ وطرد ورفض ثانيًا، تتمثّل من خلاله صورة «الشخصية المأزقية» في الرواية، بوصفها شخصية متحولة ومتشظية وغير خاضعة للسياق، وأنّ وظيفتها تشكّل فضاء سرديًّا مجاورًا، تتبدى إحالاته -تأويل التحول، وتأويل الاغتراب- من خلال تأويل التشوّه الجيني الذي تعانيه بوصفه تشوّهًا اجتماعيًّا وثقافيًّا ونفسيًّا، أو من خلال إحالته إلى قناع لتمثيل مستوى من مستويات الصراع الوجودي في مجتمع تقليدي، له مهيمناته وعلاماته، ونقائضه، التي يصطنع لها الروائي مسارًا دلاليًّا، عبر ظائف ضدية لتلك العلاقة الشائهة والطاردة بينهما، أو في علاقة «ريّان» مع الأب والأم والشقيقات والعمّة والمؤسسة الاجتماعية، التي تُفضي سيميائيًّا إلى التعبير عن موقف مركّب، يستكنه ما يعنيه ذلك التحول من مغامرة تستدعي الاعتراف بصورة «المسخ» كما يسميه الأب، أو عبر ما يعيشه من غربة داخلية، تستدعي البحث عن حيلٍ سردية للراوي الداخلي لتمريرها، عبر «الكتابة» بوصفها ممارسة رمزية يهجس بها الصوت الداخلي، أو عبر الاستسلام للتحوّل في نهاية الرواية «أشعر كأن طعما مُرًّا بفمي، قدري أن أبقى حابي»؛ إذ يعيش رعبَ اللاعترافِ، مثلما يعيش رعب ثنائية اللذة الهاربة والمؤسطرة في استيهامات فكرة الخصب، مقابل عدم اكتمال الذكورة، وفقدان القدرة على الإنجاب، وهي لعنة شرقية ينفتح تأويلها سيميائيًّا على عطب الجسد، وعطب الخطاب، وعطب الحرية ذاتها، ومن ثم فقدان القدرة على تشييد أية شبكة دلالية تتجاوز ما هو جندري في الجسد، وفي اللغة.
القراءة بوصفها نقدًا ثقافيًّا
تمثُّل فعل القراءة الثقافية للرواية يضعنا أمام تعالقات تربط بين المجال السردي والمجال النفسي، أو بين التمثيل السردي والتمثيل السيميائي، وهذا الترابط يُعطي للقراءة حافزًا للكشف عن مظاهر النسق المكبوت/ المضمر في البيئة الاجتماعية، إن كان كبتًا أنثويًّا أو ذكوريًّا، أو إن كان تعبيرًا عن سردنة افتراضية لفكرة الخضوع لمركزيات الأفكار الكبرى؛ تلك التي تخصّ الجسد، والجماعة والهوية بوصفها تشوهات يقرّها المجتمع، لكن يرفضها الجسد، أو تقبلها الجماعة/ العائلة/ المؤسسة، لكن يرفضها الفرد، وأنّ أية عملية للتحول التي يمارسها الجسد بوصفه «ذاتًا» وكتسريب نسقي لرغبة ذلك الجسد، الذي سيجد عنتًا ورفضًا من النسق الكلي الذي يصنعه ويحميه المجتمع.
رواية «حابي» هي روايةُ ذاتٍ تعيشُ استلابَها الجنسيَّ والاجتماعيَّ، وأن تحرر رغبتها عبر الجسد هي علامة لفكرة خلاصها من القيد والتشوه، ومن الخطاب التواصلي الذي يفرضه ذلك القيد الجندري، حتى الحرية لا تعني هنا سوى الذهاب إلى قيد آخر، هو قيد التشوه الهوياتي، الذي لا يعترف به الجسد/ الذات، مقابل الاعتراف به من جانب المجتمع، والعائلة، والسلطة.
سردية التحوّلتتحرك هذه الرواية على مستويات عدة، وعلى منطق الكشف عن التوصيف السردي للتحول؛ إذ تكتسب شخصية «ريان» بعدًا أضحويًّا، وبُعدًا متمردًا في آنٍ معًا، ومزاوجة البعدين تتحول إلى عناصر وأفعال، وإلى وظائف أيضًا، يُشفِّر من خلالها الروائي رؤيته للمجتمع، وللصراعات الخبيئة في أنساقه المضمرة، ولا مجال للتعاطي معها، أو لكشفها وتعريتها إلا من خلال لعبة السرد، بوصفها لعبة تتجوهر حول فكرة التحول، بوصفه الجندري/ الجسدي، والجندري/ الهوياتي، وكلا الأمرين يتحولان إلى صرخة احتجاج، وإلى موقف فلسفي، له علاقة بالحرية والإرادة، والوجود.
وبقدر ما كان هذا التحول فاعلًا في تمثيل الصراع الاجتماعي، فإن التحول السردي، وهو ما يخص المبنى السردي أولًا، وتقانات هذا المبنى ثانيًا، يرتبط بالمحتوى السيميائي وما يَعمِد إليه من استشعار للطاقات الدلالية؛ إذ يصطنع السرد عبرها تمويهًا للقراءة، وحفزًا لاستكناه ما يمكن أن تثيره، أو ما يجعل لعبة السرد تقوم على فكرة ذلك التمويه، في سياق ثنائية السارد العليم، والسارد الداخلي، أو في سياق مقاربة بعض المشكلات الخفية في المجتمعات الخليجية، التي تتخفّى تحت كثير من الرمزية، وعبر انتقالات يعاين من خلالها الروائي ما هو خفي في الواقع، الذي يكتسب فعل استعاراتها من خلال سردنة الخطاب، أو من خلال سردنة الجسد؛ إذ يتحول الجسد في هذا السياق إلى «سردية كبرى» لها خطاباتها المهيمنة، التي تتعالق مع عالم السياسة والجنس والدين والقرابة، وهي قضايا إشكالية يتقصى فيها السرد تاريخ الجسد، بوصفه مادة حكائية، لها مستوياتها وأبنيتها، ولها زمنها السردي الذي يؤطر الزمن الواقعي، على نحو يجعل لعبة السرد -هنا- هي الفضاء الذي تتبدى من خلاله محنة الشخصية المأزقية، ومحنة هويتها.
إن شخصية البطل/ البطلة هي محور الشغل السردي، وهذا الشغل يدفعها إلى القيام بوظائف يختلط فيها الرفض والخضوع، الرفض في الجسد، وعبر طقوسه، والخضوع في المكان الذي يتحول إلى معادٍ رغم ألفته -البيت والمدرسة- وشفرة العداوة تكمن في اللاتساق معه، وهو ما يدفع البطلة/ البطل لممارسة نوع من الاعتراف، عبر ممارسة بعض سلوكيات «الولدنة» وفي الإفصاح عن رغبات جنسوية مع النساء، أو عبر ممارسة طقوس الكتابة بوصفها فعلًا اعترافيًّا لمواجهة الذات، وللإفصاح عما هو مكبوت أو مضمر.
سرديات طالب الرفاعي تلامس الحدث والتاريخ في سياق رؤيته لفاعلية السرد، وفي مقاربته لأنثروبولوجيا الجماعة والهوية عبر الجسد، أو في سياق ممارسته طقوس النقد، بوصف السرد -هنا- لعبة ماكرة لمواجهة التاريخ، أو ربما لممارسة نوع التسريب النسقي ذي الحمولة الاجتماعية والسياسية، وهي ما حاول الروائي إبراز مظاهر الوعي بها، ولمواجهة ما يصنعه من مراكز لها إحالاتها، ولها منظورها وحساسيتها إزاء الضدي، الذي ينطوي -رغم فداحته- على نزعات تتجاوز ما هو جندري، إلى ما هو إيروسي، أو حتى جينيالوجي، وعلى وفق تحويل الشخصية المأزقية إلى شخصية لا تملك من خيار سوى الذهاب إلى التحول أو الذهاب إلى الاعتراف.

 لتبدو تلك الكتابة وكأنها استفزازٌ لما هو مخبوء في الوعي، واندفاع للتجاوز، وباتجاه يجعل من لعبة الكتابة محاولة في استدعاء اللذة، وفي حيازة «فكرة البقاء على قيد الحياة فيما يتعدّى المقبول والطبيعي» (المصدر السابق). فهذا الأسلوب ليس تمثيلًا للنهايات التي يقترحها الموت أو الشيخوخة، بقدر ما هو نوع من «العناد» والانغمار في إعادة توصيف الأفكار الجديدة التي تخصّ الوجود، وسردياته حول الزمن والمكان والهوية، فيقترح لها فضاء مفهوميًّا، وبصورٍ ذهنية متعددة، مثلما يضعها في مجال نسقي يجعلها الأقرب إلى الكتابة المناوئة للتاريخ، العابرة للتجنيس والتنميط، المندفعة إلى الانخراط في «المنفى الاختياري» في اللغة أو الموسيقا بتوصيف إدوارد سعيد، حيث الذهاب إلى ما يشبه صناعة الخلود عبر النص، وممارسة الشغف الأسلوبي في «تصفية حساباته مع الهويات والإشكاليات الانتمائية والثقافوية». (فواز طرابلسي: «إدوارد سعيد في «الأسلوب المتأخر»، مجلة بدايات، العدد السابع- شتاء ٢٠١٤م).
لتبدو تلك الكتابة وكأنها استفزازٌ لما هو مخبوء في الوعي، واندفاع للتجاوز، وباتجاه يجعل من لعبة الكتابة محاولة في استدعاء اللذة، وفي حيازة «فكرة البقاء على قيد الحياة فيما يتعدّى المقبول والطبيعي» (المصدر السابق). فهذا الأسلوب ليس تمثيلًا للنهايات التي يقترحها الموت أو الشيخوخة، بقدر ما هو نوع من «العناد» والانغمار في إعادة توصيف الأفكار الجديدة التي تخصّ الوجود، وسردياته حول الزمن والمكان والهوية، فيقترح لها فضاء مفهوميًّا، وبصورٍ ذهنية متعددة، مثلما يضعها في مجال نسقي يجعلها الأقرب إلى الكتابة المناوئة للتاريخ، العابرة للتجنيس والتنميط، المندفعة إلى الانخراط في «المنفى الاختياري» في اللغة أو الموسيقا بتوصيف إدوارد سعيد، حيث الذهاب إلى ما يشبه صناعة الخلود عبر النص، وممارسة الشغف الأسلوبي في «تصفية حساباته مع الهويات والإشكاليات الانتمائية والثقافوية». (فواز طرابلسي: «إدوارد سعيد في «الأسلوب المتأخر»، مجلة بدايات، العدد السابع- شتاء ٢٠١٤م).
 وفي كتابه «الحكاية الجديدة» (عام 1994م) عزز محمد خضير من إرهاصات التحول في مشغله السردي، فيرسم أفقًا لـ«التحول العميق في عملية التأليف؛ لترتقي إلى خاصية التأمل في إدراك النهاية المشتركة التي لا بد أن يصلها المؤلفون واحدًا بعد الآخر». (محمد خضير: «الحكاية الجديدة»، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمّان 1995م). يكتب عن «ذاكرة العطار» وعن «القصاص المجهول» وعن سرديات البراهين وعن «مجرات التأثير» وعن «مدينة الرؤيا» وعن «الرؤيا المرئية» فتتحول الكتابة السردية إلى أسفار في عوالم متخيلة، وفي تقصٍّ لما هو غائر في مدنه القديمة، حيث يؤدي المؤلف فيها وظيفة الرائي والمدون، والباحث في السرائر عن المخطوطات والوثائق، وكأنه يبحث من خلالها عما يشبه «عشبة الخلود» حيث يوتوبيا مدينته المُغيّبة، وحيث يتجاوز فيها إحساسه بنهايات الأشياء، ليبرهن من خلال الكتابة على وجود نواة مولدة في القص «تختفي فيه جينات الثيمات اللامحدودة» (المصدر السابق).
وفي كتابه «الحكاية الجديدة» (عام 1994م) عزز محمد خضير من إرهاصات التحول في مشغله السردي، فيرسم أفقًا لـ«التحول العميق في عملية التأليف؛ لترتقي إلى خاصية التأمل في إدراك النهاية المشتركة التي لا بد أن يصلها المؤلفون واحدًا بعد الآخر». (محمد خضير: «الحكاية الجديدة»، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمّان 1995م). يكتب عن «ذاكرة العطار» وعن «القصاص المجهول» وعن سرديات البراهين وعن «مجرات التأثير» وعن «مدينة الرؤيا» وعن «الرؤيا المرئية» فتتحول الكتابة السردية إلى أسفار في عوالم متخيلة، وفي تقصٍّ لما هو غائر في مدنه القديمة، حيث يؤدي المؤلف فيها وظيفة الرائي والمدون، والباحث في السرائر عن المخطوطات والوثائق، وكأنه يبحث من خلالها عما يشبه «عشبة الخلود» حيث يوتوبيا مدينته المُغيّبة، وحيث يتجاوز فيها إحساسه بنهايات الأشياء، ليبرهن من خلال الكتابة على وجود نواة مولدة في القص «تختفي فيه جينات الثيمات اللامحدودة» (المصدر السابق). في هذا الكتاب أراد أن يوظّف تقانة الحلم لاستغوار خفايا مدينته السرية، والتعرّف إلى حالميها الكبار –محمود البريكان، بدر شاكر السياب، محمود عبدالوهاب، مهدي عيسى القر، سعدي يوسف- تحدوه كثير من الهواجس السردية؛ إذ يجسّ عبر بنية الحلم، بنيات الجسد والمكان، وكائناته الواقعية والأثيرية، مثلما يحفر في سيرة المدينة، بحثًا عن بريدها ومعجمها، ومدوناتها وطقوسها حتى عن سرائر «كشكولها السرياني» الذي يتلمّس من خلاله سيرة نشوء التحوّل في «باصورا» التي تتقنّع بميثولوجيا «بصرياثا» وواقعية «البصرة».
في هذا الكتاب أراد أن يوظّف تقانة الحلم لاستغوار خفايا مدينته السرية، والتعرّف إلى حالميها الكبار –محمود البريكان، بدر شاكر السياب، محمود عبدالوهاب، مهدي عيسى القر، سعدي يوسف- تحدوه كثير من الهواجس السردية؛ إذ يجسّ عبر بنية الحلم، بنيات الجسد والمكان، وكائناته الواقعية والأثيرية، مثلما يحفر في سيرة المدينة، بحثًا عن بريدها ومعجمها، ومدوناتها وطقوسها حتى عن سرائر «كشكولها السرياني» الذي يتلمّس من خلاله سيرة نشوء التحوّل في «باصورا» التي تتقنّع بميثولوجيا «بصرياثا» وواقعية «البصرة». في كتبه الأخيرة –«العشار: أساطير الميل الواحد»، «العقود»، «رسائل من ثقب السرطان»، «ما يمسك وما لا يُمسك»- لا يجد محمد خضير سوى الاحتفاء بالتفاصيل، بوصفها من بنات الحكاية، حيث تكشف عن حيوية «أسلوبه المتأخر» الأسلوب الصبياني الذي يندفع من خلاله لمواجهة الشيخوخة، بما فيها شيخوخة الجسد والمكان واللغة، فتبدو اللغة في نصوصه ضاجة بالحيوية، والبلاغة الجمالية، والسيرة الشخصية الواثبة والمُتذكِّرة، أي السيرة المُركّبة لثنائية محمد خضير في المؤلف والقارئ الذي يتعالق بالكتاب، كناية عن تعالقه بالحياة ذاتها، مدافعًا باللغة عن تلك الشيخوخة، مستحضرًا لها ما يتذكره من أسفاره الشخصية في القراءة، وفي استعادة أساطير القوة/ الفحولة في مدنه القديمة، عبر الاستغوار في حكاياتها وقصصها غير البعيدة من قصص النشوء والخلق الذي يصنعه الإنسان.
في كتبه الأخيرة –«العشار: أساطير الميل الواحد»، «العقود»، «رسائل من ثقب السرطان»، «ما يمسك وما لا يُمسك»- لا يجد محمد خضير سوى الاحتفاء بالتفاصيل، بوصفها من بنات الحكاية، حيث تكشف عن حيوية «أسلوبه المتأخر» الأسلوب الصبياني الذي يندفع من خلاله لمواجهة الشيخوخة، بما فيها شيخوخة الجسد والمكان واللغة، فتبدو اللغة في نصوصه ضاجة بالحيوية، والبلاغة الجمالية، والسيرة الشخصية الواثبة والمُتذكِّرة، أي السيرة المُركّبة لثنائية محمد خضير في المؤلف والقارئ الذي يتعالق بالكتاب، كناية عن تعالقه بالحياة ذاتها، مدافعًا باللغة عن تلك الشيخوخة، مستحضرًا لها ما يتذكره من أسفاره الشخصية في القراءة، وفي استعادة أساطير القوة/ الفحولة في مدنه القديمة، عبر الاستغوار في حكاياتها وقصصها غير البعيدة من قصص النشوء والخلق الذي يصنعه الإنسان.
 كتابة علي بدر تسعى لإخفاء المتن الحكائي، لكنه يعمل على توظيفه في سياق استقراء التاريخ العراقي، بوصفه تاريخ صراعات، وعبر استقراء التاريخ «التدويني» و«السري» للإنتلجنسيا العراقية، وبما يجعل الأحداث، أو لعبة التحبيك فيها، مرهونة بما تصنعه القراءة، وبما يتكشّف في سرديات تاريخ الدولة والجماعة، وتاريخ صراعاتها، وتحولاتها، وعبر مقاربة سرائر حيوات أبطالها المخفيين، أو المطاردين. وهذه لعبة محفوفة بالخطر دائمًا، ليس لأنها تفضح التابو والمحذوف السياسي والطبقي والحزبي والجنسي، بل لأنها تضع القارئ أمام خفايا «التاريخ المضاد» بوصفه نصًّا مُستعادًا، يستكنه الغائر، ويتفاضح عبر غواياته، وأسئلته وأسراره، وربما عبر زيفه الموارب، الذي أراد من خلاله إدانة واقعٍ ما، أو حدثٍ ما، أو جماعة ما. وهو ما افتتح مقارباتها في روايته الأولى «بابا سارتر» تلك التي قدّم من خلالها سخرية سوداء عن مثقفي الستينيات، حملت معها إدانة للواقع الثقافي العراقي، وللأفكار التي تسكنها الأشباح والأوهام، ولنمط الترجمات التي روجتْ لوعيٍ زائف عن الأدب الوجودي، ولا سيما في الترجمات التي قدمها سهيل إدريس وعايدة مطرجي لروايات جان بول سارتر، والتي تمثلها علي بدر عبر شخصية بطل الرواية «عبدالرحمن» وهي شخصيةٌ متخيلةٌ كتاريخ، فضلًا عن كونها شخصية مضطربة وشائهة وكسيرةٍ وتعاني الهوس السارتري، ومن عقدة التلصص، والعقد السياسية، وأوهام الوعي الزائف.
كتابة علي بدر تسعى لإخفاء المتن الحكائي، لكنه يعمل على توظيفه في سياق استقراء التاريخ العراقي، بوصفه تاريخ صراعات، وعبر استقراء التاريخ «التدويني» و«السري» للإنتلجنسيا العراقية، وبما يجعل الأحداث، أو لعبة التحبيك فيها، مرهونة بما تصنعه القراءة، وبما يتكشّف في سرديات تاريخ الدولة والجماعة، وتاريخ صراعاتها، وتحولاتها، وعبر مقاربة سرائر حيوات أبطالها المخفيين، أو المطاردين. وهذه لعبة محفوفة بالخطر دائمًا، ليس لأنها تفضح التابو والمحذوف السياسي والطبقي والحزبي والجنسي، بل لأنها تضع القارئ أمام خفايا «التاريخ المضاد» بوصفه نصًّا مُستعادًا، يستكنه الغائر، ويتفاضح عبر غواياته، وأسئلته وأسراره، وربما عبر زيفه الموارب، الذي أراد من خلاله إدانة واقعٍ ما، أو حدثٍ ما، أو جماعة ما. وهو ما افتتح مقارباتها في روايته الأولى «بابا سارتر» تلك التي قدّم من خلالها سخرية سوداء عن مثقفي الستينيات، حملت معها إدانة للواقع الثقافي العراقي، وللأفكار التي تسكنها الأشباح والأوهام، ولنمط الترجمات التي روجتْ لوعيٍ زائف عن الأدب الوجودي، ولا سيما في الترجمات التي قدمها سهيل إدريس وعايدة مطرجي لروايات جان بول سارتر، والتي تمثلها علي بدر عبر شخصية بطل الرواية «عبدالرحمن» وهي شخصيةٌ متخيلةٌ كتاريخ، فضلًا عن كونها شخصية مضطربة وشائهة وكسيرةٍ وتعاني الهوس السارتري، ومن عقدة التلصص، والعقد السياسية، وأوهام الوعي الزائف. القصر الأرستقراطي الغامض في بغداد، هو المكان الذي تنبعث منه رائحة الماضي، ودخول الغريب إليه يعني بدء لعبة السرد، وعبر تقانة وصفية لمشاعر مضطربة تعيشها امرأة أربعينية، وعبر حركة تكثر فيها الجمل الفعلية، في إحالة إلى المجال الدلالي والتمثيلي لعواطفها المشبوبة، وللاغتراب في المكان الغابر/ المهمل/ المنسي/ المحذوف، عبر صور توحي بالغبار، والأثاث والغرف والسجاد وخزانة الصور، و«رائحة الذكريات التي تشبه الفاكهة المخمرة» وصور الأسود والأبيض.
القصر الأرستقراطي الغامض في بغداد، هو المكان الذي تنبعث منه رائحة الماضي، ودخول الغريب إليه يعني بدء لعبة السرد، وعبر تقانة وصفية لمشاعر مضطربة تعيشها امرأة أربعينية، وعبر حركة تكثر فيها الجمل الفعلية، في إحالة إلى المجال الدلالي والتمثيلي لعواطفها المشبوبة، وللاغتراب في المكان الغابر/ المهمل/ المنسي/ المحذوف، عبر صور توحي بالغبار، والأثاث والغرف والسجاد وخزانة الصور، و«رائحة الذكريات التي تشبه الفاكهة المخمرة» وصور الأسود والأبيض.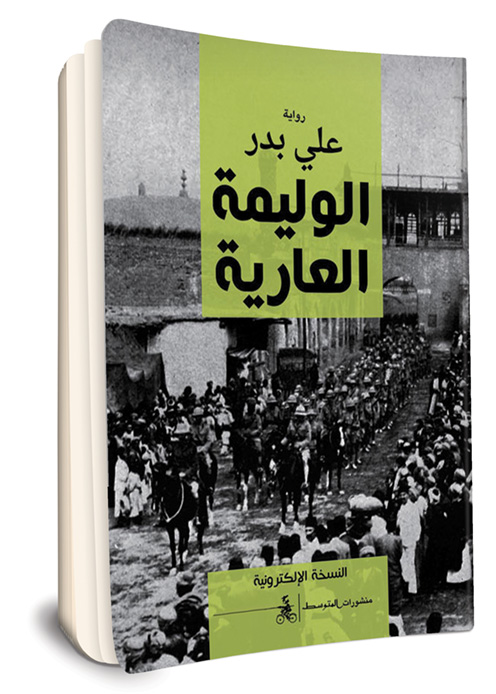 السخرية من التاريخ، هي ذاتها السخرية من تلك «النخبة» التي يمثلها «محمد بيك» المتشظي بين الروح البغدادية، والتربية الإسطنبولية، حيث تتوه، وتضطرب، وتعيش وسط العنف والجهل، وهو ما يجعل البحث عن مثقف المدينة، هو ذاته البحث عن المحذوف فيما تضمره أو تُخفيه شخصية النخبوي، الذي يمكنه تحت عوامل الزيف والخداع، التكيّف مع سرديات التحوّل التي تتضح مظاهرها عبر الجماعة والهوية؛ لمواجهة مظاهر الاستلاب والاستبداد.
السخرية من التاريخ، هي ذاتها السخرية من تلك «النخبة» التي يمثلها «محمد بيك» المتشظي بين الروح البغدادية، والتربية الإسطنبولية، حيث تتوه، وتضطرب، وتعيش وسط العنف والجهل، وهو ما يجعل البحث عن مثقف المدينة، هو ذاته البحث عن المحذوف فيما تضمره أو تُخفيه شخصية النخبوي، الذي يمكنه تحت عوامل الزيف والخداع، التكيّف مع سرديات التحوّل التي تتضح مظاهرها عبر الجماعة والهوية؛ لمواجهة مظاهر الاستلاب والاستبداد. ثيمة الهروب هي جوهر التحبيك في الرواية؛ إذ تحمل معها دلالة تمثل المثقف العراقي الذي يعيش عقدة الهوية، ويجد في الهروب والتقنّع خيارات لمواجهة قسوة الواقع والاستبداد والتهميش. وهي تماه مع الشخصيات المتعددة التي اختارها الشاعر فيرناندو بيسوا، حيث «شخصية حارس القطيع واسمه ألبرتو كايرو، والثانية للمحروس وهو ريكاردوريس، والثالثة للتبغجي وهو الفارو دي كامبوس».
ثيمة الهروب هي جوهر التحبيك في الرواية؛ إذ تحمل معها دلالة تمثل المثقف العراقي الذي يعيش عقدة الهوية، ويجد في الهروب والتقنّع خيارات لمواجهة قسوة الواقع والاستبداد والتهميش. وهي تماه مع الشخصيات المتعددة التي اختارها الشاعر فيرناندو بيسوا، حيث «شخصية حارس القطيع واسمه ألبرتو كايرو، والثانية للمحروس وهو ريكاردوريس، والثالثة للتبغجي وهو الفارو دي كامبوس».