
منتصر حمادة - باحث مغربي | يناير 1, 2022 | مقالات
ما زال تعاملنا في المنطقة العربية مع مستجدات العالم الرقمي متباينًا؛ بين دول منخرطة منذ أكثر من عقد في الاشتغال على توظيف ما تتيحه التجارب الرقمية خدمة لمشروعات التنمية المحلية والإقليمية، وأخرى ما زالت متواضعة في تفاعلها مع ثورة علمية تساهم في إعادة تشكيل رؤى الإنسان المعاصر لذاته ومحيطه والعالم في آن. بعد انتشار وتوسع العوالم الرقمية في المجالات والثقافات العالمية كافة، ظهرت تحديات عدة ذات صلة بحقول الفكر والسياسة والثقافة والدين والاجتماع وغيرها، وهو ما يُفسر انخراط العديد من المفكرين والباحثين في الاشتغال النظري على هذه التحديات، سواء عبر إصدار مؤلفات ودراسات أو تنظيم مؤتمرات وندوات، وإن كنا نشهد فورة في هذا الاشتغال في الغرب على الخصوص، تحديدًا في الساحتين الأميركية والأوربية، فإننا أصبحنا نعاين شروع بعض دول المنطقة في طَرْق هذا الباب العلمي المفتوح على آفاق بلا حدود من الإبداع والتطبيق. في هذا السياق إذًا، نروم التوقف عند محور يرتبط بتبعات التفاعل الرقمي، وعنوانه الآفاق التي تفتحها الثورة الرقمية، لتجاوز أزمات تمرّ منها المنطقة العربية.
مُحدّدات أولية
لكي نأخذ فكرة أولية عن التحولات العالمية ذات الصلة بالعالم الرقمي و«المنعطف الرقمي»(١)، نتوقف عند واقعتين: أولًا، في 24 إبريل 2018م، وقعت سابقة في مجال تلاقي مصالح العالم الرقمي بنظيره المادي؛ لأن الخبراء والباحثين كانوا على وعي بهذه التقاطعات منذ أولى محطات إطلاق المنصات الرقمية التفاعلية، وفي مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالاعتذار الذي قدمه مؤسس شركة «فيس بوك»، مارك زوكربيرغ حول قضية «كمبريدج أناليتيكا»، التي كُشف من خلالها تسريب معلومات عشرات الملايين من المستخدمين، خلال جلسة استماع أمام لجنة مشتركة من أعضاء الكونغرس الأميركي.
ثانيًا، بالنسبة للواقعة الثانية، فما زالت مفتوحة على احتمالات عدة، عالمية المدى، ويتعلق الأمر بالصراع الإستراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية والصين من أجل تحقيق السبق في المستجدات الرقمية، إلى درجة أصبحت فيها بعض الأسماء البحثية المتخصصة في الثورة الرقمية، ومن داخل المجال الأوربي، تؤكد أن الدول الأوربية، تعترف بأن النخبة الرقمية في أوربا في حالة «تخلف رقمي» مقارنة مع المستجدات التي طرقت بابها الولايات المتحدة الأميركية والصين.
الباحث الفرنسي لوران ألكسندر، الذي يُعد من أهم المتخصصين الأوربيين في موضوع «ما بعد الإنسان»، و«الذكاء الاصطناعي»، يقول في مضامين أحد إصداراته، وعنوانه «صراع الذكاءات: الذكاء الاصطناعي ضد الذكاء الإنساني»: إن دولة عظمى مثل فرنسا، تبقى متخلفة رقميًّا مقارنة مع التقدم التقني الرقمي للولايات المتحدة الأميركية والصين(٢). وهذا حُكم يتقاطع مع مجموعة من الدراسات والمقالات الصادرة في الولايات المتحدة، ونتوقف عند مثالين، على سبيل المثال لا الحصر:

إلزا كانيا
أولًا- مقالة الخبيرة الإستراتيجية إلزا كانيا، وتقول فيها: إن الصين «تُنتج تطبيقات ذكاء اصطناعي مسجلة ببراءات اختراع أكثر من أي دولة أخرى في العالم، باستثناء الولايات المتحدة، وقد نشر الأكاديميون الصينيون أوراقًا بحثية عن الذكاء الاصطناعي أكثر من منافسيهم»، مضيفة أنه في 2017م، «استقبل المؤتمر السنوي لرابطة نهضة الذكاء الاصطناعي عددًا من الأوراق البحثية من الباحثين الصينيين يُساوي ما استقبله من الأميركيين». وهذه سابقة علمية، تفيد أننا إزاء مؤشر ميداني على «التطور المتزايد في أبحاث الذكاء الاصطناعي في الصين. ومن نتائجه الاستثمار المالي الصيني الذي يصل إلى مليارات الدولارات، سواء تعلق الأمر بالاستثمار في القطاع الحكومي أو الخاص، إضافة إلى ولوجها إلى كميات هائلة من البيانات الضخمة، ومجهوداتها لاجتذاب أفضل المواهب وتعليمها، فإن الصين في طريقها إلى التغلب على الولايات المتحدة»(٣).
ثانيًا- في ملف نشرته مجلة «شؤون خارجية» الأميركية، بعنوان «الحرب العالمية السيبرانية»(٤)، تضمن ستة مقالات تصب في التركيز على الصراع الأميركي/الصيني في المضمار نفسه، مقابل التهميش من الثقل الأوربي، وتعد المجلة من المطبوعات المقربة من دائرة صناعة القرار الأميركي، تلك التي تسلط الضوء على قضايا سياسية أميركية ذات أفق إستراتيجي.
الأمثلة السابقة تحيل إلى تحول مفصلي تمرّ منه البشرية اليوم مع الثورة الرقمية التي فاجأت الجميع، سواء تعلق الأمر بصناع القرار، أو علماء الاقتصاد، أو رجال الدين والفكر وغيرهم، بل إن وتيرة التحولات السريعة جعلت من الصعب على هؤلاء مواكبتها، بسبب كثرة المستجدات التقنية من جهة، ومن أخرى انخراط القوى العظمى في توظيفها خدمةً لمصالح الأمن القومي والرؤى الإستراتيجية، بما في ذلك مقتضيات حروب السياسة والاقتصاد على الصعيديْنِ الإقليمي والعالمي.
سياقات دولية
نعيش في «العصر الرقمي»، تحديدًا في أولى مقاماته، وما تفرضه من كثرة التحديات والمستجدات المقبلة، ولا يعد الأمر تحولًا تقنيًّا عابرًا، إنما حقبة تاريخية جديدة، يُتوج فيها الجهد البشري الذي مرّ من مرحلة العصر الزراعي والصناعي وما بعد الصناعي، فمن الطبيعي أن يتم الربط بين سمة الرقمنة ومختلف أشكال التفاعل الإنساني، من قبيل الحديث عن الثقافة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والدبلوماسية الرقمية، والتعليم الرقمي، والمسابقات الرقمية… إلخ، ومن ذلك، الصراعات والأزمات الرقمية، وبخاصة أن الفرص والإمكانيات التي توفرها الثورة الرقمية تبقى مغرية، ولم تكن متوافرة في زمن الأزمات والصراعات التقليدية، أقلها رفع شعار: «الذكاء الاصطناعي هو المستقبل»؛ لأنه سيوفر فرصًا ثمينة وفريدة من نوعها وجديدة في مضامينها، ولها وقع خاص على إدراكنا، لكنه مع ذلك سيأتي أيضًا بتهديدات صعبة التنبؤ، فمن يسيطر على هذا المجال سيتحكم في العالم حتمًا، العالم الذي يتجه إلى ثورة عالمية علمية تغير وجهه إلى الأبد بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي؛ لأن الإنسان المعاصر في زمن الثورة الرقمية سيصبح بمقدوره أن يتوصل إلى ما يُشبه الحلول السوية لمعضلات مركبة يواجهها بسرعة ودقة منطقية مُعتمدًا على التمثيل الرمزي لأشياء وإدراك العلاقات بينها، وبخاصة مع دمج الذكاء البشري بالحواسيب الإلكترونية.
بل إن الحديث عن حروب رقمية عالمية مسألة متوقعة عند الخبراء، وعلينا أن نتوقع ظهور أزمات رقمية، ما ذهبت إليه الباحثة الفرنسية كارولين فايي، إحدى خبيرات الحقل الرقمي في الساحة الأوربية، من أنه من الناحية العملية، أُطلِقَت الحروب الرقمية منذ مطلع الألفية الثالثة(٥)، وتحديدًا من عام 2001م، متوقفة عند اتجاهين اثنين من هذه الحروب والأزمات: الحروب الاقتصادية والحروب الأيديولوجية، وتشير الباحثة إلى أنه «في العالم الرقمي، نحن إزاء مسرح درامي لحروب بلا رحمة من أجل إنقاذ مؤسسات وقيادات وحصص من السوق. لن يجري استثناء أي أحد، ولا حتى المؤسسات الكبرى التي تجد صعوبات كبيرة في مواكبة قواعد هذا اللعب المتحرك، ومن أجل فهم معالم الحروب الرقمية، لا مفر من العودة إلى أولى محطات الثورة الرقمية المتتالية، التي زودت وحصنت المستهلك»، بل «أصبحت الحروب المعلوماتية تتخذ حيزًا مهمًّا في العمليات العسكرية الحديثة، وفي المنصات الرقمية، وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، التي تلعب أدوارًا مهمة في تنظيم وفاعلية وترويج المعلومة، وهو ما نعاينه مع مجموعة من الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط وفي إفريقيا»(٦).
من نتائج السباق العالمي لصناع القرار على الاستفادة من الثورة الرقمية في شقها الصدامي، أصبح العالم الرقمي خلال العقد الأخير على الخصوص، أرضية جديدة لمعارك الألفية الثالثة، أخذًا في الحسبان التطورات التقنية التي خوّلت لصناع القرار السياسي والأمني، التعامل مع الثورة الرقمية على أساس أنها أسلحة رقمية تُجَنَّد وتُوَظَّف في سياق تدبير الأزمات والحروب الرقمية والمعلوماتية، مجسدة بذلك سلاحًا ذا حدين: فمن ناحية، يبقى هذا التوظيف متوقعًا من أجل مواكبة متطلبات العصر الحديث، ومن أخرى، أصبح نافذة للانكشاف الأمني والمعلوماتي.
نحن إزاء حروب رقمية ستكون تداعياتها خطيرة على العالم بأسره(٧)، حيث استهداف «أهداف سياسية أو عسكرية أو لمجرد الإثارة، أو لتحقيق أهداف إجرامية، حيث يستحوذ المهاجم رقميًّا على المعلومات الإستراتيجية ونظمها، ويقوم بالتجسس وسرقة البرامج الرقمية أو تعطيل وتخريب نظمها، واتخاذ إجراءات لمهاجمة مصادر التهديد، واستخدام نظم رقمية متقدمة، حيث يشهد العالم تطورًا حذرًا وسريًّا في هذا الصدد»(٨)، وواضح أن خطر هذه الحروب لا ينحصر في العالم الرقمي، إنما يتجاوزه إلى الواقع المادي الملموس.
لقد أصبحت الدول في مقدمة القوى الأكثر تأثيرًا في العالم الرقمي، عبر تطوير وتحديث آليات التقدم التقني والمؤهلات التي تَتوفّر عليها. كما نجد ضمن الفاعلين المؤثرين في العالم الرقمي، «العناصر الخطيرة، الجماعات الإرهابية، المرتزقة التابعين لإغراءات ومصالح، أو قراصنة العالم الرقمي، وبخاصة القراصنة الوطنيون، من المؤهلين للتسبب في اضطرابات خطيرة. ولكن، من أجل القيام باعتداءات واسعة رقميًّا، لا مفر من التوفر على المعلومة والتقنية والإمكانات البشرية»(٩).
مقدمات نظرية
نتوقف عند بعض المحددات النظرية التي نرى أنها تساعد الدول العربية في تدبير الأزمات الرقمية، وهي الأهم لأسباب عدة، بل إن أحد أهم أسباب التباين العربي في التعامل مع هذه المستجدات، ذات صلة ببعض المحددات النظرية، ويوجد في مقدمتها الموقف من أهمية الاشتغال على العالم الرقمي، بين اتجاه عربي سائد، يرى أن ذلك الاشتغال لا يستحق كل الهالة الإعلامية والبحثية والسياسية والأمنية التي تصاحبه على المستوى العالمي، وبين آخر مضاد، يرى عكس ذلك، ومنخرط بالتالي في استحقاقات الثورة العلمية، ويتقدم هذا الاتجاه ما تقوم به بعض دول الخليج العربي، كما هو الحال مع السعودية والإمارات.
في السعودية مثلًا؛ وضعت الخطط الملائمة ابتداءً من مطلع العقد الماضي، عبر «تفعيل عناصر مجتمع المعلومات الأربعة: التجارة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني، الحكومة الإلكترونية، الصحة الإلكترونية؛ تكوين مجتمع المعلومات الذي يعتمد على التحوّل من المركزية إلى اللامركزية، ومن التعليم القائم على التلقين إلى ذاك الذي يدعم لدى الدارس القدرة على التفكير والابتكار وتعليم الذات؛ تبسيط الإجراءات، وغيرها من المبادرات».
أما الإمارات، فقد تبنّت «منذ سنوات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وقطاع الأعمال ضمن إستراتيجيتها لتنويع الاقتصاد الهادفة إلى نقلِهِ من اقتصاد يعتمد على النفط إلى تنمية تقوم على المعرفة»، ويندرج خيارها، في سياق الاشتغال على قضايا مستقبلية؛ منها الآفاق التي تفتحها الثورة الرقمية، بما فيها التطلعات التي تتصل بالذكاء الاصطناعي، حتى إنها أطلقت مؤخرًا جامعة للذكاء الاصطناعي.
مواجهة التحديات الرقمية في المنطقة العربية، وفي مقدمتها الأزمات الرقمية، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، تفرض إيمان صناع القرار، بأن التحولات ليست مجرد قضايا ذات صلة بالتواصل والتثقيف، كما كان معمولًا به مثلًا، في أولى محطات إطلاق مواقع التواصل الاجتماعي، إنما قضايا مصيرية، تتعاطى معها القوى العظمى بحزم لا يختلف عن تعاملها مع الحروب والأزمات الميدانية على أرض الواقع، بل تعرف انخراط مؤسسات سيادية وحساسة(١٠)، من قبيل مؤسسات الجيش والأمن ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والصناعة.
إذا كان اقتحام العالم الرقمي للحقل السياسي يصبّ في قلب المشهد في الأعوام المقبلة، فالأمر نفسه مع الحقلين الأمني والعسكري، وليس مصادفة أن ولادة شبكة الإنترنت في الأساس، كانت لمتطلبات عسكرية وأمنية في الساحة الغربية، قبل فتح باب العمل بها للجميع في العالم بأسره، ومن باب أولى أن نعاين الأمر نفسه مع التوظيفات الرقمية التي تلجأ إليها القوى العظمى اليوم في معرض خدمة مشروعاتها الإستراتيجية، إلى درجة الحديث عن ولادة «دول مُقرصِنة»(١١)؛ لأنها توظف العالم الرقمي خدمةً لمصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية والإستراتيجية، وأن هذه الدول، «لم تعد تقتصر على المراقبة والتجسس، إنما توظف التطبيقات الرقمية للمؤسسات الأجنبية، الحليفة والمنافسة على حد سواء، سواء كانت مالية أو اقتصادية أو سياسية أو أمنية، ومن هنا أسباب الحرب الباردة الجديدة بين أميركا والصين خلال العشر سنوات الأخيرة».
مقدمات تطبيقية
نتحدث هنا عن أزمات رقمية، بما فيها «الحروب الرقمية» التي تُعد حروبًا تقنية متطورة تعكس قمة التطور الذي وصلت إليه «ثورة المعلومات وبوابتها الحاسبة الإلكترونية، التي شكلت بدورها الأداة المحورية لهذا النوع من الحروب وميدانها الرئيس، فكانت نتيجة لذلك فضاءً للتطور المستمر والتنوع والابتكار في تقنياتها ووسائلها لارتباطها بقمتي الهرم التقني للحضارة الإنسانية والمصالح الحيوية للدول»(١٢)، فمن الطبيعي أن تتميز الأزمات الرقمية بوجود أدوات تقنية تُوظف في الصراعات الافتراضية الدائرة في الفضاء الرقمي، بصور مشابهة للحروب التقليدية التي تدور على أرض الواقع.
ارتفاع مؤشر تعرض المنطقة العربية خلال العقدين الأخيرين على الخصوص لمخاطر أمنية وعسكرية عدة، وقد أحصى أحد الباحثين، مجموعة من أدوات الحروب الرقمية- تفرض على صناع القرار، أخذها في الحسبان؛ منها «اختراق المواقع الرقمية، زرع الفيروسات في البيئات الرقمية، الحرب الإعلامية، القرصنة الرقمية، الأقمار الاصطناعية، الخداع، التجسس، الأسلحة النانوتكنولوجية والروبوتية، وأخيرًا، الغزو الفكري عبر الوسائط المفتوحة».(١٣)
ننوه أخيرًا بمجموعة من المبادرات العربية التي تروم الالتحاق بالركب العالمي المنخرط في الاشتغال على الآفاق الرقمية، وفي القلب منها السبق الخليجي، وهو ما يتطلب التنبيه إلى تحديات عدة تواجهنا جميعًا؛ منها عدم الاقتصار على تنظيم مؤتمرات من دون تفعيل توصياتها، ولو تطلب الأمر تقليد دول الخليج العربي، أي الانخراط النظري والميداني في توظيف الثورة الرقمية في مشروعات التنمية المحلية والإقليمية، وهو ما اتضح خلال مواجهتها جائحة كوفيد 19، أو الرهان على العمل الجماعي لدول المنطقة، أو على الأقل لمجموعة دول في تكتل إقليمي، من قبيل المغرب العربي أو مجلس التعاون الخليجي؛ لأنه في الحالات جميعها، يتطلب المنظور الإستراتيجي الانخراط في مواجهة تحديات دولية مقبلة، تغذيها الثورة الرقمية.
هوامش:
(١) يُقصد بالمنعطف الرقمي، مجمل التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية والدينية والجيو-سياسية والجيو-اقتصادية الناتجة من ولوج الإنسان الفضاء الرقمي واستعماله وترويضه والتحكم فيه.
(٢) انظر: Laurent Alexandre, La guerre des intelligences, l’intelligence artificielle versus l’intelligence humaine, JC Lattès, Paris, p 100.
(٣) Elsa B. Kania, Artificial Intelligence and Chinese Power, Beijing’s Push for a Smart Military—and How to Respond, Foreign Affairs, December 5, 2017, in : https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-12-05/artificial-intelligence-and-chinese-power
(٤) Gideon Rose, World War Web, Foreign Affairs, Volume 97, Number 5, September/October 2018, p 8.
(٥) انظر على الخصوص الفصل الأول من كتاب الباحثة كارولين فايي لكتابها المهم، وعنوانه: «فن الحرب الرقمية: أو النجاة والهيمنة في الزمن الرقمي»، ط 1، باريس، 2016م.
Caroline Faillet, L’art de la guerre digitale – Survivre et dominer à l’ère du numérique, Dunod, Paris, mai 2016, 266 pages.
تتطرق المؤلفة في الفصل الأول من هذا العمل المهم إلى المقدمات النظرية لاندلاع «الحروب الرقمية» في العالم، أما الفصل الثاني من الكتاب فقد خُصّص للحديث عن معالم وآفاق الحروب الاقتصادية، بينما خُصّص الفصل الثالث لمعالم وآفاق الحروب الأيديولوجية، وأخيرًا، خُصّص الفصل الرابع من العمل للتوقف عند بعض الرؤى لتفادي هذه الحروب.
Caroline Faillet, L’art de la guerre digitale, Op cit, p 26.
(٦) Pierre Jolicoeur, Le rôle des médias sociaux dans la guerre des narratifs. Utilisation des médias sociaux par Daech : défis éthiques et rapports de pouvoir, in : Diplomatie Gd N°41, Medias Entre Puissance Et Influence Octobre/Novembre 2017, p 91
(٧) لمزيد من التفصيل حول واقع ومعالم «الحروب الرقمية»، انظر الكتاب المشترك الذي ألفه فرانسوا لوفيو وإريك ميان، بعنوان: «النجاة من الحرب الرقمية»:
François Levieux et Eric Meillan, Survivre la Guerre Numérique, Edition Picollec, 2017, 186 pages.
(٨) شلوش نورة، القرصنة الإلكترونية في الفضاء السيبراني: التهديد المتصاعد لأمن الدول، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، سنة 2018م، المجلد 8، العدد 2، الصفحة 197.
(٩) Frédérick Douzet : « Les Etats mènent en permanence des actions offensives dans le cyberespace », Propos recueillis par Martin Untersinger et Nathalie Guibert , In Le Monde, Paris, 23 – 24 juillet 2018, p 15.
(١٠) يرى أحد خبراء الدراسات المستقبلية أو الدراسات الاستشرافية، الفرنسي ألكسندر لوران، أن الوتيرة التي تتطور بها الخوارزميات الرقمية خلال السنين الأخيرة، تخول للمتتبعين الزعم بأننا نتجه لكي تصبح المنصات الرقمية، وعددها بالمليارات، مؤطرة القوانين على أرض الواقع، وليس المؤسسات التشريعية في المجالس النيابية؛ لأن هذه الأخيرة ستكون عاجزة عن مواكبة هذه المستجدات. انظر:
Laurent Alexandre, La guerre des intelligences Broché, p 67.
(١١) لمزيد من التفصيل في مفهوم «الدول المقرصنة»، انظر كتاب: «@الحرب: صعود المركب العسكري السيبراني»، 2015.
Shane Harris, @War: The Rise of the Military-Internet Complex, Eamon Dolan/Mariner Books, November, 2015, 288 pages.
(١٢) أشرف السعيد أحمد، الحروب في الفضاء الرقمي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 1، 2013، ص 47.
(١٣) محمد بلحاج، قراءة في محددات الحروب الرقمية، مجلة أفكار، الرباط، العدد 31-32، ص 48، 2018.

منتصر حمادة - باحث مغربي | نوفمبر 1, 2020 | مقالات
في مطلع أكتوبر الماضي، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابًا كان مخصصًا للتوقف عند المعضلة الإسلامية الحركية في الساحة الفرنسية حصرًا، متحدثًا تحديدًا عما اصطلح عليه بـ«الانفصالية الإسلامية»، أو قل الانفصالية الإسلامية الحركية؛ لأنه يقصد بذلك ظاهرة التشدد الديني أو الغلو الديني الذي بزغ هناك خلال العقود الأخيرة، ولم يكن يقصد واقع المسلمين هناك، الذين يناهز عددهم نحو سبعة ملايين مسلم، بل يقترب هذا العدد من نسبة 10% من الساكنة الفرنسية، بمعنى أنه حتى من منظور سياسي انتخابي براغماتي لا يمكن أن تكون الجالية المسلمة أو الأقلية المسلمة في فرنسا، هي المعنية بمضامين هذا الخطاب، إنما المعنيّ الأول والأخير، المشروع الإسلامي الحركي الانفصالي.
مباشرة بعد هذا الخطاب، انخرط العديد من الأقلام الفرنسية والعربية والإسلامية في التفاعل معه، سواء من باب التأييد أو من باب النقد، بصرف النظر عن مرجعية التفاعل، لأن الأمر همَّ مجموعة من المرجعيات والأيديولوجيات، بما في ذلك الأيديولوجيات الدينية والمادية، وبصرف النظر أيضًا عن طبيعة التفاعلات، التي في الأغلب تتوزع على اتجاهين اثنين: اتجاه تفاعلي أيديولوجي صرف، يُسهِم في التشويش على الموضوع، وإثارة القلاقل التي نحن في غِنًى عنها؛ واتجاه تفاعلي معرفي، ميزته الأهم أنه ينتصر للمقاربة الرصينة والنافعة، بما في ذلك الاتجاه الذي يبحث عن المشترك الإنساني، ومن ثَمّ يأخذ مسافة من خطاب الصدام والاختزال، السائد لدينا ولديهم على حد سواء.

برنارد روجييه
وعِوَضًا عن أن تنخرط أقلام الساحة العربية والإسلامية، في تقييم وتقويم ما جاء في الخطاب، من باب الإنصاف، وبمقتضى غلبة القراءات الأيديولوجية في الساحة؛ هيمن خطاب إثارة العواطف، ودخلت الأصوات الإسلامية المتشددة، وفي غضون الشهر نفسه، تطورت التفاعلات من العالم الرقمي والمنابر الإعلامية، إلى العالم المادي على أرض الواقع، عندما تورَّط شاب مسلم من أصل شيشاني، في مقتل مدرس تاريخ، بسبب مبادرة لهذا الأخير، ذات صلة بعرض بعض الرسوم الكاريكاتيرية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، على التلاميذ، حيث طلب من التلاميذ المسلمين الانسحاب سلفًا من القسم، حتى لا يتسبب في إثارة حساسيات دينية.
وهو الحدث الذي تلاه تفاعل صانعي القرار مرة أخرى، ووصل إلى التأكيد أن مقتضى «حرية التعبير» لديهم، يُخول لهم إعادة نشر تلك الرسوم في بعض المنابر الإعلامية، موازاة مع عرضها في بعض الساحات العمومية، بكل التداعيات الإقليمية التي ستتلو هذه التطورات، ومنها دعوة بعض الفعاليات في المنطقة إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، وفي مقدمتها الفعاليات المحسوبة على الحركات الإسلامية، التي كانت المعنيّة الأولى بخطاب إيمانويل ماكرون.
كشفت هذه الأحداث عن قدر كبير من الجهل المتبادل بين أغلبية المتفاعلين، ومنه جهل أبناء المنطقة بواقع العلمانية في نسختها الفرنسية، وجهل مضاعف بأنماط العلمانية في الساحة الغربية؛ لأن العلمانية علمانيات، كما كشفَت عن جهل أقلام الساحة العربية بواقع المعضلة الإسلامية الحركية التي بزغت هناك، موازاة مع معضلة تهمُّ الفرنسيين، وبعض الأوربيين، وهي معضلة الإسلاموفوبيا، فأصبحنا أمام صراع بين تشدُّدينِ، هما مجرد أقلية، ولكنهما يثيران القلاقل للجميع.
نروم في هذه المقالة، التوقف بالتحديد عند واقع الظاهرة الإسلامية الحركية في الساحة الفرنسية، ما دام هذا الواقع، كان في صلب خطاب الرئيس الفرنسي.
حتى عقد ونيف، كانت أخبار المسلمين في الساحة الفرنسية، حيث توجد أكبر جالية مسلمة في أوربا، لا تخرج عن عناوين من طينة: «مشكل الهجرة»، و«قلاقل ضواحي المدن الكبرى»، و«الجاليات العربية وتحدي الاندماج في المجتمع». ولكن مع تغلغل المشروع الإسلامي الحركي هناك، وفي مقدمته المشروع الإخواني، تحت اسم «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا»، تغيرت تلك العناوين، فأصبحت الإحالة مباشرة على مشاكل المسلمين وقلاقل الجماعات الإسلامية، سواء كانت مشاكل تهم حالات فردية، متورطة في إبداء مواقف متشددة أو شاذة عن خطاب المسلمين هناك، أو كانت مرتبطة بخطاب تجمعات أو مؤسسات أو منظمات جمعوية، تخدم المشروع الإسلامي الحركي بشكل عام، والمشروع الإخواني بشكل خاص، بحكم غَلَبة الهاجس السياسي في الجهاز المفاهيمي عند أتباع هذا المشروع.
وليس مصادفة أن هذه التطورات، دفعت صناع القرار في باريس للاشتغال على تقارير بحثية، تسلط الضوء على المعضلة الإسلامية الحركية، ولن تكن آخر هذه التقارير، ما جاء في مضامين عمل بحثي رسمي، حتى في العام الماضي، أشرف عليه الباحث حكيم القروي، وعنوانه «صناعة الإسلاميين»، وجاء في 617 صفحة، وخلُصَ إلى التأثير الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الأفكار، مؤكدًا «تنامي الأيديولوجيا الإسلامية»، رغم أن «الإسلاميين يشكلون أقلية بسيطة بين مسلمي فرنسا»، ومضيفًا أن السلفيين «يكسبون مواقع داخل الجالية المسلمة»، خصوصًا «الشبان دون 35 عامًا»، داعيًا صناع القرار إلى امتلاك «وسائل وشبكات مهمة لبثّ خطاب مضاد» للأفكار الإسلامية الحركية.
في هذا السياق، صدر كتاب بالفرنسية عنوانه: «الضواحي التي غزتها الإسلاموية» لبرنارد روجييه وجاء في 412 صفحة، ط 1، يناير 2020م، محاولًا الإجابة عن مجموعة أسئلة، منها، على سبيل المثال لا الحصر: «كيف انتشر المشروع الإسلامي الحركي في ضواحي المدن الفرنسية، في دولة تتميز بأن نموذجها العلماني مختلف عن باقي النماذج العلمانية في القارة الأوربية؟ وكيف استطاعت مشاريع عربية أن تروج تصورها للإسلام في عقر الديار الفرنسية؟ ما تقاطعات المشاريع الإسلامية الحركية في فرنسا؟
والعمل في الواقع، عبارة عن تجميع دراسات ميدانية ونظرية، استمرت طيلة مدة تُرَاوِحُ بين ثلاث سنوات وأربع سنوات، أشرف عليها مؤلف الكتاب، الباحث الفرنسي برنارد روجييه، وهو بروفيسور في جامعة باريس 8، السوربون الجديدة، ولأهمية مضامين العمل، سُلِّطَ الضوء الرسمي والإعلامي عليه في الأشهر الأخيرة، إلى درجة استدعاء الباحث لكي يدلي بشهادته والرد على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين الفرنسي. ومن مؤلفاته السابقة، نذكر: «الجهادي اليومي» 2004م، وترجم إلى الإنجليزية، حيث صدر عن جامعة هارفارد في 2007م؛ و«تشرذم الأمة» 2011م، وترجم إلى الإنجليزية، حيث صدر عن جامعة برنستون في عام 2015م. من مميزات العمل، أنه يتوقف بالشهادات والوقائع عند بعض معالم الأسلمة التي أصابت العديد من الضواحي الفرنسية، وبدرجة أقل الضواحي الأوربية، ومنها ضاحية بلدية مولنبك، التي بزغ اسمها في 22 مارس 2016م على هامش اعتداءات مترو الأنفاق في العاصمة البلجيكية.
مفاصل الإسلاموية في فرنسا
يشتغل العمل الجماعي على كشف بعض مفاصل العمل الإسلامي الحركي في الساحة الفرنسية، وأداء هذا المشروع في المراكز الدينية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني، التي تفضي مع مرور الوقت إلى تأسيس عزلة مجالية لمسلمي هذه الفضاءات عن المجتمع الفرنسي، ولا يتعلق الأمر هنا بالمراكز الثقافية والدينية وحسب، بل يهم منظمات المجتمع المدني، والنوادي الرياضية والسجون، وباقي التجمعات التي تتميز بحضور نسبة نوعية للمسلمين هناك، مع أن هذه تحولات لم تكن قائمة من قبل، أثناء قدوم الأجيال الأولى لمسلمي فرنسا، مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، في سياق إعادة إعمار القارة ومعها فرنسا، مع تذكير المؤلف الضروري هنا بأن هذا الجيل الأول لمسلمي فرنسا، جاء بالتحديد بين عامي 1970م و1980م، بينما سوف تبزغ المشاكل المرتبطة بالتدين الإسلامي، لاحقًا بعد قدوم المشروع الإخواني، كما جسدت ذلك واقعة الحجاب الشهيرة في عام 1989م؛ بسبب العمل الميداني الذي كان وما زال تقوم به مؤسسة «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» التي تُعَدُّ بمنزلة الفرع الفرنسي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
من مفاتيح العمل النظرية، التي تتلوها تطبيقات عملية على أرض الواقع، مفتاح عنوانه تعامل الإسلاميين في فرنسا مع العلمانية، حيث أشار المؤلف إلى أن العلمانية في نسختها الفرنسية بالتحديد، لا تمنع المسلمين من ممارستهم شعائرهم الدينية، بدليل وجود مساجد لإقامة الصلاة، ومكتبات تبيع الكتب الإسلامية، وغيرها من المؤشرات الميدانية، ولكن ما تعارضه هذه المنظومة، هو التأسيس لخطاب طائفي، تروجه مجموعات بشرية ما، تدعي أن قيم الطائفية أسمى من الدولة والمعتقد، ومن هنا عداء الإسلاميين لقيم الجمهورية، بل يتحدث المؤلف عن رغبتهم في القضاء على الجمهورية؛ لأنهم ضد «الإسلام الليبرالي» المفتوح على النموذج الفرنسي.
وتوقف المؤلف عند مجموعة من الرموز الفرنسية التي تنحدر من الجالية المسلمة، سواء كانت تحمل الجنسية الفرنسية أم لا، منوّهًا بانخراطها في النسيج المجتمعي الفرنسي، انطلاقًا من مرجعيتها الثقافية والدينية، عادًّا أن هذه النماذج تجسد هاجسًا حقيقيًّا لمشروع الحركات الإسلامية في فرنسا، وبيان ذلك أن هذه النماذج لا تشتغل بعقلية الأسلمة، وإنما تترك الاعتقاد الديني في المجال الخاص أو في الدائرة العائلية حتى المجتمعية مع الفرنسيين غير المسلمين (من المسيحيين واليهود مثلًا)، من دون فرض وصاية إسلامية ما.
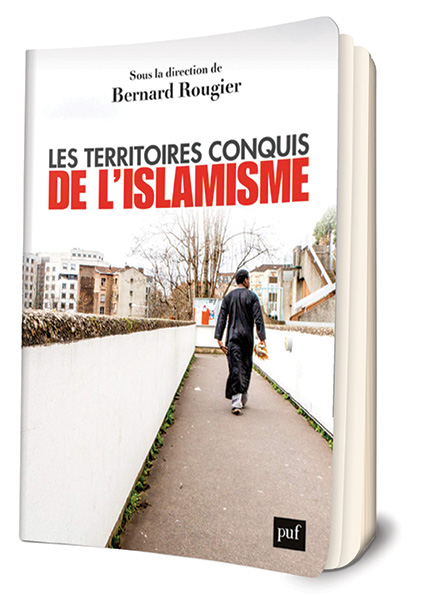 في معرض البحث عن أسباب غزو التديّن الإسلامي الحركي لدى الجاليات المسلمة في الضواحي الفرنسية، يُسلط الكتاب الضوء على أسباب عدة، ويصمت عن أخرى. فمن الأسباب التي يصمت عن الخوض فيها، مسؤولية السياسات العمومية للحكومات الفرنسية خلال العقود الأخيرة، وبخاصة السياسات العمومية التي تهمّ الضواحي، ومن الأسباب الخاصة بالتديّن الإسلامي، توقف الكتاب عند مسؤولية العديد من الدعاة والوعاظ الإسلاميين، الذين أرسلتهم الدول المغاربية، وليس مصادفة أن هذه الجزئية، ستكون أرضية التوجه الذي من المفترض أن تتبناه الدولة الفرنسية خلال السنوات القادمة، وعنوانه إيقاف نظام إعارة الأئمة من المنطقة العربية، أي الخيار الذي كانت تتبعه باريس طوال السنوات الماضية، وذلك في إطار خطة لمواجهة «الإسلاموية» وتعزيز قيم العلمانية بالجمهورية، حيث من المفترض، كما أشارت إلى ذلك أسبوعية «لوبوان» الفرنسية، حسب مضامين وثيقة «إستراتيجية لمحاربة الإسلاموية وضد الهجمات على مبادئ الجمهورية»، إنهاء «نظام الأئمة المعارين» من المغرب وتركيا والجزائر، مقابل تدريب الأئمة الفرنسيين من خلال تطوير «دورات في علم الإسلام» في الجامعات، ومشاريع المدارس الدينية، وخصوصًا في المؤسسات العسكرية والمستشفيات.
في معرض البحث عن أسباب غزو التديّن الإسلامي الحركي لدى الجاليات المسلمة في الضواحي الفرنسية، يُسلط الكتاب الضوء على أسباب عدة، ويصمت عن أخرى. فمن الأسباب التي يصمت عن الخوض فيها، مسؤولية السياسات العمومية للحكومات الفرنسية خلال العقود الأخيرة، وبخاصة السياسات العمومية التي تهمّ الضواحي، ومن الأسباب الخاصة بالتديّن الإسلامي، توقف الكتاب عند مسؤولية العديد من الدعاة والوعاظ الإسلاميين، الذين أرسلتهم الدول المغاربية، وليس مصادفة أن هذه الجزئية، ستكون أرضية التوجه الذي من المفترض أن تتبناه الدولة الفرنسية خلال السنوات القادمة، وعنوانه إيقاف نظام إعارة الأئمة من المنطقة العربية، أي الخيار الذي كانت تتبعه باريس طوال السنوات الماضية، وذلك في إطار خطة لمواجهة «الإسلاموية» وتعزيز قيم العلمانية بالجمهورية، حيث من المفترض، كما أشارت إلى ذلك أسبوعية «لوبوان» الفرنسية، حسب مضامين وثيقة «إستراتيجية لمحاربة الإسلاموية وضد الهجمات على مبادئ الجمهورية»، إنهاء «نظام الأئمة المعارين» من المغرب وتركيا والجزائر، مقابل تدريب الأئمة الفرنسيين من خلال تطوير «دورات في علم الإسلام» في الجامعات، ومشاريع المدارس الدينية، وخصوصًا في المؤسسات العسكرية والمستشفيات.
بل كان برنارد روجييه صريحًا في التأكيد أن خلاصات هذا العمل الجماعي، تفيد أنه طيلة ثلاثة عقود مضت، تأسست في فرنسا شبكات إسلاموية معقدة، تروم الهيمنة على تديّن مسلمي فرنسا، منوهًا بكون أغلب الأئمة في فرنسا لا علاقة لهم بالحركات الإسلامية، ولكن مؤكد أيضًا، يضيف روجييه، أن نسبة لا بأس بها من أئمة فرنسا، تنتمي إلى الأيديولوجية الإسلاموية، وخصّ بالذكر أربعة توجهات إسلاموية، يتقدمها المشروع الإخواني، ثم التيار الديني المحافظ، باسم السلفية، وبعده في مقام ثالث جماعات «الدعوة والتبليغ»، وأخيرًا، المشروع «الجهادي»، وإن كان أقلية في التصنيف الذي خلصت إليه أعمال الكتاب، عادًّا هذه المجموعات أو التيارات الأربعة، منخرطة في منافسة ميدانية من أجل الظفر بتمثيل الإسلام في الضواحي والأحياء والسجون والمؤسسات، مع اتفاقها الجماعي على معارضة النموذج الجمهوري والعلماني في الحكم للدولة الفرنسية.
أما أداء جماعات «الدعوة والتبليغ»، فيأخذ عليها الكتاب أنها تتبنى «أسلمة فولكلورية»، من باب الاقتداء بالنموذج النبوي حسب تصور أدبيات الجماعة، ومن هنا القيام بما يصطلح عليه أتباع الجماعة بمبادرات الخروج في سبيل الله، أي ممارسة الدعوة والوعظ في الأحياء والشارع، وبخاصة لدى أبناء الجاليات المسلمة، سواء استمرت المدة ثلاثة أيام، أو أربعين يومًا أو ثلاثة أشهر. صحيح أن هذه الجماعات بعيدة من العمل السياسي، وهذه ميزة نعاينها عند جميع تفرعات «الدعوة والتبليغ» في العالم الإسلامي والعالم الغربي، وليس في فرنسا وحسب، ولكن من أهم المؤاخذات عليها، حسب الكتاب، أنها جماعة تكرس ما يُشبه القطيعة مع المجتمع، مع أنها عضو في مؤسسة «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية»، أي المؤسسة التي تُعَدّ الناطق الرسمي باسم مسلمي فرنسا أمام السلطات الفرنسية وصانعي القرار.
ولكن مسألة القطيعة مع المجتمع كما أشار إليها المؤلف في معرض الحديث عن مشروع جماعات «الدعوة والتبليغ»، لا تهم هذه الجماعة وحسب، وإنما تهم مُجمل المشاريع الإسلاموية سالفة الذكر، محذرًا من مأزق الفصل بين هذه المشاريع، بوصفها منخرطة في غزو إسلاموي للإسلام الفرنسي، أو قل غزو إسلاموي أيديولوجي لتديّن مسلمي فرنسا الذي لم تكن له أي علاقة مع هذه الأيديولوجيات، على الأقل قبل قدومها وتغلغلها في المجتمع الفرنسي، وخصوصًا في ضواحي المدن الكبرى والمتوسطة.
ومما يغذي هذه الخلاصة، النتائج التي توصل إليها الباحثون المشاركون في هذا العمل الجماعي على هامش التدقيق في مضامين الكتب الإسلامية التي توزع وتباع في فرنسا، حيث اتضح أن نحو 31% من هذه الكتب، تتطرق لقضايا الفقه والعبادات والمعاملات، بينما يتطرق الباقي إلى الحديث عن «الدين الصحيح»، الذي يواجه الاعتداء الغربي، بما يُغذي الخطاب الإسلامي المتشدد من جهة، وخطاب أحزاب اليمين السياسي من جهة ثانية، حيث يتضح أن كليهما يريد إقناع المسلمين وغير المسلمين بأن الإسلاموية هي الإسلام، بينما الأمر خلاف ذلك. وما يعقد المشهد حسب المؤلف، أن هناك نسبة من النخب الفكرية اليسارية، تغذي هذا الطرح الاختزالي، وبخاصة اليسار المنخرط في نقد الأطروحات الاستعمارية.
معالم المشروع الإخواني في فرنسا
نأتي لأداء المشروع الإخواني في فرنسا، الذي يُسَلَّط الضوء عليه كثيرًا مباشرة بعد أي اعتداء إرهابي تتعرض له فرنسا، بمقتضى دعوة الرموز الإخوانية إلى ضرورة احترام قوانين الجمهورية، ويرى المؤلف أن المشروع الإخواني هناك تعرض لزعزعة نسبية بسبب الحضور السلفي، ولكنه ما زال قائمًا في مجالات ومبادرات عدة، منها مبادرة «تحالف المواطنة» الذي نظم مبادرة 21 مايو 2019م بمدينة غرونبل (جنوب شرق فرنسا) التي تدعي الانخراط الميداني في تنفيذ أعمال خيرية وإحيائية، من قبيل تنظيف الشوارع والمصاعد الكهربائية، ولكن تحت غطاء خطاب وعظي ديني، محسوب على المرجعية الإخوانية.
في معرض تقديم أجوبة عن أسباب تحول شباب منحرف نحو المشروع «الداعشي»، حتى إن عدد الفرنسيين الذين شدوا الرحال إلى سوريا خلال السنين الأخيرة، قبل سقوط تنظيم «داعش» ناهز 1500 شاب، بمن فيهم بعض زوجات هؤلاء، يرى المؤلف أن الأيديولوجية الداعشية، كانت ذكية في استقطاب هؤلاء من خلال تأصيل الاتِّجار في المخدرات أو سرقة أموال مؤسسات عمومية، بما فيها البنوك، بوصفها «نضالًا ضد الدولة الكافرة»، ومن ثَمَّ عَدّ تلك الأعمال جهادًا، ونستشهد هنا بعدة نماذج ميدانية، نذكر منها حالة محمد مراح أو صبري السعيد، مطالبًا بعدم اختزال هذه الحالات وتصنيفها في خانة «الذئاب المنفردة»، بقدر ما يتعلق الأمر بفشل إدماج الشباب، حيث استغله الخطاب الداعشي ووظَّفه لصالح مشروعه القتالي.
توقف الكتاب أيضًا عند بعض معالم التوافقات التي تنخرط فيها الرموز الإخوانية الفرنسية أثناء الاستحقاقات الانتخابات، البلدية والتشريعية، بمقتضى الحضور الميداني الجَلِيّ للمشروع الإسلامي الحركي، سواء في المؤسسات الثقافية أو في الضواحي والمساجد والجمعيات الرياضية ومحلات التجارة التي يُصطلح عليها هناك «التجارة الحلال»، والمؤسسات التعليمية. ومن نتائج ذلك، أن المنتخبين الفرنسيين، يتورطون في تغذية هذا المشروع وتقويته، إما بسبب الجهل بأداء هذه الأيديولوجيات الدينية، أو بسبب الرغبة في الظفر بأصوات الناخبين الفرنسيين من أصل إسلامي، فيما يُكرس ما يُشبه «اختطاف الدين» بتعبير المؤلف.
توقف المؤلف هنا عند حالة الباحث مروان محمد، الذي كان يُعَدّ أحد الأقلام البحثية والإعلامية التي كانت محسوبة في زمن مضى على الداعية والباحث طارق رمضان، حيث استعرض ارتباطاته بالمشروع التركي، بمقتضى دخول أنقرة على الخط الإسلامي الفرنسي عبر التمويل والدعم والمتابعة، من خلال أداء وزارة الشؤون الدينية التركية، موازاة مع الحضور الإسلامي الكبير في الساحة الألمانية، كما أشار المؤلف إلى اشتغال الإخوان في فرنسا على تأسيس هيئات ومنظمات إسلاموية جديدة، تكون البديل الميداني لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، بعد أن أصبح هذا الاتحاد عند صناع القرار وعند الباحثين والإعلاميين المتتبعين، محسوبًا على المشروع الإخواني، بينما الأمر مختلف مع المنظمات البديلة، من خلال عمل المشروع الإخواني بخيار التقية. وفي مقدمة هذه الهيئات، جامعة إسلامية، تحمل اسم ابن خلدون، حيث إلزامية تعلم اللغة التركية والعربية، انسجامًا مع مقتضيات التمويل التركي، بهدف إحداث اختراق المصالح السياسية التركية لدى الجاليات المسلمة في فرنسا، مع أنها جالية أصلها مغاربي أساسًا، وليست من أصل تركي.
في سياق التصدي للمشروع الإسلاموي عامة، بما في ذلك الإسلاموية الإخوانية، بوصفها الأكثر حضورًا في منظمات المجتمع المدني، يقترح المؤلف الانتصار لقيم الديمقراطية الحديثة، في شقيها الليبرالي (عبر ثنائية القانون والحرية) والجمهوري، محذرًا من أن فئة معينة من الإسلاميين، وبخاصة التيار الإخواني، توظف الشق الليبرالي في الديمقراطية، خدمة لأجندات طائفية، وانخراطها موازاة مع ذلك في نقد التاريخ الفرنسي، وتاريخ الثورة الفرنسية والمرجعيات الجمهورية.
نقد خبراء الإسلاموية في فرنسا
من مفاتيح الكتاب كذلك، تسليطه الضوء على مضامين المكتبات الإسلامية، حيث الحضور الكبير للخطاب الإسلامي الحركي، وتأثير هذا الخطاب في رؤية الشباب للآخر: العائلة، المجتمع، الدولة، المرأة… إلخ، مضيفًا أنه يمكن أن نجد الأعمال التي تتطرق للروحانيات الإسلامية أو للتصوف الإسلامي في المكتبات الفرنسية الكبرى والمتوسطة، ولكن هذه الأعمال غائبة وشبه محاربة في المكتبات الإسلامية المحسوبة على المرجعيات الإسلاموية، الإخوانية والسلفية.
وكانت هذه الجزئية الخاصة بالكتب الإسلامية، مناسبة لكي ينتقد المؤلف مواقف بعض الباحثين الذين يقزمون من تأثير الخطاب الإسلاموي، نذكر منهم أوليفيه روا وفرهاد خوسروخفار، مؤاخذًا عليهما، أنهما غير متمكنين من اللغة العربية، مذكرًا القارئ والمتتبعين، كما نقرأ في أحد الحوارات معه، أنه مباشرة بعد اعتداءات نيويورك وواشنطن، عاينا طلبًا كبيرًا على الكتب الإسلامية من الجميع، لولا أن واقع الحال في المكتبات الإسلامية، يفيد أن العديد منها تابع للأيديولوجيات الإسلاموية.
هذا معطى يُحيلنا إلى أحد أسباب نزول الكتاب التي تتطلب الكثير من التأمل، والإحالة على حالة تذمر أعلن عنها مرارًا برنارد روجييه مردّها تواضع الأعمال البحثية التي تتطرق للحالة الإسلامية في فرنسا، عادًّا أن النخبة السياسية والبحثية في فرنسا، تعاملت بازدراء كبير مع المشاكل المرتبطة بمسلمي فرنسا… وانتقد روجييه الخيط الناظم للعديد من الإصدارات الفرنسية المتواضعة التي اشتغلت على الظاهرة الإسلامية الحركية، إلى درجة وصول الأمر إلى أن بعض هذه الدراسات، اختزلت الظاهرة في البعد النفسي (الإحالة هنا مثلًا على أعمال عالم النفس الفرنسي من أصل تونسي فتحي بن سلامة)، أو تهميش التطرف لدى الأوربيين الذين اعتنقوا الإسلام، وقد ناهزت نسبة هؤلاء في الظاهرة الجهادية الفرنسية نحو 10%، مع أن كل الظروف كانت متوافرة لكي يشتغل الباحثون هناك على الظاهرة من منظور علم الاجتماع خاصة.
إستراتيجيات العمل الإسلاموي
حاصل المشهد الإسلامي الحركي في فرنسا، أنه منذ عقدين تقريبًا، أصبحنا أمام تيارات دينية تريد السطو على المؤسسات الإسلامية والمشهد الإسلامي في فرنسا، مع استهداف الفئات المجتمعية الهشة من جهة، واستغلال النتائج السلبية لفشل سياسات إدماج الجاليات المسلمة من جهة ثانية، ليبقى الهدف موجهًا نحو إعادة تأهيل وإدماج في المجتمع من منظور إسلاموي صرف، إخواني خاصة.
من تطبيقات هذه الإستراتيجية، أننا نعاين عملًا ميدانيًّا فاعلًا لهذه التيارات الدينية، مؤسسًا على علاقة العداء التلقائي تجاه المخالفين، ومن نتائج ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أن كل ما يصدر في حق هذه التيارات الإسلاموية عامة، على هامش التفاعل المجتمعي مع تبعات اعتداء مثلًا، أنه يُواجَه بخطاب التشكيك، من قبيل الحديث عن «الخلط بين التطرف والإسلاميين» أو أنهم «يهاجمون الإسلام» واتهامات أخرى موازية وجاهزة.
وموازاة مع خطاب الإخوان وباقي الإسلاميين، توقف المؤلف عند إشارات أو توجيهات بعض المواقع الإسلاموية الجهادية، تنصح الأتباع المنخرطين في العمل البحثي بالتسجيل في المؤسسات الأكاديمية لنيل شهادات جامعية، من باب اختراق الجامعات، والهدف حسب هذه الدعاية الإسلاموية، هو معرفة العدو ومنافذ السلطة والمؤسسات، في إطار العمل بإستراتيجية التمكين.

منتصر حمادة - باحث مغربي | يناير 1, 2020 | مقالات
يندرج تعامل المفكرين المسلمين المعاصرين مع مفهوم الحرية، ضمن تعامل أشمل مع لائحة من المفاهيم التي أفرزتها «صدمة الحداثة» الأولى، مع غزو نابليون لمصر عام (1798م)، وما قد نصطلح عليه بـ«صدمة الحداثة الثانية»، مع سقوط الخلافة العثمانية عام (1924م)، ونجد ضمن هذه المفاهيم: التحديث، الحداثة، النهضة، الإصلاح، ولو أن مفهوم الحرية، بتعبير المؤرخ والمفكر عبدالله العروي، جاء لصيقًا بثلاثة مفاهيم أساسية: «الاستقلال والديمقراطية والتنمية».
وتتنوع مقاربات هؤلاء المفكرين لمفهوم الحرية، بحسب مرجعيتهم الأيديولوجية من جهة، وطبيعة المنهجية المعتمدة من جهة ثانية، ولو أنه في مجالنا الثقافي، نلاحظ أنه غالبًا ما ينتصر مقتضى الانتماء الأيديولوجي على مقتضى المنهجية العلمية.
تتوقف هذه المقالة عند تعامل بعض الأسماء الفكرية المغربية بالتحديد مع معضلة الحرية، والحديث عن اسمين بالضبط: عبدالله العروي وطه عبدالرحمن، حيث نقارب تناول الأول المفهومَ من منظور المرجعية الليبرالية، وتناول الثاني المفهومَ من منظور المرجعية الصوفية. تبقى الإشارة الضرورية، بخصوص تعامل الأقلام العربية [المغربية نموذجًا] مع مفهوم الحرية، إلى أن السبق الزمنيَّ في هذا السياق، يبقى للراحل محمد عزيز الحبابي، من خلال كتبه المرجعية في هذا الصدد، ونخص بالذكر أعماله: «من الحريات إلى التحرر» (1956م)، و«الشخصانية الإسلامية» (1964م)، ومعلوم أن الحبابي اشتغل في كتابه «من الحريات إلى التحرر»، على أعمال واجتهادات هنري برغسون، ومنها أعماله المرتبطة بمفهوم الحرية، ونخص بالذكر مضامين القسم الثاني من الكتاب، وعنوانه: «البحث في الحريات البرغسونية».
الحرية العربية من منظور ليبرالي
سوف نتوقف بداية عند بعض مضامين اشتغال العروي على هذا المفهوم المؤرق، قبل العروج على بعض مضامين اشتغال طه عبدالرحمن؛ وذلك لاعتبار بَدَهيّ، مفاده أن العروي كان سباقًا للاشتغال على الموضوع، كما جاء في كتابه المرجعي «مفهوم الحرية» (صدر في غضون 1981م)، مقارنة باشتغال طه عبدالرحمن على المفهوم، وجاء في كتابه «سؤال العمل» (الصادر في غضون 2012م)، ولو أننا سنتوقف مَلِيًّا أكثر مع اشتغال طه عبدالرحمن؛ لأنه ينتصر للمرجعية الإسلامية بشكل عام، وبخاصة أن أسهم هذه المرجعية ما زالت قائمة وحاضرة في الساحة، بصرف النظر عن تجلياتها التطبيقية؛ لأننا نتحدث هنا عن الشق النظري، مع تجديد التأكيد أنها مرجعية صوفية أساسًا عند المعني.
انطلاقًا من مرجعية ليبرالية إذن، وعبر توظيف منهجي صارم للمنهج التاريخي قصد رصد تفاعل العقل الجمعي العربي الإسلامي مع مفهوم الحرية، واعتمادًا أيضًا على خبرته التاريخية، يفتتح العروي اشتغاله النقدي على المفهوم بطرح لائحة أسئلة، نذكر منها الأسئلة التالية:
– «هل مفهوم الحرية في اللسان العربي الحديث لا تعدو أن تكون ترجمة اصطلاحية لكلمة أوربية تستعير منها كل معانيها العصرية بدون أدنى ارتباط بجذورها العربية؟
– هل مفهوم الحرية مأخوذ من الثقافة الغربية، حيث لا وجود له في الثقافة العربية الإسلامية التقليدية؟
– هل ممارسة الحرية منعدمة في المجتمع الإسلامي التقليدي، حيث لم نجد مفهومًا في الثقافة ولا الكلمة بمعناها العصري المحدد في القاموس؟
لا يتردد العروي في الاشتباك النظري والمفاهيمي مع مجموعة من الأدبيات الاستشراقية التي اشتغلت على المفهوم، سواء تعلق الأمر بأدبيات منصفة للتراث الإسلامي أو غير منصفة، مُورِدًا مجموعة من الإجابات والمفاتيح النظرية؛ منها الحق في الإجابة عن تلك الأسئلة وفق ثقافتنا اللغوية مستعملين مادة حرر، انطلاقًا من أربعة معانٍ مرجعية:
– الأول: المعنى الخلقي، هو الذي كان معروفًا في الجاهلية وحافظ عليه الأدب، نقرأ في اللسان: الحرة تعني الكريمة، ويقال: ما هذا منك بحر أي بحسن.
– الثاني: معنى قانوني، وهو المستعمل في القرآن، مثلًا ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ (سورة النساء: 92)، أو: ﴿نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ (آل عمران: 35) وفي كُتب الفقه مثلًا: ولا يُقتَلُ حُرٌّ بعبدٍ، ويُقتَلُ به العبدُ. (كما جاء في رسالة القيرواني).
– الثالث: معنى اجتماعي، وهو استعمال بعض متأخري المؤرخين: الحُرّ هو المعفيُّ من الضريبة.
– الرابع: معنى صوفي، نقرأ في تعريفات الجرجاني: «الحرية في اصطلاح أهل الحقيقة الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار وهي على مراتب»، وسنرى لاحقًا أن هذا المعنى أو الخيار، هو الذي اشتغل عليه أكثر طه عبدالرحمن، بمقتضى نهله من مرجعية صوفية.
كما يُقدم عبدالله العروي في كتابه السالف الذكر، مجموعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على ممارستنا للحرية، ملاحظًا في هذا السياق أنه «في كل الأحوال، هناك ترابط بين الحرية والعقل والتكليف والمروءة»، وأن «تجربة المجتمع الإسلامي في مجال حرية الفرد أوسع بكثير مما يشير إليه نظام الدولة الإسلامي»، بدليل اتساع مجال الحرية في «الدولة السلطانية التي كانت تتسم بضعف شمولية جهازها البيروقراطي؛ إذ تمارس الحرية، بوصفها حلمًا يصطدم بالدولة التي كانت تعمل على الحد من الحرية، لكن بعد التحولات التي طرأت على الدولة مع مجيء العثمانيين، أصبحت الحرية شعارًا يرفع في وجه الدولة».
انطلاقًا من المقدمات السالفة الذكر، اشتغل العروي على محددات الحرية في كتابه هذا انطلاقًا من أربعة مستويات:
– انتشار الدعوة إلى الحرية على مستوى العراك السياسي اليومي، وتكتسي تلك الدعوة أشكالًا متنوعة حيث يناسب كل شكل فئة معينة.
– تركيز البحث الفلسفي على مفارقات الحرية عند التطبيق وضرورة إناطة الحرية البشرية بِحُرِّية مطلقة، ويتزعم هذا البحث حاليًّا أعداء الحرية الليبرالية والمتبرمون من مغزى حرية الفرد.

طه عبدالرحمن
– إهمال ازدهار الشخصية بعرقلة انتشار نتائج العلوم النفسانية السلوكية.
– تداخل القيم الضرورية لنشاط المجتمع العربي المعاصر وتطوره: التنمية، الأصالة، مع قيم الحرية.
كما يوجه العروي الدعوة إلى تأمل الخريطة الفكرية للعلوم الاجتماعية في المجتمع العربي في العقود الأخيرة، وخصوصًا في حقول الاقتصاد والسياسة، لعلها تساعدنا على كشف ورصد مستوى التحرر الذي أحرزه الفرد العربي المعاصر، معتبرًا في هذا السياق: «قد يقال لماذا تجمع مؤشر واحد كل العلوم، بما فيها الطبيعية والتطبيقية كالفيزياء والطب، والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية كالنفسانيات والسياسيات. الواقع أن الحكام عندنا يميزون بوضوح بين هذه العلوم، فهم أقل اعتراضًا، فوجب أن نأخذ من علم الاقتصاد وعلم السياسة مؤشرين مستقلين».
الحرية الإسلامية من منظور صوفي
نأتي لاشتغال طه عبدالرحمن على المفهوم ذاته، حيث سبق له أن ارتحل مع المفهوم في كتابه «العمل الديني وتجديد العقل»، من دون أن يفصل كثيرًا في الأمر، بحكم أن العمل كان مُخصّصًا للتعريف بتقويم بعض الاعوجاجات التي طالت العمل الديني مُفرقًا بين نوعين من الحرية: حرية متمثلة في الانعتاق من رِقّ «التسلطية»، وحرية متمثلة في الانعتاق من رِقّ «الشيئية» ورِقّ «العملية»، حيث يُسمي الأولى «الحرية المكانية» والثانية «الحرية الكونية»؛ قبل أن يتطرق بالتفصيل مُجددًا للمفهوم في الفصل الرابع من كتابه الذي يحمل عنوان: «سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعِلم»، وجاء هذا الفصل تحت عنوان: «العمل الديني وأخلاق الحرية».
يشتغل طه على تقييم وتقويم التصورات العامة الحديثة للحرية، حيث ارتأى الاشتغال على أهم التطبيقات المعاصرة للمفهوم، كما هي سائدة في المجال الغربي تحديدًا، وهي التصور الليبرالي والجمهوري والديمقراطي والاشتراكي.
افتتح طه عبدالرحمن مبحثه بالخوض النقدي في مفهوم الحرية كما سَطرته أبرز الأيديولوجيات الوضعية الكبرى، وجاء تعريفه لها في كل تصور من هذه التصورات، فتعريفه لها في الليبرالية هو: ألا يتدخل أحد في فعل ما تريد حيث سكت القانون، وفي الجمهورية (ألا يتسلط عليك أحد ولو جاز له أن يتدخل في فعل ما تريد، حسب رموز تيار «الجمهوريون الجدد»)، وفي الديمقراطية (أن تشارك في تدبير الشأن العام)، وفي الاشتراكية الماركسية اللينينية الإستالينية (أن تحصل القدرة على المشاركة في تدبير الشأن العام)، مبرزًا أن تعريف الحريات السالف الذكر جاء على نوعين: تعريف بالسلب أخذ به التيار الليبرالي (عدم التدخل) والتيار الجمهوري (عدم التسلط)، وتعريف بالإيجاب أخذ به التيار الديمقراطي (وجود المشاركة السياسية) والتيار الاشتراكي (وجود القدرة على المشاركة السياسية).
وبعد التفصيل أكثر في أهم معالم هذه الحريات كما عرضتها هذه المرجعيات، انخرط طه عبدالرحمن في تقويم هذه المفاهيم من منظور تجربة العمل الديني، في نسخته الصوفية؛ لأن طه، للتذكير، قادم من طريقة صوفية مغربية، وهي الطريقة القادرية البودشيشية، وقد أثمرت تجربته في هذا المسار الصوفي، التأسيس لما اصطلح عليه حرية خاصة، بناء على ما وصفه بقوانين العمل الإنساني، من منطلق أن التصورات السالفة الذكر تجاهلت هذه القوانين، فدخل عليها خلل كبير، وجاءت هذه القوانين على النحو الآتي:
أـ قانون التذكر، ومقتضاه أن «من تذكّر الله، تذكره الله، ومن نسِي الله، نسيَه، وأنساه نفسه»، مُبرِزًا أن طلب الحرية بغير طلب الله يؤدي إلى نقيضها ليغدو عدم التدخل تدخلًا، وعدم التسلط طغيانًا، والمشاركة عزوفًا والقدرة على المشاركة صارت عجزًا عن المشاركة.
ب. قانون التأنيس، ومقتضاه أن «الفرد لا يكون له من الإنسانية إلا بقدر ما يتصف به من الأخلاق المستمدة من الفطرة التي خُلِق عليها»، وتتسم هذه الأخيرة بثلاث خواص؛ أولها أن كل الأديان السماوية أتت على ذكرها صراحة أو ضمنًا، وثانيها أن الحق فُطِرَ الناس عليه، وثالثها أنها قيم كلية تشمل الإنسانية كافة.
ج. قانون التناهي، ومقتضاه أن قدرة الإنسان (وليس الإرادة) تكون دائمًا في حالة تعلق بالقدرة الإلهية.
أما التعريف البديل الذي وضعه طه للحرية، فيُصبح كالتالي: «الحرية هي أن تتعبّد للخالق باختيارك، وألَّا يستعبدك الخَلق في ظاهرك أو باطنك» مضيفًا أن التعبد لله يقوم على نوعين: التعبد الاضطراري، ومفاده أن كل المخلوقات تعبد الله بموجب قوانين وأسباب تخضع بها لسلطان الله القاهر سواءٌ وَعَتْ ذلك أم لم تَعِ، وسواء أسلّمت بذلك أم لم تسلِّم؛ وهناك تعبّد اختياري (ولا يقصد به التعبد بواسطة النوافل)، وإنما هناك من الخلق من كرمه الله بأن خَيَّره في طاعته، ابتلاءً له، فإن شاء امتثل وإن شاء امتنع، فضلًا عن كونه يتعبد له اضطرارًا.
كما يُفرّق طه عبدالرحمن، بين الاستعباد الباطن والاستعباد الظاهر، عكس التصورات السياسية للحرية التي لم تتطرق سوى للاستعباد الظاهر، ويقف هنا على حقيقتين هما:
أ. أن الاستعباد الباطن هو مبدأ الاستعباد الظاهر، فيتعين مواجهته، بمعنى أنه لكي نتحرر ظاهريًّا، ينبغي أولًا أن نتحرر باطنيًّا، ويلزم من هذا المعطى حقيقتان أساسيتان: أولاهما أن الإنسان بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يتعبد للحق، فيطمع في التغلب على الاستعباد في نفسه أو في غيره، وإما أن يستعبده الخلق؛ فلا يخرج من استعباد إلا لكي يدخل في آخر، إن لم يكن أسوأ منه، ولما خلت الحريات السالفة من ركن التعبد وجبَ أن تكون حريات ناقصة لأن الاستعباد يلازمها، خفيًّا أو علنيًّا.

عبدالله العروي
ب. أما الحقيقة الثانية، فمفادها أن الذي يستعبد غيره، ينقلب فعله، فيصبح بدوره مُستعبدًا، بموجب قانون تداعي الاستعباد، ومقتضاه، أن معاملة السيد لعبده قد تنتشر في مجتمعه، أو على الأقل في محيطه، فتنعكس عليه هو نفسه هذه المعاملة، فيجد نفسه، هو الآخر، عبدًا لمن له إليه حاجة، حتى لو كان دونه منزلة، فضلًا عمن يعلوه رتبة؛ وعلى قدر إذلاله لعبده، يكون إذلال سيده له؛ فيكون الناس في هذا المحيط أسيادًا عبيدًا أو عبيدًا أسيادًا، رؤساء كانوا أو مرؤوسين.
تقويم «المعقولية الصوفية» للحريات الغربية
في معرض وقوف طه عبدالرحمن على خصوصيات العمل الديني الصوفي، يُدقّق في كون هذا الأخير له من المعقولية ما ليس لغيره من الأعمال، باعتبار أن «المعقولية التزكوية» [أو الصوفية] تُعدُّ، من وجهة نظره، أسمى معقولية بالنظر إلى استهدافها تحقيق حرية الإنسان على الوجه الأكمل وبأزكى الوسائل عبر التعلق بالإرادة الإلهية، التي ستكون وسيلة التحرير الأكمل للإنسان، مُحددًا خصائص العمل التزكوي في النقاط التالية:
– العمل التزكوي عمل نموذجي لا يُضاهَى في استيفاء شرائط العمل، حتى إنه يستحق أن يُشكِّل نموذجًا لأي عمل آخر، لأن المتزكي يأتي به، أصلًا، بِنِيَّة القُرْبَة إلى الله، متحرِّيًا فيه من مقتضيات الشرع كلَّ ما يُحقق له هذا التقرب، وحينئذ، لا عجب أن تكون فاعلية العمل التزكوي أعظم من فاعلية غيره.
– العمل التزكوي عمل تحويلي؛ لأنه يدور في عمق الإنسان، فعقل التزكوي ليس كعقل غيره؛ إذ يتجاوز فهم الأشياء بأسبابها الموضوعية، إلى أن يفهم عن خالق هذه الأشياء ماهيتها وأسرارها.
– العمل التزكوي عمل تكاملي، لأنه لا يقيم حدودًا بين دوائر مختلفة؛ لأن الحياة عنده عالم واحد، كما أن سر الوجود يشملها جميعًا، كما أنه يعامل الأشياء الزمنية والتاريخية على أنها موصولة على الدوام بأفقِ القدسي وأفقِ الخلد، كأنما التزكوي يرتحل بقلبه إليها لكي يعود إلى هذا العالم.
– العمل التزكوي عمل استمراري، لأنه ليس محصورًا في زمن معين، فليست له نهاية يقف عندها، إلى أن يحل أجل التزكوي؛ ولذلك وصف الواصفون عمله بـ«السير إلى الله»، فهو السائر الذي، وإن عَرَفَ إلى أين يسير، فإنه لا يعرِف أين مستقرّه، ولا متى يَستقرّ فيه.
– العمل التزكوي عمل تصاعدي، بحيث يبقى في تبدّل متزايد، مع وجود ما لا يقل عن ثلاث مزايا لهذا النوع من التبدّل: أولها أنه ليس في الأعمال كالعمل التزكوي احتياجًا إلى الخبرة التربوية والنفسية؛ وثانيها أن العمل التزكوي هو أصلًا عمل مجاهدة؛ وثالثها أن المتزكي كلما ارتقى في مراتب التعبد، أصبح التجدد قانون تعبُّده.
– العمل التزكوي ليس من جنس الأعمال الأخرى، وإنما يخترق كل هذه الأعمال من داخلها، بوصفه عامل إحياء روحي لها.
بعد أن فرغ طه عبدالرحمن من التدقيق في التعريف الذي يُروِّجه لمفهوم الحرية، والمؤسَّس على أرضية مشروعه الإصلاحي القائم على تبني الخيار الصوفي، يُعرج على ذكر وتبيان أدوار هذا الخيار في التصدي للآثار الاستعبادية لتطبيق الحريات الحديثة، فيخلصُ إلى النتائج التالية، وهي أن الحرية الليبرالية أفرزت ما يصطلح عليه بالعبودية لشهوة السوق؛ والحرية الجمهورية أفرزت العبودية لِمنَّة القانون؛ والحرية الديمقراطية أفرزت العبودية لهوى الرأي العام؛ وأخيرًا، أفرزت الحرية الاشتراكية العبودية لتربّب السلطة.
وحاصل القول في هذه المقالة، أنه إذا كان عبدالله العروي، قد تعامل مع مفهوم الحرية، من خلال الترحال فقط مع المرجعية الليبرالية للمفهوم، كما جاء ذلك مفصلًا في كتابه المرجعي «مفهوم الحرية»، معتبرًا أنه «كلما تكلمنا عن الحرية، اضطررنا إلى اتخاذ موقف من المنظومة الفكرية التي تحمل في عنوانها حرية، أي الليبرالية»، فإن تقييم طه عبدالرحمن لتطبيقات المفهوم أفضى إلى نقد أهم التصورات العامة الحديثة للحرية، كما هي سائدة في المجال الثقافي الغربي: التصور الليبرالي، الجمهوري، الديمقراطي، الاشتراكي، مختلفًا بذلك مع اجتهاد العروي في منهجية التعامل مع المفهوم، حيث ارتأى صاحب «مفهوم الحرية» البحث في «مفاهيم تستعملها جماعة قومية معاصرة هي الجماعة العربية. إننا نحلل تلك المفاهيم ونناقشها لا لنتوصل إلى صفاء الذهن ودقة التعبير وحسب، بل لأننا نعتقد أن نجاعة العمل العربي مشروطة بتلك الدقة وذلك الصفاء… هذه هي الطريق التي سنسلكها ونحن نعالج مسألة الحرية في المجتمع العربي المعاصر».




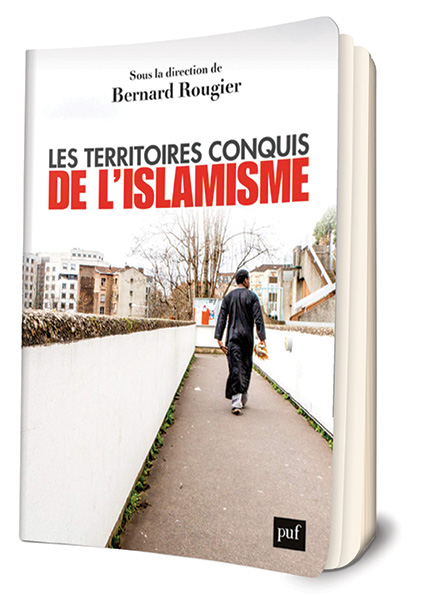 في معرض البحث عن أسباب غزو التديّن الإسلامي الحركي لدى الجاليات المسلمة في الضواحي الفرنسية، يُسلط الكتاب الضوء على أسباب عدة، ويصمت عن أخرى. فمن الأسباب التي يصمت عن الخوض فيها، مسؤولية السياسات العمومية للحكومات الفرنسية خلال العقود الأخيرة، وبخاصة السياسات العمومية التي تهمّ الضواحي، ومن الأسباب الخاصة بالتديّن الإسلامي، توقف الكتاب عند مسؤولية العديد من الدعاة والوعاظ الإسلاميين، الذين أرسلتهم الدول المغاربية، وليس مصادفة أن هذه الجزئية، ستكون أرضية التوجه الذي من المفترض أن تتبناه الدولة الفرنسية خلال السنوات القادمة، وعنوانه إيقاف نظام إعارة الأئمة من المنطقة العربية، أي الخيار الذي كانت تتبعه باريس طوال السنوات الماضية، وذلك في إطار خطة لمواجهة «الإسلاموية» وتعزيز قيم العلمانية بالجمهورية، حيث من المفترض، كما أشارت إلى ذلك أسبوعية «لوبوان» الفرنسية، حسب مضامين وثيقة «إستراتيجية لمحاربة الإسلاموية وضد الهجمات على مبادئ الجمهورية»، إنهاء «نظام الأئمة المعارين» من المغرب وتركيا والجزائر، مقابل تدريب الأئمة الفرنسيين من خلال تطوير «دورات في علم الإسلام» في الجامعات، ومشاريع المدارس الدينية، وخصوصًا في المؤسسات العسكرية والمستشفيات.
في معرض البحث عن أسباب غزو التديّن الإسلامي الحركي لدى الجاليات المسلمة في الضواحي الفرنسية، يُسلط الكتاب الضوء على أسباب عدة، ويصمت عن أخرى. فمن الأسباب التي يصمت عن الخوض فيها، مسؤولية السياسات العمومية للحكومات الفرنسية خلال العقود الأخيرة، وبخاصة السياسات العمومية التي تهمّ الضواحي، ومن الأسباب الخاصة بالتديّن الإسلامي، توقف الكتاب عند مسؤولية العديد من الدعاة والوعاظ الإسلاميين، الذين أرسلتهم الدول المغاربية، وليس مصادفة أن هذه الجزئية، ستكون أرضية التوجه الذي من المفترض أن تتبناه الدولة الفرنسية خلال السنوات القادمة، وعنوانه إيقاف نظام إعارة الأئمة من المنطقة العربية، أي الخيار الذي كانت تتبعه باريس طوال السنوات الماضية، وذلك في إطار خطة لمواجهة «الإسلاموية» وتعزيز قيم العلمانية بالجمهورية، حيث من المفترض، كما أشارت إلى ذلك أسبوعية «لوبوان» الفرنسية، حسب مضامين وثيقة «إستراتيجية لمحاربة الإسلاموية وضد الهجمات على مبادئ الجمهورية»، إنهاء «نظام الأئمة المعارين» من المغرب وتركيا والجزائر، مقابل تدريب الأئمة الفرنسيين من خلال تطوير «دورات في علم الإسلام» في الجامعات، ومشاريع المدارس الدينية، وخصوصًا في المؤسسات العسكرية والمستشفيات.


