
نادية هناوي - ناقدة عراقية | مارس 1, 2021 | دراسات
من تلك الثيمات المستبعدة والمهملة التي نأى الأدب الرسمي عن توظيفها والتعبير عنها ثيمة الجنون؛ لما فيها من عقبات ومصدات على الكاتب أن يتحمل أعباءها كي يتجاوزها، مادًّا جسورًا جديدة تساعده في اقتناص ما فيها من غنى فكري. وليس في طرق ثيمة الجنون عقبة مثل عقبة الغنى الفكري الذي يهدي الكاتب إلى أشكال مبتكرة وأصيلة، ثم عقبة الشكل الذي به يستطيع التعبير بحرية وامتلاء.
وهو ما نجد مثاله متجسدًا في قصص الكاتبة لطفية الدليمي التي اختطت لنفسها مسارًا سرديًّا خاصًّا وهي تتعامل مع ثيمة الجنون بطريقة غير اعتيادية، وفق قوالب مبتكرة منذ بواكير كتاباتها القصصية. وهو ما يدلل على موهبة أصيلة ووعي عال بأسرار الكتابة السردية مع القصدية الإبداعية في تسخير الشكل لصالح المضمون وبتوازنية لا ينفصل فيها أحدهما عن الآخر.
بيد أن مراهنة القاصة لطفية الدليمي على الثيمات، ومنها ثيمة الجنون، جعلتها تهتدي إلى توظيف أشكال وتقانات في الكتابة القصصية غير مألوفة، ومنها تقانة المتوالية السردية التي اتخذتها وسيلة فاعلة في أشكلة الجنون وتمثيل تشظياته. وبناء المتوالية السردية على شكل حبكة شجرية ذات وحدات فرعية مسببة أو سببية، هو ما يناسب المنظور الأركيولوجي في التعامل السردي مع ثيمة الجنون. وقد تفردت لطفية الدليمي في استعمال المتوالية السردية في مجموعتها القصصية «موسيقا صوفية»، حفرًا في المتضادات ورصفًا للمتناقضات ثم الجمع بينها. فيغدو العالم هو الجنون بعينه وتصبح المعقولات غير منفصلة بحدود عن اللامعقولات فيندمج المعتاد بالعجيب والمألوف بالغريب والمتوقع بالمفاجئ.
ولا غرو أن وراء هذه الرؤية الفلسفية أبعادًا جمالية، رسمتها الكاتبة بعناية مبتغيةً فكّ لغزِ المكانِ وفهمَ شفرةِ الزمانِ اللذين بهما تنفرج أزمةُ الذات الحائرة في وجودها ووجود من/ ما حولها. ولكي نفكك أشكلة الجنون لا بد من الارتكاز على مهيمنات ثقافية، منها ننطلق في الإلمام بتشظيات هذه الثيمة. ومن تلك المهيمنات: الموسيقا والمرآة والماء والأسطورة والمرأة.
الجنون والموسيقا
تستجيب الموسيقا للمتغير الثقافي معبرة عن الصراع وعدم الرضا وعدم الاستقرار، وقد تُستعار من ثقافة إلى ثقافة لكنها تظل محافظة على شكلها. وتُراوِح وظائف الموسيقا واستخداماتها بين أن تكون عبارة عن شعائر وقد تبدو وسيلة للترويح والامتاع، معبرة عن تطلعات الفرد والجماعة في الحياة أو مخاوفهما منها قلقًا واحتجاجًا وصراعًا. وقد وظفت لطفية الدليمي الموسيقا في قصص «رابسوديات العصر السعيد» واضعةً يدها على ثيمة الجنون من خلال اعتماد شكل إيقاعي يتتابع، عاكسًا أشكلة الجنون كفوضى حواس وتشتت لغة، ما بين إنتاج أفعال الإنجاز وإنتاج أفعال التقرير، باتجاه أسطرة الأسطورة واستعارة الاستعارة. وبالتوالي الموسيقيّ يتجسد الوهم الذي يصفه بورديو بأنه «استثمار ومبدأ للإدراك، لكنه هو كذلك ما يعطي معنًى واتجاهًا للوجود. إنه اهتمام بالأشياء التي يتحكم وجودها وثباتها بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في وجودي وثباتي الاجتماعيّ وكذا هويتي وموقعي الاجتماعي»(١).
ويوصف التوالي بأنه فلسفة تغدو فيه الكتابة عبارة عن ممارسة فكرية تجعل المضمون المعبر عنه عدميًّا، سواء إذا ما استجوبناه بالنسبة للفكر أو إذا ما استجوبناه بالنسبة لمصير الكينونة التي تنشره(٢). ويبنى الجنون في قصص «رابسوديات العصر السعيد» على أساس وهمي في شكل موسيقيّ متوالٍ ينماز بعدم استقرار الحركة وعدم ثبوتية السكون. ومثلما أن الرابسودي كنمط شعري لا قالب له كذلك تكون القصص في حركتها وسكونها متأرجحة لا مستقر لها. ولا تخضع الرابسوديات إلى ترتيب معين في أرقامها فمن 2 إلى 13 إلى 19.
وفي القصة الأولى «الرابسودي رقم 2» يكون الجنون موسيقيًّا فيه أزمة الذات المؤنثة أزمة نفسية فهي تبدأ بالأرجحة والتماوج، والساردة تتساءل متحيرة: «متى متى يتوقف كل شيء؟»(٣) وشعورها باللاتوازن والارتعاش وعدم الاستقرار وفقدان الثبات يجعلها توالي توظيف الأفعال الحركية (أسير/ أعدو/ أبلغه) مندمجة بالأفعال الذهنية (أفكر/ أعرف) في إشارة إلى إضاعتها البوصلة في الخروج من المحنة التي هي فيها. ولأن اسمها أميمة تغدو ابنة أيوب الصابرة التي عليها أن تتحمل همها مضاعفًا ككينونة محاصرة ووحيدة «أنا وحدي أتعرض لبشاعة الرعب وحدي دونما أصدقاء يمنعونني من الانتحاب، دونما أحد يحول بيني وبين الأسى المميت».
ويتأرجح الكون، وتتداعى الأفكار، والأسئلة تتلاحق كما يطغى الفكر على السرد. فالحياة ليست السعادة والحرية بل هي الضنى والسجن. وما من مخرج سوى جنون الوهم الذي به تبلغ الحقيقة «أُوهِمُ نفسي ثم أتجه نحو الشرفة وأحلم. وأمامي شيء واحد ثابت رصين قضبان الحديد المزخرفة على واجهة الشرفة».
اللوعة والحزن وطلب النجدة هي دلائل وعيها بالجنون، الذي يجعل أميمة تتوهم قدوم شيء أو حدوث أمر ما «يلزم ضرورة باتخاذ موقف وتموقع بالنسبة إلى هويتي وإلى التعارضات التي تكونها في فضاء لا يملك إلا معنى العلائقي»(٤). وباستماعها إلى رابسوديات فرانزليست تترك الحاضر وتعيش في المستقبل، وقد أوهمها وعيها أنها الآن تعيش جوًّا فيه الرجل/ أنيس هو الفرح الذي سيغدر مستقبلًا، ووجوده ليس إلا مقدمة لحزن سيوصل إلى تعاسة أبدية «كنت أبكي لأنني وحيدة وخائفة ومدركة أن ذلك الفرح الذي أرتديه مثل عباءة واسعة ليس لي وما هو إلا أكذوبة زائلة لا تليق بي وأنني منقوعة في الحزن مثل إسفنجة بحرية»، وتغدو أميمة امرأة لا تعرف التعبير عن أساها سوى بالموسيقا والبكاء.
ولأنها كينونة هشة ممزقة فلا جدوى في تأسف أنيس لها وهو يستملي بهشاشة وتضرع أن تصفح عنه «لا أريده أن يأتي الآن فما جدوى أن يعود لجمع شظايا المرأة التي حطمها جنونه الأخير؟ ما نفع شظايا المرايا في الحب المهشم؟».
ويجعلها صوت الموسيقا كيانًا بلا قالب كالرابسودي مستجلبًا جنونها متخذًا صورة ضوئية تحاول عبرها اصطياد إشعاعات لا تقدر عليها، فتميل إلى التمويه والمراوغة وقد لبست قناعًا يحجب حقيقتها «نحن وزماننا نشبه تلك الرابسوديات العجيبة التي صاغها فرانزليست لانتفاضات الروح»، وهي مكشوفة ساعة الفرح أو الحزن وهي في منظور نفسها ليست دمية، وتتذكر أنها حين كانت تهتم بمظهرها كانت غيرة أنيس تزداد، فقررت ألا تغريها المظاهر والأزياء والحقائب، متسائلة: «لماذا يرى رجل نفسه أدنى من أن يستحقني فيحدس تهديد الآخرين له؟ تلك كانت إحدى نغمات رابسودية عصرنا السعيد الحزين».
وجنونها مزاج متبدل فهو الجراح والمراح وهو الصخب والهدوء، يجتمع الحلم والشعور الرومانسي بالتذكر والاستشراف التراجيدي، فتعاودها مجددًا مشاعر الارتجاج والتأرجح، وترى أشباحًا تنظر لها فتركن إلى حقيقة أنها امرأة تعيسة.
والقصة التي تلي هذه القصة هي توال للقصة التي قبلها، مستكملة تواتر وعي أميمة بجنون العالم من حولها فتعود إلى سماع موسيقا الرابسودي، ويتداعى وعيها حول موضوعة المعرفة التي بها ستفهم لِمَ العالم من حولها مصطخب ومجنون؛ «بدأت أجمع قطرات المعرفة عمرًا بأكلمه لا يمنحنا سوى قطرات ثمينة من المعرفة».
وفك شفرة المعرفة يتطلب الصدق فتقرر ترك التفكير في المعرفة، مديرة ظهرها للصدق ومن ثم لا ينبغي لها أن تسمع الموسيقا التي بها يتوهج وعيها ويأخذها صوب العالم الذي تزدريه؛ «كلما أمعنت في الصدق وتألقت مميزات إنسانيتي أمعنوا في التوحش والقسوة، فلتهمد الموسيقا إذن، وليتوقف كل شيء، أغمض عيني من جديد على شناعة الألم من دون أن أحلم بشيء»، وبالأحلام تنتهي القصة وقد تؤكد لأميمة عدم جدوى كل شيء.
وتستكمل القصة الثالثة وعنوانها: «الرابسودي رقم 13» دوامة اللاعقل، فبعد أن انتهت القصة السابقة بانهزام وفتور تبدأ هذه القصة بانتهار الذات ومؤاخذتها انتفاضًا على كل الأشياء التي بدت متأرجحة بالنسبة إليها، لكن أوار ذلك الانتهار والانتفاض سرعان ما سيذوي فتنتكس أميمة مجددًا، وقد أدركت أن لا جدوى من الموسيقا التي غلبها الصمت، واجدة نفسها حبيسة ذاتها وعلى التوالي ذاته، الذي شهدناه في القصتين السابقتين. تنتهي القصة وأميمة كينونة ذاوية هيمَنَ عليها التأسلب فانهارت قواها، «سئمت إغماض عيني على الحلم المهدد، كرهت استسلامي للجانحة، لا أريد هذه الغشاوة التي تحجب صورة الإنسان وصورة أنيس أيضًا».
وتأتي القصة الرابعة وعنوانها: «الرابسودي رقم 19» وأميمة تستمع لرابسودي جديد لكن بلا تتابع المقطوعات، كدلالة على حالة اللاستقرار العقلي الذي تمرّ به رُوحها. وهنا تفطن إلى أنها ابنة أيوب الصابرة فتتداعى في ذهنها ذكرى الثوب الذي اشتراه لها أنيس، وتداهمها الموسيقا فتتعرى الذاكرة، وتتبدى المشاعر، ويتحول الحس إلى تجريد فتنتفض على جسدها؛ لأن لا بقاء إلا للروح التي تجد في الرابسودي قلقها ولا توازنها، فتضطرب مع صخب الموسيقا، وينتابها انتحاب وعويل وخفوت وإيقاع وهمود واشتعال.
الجنون والماء
كثير من الحكايات القديمة إنما تتأتى قدسيتها وخلودها من تراكمها الجينالوجي الذي ينعكس في اللاوعي، في التصرفات السلوكية المختلفة. وتوظيف هذه الحكايات في بناء القصة القصيرة عند لطفية الدليمي هو بمنزلة إشارات لسانية وسيميائية تحاول تقديم الذرائع أو المبررات التي بها نفهم ثيمة الجنون، وما يكتنفها من ملامح فكرية إزاء الوجود والعدم والحياة والموت والواقع الحاضر.
وهو ما نجده في مجموعة «سليل المياه» التي فيها الماء رمز أسطوريّ لكل ما هو خارق وعجائبي. وتُبنَى المجموعةُ على التقانة نفسها أي تقانة التوالي السردي التي بُنِيتْ عليها المجموعتان السابقتان: «رابسوديات العصر السعيد» و«موسيقا صوفية»، بيد أن هذه المجموعة تتخذ من الماء فاعلًا سرديًّا يشظي العقل ويبعثر ثباته.
ففي القصة الأولى وعنوانها «الطوفان» يحتل النهر بؤرة الأحداث، دافعًا بها باتجاه التأزم من خلال تكرار أوصاف ومسميات مائية مثل: (دمدمة النهر/ حراس الماء/ هدير الأجراف…) ويتجلى جنون هذا التصوير المائي في عجائبية الحكايات التي تستدعيها القاصّة من التراث؛ مثل: حكاية البنات الثلاث اللائي غرقن في النهر وأخريات خطفهن الغجر بعد أذان المغرب، وأيوب ابن الماء وعشقه لزكية وكائنات الغرير، التي تسرق الرضع من المهود والأرض التي سميت أرض الأفاعي.
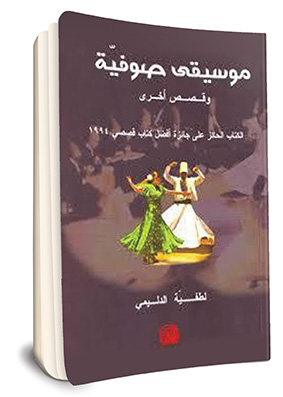 والنهر هو الجنون الذي يجمع الخير بالشر فيأتي بالقوة والمتع في سنوات الرخاء، ولكنه في سِنِي الفيضان يأتي بالكوارث والنذر «جارفًا الأكواخ والزرائب وجذمات الشجر وأعمدة الخشب وجلودًا وفروات كبائش وقرون بقر وملابس غرقى ومهود أطفال غرقى»، وحكاياه هي الأساطير التي تدلل على أن العالم بحيواته وأشيائه أكثر جنونًا منه. وتجتمع في النهر المجنون المتناقضات فهو الجدب والفيضان. ويهيمن جنون الماء على الفعل البشري الذي مثله حسين العبدالله وأيوب النهري ورجال آخرون، «مياهه تعلو تعلو حتى امتزجت بملح شجر الصبير وحرقة حليب التين وحموضة نسغ الرمان ومرارة النارنج، ثم منحته هذه المذاقات مجتمعة قوة فوق قوته، فارتفعت مياهه بدفقات متسارعة إلى أعالي النخل، وتذوقت طلائع الماء حلاوة الجمار في قلب النخيل».
والنهر هو الجنون الذي يجمع الخير بالشر فيأتي بالقوة والمتع في سنوات الرخاء، ولكنه في سِنِي الفيضان يأتي بالكوارث والنذر «جارفًا الأكواخ والزرائب وجذمات الشجر وأعمدة الخشب وجلودًا وفروات كبائش وقرون بقر وملابس غرقى ومهود أطفال غرقى»، وحكاياه هي الأساطير التي تدلل على أن العالم بحيواته وأشيائه أكثر جنونًا منه. وتجتمع في النهر المجنون المتناقضات فهو الجدب والفيضان. ويهيمن جنون الماء على الفعل البشري الذي مثله حسين العبدالله وأيوب النهري ورجال آخرون، «مياهه تعلو تعلو حتى امتزجت بملح شجر الصبير وحرقة حليب التين وحموضة نسغ الرمان ومرارة النارنج، ثم منحته هذه المذاقات مجتمعة قوة فوق قوته، فارتفعت مياهه بدفقات متسارعة إلى أعالي النخل، وتذوقت طلائع الماء حلاوة الجمار في قلب النخيل».
والنهر فاعل سردي أنسنه السارد العليم فاستبطن دواخله كما في هذا التداعي الحر، الذي فيه النهر كائن حيّ يتكلم ويتحدى ممتلكًا قدرات فوق بشرية «سوف يفهمون عندما يرون غريني الأحمر يخصّب أراضيهم البور، ولكن أنَّى لهم أن يفهموا عظمة هذا الطمي الأحمر وهم يواصلون الدعاء والصلوات ليوقي الله طوفاني ويرحمهم من جنوني»، كما تأنسنت البساتين والمراعي التي صارت تنادي النهر أن يغمرها بجنونه، «دعك منهم تعالَ واغمرني بروائح الجبال البعيدة، واتركْ بذور نباتات السفوح وبيوض فراشات البراري ها هنا في أحضاني فقد جفت عروقي وسئمت خمود مياه الجداول وركود الشتاء» كترميز إلى أن عقل الإنسان أوهن من أن يسيطر على لا عقلانية ما حوله. وإذا كانت إرادة الإنسان ضعيفة ومتهاوية؛ فإن إرادة البساتين قوية وقد صارت هي والمطر والنهر فاعلًا سرديًّا. وكأن في الجنون أسطورة إخصاب وولادة، وفي العقل واقعية الموت والاندثار.
وتنتهي القصة وجنون النهر قد انتصر على عقل الإنسان، وتعيد القصة التالية، وعنوانها: «سنوات القحط»، للإنسان بعضًا من قوته وكبريائه، ممثلًا بأيوب الذي تصالح مع النهر وقد اتخذه أبًا وأمًّا وملاذًا، وهو يتنبأ أن «ستكون الأرض سجني والقرية عذابي» وصحيح أن للماء هيمنة بها ستتفكك شفرة الجنون، لكن أيوب هو ابن الماء الذي احتضنه النهر واضعًا أمامه ماضيه وحاضره ومستقبله «أنت ابن الماء فلا تذهب إلى أرض الناس، واحذر ذئاب التراب وأفاعي الظل».
هكذا كان على أيوب أن يعيش بعيدًا من الناس، وفي الآن نفسه كان عليه أن يحذر بنات الجرف «المخلوقات العجيبة اللامرئية التي حكت له أمه عنهن بنات بأجساد بيضاء كالجبن يختفين في مغاور الأجراف… فإذا نُودِيَ عليهن رددن الإجابة.. يقلدن أصوات الناس ويَسحرن الرجال» فقرر أيوب أن يمتثل لنصيحة النهر ويحذر البشر باحثًا عن أمه في قرية الشيخ عبدالدايم.
والمفارقة أنه سيجد جنونًا لا يقلّ عن جنون النهر، فالممارسات تحكمها معتقدات بالية والناس على خلاف مظاهرهم، فالشيخ شيطان أَمْرَدُ في صورة عبدالدايم، والرجال يستعبدون النساء في صورةِ زكيةَ، التي أَلْقَتْ بنفسها في النهر؛ كي لا يستعبدها تاجر بِيعَتْ له. وهو ما يزيد في كُره أيوب لعالم الرجال فيقف إلى صف النساء.
وإذ تنفرج الحبكة والمطر يغمر الأرض، فإن القصة التالية «شفيع الظامئين»، ستُتمِّم قصة أيوب الذي صار كالمجنون يحمل حكايات النهر ويتخفى في ثياب النساء، «يضج الصبيان بالضحك وهم يلاحقونه ويسحبون عباءته ويترنمون أغنيات ساحرة»، ليصير هو نفسه أسطورة «لم تحتجب عنه النساء فقد كن يعاملنه كما تعامل امرأة مسترجلة بينما عيون النساء والرجال ظلال الشهوات فيهرب منهم ومنهن إلى فتاة الطوف ووجه أمه».
ويرمز انتصار الجنون ممثلًا في أيوب على العقل ممثلًا في الشيخ عبدالدايم، إلى أن العقل هو أصل الشر الذي لا تقضي عليه إلا الفطرة والبراءة، ممثلة بالسحر الذي تملكه شخصية نجمة التي ظهرت في نهاية القصة كأمل قادم، ينتصر فيه الضعفاء والمغلوبون، فتَتَوَكَّد نبوءة النهر ويصدق جنونه.
الجنون والمرأة
قد لا نبالغ إذا قلنا: إن غالبية الشخصيات الأدبية هي ذكورية، وما ذلك إلا لأنها أكدت نفسها بالجنون، فتحررت من أسوار العقل وقواعده الأخلاقية الرتيبة، كما في شخصيات أوديب ودونكيشوت وفاوست وهاملت… بينما تكبَّلت الشخصيات الأدبية الثانوية التي هي في الغالب نسوية بالعقل مؤكدة ذاتها به. ولو أتيح لها أن تؤكد ذاتها بالجنون لغَدَتْ ظاهرة بأدوار مركزية عظيمة، كما هو الحال في شخصيات مثل: عشتار وفينوس وشهرزاد وزنوبيا وكليوباترا ودزدمونة وجوليت وغيرها.
وسبب الإحجام عن توكيد المرأة لذاتها بالجنون هو أن الجنون خطير، وأنه يرسم مسالك الشك، وهنا يكمن خطره في الممارسة العقلية حتى إنه ليس بالإمكان إقصاؤه أو تهميشه. وكان دريدا قد أكَّد أن العقل أكثر جنونًا من الجنون، والجنون أكثر عقلانية من العقل؛ لأنه أقرب إلى المنبع الحي والصامت والهامشي الذي ينبثق منه المعنى، فيغدو القول: «أنا لا أتفلسف إلا داخل الرهبة أي الرهبة المعلنة بأنني مجنون»(٥). وبالطبع يحتاج إثبات هذه المسألة أدلة منطقية تجعلنا نتيقن من أن الإنسان كائن مجنون يتسم بالانفلات. ولنا أن نتصور عند ذاك فاعلية هذا الانفلات بالنسبة لكائن هو امرأة امتلكت حريتها فاستعادت سيادتها على حين غفلة.
وهو ما يتجسد في مجموعة «أخوات القمر» التي تضم خمسة نصوص هي: (أخوات الشمس يدخلن منازل القمر/ ادخل المحاق/ مقاطع من قصة أخوات القمر/ اقتفاء الأثر) وهي تحفل ببنية رمزية ذات شفرات، قسَّمها عالم الاجتماع بازيل برنتاين إلى شفرات مقيدة وشفرات محكمة… وهي شفرات اجتماعية في جذورها أكثر منها لسانية، وبمجرد تعلمها يكون لها عواقب مختلفة على المتكلمين. وإذا كان مستخدم الشفرة المحكمة أكثر حرية وأقل تقيدًا وقدرة على التعميم وعلى الترميز؛ فإن مستخدم الشفرة المقيدة محدد في المعاني التي تتضمن الحالة الراهنة وهو يتلفظ ذلك إشاريًّا مستخدمًا كثيرًا من الضمائر والأشكال(٦)، وعلى وفق مفهوم الإرجاء في القبض على المعنى واستدعاء الفكر تبدو الغرابة في شفرات هذه النصوص أنها شفرات مقيدة بالجنون الأنثوي الذي يهدم الأسس الذهنية لليقين معيدًا بناءها من جديد، وبما يجعل القصص موصوفة بأنها قصص نسوية.
ومن جنونها تتشكل واقعية التخييل كاشتغال تقاني، يموضع الشخصية المؤنثة في علاقات ذات وظائف وبتعاقب زماني ورابطة سببية محتملة أو ضرورية.
وتحفل أول القصص وعنوانها: «أخوات الشمس يدخلن منازل القمر» بشفرات مقيدة تعبيرية وأخرى محكمة استعارية، هي الأكثر بوصف «الاستعارة حاضرة في كل مجالات حياتنا اليومية. وأن التصورات التي تتحكم في تفكيرنا ليست ذات طبيعة ثقافية صرف، فهي تتحكم أيضًا في سلوكياتنا اليومية البسيطة قبل تفاصيلها»(٧).
والمهيمن في القصة هو الجنون الذي يجعل الساردة دكتورة هدى تتحرى العالم من حولها، فتجده أنثويًّا مجنونًا، ممثلًا في «سلمى وحياة» خاصة، وفي النساء عامة. ويصدم هذا العالم النسوي المجنون هدى، فتهرب إلى الحلم، حيث الشمس والقمر كائنان فيهما يكمن سر الأنثوية ومأساتها الأزلية…
ختامًا
تعكس قصص لطفية الدليمي عالمًا غريبًا وساحرًا، فيه الإنسان عقل مجنون، والعالم جنون معقول؛ ولا سبيل لفهم أحدهما إلا بفهم الآخر. وهذه الثنائية التضادية هي سر المداومة التي هي دائمة بينهما لا تنتهي. ولأن لا إنسان من دون عالم مجنون يجعله لا عقليًّا في عقلانيته ومتعقلنًا في جنونه، يغدو كائنًا متضادًّا من خير وشر وعقل وجنون، غير أن تبعات هذا التضاد على المرأة أقوى أثرًا وفاعليةً منه على الرجل. والسبب سطوته التي تجعله يتحكم أكثر من المرأة في إخضاع نفسه رُوحًا أو جسدًا أو كليهما معًا لتأثيرات ذلك التضاد، ناهيك عن تحكمه في المرأة أصلًا. وهذا بالضبط ما تمثلته لطفية الدليمي في قصصها، متعاملة مع ثيمة الجنون تعاملًا تفكيكيًّا أركيولوجيًّا، به تشظت الشخصيات، فخسرت جانبًا مهمًّا من إنسانيتها، في سبيل أن تظل محافظة على الجانب الآخر فيها سليمًا.
هوامش:
(١) معجم بورديو، ستيفان شوفالييه وكرستيان شوفيري، ترجمة الزهرة إبراهيم، النايا للنشر والتوزيع، دمشق، 2013م، ص290.
(٢) بيان من أجل الفلسفة، آلان باديو، ترجمة مطاع صفدي ، بيروت، د.ط، د. ت، ص7، وص11.
(٣) ينظر: موسيقا صوفية وقصص أخرى، وقد نشرت في مجلة الأقلام العدد 11 و12، 1988م، ص114، 126، كما نشرت قصص (رابسوديات العصر السعيد) في مجلة الأقلام، العدد الخامس، مايو 1988م، ص35، 41. لن نحدد صفحات النصوص المقتبسة؛ لأن جميعها وردَ موسيقا صوفيةً مجموعةً في مجلة الأقلام العراقية… ونشرت قصص موسيقا صوفية وقصص أخرى في مجلة الأقلام العدد الخامس، مايو 1988م، ص35، 41.
(٤) معجم بورديو، ص291.
(٥) إستراتيجية تفكيك الميتافيزيقيا، ص68.
(٦) ينظر: اللسانيات والرواية، روجر فاولر، ترجمة أحمد صبرة، مؤسسة حورس الدولية للنشر، الإسكندرية، 2009م، ص174.
(٧) الاستعارات التي نحيا بها، جورج لايكوف ومارك جونسن، ترجمة عبدالمجيد جحفة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط2 ،2009م، ص21.

نادية هناوي - ناقدة عراقية | مارس 1, 2020 | دراسات
التّعبيرية في السّرد: أثَّرتْ الفلسفات الوضعية وما انبثق عنها من صراعات ديالكتيكية في ظهور حركاتٍ فنية ومذاهبَ أدبية حفل بها النصف الأول من القرن العشرين. ومن تلك المذاهب التعبيرية impressionism التي نشأت في ألمانيا في العقد الأول من القرن العشرين ثم انتقلت إلى بلدان أوربية أخرى كنزعة تحاول مواجهة واقع مصطنع ومتكلف، تتحكم فيه القوى التي لا تأبه بالإنسان وهي تُلقي به في أتون الحروب وقودًا غير مأسوف عليه، مزعزعة أمنه ووجوده في ظل قوانين جامدة تحكمها المادة والآلة غير الرحيمتين.
والإنسان هو بغية التعبيرية التي تسعى إلى تخليصه من عالم فاسد، والانتقال به إلى يوتوبيا خالصة، منتشلة إياه من براثن القوى المعادية لإنسانيته، عائدة به إلى مرحلة الصفاء الداخلي حيث الغرائز الأصيلة التي لم تلوثها المدنية بعد، والمشاعر النقية التي ليس فيها مكان للميول الوحشية. ولأن التعبيرية راهنت على الإنسان، «نجحت في التعبير عن القضايا الفرويدية»، فربطت الوعي باللاوعي والأحلام بالحقيقة والطبيعي بما فوق الطبيعي.
وبسبب هذه المرامي الإنسانية انتهج التعبيرية بعض كتّاب المسرح الأوربيين والشعراء والقصاصين والرسامين والموسيقيين وفرق الرقص. وممن مثّل التعبيرية في الشعر تراكل وهايم وبن وشتادلر، وفي القصة والرواية كافكا ودوبلن وموزبل وفرانز فيرفل.
وقد تتلاقى التعبيرية مع مذاهب أخرى تؤمن أن الفن للفن والأدب للأدب، ومن تلك المذاهب الرومانسية التي منها تستمد التعبيرية أصولها، لكنها تفترق عنها في كونها ليست انهزامية تحبذ الهروب على مواجهة الواقع؛ في حين أن التعبيرية تجابه الواقع وشروره بالتعبير. وإذا كانت الرومانسية تؤنسن ما هو جامد من أجل منحه خيالًا شاعريًّا، فإن التعبيرية تتعامل مع العضوي كشيء من الأشياء، جاعلة العالم ماديًّا، هو عبارة عن سطوح وجسوم وحجوم وصور متحركة وخطوط وأشكال وأضواء وظلال وسلاسل كتل تتوالى في المكان، والهدف إعادة صنع الواقع وقد تأنسنت فيه الأشياء الحية وغير الحية بشكل واقعي.
ولا شك في أنّ المذهب الواقعي يتخذ من الطبيعة منطلقًا لتصحيح الواقع، بيد أن التعبيرية لا تعتمد في تحقيق ذلك على التصريح، وتفضل عليه الإيحاء بالكلمة واللون والصوت والصورة والحركة وبما يضمن تخليص الإنسان من شرور الواقع وكوارث مادياته.
وقد يشابه هذا المذهب المدرسة الإنسانية الجديدة التي عرفها الأدب الأميركي في الحقبة نفسها التي ظهرت فيها التعبيرية، ومثَّلها إليوت وبابيت ومينكن وإرفنج، الذين تصدوا للمدرسة التصويرية عند راسوم وألن تيت وبلاكمور وسبيجارن، كون هؤلاء عنوا بتصوير وجهة النظر الجمالية في الصور والأشكال، غير أن التعبيرية اختلفت عن هاتين المدرستين في مسألة تركيزها على المنظور البصري في منتجة البناء النصي.
وللتعبيرية كمدرسة أدبية ميزات فنية منها:
1) التأطر بالذاتية المفرطة بحيث تتحول أية رؤية موضوعية إلى رؤية بالغة الذاتية، ولا ضير في أن تتقوقع الذات حول نفسها لأنها سترى صدقها في التعبير عن الإنسانية في صورتها الجديدة التي فيها الفرد هو الأساس ومنه يبدأ إصلاح المجتمع.
2) توظيف المفارقة التي بها يختلط الواقع بالحلم والتبسيط بالمبالغة والذاتية المفرطة بالوعي الاجتماعي، والغاية من وراء المفارقة الانتصار للطبقات المطحونة التي نماذجها شحاذون وكسبة ومعدمون وذوو فاقة.
3) اعتماد الإيجاز والتكثيف والانزياح كانتهاج لا يخلو من الشاعرية والتدفق العاطفي، وبمختلف وسائل التعبير القولية والإشارية من حركة وصوت وتخطيط وفكاهة مع التركيز على توظيف الحوار كمولونوجات وديالوجات.
4) استعمال تكنيك المشهد في السرد تعبيرًا عن المواقف الإنسانية في شكل لوحات متتابعة، تساير التجربة الذاتية وتتوالى من دون اهتمام لتفتيت الحدث السردي، إذ لا حاجة إلى وجود الحبكة التي ستعوض عنها المشاهد وهي تجتمع معبرة عن «سيادة الروح على المادة وبأنّ الفرد ليس نتاجًا وعبدًا لظروف وقوى اجتماعية ومادية وتاريخية».
وعلاقة التعبيرية بالدراما ليست قوية، لأن الدراما تصور صراع الإنسان الذي تسيطر عليه قوة أكبر منه، تدفعه للعذاب والفشل والسقوط، في حين تريد التعبيرية أن تقدم الإنسان المتحرر من كل قوة وكل سلطان.
5) التأثر بأسلوب الفيلم السينمائي، ولا سيما طريقة المونتاج في تركيب اللوحات تقدمًا للأمام أو رجوعًا إلى الوراء أو ثباتًا عند نقطة ما، والنظر إليها من زوايا مختلفة.
6) تعاطف البطل التعبيري مع المجتمع الذي يرسمه في صورة جديدة، تختفي فيها مظاهر الظلم والاضطهاد، وقد صحا الإنسان من الغيبوية التي سببتها الحروب والأزمات.
7) المراهنة على النوم والحلم تحقيقًا لصحوة فيها بشرى المستقبل الذي فيه يبزغ فجر البشرية وقد تخلصت من كل ما يؤلمها ويشوه جمالها، حتى لو كان هذا الخلاص متخيلًا في شكل حلم يوتوبي، يستعيد فيه الفرد إنسانيته المهانة، وقد غدتْ الطبيعة بالنسبة له هي المحضن الذي فيه النقاء والفطرة والسلام.
وبالرغم من هذه المزايا الموضوعية والجمالية، لم تدم التعبيرية طويلًا، ربما لأن أدواتها ولاسيما التجريد والتكثيف التي اعتمدتهما في سبيل تحقيق مطالبها الموضوعية لم تكن واقعية، فظل الحلم التعبيري مجرد تطلع يوتوبي كما غدت فكرة ولادة الإنسان من جديد مجرد فكرة عارية وعابرة.
وإذا كان عمر التعبيرية قصيرًا من 1910 ـ 1925م تقريبًا؛ فإنها لم تأفل تمامًا بسبب ما تركته من أثر إيجابي في سائر التوجهات الأدبية الأخرى، ولاسيما في مطلبها الإنساني المتمثل في صنع مجتمع فاضل هو بمثابة فردوس أرضي.
من التأثيرات التي تركتها التعبيرية على السرد أنها غيرت وظيفة السارد الذي هو في السرد الدرامي وغير الدرامي يتمظهر بصيغ مختلفة، فمرة هو ذاتي مشارك أو مصاحب، ومرة ثانية هو موضوعي غائبًا كان أو مقتحمًا، وثالثة هو مموه في ضمير الشخص الثالث، في حين يتمظهر وجوده في السرد التعبيري مراقبًا الشخصية، مكتفيًا بوصف الأشياء وترتيب الصور التي فيها اهتمام بالتفاصيل الدقيقة والبسيطة من قبيل وصف صورة ملامسة ضوء المصباح لوجه الشخصية أو طريقة سقوط شعاع الشمس على صفحة النهر أو الظل الذي تتركه شجرة على قارعة الطريق، وغير ذلك من التفاصيل التي تدخل في بناء الصور الوصفية، والتي تتطلب من السارد وعيًا بالمكان وتصالحًا معه بوصفه ملاذًا روحيًّا.
ومعلوم أنّ المكان بالمكين، والإنسان في مقدمة الموجودات المكانية التي عليها توجه الكاميرا عينها التي هي عين ثالثة لا ثبات لها، وهي تتنقل من هنا إلى هناك محاولة الإمساك باللحظة مكانيًّا، بيد أن ذلك لا يعني أن السارد يتنكر للزمان وطرائق سرده ولا سيما الاهتمام بالضمائر السردية وطريقة توالي الأحداث، في هذه اللحظة ممنتجًا كل ما فيها من حركة وصوت جاعلًا المشهد فلميٍّا، فيكون مرئيًّا وقد تساوى فيه زمن السرد وزمن المشاهدة. ومن ذلك مثلًا التعبير عن لحظة وقوع بصيص من ضوء على شيء من الأشياء، فيمكن للسارد أن يتجاوز ترتيب لقطات هذه اللحظة إلى الاكتراث بالزمان في بناء الجملة السردية.
ولا خلاف في أن المؤلف يكتب فكرته بعد أن يستفزه موضوع ما، متدبرًا أسلوب كتابته باعتمال شعور وتركيز نظر يجعلان عملية انصباب الفكرة ممكنة داخل قالب كتابي ذي وحدة أجناسية معينة، بيد أن هذا الأمر في الكتابة السردية لا يتم بإبداعية ما لم يتبنَّ الكاتب بقصدية ودراية مذهبًا أدبيًّا معينًا، يسير في ضوء مبادئه، ويصوغ أبطاله على هدي مواضعاته وأعرافه.
وعادة ما ينتهج قصاصونا وروائيونا المذهب الواقعي وبمختلف صوره، بدءًا من الواقعية النقدية التي مثلتها مرحلة التأسيس مطلع القرن العشرين عند محمود أحمد السيد وذي النون أيوب وعبدالحق فاضل ويوسف متى وجعفر الخليلي ومرورًا بالواقعية الاشتراكية والواقعية الجديدة المنغمسة في تيار الوعي وتداعي الشعور الحر التي مثلتها مرحلة التبلور في منتصف القرن نفسه عند عبدالملك نوري وفؤاد التكرلي وفهد عيسى الصقر ومحمد روزنامجي، ووصولًا إلى واقعيات أخر تبناها بعض الكتّاب العراقيين في الربع الأخير من القرن الماضي وإلى اليوم.
كاتب ينتزع الريادة من مجايليه
ولا نعدم وجود فئة من الكتّاب راهنت على التمذهب بغير الواقعية، مجرِّبة الانتماء إلى مدارس أدبية كالرومانسية والرمزية والسريالية، لكنها لم تستطع إثبات نجاعة هذا التمدرس، وظلت مجرد تجريب لم يبلغ مستوى الظاهرة التي يمكننا أن نمثِّل عليها ونتبين مساراتها؛ باستثناء تجربة القاص محمد خضير الذي انتهج خطًّا مذهبيًّا مختلفًا في الكتابة السردية تمثل في تبني المدرسة التعبيرية وداوم على هذا التبني حتى أجاد في تمثيله في القصة القصيرة.
والمدهش أن ينتهج قاص وحده مذهبًا، ويتخذ منه قاعدة يؤسس عليها سروده، محتشدًا له بوعي نقدي مناسب مع الإخلاص في الانتماء إليه، مخالفًا بذلك القصاصين مجايليه وسابقيه، راسمًا لنفسه خطًّا يميزه في السرد، منتزعًا لنفسه الريادة بينهم.
هذا ما مارسه القاص محمد خضير وهو يتخذ التعبيرية موجهًا لسردياته منذ ستينيات القرن الماضي، والجًا متاهات السرد وأفانينه، متطلعًا برؤية فكرية واعية إلى مستقبل واعد، فيه تتبوأ إنسانية الفرد مكانها اللائق الذي به ترتفع عن العالم المادي إلى آخر صاف ونقي لا يشوبه صراع ولا نزاع، هو مملكة فيها ينعم الإنسان بالسلام بلا مصادرة ولا إلغاء. وقد تمثل ذلك أولًا في مجموعته المائزة «المملكة السوداء» ثم تلتها أعمال سردية أخرى مشهود لها نقديًّا بالتميز الإبداعي. ومما هو مؤكد أنّ النقد العربي شخّص مختلف التمذهبات الأدبية في الأعمال الإبداعية شعرية كانت أم سردية. وأغلب اهتمامه كان موجهًا نحو المذاهب الكبرى التي بزغت في أوربا مع عصر النهضة واستمرت إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت بغيته النقدية الوقوف على تمثلات الإيهام السردي في صنع الواقع النصي. أما المذاهب الموصوفة أنها صغرى، فإن الاهتمام بها ظل غائبًا نسبيًّا عن تناول النقاد. ومنها المذاهب التي أعقبت الحرب العالمية الأولى كالسريالية والتصويرية والعبثية والوجودية والتكعيبية والتعبيرية، مع أنّ لها مواضعاتها الفنية الجلية.
ووراء ذلك أسباب مختلفة منها أنّ نقدنا العربي منبهر بالواقعية في صورتيها النقدية والاشتراكية اللتين تماشيان اتجاهات النقاد الفكرية وانتماءاتهم الأيديولوجية، ومنها أننا ميالون إلى اتخاذ البعد الزمني معيارًا في الحكم على هذه المذاهب، فالجيد منها أدبيًّا هو ما طال عمره ولم يأفل نجمه سريعًا، وهكذا أخذتنا المذاهب التي بزغت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ووصفناها بالكبرى وفي الوقت نفسه استبعدنا المذاهب التي عرفها القرن العشرون ذات العمر القصير على أساس أنها لا تتمتع بالتبلور والاكتمال الكافيين، وهكذا أسدلنا عليها الستار. وكأن العبرة النقدية بالتاريخ وليس الفن وهو معيار مغلوط ينبغي أن نتجاوزه ونحن بصدد التجارب أو الظواهر أو الموضوعات الأدبية. ولحسن الحظ فإن الأدباء والفنانين لا ينتظرون من النقاد أن يقرروا لهم أي المذاهب أنجع إبداعيًّا.
فبعض المبدعين لهم وعي نقدي بتجربتهم الذاتية وأيضًا معرفة معمقة بخفايا مذهب ما، وهذا ما يجعلهم متحررين من كلاسيكية التوجه الإبداعي، قادرين على انتهاج مذاهب غفل عنها الدرس النقدي أو هي ما زالت فتية ونقدنا بعيد عنها، لينتفعوا من مزاياها الفنية وتوجهاتها الفكرية، والقاص محمد خضير واحد من هؤلاء المبدعين؛ لذا كان ساردًا في ناقد وناقدًا في سارد. ولا يفهم من مسألة التبني الإبداعي لمذهب ما، أن هناك ثلمًا في حرية المبدع في الكتابة، وقدحًا في أفضلية الموهبة التي ينبغي أن تملي هي عليه أولًا وأخيرًا، بل يفهم أن الحرية الإبداعية لا تعني الفوضوية؛ وإنما الانضباط بوجهة نظر يتبناها الكاتب تجاه ذاته أو واقعه أو كليهما معًا. ومن ثم يغدو التزود بتكنيكات معينة والتمنهج برؤى محددة ضروريًّا لتحقيق الهدف المرسوم. ولا شك أن وعي المبدع بالوسائل المعبرة عن هذا الهدف، سيمكنه من اختيار المذهب الملائم لتطلعاته وبما يضمن له توصيل وجهة نظره إلى المتلقين.
وكلما كان الكاتب متعاملًا مع إبداعه بهندسة شكلية معينة كان أمر تميزه واردًا ومحتملًا، وهذه الهندسة هي التي بها رسم محمد خضير لسروده معمارًا استند على قاعدة التعبير وحده، حيث لا حبكة يسعى إلى توطيدها، ولا شخصية يبحث لها عن بطولة كي يجعلها إشكالية ولا زمكانية يقصدها قصدًا، بل الذي يبحث عنه هو تحشيد التعبير باللقطات والتخطيط لطريقة تواليها بالتشذيب والترتيب وقد اتسمت بالتجانس والاتزان. والحاصل هو سرد غير اعتيادي في أبنيته، يرتفع على سياقات المتداول السردي شكلًا ومضمونًا. ولا تحوز التجربة السردية على التفرد عن سائر التجارب المجايلة لها ما لم تبتدع جديدًا غير اعتيادي سواء على مستوى الفكر والثيمات أو على مستوى الشكل والإطار، وقد تعدت المواضعات السائدة وغامرت بانتهاج أخرى غيرها. ولقد شهدت مرحلة الحرب العالمية الثانية منتصف القرن العشرين مثل هذا الوعي النقدي بالسرد، عند القاص عبدالملك نوري، لكن في مجال التجريب لتقنية سردية هي تيار الوعي، الذي وظفه نوري في قصصه فحاز الريادة في هذا التجريب عراقيًّا وعربيًّا.
والتميز السردي الذي سجله القاص محمد خضير في الستينيات كان قد كشفه د.شجاع العاني في مقاله «محمد خضير ومغامرة القصة العراقية» والمتمثل في الاقتراب كثيرًا من أسلوب السينما وهو التصوير بعين الكاميرا الذي لا يتدخل فيه المؤلف بل يكون مثل مصور سينمائي تأثرًا بالروائيين الأميركيين. وفي موضع آخر وجد في المملكة السوداء متوالية نص قصصي كاشتغال فني؛ إذ «يقوم على تغريب الأشياء بحيث لا يعود هذا النص مجرد استنساخ لهذا الواقع أو رصد سطحي له؛ بل تغريب له سيغير المنهج ولكن الرؤية ستظل غالبًا الرؤية الواقعية النقدية».
وسائل فلمنة القصة القصيرة
معلوم أن السينما قادرة على ملاحقة اللحظة الزمنية الواحدة في أماكن مختلفة عبر وسائلها التعبيرية التي بها تصبح الأشياء والحيوات مرئية صوتًا وصورة، ضمن شريط فلمي يحاكي الحقيقة فعلًا وليس احتمالًا، وتستطيع القصة القيام بذلك أيضًا بطرائق مختلفة لتكون «إحدى المقومات الأساسية لإدراكنا الحقيقة». وما يجعل السرد مفلمنًا، هو التداخل الأجناسي بين السينما والسرد، الذي به تنتفع السينما مما في السرد من تصوير نفسي لدواخل الشخصية، بشكل يسميه دولوز بالرسومي piclural الذي يتجاوز حدود الوصف إلى الاحتواء داخليًّا وخارجيًّا حيث لا انغلاق في وجهة النظر بمعنى أنها لن تكون عند السارد واحدة؛ وإنما متعددة بتعدد المواقع التي يتنقل بينها حاملًا كاميرته واصفًا وساردًا، هذا من جانب ومن جانب آخر ينتفع السرد مما في السينما من مؤثرات فلمية ضوءًا وصوتًا وحركات وألوانًا عند اختيار زاوية اللقطة الواحدة ثم التوليف بين مجموع اللقطات داخل مشهد سردي يمنتج من ثم كشريط فلمي.
والسرد الذي ينحو منحى سريعًا تتمحور لقطات شريطه الفلمي حول لحظة زمنية خاصة ومأزومة، سيمنتج فيما نطلق عليه (القصة المفلمنة) التي يتزامن فيها الصوت والصورة.
والانتقال سمة فلمية بها يصبح السارد مخرجًا سينمائيًّا وليس مصورًا حسب؛ لأن الأول هو الذي يعطي للثاني زاوية المنظور الذي عليه يسلط عين الكاميرا وهو ما لا يعرفه سوى السرد التعبيري، الذي فيه السارد معني كل العناية بالزاوية التي منها يقبض على اللقطة المميزة أو يقتنص الصورة الفوتوغرافية المناسبة وهو يستقصي أبعاد المكان ومواقع الحيوات والأشياء فيه. ثم تتبع هذه العملية التجميعية للقطات والصور عملية أصعب وهي التوليف بينها بمونتاج يجعل السارد يلصق هنا صورة ويقص هناك أخرى أو يتناوب بين اللقطات المشهدية بالطريقة التي تمكنه من صنع المفارقة paradoxal التي هي سمة مهمة من سمات المذهب التعبيري.
وما يريده السارد هو رصد حركات لحظة زمنية بعينها في لقطات هي عبارة مشهد أو أو مشاهد؛ كي يعبر من خلالها عن موقف بصري معين. وتغدو الدرامية في القصة القصيرة متراجعة وليست مختفية تمامًا، ما دام تزامن الصور والمشاهد في القصة المفلمنة موجهًا نحو شخصية أو أكثر يراد من السارد التعبير عنها تمثيليًّا، الأمر الذي يستدعي منه وربما لا يستدعي إيلاء الدرامية بعض الاهتمام في التصوير لكن الأمر يظل اختياريًّا وليس ضروريًّا. وتفترض التعبيرية وجود رؤية سينمائية لا تقتصر على تنقلات السارد وهو يوجه عين الكاميرا نحو زاوية تُلتقط منها الصور والمشاهد، بل ستدعم هذه العين الثالثة موقع السارد واصفًا حينًا وساردًا ذاتيًّا أو موضوعيًّا حينًا آخر، مفيدًا من الخطاب السردي في تعزيز الخطاب السينمائي. وبتداخل الخطابين يتحقق المقصد التعبيري وهو تحويل المعطى السردي من الإيهام إلى نفي الإيهام وتحقق الواقع الذي فيه تكمن الوظيفة السردية بالمطلق.
بمعنى أن وجهة النظر point of view التي كانت فاعلة في التداخل بين السرد والدراما كعنصر من عناصر المسرح، لن تكون كذلك في التداخل بين السرد والسينما، الذي فيه يحتل الوصف مكانًا محوريًّا فينسحب التسريد بوجهة النظر المحددة ليحتل مكانه التعبير بأكثر من منظورperspective بوصف المنظور «منظومة لتمثيل مكان ثلاثي أو رباعي الأبعاد بوساطة وسائل فنية خاصة بشكل فني معين. ونقطة الإحالة في منظومة المنظور الخطي هو موقع الشخص الذي يقوم بالوصف» وعادة ما تنقل عين الكاميرا المنظورات إما خطيًّا أو عموديًّا أو منحنيًا أو بينيًّا.
وإذا كان (المنظور) في الأصل نظرية فنية يعود بها مؤرخو الفن إلى العصور الوسطى التي كان فيها المنظور مقلوبًا inverse في الفنون البصرية؛ فإن (وجهة النظر) نظرية شكلانية مقصورة على الأدب، وقد تعامل معها شكلوفسكي بوصفها عملًا تقانيًّا ثم تناولها باختين وفريدمان وبرسي لوبوك وأوسبنسكي الذي حدد وجهة النظر بأربعة مستويات تؤلف شعرية السرد التي فيها تتداخل الدراما بالسرد في صنع المنظور داخل العمل الأدبي. وإذا كان المستوى الأيديولوجي معنيًّا بوجود الشخصية والسارد والمؤلف؛ فإن المستوى التعبيري يعنى بالتعبير عن وجهة نظر بوسائل تكنيكية كتوظيف الضمائر واستعمال الخصائص الكلامية للحوار، التي بها تتم «إعادة صياغة المؤلف لكلام الغير في الحالات التي نعرف فيها مشاعر الشخصية وأفكارها بصورة يبدو أنها تحاكي طبع الشخصية في حين الإشارة إلى هذه الشخصية تأتي بصيغة ضمير الشخص الثالث الغائب».
وبذلك يتمكن السارد من وصف الشخصية بطرائق مختلفة، مما تعتمده القصة الدرامية التي تتحكم في الجملة السردية الواحدة وجهة نظر معينة، في حين يعتمد السارد في القصة المفلمنة على منظور معين وهو ينقل لنا اللقطات والصور، مغيِّرًا موقعه مخرجًا المنظور أو مصورًا الحدث أو واصفًا تفاصيل الأشياء. وبتناوبه بين هذه المواقع سيعبر عن دقائق واقعية صغيرة مثل قسمات الوجه وتعابير الحركة وتنغيمات الصوت، وهي تتزامن ضمن حيز مكاني واحد أو متعدد لكن في لحظة زمنية معينة. وللمكان أهمية خاصة في رسم المنظور الذي فيه يتموقع السارد إما مقابلًا الشخصية بشكل خطي أو واقفًا خلفها ماسحًا حركاتها مسحًا تتابعيًّا أو منتقلًا في تسجيل اللقطة بالتوالي من الأعلى إلى الأسفل.
ومثلما تحوِّل الفنون البصرية ومنها السينما المكان الواقعي المتعدد الأبعاد إلى سطح مرسوم ذي بعدين ونقطة موجهة هي موقع الفنان في الأدب، يعمل السرد التعبيري على موقعة السارد خارجيًّا كمراقب هو أشبه بالمخرج، يلازم الشخصية لكنه لا يتدخل في شأنها، وفي الآن نفسه يمكنه ممارسة أدوار أخرى، فمرة هو سارد موضوعي يجلس في مكان عالٍ، ومرة ثانية يغيِّب نفسه في ضمير الشخص الثالث أو أنا الراوي الغائب وقد يكون ساردًا ذاتيًّا مرة ثالثة يشارك الشخصية تجسيد الحدث، وقد يهيمن بضمير الأنا على السرد كله.
وبحسب منظري الزمان، فإن الحركة التي تتم بالانتقال في المكان لا تنقسم وهي غير متجانسة بعكس المكان الذي يقبل القسمة لكنه يظل واحدًا متجانسًا. وهذا ما لم يقتنع به دولوز وهو يطبق هذه الفرضية على السينما؛ لأن إعادة تأليف الحركة ستتغير بأوضاع محتملة داخل المكان الواحد…والسينما تستخدم معطيين اثنين: مقاطع هي الصور وزمن هو الحركة، ليأتلفا داخل شريط سينمائي يبث بدوره المشهد متعاقبًا في صوره واحدة بعد واحدة وعلى اتصال بعضها ببعض. وهذه الحركة بمنظور برجسون هي وهم لأنه لا جديد فيما يفعله الإدراك الحسي الطبيعي فمعرفتنا العادية هي في الأصل ذات طبيعة سينمائية.
وهذا ما يعترض عليه دولوز أيضًا، رافضًا عدَّ الحركة وهمًا سينمائيًّا، ودليله أن في السينما تتم إعادة إنتاج الوهم من جديد، أو إرجاع الحال الواهم إلى الحقيقة، بمعنى أنّ الوهم في السينما يتصحح في اللحظة نفسها التي تظهر فيها الصورة للمتفرج.
الإيهام الواقعي وتوظيف التخييل
على هذا الأساس فإن الفنون على اختلافها من أدب ورقص وغناء ونحت ورسم تعتمد الإيهام الواقعي بتوظيف التخييل باستثناء السينما التي تتخذ من وسائل التعبير صوتًا وحركة ولونًا وإيحاءً أدواتٍ تصنع بها واقعًا افتراضيًّا لا وهم فيه. والسرد إذ يتداخل بالسينما فإنه يستعير منها هذه الإمكانية من خلال التعبير عن حركة تنماز بأنها فريدة، ليتخذ منها موضوعًا للتأزم. والديمومة في السينما ليست زمانية حسب، كما هو الحال في السرد تباطؤًا وسرعة واسترجاعًا واستباقًا، بل الديمومة أيضًا مكانية بسبب تنوع الأمكنة تبعًا للمنظور الذي تعتمده عين الكاميرا، وفي أنفسنا أيضًا هذه الديمومة موجودة؛ فالشعور له زمانه الذي تحدده الذاكرة وعيًا أو لا وعيًا بالتخييل. وهذا ما يجعلنا قادرين أن نسرح بمخيلتنا في آن معين ونحن ننتقل مكانيًّا إلى أمكنة أخرى.
ولأن الديمومة انتقال وحركة يصبح السرد شريطًا فلميًّا، تتم عملية ترتيب حركاته وتنقلاته بوساطة المونتاج الذي هو القص والتشذيب للقطات التي تؤلف وتركب في شكل سيمي (سيتيم) مشكلًا الإطار كادرج cadrage الذي يضم انتقالات الكاميرا وحركتها ولقطاتها. وقد أفادت الديمومة في السرد الدرامي من مستحدثات السينما ومنها تنظيم حركة الشعور باللقطة البطيئة واللقطة عن قرب والامتداد اللانهائي للحظة. بقصد التعبير عن الحركة وتعدد المكان، بيد أن ذلك ظل في حدود «وعي الشخصية المنطوي».
أي أن التداخل مع مستحدثات السينما تحدد في إطار الشعور والعمليات النفسية الداخلية ولم يشمل الوصف الذي يظل في السرد الدرامي ثابتًا، يلتقط فيه السارد أنفاسه ليعود مجددًا إلى سرد الأفعال، الذي فيه قد يثبت البطل عند زمان معين ويتحرك وعيه في المكان وهذا هو المونتاج المكاني أو بالعكس يتوقف البطل في المكان نفسه، ويتحرك وعيه في الزمان وهذا هو المونتاج الزماني.
وعادة ما يشتمل السرد الدرامي على مشاهد بعضها سردية تصويرية أو بانورامية وبعضها الآخر مشاهد صامتة، فيها يعمل المونولوج الداخلي كتقانة وظيفتها تقديم المحتوى النفسي للشخصية تعبيرًا «عن الفكرة الحميمة التي ترقد في منطقة أقرب إلى منطقة اللاوعي».
بهذا يكون السرد الدرامي مقصورًا في الأساس على السرد، في حي يفيد السرد السينمائي من السرد والوصف معًا، في عملية منتجة زاوية الإطار، مع تباين في صيغة المونتاج ووظيفته؛ فالمونتاج السينمائي الألماني يختلف عن المونتاج الفرنسي والأميركي في أن لقطاته تعبيرية (أضوائية) تعتمد على تناوب الضوء والظل امتدادًا انقباضًا وانبساطًا، فيقف في المشهد الواحد الضوء إلى جانب الحركة باعتبار أن «الضوء هو الحركة. أما الصورة الحركة والصورة الضوء فهما الوجهان لتجل واحد».
وتوصف المنتجة التعبيرية في السينما الأميركية أنها عضوية سريعة وفعالة وإيقاعية، من ناحية نسبة الزمن إلى الحركة بعكس المونتاج الفرنسي الذي يوصف بأنه ميكانيكي أوتوماتيكي وليس إنسانيًّا. ولا غرو أن تساهم التعبيرية في منتجة القصة القصيرة كشريط فلمي، وعادة ما تعكس المنتجة هندسية المكان تقديمًا وتأخيرًا وامتدادًا وضيقًا وانبساطًا وانقباضًا عبر متوالية اللقطات في المشهد الواحد.
ولا شك في أن لجوء القاص إلى المنتجة والتوليف في التعبير عن الأمكنة الأليفة والأثيرة متأتٍّ من إحساس فني مفاده أن الدراما وحدها غير كافية لإظهار إنسانية الإنسان، وأن الحقيقة ليست كامنة في حبكة فيها الإنسان يتأزم حتى يبلغ الذروة لينتهي صريع الزمان والمكان. والحل يكمن في تعمد قلب الحقيقة عبر استعادة لحظة الإيهام السردي وقد تصححت إلى لحظة للإشراق والتصديق، فيها تشع الحقيقة بصريًّا بالوصف الخارجي الذي يعكس ربما الوعي الباطني.
والملموس في قصة «الأرجوحة» القصيرة أنها «إرهاصات أولية بحساسية جديدة وقصة عراقية جديدة توشك أن تولد»، فضلاً عن كونها انتهاجًا جديدًا في السرد يجعل هذه القصة أنموذجًا جليًّا للتوظيف الفلموجرافي الذي فيه توصف القصة بأنها مفلمنة، تراهن على المكان بحميمية خاصة أتقنها القاص محمد خضير وداوم عليها في أكثر قصصه. وعشق المكان نابع من عشق المكين الذي هو الإنسان، مطلب التعبيرية ومبتغاها، فإذا كان المكان قرية نائية بامتداد شاسع كان الإنسان طليقًا متحررًا من الزمان، وإذا كان المكان غرفة في فندق أو مقعدًا في سيارة كان الإنسان محاصرًا مغمورًا ومضطهدًا بالزمان.
ولا يقتصر هذا التمذهب بالتعبيرية على قصة الأرجوحة وحدها؛ بل يشمل قصصًا أخرى كتبت قبلها، لكن القاص لم يضمها إلى مجموعته القصصية (المملكة السوداء)، التي حفلت باهتمام نقدي واسع في حين أُهملت القصص السابقة للأسف نقديًّا، ومنها قصة «أوهموا بعضكم بعضًا» التي فيها انتهج محمد خضير المذهب التعبيري، مركزًا على عنصري الطبيعة والإنسان، فأما الطبيعة فهي المكان الذي فيه تتضح تفاصيل الأشياء بالوصف الفيزيقي لونًا وضوءًا ورائحة وصوتًا «سيارة الخشب بمقدمتها الحمراء، الطريق الترابي الملتوي، انكسار الأحداق» ويستعيض بوصف الحيوات عن تسميتها «وجوه متداخلة/المرأة المرضعة/رجل ذو لحية بيضاء/العيون تتداخل مع ارتجاج السيارة المستمر».
وتتخلل هذه الشيئية مشاهد حوارية قصيرة. أما التركيز على الإنسان فيظهر بتوظيف المفارقة التي بها يغدو الإنسان واقعًا تحت مراقبة شيء غرائبي مبهم عبر عنه «بالشكل الخارجي» بديمومة ذات مواقع ثلاثة (1) «كان الشكل الذي توهم أنه يجري مع السيارة في الخارج المولود من رحم الريح يزيد من سرعته متخطيًا النباتات الشوكية»(2) «كف الشكل الخارجي عن الجري وتلوث الضياء»، ثم المفارقة التي تختم بها القصة وفيها يتبين أنّ الشكل الغرائبي المبهم هو الزمان الذي يترصد الإنسان في الحياة التي هي متنقلة وسريعة كالسيارة (3) «واستمر الشكل الذي أنجبته الريح والغبار والشمس بالجري مع السيارة وكان يبدو أنه ضجر جدًّا».
وترتفع في قصة «جامعو الجثث» التي كتبها القاص بعد نكسة حزيران بشهر أو أكثر، نزعة التشيؤ التي فيها اعتمد منظورًا سينمائيًّا أفقيًّا، فيه عين الكاميرا ترصد الإنسان من قرب، إما كجثة هامدة مثل كتل الحجارة تُردم في حفرة، أو كأجساد منحوتة سوداء ترميزًا للفلسطينيين، غير أن ظهور البنت الصغيرة وهي تراقب جامعي الجثث كيف يلقون ببعضها في الحفرة، والشمس تبزغ من بعيد بما يجعل الأمل حاضرًا لمستقبل يمكن أن ينبثق من جديد، جاعلًا الإطار العام للقطات يتحول من أسفل/ الأرض إلى أعلى/ السماء.
ويستمر القاص على الإيحاء بالبعد المستقبلي من خلال توجيه الكاميرا نحو الأشياء توجيهًا إشاريًّا يوحي بالمقصد من دون تصريح. وهذه أهم سمة موضوعية في التعبيرية، كما في قصة تقاسيم على وتر الربابة، التي فيها التشيؤ مؤنسن بالباب والقطار وزاوية الجدار والمطر والسكة الحديدية والزقاق.. إلخ، التي تعكس بحركتها وألوانها وإضاءتها وعتمتها ورائحتها الاحتدام الشعوري الذي يكتنف الجندي العائد من حرب خاسرة تركت في داخله شرخًا لا يمكن إصلاحه.
وبدلًا من أن يحكي لنا السارد عن هذا الشرخ باطنيًّا بالمونولوج ترك الأشياء هي التي تتحدث تعبيريًّا وليس واقعيًّا وبمنظور يشكل مشاهد فلمية ذات لقطات تشييئية تحكي صمتًا هو أبلغ من الكلام «وباتجاه المصباح كانت الشعيرات الدقيقة النافرة عن مستوى شعرها المرصوف تمتد كأسلاك رخوة بين جدران الغرفة تنطلق منها ذرات متقدة سريعة جدًّا تملأ الغرفة كانفجار مفاجئ لقنبلة، وأبعدها»، لنعلم أن الجندي معطوب محطم وقد قتلت الهزيمة كبرياءه، فعجز عن إثبات رجولته. وباعتماد الإيجاز والتكثيف يتضح هذا العطب الذي أصاب دواخله بلقطات تركز على تفاصيل جسدية كوجه الزوجة وطريقة نوم الطفلتين، حركة الشعر واليدين، برودة المكان، لون الثياب والفراش، لمس الأصابع لوتر الربابة… إلخ. وتعمل الحوارات القصيرة على تعضيد اللقطات المقربة، بعيدًا من الدرامية لكن بذاتية عالية فيها الإنسان شيء كبقية الأشياء.
ولأن النوم هو الحل الذي به يتصالح الإنسان المهزوم والمأزوم مع نفسه، يشعر الجندي الذي هو سيظل بلا اسم، أنه بحاجة إلى نوم طويل. وبالمفارقة التي تقوم على التغريب تنتهي القصة والإنسان يطارده شيء بثياب سوداء وأساور في معصميه وقدميه.
أرجحة المكان السردي تعبيريًّا في قصة «الأرجوحة»
للتنظيم والتزويق والتخطيط أهمية كبيرة في بناء المكان السردي الذي به يصبح المكان متسعًا أو ضيقًا حيًّا نابضًا أو شيئًا جامدًا. والأداة هي المخيلة التي رافقت البشرية منذ أن وعت مكانها، فوجدت في الخيال ملاذًا من الزمان فبنت أمكنة متخيلة كي تضمن لنفسها الخلود وتتحصن من الاندثار. واتخذت الزقورات والأهرامات شكلًا مخروطي البناء، يبدأ متسعًا ثم يضيق، مقربًا الموتى من نقطة الصفر التي فيها يتلاشى الزمان والمكان فتستعيد المومياء الحياة.
وليس خافيًا أن الزمان هو العنصر الأساس في بناء الحبكة في السرد التقليدي، حتى دخلت المستحدثات السينمائية السرد فتخلى عن الحبك متحولًا إلى اللقطة التي تمنتج مع غيرها في شريط فلمي، فيه المكان عنصر مهيمن على الزمان، وهو ما ساهم في تأكيد أحقية تمتع هذا العنصر بالتسيد انتهاج المدرسة التعبيرية.
ولعل سائلًا يسأل: لماذا يركز السرد السينمائي على المكان ويضع له طرائق في التخطيط والتنظيم؟ إن الزمان معضلة فلسفية تصدى لها الفلاسفة وحاولوا حلَّها، بدءًا من أرسطو ومرورًا بسبينوزا وهيغل وماركس وانتهاء بهيدغر، وحاول سلافوي جيجيك اختصار معضلة الزمان بالمأساة/المهزلة، قائلًا: «يبدأ ماركس كتابه «الثامن عشر من برومير» بتصحيح لفكرة هيغل عن أن التاريخ يعيد نفسه.. ونسي أن يضيف المرة الأولى كمأساة والثانية كمهزلة.. وأن النظام القديم الحديث هو بالأحرى مجرد مهرج لنظام.. أبطاله الحقيقيون موتى. والتاريخ شامل ويمر بمراحل عديدة وهو يحمل الصيغة القديمة إلى قبرها. والمظهر الأخير لشكل العالم التاريخي هو ملهاته». ومهما يكن الأمر؛ فإن جدوى ما تقدمه الفلسفة من تفسير للزمان أقل بالتأكيد من الجدوى التي يقدمها السرد السينمائي في شكل قصة أو رواية مفلمنة تعبيرية، تتخذ الخيالي وسيلة لمقاومة الواقعي.
والقاص محمد خضير من أوائل قصاصينا الذين تنبهوا إلى دور المكان في السرد وأثر التعبيرية في تعضيد التشيؤ بالأنسنة. والسبب هو إمكانيات الوصف الخارجي باستعمال عين الكاميرا في اقتناص زوايا المنظور، لتكون اللقطة قريبة أو بينية أو بعيدة ثم منتجة تلك اللقطات متقاطعة أو متضافرة أو متعاقبة أو مسطحة. ويتصدر بناء المكان بكل موجوداته الحية وغير الحية سائر عناصر السرد في أغلب قصص محمد خضير، بوصف المكان الملاذ من الزمان الذي يطارد الإنسان غريمًا يهدده بالتشظي والتلاشي.
وفي قصة «الأرجوحة» يتجسد ما تقدم، بيد أن زاوية النظر تتجاوز المنظور الأفقي إلى منظور دائري يروج ويجيء في شكل أرجحة فيها الكاميرا تنتقل خطيًّا تعاقبًا وتواليًا أو عموديًّا صعودًا ونزولًا، راسمة عالمًا يوتوبيًّا. ويحتل النوم أهمية مركزية؛ لأن فيه تعمل المخيلة بعيدًا من الواقع، وتتضح هذه الهيمنة من أول سطر في القصة «على جادة السكون المظلة بمراوح السعف كان فتى حليق الرأس يتحرك فوق دراجته الخفيفة كالنائم»، وتعمم الغفوة على الموجودات كافة «الجادة والجدار والسعف والأعشاب وضفة النهر وعجلات الدراجة والحقيبة والبيت… إلخ».
فتبدو الطبيعة مسالمة والإنسان فيها شبه نائم حتى في وجود وحوشها «فجأة حدث هجوم الحيوات المختبئة وكادت تلقي بالفتى في الجدول أسفل الجادة»؛ إذ تظل الطبيعة هي الأصل الذي لن يشوهه الشر. ثم يتبع هذا المشهد الخاطف مشهد رائق يعيد للسرد هدوءه، فتستمر النفس في غفوتها «كان الماء يجري تحت القنطرة في سورات لامعة.. كانت تنبت شجرة عالية عند الضفة وثلاث نخلات طويلات ربطت بين اثنتين منها أرجوحة تحاول الطفلة التي خرجت من الغرفة الصعود إلى حمالتها».
ومثلما في القصص السابقة هناك شيء غرائبي يراقب الإنسان، هو في هذه القصة (كائن محلق) والأمكنة كلها متحركة (الدراجة، النهر، لظى التنور، الأرجوحة) والإنسان متجسد فيها ومتحرك على وفق حركتها. وهو ما عبرت عنه تنقلات الكاميرا التي أعطتنا صورًا وصفية ملتقطة بمنظور أفقي، وبطريقة الكاتالوغ تتوالى هذه الصور كلوحات فوتوغرافية مرتبة قصًّا ولصقًا، مع اللقطات داخل شريط فلمي يحفل بالحركة واللون والضوء والصوت، وبطريقة سريالية يتمازج عبرها العنصران الطبيعي والإنساني ويتوحدان بعضهما في بعض وقد التصقت أجزاؤهما بشاعرية، فتحول المكان الذي كان مؤثثًا بالأشجار والأعشاب والنخيل، إلى كائنات فردوسية تشي بالوداعة والسلام.
وتعتمد تخطيطية المكان في قصة الأرجوحة منظورًا خطيًّا أماميًّا منبسطًا وممتدًّا (سكون تظلله مراوح السعف/ فيء ساخن / جادات ضيقة محاصرة / ضوء مفاجئ) يقطعه منظور عمودي من (شمس قوية / سورة ماء / حركة أجنحة / دورات عجلتي الدراجة/ النار الملتهبة) وما بين هذين المنظورين مسافات بينية ترصدها عين الكاميرا بلا حواجز ولا نتوءات.
ثم بظهور الأرجوحة يتحول المنظوران الأفقي والعمودي إلى منظور مقلوب، فيه الأشياء تبدأ في كل لقطة في حركة بندولية صعودًا باندفاع (دفعها/ فصعدت/ اندفعت) ثم هبوطًا باسترخاء (عادت/ أحاط / حاد)، بحسب حركة الأرجوحة وبداخلها الطفلة حليمة، يحتضنها حليق الرأس «انحنى خلف ظهرها ثم دفعها دفعًا خفيفًا ولكنها طلبت أن يؤرجحها بقوة حتى تطير وتلقي جسدها بعد أن رجعت إليه وأحاط خاصرتها ثم دفع الأرجوحة فصعدت خارج ظل السعف فوق الماء وغمرت بالشمس ثم عادت إلى الوراء فحاد عنها ثم اندفعت ثانية خارج الضفة دون أن يمسها».
تصعيد السرد
وتعمل الحوارات القصيرة التي تتخلل المشاهد على تصعيد السرد بالتصوير والتمثيل، ثم منتجتها واقعًا نصيًّا تلتقطه عين الكاميرا خارجيًّا وليس بوجهة نظر السارد الذاتي أو الموضوعي. ومن خلال توليف الأوصاف والأفعال يتحول الوهم الواقعي إلى نص واقعي مرئي تدركه العين وتسمعه الأذن مفلمنًا السرد كشريط سينمائي قصير. وما الأوصاف المستعملة في السرد (حليق الرأس/ امرأة التنور/ رجل الحقيبة/ طفلة الحمالة) سوى ترميز إلى الإنسان بالعموم مما تعتمده التعبيرية كسمة إيحائية، ستظل مهيمنة على القصة كلها.
ولأن لا حبكة في السرد، يغدو إعطاء الشخصيات أسماء، مجرد تعبير عن تخلخل الذاكرة، فحليق الرأس اسمه ستار وتسميه الطفلة الزائر، ووالد الطفلة اسمه علي، وفي موضع آخر هو رجل الحقيبة وتصفه حليمة بالدخان وحليق الرأس والأخرس في إشارة إلى أنه أيضًا كان جنديًّا والآن هو قتيل حرب. ومن ثم لا تعرف الحقيقة سوى بالحركة التي هي جزء من أجزاء المكان وليس الزمان.
ونلمس في كل صورة أو لقطة بعدًا مرئيًّا فيه ضوء وظل داخل الإطار السيمي وبإيحائية يتناظر فيها موقع الحيوات والأشياء بين أعلى /أسفل أو يتناوب بين الضوء/ الظل والفتور والهز واللون واللالون. ويعبر تكرار الحركة عن حقيقة الحياة التي هي رجراجة فيها الإنسان طفل لا يريد أن يعرف أين سيذهب أو متى يعود، وكل ما يستطيعه هو أن يتوهم أنه يرى، معبرًا بذلك عن حبه للأشياء في فضاء متسع يتأرجح بلا هوادة، وقد اختصر حياتنا زمانيًّا ومكانيًّا «أرى أبي ها هو يؤرجحني في حضنه ولكنه لا يتكلم كالأخرس حلق شعر رأسه مثلك». وبالوهم يبدو الفرد منومًا، وهنا تكمن المفارقة فالتنويم صحوة هي أشبه بالتطهير الذاتي الذي به يرى الإنسان الحقيقة مضاءة ويشاهد الأشياء ملونة وهي تتحرك في فضاء لا زمان فيه للحرب.
والحركة في كل صورة محسوبة بدقة، من خلال منظور، فيه نقطة التلاشي هي الخط الفاصل بين الطفلة والجندي من جهة، والأرض والسماء من جهة أخرى. فتصبح الريح والماء وذرات الغبار وغيرها متأرجحة، صعودًا ونزولًا.
ولا غرو أن توحي منظورات تلك اللقطات إيحاءات عاطفية أو موضوعية، وهذا ما تحققه التعبيرية بعكس الواقعية السحرية التي فيها المشهد دراميّ يخضع للزمن وهو يمزج الواقع بالفانتازيا، ومن ثم لا تظهر السمة المكانية للسريالية التي يختص بها التقطيع الصوري المكون للمشهد السيمي، الذي يحفل بتعبيرية بصرية إزاء الحيز الذي تشغله تلك الصور كأن تكون مائلة أو مكتملة، مثلومة أو منقسمة، مضاءة أو نصف معتمة.
وتعمل الحركة المتوالية بالارتداد على جعل المشهد حيًّا، بسريالية تجمع الواقعي بما بعد الواقعي «تلقى الزائر الأرجوحة من الخلف بأن وضع راحتيه حول الحمالة الممتلئة بجسد الطفلة الصغير ودفعها بقوة فحلقت فوق النهر وانطبعت على سطحه منسحبة فوق الأشكال الطافية». وتهيمن إيحائية النوم على أغلب اللقطات فالطبيعة غافية على النهر مترامية الأطراف وديعة، والطفلة «سرعان ما كانت تنام في هذه الأرجوحة» بريئة وذات مخيلة، تتجاهل عبرها الزمان والذاكرة والتاريخ متدارية في المكان الذي يتأرجح بها صفوًا وتناغمًا، كأنه في فورة.
و(فورة المكان) تعني احتدامه بالأوصاف التي بها تتبدد سكونية كل شيء حيًّا وغير حي فتتوالى أمام أعيننا صور الطبيعة مؤنسة وفائرة باخضرار الأعشاب وسخونة الهواء وتموج النهر وحركة السعف جنبًا إلى جنب الصور المشيئة للإنسان، الذي أنهكته مرارة الواقع، فحاول أن يتلون معه، مرة حليق الرأس ومرات هو زائر وسابح وجندي وصديق وابن، في حين ظلت المرأة التي هي زوجة وأم وجدة متشحة بالسواد، لها موقع واحد في القصة هو تلقى لظى التنور وهي ساكنة وسكونها مريب، ووجهها متضائل، مثل جذع فحم، حتى صارت امرأة التنور، ترميزًا إلى انسحاق الإنسان رجلًا أو امرأة بالحرب، لكن المؤلف يضع الأمل في الطفلة حليمة الحالمة التي لا تريد أن تفتح عينيها كي لا يختفي والدها الذي يسكن الحقيبة كالدخان وبمخيلتها البريئة والبسيطة تعيد للجندي تفاؤله بأنّ المستقبل لنا، إن نحن صدقنا ما نحلم به. وهو ما تمثله خاتمة قصة الأرجوحة التي جاءت في شكل غفوة، شاهدت حليمة فيها أباها «يخرج من الحقيبة هناك ويأتي نحونا بلا رأس ولا يدين ولا رجلين ودون ثياب كالدخان، دعيه يقترب تظاهري بالنوم ولا تفزعيه؛ لأنه لا يحب غير النيام كالموتى خرج من الحقيبة كالدخان ولم يتكلم، خرج من الحقيبة كالدخان ولم يتكلم، غاص في النهر، غاصا أثره».
هكذا اختصر السارد الزمان كله في لحظة الغوص التي فيها وعت الطفلة حقيقة العالم من حولها وقد توحدت مع الآخر/ الزائر باستعمال ضمير المتكلمين حتى بدا هو هي كما توحد هو من قبل مع الأب الغائب (أنا هو كما لو كان هو)، وتصبح الإغفاءة هي نفسها الصحوة في إشارة إلى أن عالمنا متموج كالأرجوحة لا ثبات له، وأن من اقتنع أن المكان ثابت، سيغدره الزمان ويضيع في متاهاته، والحل هو الحلم الذي به نقتنص من الواقع حقيقته. هكذا تكون قصة الأرجوحة سردًا تخطيطيًّا وليس دراماتيكيًّا، فيه الحرية والحتمية تكمن في «كل الإجابات أو ردود الفعل الممكنة لتضاد أو استعصاء».
من هنا احتل التعبير عن الطبيعة موقع الصدارة في سرديات القاص محمد خضير بوصف الطبيعة هي مسقط رأس الإنسان؛ منها يبدأ وإليها يعود احتماءً واحتضانًا لا خداع فيه ولا خيانة. بعكس الزمان الذي يذكِّره كل لحظة أنه جسد ذاوٍ وذاكرة يهددها النسيان. وإذا كانت مقاومة فعل الزمان في السرد الدرامي تتم باختلاق زمان آخر وذاكرة تتغلب على النسيان بالتمسك بالهوية، فإن المقاومة في السرد التعبيري تتم سينمائيًّا باللقطات المركزة على المكان الذي لا يعرف الصمت، ولذا حلمت الطفلة بالزمان من خلال أرجحة المكان.

نادية هناوي - ناقدة عراقية | سبتمبر 1, 2019 | مقالات
كثيرًا ما نشهدُ توظيفاتٍ منهجيةً متغايرة وجديدة في تناول نصوصٍ شعرية أو سردية معينة، وهو أمرٌ طبيعيٌّ؛ لأنَّ الاشتغالَ المنهجيّ لا يتحدد بنصٍّ معينٍ يصلحُ له أو لا يصلحُ؛ وإنما كل المناهجِ يُمكن تطبيقها على النص الواحد، شريطة أنْ يكون في هذا النص عمقٌ فنيٌّ يؤهله للتوظيف المنهجي المغاير.
وليس في الالتقاطات المنهجية لما هو جديد نظريّ أو مستحدث فكريّ سوى مزيد من الغنى المعرفيّ الذي يفيد أكثر في تحليل النصوص واكتشاف مدياتها الجمالية. في المقابل فإن في النصوص التّراثية من الغنى والتعدد ما يؤهلها لأنْ نمرَّ عليها بمختلف المنهجيات على تفاوت توظيفاتها والأسس النظرية والفكرية التي تنبثق عنها.
صحيح أنّ التقاط منهجٍ جديدٍ أو مستحدثٍ ومحاولة الاشتغال عليه بثقة واقتدار أمرٌ ليس باليسير، والنقطة المفصلية في الاشتغال هي كيفية انتقاء الناقد المنهج الملائم للعينة النصيّة مفيدًا مما فيه من آلياتٍ وحيثياتٍ تسمح بالوقوف على أبعاد تلك النصوص الجمالية والفكرية.
ولا غرو أنَّ السرعة والعجالة في الاشتغال المنهجي تولدان سوءَ الفهم، ومن ثم يبدو المنهج نفسه فاشلًا في إثبات نجاعته كوسيلة قرائية، وغير مناسب لأي عمل إجرائي؛ مع أنّ الخلل ليس في المنهج وإنما في الكيفية التي بها باشر الناقد العمل بوساطة هذا المنهج.
وقد يتوقف النجاح في توظيف منهج حديث مستقدم ومستجد، على درجة المغامرة التي ينبغي أن يتحمل الناقد نتائجها مجازفًا في التوظيف الإجرائي لمنهج مثل هذا لم تثبت نجاعته بعد، وأكثر المغامرين في هذا المجال هم النقاد الواثقون من قدراتهم القرائية والعارفون لإمكانياتهم الحقيقية. وهذه المعرفة وتلك الثقة هما العاملان في نجاح أية ممارسة نقدية ذات رؤى وتصورات أصيلة وإبداعية.
وليس لمنهجٍ أن يصل إلى درجة النضوب الإجرائي ما دام الناقد جادًّا في التعامل معه برسوخ من ناحية الخلفية المعرفية والمفاهيمية، متعاملًا مع المنهج بحساسية نقدية تخدم النص الأدبي وتسهم في استبطانه وتأويله. ولا خلاف في ذلك كله بين أنْ يكون النص تراثيًّا أو يكون معاصرًا. وكثير من نقادنا المعاصرين بدؤوا طُرقهم النقدية من عينات نصية تراثية موظفين عليها منهجيات نقدية حداثية، مقتربين من منطقة النص التراثي تارة وداخلين فيها تارة أخرى، منجزين نقودًا رسخت المناهج التي اعتمدوها وخلقوا آفاقًا جديدة للدرس النقدي، كما رسختهم نقادًا مرموقين.
إن الحساسية النقدية في البحث عن منهجيات جديدة ومستحدثة أمر ينبغي أن يهجسه الناقد وهو يقرأ مختلف الأعمال الإبداعية؛ لأن ذلك هو طريقه إلى الاستشراف، وسبيله الذي به يصل إلى خرق المعتاد والمقولب.
والتطور في اكتساب الجديد من المناهج أمرٌ لا مناص منه في راهننا النقدي، وهو ما ينبغي أن نبحث عنه غير مكتفين بما هو موجود تحت أيدينا من منهجيات معتادة.
ومتى ما امتلك الناقد العربي القدرة على الارتقاء محاورةً ومحاججةً وتدقيقًا، كان أقدر ليس على استقدام المنهج الأحدث والأكفأ فحسب؛ بل ابتداع منهج لا يرتهن بالآخر لكنه يتحاور معه، كما لا يتسمر عند الذات فينغلق عليها.
وليست عملية ابتداع منهج بالمتعسرة، إذا عرفَتِ الذات الناقدةُ أنها تتحاور مع ذاتها قبل الآخر من غير انفصام ولا غرور، متسلحة بالمقايسة وملتزمة بالعقلانية ومستفيدة من الفلسفة ومستعينة بكشوفات النظرية الأدبية وما وصلت إليه العملية النقدية العالمية تنظيرًا وممارسةً.
إنّ الارتقاء بالفعل المنهجي لدينا هو الذي يهيئ نقدنا لصحوةٍ معرفيةٍ حقيقيةٍ تنتشله من معتادية الاستقبال والاستقطاب، ملقية به في منطقة الابتكار والابتداع. وبذلك سيتخلص نقدنا العربي الراهن من تبعات الممارسات القرائية الصحفية المحسوبة على النقد الأدبي استسهالًا؛ بسبب شوائبها اللامعرفية الكثيرة التي هي ليست نقدية؛ وإنما هي رغبات شخصية وظرفية مناسباتية واعتبارات غير سليمة، بعيدة كل البعد من الممارسة النقدية الجادة.
وما يمنح الناقد الوعي الكليّ هو إمكانية الظفر بالمنهجية الملائمة أو ابتكارها بنفسه، ليدشنها ويغامر في جعل الآخرين من النقاد مهتمين بها، وربما يضعونها في مخابرهم النقدية؛ كي يمتحنوا صحة فاعليتها، وعندها قد تنجح عملية الابتكار، فيكون لها وجودها اسمًا وكيانًا. وقد تخفق فلا يُكترث بها، لكن مع ذلك تُحسب للناقد المبتكر والمجرب حسنة من حُسنيين.
ولا خلاف أن إخلاص الناقد للجديد وعيًا وطموحًا سيؤدي حتمًا إلى إضافة نوعية للمشهد النقدي.

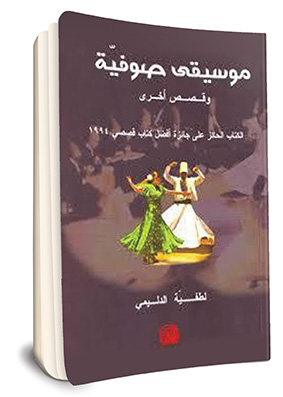 والنهر هو الجنون الذي يجمع الخير بالشر فيأتي بالقوة والمتع في سنوات الرخاء، ولكنه في سِنِي الفيضان يأتي بالكوارث والنذر «جارفًا الأكواخ والزرائب وجذمات الشجر وأعمدة الخشب وجلودًا وفروات كبائش وقرون بقر وملابس غرقى ومهود أطفال غرقى»، وحكاياه هي الأساطير التي تدلل على أن العالم بحيواته وأشيائه أكثر جنونًا منه. وتجتمع في النهر المجنون المتناقضات فهو الجدب والفيضان. ويهيمن جنون الماء على الفعل البشري الذي مثله حسين العبدالله وأيوب النهري ورجال آخرون، «مياهه تعلو تعلو حتى امتزجت بملح شجر الصبير وحرقة حليب التين وحموضة نسغ الرمان ومرارة النارنج، ثم منحته هذه المذاقات مجتمعة قوة فوق قوته، فارتفعت مياهه بدفقات متسارعة إلى أعالي النخل، وتذوقت طلائع الماء حلاوة الجمار في قلب النخيل».
والنهر هو الجنون الذي يجمع الخير بالشر فيأتي بالقوة والمتع في سنوات الرخاء، ولكنه في سِنِي الفيضان يأتي بالكوارث والنذر «جارفًا الأكواخ والزرائب وجذمات الشجر وأعمدة الخشب وجلودًا وفروات كبائش وقرون بقر وملابس غرقى ومهود أطفال غرقى»، وحكاياه هي الأساطير التي تدلل على أن العالم بحيواته وأشيائه أكثر جنونًا منه. وتجتمع في النهر المجنون المتناقضات فهو الجدب والفيضان. ويهيمن جنون الماء على الفعل البشري الذي مثله حسين العبدالله وأيوب النهري ورجال آخرون، «مياهه تعلو تعلو حتى امتزجت بملح شجر الصبير وحرقة حليب التين وحموضة نسغ الرمان ومرارة النارنج، ثم منحته هذه المذاقات مجتمعة قوة فوق قوته، فارتفعت مياهه بدفقات متسارعة إلى أعالي النخل، وتذوقت طلائع الماء حلاوة الجمار في قلب النخيل».

