
فرانسيس فوكوياما: التهديدات الأكثر مكرًا ضد الليبرالية تأتي من داخل الدول الديمقراطية يرى أن العالم المفتوح يتحول أكثر انغلاقًا وأقل ازدهارًا
أجرت جريدة لوموند الفرنسية في ملحقها الفكري عدد 22838 حوارًا مع الكاتب السياسي الأميركي الشهير فرانسيس فوكوياما حول التحولات الكبرى، التي يشهدها العالم اليوم، وفي قلبها بداية نهاية الهيمنة الغربية وصعود قوى دولية جديدة مثل الصين والهند. في الحوار يرى فوكوياما أن النموذج الليبرالي الغربي مهدد في عقر داره بأوربا والولايات المتحدة الأميركية من طرف المد الشعبوي، الذي أحيا «الهويات الوطنية القاتلة»، ويستهدف في العمق أسس الديمقراطية الغربية متجسدة في سيادة القانون ودولة الحق واستقلالية العدالة. اشتهر فرانسيس فوكوياما بكتابه «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» الذي أثار ضجة كبرى عبر العالم عند صدوره عام 1992م، إلا أنه عاد ليراجع الكثير من أفكاره وأطروحاته في كتبه اللاحقة من قبيل «بعد المحافظين الجدد: أميركا في مفترق الطرق»، و«النظام السياسي والاختلال السياسي»، ثم «الهوية: مطلب الكرامة وسياسات الكراهية».
فيما يلي ترجمة للحوار
● شُيدت الديمقراطية الليبرالية في غضون سيرورة تاريخية كاملة بالاستناد إلى عصر التنوير الأوربي. وقد قُدمت غالبًا بوصفها أفضل الأنظمة السياسية الممكنة، أو أقلها سوءًا. هل تعتقد أن هذه الحركة كونية؟
■ لم تكن الديمقراطية الليبرالية قط قيمة كونية. في الغرب، ظهرت بالفعل منذ قرنين بوصفها لحظة تاريخية. إذا ما نزعت نحو الكونية فبسبب أنها غدت شيئًا فشيئًا مرغوبة ما دامت المجتمعات صارت حديثة وغنية، ومواطنوها يبحثون عن أعلى مستويات العيش الرغيد اقتصاديًّا وعن الحرية الفردية. بعجالة، التنظيم السياسي لعالمنا تطور عبر عدد من الحقب التاريخية، مرورًا بالمجتمعات المنظمة في عصبات وزمر، ثم في قبائل، ثم في أمم، بعدها في دول استبدادية، وأخيرًا في دول الحق الخاضعة للقانون والمسؤولية الديمقراطية. الحياة الاقتصادية هي الأخرى تغيرت: لقد انتقلنا من حياة الصيد وجني الثمار إلى الزراعة المعيشية، ثم إلى أنشطة الصناعة التقليدية والتجارة، وأخيرًا إلى ميلاد وتوسع العالم الصناعي.
تبين الدراسات أن الساكنة، بوصولها إلى مستوى مرتفع في الرخاء والتعليم، تثمن عادة الحكومات المنتخبة والمسؤولة أمام مواطنيها. هذا الاتجاه التاريخي، الذي وصفته في «نهاية التاريخ والإنسان الأخير»، يبقى صحيحًا اليوم في العديد من البلدان، وإن كنا نشهد حاليًّا «انحسارًا في الديمقراطية»، التي نتحدث عنها. والدليل على وجود أمل كوني تقريبًا، للعيش في ظل مجتمعات ديمقراطية لـ«نهاية التاريخ»، يتمثل في أن ملايين الأشخاص، يحاولون، كل سنة، الهروب من البلدان المأزومة، الفقيرة والاستبدادية، من أجل الالتحاق بالمجتمعات الليبرالية في أميركا وشمال أوربا. هؤلاء الناس «يصوتون بأقدامهم» لفائدة نمط الحياة المقترح من طرف ديمقراطياتنا المزدهرة، حيث الأطفال يَلِجُون إلى التربية والتعليم، ويَجِدُون، بعد بلوغهم سن الرشد، العمل عمومًا، ويطورون مواهبهم، سواء كانوا رجالًا أو نساء.
يبقى أن الديمقراطية عرضة للتأويل بصورة مختلفة تبعًا للثقافات والدول. مفاهيم الهوية الجماعية تتباين، مثلها مثل مفهوم روابط القرابة والعائلة، واحترام سلطة الدولة، ودرجة الصرامة في حرية التعبير، إلخ. عن كل هذه المسائل، تقدم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ثقافات سياسية شديدة الاختلاف. فضلًا عن ذلك، عدد من الديمقراطيات الليبرالية، كما شاهدنا، تعيش اليوم في أزمة، مع مستوى عالٍ من الفساد، وتلاعب في الانتخابات، وانتهاك صارخ للحقوق الفردية ودولة القانون. هذا يعني، أنْ ليس من الثابت أن هذا الصعود لعدم التسامح والسلطوية يخلق مجتمعات سعيدة وأكثر استقرارًا على المدى الطويل. في هذا الصدد، يبدو لي أن الديمقراطيات لم تزل تقاوم…
الهويات الجماعية وتعبيراتها
● عنوان كتابك الجديد «الهوية: مطلب الكرامة وسياسات الكراهية»، يبدو مؤشرًا على أنك تنوي مواجهة سؤال الهوية المخدوشة من الشعبويين. كيف تحلله؟
■ في كتاب «الهوية..» أحلل كيف أن الاعتراف، الذي يتلقاه كل واحد منا بصفته مواطنًا مساويًا لأي مواطن آخر، محميًّا عبر حقوق الديمقراطية الليبرالية، ليس كافيًا للاستجابة للمطلب الشعبي بالاعتراف بالهويات الجماعية وتعبيراتها السياسية. لقد ظهرت السياسة الهوياتية والحاجة إلى الاعتراف في اليسار عندما شرعت مختلف الأقليات –الأميركيون من أصل إفريقي، والسكان الأصليون، ورابطة الاندماج الاجتماعي، والمعوقون الأميركيون، وجماعات أخرى- في التنصيص على حقوقها وحاجاتها إلى الاعتراف. اليوم، تعبر هذه السياسة الطائفية عن نفسها بقوة في صفوف اليمين؛ إذ يرى الأميركيون البيض أنفسهم عبر هذا المنظور الهوياتي، ويطالبون هم أيضًا بالاعتراف.
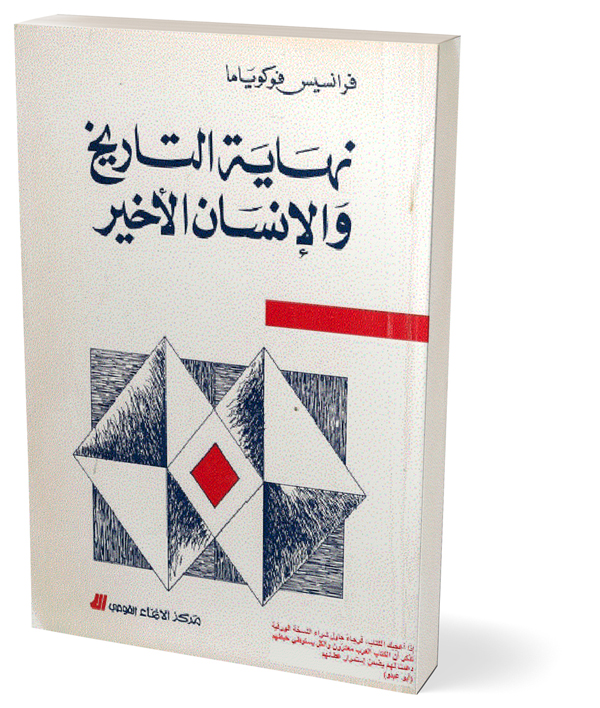 نسخة قريبة من هذه الحركة المطالبة بالاعتراف توجد بفرنسا وأوربا. في اليسار، جرى التشكيك في الديمقراطية الغربية من خلال سياسة هوياتية للأقليات مثل الدفاع عن المهاجرين – التي عوضت، بالنسبة لليسار، الدور الذي لعبته أمس البروليتاريا، المعتبرة كضحية رئيسية للنظام الرأسمالي. هذه السياسة أثارت رد فعل مضاد من اليمين، الذي يبحث عن إعادة الاعتبار إلى نسخة قديمة للهوية الفرنسية والأوربية مؤسسة على الانتماء العرقي والديانة المسيحية. هذا الانزلاق لأجوبة اقتصادية وقانونية نحو حلول هوياتية ليس ملائمًا للديمقراطية الليبرالية والمجتمع المنفتح: إننا ننظر في الأغلب إلى الهويات كما لو أنها متجذرة وجامدة في قواعد ثابتة أو في البيولوجيا…
نسخة قريبة من هذه الحركة المطالبة بالاعتراف توجد بفرنسا وأوربا. في اليسار، جرى التشكيك في الديمقراطية الغربية من خلال سياسة هوياتية للأقليات مثل الدفاع عن المهاجرين – التي عوضت، بالنسبة لليسار، الدور الذي لعبته أمس البروليتاريا، المعتبرة كضحية رئيسية للنظام الرأسمالي. هذه السياسة أثارت رد فعل مضاد من اليمين، الذي يبحث عن إعادة الاعتبار إلى نسخة قديمة للهوية الفرنسية والأوربية مؤسسة على الانتماء العرقي والديانة المسيحية. هذا الانزلاق لأجوبة اقتصادية وقانونية نحو حلول هوياتية ليس ملائمًا للديمقراطية الليبرالية والمجتمع المنفتح: إننا ننظر في الأغلب إلى الهويات كما لو أنها متجذرة وجامدة في قواعد ثابتة أو في البيولوجيا…
● في هذا العمل، تثير إمكانية إعادة تحديد المفهوم الجامد للهوية الوطنية. ماذا تعني بذلك؟
■ علينا أن نعود من جديد إلى مفهوم هوية وطنية شاملة، نعدُّها قاعدة مجتمع ديمقراطي؛ إذ يستطيع أناس مختلفون العيشَ والعملَ معًا. تاريخيًّا، كانت الهوية الوطنية القوية مرتبطة بالنزعة القومية العدوانية، التي دمرت أوربا في القرن العشرين. غير أن الهوية الوطنية تستطيع أيضًا أن تكون مؤسسة على المبادئ الديمقراطية الليبرالية. مفاهيم الهوية الوطنية الأكثر فعالية، سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو في فرنسا، كانت قائمة على المبادئ الدستورية والجمهورية، التي توحد كل المواطنين حول مجموعة مشتركة من المثل العليا: مثل اللائكية والحريات الفردية.
في المقابل، تؤدي السياسة الهوياتية التي تحافظ على الاختلافات الثقافية والطائفية، دائمًا تقريبًا، إلى تعارضات مع المبادئ الديمقراطية، عِلمًا أن كل التقاليد الثقافية ليست متوافقة مع الديمقراطية الحديثة. كل أولئك الذين يتطلعون إلى بقاء الديمقراطية الليبرالية عليهم اليوم تشجيع ثقافة وطنية منفتحة وشاملة، قائمة على المبادئ المؤسسة للمساواة والحرية المحددة في عصر التنوير الأوربي، ثم البحث عن استيعاب الوافدين الجدد في قلب هذه الهوية الوطنية.
الإثراء تحت سيطرة الحزب
● في عام 2014م، بعد 22 سنة على إصدار كتاب «نهاية التاريخ والإنسان الأخير»، أصدرتَ كتاب «النظام السياسي والاختلال السياسي»، تصف فيه من منظورك الأسسَ الجوهريةَ الثلاثة للديمقراطية، قبل ملاحظة أنها مهددة في كثير من البلدان…
■ اليوم، المبادئ الكبرى للديمقراطية الليبرالية –دولة موقرة من أجل خدماتها العمومية، مبدأ أسبقية القانون واستقلالية سيادة القانون، المسؤولية الديمقراطية للسلطة– مُساء إليها ومهددة عبر أنظمة مختلفة، في بلدان عدة. التهديد الأول يأتي من الصين حيث تقدم دولة متسلطة للعالم، منذ المؤتمر 19 للحزب الشيوعي الصيني [أكتوبر 2017م]، نموذجًا تناوبيًّا يجمع بين نظام استبدادي للحزب الوحيد ونظام اقتصادي شبه رأسمالي.
ضِدّ التحليلات الكلاسيكية حول التحديث والثراء، التي لوحظ أنها تفضي عادة إلى الديمقراطية، فإن الطبقة الوسطى الصينية الجديدة لا تعبر، في الوقت الحاضر، عن مطلب ديمقراطي قوي، ولا تطالب باكتساب حريات فردية أكثر. يبدو أنها ترضى بالعيش والإثراء تحت سيطرة الحزب. في الوقت نفسه، ينمو تأثير السياسة الخارجية الصينية ونموذجها بقوة أكبر في كل بحر الصين الجنوبي، بإندونيسيا، وماليزيا، والفيلبين، وسنغافورة، وتايوان، وفيتنام…
● لكن، أليست الديمقراطية الليبرالية مهددة أيضًا في العديد من الدول الديمقراطية؟
■ في الواقع، التهديدات الأكثر مكرًا ضد النموذج الليبرالي تأتي من داخل الدول الديمقراطية حيث يستغل الساسة الشعبويون المشروعية، التي يحصلون عليها في أثناء انتخابات حرة، لتقويض الأساسين الأولين للديمقراطية: سيادة القانون، التي يلتفون عليها، ومؤسسات الدولة، التي يفسدونها. انظروا إلى ما يقع اليوم في هنغاريا، في بولونيا، في تركيا، من دون نسيان الولايات المتحدة الأميركية. في هنغاريا، صرح فيكتور أوربان علانية في يوليو 2014م أنه يسعى لتشجيع ديمقراطية «غير ليبرالية»، وهو ما يعني أنه يرفض أسبقية القانون والحق الذي يحمي المواطنين بصرف النظر عن قرارات الحزب المسيطر. تطور مماثل يقع في بولونيا، حيث أعلن حزب «القانون والعدالة» عن إصلاح دستوري يتعارض مع معاهدات الاتحاد الأوربي، يسمح له بمراقبة سير العدالة مع مناصريه، مُقوِّيًا رقابة الجهاز التنفيذي على الجهاز القضائي. في الولايات المتحدة الأميركية، يسعى الرئيس دونالد ترمب إلى تقويض الثقة في استقلالية العدالة وفي تطبيق القانون حتى يحمي نفسه وعائلته ضد أي شكل من المتابعة القضائية…
نهج النقضقراطيا
● تقدمت بفكرة أن الديمقراطية والنظام السياسي الأميركي يمر بأزمة خطيرة. هل يمكنك أن تحدثنا عن هذا الموضوع أكثر؟
■ أرى مُحرِّكين اثنين للموجة الشعبوية التي تنتشر في الولايات المتحدة الأميركية منذ سنوات عدة. المُحرِّك الأول اقتصادي. فقد حملت العولمة معها في الأعوام الأخيرة نموًّا كبيرًا استفادت منه أقلية تنتمي أساسًا إلى نخبة الجيل السابق. في هذا الوقت، عايَنَ العديد من العمال الأميركيين دخلهم الحقيقي يتجمد أو يقلّ. وقد صاحَبَ هذا الترديَ الاقتصاديَّ تدهورٌ اجتماعيٌّ كبير: كثير من الأسر يرعاها عائل وحيد بدخل قليل، وباء استهلاك الأفيون المفجع، ارتفاع معدل الجريمة…
المُحرِّك الثاني سياسي. فقد انفرط نظام التوازن الكلاسيكي بين السلطات وأنتج نهجًا أسمِّيه «النقضقراطيا» (أو الفيتوقراطيا Vétocratie) للقرار؛ أدى إلى شكل من الشلل والعجز السياسي. لقد أصبح من السهولة بمكان لجماعات ذات مصالح منظمة وممولة بشكل جيد أن تعطل كل المبادرات السياسية التي ترفضها. هذا التعطيل يتضافر مع درجة التقاطب السياسي الحادة، وهو ما يفضي إلى عدم فاعلية مزمنة للكونغرس في تنفيذ كل التشريعات، التي حصلت مع ذلك على دعم الأغلبية الشعبية. كل عام، نشهد استعراضًا لشل القوة حول خيارات أساسية مثل تحديد الميزانية الفيدرالية، يمنع الحكومة من العمل. هذه الوضعية تسهل الاستيلاء على السلطة من زعيم قوي، وحده يستطيع أن يكسر «النقضقراطيا» من أجل فرض قراراته.
● هل فاقم انتخاب دونالد ترمب هذه الظواهر؟
■ بالتأكيد؛ لأن الشعبوية لها محرِّك ثالث: سؤال الهوية الأميركية. لقد فُسر التدهور الاقتصادي للطبقات الشعبية في البلاد بوصفه تدهورًا ثقافيًّا. واستغل دونالد ترمب مشاعر العديد من الأميركيين العاديين، الذين يرون أن السياسيين وكبريات وسائل الإعلام لا يحترمونهم، وينظرون إليهم من فوق ولا يأخذون مشاكلهم على محمل الجد. زيادة على ذلك، يندد دونالد ترمب، مثل الشعبويين الأوربيين، بالهجرة بوصفها تهديدًا للقيم والهوية الأميرية مقدمًا نفسه بوصفه المدافع النوستالجي عن مرحلة كانت فيها الولايات المتحدة الأميركية أقل تنوعًا.
● كيف تصف هذه الرئاسة؟
■ عوض أن يسعى لتقديم نفسه بصفته رئيسًا موحدًا للبلد حول مشروع مشترك، يكرس ترمب الانقسامات العرقية والاجتماعية والثقافية للبلاد. يسارع إلى انتقاد العدائيين السود أو بعض المشاهير الملتزمين، بينما يقوم بتشجيع المتعصبين العنصريين الذين يساندونه. ليس له أية فكرة عن دلالة دولة الحق ومبادئها: يهاجم، مثل أغلبية الشعبويين، القانون والعدالة عندما يسعيان لإجباره.
● ماذا تقصد بـ«العالم المفتوح»؟
■ منذ عام 1945م، سعت الديمقراطيات المتقدمة إلى وضع نظام دولي ليبرالي، يمكن فيه للسلع والاستثمار والأشخاص والأفكار أن تنتقل بسهولة عبر الحدود. نجاحه سمح بأن يتطور إلى اقتصاد قوي – تضاعف الإنتاج العالمي في قيمته الحقيقية أربع مرات بين عامَيْ 1970م و 2008م. لكن هذا العالم المفتوح والديمقراطي يوجد اليوم تحت الضغط من طرف القوميات الشعبوية، التي تريد قلب هذه السيرورة وإغلاق الحدود. سيكون عالمًا أكثر انغلاقًا وأقلَّ ازدهارًا، وسيكون هناك ميل للدخول في نزاعات حول مسألة المصادر والوضع المرتبط بكل بلد…
