
مدينة البدايات… حداثة بيروت (المترجمة) وتحولات أدونيس
منذ أواخر القرن التاسع عشر وسؤال المدينة وعلاقتها بالتحديث الشعري مُتلازمٌ مع مسألة التجديد الأدبي والتحديث الثقافي عمومًا حين غدت القاهرة مركزًا لثقافة «عصر النهضة» وما أعقبه من ظهور الحركات والجماعات الشعرية حقبة ما بين الحربين العالميتين: «جماعة الديوان» و«جماعة أبولو» وسواهما، ليبرز دور بغداد بعد الحرب العالمية الثانية عاصمة للشعر الحديث من خلال ما عرف بجيل الرواد، أو شعراء ما سُمِّي «الشعر الحر» فكان السؤال: من هو المجدِّد الحقيقي للقصيدة العربية، بعيدًا من أسبقية تاريخية ملتبسة هي الأخرى، هل هما نازك والبياتي البغداديان؟ أم السيَّاب القادم من ريف الجنوب؟ ومذَّاك دار السجالٌ حول تخوم المدن بشأنِ مركزية حواضر الشعر التقليدية. ليصل الحديث خلال العقود الأخيرة عن بيروت بوصفها عاصمة الحداثة التنويرية.
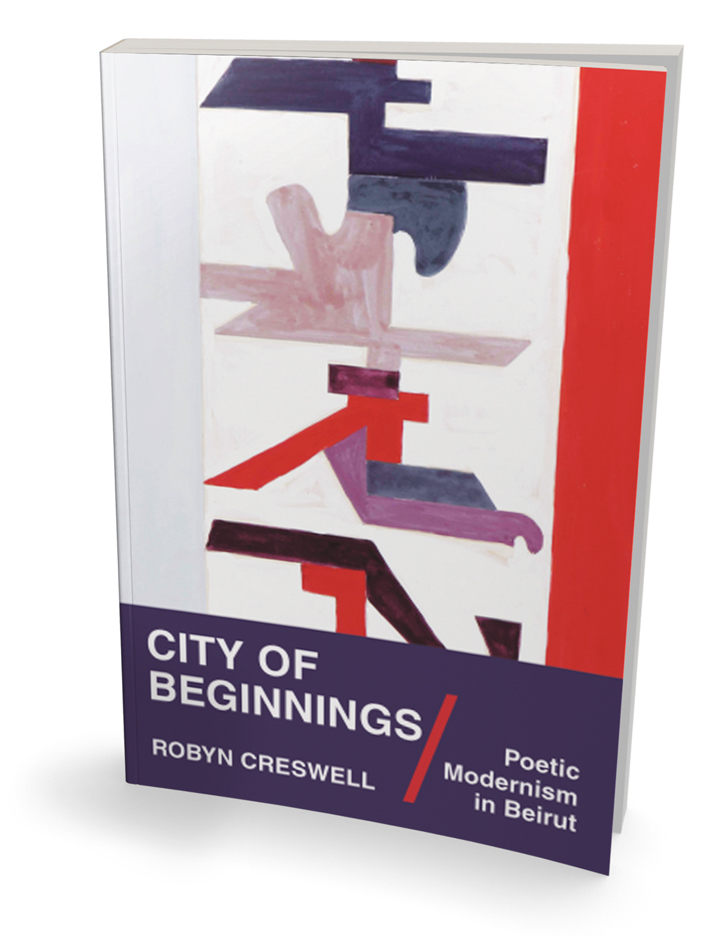 في هذا السياق يأتي كتاب الأكاديمي الأميركي «روبن كريسويل»: «مدينة البدايات… الحداثة الشعرية في بيروت» الصادر مؤخرًا عن «جامعة برينستون» في منهج بحث مقارن يكرِّس فيه الحديث عن: شاعر، ومدينة، ومجلة، وإذا كانت المدينة صريحة في العنوان وهي «بيروت» فإن الحداثة كناية مضمرة في مجلة هي مجلة «شعر» التي صدرت في بيروت ابتداءً من عام 1957م، رغم أنه يتحدث في مواضع كثيرة من الكتاب عما يسميه: «حركة» أو «جماعة» لكن أية بدايات يقصد؟ أهي بدايات الحداثة كما جاء في الجزء الثاني من العنوان؟ أم أن البدايات المقصودة هي كناية مضمرة عن رحلة شاعر؟ أي بدايات أدونيس صحبة المدينة: بيروت، والمجلة: شعر؟ ولا سيما أن الكتاب يخصِّص أغلب فصوله لدراسة تجربة أدونيس، بل إن العنوان نفسه مقتبس من عبارة للأخير في كتابه «ها أنت أيها الوقت» الصادر عن دار الآداب عام 1993م: «بيروت منذ لامستْ قدمايَ ترابها، وبدأتُ أشردُ في شوارعها، شعرتُ أنها مدينة أخرى، ليست مدينة «النهايات» كدمشق، وإنما هي مدينة «البدايات» وليست مدينة اليقين، بل مدينة البحث». ومن هذه البداية ينطلق ليدرس تحولات وجوه وأقنعة «مهيار الدمشقي» في الشعر والفكر.
في هذا السياق يأتي كتاب الأكاديمي الأميركي «روبن كريسويل»: «مدينة البدايات… الحداثة الشعرية في بيروت» الصادر مؤخرًا عن «جامعة برينستون» في منهج بحث مقارن يكرِّس فيه الحديث عن: شاعر، ومدينة، ومجلة، وإذا كانت المدينة صريحة في العنوان وهي «بيروت» فإن الحداثة كناية مضمرة في مجلة هي مجلة «شعر» التي صدرت في بيروت ابتداءً من عام 1957م، رغم أنه يتحدث في مواضع كثيرة من الكتاب عما يسميه: «حركة» أو «جماعة» لكن أية بدايات يقصد؟ أهي بدايات الحداثة كما جاء في الجزء الثاني من العنوان؟ أم أن البدايات المقصودة هي كناية مضمرة عن رحلة شاعر؟ أي بدايات أدونيس صحبة المدينة: بيروت، والمجلة: شعر؟ ولا سيما أن الكتاب يخصِّص أغلب فصوله لدراسة تجربة أدونيس، بل إن العنوان نفسه مقتبس من عبارة للأخير في كتابه «ها أنت أيها الوقت» الصادر عن دار الآداب عام 1993م: «بيروت منذ لامستْ قدمايَ ترابها، وبدأتُ أشردُ في شوارعها، شعرتُ أنها مدينة أخرى، ليست مدينة «النهايات» كدمشق، وإنما هي مدينة «البدايات» وليست مدينة اليقين، بل مدينة البحث». ومن هذه البداية ينطلق ليدرس تحولات وجوه وأقنعة «مهيار الدمشقي» في الشعر والفكر.
إذن البداية المقصودة هي: تزامن إقامة أدونيس في بيروت مع بداية نشاط أول مكتب «لمنظمة حرية الثقافة» في بيروت، وعودة يوسف الخال من الولايات المتحدة حيث كان يعمل في الأمم المتحدة في ظل أجواء من الفعل السياسي وأجواء الحرب الباردة.
لكن مكانة بيروت نفسها خضعتْ لتحوُّلات أدونيس، فبعدما أسهب في مدحها وتغنى بها طويلًا، وصفها لاحقًا بأنها مدينة «تجارة» وليست مدينة «حضارة» ومدينة «عمران» لا «إنسان» بمعنى أنها فقدت دورها الحداثي الحضاري الذي لعبته خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. وبرأيي أن ملاحظة هذا التحول الأدونيسي، الذي يربطه الكاتب بمقولة نيتشه: «الأفعى التي لا تستطيع أن تغير جلدها لا بُدّ أن تموت وكذلك العقول التي تمتنع عن تغيير آرائها لا يمكن أن تواصل التفكير» يشكل مفتاحًا أساسيًّا لقراءة الكتاب، فأدونيس الذي لم يطمئن إلى اكتمال قصائده، أعاد صياغتها صياغات متعددة، تنقيحًا وحذفًا وإضافة، قبل أن يستقرَّ على ما سمَّاه صياغة (نهائية) لعدد من دواوينه. وعمل «كريسويل» في الخلاصة، ليس كتابًا نقديًّا إجرائيًّا لشعر الحداثة فهو لا يدرس الحداثة من خلال تاريخ قصيدة النثر وفحص نصوصها بل من خلال وقائع (الما حول) فيركز على أجواء السجال وجذور الخلاف بين توجهات شعراء تلك الحقبة وفحص خلفياتهم الحزبية والمذهبية وأثرها في ذلك السجال.
ولو دقَّقنا عبرَ منظور البدايات هذا، فسيتحتم علينا إعادة فحص مواد العدد الأول من مجلة «شعر» لنرى إن كان ثمة مشروع حداثي للقصيدة العربية واضح المعالم، ويبدو أن الكاتب نفسه لم يجد في مواد العدد الأول ما يرسخ ذلك، فوضع بدلًا عنها صورة لفهرس العدد الثالث من المجلة. ففي عددها الأول نشرت «شعر» قصيدتين عموديتين لبدوي الجبل ورفيق المعلوف وأخرى عامية لميشيل طراد وقصيدةً من الشعر الحر لسعدي يوسف من بحر الكامل. وأخرى لأدونيس من بحر الرجز، ولبشر فارس موشحًا من وزنين، ولكل من نازك الملائكة وفدوى طوقان ونذير العظمة وفؤاد رفقة قصائد موزونة على المتقارب، وهي الأوزان التي أصبحت شائعة في قصيدة التفعيلة. فلا وجود لقصيدة النثر، إلا تلك القطعة النثرية للبير أديب التي لا يمكن أن توصف بأنها قصيدة نثر (لمجرد كونها غير موزونة).
أما مساهمة أنسي الحاج فبدأتْ من العدد الثاني، لكن ليس بقصيدة بل بمراجعة لديوان عبدالوهاب البياتي: «المجد للأطفال والزيتون»، حتى في ترجمة الشعر لم تتبنَّ المجلةُ شعرَ الحداثة الأوربي برؤية واضحة فثمة قصيدة مترجمة لـ«إيميلي ديكنسون» ولم تظهر قصيدة «إليوت» (أربعاء الرماد) إلا في العدد الثاني، بترجمة منير بشور. بينما خلا العدد من أي بيان أو رؤيا للحداثة أو لقصيدة النثر، مكتفيًا بترجمة مقال لـ«أرشيبلد ماكليش»، وهو ما يعني أن الجدل الذي أثارته «شعر» ولا تزال، يطغى على وجود تأثير حقيقي لها في القصيدة العربية الحديثة، وبهذا المعنى فهي محرِّض وليست مُعلِّمًا.
ومع هذا يزخر الكتاب بمسح دقيق وعدد من الوثائق والمراسلات تجعل منه محرضًا لإعادة قراءة التاريخ الآخر للحركة وعلاقتها بالصراعات السياسية في المنطقة المرتبطة أصلًا بتفاعلات الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي.
مقارنة واسعة
ولأن اختصاص الكاتب «الأدب المقارن» فقد هيمن هذا المنهج على مجمل فصول كتابه؛ إذ ثمة مقارنة واسعة بين الأدبين العربي والعالمي، الإنجليزي والفرنسي تحديدًا، وثمة مقارنة بين آراء أدونيس وتحولاته عبر العقود التي غَطَّتها الدراسة. ومن خلال هذا المنهج يتبنى فكرة أن قصيدة النثر العربية وُلدت في بيروت ومع «مجلة شعر» ومع أدونيس في بعض تجاربه التي تعود إلى عام 1958م، وأنسي الحاج في ديوانه «لن» عام 1960م، ويشير إلى الجدل الذي بدأته نازك الملائكة في كتابها قضايا الشعر المعاصر عام 1962م، وبيان أدونيس عن قصيدة النثر المنشور في عدد ربيع 1960م، وتأثره الواضح بكتاب سوزان برنار «قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا» بتبنيه لمصطلحاتها الأساسية مثل: «الوحدة العضوية» و«الإيجاز» و«الكثافة» و«البناء» كشأن مقدمة «لن» لأنسي الحاج التي تكاد تكون ترجمة بتصرف لمفهوم «برنار» عن قصيدة النثر الفرنسية.
لكن تاريخ قصيدة النثر غير المكتوب بدقة حتى الآن يقول: إن العراقي «حسين مردان» سبقهم جميعًا، فقد نشر ست كراريس شعرية تحت توصيف «النثر المركز» قبل أن ينشر أي من شعراء مجلة «شعر» قصيدة نثر، وقبل أن تظهر المجلة نفسها، ومن دون أن يطلع على المفهوم الفرنسي «لقصيدة النثر» فقد نظَّر لرؤيته حول الكتابة خارج الوزن في مقالات عدَّة نُشرت في الصحف العراقية خلال الخمسينيات، قبل ظهور أي سجال حقيقي حول شكل القصيدة ومشكلة الوزن في الشعر. كما أصدر توفيق صايغ «ثلاثون قصيدة» عام 1954م، أي قبل ظهور «لن» لأنسي الحاج و«حزن في ضوء القمر» لمحمد الماغوط، ولا أدري سبب تجاهل هذا الديوان من الكاتب رغم أن صايغ وجبرا إبراهيم جبرا من بين المشاركين في «مؤتمر روما» لكنهما سرعان ما انفصلا عن جماعة شعر، وأسَّسَ الأول مجلة حوار التي ثبت لاحقًا أنها ممولة كذلك من «منظمة حرية الثقافة»
بيد أن منهج المقارنة مع الشعر الغربي، والتلميح الواضح بأنَّ حداثة بيروت ومجلة «شعر» حداثة ترجمة لم يُتحْ له التوقف حتى عند تجربة الماغوط، فاستبعدها المؤلف من كتابه؛ لأنه «بسبب التركيز على تأثير الترجمة» لم يكن لديه الكثير ليقوله عن عمل الماغوط، كما أن كثيرًا من قصائد المجموعة «مكتوبة أو تدور في شوارع ومقاهي دمشق لا في بيروت!» رغم أنه يقرّ بأن «حزن في ضوء القمر» (1959م) سيكون ضروريَّا في أي دراسة شاملة لحداثة بيروت.
الحرب الباردة ومؤتمر روما
حين يحدِّد المؤلف مدة تاريخية معينة حيزًا لدراسته (1955- 1975م) فإن مثل هذه البرهة الزمنية لا يمكن عزلها عن الأحوال السياسية الداخلية والعالمية التي ألقت بظلالها على الخطاب الثقافي في تلك الحقبة من هنا يربط صعود بيروت عاصمة ثقافية وتحولها إلى مركز استقطاب للمثقفين بمعطيات عدة في الواقع العربي والعالمي، حيث نزح الآلاف من الفلسطينيين باتجاه لبنان في أعقاب النكبة عام 1948م، واستتبعتهم موجات لاحقة من المصريين والسوريين الهاربين من أنظمة جمال عبدالناصر والبعث. إضافة إلى أنَّ هوية بيروت نفسها تشبه فكرة الحداثة المترجمة، فقد جرى نقل نمط المدينة الأوربية أو ما سماه البياتي يومًا «مدن الضرورة» لا مدن الأصالة، إلى بيروت ففندق «فينيسيا إنتركونتيننتال» الذي دُشِّنَ عام 1961م، وهو أول نموذج في الشرق لمجموعات «فينسيا» مثَّلَ «أيقونة حداثية» وتزامن مع تكوين الصورة النمطية لبيروت بوصفها «باريس الشرق الأوسط» وميدانًا دوليًّا عصريًّا للسياح الأوربيين والعرب وكذلك لنخبة من الشركات والبنوك!

أنسي الحاج
في زخم هذه الأجواء يؤرخ الكاتب لنشاطات «منظمة حرية الثقافة» التي كانت قد افتتحت مكتبها ببيروت منذ عام 1954م، وبدأت بتمويل مجلات أدبية تصدر في بيروت: «شعر» و«أدب» ومن ثمَّ «حوار»، وفي عام 1960م بادر مكتب «منظمة حرية الثقافة» في باريس الذي كان يديره «جون هنت» الضابط بوكالة الاستخبارات المركزية وخريج جامعة «هارفارد» إلى عقد ورشة ثقافية في «روما» عُرفت باسم «مؤتمر روما» حيث دُعي له أدباء شيوعيون أوربيون انشقّوا عن الحزب الشيوعي ودوَّنوا شهاداتهم عن فشل التجربة الشيوعية في كتاب «الإله الذي فشل»: من بينهم الشاعر الإنجليزي «ستيفن سبندر» والروائي الإيطالي «إيغناسيو سيلوني» الذي ألقى كلمته الافتتاحية في مؤتمر روما معبِّرًا فيها عن (تمسكه بالاشتراكية مقابل تخلِّيه عن الافتتان بالسياسة البلشفية) إضافة إلى مثقفين عرب منشقين أو مطرودين من أحزابهم: يوسف الخال الذي يقول إنه طُرد من الحزب القومي السوري عام 1947م، وأدونيس الذي ترك العمل الحزبي عام 1958م، والسياب المتحول من الحزب الشيوعي إلى الميول القومية (وهو ما جعله هدفًا جذابًا للأميركيين على نحو خاص) وقبيل مؤتمر روما بقليل، منح الجائزة السنوية للمجلة – مع مكافأة مالية عن مجموعته «أنشودة المطر» وكان السياب نفسه قد نشر عام 1959م سلسلة مقالات بعنوان: «كنت شيوعيًّا» في جريدة الحرية العراقية (ذات التوجه القومي). فشنَّ السياب بورقته المقدَّمة للمؤتمر هجومًا على مفهوم الالتزام كما حدَّده الشيوعيُّون، منوهًا إلى أن الارتباط الشيوعي يَعني الإلزام بدلًا من «الالتزام» وكان القوميون آنذاك شأنهم شأن الشيوعيين قد تبنوا مفهوم «الالتزام» في الأدب من خلال تكييف دار «الآداب» لأفكار سارتر والفلسفة الوجودية بوصفها ملائمة للفكر القومي واليساري العربي، بينما نزعت جماعة «شعر» نحو الليبرالية الغربية من خلال مفهوم الحرية وهكذا: «كان الحداثيون على استعداد للتعاون مع الأجانب باسم الانفتاح الثقافي والحداثة»، وإذ يرى «كريسويل» أن «هذا لا يعني أنهم كانوا عملاء أميركان» كما اتهمتهم مجلة «الآداب» في افتتاحيتها بعد المؤتمر وربطت مؤتمرهم بالمحاولة الانقلابية في لبنان على حكومة فؤاد شهاب، فإنه يشير إلى مفارقة حقيقية في كون مثقفي «منظمة حرية الثقافة» الذين تقوم عقيدتهم على رفض الثقافة التي ترعاها الدولة، روّجوا بالمقابل للدعاية الرسمية الأميركية وقبضوا من الأموال الأميركية، إضافة إلى هذا الازدواج يشير إلى مفارقة أخرى كشف عنها المؤتمر تمثلت في تناقضات الخطاب بين المنظمين والضيوف، فكلمة أدونيس ويوسف الخال، عن «الحضارة الإنسانية» ورفض الانعزال الثقافي عن آداب الشعوب الأخرى اتُّهِمَتْ بالقطيعة وعدم الأصالة؛ لأنَّ «حداثتهم» «وتفاعلهم مع الحضارة الإنسانية» كانتا تنطويان في الواقع على خصومة مع تراثهم الثقافي، وهو ما دفع «سبندر» في ردِّه على حديث أدونيس إلى إبداء تحفظات على أفكار أدونيس (المتطرفة) عن الثورة ضد التقليد، مذكّرًا بأن (إليوت) نفسه حداثي وكلاسيكي في الوقت نفسه، وأنحى باللائمة على أدونيس لتجاهله التامّ لتراث الشعر العربي. ويعلق الكاتب بأن من المثير حقًّا «أن شاعرًا إنجليزيًّا لا يعرف الكثير عن الأدب العربي ينتقد أدونيس بسبب قطيعته مع تراثه!».
ولعلَّ هذا الانتقاد الذي ينطوي على تأنيب هو ما حرَّض أدونيس على تحوله اللاحق، بإعادته قراءة الشعر العربي برؤية جديدة، واكتشاف الحداثة في التراث العربي، بمختاراته التي بدأ بنشرها في «شعر» مع نماذج قصيرة من الشعر الجاهلي حتى اكتمالها في «ديوان الشعر العربي» ويلاحظ الكاتب استبعاد أدونيس في مختاراته لشعر المديح والهجاء، تحت ذريعة إنهما جزء من تاريخنا السياسي والاجتماعي، وليسا جزءًا من تاريخنا الشعري، وفي الواقع إن هذا الإقصاء يؤدي إلى شطب كل آثار الصراع السياسي على السلطة، وكل ما يرافقه من ثقافة وهو ما يهتمُّ به أدونيس عادة. كما ينطوي هذا الاستبعاد على تضاد مع مفهوم تقسيم فن الشعر لدى «أرسطو» كما قدَّمه ابن رشد وعرَّبه؛ إذ رأى أرسطو أن تصنيف الشعر يتحدَّد في غرضين: المأساة والملهاة: جانب تراجيدي وجانب فكاهي، وهو ما عبر عنه ابن رشد بالمديح والهجاء بوصفهما الغرضين الأساسيين اللذين تندرج تحتهما بقية أغراض الشعر، فشعر الغزل على سبيل المثال ضربٌ من المدح لأنه يُظهر جمال الحبيبة مثلما يُظهر المدح فضائل الممدوح، وكذلك الرثاء يقوم على مدح مناقب الفقيد، وكذا الحال حتى مع شعر الوصف لأنه يظهر جمال الطبيعة ويتغنى بها وكذا الهجاء فهو يتضمن مواقف سياسية إزاء السلطة والعالم وهو ما فعله أدونيس لاحقًا في هجاء المدن! كما أن «أبو تمام» وهو أحد أكثر الشعراء المفضَّلين لدى أدونيس يمثِّل المدح كثيرًا من شعره وكذلك المتنبي.
ترسَّخَ تحول أدونيس هذا نحو العروبة الثقافية، ابتداءً من منتصف الستينيات، ومع استقالته من «شعر» في عام 1963م. وما إن أصدر مجلة «مواقف» 1968م حتى بدأ انفصاله التامّ عن مجلة «شعر» وهو ما يتضح خاصة من خلال محور العدد الأول عن «الثورة» وتفاعله مع المثقفين العرب اليساريين «الملتزمين» وهو تحوُّلٌ جذريّ نحو التراث وإعادة قراءته من خلال التأويل الباطني وليس التفسير الظاهري، وبخاصة أدب المتصوفة الباطني، وتراث المعتزلة العقلي، فانحاز للمهمشين والحركات الاجتماعية الثورية (الزنج، والقرامطة)، فعثر على جذور الحداثة في التراث العربي، بمعنى إعادة انتقاء ما هو قادر على الحضور في الراهن من التراث، وبما يتلاءم مع روح العصر. أو ما يسميه أدونيس نفسه سعى إلى تشييد متحف للحداثة. وهكذا أعاد قراءة شعر أبي تمام، ذي المعاني المعقدة بوصفه «مالارميه العرب» وأبي نواس بخمرياته «بودلير العرب»، وصولًا إلى إحالة جذور السريالية الأوربية إلى التصوف الإسلامي، وهكذا لم يعد المرجع للحداثة أوربا أو الغرب بقدر ما هو روح «الحداثة» نفسها.
وبهذا المعنى فإن تجربة مجلة «شعر» لم تكن ولا يمكن أن تكون الهوية النهائية لأدونيس ولا المفتاح الأساسي لفهم شعره، بل هي مرحلة في تجربة زاخرة مليئة بالتناقضات والتحولات. كما يرصد المؤلف تحول وجهة نظر أدونيس تجاه الغرب منذ قصيدة «قبر من أجل نيويورك» 1971م، وهي بالمناسبة قصيدة (هجاء) للثقافة الغربية، وهجاء لمدينة تدَّعِي الحريةَ وتتباهى بها، بينما تقتل الأطفال والهنود، وهو الغرض الذي استبعدَه من مختاراته للشعر العربي. وهكذا فأدونيس الذي رأى خلال الخمسينيات أن الحضارة الغربية صِنْوٌ «للحداثة» يعود فلا يرى فيها إلا قرينًا للعدوانية والعنف ضد خصومها، وهنا تكمن «صدمة الحداثة» الحقيقية.
عن نَسَب الحداثة البيروتية: مرجعيات أدونيس والخال والحاج
حين أعلن أدونيس قيامة الحداثة من خلال الرفض في قصيدة «نوح الجديد» مؤكدًا أن العهد الجديد للكتابة لا يقوم على الماضي الذي ذهب مع الطوفان، كان لا يزال شغوفًا بأفكار أنطون سعادة، ذات النزعة التموزية في تجدد الخصب، وانبعاث طائر الفينيق من الرماد، وهو يتأمل في بحر الفينيقيين المفتوح، ثمَّ اطلع على تجربة «سان جون بيرس» وترجمته لـ«ضيقة هي المراكب» ووجد تجربته منسجمة مع فكرة البحر الفينيقي لكون بيروت مدينةً بحريةً فينيقيةً أساسًا، لكن المؤلف يلاحظ أن علاقة الحداثيين العرب مع البحر وعدم الاهتمام بالمدينة تتناقض مع أقرانهم الحداثيين الأوربيين والأميركيين الذين تعد المدينة منظارهم للحياة المعاصرة فرغم أن بيروت تُعدُّ مدينة مزدحمة خلال تلك الحقبة فإن الشعراء العرب (نادرًا ما انخرطوا في زحامها) فهي بالنسبة لهم ليست مدينة حقيقية بقدر ما هي مدينة غير مرئية. فيكتب أدونيس في قصيدة «ريشة الغراب»: «أعبر بيروتَ ولا أراها. أسكن بيروت ولا أراها».
ومثلما جمع أدونيس بين فكر أنطون سعادة وشعر بيرس، جمعت رؤيا يوسف الخال فينيقية بلاد الشام ومسيحية لبنان. بتأثره بأفكار «شارل مالك» الذي يصف لقاءه به بأنه نقطة التحول في حياته. وأفكار شارل مالك المناوئ للشيوعية تحمل ما يصفه المؤلف «مزيجًا غريبًا» من أفكار الليبرالية وحقوق الإنسان واللاهوت المسيحي، والعلاقات الدولية، وفلسفة الإنسان، سعى من خلالها إلى رسم إستراتيجية للسياسة الغربية في الشرق، المسرح الحيوي للحرب الباردة في تلك المنطقة، إذ دعا مالك الغرب لإعادة اكتشاف نفسه من خلال الشرق بوصفه الينبوع التاريخي للمسيحية. واصفًا هذه العودة إلى الشرق بأنها فعل «حب» أو معاناة من خلال تجديد الهوية. وقد ظهر تأثيره على شعر الخال في ديوانه الأول «الحرية» المكتوب في الأربعينيات في أثناء تلمذته على يد مالك حيث يصف لبنان: «يعربيّ الوجه غربيّ الخصال» أو في قصيدة «هذه الأرض لي»: «ما لشرقٍ لولا شفاعةُ لبنانَ خلاص ولا لغرب فداء» حتى إن تأثير مالك امتدَّ إلى ترجمات الخال وبينها ترجمته لكتاب: «خواطر عن أميركا» لجاك ماريتان فظهر تأثير أعمال «ماريتان» نفسه في تبني الخال لفكرة الشاعر كمسيحٍ معذَّب أو بطل فادٍ.

أدونيس
وإضافة إلى تأثيرات مالك الفكرية، ثمة تأثيرات شعرية لـ«عزرا باوند» الذي ترجم مختارات من أشعاره، فثلاثية «الدعاء» و«السفر» و«العودة» آخر قصائد «البئر المهجورة» بالذات يظهر فيها تأثر واضح بشعر باوند وتحديدًا في أناشيده «الكانتوس» في إعادة كتابة رحلة عوليس، اقتداء بملحمة هوميروس، وتكييفها داخل فينيقية جديدة مستلهمًا فكرة الإبحار الفينيقي وهو يحاول الشروع برحلة التحرر من الانتماءات الماضية، سواء كانت سياسية أم مذهبية أم سواهما.
وكما تبنى فكرة تأثير ترجمة أدونيس لشعر بيرس، وترجمة الخال لشعر «عزرا باوند» يمضي على هذا المنوال في التذكير بتأثير الشاعر والمسرحي الفرنسي «أنتونان أرتو» في شعر أنسي الحاج.
كان أنسي الحاج وهو في العشرينيات ساخطًا على مصير «أرتو» الذي ذهب ضحية السرطان، وسيغدو هذا السخط مصيره هو أيضًا! وكان تركيزه على «السرطان» أشبه بحدس مبكر ولا واعٍ للمصير الشخصي. لكن السرطان ليس وحده ما يجمع أنسي الحاج بـ«أرتو»؛ فقد أسهبت خالدة سعيد في مقاربة فكرة السرطان في شعر الحاج منذ وقت مبكر في دراستها التي نشرتها في مجلة شعر عن مجموعته «لن» وقرنتها بتأثير شعر «أرتو» في الحاج الذي بدأ مع ترجمته لإحدى عشرة قصيدة من شعر «أرتو» في «شعر» خريف عام 1960م مع دراسة لشعر أرتو المريض جسديًّا ونفسيًّا، والملعون والمدمن، والسوريالي المطرود أو المنشق، والمهلوس السائر في نومه. إضافة إلى مقدمة الحاج في ديوانه «لن» المتكئة بوضوح على كتاب سوزان برنار، فقد أسس شعر «أرتو» للمعجم الغريب لشعر الحاج المبكر، ومفاهيمه عن التجسيد والتعبير عنه.
ثم يقدم الكاتب دراسة لديوان «لن» متوقِّفًا عند قصيدتي «عفاف يباس» و«فقاعة الأصل» التي يترجمها كاملة في ملحق خاص ويحيل رمز «شارلوت» إلى الثقافة الفرنسية، والأيروسية المسيحية، أي الرغبة المشوبة بعقدة الذنب. مشيرًا لما فيها من غنوصية مسيحية. (إذا كان يوسف الخال شاعر صَلْبٍ وقيامة، فإن أنسي الحاج هو شاعر التجسد وهو ينتمي إلى الجسد).
خاتمة التحولات
في الخاتمة التي عنونها: «طهران 1979 – دمشق 2011» التي تتجاوز الحقبة التي خصص لها الدراسة 1955- 1975م، يمضي المؤلف بمنهج المقارنة ذاته بين موقف أدونيس بدعمه للثورة الإيرانية (وهي ثورة ذات طابع ديني) «بقصيدة» التي نشرت على الصفحة الأولى لجريدة السفير في 12 فبراير 1979م، وبين موقفه المناوئ لتأييد ما سمِّي «الربيع العربي» بشكل عام والتظاهرات في سوريا تحديدًا؛ لأنَّها (تظاهرات تخرج من المساجد) ويشير إلى السجال بينه وبين صادق جلال العظم، ويقارن بين موقف أدونيس هذا وموقف المفكر الفرنسي «ميشيل فوكو» الذي رأى في الثورة الإيرانية أنها «تضفي طابعًا روحانيًّا على السياسة».
وبينما فسر «فوكو» أحداث طهران بأنها «ثورة ضد الحداثة» رأى فيها أدونيس بداية للحداثة البديلة، لكنَّه بدا غير متيقِّن تمامًا في تحديد عناصر محددة لهذا البديل الحداثي، فبعد ستة أشهر وفي جريدة «السفير» نفسها التي نشرت «التحية» يوضح أدونيس أن تحيَّته تلك لم تكن قصيدة إنما «شهادة» وبالفعل لم يدرج تلك «القصيدة» في أي من دواوينه اللاحقة.
وفي ثلاثة مقالات لاحقة نشرت في «النهار العربي والدولي» بين عامي (1979- 1980م) أعاد أدونيس مراجعة موقفه من «الثورة الإيرانية» ليعبر في المقال الثالث عن خوفه من أن يحلَّ «الفقيه العسكري» محل الحاكم العسكري. وصولًا إلى صيف عام 2011م، عندما أعلن تخليه عن دعمه للثورة الإيرانية، حين كتب رسالة مفتوحة إلى المعارضة حول التغيير في سوريا قال فيها: «ماذا أفادت إيران من القضاء على نظام الشاه الاستبدادي، باسم الليبرالية، وإحلال نظام آخر محلّه، استبدادي هو أيضًا، لكن باسم الدين؟ الاستبداد باسم الدين، أشد خطرًا لأنه شامل: جسمي وروحي. ولعلنا أخطأنا جميعنا نحن الذين وقفنا إلى جانب الثورة الإيرانية ظنًّا منا أنها ستعمل من أجل الحريات حقًّا. لكن، كان هذا الظن، في المحصّلة، إثمًا» ليختتم «روكسويل» كتابه بعبارة تلخص سوء الفهم من جانب «الجمهور» حتى المثقفين لتحولات أدونيس: بالقول: إن «أولئك الذين خاب أملهم جراء موقف أدونيس بشأن سوريا، والذين صُدموا بتبرؤ «الحداثي الثوري من الانتفاضة» لأنهم لم يفهموا عن أي مفهوم للثورة وأي مفهوم للحداثة كان أدونيس يكتب منذ أكثر من نصف قرن».
