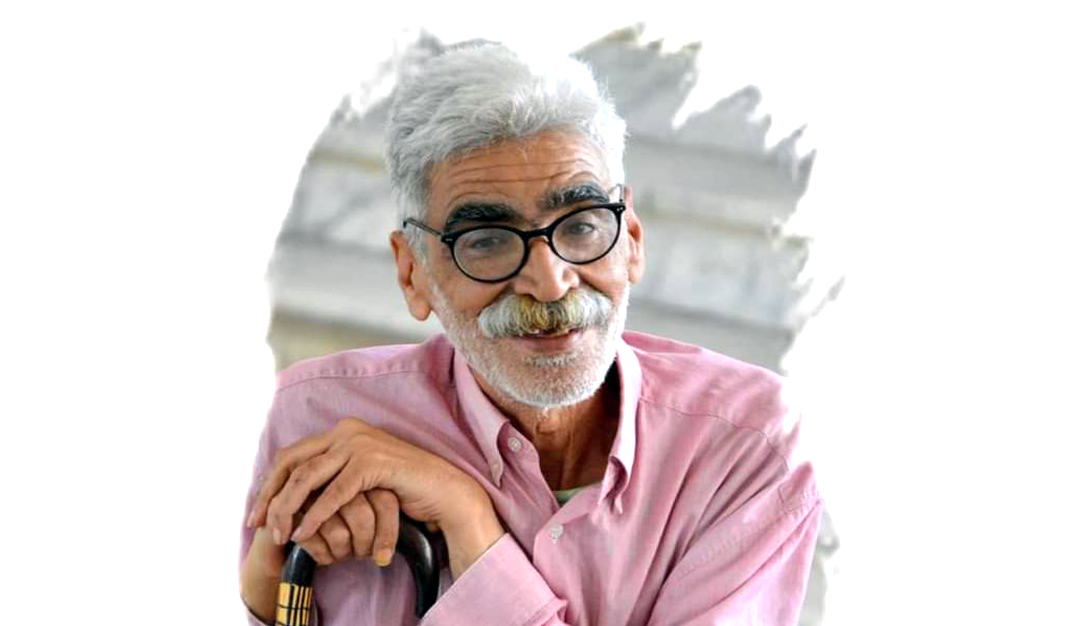
حسونة المصباحي - كاتب تونسي | مارس 1, 2024 | بورتريه
ظروف كثيرة، منها جائحة كورونا والمرض الذي فرض عليّ التردد على المصحّات على مدى أشهر طويلة، منعتني من زيارة صديقي القديم الشاعر والكاتب المسرحي بشير القهواجي، حتى الاتصال به هاتفيًّا. وكان ذلك يحزّ في نفسي كثيرًا لأن بشيرًا من أفضل أصدقائي، ومن أقربهم إلى نفسي، سواء على المستوى الروحي أو الأدبي.
تعود علاقتي ببشير إلى مطلع السبعينيات من القرن الماضي، أي إلى أيام الجامعة التي كانت تشهد في ذلك الوقت اضطرابات حامية يؤجّجها اليساريون. وقد تحمّس بشير في البداية إلى الأفكار اليسارية والتقدمية لكنه سرعان ما تخلى عنها، وغادر الجامعة حيث كان يدرس اللغة العربية وآدابها ليستقر في القيروان مسقط رأسه منصرفًا إلى القراءة والكتابة بعيدًا مما كان يُسمّيه «الصخب الأيديولوجي». وعلى الرغم من أن مواقفه كانت تثير غضب أهل اليسار بمختلف توجّهاتهم، فإن ذلك لم يكن يُخفف من تهجماته عليهم، ومن سخريته اللاذعة منهم. كان يقول: «هؤلاء -يعني اليساريين- يفلحون في الصراخ وابتكار الشعارات البراقة التي تفتن أصحاب العقول الصغيرة وتُهيّجُ الجهلة… لذلك ابتعدت عنهم لأني لا أريد ان أبدّد حياتي فيما لا يجدي ولا ينفع».
وفي تلك السنوات التي اختار فيها العزلة في القيروان، اكتسب بشير القهواجي ثقافة عالية ليصبح انطلاقًا من نهاية السبعينيات من القرن الماضي من أفضل كتّاب المسرح، ومن أشهر شعراء قصيدة النثر في تونس. والآن هو بصدد تجميع كل مؤلفاته آملًا أن تصدر أعماله الكاملة وهو على قيد الحياة.

حديث عن الشعر والترجمة
في منتصف الصيف الماضي كنت بصدد نقل قصيدة بديعة للشاعر الفرنسي بيار ريفاردي إلى اللغة العربية، وإذا ببشير يقفز فجأة إلى ذاكرتي. ولعل ذلك يعود إلى مطلع القصيدة الذي بدا لي وكأنه يُحيلُ إليه وهو متوحّد بنفسه في القيروان التي تشدّه إليها بقوة فلا يرغب في الابتعاد منها أبدًا. يقول المطلع: «حين تُمزّقُ الابتسامةُ الساطعة واجهات الديكور الهشّ للصباح، حين يكون الأفق لا يزال ممتلئًا بالنوم الذي يتأخر، والأحلام تتهامس في جداول الأسيجة. حين يَجْمَعُ الليل ثيابه الرثة التي تتدلّى من الأغصان الواطئة، أخرج، أهيئ نفسي، وأنا أشدّ شحوبًا وارتعاشًا من تلك الصفحة التي لم تُدوّن فيها بعد أية كلمة من كلمات المصير».
بعد أن أكملت الترجمة، هتفت له فجاءني صوته مُثقلًا بالحزن وبأوجاع المرض الطويل الذي أرهقه فبات عاجزًا عن التنقل حتى لو لمسافة قصيرة إلا مُستعينًا بعكاز. في نهاية المكالمة، طلب مني أن أزوره في أقرب وقت ممكن، فلبَّيتُ دعوته صباح يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر 2023م.
استقبلني في مدخل الزقاق الضيّق الذي يقع أمام مسجد الزيتونة الذي يُعَدُّ من أقدم ومن أجمل مساجد عاصمة الأغالبة. تعانقنا بحرارة يقتضيها فراق مديد، ثم صعدنا مدارج تنفتح على شقته الصغيرة التي عكست لي من أول نظرة عالمه الخاص، عالم الفنان الذي يكتفي بلوحات وكتب ليُخفف عن نفسه وطأة العزلة وآلام المرض. أعدّ لي وله قهوة، ثم جلسنا في الشرفة التي نرى من خلالها جزءًا من سطوح القيروان العتيقة، وبدأنا الحديث.

جيرار دو نرفال
أخبرته أنني بصدد العمل على ترجمة مختارات من الشعر الفرنسي تبدأ من جيرار دو نرفال، وتمتدّ إلى أشهر الشعراء الفرنسيين في النصف الأول من القرن العشرين، مُركزًا بالخصوص على شعراء لم يحظوا بترجمة جيدة وبتعريف وافٍ بهم في اللغة العربية مثل: بول كلوديل، وبيار ريفاردي، وماكس جاكوب، وروبير دسنوس، ولوي سكوتنار، وفرانسيس جيمس، وبليز ساندرار… وقلت له: إني فضّلت أن أترجم نصوصًا نثرية تتميز بشاعرية عالية لستيفان مالارميه عوض ترجمة قصائده الموغلة في الغموض، والمكبّلة بألاعيب لغوية خاصة باللغة الفرنسية بحيث تكون ترجمتها إلى لغتنا عقيمة وغير ذات منفعة… وافقني على ذلك مُضيفًا: «ما تقوم به عمل جيد… الغربلة مهمّة للغاية… ليس علينا أن نترجم كل شيء، بل لا بد أن نختار قصائد ونصوصًا لا تفقد قيمتها وروحها في لغتنا؛ بل تظل متلألئة بتلك الجمالية التي تتميز بها في لغتها الأم… الترجمات السيئة يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية للغاية على شعرنا، وعلى أدبنا، وعلى ثقافتنا بصفة عامة… ومؤخرًا عدت إلى مجلة «شعر» لأجد فيها بعض الترجمات الرديئة التي قد تكون فرّخت كثيرًا من الشعراء السيئين مشرقًا ومغربًا لنقرأ قصائد بلا روح وبلا معنى باسم الحداثة والتجديد… والآن هناك كثير من الترجمات التي تسيء كثيرًا للغة الأصلية وللغة العربية لكنها تكتسح المكتبات من دون حسيب ولا رقيب… بل بعض هذه الترجمات تحظى بجوائز رفيعة… وهذا ما يرقى إلى مستوى الجريمة… لذلك أنا أحذر كثيرًا من الترجمات العربية الرائجة الآن، وأحرص على أن أقرأ النصوص والكتب في ترجمات فرنسية لأنها مُحترمة في غالب الأحيان».
مدينة بلا قلب

أحمد عبدالمعطي حجازي
صمت بشير قليلًا، ثم أضاف: «بالنسبة للشعر العربي الذي جاءت به حركة الحداثة انطلاقًا من منتصف القرن الماضي، أرى أنه من الضروري أن تكون هناك غربلة نقدية صارمة لكل التجارب التي حدثت لكي نميز ما هو جدير بأن ينتمي حقًّا إلى الشعر، ونهمل البقية حتى لا تجد الأجيال القادمة نفسها أمام ركام هائل يختلط فيه «الغثّ بالسمين» كما يقال في اللغة القديمة. وعملية الغربلة لا يمكن أن يقوم بها إلا نقاد كبار عارفون بخفايا الشعر والكتابة بصفة عامة. وهؤلاء غير متوافرين في الزمن الراهن الذي تحضر فيه بقوة المجاملات التي ترفع من قيمة شعراء نصف موهوبين أو بلا موهبة أصلًا ليكونوا في الواجهة، بينما يظل الشعراء الحقيقيون في عتمة الإهمال والإقصاء… وشخصيًّا أميل إلى بدايات من يُسمّون بـ«الشعراء الرواد»… مثلًا أنا أفضّل ديوان «مدينة بلا قلب» لأحمد عبدالمعطي حجازي على كل دواوينه اللاحقة. وأعُدّ قصيدة «مدينة بلا قلب» من أروع القصائد في الشعر العربي الحديث. وفي إحدى زياراته إلى تونس، قدّم لي الشاعر العراقي الراحل سعدي يوسف مجموعة من المخطوطات طالبًا مني أن أختار منها ما يمكن أن يصلح لمختارات شعرية تصدر عن دار تونسية. وقد قبلت هذا الطلب بكثير من السعادة؛ لأن سعدي يوسف من أحبّ الشعراء إليّ. لكن بعد تمحيص طويل، تبين لي أن «الأخضر بن يوسف ومشاغله» هو أفضل ما أبدع سعدي يوسف، وأن القصيدة التي هي عنوان الديوان: «الأخضر بن يوسف ومشاغله» هي من أروع قصائده… حتى هنا في تونس، أنا أفضّل قصائد المنصف الوهايبي في سنوات شبابه بالجامعة، على كل ما كتب من قصائد في العقود الماضية… والغريب في الأمر أنه لا يعترف بهذه القصائد، ويَعُدُّها دون قامته الشعرية الراهنة… إذن قضية الغربلة مُهمّة للغاية خصوصًا في الزمن الراهن؛ إذ إنه من دونها لن يكون بإمكاننا أن نؤسس لمرحلة شعرية وثقافية جديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة… ومخطؤون أولئك الذين يتوهّمُون أن تأسيس المرحلة المذكورة يمكن أن يحدث من خلال ركام جديد من القصائد ومن الدواوين باسم المزيد من الحداثة والتجديد».
تجارب شعرية من جيل السبعينيات
سألته عن جيلنا، جيل السبعينيات، ففكر قليلًا مادًّا بصره باتجاه السطوح البيضاء، ثم قال: «خالد النجار شخص صعب ومتقلب المزاج ولا يُحتمل أحيانًا، لذلك أقول دائمًا: إن شعره أكبر منه… هناك قصائد لخالد النجار هي من أفضل ما كتب في الشعر العربي، وليس في الشعر التونسي وحده، منذ السبعينيات حتى هذه الساعة… وعند خالد النجار نصوص نثرية راقية جدًّا… لكن شخصيته المضطربة ومعاركه المجانية ضد الآخرين، حجبت تجربته الشعرية عن أحباء الشعر، وعن المتذوقين لموسيقاه الداخلية الرفيعة… هناك تجربة شعرية أخرى مهمة، أعني بذلك تجربة علي اللواتي التي هي فريدة من نوعها بحسب رأيي؛ إذ إن عليًّا نضج وحيدًا بعيدًا من كل التيارات الشعرية، سواء في تونس أم في العالم العربي. وهو عرف كيف يستفيد من التراث القديم من دون أن يصبح سجينًا له ولبلاغته وإيقاعاته. كما أنه استفاد من الشعر الفرنسي، ومن الشعر العالمي، خصوصًا الأنغلوسكسوني من دون أن يسقط في التقليد والمحاكاة.

خالد النجار
إضافة إلى كل هذا، هو متذوق بارع للفنون التشكيلية، ومُنفتح على فنون أخرى مثل السينما، والدراما التلفزيونية. وجميع المسلسلات التي أنجزها للقناة الوطنية التونسية كانت من أنجح المسلسلات، خصوصًا على مستوى اللغة والحبكة الدرامية. وما هو مثير للإعجاب في شخصية علي اللواتي هو أنه منجذب إلى كل ما هو جميل سواء في النثر أم في الشعر أم في مختلف الفنون الأخرى. وهو متوافق مع ذاته فلا يُزعجه أبدًا أن ينعته بعضٌ بـ«المحافظ» أو بـ«الرجعي»… الآخرون، وأعني بذلك أبناء جيلي أساسًا، لا يعيشون الشعر، بل يكتبونه انطلاقًا من وضعهم الوجودي البائس، ومن خوائهم الروحي والمعرفي ومن البلاغة الرنانة، وليس انطلاقًا من تجارب حياتية وروحية عميقة ومريرة… ومرة كنت مع واحد من هؤلاء في طهران… قرأت أنا بصوت خافت قصائد قصيرة جدًّا كتبتها من وحي جولاتي الليلية بالخصوص هنا في القيروان… وقرأ هو قصائد من وحي القيروان أيضًا لكنها كانت طويلة وثقيلة في لغتها، وفي معانيها. فعل ذلك بصوت عالٍ أزعج الحاضرين مُتوهمًا أن القراءة بصوت جهوري قد تجلب له الانتباه… وفي النهاية أحاط بي الجمهور الذي كانت تغصّ به القاعة ليطرح عليّ أسئلة كثيرة… أما هو فلم يعبأ به أحد… ومؤخرًا جمعتني قراءة شعرية بالمنصف الوهايبي هنا في القيروان… وقد تبين لي أنه ظل سجين الرنين البلاغي بحيث تكون قصيدته في النهاية مجرد لغو، وصدى لتراث شعري قديم مدفون في الكتب الصفراء…».
الثقافة في تونس بين الماضي والحاضر
وعن الوضع الثقافي في تونس راهنًا، قال بشير القهواجي: «الثقافة التونسية الرسمية، ولا أعني ثقافة الهامش، عرفت ثلاث مراحل مُهمّة: مرحلة التأسيس مع الراحل الشاذلي القليبي الذي كان له الفضل في بعث مهرجان قرطاج السينمائي والفني، وفي دعم الفرق المسرحية الجديدة التي ظهرت بعد الاستقلال، وفي نشر الثقافة في جميع مناطق البلاد عبر ما أصبح يُسمّى بدور الثقافة وبدور الشباب. المرحلة الثانية، مرحلة السبعينيات كانت مرحلة مهمة أيضًا؛ إذ إن وزير الثقافة آنذاك كان الكاتب الكبير محمود المسعدي الذي أسس مجلة «الحياة الثقافية»، التي لا تزال تحتضن إلى حد الآن كل تعابير الثقافة الوطنية. أما المرحلة الثالثة فكانت مع الراحل الآخر الكاتب البشير بن سلامة الذي اهتم بأوضاع المثقفين والفنانين العصاميين، وخصّص لهم رواتب دائمة، وأعاد الاعتبار لصورة المثقف والكاتب في زمن بدأت هذه الصورة تتهشم وتتفتت. وفي عهد ابن علي، رُفِعَت ميزانية وزارة الثقافة ليستفيد منها المقربون من النظام ومن المؤسسات الرسمية خاصة. وفي العقد الأخير، هُمّشت الثقافة وخُفِّضت ميزانية وزارة الثقافة لصالح وزارة الشؤون الدينية؛ ليكون المثقفون من أكبر ضحايا الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا راهنًا؛ لذلك استفحلت الرداءة بشكل لم يسبق له مثيل. مع ذلك أنا متفائل لأن تونس تزخر بطاقات كبيرة في جميع المجالات المعرفية والثقافية والفنية… وأنا على يقين من أن نهاية هذه المرحلة الرمادية
باتت وشيكة…».

زمن الصداقات انتهى
سألته عن وضعه… هل يزوره شعراء القيروان؟ ابتسم بمرارة، وأجاب: «لم يزرني أيّ أحد منهم، فكما لو أنهم لم يعرفوني ولم أعرفهم… والحقيقة أني لست في حاجة إلى عطفهم. زمن الصداقات والعلاقات المزيفة والمغشوشة انتهى… ما يعنيني هو عالمي الخاص… وهو كما ترى عالم بسيط، وفي ظاهره فقير لكنه في جوهره غنيّ بالروحانيات وبالشعر وبالفن وبأشياء بديعة أخرى… صحيح أن المرض أنهكني لكني أرفض أن يشفق بحالي أناس قلوبهم من حجر، ونفوسهم عفّنها البحث عن الشهرة والثروة…».
نظر إلى شجرة ياسمين صغيرة في وعاء، وقال: «تكفيني هذه لكي أكون سعيدًا… وكم أتمنى أن تكون لي نباتات وأزهار داخل الشقة وخارجها، لكنها تحتاج لمن يعتني بها حتى لا تذبل وتموت… وهذا ما لا أستطيع القيام به للأسف الشديد…».
لكن من يعتني بك؟ أجاب: «عندي ابنة أختي تعدّ شهادة دكتوراه تأتي مرتين أو أكثر في الأسبوع لتنظيف الشقة، وتطبخ لي بعض الأطباق التي أشتهيها… وأنا أحبها كثيرًا لأن لها ملامح أمي التي كانت امرأة جميلة لكنها لم تكن تهتم بنفسها، بل لعلها لم تكن واعية بجمالها؛ لأن ما كان يعنيها بالدرجة الأولى هو الاعتناء بأولادها وبناتها… وفي لحظة توديعها وهي تحتضر، انحنيت لتقبيل جبينها فأبهرني جمالها الذي لم يذبل حتى في اللحظات الأخيرة من حياتها…».
في نهاية اللقاء، رافقني بشير إلى الشارع لنأخذ صورًا… وعند توديعه قال لي: «المرة القادمة تعال ومعك شمعة نضيئها بيننا ليكون حوارنا أكثر متعة وعمقًا…».

حسونة المصباحي - كاتب تونسي | مايو 1, 2022 | بواكير الحداثة العربية
بعد انهيار نظام ابن علي، في الرابع عشر من شهر يناير 2011م، كثر اللغط والحديث في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وأيضًا في المنابر والندوات والملتقيات الثقافية، عن أوضاع الثقافة التونسية، وعن إمكانيات تجديدها، وتخليصها من أزمات، ومن شوائب عانتها في حقبتَيْ نظام بورقيبة، ونظام ابن علي. ولم يتردد أولئك الذين رحّبوا بـ«ثورة الكرامة والحرية» في القول: إن تونس عاشت في الحقبتين المذكورتين «تصحّرًا ثقافيًّا مريعًا»؛ لذا لا بد من العمل على إعادة الاعتبار للثقافة والمثقفين بهدف انبعاث «ثورة ثقافية» بالمعنى الحقيقي للكلمة تقوم على تشجيع الطاقات الإبداعية والفنية التي كانت مُجمّدة ومقصيّة ومهمّشة، على النشاط والخلق والابتكار في ظل «الديمقراطية الجديدة» التي جاءت بها الانتفاضات الشعبية التي أطاحت بنظام ابن علي.

أبو القاسم الشابي
والحقيقة أن تونس لم تعش «تصحّرًا ثقافيًّا» لا في عهد بورقيبة، ولا في عهد ابن علي، ولا في الحقبة الاستعمارية، بل عاشت ظروفًا أخرى سوف نحاول أن نشير ولو باختصار إلى أهمها. وما يعكسه التاريخ التونسي منذ بداية القرن العشرين، إن لم يكن قبل ذلك بنحو نصف قرن، وهو أن الحقب الثقافية المضيئة كانت مرتبطة دائمًا وأبدًا بالصراع بين القديم والجديد. ففي عام 1904م مثلًا، وبفضل تأثيرات الحركات الإصلاحية التي كانت مُشعّة آنذاك في العديد من البلدان العربية والإسلامية، أصدر الشيخ عبدالعزيز الثعالبي (1876-1944م) كتابه الشهير: «روح التحرر في القرآن»، مُطلقًا من خلاله أطروحات وأفكارًا جريئة لم يسبق لها مثيل، وتطرَّق إلى قضايا ساخنة مثل الحجاب، والتسامح الديني، والعلاقة بين الأديان، والعلاقة بين الشرق والغرب، وفصل الدين عن الدولة، وغير ذلك من القضايا التي لا تزال تشغل العرب والمسلمين إلى حد هذه الساعة. وما نستخلصه من كتاب الشيخ عبدالعزيز الثعالبي هو أنه دعا إلى ضرورة جعل القرآن «دستورًا» للدفاع عن التحرر، والتقدم والرقي، مُهيبًا بالعلماء المسلمين أن يجتهدوا من أجل تنوير العقول، وتحرير مجتمعاتهم من قيود الماضي للخروج بها من عصور الانحطاط والجهل والتخلف والقهر.
وقد أثار كتاب: «روح التحرر في القرآن» جدلًا ساخنًا في أوساط النخبة التونسية بجميع فصائلها وتياراتها. وكان من الطبيعي أن يجد الفصيل المتطلع إلى الإصلاح والتحديث في الكتاب ما يدعم مواقفه وطموحاته وآماله. أما الأوساط الرجعية والمحافظة فقد شنّت على صاحبه حملة عنيفة، مُتّهمة إيّاه بـ«الكفر والإلحاد»، و«الدوس على الإسلام ومقوماته». وعلى الرغم من ذلك، رفض الشيخ الثعالبي التراجع عن أفكاره، مواجهًا الحملة المضادة له بشجاعته المعهودة التي تحلى بها طوال مسيرته النضالية المديدة.
تحولات ما بعد الحرب
بعد الحرب الكونية الثانية، تجددت المعركة بين المناصرين لحركة التقدم والتحديث، وبين الرافضين والمُعادين لها لتشمل في هذه المرة مجالات أخرى غير مجال الدين والفقه، وما يتصل بهما؛ إذ برزت للوجود أجيال شابة طموحة، ومُتعطشة للمعارف الحديثة العاكسة لحضارة العصر. ومنذ البداية كان واضحًا أن تلك الأجيال تطمح إلى التسلح بأدوات معرفية غربية لمواجهة تحولات وأوضاع مجتمعها. ومع مطلع الثلاثينيات، برز للوجود تيار فكري جديد، أعني بذلك الفكر الاجتماعي مُتجسدًا خاصة في كتاب «امرأتنا في الشريعة وفي المجتمع».
وعلى الرغم من أن الطاهر الحداد، صاحب ذلك الكتاب، كان من طلبة الجامعة الزيتونية، معقل الشيوخ المحافظين، فإنه انجذب مبكرًا إلى الحركة الإصلاحية، وناصرها بقوة مناديًا بضرورة تحرير المرأة من القيود الاجتماعية والنفسية التي تكبلها لتكون مساهمة مع الرجل في بناء المجتمع الجديد. كما أنه تأثر بأفكار ابن الجنوب، محمد علي الحامي الذي عاد من برلين في عام 1924م، ليشرع في تأسيس أول نواة لنقابات عمالية تونسية، مستقلة عن النقابات الفرنسية. ومعه طاف في مناطق مختلفة من البلاد ليكتب تحقيقات ميدانية عن أوضاع العمال لتصدر فيما بعد في كتابه الذي حمل عنوان: «العمال التونسيون». وكان لصدور كتاب: «امرأتنا في الشريعة وفي المجتمع» وقع كبير في أوساط النخبة التونسية، عكسته الهجمات الشرسة التي تعرض لها من جانب شيوخ الجامعة الزيتونية الذين لم يترددوا في هذه المرة أيضًا في نعت مؤلفه بـ«الكافر»، و«الملحد». بل إنهم حرضوا العامة لتعنيفه في الأسواق، وفي الشوارع.

الطاهر حداد
إلى جانب الفكر الاجتماعي، برزت تيارات جديدة في المجال الأدبي يدعو أتباعها إلى التجديد، وإلى الثورة على القديم. وكان أبو القاسم الشابي (1909-1934م) أول من انتقل بالشعر التونسي الذي كان يعاني حتى ذلك الوقت الابتذالَ والسطحيةَ والركاكةَ، إلى الحداثة شكلًا ومضمونًا. وعلى الرغم من أنه كان «يطير بجناح واحد» كما كان يحب أن يقول تعبيرًا عن عدم حذقه للغة الفرنسية، فإنه تمكّن بفضل صديقه محمد الحليوي من الإلمام بجوانب مهمة من الشعر الأوربي، وبخاصة الرومانسية. إلى جانب ذلك تأثر بشعراء المهجر، وبخاصة جبران خليل جبران. وهذا ما يعكسه ديوانه اليتيم: «أغاني الحياة». وقد تلقت الأوساط الأدبية المحافظة ذلك الديوان، وأيضًا كتاب الشابي النقدي: «الخيال الشعري عند العرب»، كما لو أنهما صفعة قوية، ودعوة للتمرد عليها، وعلى مناهجها، وعلى مفاهيمها للأدب والحياة؛ لذلك تصدّت للشابي بعنف مثلما فعلت مع الطاهر الحداد لتجبره على «الهجرة» بقصائده إلى مجلة «أبولو» المصرية.
وفي تلك المرحلة الغنية بمختلف التجارب، أي مدة ما بين الحربين، لمع في المشهد الثقافي التونسي تيار أدبي تمثّل فيمن أصبحوا يُسمّون بـ«جماعة تحت السور». و«تحت السور» هو اسم المقهى الذي كانت ترتاده تلك الجماعة في حي «باب سويقة» بمدينة تونس العتيقة. وجميع أعضائها ينتمون إلى عائلات فقيرة، أو متوسطة الحال، كما أنهم انقطعوا مبكرًا عن الدراسة «قبل أن تُبْلى سراويلهم» بحسب عبارة «عرّابهم» علي الدوعاجي. وبفضل اللغة الفرنسية، تعرفوا إلى آداب أوربا الحديثة، وتأثروا بكتاب وشعراء من أمثال غي دو موباسان، وتشيكوف، وفلوببر، وبودلير، وفيكتور هوغو، وغوغول… وقد كان لتلك الجماعة التي كانت تعيش حياة «بوهيمية» – والمتمثلة على نحو خاص في «الثنائي الرهيب» علي الدوعاجي ومحمد العريبي- دور في تحديث القصة والشعر والأزجال، وبعض الصحف اعتنت بالدفاع عن الثقافة الجديدة المناهضة للتزمت والرجعية.
تحرير اللغة والشعر
تزامنًا مع ظهور جماعة «تحت السور»، برز في المشهد الثقافي التونسي، محمود المسعدي (1911-2005م) الذي حقق حضورًا قويًّا بفضل عملين مُهمّين هما: «السد»، و«حدث أبو هريرة قال…». وكان المسعدي قد عاد من باريس حيث كان يَدرُسُ في جامعة «السوربون» مُحمّلًا بأفكار جديدة تولّدت عنده بعد قراءته أعمال الكبار من الغربيين في مجال الرواية، والفلسفة، والشعر، أمثال: شوبنهاور، ونيتشه، ومالرو، وغيرهم. والجديد الذي أتى به المسعدي هو الأدب الذي يقوم على التأملات الذهنية والفلسفية، وعلى التجريد. وخلافًا لجماعة «تحت السور» الذين بسّطُوا اللغة لتكون قريبة من اللغة الشعبية اليومية، وحرروها من البلاغة الثقيلة، عَمَدَ المسعدي إلى إعادة الإشراق للغة العربية القديمة مثلما كان حالها عند الجاحظ، والتوحيدي، وأبي الفرج الأصفهاني، وعبدالله بن المقفع، ومحيي الدين بن عربي.

محمود المسعدي
وبقدر ما كان كلاسيكيًّا في لغته، كان المسعدي حداثيًّا في أفكاره، وفي مفهومه للأدب والحياة. ففي «السد» مثلًا هو يتطرق إلى طموح الإنسان إلى تحدي ما يبدو له مستحيلًا. وهي قضية انشغل بها الوجوديون في الفلسفة وفي الأدب. وأما في «حدث أبو هريرة قال» فقد طرح مسألة شائكة ومعقدة تتعلق بحيرة العربي المسلم في زمن يبدو فيها مقصيًّا ومهمشًا كما لو أنه يعيش في زمن غير زمنه.
بعد حصول تونس على استقلالها عام 1956م، شهدت الثقافة التونسية انتعاشة كبيرة. فقد برز جيل جديد من الشعراء والكتاب يطمح إلى آفاق جديدة في الكتابة شكلًا ومضمونًا. وجُلّ أبناء هذا الجيل كانوا متأثرين بالتيارات الحداثية في فرنسا، وبالعالم الغربي عمومًا مثل الوجودية، والسوريالية، والرواية الجديدة وغيرها… ولم تكن الواقعية الاشتراكية غائبة عن تلك التأثيرات خصوصًا في مجال الشعر حيث برزت في المشهد موجة جديدة سماها أصحابها: «في غير العمودي والحر». وقد انشغل شعراء تلك الموجة بالدفاع في قصائدهم التي تكثر فيها تعابير اللغة الشعبية لدى الكادحين وبسطاء الناس. وفي البداية تعامل نظام بورقيبة من تلك التيارات الجديدة بكثير من التسامح، فاتحًا لها صحفه ومجلاته الرسمية. إلا أن الانتفاضة الطلابية التي اندلعت خلال حرب 1967م، دفعت النظام إلى التراجع، فبادر بغلق المنابر والصحف والمجلات أمام الرافضين
لسياسته ولتوجهاته واختياراته…
مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، عاشت تونس انتعاشة ثقافية جديدة أذابت بسرعة جليد عقد السبعينيات الذي تميز بكثرة المحاكمات السياسية خصوصًا ضد اليساريين والنقابيين، وباشتداد الرقابة على الفنون والآداب. ولعل ذلك يعود إلى ما سماه بعضٌ بـ«ربيع الديمقراطية» حيث قرر نظام بورقيبة، بعد أحداث مدينة قفصة الدامية في أول عام 1980م، تعديل سياسته والجنوح إلى المصالحة الوطنية؛ بهدف التخفيف من حدة الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي كانت تعيشه البلاد آنذاك؛ لذلك سمح لبعضٍ من حركات المعارضة المعتدلة بالنشاط وبالحركة، وبإصدار صحف ومجلات.
كما أطلق سراح العشرات من النقابيين واليساريين. وبذلك استعادت الحركة الثقافية حيويتها فتعددت الأصوات في جميع مجالات الفن والأدب. وكانت مسرحية «غسالة النوادر» (أي أمطار بداية الخريف)، لفرقة المسرح الجديد، من بين أهم الأحداث الثقافية والفنية التي عاشتها تونس في تلك المدة؛ إذ إنها جاءت بديعة في إخراجها، وفي أداء ممثليها، وفي مضمونها الذي ارتكز على نقد التطرف اليساري في عقد السبعينيات.
لذلك كانت تلك المسرحية بمنزلة الغيث النافع الذي أعقب جدبًا ثقافيًّا طويلًا. وأما الحدث الثقافي الآخر فقد تمثل في العرض الافتتاحي لمهرجان قرطاج في صيف العام المذكور آنفًا. ففي ذلك العرض الرائع اكتشف التونسيون، وبخاصة سكان المدن الكبيرة، ثراء الفنون الشعبية، وجمال الموسيقا الفولكلورية في مختلف مناطق البلاد.
وبفضل الشعراء والكتاب والنقاد الجدد الذين برزوا في تلك المدة، تمكنت الثقافة المضادة من أن تفرض نفسها، مُجبرة الثقافة الرسمية التي كانت مُهيمنة في عقد السبعينيات على الانكفاء والتراجع. وفي هذه المرة، سيغضّ نظام بورقيبة الطرف عن تلك الثقافة الصاعدة بقوة، إلا أن حركة «الاتجاه الإسلامي» التي ستصبح فيما بعد حركة «النهضة» الإسلامية، ستحاول في العديد من المرات، التصدي لها بعنف، وبالتهديد والوعيد، كما فعلت مع عدد من الكتاب والشعراء الذين كانوا ينتقدون التزمت الديني، والأفكار الظلامية. وكان الاتجاه الإسلامي يُصدر في بياناته، ومنشوراته الناطقة باسمه، مقالات تندد بالتوجهات «الغربية» في الثقافة التونسية، وتنعت كبار الفلاسفة والمفكرين الغربيين بأقبح النعوت.
الحلم وإكراهات الواقع
منذ التسعينيات من القرن الماضي حتى سقوطه المدوي في التاريخ المذكور آنفًا، وفّر نظام ابن علي للثقافة الرسمية كل الوسائل الممكنة، المادية منها والمعنوية، بهدف التصدي للثقافة المضادة في جل تعابيرها، إلا أنه فشل في ذلك فشلًا ذريعًا؛ إذ ظلت تلك الثقافة تقاوم بجرأة وحماسة كل العراقيل والعقبات للمحافظة على وجودها واستقلاليتها وحريتها. كما ظلت محافظة على قوتها في التعبير عن تحولات المجتمع، وعن تطوراته. وهذا ما انعكس في العديد من الأعمال الشعرية، والقصصية والروائية والفنية سواء كانت في المسرح، أم في السينما، أم في الموسيقا، أم في غيرها من التعابير. أما الثقافة الرسمية فقد ظلت منكمشة على نفسها، جامدة كعادتها، وسجينة المكاتب الرمادية…
وكان المثقفون التونسيون بمختلف توجهاتهم ومشاربهم يتطلعون إلى مستقبل مشرق بالإبداع الأدبي والفني بعد انهيار نظام ابن علي، إلا أن الواقع سرعان ما خيّب آمالهم وأحلامهم وأمانيهم العريضة. فقد أظهرت حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي، التي اكتسحت المشهد السياسي منذ البداية، عداءها القديم للمثقفين والفنانين والمفكرين الرافضين لأطروحاتها، وتوجهاتها. وبتحريض علني منها، قامت جماعات متطرفة بالهجوم على قاعات السينما في العاصمة، وبالاعتداء على مثقفين وفنانين ومبدعين في العديد من الفضاءات الثقافية والفنية في مختلف مناطق البلاد. ولم تسلم الجامعات والمدارس من تلك الهجمات، ومن تلك الاعتداءات.
 ولم يتردد المنصف بن سالم، وهو أحد كبار قادة حركة النهضة في إظهار كراهيته لرموز النخبة التونسية الذين صنعوا مجد الثقافة التونسية في مراحل مختلفة من التاريخ المعاصر، مطالبًا بحذف نصوصهم من البرامج المدرسية، وناعتًا جماعة «تحت السور» بـ«الكحوليين المارقين عن الدين». وقد استغلت الحركات السلفية المتطرفة هيمنة حركة النهضة على المشهد السياسي في المدة الفاصلة بين 2011 و2014م لكي يُجاهر قادتها وأنصارها بعدائهم المطلق لمختلف التعابير الأدبية والفنية. وفي غياب كامل للردع، ولغياب القوانين، دأب هؤلاء على مدى ثلاث سنوات على التهجم اللفظي والمادي على الفنانين، والمثقفين.
ولم يتردد المنصف بن سالم، وهو أحد كبار قادة حركة النهضة في إظهار كراهيته لرموز النخبة التونسية الذين صنعوا مجد الثقافة التونسية في مراحل مختلفة من التاريخ المعاصر، مطالبًا بحذف نصوصهم من البرامج المدرسية، وناعتًا جماعة «تحت السور» بـ«الكحوليين المارقين عن الدين». وقد استغلت الحركات السلفية المتطرفة هيمنة حركة النهضة على المشهد السياسي في المدة الفاصلة بين 2011 و2014م لكي يُجاهر قادتها وأنصارها بعدائهم المطلق لمختلف التعابير الأدبية والفنية. وفي غياب كامل للردع، ولغياب القوانين، دأب هؤلاء على مدى ثلاث سنوات على التهجم اللفظي والمادي على الفنانين، والمثقفين.
كما أنهم عطّلوا ندوات فكرية، ومنعوا نشاطات ومهرجانات فنية. وفي العديد من الجامعات استعملوا الأسلحة البيضاء والهراوات لترهيب الأساتذة والطلبة. ولم تتوقف حركة النهضة عند تلك الحدود، بل استغلت إشرافها على أول حكومة بعد انتخابات خريف 2011م؛ لكي تخفض ميزانيةَ وزارة الثقافة ليجد العديد من الفنانين والكتاب والشعراء أنفسهم بلا مورد رزق. وفي السنوات الماضية، توفي بعضهم جراء الإهمال والإذلال وعدم القدرة على شراء الدواء. كما توقفت فرق فنية ومسرحية عن العمل، وحُرم مخرجون سينمائيون من إنجاز أفلام كانوا يحلمون بها. وعالمة أنها بلا فنانين وبلا كتّاب وبلا مفكرين وبلا شعراء، سعت حركة النهضة حال هيمنتها على المشهد السياسي إلى «شراء ذمم» بعض أشباه المثقفين والفنانين الذين غالبًا ما يكونون قادرين على «تغيير جلودهم» بحسب الظروف والمصالح.
وعلى الرغم من أنها نجحت في ذلك نسبيًّا، فإنها لم تتمكن من تنفيذ مخططها الرهيب المناهض لكل شكل من أشكال الثقافة الحرة، والتفكير الحر. وفي السنوات القليلة الماضية، اشتدت المعارضة الثقافية والفنية لحركة النهضة لتنعكس في العديد من الأعمال الروائية والقصصية والشعرية، مانحة «ثقافة الحياة» قدرات وأساليب فنية وأدبية لمواجهة «ثقافة الموت» التي تمثلها النهضة.
مافيات ثقافية
ثمة ظاهرة أخرى تتوجب الإشارة إليها، وأعني بذلك استغلال بعض من الانتهازيين لـ«ثورة الكرامة والحرية» للحصول على مناصب وامتيازات مادية خاصة. وجميع هؤلاء كانوا في طليعة المستفيدين ثقافيًّا وماديًّا من نظام ابن علي. وبعضهم كانوا يتمتعون بمناصب رفيعة في المؤسسات الثقافية، وفي الجامعات. لكن حال سقوط نظام ابن علي، وضعوا أقنعة جديدة، معلنين من دون خجل أو حياء أنهم كانوا «معارضين» لذلك النظام، ناسبين لأنفسهم بطولات وهمية. وباسم «الثورة»، روّج هؤلاء لأدب هزيل، ولفنون تافهة، ولمسرحيات وأفلام لا هدف من ورائها سوى الركوب على الأحداث، وتوفير أرضية لبروز ثقافة سطحية تقوم على الأكاذيب، وعلى الشعارات الجوفاء.
ولأنهم بارعون في حبك المؤامرات القذرة، وفي بعث «مافيات ثقافية» موالية لهم، فإن هؤلاء تمكنوا من الهيمنة بشكل كبير على المشهد الثقافي التونسي من خلال المؤسسات الثقافية التي أصبحوا يسيطرون عليها، ويديرونها بحسب أهوائهم ومصالحهم الخاصة مثل «بيت الرواية» الذي يشرف عليه كاتب من الدرجة الثانية، ليس في رصيده سوى مجموعتين قصصيتين، على الرغم من أنه قارب سن الستين. وبسبب هذه «المافيات الثقافية» التي استغلت الفوضى المدمرة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات منذ عشر سنوات، فقدت الجوائز الأدبية مثل جائزة أبي القاسم الشابي، وجوائز معرض الكتاب، مصداقيتها لأنها أصبحت تمنح لمن لا يستحقونها سواء في القصة أم في الرواية أم في النقد الدبي أم في غير ذلك.
 ومن بين المظاهر السلبية الأخرى، قلة المجلات والملاحق الثقافية التي تُعنَى بالآداب والفنون. والمجلتان الوحيدتان اللتان تصدران راهنًا، لكن ليس بانتظام دائمًا، هما «مجلة الحياة الثقافية» التي تشرف عليها وزارة الثقافة بشكل مباشر، ومجلة «المسار» الناطقة باسم اتحاد الكتاب التونسيين. لكن اهتمام القراء بالمجلتين المذكورتين يكاد يكون منعدمًا؛ إذ إن المواد المنشورة في كل عدد من أعدادهما تفتقر إلى المستوى الأدبي والفني المطلوب. وليس ذلك بالأمر الغريب. فرئيس تحرير مجلة «الحياة الثقافية» التي أسسها الكاتب الكبير محمود المسعدي، يشرف على تحريرها كاتب بمجموعة قصصية واحدة، كل قصة من قصصها لا تتجاوز السطرين. وحجته في ذلك هو أنه من مبتكري ما يُسمّى بـ«القصة الومضة». أمّا مجلة «المسار» فيديرها من لا يفكرون أصلًا في الثقافة، بل في مصالحهم الخاصة التي لا يضمنها لهم سوى البقاء على رأس اتحاد الكتاب…
ومن بين المظاهر السلبية الأخرى، قلة المجلات والملاحق الثقافية التي تُعنَى بالآداب والفنون. والمجلتان الوحيدتان اللتان تصدران راهنًا، لكن ليس بانتظام دائمًا، هما «مجلة الحياة الثقافية» التي تشرف عليها وزارة الثقافة بشكل مباشر، ومجلة «المسار» الناطقة باسم اتحاد الكتاب التونسيين. لكن اهتمام القراء بالمجلتين المذكورتين يكاد يكون منعدمًا؛ إذ إن المواد المنشورة في كل عدد من أعدادهما تفتقر إلى المستوى الأدبي والفني المطلوب. وليس ذلك بالأمر الغريب. فرئيس تحرير مجلة «الحياة الثقافية» التي أسسها الكاتب الكبير محمود المسعدي، يشرف على تحريرها كاتب بمجموعة قصصية واحدة، كل قصة من قصصها لا تتجاوز السطرين. وحجته في ذلك هو أنه من مبتكري ما يُسمّى بـ«القصة الومضة». أمّا مجلة «المسار» فيديرها من لا يفكرون أصلًا في الثقافة، بل في مصالحهم الخاصة التي لا يضمنها لهم سوى البقاء على رأس اتحاد الكتاب…
وفي النهاية يمكن القول: إن الثقافة المضادة -التي جسّدت ولا تزال تجسد الثقافة في مفهومها الأصيل والعميق منذ ثلاثينيات القرن الماضي حتى اليوم- تواجه راهنًا تحديات خطيرة، وتواصلها رهين بالفاعلين فيها، الذين يتوجب عليهم مواصلة «المقاومة» لمواجهة وتذليل العقبات التي تضعها أمامهم التيارات الرجعية والسلفية، و«المافيات الثقافية» لعرقلة مسيرتهم المجيدة…

حسونة المصباحي - كاتب تونسي | مايو 1, 2020 | مقالات
تحتضن تونس هذا العام الدورة الـ50 للفرنكفونية. وبذلك تكون الدولة العربية الثانية بعد لبنان التي احتضنتها عام 2002م. وسيحضر الاحتفال الكبير بهذه الدورة الذي سوف ينتظم في ديسمبر القادم من العام الحالي، رؤساء دول وحكومات من مختلف أنحاء العالم. وتعدّ الفرنكفونية ركنًا أساسيًّا في السياسة الخارجية الفرنسية، ووسيلة للحفاظ على مكانة لغة موليير التي تقلصت بعد أن أصبحت اللغة الإنجليزية اللغة الأولى بالنسبة للعالم بأسره. وستعيش تونس على مدى العام الحالي على وتيرة تظاهرات وندوات ثقافية وسياسية وفنية واقتصادية تعكس وضع فرنسا الراهن على مستويات متعددة ومختلفة، وتبرز علاقتها بالدول التي لا تزال تولي اهتمامًا للغة موليير التي كانت اللغة الأكثر انتشارًا في أوربا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر.
وعلينا أن نشير في البداية إلى أن النخب التونسية أقبلت على تعلم اللغة الفرنسية انطلاقًا من مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أي عقب مرور سنوات قليلة على الزيارة التاريخية التي أداها أحمد باي إلى العاصمة الفرنسية وذلك عام 1846م. وخلال تلك الزيارة التي تمت بدعوة من الملك لوي نابليون، زار الباي العديد من المعالم التاريخية، واطلع على العديد من مظاهر الحضارة الجديدة في مجال الصناعة والثقافة، وحضر لأول مرة في حياته عرضًا مسرحيًّا تضمن دفاعًا جريئًا عن حرية المرأة. وعند عودته إلى تونس، بنى قصرًا جنوب العاصمة محاولًا تقليد قصر فارساي، وشجع مستشاريه من الشبان خاصة على تعلم اللغة الفرنسية مطالبًا إياهم بترجمة كتب عن بطولات وحروب نابليون. وكان خير الدين باشا الذي تزعم الحركة الإصلاحية، وأشرف على إنجاز أول دستور تعرفه تونس وذلك عام 1858م، أول من أتقن اللغة الفرنسية، وبها تحاور مع شخصيات سياسية كبيرة في فرنسا، وفي أوربا عامة.
كما أن هذه اللغة ساعدته على الاطلاع على الدساتير الغربية، وعلى التعرف إلى تاريخ الثورة الفرنسية ليؤلف كتابه الشهير :«أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك». وقد ازدادت النخب التونسية إقبالًا على تعلم اللغة الفرنسية بعد أن أسس خير الدين «المدرسة الصادقية» التي كان الهدف الأساسي منها الانفتاح على الحضارة الغربية ومنجزاتها العلمية والصناعية والفكرية والثقافية بواسطة اللغة الفرنسية التي ازدادت انتشارًا في البلاد التونسية بعد أن وقّعَ حاكمها الصادق باي وثيقة الاحتلال الفرنسية في الثاني عشر من شهر مايو 1881م.
لكن ماذا عن الأدب التونسي المكتوب باللغة الفرنسية؟
بداية يجدر بنا أن نشير إلى أن هذا الأدب لم يعرف الرواج والانتشار اللذين حظي بهما في كل من الجزائر والمغرب لا خلال الحقبة الاستعمارية، ولا بعدها. وأول عمل أدبي لفت انتباه النقاد الفرنسيين كان رواية «تمثال الملح» لليهودي التونسي ألبير ممي الذي ولد في حارة اليهود في قلب الجزء العتيق من العاصمة التونسية، وفيها يرسم صورة بديعة لطفولته البائسة التي عرف فيها الجوع والقهر، إلّا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة تعليمه ليحصل من جامعة السوربون بباريس على إجازة في الفلسفة. حتى وإن كتبت بالفرنسية، وكان مؤلفها يهوديًّا، فإن النقاد ومؤرخي الأدب يعدُّون «نمثال الملح» من أهم الروايات التي تصف الحياة التونسية في النصف الأول من القرن العشرين. وفي حوار أجري معه يقول ألبير ممي: «لقد عشت الصراع بين الغرب والشرق في فترة شبابي. من ناحية أحاسيسي، وحياتي الخاصة يمكن أن أقول بإنني ظللت شرقيًّا بأتم معنى الكلمة. وأنا هنا في قلب باريس التي انتقلت للعيش فيها منذ الخمسينات، أستريح في القيلولة مثل أي شرقي يحترم عاداته وتقاليده. وعندما كنت صغيرًا، كان التكلم بالعربية في المدرسة ممنوعًا منعًا باتًّا. لذا كانت اللغة الفرنسية نافذتي على العالم».
بعد استقلال تونس، قام بورقيبة بغلق جامع الزيتونة ليجعل من اللغة الفرنسية اللغة الأولى في المدارس والجامعات، حتى في الإدارة. مع ذلك، ظلت اللغة العربية اللغة المفضلة للكتاب والشعراء الذين لعبوا دورًا مهمًّا في بروز حركات وتيارات طلائعية في القصة والنقد والشعر خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. لكن البعض من أبناء تلك الحقبة اختاروا الكتابة باللغة الفرنسية. ومن أبرز هؤلاء يمكن أن نذكر الراحل عبدالوهاب المؤدب، والمنصف غشام، والطاهر البكري، وأمينة سعيد، والهادي بوراوي، ومحمد عزيزة الذي كان يمضي نصوصه النثرية والشعرية بـ«شمس نذير».
شهرة في الأوساط الفرنكفونية
لكن ثلاثة فقط من بين هؤلاء تمكنوا من أن تحظى أعمالهم بنوع من الشهرة في الأوساط الفرنكفونية. أول هؤلاء هو عبدالوهاب المؤدب الذي كتب الشعر، والرواية والدراسة الفكرية المركزة بالخصوص على وضع الإسلام بعد بروز الأصوليات وتغلغلها في المجتمعات العربية، وفي الجاليات المغاربية التي تعيش في فرنسا تحديدًا. وقبل وفاته عام 2014م، ازدادت شهرة عبدالوهاب المؤدب اتساعًا في فرنسا التي أقام فيها منذ سنوات شبابه ليحصل على العديد من الجوائز الرفيعة تقديرًا لأعماله الشعرية والنثرية والفكرية.
أما الهادي بوراوي الذي توفي عام 2009م، فقد عاش الشطر الأكبر من حياته بين نيويورك وتورنتو الكندية. وقد صدرت جل رواياته عن دار «غاليمار» الفرنسية المرموقة. كما أنه أحرز العديد من الجوائز المهمة في كل من كندا وفرنسا. وخلافًا لعبدالوهاب المؤدب، والهادي بوراوي، فضل المنصف غشام المولود في مدينة المهدية البحرية عام 1946م العيش في تونس. وقد أصدر إلى حد الآن العديد من المجموعات الشعرية التي لاقت تجاوبًا كبيرًا لدى أحباء الشعر.
كما أصدر المنصف غشام مجموعة قصصية واحدة حازت تقدير النقاد الفرنسيين، وفيها يرسم صورة رائعة عن حياة البحّارة في مدينته، وعن كفاحهم اليومي من أجل الحصول على القوت وسط أمواج البحر وعواصفه الهوجاء.
وإلى حد هذه الساعة، أصدرت أمينة سعيد التي تعيش في باريس منذ السبعينيات من القرن الماضي، سبع مجموعات شعرية، نالت اثنتان منهما جائزتين. وهي تقول: «صحيح أنني أكتب بالفرنسية، إلاّ أنني أحس أنني شرقية، وأن ما كتبته ينتمي إلى الشرق… والذين نقلوا قصائدي إلى اللغة العربية أكدوا لي أن قصائدي تعكس عوالم وأجواء شرقية بألوانها وروائحها وأساطيرها».
وراهنًا تشهد اللغة الفرنسية في تونس تقلصًا كبيرًا لم يسبق له مثيل. مع ذلك لا يزال هناك كُتّاب وشعراء متعلقون بها، وبها يكتبون نصوصهم النثرية والشعرية. ومن أبرز هؤلاء الكاتبة فوزية الزواري التي تعيش في باريس منذ السبعينيات من القرن الماضي. وهي تكتب بلغة فرنسية راقية وشعرية. وجميع الروايات التي أصدرتها إلى حد هذه الساعة مستوحاة من قضايا وأجواء تونسية، بل من بيئتها الريفية القريبة من الحدود الفاصلة بين تونس والجزائر. وقد حازت روايتها الأخيرة «جسد أمي» جوائز عدة تونسية وفرنسية. كما أنها كرمت مؤخرًا بوسام الفرسان من الرئيس الفرنسي ماكرون. ويُنتظر أن تؤدي فوزية الزواري التي تتمتع بتقدير الأوساط الفرنسية المثقفة والسياسية والإعلامية دورًا مهمًّا في إنجاح الدورة الحالية للفرنكفونية في تونس بحكم ترأسها لبرلمان الكاتبات الناطقات بلغة موليير الذي أنشئ قبل عامين…

حسونة المصباحي - كاتب تونسي | نوفمبر 1, 2019 | فضاءات
قبل وفاته بثلاثة أعوام، أصدر الكاتب والمفكر المغربي المرموق عبدالكبير الخطيبي (1938- 2009م) عن دار «المنار» بالرباط كتابًا بعنوان: «الرباعي الشعري» خصصه لأربعة من شعراء الغرب الكبار، وهم: الألمانيان غوته وريلكه، والسويديان أكيلوف ولوندكفيست. ويبدو جليًّا أنه اختار هؤلاء لأنهم أظهروا اهتمامًا كبيرًا بالإسلام، وبالثقافة الشرقية.
وفي نصه الذي حمل عنوان: «نذْرُ الصمت»، يستحضر الخطيبي جملة لريلكه (1875-1926م) فيها يقول: «ليس هناك أشدّ قوة من الصمت. ولو أننا لم نولد في قلب الكلمة لكان من المحتمل ألّا ينقطع». كما يستحضر جملة لبيكت يقول فيها: «الصمت هو لغتنا الأم» ليقول بأن الشاعر يجد نفسه وحيدًا أمام القوة اللامتناهية للصمت، «الضامن والهوّة» لنشيده. ثم يضيف قائلًا: «الشاعر يحسّ أن اللغة التي يتكلمها وُهبت له كما لو أنها ستسلب منه فيما بعد، بسبب ابتزاز أو ثقل الصمت الذي يغذّي في أوقات الحيرة والضياع، حياته الصعبة. إن نذر الصمت –سواء كان مطلقًا أو نسبيًّا- الذي يطالب به، يؤسس لإنسان الوحدة التجربة الفريدة للشاعر ولوجهه الآخر الصموت. وعشاق الصمت يعرفون هذا السر».

راينر ماريا ريلكه
أما عبدالكبير الخطيبي، فقد يجد الشاعر في تدفق اللغة نشوة عارمة، ووهمًا بحرية لا حدود لها. لكن تدفق الكلمات قد يتوقف فجأة. لذلك لا أحد يعلم لماذا فضّل شاعر مُلهم مثل رامبو أن يتخلى عن الكلمات ليخلد إلى الصمت المطلق. ومثل الزهاد الكبار، كان ريلكه يطمح إلى تطهير النفس والجسد حتى لو تطلَّب منه ذلك تحمّل عذابات أليمة. فبعد المحنة التي يمر بها في ساعة التطهير، يعود الجسد إلى نفسه في بهجة الصمت. وأما الروح فتحلم أن تكون ملاكًا للحقيقة. وكان ريلكه يعشق الوحدة. إليها يلجأ كلما اقترب المخاض. مخاض ولادة القصيدة؛ لذا لا أحد مثله مجّدَ التحالف بين الصمت والقصيدة. وفي الرسائل التي كان يبعث بها إلى لو أندرياس صالومي، وإلى حبيباته الأخريات، كان يشير دائمًا إلى حلم الشاعر المفتون بالصمت، وبمكان مثاليّ فيه ينعم بسلام لا متناه بعيدًا من صخب البشر وعنفهم وضجيجهم. وهناك يبدأ حوار الشاعر مع نفسه أمام أفق تشع فيها الصور والإشارات والمعاني الخفية. أما ريلكه، فيحتاج الشاعر دائمًا إلى «صمت جديد لا يذكره بأيّ شيء». صمت بديع لا يقطعه صراخ ولا شكوى، يرافق انبثاق الاستعارات المتراكمة في ذاكرة تعوَّدت على التنقل بين الأمكنة والأزمنة. ذاك هو ثمن القصيدة. تلك القصيدة التي تُصَوّبُ إلى ما هو جوهري وأساسي، وإلى الصفاء المطلق لأصوات الكلمات الذي يُجْتَثّ من نشوة اللحظة. ويكتب الخطيبي قائلًا: «الصمت ليس الصمت. هو ينفجر في اتجاهين، تمامًا مثل الحاضر بالنسبة للماضي أو المستقبل. وهو يمضي في الوقت نفسه، وربما على مسافة متقاربة، باتجاه الحياة والموت. ذاكرته غير مُتَوَقّعَة. وهو يهمس كما يمكن أن ينفجر. وعندما يُحْدث صخبًا، هو يحدثه إما في الخسّة والدناءة، وإما تدريجيًّا بالهمس والوشوشة. عندئذ تسّاقط أوراق تعلن عن الريح، أو عن النسيم الذي يأتي ليستريح على قمم الأشجار. هكذا تختلج الطبيعة. وعدم إنجازنا يتجذّرُ في أجزاء هذه الأشياء، هناك حيث تترك الطبيعة كلمتنا تتبرْعَمُ».
أما ريلكه، فلا يكفي الصمت والوحدة؛ إذ لا بدّ للشاعر من مغامرة، ومن فرار من أشباحه. لذلك هو يفرض على نفسه نظام عمل قاسيًا يحتّم عليه التركيز ليظل شبه أصم وهو جالس بين أشياء العالم. وعندما كان على ضفاف البحر الأدرياتيكي عام 1912م، سمع ريلكه البيت الأول من قصيدته الشهيرة «مراثي دوينو» :
من يسمعني إذن إذا ما أنا صرخت،
بين مراتب الملائكة؟
كل أبواب العالم
وفي ختام نصه عن ريلكه، يكتب الخطيبي قائلًا: «بين كلمة الشاعر والصمت، هناك تغييرات –على خلفية هوة. وكل قصيدة جميلة تولد من التدمير الذي لا يرحم لآثارها. مستندة إلى الصمت، هي موضوعة هناك في هذا الكتاب مثل باب أعمى على جدار لا مرئي. وإذا ما نحن فتحنا كل أبواب العالم، فأين نكون في الصقع غير المحتمل للمجهول؟».
وفي النص الذي خصصه له، والذي جاء بعنوان «الشاعر مُقَنّعًا»، يلقي الخطيبي الأضواء على عالم غوته (1748- 1832م) الروحي والشعري من خلال ديوانه الشهير «الديوان الشرقي من خلال الشاعر الغربي»، مشيرًا في البداية إلى أن صاحب «فاوست» كتب هذا الديوان في شيخوخته. ومن خلاله أراد أن يتحاور مع شعراء الشرق الكبار. ويعني ذلك أنه لم يكن يبتغي تقليدهم، وإنما أن يصيغ انطلاقًا من ثقافته، ومن عالمه، ما يمكن أن يقيم جسورًا روحيه بينه وبينهم.
وكان غوته قد بلغ في سنة 1814م الخامسة والستين من عمره. وكان يعيش في عزلة شبه تامة. وكانت حالته النفسيّة يشوبها الاضطراب، والتمزّق، والقلق. فقد هزم نابليون، بطله المفضّل عام 1813م. فكانت تلك الهزيمة ضربة قاسية له. ورغم أنه كان في قمة المجد والشهرة، فإن نبال الأعداء، والمناوئين كانت تصيبه بين وقت وآخر، مُخلّفة في الروح جراحًا عميقة. ولكي يتجاوز محنته تلك، ويتخلص من القلق النفسيّ الرّهيب الذي كان يعصف بحياته، ويعطّل قدراته الإبداعية، شعر غوته أن أفضل مخرج هو الهروب «إلى عالم خياليّ مثالي» فيه ينعم «بما شاء من الملاذ والأحلام بالقدر الذي تحتمله قواه». ولم يكن هذا العالم غير ذلك الشرق الذي سحره وفتنه وهو يقرأ القرآن، والمعلقات، وشعراء بلاد فارس. وفي تلك السنة نفسها، عاش غوته أحداثًا وثّقت صِلَاته بالشرق. ولعلّ أهم تلك الأحداث هو قراءته ديوان الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي. وعن ذلك كتب يقول في مذكراته عام 1815م: «استطعت أن أحصل في العام الماضي على ترجمة فون همر لديوان حافظ كلّه. وإذا كنت لم أظفر بشيء من قراءتي لما ترجم لهذا الشاعر العظيم من قبلُ من قطع نُشرت في المجلّات هنا وهناك، فإن مجموعة أشعاره قد أثّرت فيّ تأثيرًا عميقًا، وقويًّا حملني على أن أنتج، وأفيض بما أحسّ وأشعر لأني لم أكن قادرًا على مقاومة هذا التأثير القوي على نحو آخر، لقد كان التأثير حيًّا قويًّا، فوضعت الترجمة الألمانيّة بين يدي، وجدتُ نفسي أندفع إلى مشاركته في وجدانه. وإذا بكلّ ما كان كامنًا في نفسي مما يشبه ما يقوله حافظ سواء في موضوعه، أو في معناه يبدو ويظهر، وينبعث بقوة وحرارة حتى إني شعرت شعورًا قويًّا ملحًّا بحاجتي إلى الفرار عن عالم الواقع المليء بالأخطار التي تتهدّدني من كلّ النواحي سواء في السرّ، أو علانية؛ لكي أحيا في عالم خيالي مثالي أنعم فيه بما شئت من المتع حسب طاقتي».
بعد قراءته ديوان حافظ الشيرازي، قرّر غوته مغادرة «فايمار» حيث كان يقيم لقضاء مدة الراحة والاستجمام في منطقة «الراين» الجنوبية التي أمضى فيها حقبة من حياته عندما كان طالبًا في جامعة سترازبورغ. وقد بدأت تلك الرحلة في 15 يوليو- تموز 1814م. وخلال توجهه إلى «فيسبادن» حيث سيمضي بضعة أسابيع، كانت أبواق الحرب تختلط بإشاعات السلام. وها هو الشاعر الشيخ يواجه ماضيه، ومرابع طفولته من جديد محاولًا من خلال الذكريات السعيدة نسيان ما كان يثقل نفسه من آلام وأوجاع.
قصة حب عاصفة
 وفي شهر أيّار- مايو من السنة التالية (1815م) عاد غوته من جديد إلى منطقة الراين الجنوبية. وخلال رحلته عاش قصّة حبّ عاصفة ستبدو آثارها جليّة في «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي». فقد نزل غوته ضيفًا على صديقه القديم فيلمير. وهو شخصيّة من شخصيّات فرانكفورت المرموقة. وكان فيلمير قد تزوّج قبل عام فتاة جميلة تدعى ماريان تصغره بخمسة وعشرين عامًا. وكانت ماريان قارئة نهمة. وكانت قد أتت على جميع مؤلفات غوته. لذلك انجذبت إليه، وخفق له قلبها حبًّا من النظرة الأولى. وفي «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» سوف تصبح ماريان «زليخة»، امرأة العزيز التي راودت النبي يوسف عن نفسه. أما غوته فسوف يختار لنفسه اسم حاتم. في القصيدة التي تأتي في خاتمة كتاب «زليخة»، يقول غوته:
وفي شهر أيّار- مايو من السنة التالية (1815م) عاد غوته من جديد إلى منطقة الراين الجنوبية. وخلال رحلته عاش قصّة حبّ عاصفة ستبدو آثارها جليّة في «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي». فقد نزل غوته ضيفًا على صديقه القديم فيلمير. وهو شخصيّة من شخصيّات فرانكفورت المرموقة. وكان فيلمير قد تزوّج قبل عام فتاة جميلة تدعى ماريان تصغره بخمسة وعشرين عامًا. وكانت ماريان قارئة نهمة. وكانت قد أتت على جميع مؤلفات غوته. لذلك انجذبت إليه، وخفق له قلبها حبًّا من النظرة الأولى. وفي «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» سوف تصبح ماريان «زليخة»، امرأة العزيز التي راودت النبي يوسف عن نفسه. أما غوته فسوف يختار لنفسه اسم حاتم. في القصيدة التي تأتي في خاتمة كتاب «زليخة»، يقول غوته:
بإمكانك أن تتخفّي في ألف شكل/ غير أني أيّتها الحبيبة، سأعرفك على الفور/ قد تخفين محيّاك وراء الأقنعة الساحرة/ لكني أيّتها الحاضرة في كلّ شيء/ سأعرفك على الفور./
في وشوشة القناة الصافية الموج/ سأعرفك على الفور!.
في مستهلّ «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي»، يسمّي غوته رحلته الخياليّة إلى الشرق بـ«الهجرة». وفي القصيدة التي حملت العنوان نفسه، يقول: الشمال، والغرب، والجنوب، كلّ هذا/ يتحطّم ويتناثر/ فلنهاجر إذن إلى الشرق في طهره وصفائه/ كي نستروح جوّ الهداة والمرسلين!/هناك حيث الحب والشرب والغناء/ سيعيدك ينبوع الخضر شابًّا من جديد،/ إلى هناك حيث الطهر والحقّ والصّفاء/ أودّ أن أقود الأجناس البشريّة فأنفذ بها إلى أعماق/ الماضي السحيق/ حيث كانت تتلقّى من لدن الربّ وحي السماء بلغة الأرض/ دون أن تضني الرأس بالتفكير».
وفي مكان آخر يعبّر غوته عن هذه الهجرة نفسها قائلًا: «دعوني وحدي مقيمًا على سرج جوادي،/ وأقيموا ما شئتم في دياركم/ مضارب خيامكم،/ أما أنا فسأجوب من الأنحاء قاصيها/ على صهوة فرسي/ فرحًا مسرورًا لا يعلو على قلنسوتي/ غير نجوم السّماء!».

يوهان غوته
ولا ينسى غوته أن يقدّم لقراء «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» في فقرات مكثفة للغاية قائمة الشعراء، وجميعهم من شعراء الفرس الذين تأثر بهم. وتبدأ هذه القائمة بالفردوسي الذي عاش في القرن الحادي عشر، وتنتهي بعبدالرحمن الجامي الذي عاش في القرن السادس عشر. وهؤلاء الشعراء مختلفون في نزعاتهم، وفي أغراضهم الشعرية والوجوديّة، سوى جلال الدين الرومي الذي يعاب عليه توجّهه التجريدي، ولجوؤه إلى نظريّة «الوحدة الكونيّة»، يجرّ غوته بقية الشعراء إلى عصره محاولًا أن يسبغ عليهم بعض القيم الإنسانية النبيلة السائدة فيه. أما الشاعر الأقرب إلى نفسه فهو بلا شك حافظ الشيرازي؛ لذا هو لا يتردد في أن يعلن أن هذا الأخير هو معلمه، والنموذج الذي يحتذي به. عنه كتب يقول: «من قصائد هذا الشاعر يتدفق سيل من الحياة لا ينقطع، حافل بالاتّزان. وكان راضيًا ببساطة حاله، فرحًا، حكيمًا، يشارك في خيرات هذا العالم، ويلقي بنظرة بعيدة على أسرار الألوهيّة، مُنصرفًا عن أداء الفروض الدينية، وعن ملذّات الحواس في وقت واحد، حتى إن نوع شعره، وإن كان يبدو أنه يعظ، ويعلّم، يحتفظ بحركة شكّيّة دائمًا».
غير أن الشرق ليس هو وحده الحاضر في «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي»، وليس كلّ ما فيه خيالًا. فهناك الشاعر الغربي الذي هو غوته. وهو يعبّر عن ضيقه بمن يسمّيهم «الرّهبان الصغار الذين لا يضعون على رؤوسهم قلنصوات». هناك أيضًا الرجل الذي هو غوته وقد بدأ يشيخ، ويواجه خطر الأمراض. ولكي ينسى ذلك، ويستعيد طاقة الشباب، ها هو يهرب إلى ذكريات الماضي. غير أنها تبدو من دون نفع ولا جدوى: غربت الشمس/ لكنها لا تزال تلمع في المغرب/ بودي أن أعرف كم من الزمان/ سيستمر هذا البريق الذهبي؟».
صدر «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» أول مرة عام 1819م. غير أن أهم ما تضمّنه من قصائد هي تلك التي كتبها غوته خلال الرحلتين اللتين قام بهما إلى منطقة الراين الجنوبية عامَيْ 1814م، و1815م. وربما يعود ذلك إلى أن غوته كان خلال الرحلتين في أقصى درجات توهجه الشعري والذّهني. كما أنه كان عاشقًا متيّمًا. بعد «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي»، ظلّت الغنائيّة حاضرة في قصائد الشعراء الألمان. إلّا أن جمال هذا الديوان لم يتجدّد بعد غوته أبدًا…
الدليل إلى جهنم
ومثل غوته، فتن الشاعر السويدي غونار أكيلوف (1907- 1968م) بالشرق وبشعرائه، وتحديدًا بمحيي الدين بن عربي. انعكس ذلك من خلال الدواوين التي أصدرها مثل: «ديوان حول الأمير»، و«أسطورة فطومة»، و«الدليل إلى جهنم». وكان غونار أكيلوف قد بدأ يهتم بالأدب العربي مبكرًا؛ إذ تعلم البعض من مبادئ اللغة العربية في قسم اللغات الشرقية بجامعة «أوبسالا». بعدها انتقل إلى لندن ليواصل دراسته في المجال نفسه، مجال اللغات الشرقية. وهناك اكتشف محيي الدين بن عربي من خلال ديوان «ترجمان الأشواق» الذي كان قد نقله إلى لغة شكسبير المستشرق البريطاني نيكولسون. ومنذ ذلك الحين، سوف يصبح هذا الديوان، المرجع الأساسي لغونار أكيلوف، وسوف يجد فيه ملامح التيارات الشعرية الطلائعية التي كانت شائعة في عصره مثل الرمزية والسوريالية.
وتحت تأثير «ترجمان الأشواق» تخيّل غونار أكيلوف قصة حب بين شاب يدعى حبيب، وشابة تدعى فطومة. وفي ذلك كتب يقول: حبيب! حبيبي، هل نلتقي عندك أو عندي/ كان ذلك هو صدى صوتها الساحر في الليل،/ نلتقي عندك، كان ذلك صدى جوابه الساحر،/ وتجولا ثانية في خلال الليل، بعيدًا عن المدينة/ بعيدًا عن أطراف المدينة، وتجاوزا الواحات حتى وصلا قلب الليل وبزغ الفجر الأحمر، أمامهما على الطريق/ وأضاع الفجر نفسه في الرحال، في الشمس التي صعدت خارج الليل،/ وأصبح القمر شاحبًا، وألقت الشمس ظلالًا أكثر دكنة/ وحين غربت جاءا إلى مكانهما، في الليل/ واختفت كل الطرقات، وأغفيا بجوار بعضهما البعض/ ودونه كان لا يبين شيء من ظلها ولكن حين غيّرا وضعهما كما يفعل العشاق/ كان شيء ما لا يبين تحت ظله/ وهكذا أصبح الليل نهارًا، والنهار ليلًا».
وفي مقطع آخر من القصيد ذاته، كتب أكيلوف يقول: في أحلامي سمعت صوتًا/ هل تحبّ هذه الزهرة، يا حبيب/ أم ورقة من أوراقها/ عندئذ وقعت في حيرة/ فقد كان هذا السؤال الملغز هو سؤال حياتي/ هل أفضّل الجزء على الكل/ أو الكل على الجزء/ لا، إني أريد كليهما/ جزء الكل، والكل/ ولا يكون في هذا الاختيار أي تناقض».

غونار أكيلوف
وفي قصائد أخرى تقمص أكيلوف شخصية ديجينيس أكريتاس الذي كان قد وُلد عربيًّا. غير أن الروم قاموا بأسره خلال الحروب الصليبية، فأصبح مسيحيًّا رغمًا عنه. وعندما اكتشف الروم أنه ظل وفيًّا لعروبته، ألقوا به في السجن. وظل هناك إلى أن قضى. غير أن أكيلوف لا يلبث أن يعود إلى محيي الدين بن عربي ليكتب قصيدة عن نظام، وفيها يقول: «الشباب يرقصون ويدقون ساقًا بساق/ والفتيات يغطين وجوههن كل واحدة بنقابها/ كل من الفريقين يعبّر عن رغبته بطريقته/ وهي رغبة متبادلة بينهم/ أما أنت فتبقين خارج مجال الحصول،/ تبقين أنت الواحدة المفردة».
بعد أن أمضى بضع سنوات في لندن، انتقل أكيلوف إلى باريس حيث أقام في فندق متواضع. وكان يقضي جلّ أوقاته في الكتابة، وفي الاستماع إلى سيمفونيات سترافينسكي الذي كان يعشقه. وكانت الكآبة تشتد عليه أحيانًا، حتى إنه فكر أكثر من مرة في الانتحار. ولأنه اكتشف أن التمرد عملية عبثية، مآلها الخيبة والخسران، فإنه ازداد ميلًا إلى العزلة والوحدة. وكانت بلاده السويد، تبدو له من بعيد سوداء قاتمة، كأنها ليل بلا نهاية؛ لذلك كان إحساسه بالغربة شديدًا. وهذا ما تكشفه الأبيات التالية: «أنا غريب في هذه البلاد/ غير أن هذه البلاد ليست غريبة عني/ ليس لي وطن في هذه البلاد/ غير أن هذه البلاد تريد أن تكون لي وطنًا في داخلي!».
ومع اندلاع الحرب الكونية الثانية، بدأ أكيلوف يشعر أن التاريخ معادٍ لآمال الإنسانية، ومطامحها في الحرية، والحب، والعدالة؛ لذا ازداد تشاؤمًا ويأسًا، وأصبح فصل الخريف رمزًا للاحتضار، وللتعفن الشامل. وفي قصيدة بعنوان «مرآة أكتوبر» كتب يقول: «الأعصاب تصرّ بهدوء في الأصيل/ الذي يسيل رماديًّا ولطيفًا عبر النافذة/ والأزهار الحمراء تؤلم قليلًا في الغروب/ والمصباح الكهربائي يغني وحيدًا في الركن/ الصمت يشرب أمطار الخريف الهادئة/ والتي لا تأتي بأي شيء للمحصول الزراعي/ والأيدي المضمومة تتدفأ/ والنظرات الثابتة تتغشى في الجمر./ بالمعجزة التي تلامس المنازل».
ويرى عبدالكبير الخطيبي أن أكيلوف كان يرغب دائمًا في أن يكتب قصائده التي يحضر فيها الشرق على شكل مسبحة مشرقية؛ إذ إن كل قصيدة تبدأ وتنتهي دائمًا بالحركة نفسها. والمسبحة له هي لعبة من ألعاب الجسد. وخاصيتها أنها توقظ الحواس، وتنتظم حباتها تنظيمًا شعريًّا يتكون من تتابع دائري بين الكلمات والاستعارات. وفي الشرق، يتعلم الشاعر لغة الطيور، والملائكة والنساء المتبرجات في ظلال البيوت بعيدًا من أنظار المتطفلين. كما يتعلم كيف ينسج النظرات، والكلمات، والصرخات، والضحكات.
خطورة الحياة وكثافة الأشياء
وفي الليلة الفاصلة بين التاسع والعشرين من شهر فبراير وفاتح مارس 1960م، ضرب زلزال عنيف مدينة أغادير المغربية مخلفًا 50000 قتيل. وكان الشاعر السويدي آرتور لوندكفيست (1906- 1991م) موجودًا في المدينة المنكوبة برفقة زوجته الشاعرة ماريا فين. والاثنان نجيا من الكارثة التي من وحيها كتب الشاعر السويدي قصيدة حملت عنوان «أغادير». وعلى هامش ندوة انتظمت في أغادير يومي 10 و11 إبريل 1997م بحضور زوجة الشاعر، قدم عبدالكبير الخطيبي قراءة لقصيدة لوندكفيست من خلال مداخلة بعنوان «ما بعد الكارثة». وهو يرى أن الشاعر نجح إلى حد بعيد في بلورة صورة شعرية رائعة لمدينة دمرها الزلزال، مثبتًا بذلك أن الشعر قادر على أن يستكشف خطورة الحياة وكثافة الأشياء، وعلى أن يبتكر مجالات جديدة لكل حدث يتسبب في مأساة إنسانية.

آرتور لوندكفيست
وكان الشاعر لوندكفيست بصدد قراءة كتاب لما ضرب الزلزال أغادير. وكان الوقت شهر رمضان. وفي النصوص القديمة نحن نعاين أن الحيوانات والطيور هي التي تبادر بالإعلان عن الكوارث الطبيعية. وفي بداية قصيدته، يتحدث الشاعر عن حمامة تطير من بين صفحات الكتاب وهو في حالة من الانزعاج والخوف. ثم فجأة تهتز الأرض، وتتحول المدينة إلى ركام من الأطلال. وتلك اللحظات العصيبة التي تحدث فيها الكارثة تبدو بلا نهاية. ويكتب الشاعر قائلًا:
أسمع نفسي أصرخ/ كم من الوقت سيدوم كل هذا؟/ عشر ثوان؟/ أكثر؟ أقل؟/ أو أنه لا وقت محددًا لذلك- الوقت انقطع/ فاقدًا امتداده المحدد،/ ربما تكون هناك كرة سوداء من الزمن مضغوطة/ ومثقلة بقرارات سريعة مثل البرق:/ ذلك أن العالم كان قد انبثق من جديد هادئًا، صامتًا،/ والوعي اتحد مرة أخرى بالجسد، وها أنا أجد نفسي حيًّا،/ (أو ربما تكون مجرد فكرة في لحظة الموت).
ويشير عبدالكبير الخطيبي إلى أن لوندكفيست حَوّل قصيدته إلى ملحمة شعرية؛ إذ إن الكوارث الطبيعية لا يليق بها غير ذلك. ومُعلقًا على البيت التالي في القصيدة نفسها: «أغادير، كوني متهيئة، تذكري ما ينتظرنا ربما: الدمار الشامل»، يضيف عبدالكبير الخطيبي قائلًا: «ربما هذه لا بد أن تظل راسخة في قوى الصمت، وفي كل ما هو شاسع وغير مُقَدّر، أو إذا ما نحن أردنا، في ما يشير إلى الوعد. وهكذا نتعلم مع الشعراء أن الحياة مهنة، أو هي فن. وكان لوندكفيست يعلم أن كل واحد منا يحمل في ذاته مزدوجه الذي هو مستعد أن يلعب لعبة الناجي من الموت. وهذا المزدوج هو الصورة الحزينة للشاعر الذي يأخذنا باتجاه العالم الآخر، مثل هاملت الذي يعيد على ركح كل مسارح العالم تكشيرته أمام رعب العدم. وفي حد ذاتها، تكون قصيدة لوندكفيست تجربة قصوى، وتمرينًا يهيّئنا لنهايتنا، تمرينًا حقيقيًّا لتزهدنا، ولاستكشاف قدراتنا».

حسونة المصباحي - كاتب تونسي | مايو 1, 2019 | كتب
يَعْكس ديوان الشاعر اللبناني شوقي بزيع «الحياة كما لم تحدث» الصادر عن دار «الآداب» أحوال الشاعر في تجليات وفي صور مختلفة. ففي قصيدة «بيوت الكهولة»، هو يرسم لنا صورة قاتمة عن نفسه وقد بدأ يطلّ بعد اكتمال مرحلة الكهولة على زمن الشيخوخة وأوجاعها ومخاوفها. وها هو يلاحظ أن الأيام تجري بسرعة أكثر من ذي قبل، فلا تتوافر له سوى لحظات قليلة للالتفات إلى الماضي ليستحضر زمن الطفولة، وليسترد هو وأبناء جيله وهم «ظماء وأنصاف غرقى» ودائعهم من «بريق النجوم، وحلوى النعاس، وما سيّلته شفاه الحنان الأمومي فوق وسائدهم من لعاب». وكان محتومًا عليه وعلى أصحابه أن يعودوا إلى الماضي ولو «عجزًا وحفاة من الانتظار» ليدركوا أن الحياة «قطار يسير على سكتين، واحدة للذهاب، وواحدة للإياب». إلّا أن هذه العودة لا تحقق شيئًا لا للشاعر ولا لأبناء جيله الذين بدؤوا يئنّون تحت ثقل السنين التي باتت تركض ركضًا جنونيًّا فوق أجسادهم المنهكة. وفي النهاية هم يزدادون شعورًا بأنهم «أيتام الوقت وسباياه». لذا لا عمل لهم الآن سوى «التدرّب على فكرة الموت».
وفي قصيدة «مناديل لرياح الفقدان»، يجوس شوقي بزيع بين الأطلال مثل الشاعر الجاهلي. وعكس هذا الأخير هو لا يبحث عن الحبيبة التي غابت في سراب الصحراء، ولا عن بيوت كان قد أقام فيها في ماضٍ قريب أم بعيد، ولا عن بلاد توفر له الشعور بالأمان، إنما عن «فهرس للظلال التي تعصم الخلق من فكرة الامّحاء» تمامًا مثلما فعل بطل قصة خورخي لويس بورخيس «الميت» الذي يذهب إلى أقصى الأرض ليسبح في النهر الذي يحقق الخلود. ومناديل الفقدان عند شوقي بزيع لا تتمثل في صورة واحدة، أو في مشهد يتيم، بل في صور ومشاهد عدة. فقد تتجسد فيمن «رفعوا يأسهم كالصواري على سفن لم تعد»، وفي التفاتة صف طويل من الجند «نحو الدموع التي تترقرق في أعين الفتيات الصغيرات قبل اندلاع الحروب»، وفي الذين «تركوا هائمين على وجههم عند مفترقات الدروب».
سماء صافية زرقاء
وفي قصيدة «حديقة الأخطاء»، يحاول شوقي بزيع وقد تقدمت به السن بحيث باتت حياته جديرة بالمراجعة، أن يرسم لنا صورة دقيقة عن ذاته. فهو يعلم الآن أنه لم يكن يريد من الحياة منذ البداية غير «أرض صلبة يمكنه الوثوق من حولها، و«غير خط واضح يعيد لاستقامته طريقها السوي». ولم يكن يريد من خطاه سوى أن تقوده إلى الماضي ليرى سماء طفولته صافية وزرقاء، ويسمع الريح وهي تهب لكي «تذهّب السنابل التي تنام في ضفائر النساء». ولكنه لا يلبث أن يشعر بالإخفاق والخيبة المُرّة. فكلّ النساء اللائي أحبهن تبخَّرْنَ وتبخَّرَ جمالهن بحيث لم يعُدْ يرى إشارة تدلّه على نفسه. لكأنه شبح هائم في ظلمة الزمن، يبحث دونما جدوى عن شيء يردّه إلى نفسه فلا يعثر عليه أبدًا. فهو من وهم إلى وهم آخر، ومن كابوس إلى كابوس آخر، ولا نهاية للمتاهات التي هو ضائع فيها بحيث لم يُعثَرْ عليه حتى في «زخارف البلاغة البلهاء أو حبائل الكلام». وموجع القلب والروح، ينهي شوقي بزيع قصيدته قائلًا:

شوقي بزيع
وها أنا كما ترون،
لست إلّا رجلًا محَرّفًا،
يسير عكس ما أراده لكي يقيم في حديقة الأخطاء…
وتذكرنا قصيدة «كعبة الكلمات» التي افتتح بها شوقي بزيع ديوانه بقصائد ونصوص عبّر فيها أصحابها عن معاناتهم في أثناء الكتابة. فالشاعر الفرنسي مالارميه مثلًا كان يمضي الليل كله أمام الورقة البيضاء لكي يعثر على الكلمة المناسبة. وكان فلوبير الذي كان يريد أن يكون «شاعر النثر» يمضي ساعات طويلة في كتابة جملة واحدة. لذلك كان يمضي الليل ساهدًا وهو يروح ويجيء، مرددًا الكلمات بصوت عالٍ بحثًا عن تلك التي تكون رنتها الموسيقية أفضل من غيرها. وفي قصيدته المذكورة يأخذنا شوقي بزيع إلى عالمه السري لنراه في عزلته أمام الورقة البيضاء، وهو يبحث عن شوارد الكلمات، وعن نوادر الاستعارات التي كان من اليسير على أبي الطيب المتنبي العثور عليها في حين يسهر الآخرون جرَّاها ويختصمون. «متباريًا على ملعب من رموز»، ينتظر الشاعر ولادة القصيدة «محلوْلكًا مثل أرملة في الحداد»، و«منفصمًا كالمرايا»، و«مستوحشًا كالمسيح بلا مريمات». وأحيانًا تظل الكلمات أمام عينيه مثل «بيادق عمياء»، وأما الاستعارات فتتركه لـ«الصقيع». لكن في لحظة ما تشعّ أمامه مثلما تشعّ نجْمة الصبح أمام المسافر الضالّ في البيداء، فيقطف الشاعر عندئذ «ثمار العناء»، ويتذوّق متعة الكتابة في الصمت والعزلة. أما شوقي بزيع، فوحدهن النساء يستطعن محاكاة ولادة القصيدة عند الشاعر.
مرثية للأب
وفي قصيدة «النهر والتمثال»، يرثي شوقي بزيع «أباه» الذي هو الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب الذي مات «ظمآنَ»، وبلا «سلالم لانتشال زفيره المشلول من درك القنوط». وصاحب «أنشودة المطر» هو في هذه القصيدة رمز للعراق الذي لا تلتئم جراحه إلّا لكي تنفتح من جديد، ولتكون أكثر عمقًا وتعفنًا من ذي قبل. ورغم أنهم أقاموا له تمثالًا على ضفاف مصب النهرين في البصرة، أملًا في أن تسهم أشعاره في التوحيد بينهم، وفي أن يستوي العراق «وطنًا سويًّا»، إلّا أنه سرعان ما يغيب عن ذاكرتهم فيخذلونه ومن جديد يغرقون في النزاعات والصراعات القاتلة والمدمرة ليكون «الظلام» الذي طالما حذر منه «أشد إطباقًا على الموتى، وأعتى في شراسته على الأحياء».
في ديوان «الحياة كما لم تحدث»، يُعِيد شوقي بزيع الإشراقة لتلك الغنائية الحزينة والشجية التي وسمت أشعار «أبيه» الذي هو بدر شاكر السياب. لكنها غنائية تحيلنا إلى غنائية الشعراء الألمان؛ إذ إنها لا تخلو من أفكار فلسفية حول الحياة والموت وفقدان الأوطان وانهيار القيم وانتشار الظلمات والفوضى الخلاقة في عالم عربي تمزقت أوصاله فبات أشلاءَ مرميةً في صحراء موحشة تحلِّق فوقها الطيور الكواسر.
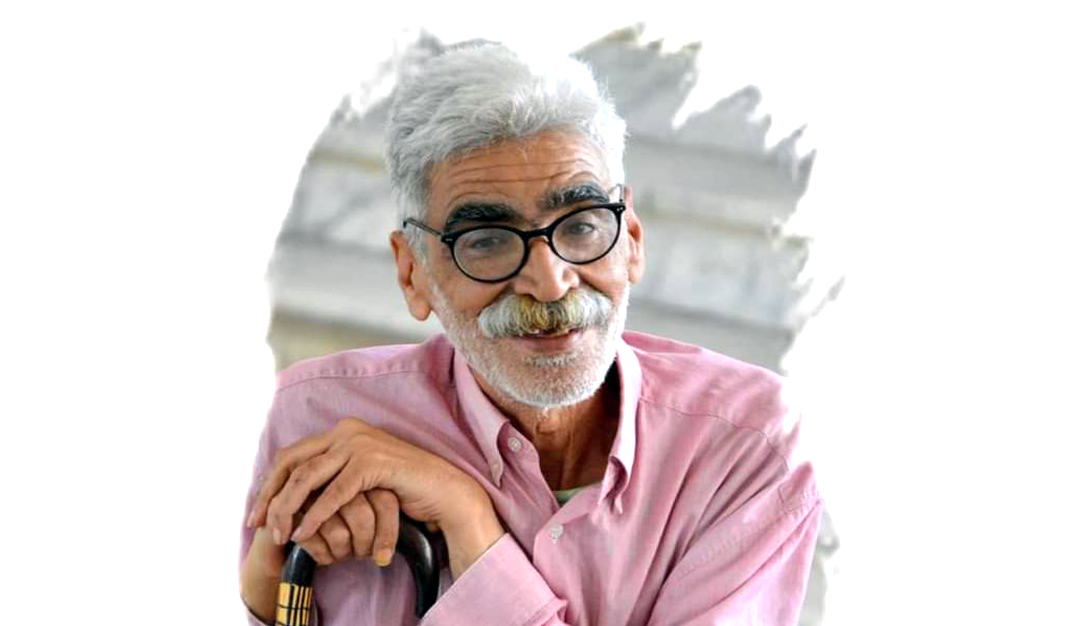









 ولم يتردد المنصف بن سالم، وهو أحد كبار قادة حركة النهضة في إظهار كراهيته لرموز النخبة التونسية الذين صنعوا مجد الثقافة التونسية في مراحل مختلفة من التاريخ المعاصر، مطالبًا بحذف نصوصهم من البرامج المدرسية، وناعتًا جماعة «تحت السور» بـ«الكحوليين المارقين عن الدين». وقد استغلت الحركات السلفية المتطرفة هيمنة حركة النهضة على المشهد السياسي في المدة الفاصلة بين 2011 و2014م لكي يُجاهر قادتها وأنصارها بعدائهم المطلق لمختلف التعابير الأدبية والفنية. وفي غياب كامل للردع، ولغياب القوانين، دأب هؤلاء على مدى ثلاث سنوات على التهجم اللفظي والمادي على الفنانين، والمثقفين.
ولم يتردد المنصف بن سالم، وهو أحد كبار قادة حركة النهضة في إظهار كراهيته لرموز النخبة التونسية الذين صنعوا مجد الثقافة التونسية في مراحل مختلفة من التاريخ المعاصر، مطالبًا بحذف نصوصهم من البرامج المدرسية، وناعتًا جماعة «تحت السور» بـ«الكحوليين المارقين عن الدين». وقد استغلت الحركات السلفية المتطرفة هيمنة حركة النهضة على المشهد السياسي في المدة الفاصلة بين 2011 و2014م لكي يُجاهر قادتها وأنصارها بعدائهم المطلق لمختلف التعابير الأدبية والفنية. وفي غياب كامل للردع، ولغياب القوانين، دأب هؤلاء على مدى ثلاث سنوات على التهجم اللفظي والمادي على الفنانين، والمثقفين. ومن بين المظاهر السلبية الأخرى، قلة المجلات والملاحق الثقافية التي تُعنَى بالآداب والفنون. والمجلتان الوحيدتان اللتان تصدران راهنًا، لكن ليس بانتظام دائمًا، هما «مجلة الحياة الثقافية» التي تشرف عليها وزارة الثقافة بشكل مباشر، ومجلة «المسار» الناطقة باسم اتحاد الكتاب التونسيين. لكن اهتمام القراء بالمجلتين المذكورتين يكاد يكون منعدمًا؛ إذ إن المواد المنشورة في كل عدد من أعدادهما تفتقر إلى المستوى الأدبي والفني المطلوب. وليس ذلك بالأمر الغريب. فرئيس تحرير مجلة «الحياة الثقافية» التي أسسها الكاتب الكبير محمود المسعدي، يشرف على تحريرها كاتب بمجموعة قصصية واحدة، كل قصة من قصصها لا تتجاوز السطرين. وحجته في ذلك هو أنه من مبتكري ما يُسمّى بـ«القصة الومضة». أمّا مجلة «المسار» فيديرها من لا يفكرون أصلًا في الثقافة، بل في مصالحهم الخاصة التي لا يضمنها لهم سوى البقاء على رأس اتحاد الكتاب…
ومن بين المظاهر السلبية الأخرى، قلة المجلات والملاحق الثقافية التي تُعنَى بالآداب والفنون. والمجلتان الوحيدتان اللتان تصدران راهنًا، لكن ليس بانتظام دائمًا، هما «مجلة الحياة الثقافية» التي تشرف عليها وزارة الثقافة بشكل مباشر، ومجلة «المسار» الناطقة باسم اتحاد الكتاب التونسيين. لكن اهتمام القراء بالمجلتين المذكورتين يكاد يكون منعدمًا؛ إذ إن المواد المنشورة في كل عدد من أعدادهما تفتقر إلى المستوى الأدبي والفني المطلوب. وليس ذلك بالأمر الغريب. فرئيس تحرير مجلة «الحياة الثقافية» التي أسسها الكاتب الكبير محمود المسعدي، يشرف على تحريرها كاتب بمجموعة قصصية واحدة، كل قصة من قصصها لا تتجاوز السطرين. وحجته في ذلك هو أنه من مبتكري ما يُسمّى بـ«القصة الومضة». أمّا مجلة «المسار» فيديرها من لا يفكرون أصلًا في الثقافة، بل في مصالحهم الخاصة التي لا يضمنها لهم سوى البقاء على رأس اتحاد الكتاب…


 وفي شهر أيّار- مايو من السنة التالية (1815م) عاد غوته من جديد إلى منطقة الراين الجنوبية. وخلال رحلته عاش قصّة حبّ عاصفة ستبدو آثارها جليّة في «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي». فقد نزل غوته ضيفًا على صديقه القديم فيلمير. وهو شخصيّة من شخصيّات فرانكفورت المرموقة. وكان فيلمير قد تزوّج قبل عام فتاة جميلة تدعى ماريان تصغره بخمسة وعشرين عامًا. وكانت ماريان قارئة نهمة. وكانت قد أتت على جميع مؤلفات غوته. لذلك انجذبت إليه، وخفق له قلبها حبًّا من النظرة الأولى. وفي «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» سوف تصبح ماريان «زليخة»، امرأة العزيز التي راودت النبي يوسف عن نفسه. أما غوته فسوف يختار لنفسه اسم حاتم. في القصيدة التي تأتي في خاتمة كتاب «زليخة»، يقول غوته:
وفي شهر أيّار- مايو من السنة التالية (1815م) عاد غوته من جديد إلى منطقة الراين الجنوبية. وخلال رحلته عاش قصّة حبّ عاصفة ستبدو آثارها جليّة في «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي». فقد نزل غوته ضيفًا على صديقه القديم فيلمير. وهو شخصيّة من شخصيّات فرانكفورت المرموقة. وكان فيلمير قد تزوّج قبل عام فتاة جميلة تدعى ماريان تصغره بخمسة وعشرين عامًا. وكانت ماريان قارئة نهمة. وكانت قد أتت على جميع مؤلفات غوته. لذلك انجذبت إليه، وخفق له قلبها حبًّا من النظرة الأولى. وفي «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» سوف تصبح ماريان «زليخة»، امرأة العزيز التي راودت النبي يوسف عن نفسه. أما غوته فسوف يختار لنفسه اسم حاتم. في القصيدة التي تأتي في خاتمة كتاب «زليخة»، يقول غوته:




