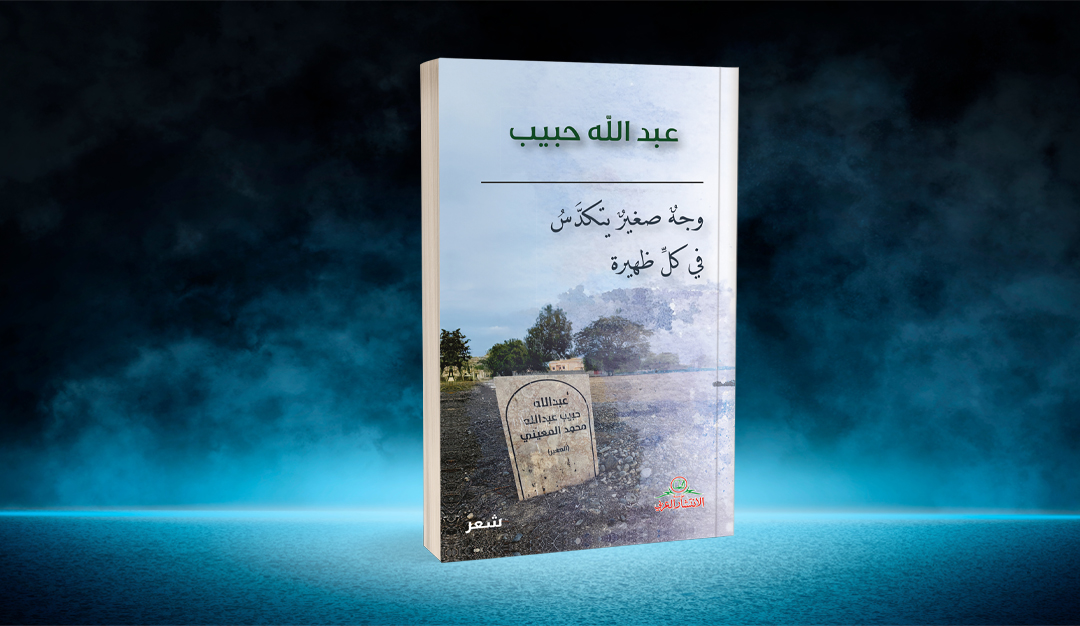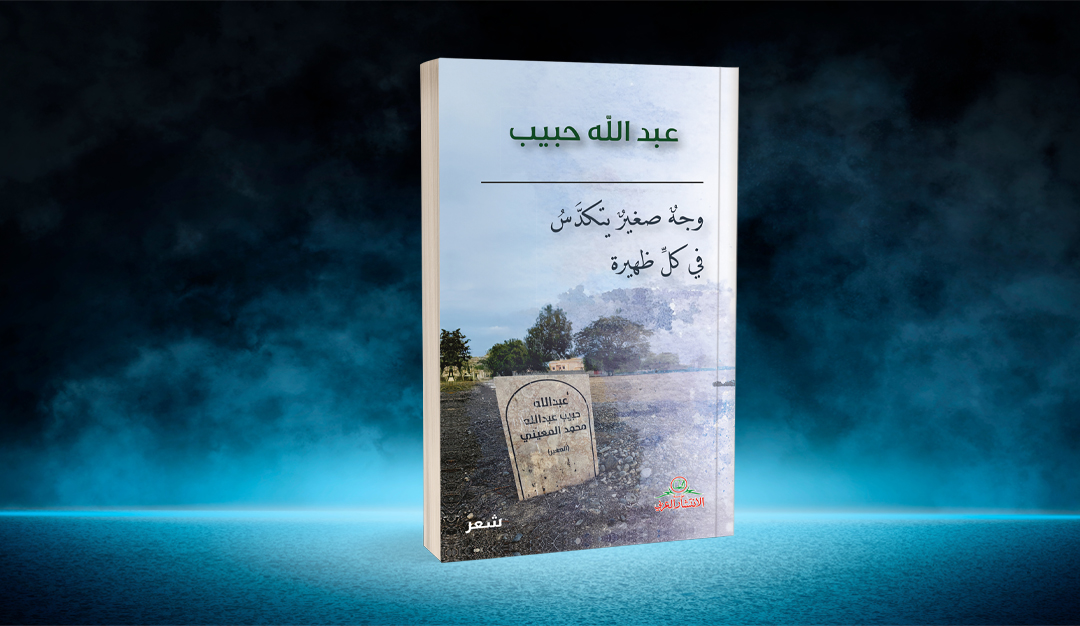
عماد الدين موسى - كاتب سوري | يناير 1, 2025 | كتب
يصعب تصنيف قصيدة الشاعر العماني عبدالله حبيب (من مواليد 1964م)، في خانة بعينها «الشعر» أو «النثر»، فهي عبارة عن «نص مفتوح وعابر للأنواع» على حد تعبير الناقد المؤسس عزالدين المناصرة، وأقرب ما تكون إلى لقطات سينمائية أو إسكيتشات مسرحية، عدا أنها لا تشبه إلا نفسها، وفيها من عموم الأدب وبقية الفنون الإبداعية الأخرى، بما فيها تقنيات تخص الموسيقا أيضًا.
في كتابه الشعري الأحدث «وجهٌ صغيرٌ يتكدسُ في كل ظهيرة» (دار الانتشار العربي)، يحلق الشاعر عبدالله حبيب بعيدًا مع الذكريات وحدها. ثمة روح شعرية شفيفة، وغاية في الرقة والإدهاش على طول الصفحات، تجوب عوالم المخيلة كانتقال النحل من وردة لأخرى، أو طائر من غصن لآخر.
القصيدة هنا، قطعة من الطبيعة، مشحونة بطاقة -هائلة وهادئة في الآن معًا- من مفردات وعبارات تخصها وحدها. في قصيدة بعنوان «بحر» يقول الشاعر:
«رأيتُ البارحة أنكِ عدت/ لم يعد الأمر يهمني كثيرًا/ لكني سأذهب الآن إلى آخر البحار/ تاركًا للسرير أكثر الظلال والطحالب وحدةً على الأرض».
ثمة نهاية مفتوحة ما نجده في القصيدة السابقة، تترك الباب مواربًا على المزيد من الاحتمالات والتأويلِ، وهو ما ينسحب على جل قصائد هذا الكتاب، الواقع في 80 صفحة من القطع المتوسط.
الكتابةُ مُسرنمًا
يكتبُ صاحب «صورة معلقة على الليل» (1993م)، بماء الحُلمِ، يكتب وكأنه مُسرنم فيما القصيدة تُدون من تلقاء نفسها. حيث الشغب الطفولي وحده يخيم على أجواء الكتاب، لكأنه كتاب طفولة، ليست طفولة الشاعر فحسب، بل طفولتنا جميعًا ودونما استثناء، هنا «قطة تموء في مخزن بيت العائلة»، وهناك «كسرة خبز تتحشرج»، و«لم تكن العشرينيات موعد الحب»، و«كلب يعض نفسه».. وغيرها كثير من العبارات الحميمة التي تخص الماضي والطفولةِ معًا. يقول:
«نزرع ذكريات في البحر ونُلونها/ الليل نَسحبُه مقطورًا على عجلات/ العُمرُ غفوةٌ مخمورةٌ على شعر رأسك الأسود الطويل/ وإذْ تمطر بغزارة/ أتعكز بمظلتي/.. لأنني مُثْقَلٌ بالذكريات».
البساطة حد الهشاشة هو ما نجده في المقطع السابق، غير أن الشاعر بدهائه يُهندس النص كما لو أنه قطعة موسيقية تنتهي بقفلةٍ مُبهرة.
تعال أيها المسدس
تزخر قصيدة عبدالله حبيب، من الناحية الأسلوبية، بعنصر المفاجأة؛ إذْ يكاد لا يخلو أي مقطع من كتابهِ «وجهٌ صغيرٌ يتكدسُ في كل ظهيرة» من جمالياتِ هذه التقنية، وتحديدًا في النهايات حيث بؤرة التوتر، جنبًا إلى جنب مع تقنيات أخرى تخص القصيدة المعاصرة. ثمة لغة شديدة السلاسة والتجانس، بينما الجُمل تبدو آلية، عفوية، تلقائية وبسيطة، أكثر من كونها مبهمة أو شديدة الجزالة، فيما القفلة أو الجملة الأخيرة تكون مغايرة ومختلفة، بل مباغتة أيضًا، محققة بذلك شرط الدهشة والانبهار لدى القارئ. في قصيدة بعنوان «أم» يقول الشاعر:
«سأتظاهر الليلة بالطيبة للمرة الأخيرة/ تعال/ تعال/ ليست هناك ليلة أخرى/ تعال أيها المسدس».
النبرة الدرامية في القصيدة السابقة، وتحديدًا من خلال تكرار كلمةِ (تعال) جعلتْها في تصاعد هادئ ومفاجئ في الآنِ معًا، وصولًا إلى الذروةِ غير المتوقعة، حيث (المسدس) دونًا عن أية مفردة أخرى قد تخطر للقارئ، كـ(الموت) على سبيل المثال لا الحصر.
السينما في الشِّعر

عبدالله حبيب
مثلما يحضر الشِّعر وتحضر الشِّعرية في أفلام عبدالله حبيب السينمائية، كذلك تحضر السينما في شِعره. طالما «أن لغة السينما هي جوهريًّا لغة شِعرية» بحسب الإيطالي بيير باولو بازوليني في نصه النظري «سينما الشعر»، هذا الحضور يطغى على اللغة والأجواء وعوالم القصائد وهو جزء أساسي من بنيتها وتشكيلها.
نقرأ بين ثنايا قصائد الشاعر حبيب عن المشهد الافتتاحي من «القربان» فِلْم أندريه تاركوفسكي الوداعي، وفي مكانٍ آخر نقرأ عن مشاهدة فِلْم لميرنال سِنْ، المخرج السينمائي الراحل وأحد مؤسسي تيار (السينما الهندية الموازية)، كما نقرأ قصيدة بعنوان «ليس في فِلْمٍ لبارادجانوف»، سيرجي بارادجانوف المخرج السينمائي الأرمني/ الجيورجي الذي تمكن من إنجاز أفلام روائية شِعرية استثنائية حقبة هيمنة «الواقعية الاشتراكية» في الاتحاد السوفييتي سابقًا وغيرها.
في قصيدة بعنوان «عمر» يقولُ الشاعر:
«غدًا لن يحدث شيء/ غير منديل في الريح/ ودوران الكاميرا أمام جرح طفيف/ في حُلمٍ طفيفٍ/ عن حياةٍ أكثر خِفة من أفلام تاركوفسكي».
ما نجده في القصيدة السابقة من مزج حميم بين الشِّعر والسينما، يكاد يكون السمة الأبرز لقصائد هذا الكتاب.
القصيدة القصيرة
يبرع الشاعر عبدالله حبيب في كتابة القصيدة القصيرة والقصيرة جدًّا، التي تشبه إلى حد ما لعبة «الفلاش»، تلك الخالية من الحشو والزوائد اللغوية والملتقطة لمشهدٍ ما بروية وأناة. تكاد قصائد كتابه هذا ألا تتجاوز الصفحة الواحدة، وغالبًا ما تكون عبارة عن أسطر معدودة لا أكثر. ولعل ما يميز هذه القصيدة أولًا الاختزال المشهدي الشديد بتسليط الضوء على زاوية معينة، وثانيًا يتحرر الشاعر من الأوزان والتفعيلات أو ما يسمى بالموسيقا الخارجية ويكتفي بالموسيقا الداخلية للكلمات. في قصيدة «حرب» يقول الشاعر:
«دخانٌ وحليبٌ يتدفقان من مسامات الصخور/ جرحى يجرون بلدةً تحترق/ كلب يعض نفسه وهو يغطي انسحابًا مُرتَجَلًا/ حديقةٌ لا تكتمل».
ثمة طبيعة صامتة في القصيدة السابقة، الصمت بوصفهِ أعلى درجات الصراخ والانفجار وليس السكون أو الهدوء، وما العبارة/ الجملة الختامية سوى ضربة فرشاة أخيرة لإنهاء اللوحة/ المشهد.

عماد الدين موسى - كاتب سوري | مارس 1, 2021 | كتب

أحمد ضياء
يُعد «المسرح» الفنّ الأكثر قدرةً على تغيير مسارات التفكير والوعي، وهو ما يدفع الطغاة على أشكالهم وأجناسهم لاستغلاله في الترويج لديمقراطياتهم، فيتحوَّل إلى مشروعٍ غائي لرسالتهم الوحشية في افتراس البشر. الناقد العراقي أحمد ضياء في كتابه «فرانكفونيّة المسرح بين الأنا والآخر» (دار كنعان، دمشق 2020م)، يكشف في خمسة فصول كيف تسعى «الفرانكفونية» إلى احتلال العقول من خلال المسرح، بعد أن نزعت عنها خوذتها العسكرية.
بعد أن يُعرِّف المؤلِّف الفرانكفونية يرى أنَّ انتشارها جعل من الفعل الخطابي المفاهيمي حافزًا من أجل بيان المرمى البدائي، هادفًا إلى وضع يده على البلدان لنقلها إلى بر الأمان، وبعدها يجري الاتصال وتتماثل عبر أيديولوجيته المختلفة الكثير من المواقف؛ إذ تُفرَض ثقافة الانمساخ على الدول المُستَعمَرة وتُسلَب هويتها الثقافية والحوارية، وتزحف عليها لتزودها بإرث لا دخل لها به، ولكنَّها بهذا إنما تحاول أن تطبق انمحاءها التام على هذه الدول…
في الكتاب يتناول المؤلف تنوّع جغرافيا الفكر الفرانكفوني وما جاءت به، حيث تُبلور الفرانكفونيّة لمكمنها شرفة خاصة من أجل لفت الأنظار إليها وسحب كل الجوانب المعرفية المقامة ضمن المهيمنات الحياتية، وهي بذلك تأخذ مفهوم البراءة وتعمل عليه ضمن عباءة موسيقية عالية الفعل تتمخض عنها تلافيف استطاعت أن تكتسح التيارات كافة، وتعبئ الموقف حسب ما تخطط له من تسهيلات وحركات مستقبلية.
كما يرى الناقد أحمد ضياء أنَّ الفرانكفونيّة تتبنى الاشتباك مع ذوي الهوية الهشَّة من أجل تسيّد لغتها والاهتمام بها بشكل أكثر معرفة ومصداقية، والمثير هنا أن يسأل مثقف عربي، هو فؤاد العتر، كاتبًا مسرحيًّا من أهم أعلام الفرانكفونيّة صموئيل بيكيت قائلًا له: لماذا تكتب باللغة الفرنسية؟ فأجابه: لكي أُعذِّب نفسي، ولأجدَ صعوبة أخرى للكتابة، ربَّما هو نوعٌ من الإغراء أن تكتب بلغة تعرفها بدرجة أقل مما تعرف من لغات أو لغة معينة.
ويستنتج المؤلف أنَّ النموذج الفرانكفوني لا يقف عند بؤرة معينة، «ففي الفرنسية، وهي لغة لا تكترث كثيرًا للجهة التي انطلق منها الكاتب. يكون التذويب شغلًا أساسيًّا داخل هذه المنظومة الكبيرة؛ لأنَّها تسعى إلى سلب الآخر من هويته، وإلحاقه إلى داخل كوكبة إبستمولوجية جديدة تغاير منظومته ومفاهيمه، وتسعى إلى خلق حوار معه من أجل الدخول في خطاب مغاير لطبيعة البيئة التي كان يقطن فيها، وهو الأمر الذي يحتِّم عليه وجود أكثر من مفهوم ومرجعية بهذا الشكل المختلف».
فرانكفونيّة الأجناس الأدبيّة
يرى المؤلِّف أنَّ الحضور القوي للجسد الفرانكفونيّ على خشبة المسرح رغم تشوهاته، يمثِّل استراتيجية للتحول الإيجابي؛ لكونه يتعلق بمسألة المقاومة الإمبريالية. فهذه التجسيدات تساعد الممثل/ الكاتب على بث خطابه من الركح أو النص، وكذلك ينبغي ألّا يكون الإنسان المنتمي للحراك الفرانكفوني ممسوخًا أو خاليًا من مرجعياته كافة، بل عليه امتلاك التعددية؛ لأنه جزء من الانتماء الجديد المتمثل في الحداثة الخصبة التي يتلقاها في إطار الاستحداث والاستهلال، لجعله متمسكًا بالعتبات الأولية ومغادرًا إليها في الوقت ذاته.
وقد جاء تمتين الفعل المسرحي المتثاقف من المهاجرين عبر سلسلة من الاتفاقات المنعقدة بين الدولة الأم للمهاجر، والدولة الحاضن فرنسا، مما هيّأ لهم مناخًا استيطانيًّا رسميًّا؛ لذا نرى المسرحي الفرانكفوني الجزائري كاتب ياسين قد كتب عددًا من المسرحيات مُثِّلَت لشهورٍ متواصلة «كانت المسرحية تثير الحماس أينما عرضت. والمشاهدون الفرنسيون رأوا في المسرحية نتاجًا مهمًّا للعالم الثالث وتجدر الإشارة إلى أنَّ مسرحية (محمد احمل حقيبتك)! تركت أثرًا بالغًا في الصحف والأوساط الفرنسية».
يحلِّل أحمد ضياء أربعة نماذج مسرحية فرانكفونية مقترحة لمعرفة الامتدادات التأثرية على المنتج المسرحي. حيثُ نقرأ عن مسرحيّة «في انتظار جودو» 1970م لصموئيل بيكيت، التي يعدّها المؤلف الجانب الضمني المتشح بعبثية البقاء أو المثول إلى الواقع، وهو الانحسار أمام الآخر لما يملكه من قوَّة وهيمنة من شأنها خلق فجوة بينه كمسافر وبين الابن الشرعي للبلد.
في مسرحيّة «العارض» 1975م للكاتبة اللبنانية المصرية أندريه شديد تُحدد عدد القضايا الفرانكفونيّة المتغلغلة في ذاتها لا إراديًّا، وهي تتشح بسلسلة من المواقف المتجذِّرة في كوامنها لأنها العنصر الأساس في تشكلاتها المعرفية، فلا تتوقف في بث خطابها الإستاطيقي على الصُّعُد كافة؛ لأن مسرحية «العارض» تشكل البذار الأوَّل للمكونات القمعية التي تؤرِّخ لمهمة إخراجه بطريقة أكثر وعيًا ومقبولية لدى القارئ.
في مسرحية «فن Art» تأليف ياسمينا رضا، إخراج باتريس كاربرا 1994م. يرى الناقد ضياء أنَّ العرض أضحى قابلًا للتأويل وتأكيد مفاهيم السلطة وتدويرها تحت طائلة مختلفة من شأنها التركز على نهايات الأشياء، أي الأداءات الراشحة من الصدام الفكري الذي تضعه الدول الفرانكفونيّة إزاء منتوج الآخر، ومن ثم؛ تمثلَ العرض بإظهار سلطوية المثقف الآخر على المهاجر راغبًا بتمييع الحواجز كافة، وجعل التلاحم هو الغاية الرئيسة من العرض؛ لأن هذا الأمر لا يزعزع أي ركن من أركانها أي (الفرانكفونيّة)، فالخاص الجمعي من كل الأمور هو اختراع باب التثاقف كحَلٍّ لصهر اللامألوف في الأشياء، ويحيلنا إلى طمأنينة التعامل والتوافق مع المواطن الأصلي أو الآخر الوافد.
في مسرحيّة «الحب عن بعد» لأمين معلوف 2002م. وبرأي المؤلف فهي تعالج مسألة النيوكولونيالية المتمركزة ببعديات الخطاب وما يترتب عليها من تداعيات مختلفة، وهذه المتطلبات تأتي كماركة عقلانية تستطيع جلب مواقف مكَّنت الأيديولوجيا من الدخول في تيار المسرح المعاصر، وهي بهذا تموج بأسلوبيات تضعه أمام العتبات الحقيقية الواصفة لتنظيم معالج، يربط بين قالبين ويحقق بعدًا شموليًّا متساميًا يغوص بالبيئة الجديدة الراديكالية، ويكتفي بوجود ثيمة الحب مِن بُعْد للدولة المركزية المعوَّل عليها ألا وهي فرنسا.
ويخلص الكاتب إلى جملة من النتائج لعلَّ من أهمِّها؛ الاكتساح الثقافي كحاصل ضمور في الثقافات المجاورة، لذا شعَّ المجال الفرانكفوني وتبلور قوامه حيث حاول أن يعوِّم المعارف كافة لإبراز خطابة السلطوي المهيمن، وكذلك الإحساس بالهوية الجديدة، وهو الثورة الحقيقية النموذجية التي ترغب فيها الفرانكفونية، وأيضًا العمل على تحيين الأفعال والأعراف المسرحية وتوضيبها إبستمولوجيًّا.

عماد الدين موسى - كاتب سوري | نوفمبر 1, 2019 | كتب
تعد رواية «آخر رمانات العالم» (ترجمها إبراهيم خليل وعبدالله شيخو وصدرت عن دار مسكلياني) من أهم أعمال الكاتب الكُردي بختيار علي (1960م)، ونقطة التحوّل الأبرز في مساره الروائي؛ إذ ترجمت إلى عدد من اللغات العالميّة الحيّة مثل: الألمانيّة والإنجليزية والفارسيّة والإيطاليّة والعربيّة مؤخّرًا. وصفها الناقد الألماني شتيفان فايدنر بأنها «قنبلة بكل معنى الكلمة». في هذا العمل، يدوّنُ بختيار علي تفاصيل رحلة أبٍ يبحثُ عن ثلاثة أبناء مفقودين، يحملون الاسم نفسه، بينما لكلّ واحد منهم حكاية مختلفة، تكاد تكون قائمة بذاتها.
تبدأ الرواية من النهاية؛ حيث (مظفري صبحدم) بطل الرواية في سجنه، يسرد خواطره وحديثه ونجواه مع صحراء لا نهاية لها، وجدران أربعة لسجن بقي فيه 21 عامًا، بعد أسره من بين قوات البشمركة؛ لتعود بالقارئ إلى البداية، ويعود معها مظفري يسرد قصته في السجن، ومواقفه، ووجهة نظره التي هي وجهة نظر الكاتب (بختيار علي) نفسها عن العالم والوجود، والغوص في أعماق التاريخ المأساوي للشعب الكردي في العراق؛ في ثمانينيات القرن الماضي، وصولًا إلى تسعينياته؛ ليروي في أثنائها تفاصيل تلك الأحداث. سرد رائع لمراحل تاريخية؛ يبين فيه الكاتب مدى تأثر الإنسان بأحداثها، ومدى قدرته على تحملها، بعد أن وضعت تلك المراحل أوزارها، يصبح من الصعب تصديق كل ما جرى لهم فيها، ليكمل روايتها؛ التي هي في الأساس حادثة بحث مظفري عن ابنه (سرياسي) الضائع؛ ليجد ثلاثة أطفال يحملون الاسم نفسه، وثلاثتهم شربوا من عصير الرمان؛ الذي سميت الرواية تيمُّنًا به، وهم في المهد- ليعرّي لنا كل الظروف التي قتلت الطفولة، وكانت سببًا رئيسًا في وأدها؛ وهي على قيد الحياة في بلدهم- حيثُ لكل واحدٍ منهم طبيعة مختلفة عن الآخر، ونمط معيشة لا تشبه الثاني، فالأول يرد ذكره في سوق الباعة المتجولين الذين يحتمون به، فيدافع عنهم ويصبح بطلًا أسطوريًّا لهم، والثاني ينخرط في ساحات القتال، ويرغب في الموت الذي لا يأتيه، والثالث يعود إلى الوطن بعد اغتراب عنه مع المسافرين.
رحلة البحث عن سرياسي
يبحث بطل الرواية عن ابنه سرياسي، الذي كان الذكرى الوحيدة له في هذا العالم، ولم يستطع نسيانه؛ حتى في قلب الصحراء الواسعة؛ التي سيطرت عليه بكلّيتها، رياحها ورائحتها، وذرات رمالها المتناثرة، والتي كانت تلتهمه، وتلتهم ذكرياته معه، على الرغم من أنه صار يحب العلاقة الجدلية التي ربطته به في يوم خروجه إليها مع حارس وحيد كل شهر مرة واحدة؛ ليرسم آثار خطاه فيها لمدة مئة متر فقط، ثم يعود إلى سجنه الذي قضى فيه 21 عامًا، يشعر بالوحدة تأكله من كل جانب، والفراغ يمدّ أصابعه نحو كل شيء في عالمه الحالم؛ الذي كان يعيش قبل لحظات؛ في تلك الصحراء التي شكلت له دائرة جديدة؛ كان يرى فيها خلاصه، ورحلة عمر تتآلف رويدًا رويدًا مع زمنه الذي طحن عمره، ودفنه داخل تلك الزنزانة الخاصة به وحده؛ ليقبع في زواياها مرة أخرى؛ ناسيًا العمر، كيف يمضي، إلى أين! ليقرر فيما بعد، وبعد سبع سنوات ترك عملية الحساب في ذاكرته في السجن، فيكفّ عن عدّها، وينشغل بعالمه الوحيد مثله، والعالق في صحراء واسعة، وبين رمالها التي نالت من كل شيء في ذاكرته؛ إلا من ابنه سرياسي؛ الذي لم تستطع كل تلك الأجواء أن تنسيه إياه، وما كانت رغبة الخلاص والانعتاق من ذلك السجن الصحراوي لديه إلا من أجل أن يبدأ رحلة البحث عنه، ليكتشف أن هناك (سرياسي ثانيًا وثالثًا)، مع ابنه (سرياسي) الذي صار الرقم الأول له، وليكتشف أن لكل واحد منهم طريقًا خاصًّا، وشخصية مختلفة عن الآخر، وطبيعة يصعب عليه الوقوف على حقيقة ابنه، وأي واحد يكون منهم؛ «لا يذهبن بك الظن أني ألقي الكلام جزافًا، فحين خلّفت «سرياسي صبحدم» ورائي كان عمره بعض أيام، ولم أكن أعلم حينها أن سرياس ثانيًا وسرياس ثالثًا في طريقهما إلى الحياة».
«في الصحراء، كنت رهين جغرافية خالية تمامًا من أيّ زخرفة، عالم بلا ديكور، عالم لا يشاركني فيه سوى ظلّي، عالم كان بقاء المرء فيه حيًّا هو الكون بذاته، وبقاء الروح رهين الرمل والسماء»؛ أزقة، سماء مغلقة وسوداء في سجن معتم؛ مثل حياته الجديدة، والمفتوحة على غاربها في تلك الصحراء اللامتناهية، ووطن تسبب له بكل تلك المصائب التي حلّت على رأسه؛ ليغدو معها كل شيء (الوطن- البشمركة- السياسة- الأطفال- الموت) ماضيًا هاربًا من مخيلته، ويتشوّه كل ذلك في داخله، وحقيقة أيضًا؛ بعدما خرج من السجن، ويبقى هو أسيره كلما حاول الهروب منه إلى الحاضر، إلا أنه يجده ممسكًا بتلابيب روحه؛ في حياته الحاضرة، ليقفز ذلك الماضي إلى الحاضر؛ بعدما تاه في غياهب الصمت والغياب طيلة واحد وعشرين عامًا، وتضعه في قلب المعمعة مرة أخرى؛ عندما بدأت أولى خيوط الذاكرة تجتمع؛ مشكّلة رغبة دفينة، قديمة وحديثة معًا، رغبة لم تمت بعد؛ بل ما زالت كما كانت مستيقظة؛ لأنها رفضت الموت والعدم، وأصرت على البقاء والعيش، فتدفعه إلى البحث مجددًا بقلب مفعم بالأمل، يحدوها عطش روحي في ذلك؛ لمعرفة أي خبر عن ابنه؛ فيتجدد الماضي الهارب، ويتواشج مع الحاضر في كل واحد؛ لينطلق محاولًا اقتفاء آثار ابنه؛ في شقاء لا نهاية له؛ «لا شيء مثل الرمال يلتهم ذكرياتنا، تنهض كل يوم لتكتشف أن جزءًا من ماضيك قد فرّ من ذاكرتك. لا… لم أَنْسَ قط سرياسي صبحدم، نسيت الكون بأسره ولم أنس سرياسي صبحدم، إنه الشيء الوحيد الذي لم يتحوّل إلى رمل، الشيء الوحيد الذي احتفظ بنضارته».
مآسٍ لا نهاية لها
يطلّ الراوي على الواقع من دروب شتى، ونوافذ تسلط الضوء على الواقع الكردي، وحياة الكرد، ومآسيهم التي قضوها في تلك حقبة من الزمن، من دون أن يكون غرضه تأريخ الحوادث؛ بل إظهار القبح، وبشاعة المواقف والظروف التي مروا بها، بدءًا من الانتفاضة ضد صدام حسين، ومحاولة قمعه لها بالوسائل الممكنة؛ بما فيها استخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا؛ لتظهر نتائج تلك الهجمة الوحشية في مدينة (حلبجة)؛ التي قصفت بها، وانتهاء بالحرب الأهلية الكردية- الكردية، بين أعضاء الحزبين الكرديين اللذين كانا مسيطرين على الموقف آنذاك، لتعرض الكرد نتيجة كل ذلك لدمار شامل، وليعيشوا أحزانهم بسببها، فقد كان العالم في ذلك الوقت بحسب قوله: «يشع بالظلمة والسواد، وُلد في سنوات الجدران والزوايا الطينية، والأقبية السميكة والأبواب الموصدة، في عصر يعمل فيه جميع الناس في الخفاء/ الدولة تذبح خصومها في الخفاء، والخصوم كذلك يعيشون في الخفاء، في غدوّهم ورواحهم».
كانت الحرب الأهلية، وكان الموت في كل مكان؛ لأن الزمن هو زمن الموت، وقتل الأخوة لبعضهم، وكانت كل دعواه إلى العيش بسلام ورفع رايته مجرد وهم لا طائل منه؛ لأنها وقعت، ولم يسلم منها أحد؛ «لم تكن الحرب الأهلية قد بدأت يوم كنا جالسين تحت ظلال آخر رمانات العالم، لكنه كان يقول كمن يقرأ الغيب: «الآن نعيش زمن موت الأخوة، فلأتقطع إربًا إربًا، ولتكن أنت في خير وسلام.. إن لم نفعل ذلك فإننا ننتظر زمنًا ينهش فيه الأخ لحم أخيه كالذئاب».

عماد الدين موسى - كاتب سوري | مارس 3, 2019 | كتب
تبدو الكتابةُ في زمن الحروب والصراعات أشبه بتلك القشّة التي طالما تمسك بها الغريقُ، سواء علم بلا جدوى النجاةِ أم لم يعلم؛ لذا تأتي أغلب هذه الكتابات، إلا ما ندر، فاقدةً للأمل وغير مُجدية. وهنا، يمكننا أن نحصر ما يسمّى بأدب الحرب، في قسمين رئيسيين: الأوّل، سوداوي، كئيب، يزول بزوال الحرب، بالرغم من أنّه يُعد صورة حقيقيّة ومستنسخة عن الواقع المرير؛ في حين الثاني، إيجابي، مليء بالحبّ والأمل، ويُعتبر -دون شك- أدبًا عابرًا إلى المستقبل.
في مجموعتها الشِّعريّة الجديدة «رأيتُ غيمةً شاحبةً، سمعتُ مطرًا أسودَ»، الصادرة مؤخرًا عن دار النهضة العربيّة (بيروت 2018م)، تحاول الشاعرة هنادي زرقة ترويض «الحرب»، لا بوصفها مُفردة قاموسيّةً فحسب، وإنما باعتبارها غدتْ الجحيم الذي طالما نعيشه ويعيشُ معنا منذ سنوات، الجحيم الذي أتى على الأخضر واليابس من حياتنا وذكرياتنا، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، حزننا وفرحنا. حيثُ تقتفي الشاعرة أثرها من موتٍ أو دمار لحق بالبشر والحجر معًا، تقول: «جسدي بقايا أجسادٍ كثيرة/ ملايينُ ملايين الخلايا لبشرٍ ماتوا…/ هذا القلبُ المكسورُ أتيتُ به/ من شاعراتٍ أدمنَّ الحبَّ/ فرمى بهنَّ من شاهقِ العاطفة».
تذخر قصيدة هنادي زرقة بمزيدٍ من التضاد والمفارقات اللفظيّة والشِّعريّة، ولا سيما تلك المتناقضة والمألوفة، المُخيفة والمُحبّبة في الآنِ معًا؛ «الكفن الجميل»، و«الأسرة المدلاة من أغصانها»، و«صندوق عرسك الخشبي/ غدا تابوتًا لعشّاقي»، و«هل للحزن ألوان»، و«كان تفاحةً/ بات أصفرَ كالليمون»، و«لطالما خبّأت أمّي الأحزان عنّا في جيوبها كالسكاكر»، و«بيتٌ مقبرة»، و«ذاكرتي مسخٌ مخيف»، و«طفلي المولودُ من العدم»، و«أريدُ لذاكرتي أن تغدو بيضاء مثل كفن»، و«أمضي إلى الموت برائحة رضيعٍ/ غادر للتوّ رحم أمّه!»، وغيرها الكثير من هذه المفردات والجمل والعبارات، غاية في القساوة والإدهاش، نقرؤها بين جنبات قصائد هذه المجموعة. إضافة إلى كل ذلك، نجد أنّه ثمّة مزج حميم بين ثنائيّة «الواقع» و«الخيال»؛ إذْ ثمّة قدمٌ هنا وأخرى هناك، وهو ما يُذكّرنا بمقولة تُنسب للمتصوّف شمس الدين التبريزي، يقول فيها: «بين الواقع والخيال هناك برزخ إليه أنا أنتمي». في المقطع الذي حمل الرقم (9)، ثمّة العودة، تلك الرحلة العكسيّة من الفناء إلى الأزل، حيثُ لا شيء يغرينا، وكل شيء في مهبّ الريح، وما الريح سوى الحرب التي تعصف بنا؛ تقول الشاعرة: «غدًا أعودُ إلى الترابِ/ غدًا تنمو القصائد على أجسادِ نساء غيري/ غدًا أفرحُ إذ تنزعُ إحداهنَّ قطعة قلبي الواهنة/ وترميها للريح».
مجموعة «رأيتُ غيمةً شاحبةً، سمعتُ مطرًا أسودَ»، التي جاءتْ في مئة وإحدى عشرة صفحةً من القطع المتوسط، هي الإصدار الشِّعري السادس للشاعرة هنادي زرقة؛ إذْ سُبق لها أنْ أصدرت المجاميع الشِّعريّة التالية: «على غفلة من يديك» (2001م)، و«إعادة الفوضى إلى مكانها» (2006م)، و«زائد عن حاجتي» (2008م)، و«الزهايمر» (2014م)، و«الحياة هادئة في الفيترين» (2016م).
في هذه المجموعةِ؛ ثمّة قلق وجودي حول ماهيّة الحياة والموت، يُسيطر على أجواء مُعظم القصائد؛ إذ تكتفي الشاعرة أحيانًا بوصف المشهد المُلتقط وتركه هكذا كما هو تمامًا، وفي أحيان أخرى تحاول طرح المزيد من الأسئلةِ؛ لكونِ الشِّعر في أحد أبرز وجوهه عبارة عن البوح الشفيف، إذْ تترك القارئ في مهبّ الحيرة وحدها، من دون أن تُفضي الأسئلة إلى أي برّ في رحلةِ بحثنا عن أجوبةٍ لتلك الأسئلة، التي تذخر بها قصائد هذه المجموعة، تقول الشاعرة: «لستُ أعلمُ كيف أرسمُ الحزنَ،/ لكنّ ظلًّا يمتدُّ كظلِّ الحرب،/ ظلٌّ يغطي جثّة البلاد/ جثّتي باللون الأحمر».