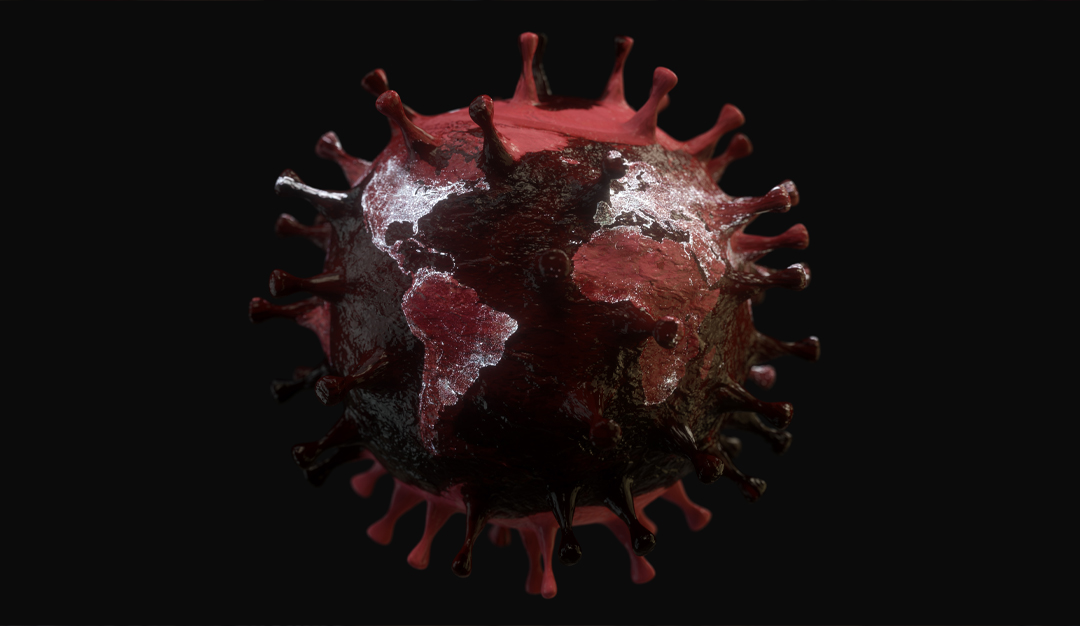
ماجد الشيباني - كاتب سعودي | يناير 1, 2023 | مقالات
رافق أحداث جائحة كورونا نشاط عقلي تكشف لنا من خلال الوفرة من المقالات العلمية التي كانت نتيجة للتباين في الأمكنة، بمعنى أن كل بقعة جغرافية لها الحق في النشر. إذا كان الزمان يؤكد لنا أهميةً تاريخيةً فإن المكان يفضي إلى أهمية جغرافية، سواء كان المقصود بالمكان منطقةً، إقليمًا، أرضًا أو سطح الأرض. مفرد الأمكنة؛ مكان، ومفردة المكان نفسها في اللغة ظلت حائرة؛ لم تجد دلالتها خارج كونها لفظة تعبر تعبيرًا واضحًا عما يُراد منها، هو الذي يكون فيه الشيء ثم يفارقه بالحركة، وهو ما يحل فيه الشيء أو ما يحوي ذلك الشيء ويفصله عن باقي الأشياء.
في البدايات، وأمام هذا الزخم الكبير، لم تكن الرؤية واضحة، وتأكد أننا أمام مشكلة حقيقية يصعب معها التنبؤ في احتواء المشكلة مستقبلًا، وما كان من التقاطات الألسنة تأويلًا لهذه الدراسات سوى أحاديث تأتي بحماسة على طريقة التفكير بصوت عال، وبعضها الآخر أقل حماسة لكون المتحدث في حيرة من أمره. وبعضٌ لازمه الصمت؛ يتأمل من صومعة الاعتزال القسري في مآلات الحدث، وأشدها تلك النظرة غير العلمية تجاه الحدث من طائفة بات لها وجود على طريقة الكوجيتو الديكارتي «أنا أشك إذن أنا موجود»، ولكن بطريقة عكسية فأصبحت تشكك في كل شيء، لا لشيء يخص جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة، بل من أجل إراحة عقولها، والسخرية ممن يقومون بإجراءات الوقاية؛ فهي في نظرهم وقاية مفرطة!
نشاط عقلي يمكن النظر إليه كما ننظر إلى أثر الجائحة نفسها، فلم تكن قصة المواجهة بين أجهزتنا المناعية وبين أي تهديد خطر لأحد العوامل المسببة للمرض بالشيء الجديد الذي قد يكشف عن حقيقة ما تختلف عمّا عرفناه من حالات التأثر التي تتعرض له أجسادنا في حال حصل اختلاف طفيف في المستضدات الموجودة في العامل المسبب للمرض. ولكن في نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، فوجئ العالم بأكمله بملامح في الأفق لخطر قادم من جهة الشرق، يتفاقم وضعه كلما تقدم به الوقت. لم يكن أحد ليصدق هذا الانتشار السريع في التقاط الفيروس الذي حقق جغرافيًّا العلامة الكاملة في الاحتواء لكوكبنا الأزرق، فاعتُرِفَ به كجائحة لترتفع الاحترازات الصحية.
ما قبل العقل اليوناني
هذا النشاط العقلي الذي تكشف لنا كان قد خرج من مؤسسات أكاديمية، لكنه ليس بالشيء الجديد كنشاط عقلي يؤرخ فلسفيًّا مع العقل اليوناني في حقبة ما قبل ازدهار المؤسسات الأكاديمية، مع الإشارة إلى وجود مدارس في تلك الحقبة، لكنها لم تكن تعمل بالنظام نفسه الذي نراه الآن، من صرامة في تطبيق أدوات العلم على كل لغة موضوعية.
أمكن تمييز مرحلة تسبق العقل اليوناني في الكشف عن النشاط العقلي الإنساني، فلغرض التجارة كان النشاط العقلي ولأن الأرقام أكثر من أن تحفظها ذاكرة كانت الكتابة.. هذه التحولات النفعية جاءت بعد الثورة الإنسانية الأولى في الكشف عن الزراعة، أول ثورة كبرى في المجتمع الإنساني رافقها استئناس الحيوانات والغزل والنسيج وصناعة الخزف وما تلي ذلك من استخدام المعادن. كانت الزراعة سببًا في وجود أوجه النشاط الاجتماعي وفي إبراز أهمية العلم؛ لكون فكرة التجارة في شكل التبادل العيني تحتاج إلى ضرب من المعايرة، وقد وثقها الدكتور برنال في كتابه «رسالة العلم الاجتماعية».
 ونجد أيضًا في عملية توثيق أقدم اختبار معروف على سوائل الجسم لتشخيص مرض السكري، التي نستعرض فيها هذا النص الذي جاء توثيقًا من الدكتور نهيد علي في كتابه «أنت والسكري»: «فقد تضمنت الكتابات الهندية القديمة أن النمل الأسود والذباب كان يحوم حول بول السكريين. وقد كتب سوشروتا، وهو طبيب هندي عاش في فترة تقرب من أربع مئة سنة قبل الميلاد، يصف البول لدى السكريين وطعمه الحلو، وبعد ذلك اعتقد الأطباء أن حلاوة البول هي إحدى علامات السكري».
ونجد أيضًا في عملية توثيق أقدم اختبار معروف على سوائل الجسم لتشخيص مرض السكري، التي نستعرض فيها هذا النص الذي جاء توثيقًا من الدكتور نهيد علي في كتابه «أنت والسكري»: «فقد تضمنت الكتابات الهندية القديمة أن النمل الأسود والذباب كان يحوم حول بول السكريين. وقد كتب سوشروتا، وهو طبيب هندي عاش في فترة تقرب من أربع مئة سنة قبل الميلاد، يصف البول لدى السكريين وطعمه الحلو، وبعد ذلك اعتقد الأطباء أن حلاوة البول هي إحدى علامات السكري».
هذه الحكاية تكررت كثيرًا في التقاط تاريخي في علم طب المختبرات منذ العصور القديمة وغالبًا ما تُنسب إلى الإغريق! ثمة أشياء ساطعة خارج مجال رؤيتنا وقد تبدو وكأنها لم تحدث أبدًا، قصور في الانتباه كامن في البواطن بحجة أن التوقف عند هذه المحطة والاعتراف بفضل الإغريق في تعزيز النشاط العقلي متطلب ساهم في وجوده فكرة المؤسسات الأكاديمية نفسها!
عمل المؤرخ لا يقل أهمية عن عمل المترجم، فلا بد له من معانقة التاريخ في بداياته؛ لأن في ذلك العمق التاريخي أهمية وإن صاحبه ارتياب وشك. فهذه الشكوك، في حال التسليم بها، لا تدفع بأي حركة، ومن شأنها أن تشكل حاجزًا يصعب تجاوزه مع مرور الزمن، وبالتالي يخلق لنا مساحات من التباعد والانفصال ليؤكد بعد ذلك القطيعة الإبستمولوجية. ذلك المفهوم يعبر عن مراحل الانتقال الكيفي في تطور العلوم. والقطيعة هنا تنسب إلى غاستون باشلار الذي يرى أنها إعلان عن ميلاد علم جديد لا علاقة له بالماضي، ومن أجل الاتصال يتوجب على الباحث معانقة ذلك العمق التاريخي بعيدًا من إشراقة اللف والدوران في ظل غياب الأصل.
حصيلة من الأثر التراكمي لخبرات وعلوم يمكن وصفها في بداية تشكلها بالإبداع الذي يتبعه ابتكار. وهذا أمر يرفضه من يؤمن بمسألة القطيعة الإبستمولوجية؛ فهم ينظرون إلى أن العلم في مسار متقطع منفصل لا ثابت متصل، عكس ذلك الاتجاه المؤيد لأن يكون ثابتًا متصلًا لا انقطاع فيه وأن ما قد حصل من قفزات إنما صادف حظه في الزمان والمكان لأن يتحقق وأن يظهر على السطح كحقيقة علمية مسلم بها وأن يكون العالم بعدها في صورة مغايرة عمّا كان عليه في السابق.
وبفضل الاتجاه الأول أصبحت الفلسفة تميزًا إغريقيًّا، والعلم تشكل وجوده في الثورة الصناعية، والآلة البخارية مع الإنجليز. ولعلنا هنا نستحضر حكاية تتعلق بالشق الثاني الخاص بالعلم، ونستذكر فرح المؤرخ البريطاني إريك هوبزباوم بإنجاز بلاده، الذي دفعه إلى أن يقول في كتاب «عصر الثورة»: «هل ثمة إنسان في أي منحى من مناحي الحياة لم تنتعش آماله بعد رؤية المحرك البخاري الذي اخترعه جيمس وات؟». وأن يصف الثورة الصناعية، قائلًا: «ترى، ماذا تعني عبارة «اندلعت الثورة الصناعية»؟ إنها تعني أنه في وقت ما من ثمانينيات القرن الثامن عشر، سقطت للمرة الأولى في التاريخ الإنساني الأغلال التي كانت تكبل القوة الإنتاجية للمجتمعات البشرية التي أصبحت قادرة منذئذٍ على مضاعفة الناس، والبضائع والخدمات، على نحو مستمر سريع، حتى الوقت الحاضر، لا حدود له». وارتفع حماسه فقال: «إن تسمية هذه العملية بالثورة الصناعية تبدو أمرًا منطقيًّا منسجمًا مع التقاليد الراسخة، مع أن بعض المؤرخين المحافظين درجوا ذات يوم على إنكار وجودها، ربما بسبب خشيتهم من مواجهة المفاهيم الملتهبة، وهم يستخدمون بدلًا من ذلك مصطلحات تافهة من نوع التطور المتسارع».
ما بعد الثورة المعرفية والتقنية
مصطلح التطور المتسارع في نظر هوبزباوم مصطلح تافه، وإن أردنا وصفًا أكثر دقة لما يريد أن يوصله من معنى، هي نفسها تلك الإشراقة في اللف والدوران؛ لأن في التفاهة خلطًا في الأنساق. ولو كان حاضرًا معنا اليوم لأعاد النظر فيما قاله؛ ذلك لأن التطور المتسارع أصبح حقيقة. هذا فيما يخص التقنية، وليس الموضوع مجرد تطور في المحركات البخارية أو حتى المحركات الكهربائية أو تطورًا في صناعة الحديد والصلب، ولو أن الزمن توقف عند هذه اللحظة فلا أحد يمكنه نقد مؤرخ بحجم هوبزباوم. لقد وصل الفاصل الزمني لمسافات أقل في معيار الزمن بمجرد الالتحام في عصر المعلومات والإنترنت.
المصطلحات التافهة في نظر هوبزباوم ساهمت بعد رحيله في أن النظرة في عملية تكّون المعرفة الإنسانية من حيث طبيعتها وحدودها وعلاقتها بالواقع تُختزل في العلاقة الثنائية ما بين الذات والموضوع. ذات هي (أنا وأنت وهو) في مقابل ما يعلن عن نفسه بفعل (الموضوع)؛ قد أصبحت تقليدية؛ ذلك لأن هذه العلاقة باتت قاصرة في الوقت الذي نرى فيه الآن حضور التقنية على جميع الأصعدة. لم يعد العالم في ثورته المعرفية كما كان قبل الثورة المعلوماتية، التقنية بات لها حضور قوي في حياتنا ومن الصعب تجاهلها في كل المسائل التي تتناول مسائل الاستقلال العلمي وطبيعة ذلك الفضول المعرفي في أذهان البشر. وهذا يعني أن العلاقة التي كانت حصرًا بين الذات والموضوع أصبحت علاقة جديدة تستحضر الآلة وتستدعي الإنسان والعالم في علاقة تداولية. ولهذا برز مجتمع معرفي جديد تقوم بنيته الأساسية حول التقنية من أجل فهم الأطر الجديدة التي تستحضر التسارع في التغير وما يصاحبه من تصاعد في النمو الذي يطبع كل الوسائل في ممارسة الأنشطة المهنية.
ويبقى اختلاف العلوم في طرق البحث، وهذا يعني اتفاقًا في الغاية بحسب معايير علماء المنهج في الوصف، والفهم، والتفسير والتنبؤ. هذا التقارب في الغاية جعل من التقنية أساسًا في فهم العلم بكل تخصصاته لتتشكل معها قراءة جديدة حاضرة بهذه الأداة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تكويننا المعرفي.

ماجد الشيباني - كاتب سعودي | مايو 1, 2020 | مقالات
كان كل ما يفعله الإنسان البدائي هو التسلط على العالم الخارجي؛ من أجل الحصول على الطعام وتجنب الألم والموت، فكانت الأسرة أصلح له من البقاء وحيدًا، والقبيلة أعم نفعًا من الأسرة للبقاء على قيد الحياة. ومنذ وقت مبكر جدًّا بدأ الفرد بالتحول تدريجيًّا من كائن لا تحركه سوى غريزة البقاء إلى غريزة تقدير الذات ومنها إلى تقدير الذات العام، ليتشكل مع الوقت السر الخفي في أتون الكفاءة والإمكانية. وما هو عام وما هو شخصي يكمن في فضاءات هذه الغريزة من التقدير، وحين نتأمل ذلك لا يمكننا تجاهل تنبيه فرويد في أن تجاوز هذه الغريزة يأتي بما هو أسوأ، أي: النرجسية، فنلاحظ أن حب الذات سمة طبيعية في مراحل نمو الطفل المبكرة، فإذا أصبحت هذه السمة مفرطة في الظهور صارت حالة مرضية، وتحول التمركز الغريزي حول الذات إلى عائق يمنع رؤية العالم الخارجي.
ومع أن في معنى التمركز رفعةً وسموًّا، وفي تقدير الذات العام فكرة أساسية تحتم على الأفراد عدم الإفراط في التقدير لجماعة ما حتى لا يحدث تجاوز على الآخرين؛ إذ كثيرًا ما مرت سلسلة من المواضيع بقصدية إنسانية قبل انحرافها عن مسارها الطبيعي، لكن في هذا المسار يلوح السؤال الحائر المحمل بكل مآلات التكنولوجيا: هل يجدر بالباحث الانشغال بقضايا تمركز جماعة ما (التمركز الغربي أو المركزية الأوربية مثلًا) أم عليه التوقف تمامًا حتى لا يتهم بالذاتية في عمله؟
عندما يتعلق الأمر بوصف حركة ما أحدثت تغيرًا كونيًّا وتُعرّف بأنها ثورة، يجب علينا أولًا وقبل كل شيء أن نتأمل في مسألة التاريخ وكيفية عمل المؤرخ (الذي مناطه الزمان كما هو المكان بالنسبة للجغرافي)، وأن يكون تأملنا تأملًا عميقًا على نحو يفضي
إلى ضرورة النظر في أي مسافة زمنية ممكنة قد تنتهي معها المادة التاريخية؛ أي: المخطوطات والآثار والوثائق، وهي أدوات يشتغل عليها المؤرخ متتبعًا دلالة الرموز فيها، وعمله هذا الذي بدأ بجمع المادة التاريخية وفرزها وتحليلها وتركيب وقائعها استنادًا إلى المنهج التأويلي لا بد أن ينتهي بالذاتية في اللغة. وقد لا يجد المؤرخ صعوبة في رسم حدود التغيرات المؤثرة في مسيرة المجتمع الإنساني سواء كانت اجتماعية، أو ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، متى كانت الأدوات والمادة التي يشتغل عليها متوافرة. فلولا عمل المؤرخ واجتهاده ما عرفنا متى كانت لحظة انطلاقة الإنسان الأولى في الزراعة، مرورًا بعصور وحقب طويلة استمر فيها التطور، وارتقت فيها قدرات الإنسان الصناعية والتقنية، وصولًا إلى عصرنا هذا وما فيه من تطور في المعلومات، ووسائل الاتصال، وتقنية النانو التي كشفت لنا بداية تشكل العقل الاصطناعي.
كان ما حققه الإنسان البدائي الأول عظيم الأثر؛ لأنه ابتكر الحلول للحفاظ على الفائض من الطعام، وكذلك استأنس الحيوانات وصنع الخزف والغزل والنسيج… إلخ. وبنظرة سريعة إلى فلسفة التاريخ سنجد أن هناك ثلاثة اتجاهات كبرى: اتجاه علمي وضعي أسس له أوغست كونت، واتجاه آخر يعتمد المنهج التأويلي، ويميز بين العلم الطبيعي والعلم التاريخي وأسس له إيمانويل كانط، واتجاه إبستمولوجي ينتمي إلى المدرسة الفرنسية التي تتميز بالتعددية كما عند باشلار وفوكو، فتعقد عمل المؤرخ أكثر بسبب النقد الموجه إلى أهمية هذا العلم وفائدته من جهة، والتأسيس من جهة أخرى لحلول من شأنها أن تنقذ عمل المؤرخ من إشكاليات أبرزها: إشكالية (الموضوعية/ الذاتية)، فمن يحمي الذاتية في اللغة من إشكالية التوظيف الأيديولوجي؟ فإذا كانت الإجابة أنها المؤسسات الأكاديمية، فالحديث سيأخذ منحًى تشكيكيًّا أكبر، يصل إلى المؤسسة الأكاديمية نفسها؛ لأنها الأصل في تمرير هذا التوظيف الأيديولوجي.
تحيل هذه الإشكالية إلى استحضار سجال المركزية الأوربية، الذي يراوح بين تأكيد الفكرة من باب الإسهام في الدعوة إلى حوار الحضارات، وبين تهميشها لأن الأفكار الإنسانية لا يمكن تقسيمها على أساس فئوي. أي حديث عن المركزية الأوربية هو في الأصل حديث عن المؤسسات الأكاديمية، والحديث عن مخرجات المؤسسات الأكاديمية هو حديث عن مجموعة أفكار عززت ثنائية: الثقافة/ العرق، وعليها فالعقل (الأوربي) حاضر في كل مسألة تميز فيها العقل الإنساني، فالفلسفة مثلًا بدأت إغريقية ولا وجود لفلسفة سابقة عليها، والآلة البخارية في إنجلترا هي أصل الثورة العلمية، وفي السياسة والاجتماع أيضًا العقل (الأوربي) حاضر بنتاج هوبز ولوك ومونتسيكيو وجان جاك روسو وفولتير… إلخ.
ويزداد سجال المركزية حدة بين المثقفين العرب، ويتخذ طابعًا جدليًّا؛ فهناك من لا يرى أي مرجعية أوربية، أو لا يؤمن بوجودها من الأصل، وهناك من يعترف بها ويسلم بأنها قاعدة يجب الانطلاق منها، وفريق يقرّ بوجودها لكنه يرفضها، وينصرف عن النقاش الموضوعي للفكرة لينتصر لنفسه، وبعض أعمال هذا الفريق لا نجد فيها سوى الإفراط في تقدير ذات الباحث.
التقليد والتجديد في الفكر العربي المعاصر
عقدت في نوفمبر عام 2017م ندوة مغلقة بمشاركة نخبة من الأكاديميين العرب، وكان محور جلستها الثانية «التقدم العلمي والحداثة» (نشرت مجلة عالم الفكر في عددها رقم 174 إبريل-يونيو 2018م ندوة بعنوان: «التجديد والتقليد في الفكر العربي المعاصر)، فأشار الدكتور شاكر نوري من العراق إلى أن «مصطلح الحداثة هو فعلًا يشير إلى مرحلة من مراحل تقدم أوربا»، وخصوصًا «الحديثة»، هذا التقدم من وجهة نظره استند إلى «ثلاثة عناصر، هي: العلم، والعقل، ومركزية الإنسان، غير أنه يمكننا تعميم المفهوم لنجعل منه معيارًا لأي مجتمع من المجتمعات». وذكر الدكتور عبدالله إبراهيم في مداخلته أن «الحداثة، بمفهومها الشائع الآن، هي رواية الغرب لتاريخه وتجربته، والتجربة الغربية، كما هو معلوم، تجربة ثرية وغنية قولًا وفعلًا، لكن هل الرواية الغربية لتاريخ الغرب تستجيب فعلًا لأحوال مجتمعات تقع خارج الحضارة الغربية؟ وهذه مجتمعات إنسانية عريقة، ولها تجارب ثرية وخصبة، وفي تقديري الشخصي، أقول: إن هذه الرواية -مهما كانت مهمة- لا تحيط بالتجارب الإنسانية الأخرى، وربما لا تستجيب لشروط تلك الثقافات المتنوعة». وفي مداخلة الدكتور باقر النجار أكد أن «التقدم العلمي ليس من الممكن أن يحدث من دون الارتباط بالحالة الغربية، هذه الحالة التي أرى أنها مؤثرة في إحداث التغيير، وإن لم نرغب -في العالم العربي- في ذلك التغيير». ولكي يكون حديثه عابرًا للثقافات هاجم الدكتور علي حرب ثنائية إدوارد سعيد في الاستشراق والاستعراب، وحسن حنفي في ثنائية الإسلام والإمبريالية ووصفها بأنها: فقدت مصداقيتها وباتت خادعة ومضللة؛ لأن أصحابها يحاربون الغرب الحديث بثقافته وأدواته المعرفية ولغاته المفهومية.
قد يشعر القارئ أن في هذه المداخلات بتفاصيلها كافة موضوعات مستهلكة؛ باعتبار أن العالم منشغل الآن بالحديث عن مرحلة تتجاوز مرحلة ما بعد الحداثة، وقد ظهرت مسميات لأنساق جديدة، إحداها: «الحداثة الزائدة» (تناول الدكتور الزواوي بغوره موضوع الحداثة الزائدة في كتابه المعنون بــ«ما بعد الحداثة والتنوير» موقف الأنطولوجيا التاريخية، دار الطليعة، لبنان 2009م) لكن الواقع غير ذلك، فلم نقطع بعد تلك لمرحلة، في ظل وجود أصوات تشكك في كونية لغة نسق فكري حاضر مع مخرجات الحداثة، ولأننا لم نخرج بعد من مبالغة بعض المؤرخين في تقديراتهم، ومنهم المؤرخ الفرنسي إرنست رينان الذي ميّز بين العقول عرقيًّا، فكان لدينا العقل الآريّ والعقل الآخر الساميّ… إلخ.
الثورات العلمية: إذا كانت نظريات هيغل وماركس وكونت في التاريخ تعزز فكرة التقدم الخطي للتاريخ البشري، فإن لآخرين كتوماس كون وألكسندر كويري (هل حدثت الثورة العلمية؟ لجان فرانسوا دورتييه، ترجمة الدكتورة نصيرة إدير لصالح مجلة الثقافة العالمية، عدد مارس- إبريل 2018) رأيًا آخرَ يرى أن العلم لا يتقدم بشكل خطي، بل نتيجة ثورة ذهنية وتغيرات مفاجئة في الخلفية الفكرية، وقطيعة إبستمولوجية من شأنها أن تعزز مفردة الـ«ثورة» كما عند غاستون باشلار، بينما الرأي المضاد يرى أن مسار العلم مسار يتقدم بشكل خطي، ويرفض وجود هذه الثورات في العلم كما عند ستيفن شابين رئيس قسم تاريخ العلوم في جامعة هارفارد، وينتقد هذا الرأي فكرة الطبيعة نفسها وأسباب «الثورة العلمية»، فلا يمكن للعلم أن يعيش في عزلة ولا يمكن للثورة الذهنية أن توجد من دون حجر أساس اجتماعي واقتصادي وتقني، ومنظار غاليليو ونظام الملاحة مثالان على ذلك. وانتقاد آخر يتعلق بطبيعة العلم التقليدي ذاته، وتأسيس فكرة الثورة لـ«ترييض» الطبيعة من خلال حسابات السرعة والكتل ومسارات الأجسام، وفي المنهج التجريبي من دون النظر إلى المنهج الذي دعا إليه ديكارت الذي قام على المنطق والاستنتاج لا على المنهج التجريبي للإنجليزي فرانسيس بيكون، الاستنتاج البحت أو التجربة هما طريقتان مختلفتان جدًّا لتصور المسار العلمي. و«الثورة العلمية» مصطلح بات يُستخدم للدلالة على معنًى مضمر يشير إلى تحولات اجتماعية واقتصادية أعمق بكثير.
كل مخرجات مرحلة ما بعد الحداثة في نقد الحداثة كأركيولوجيا التاريخ عند فوكو والتفكيكية عند جاك دريدا تقوم على الإرث الذي تركه نيتشه في تفكيك مؤسسة الحقيقة، حقيقة أن النص الأصلي إنْ هو إلّا الوهم وليس الحقيقة، وحقيقة أن تأثيرًا قسريًّا أسس لمعالم في الثقافة دفعت نيتشه لأن يعلن عن ثقافة جديدة؛ هي الثقافة ما بعد التاريخية عبر أسئلة جينالوجية تبحث عن إجابات في مسألة من يحدد القيمة؟ ومن يقف خلف المفاهيم العقلانية والتقدم والحرية؟
كتب جان فرانسو دورتييه في أكتوبر – نوفمبر 2017م مقالة عن جوزيف نيدهام المؤرخ المتخصص (ترجمتها الدكتورة نصيرة إدير لصالح مجلة الثقافة العالمية، مارس- إبريل 2018م)، قدم فيها سلسلة من الابتكارات الكبرى التي عرضها نيدهام في موسوعة «العلم والحضارة في الصين»، وهذه الابتكارات ظهرت أولًا في الصين، مثل: البوصلة: التي عُرفت في الصين منذ القرن الثاني قبل الميلاد، وكانت تستعمل في ممارسات ضرب الرمل لرصّ القبور والمباني بشكل ملائم، قبل أن تستعمل في وقت لاحق للملاحة في أعالي البحار. ووصلت البوصلة إلى البحارة الإيطاليين في القرن الثاني عشر الميلادي، وقد يكون ذلك بواسطة الملاحين العرب. الطباعة: اختراع جوتنبرغ ظهر متأخرًا عن ظهوره في الصين في القرن العاشر، لكن بسبب عدد الأحرف الصينية الكبيرة فقد أثرت في فعالية الأحرف المتحركة، التي تغلب عليها الصينيون في القرن التاسع عشر، أي: بعد ظهور الطباعة بفاعلية في أوربا.
الورق: كان الأوربيون إلى العصر الوسيط، يكتبون على ما يصنع من جلود الحيوانات (الرّقّ، الذي كان يصنع من جلود العجول). وكانت هذه المادة نادرة وغالية الثمن، أما الصينيون فكانوا قد صنعوا الورق من ألياف نباتية قبل القرن الثاني قبل الميلاد، وانتشرت هذه التقنية في الغرب من طريق العرب. البارود: تقول فكرة سائدة: إن الصينيين على الرغم من كونهم اخترعوا «المسحوق الأسود» فإنهم لم يستعملوه إلا في المفرقعات والألعاب النارية، في حين حول الغربيون استعماله لأغراض عسكرية. والحقيقة أن الصينيين استخدموه أيضًا في إطلاق المقذوفات منذ القرن الثالث عشر، أي: قبل أن يستخدمه الأوربيون، فالمدفعية التي تُشعل بالبارود لم تتطور في أوربا إلا في القرن الرابع عشر بفضل المغول والعرب.
إذا كانت الصين متقدمة بهذا المقدار عن الغرب في ميادين علمية وتقنية، فلِمَ لمْ نشهد ثورة علمية شبيهة بتلك التي شهدها الغرب؟ ولِمَ لمْ يوجد في الصين غاليليو ولا نيوتن صيني؟ تلك هي مفارقة نيدهام.
شركات متعددة الجنسيات
عندما ننظر إلى جملة الإنجازات العلمية والثقافية والعمرانية الأخيرة، سنجدها تُنسب إلى شركات متعددة الجنسيات بفضل وحدة اللغة، ومنذ لحظة التحول الحضاري الأول في تاريخ البشرية من الحالة البدائية إلى ارتقاء سلم الحضارة، كان كل كيان يقوم في جزء من العالم يعبر عن مشروع حضاري مرتبط بثقافة ما، وفي حال توقف الأول ضعفت الثانية، وفي عصرنا الحديث اكتسحت ثقافة ذات لغة واحدة كوكب الأرض، تلك اللغة التي بفضلها تعمل الشركات متعددة الجنسيات من دون ارتباك في عملها. وما أفرزته المؤسسات الأكاديمية لا يمكن نَقْده وتقويمه إلا بجهد المؤسسات الأكاديمية نفسها، فعليها نقد الخلل الموجود لا القفز عليه، فالرهان على العمل الجماعي المشترك لا على الفردي، فلا يمكن تجاهل اللغة الكونية وأثرها الواضح في حركة التقدم، والعمل الفردي لن يقدم شيئًا بل قد يؤخر، ومن يأمل فيه خيرًا فهو أشبه بمن يرجع القهقرى إلى الوراء، حيث المحطات الغابرة للتمركز المرضي حول الذات.
وبين ظهرانينا اليوم من اعتمد جملة من الأفكار التي ورد بعضها في هذه المقالة؛ ليؤكد أن الفلسفة في جملتها منتج غربي، وعلينا نحن أن نصنع فلسفتنا بأنفسنا، والصناعة التي يعنيها شأن خاص به وهو وحده، وكأنما المطلوب منا كي نكون فاعلين ثقافيًّا وحضاريًّا أن نلغي سلسلة تراكمية طويلة من منجزات العقل البشري لنبدأ من الصفر، ولو قُدّر لنا فعل ذلك لعدنا إلى عصور سحيقة جدًّا موغلة في القدم، عصور ما قبل اختراع الطابعة.
ونؤكد مرة أخرى أن المؤسسات الأكاديمية وحدها هي المعنية، وهي من يقع عليها الدور الأكبر متى ما كان الخلل في كونية اللغة موجودًا، ولأن المنجز الحضاري الإنساني جهد تراكمي، فالعمل لا بد أن يكون مؤسساتيًّا صارمًا، قد يتجاوز -متى ما أتم رسالته- الانشغال بقضية المركزية الأوربية إلى قضايا كونية أهم، قد توصلنا إلى فهم سر تلك التحولات العظيمة التي انتقلت فيها مجتمعات ريفية زراعية بسيطة إلى مجتمعات صناعية تزاحم المجتمعات المتقدمة على قمرة قيادة قطار الحضارة.

ماجد الشيباني - كاتب سعودي | يناير 1, 2019 | فيلوسوفيا
ما الكتب التي تنصح بها قراء مبتدئين؟ كان وقع السؤال صادمًا لي؛ لأنه لا وجود لبدايات يمكن الاتفاق عليها لغرس الرغبة ولتعزيز الاستمرارية، فامتنعت عن إعطاء إجابة بيداغوجية مباشرة، وعوضًا عن ذلك دار الحديث عن الأعمال الفنية الروائية، ومَنْ مِنَ الكتّاب يستحق أن يُقرأ له؛ من أجل الانتصار لفكرة هدفها الأول والأخير تفعيل الممارسة اليومية للقراءة لتصبح عادة، بعدها تحول القلق المضمر في سؤال السائل -أعلاه- إلى تعبير صريح بالتخوف من جرأة بعض الكتّاب الروائيين على بث أفكار متمردة على القيم الخلقية والفكرية عبر رواياتهم، وحتمًا لن تمر تلك الأفكار مرور الكرام في عقل أي ناشئ في بداية التشكل. تحول الهاجس المضمر في السؤال إلى التصريح دفعني إلى الاستسلام ومحاولة الإجابة عن السؤال، لأن حالة القلق هذه كانت أقرب إلى حالة القلق السارترية، التي تُعدُّ طبيعية؛ لضرورة الاختيار ليتبعه اتخاذ قرار، وفي اتخاذ القرار التزام بمسار معين، رغم اعتقادي بضرر ذلك على تحديد هوية الفرد الشخصية، ولأنني أشعر أيضًا بخطورة الاستناد على اللغة الشخصية على حساب كونية اللغة في رحلة تعزيز معارف الفرد التراكمية، وقد حاولت دفع السائل إلى نتيجة أنه لا شيء أنفع وأصلح في البدايات من البدء في البحث عن مواضيع متنوعة في العلوم؛ من أجل الانتصار لفكرة البحث نفسها لا فكرة وجوب قراءة كاتب بذاته أو كتاب بعينه. لم تكن الإجابة مرضية للسائل بالطبع.
يميل جل المبتدئين إلى الأعمال الروائية؛ لدافع طبيعي -ربما- يدفع إلى السرد والحكايات.
والرواية فرع من فنون الأدب، والاستفادة تحققها كل الأجناس الأدبية، ولا يمكن اختزالها في فرع واحد؛ لأن كل فنون الأدب فنون قولية لغوية. واللغة في أبسط صورها تتكشف لنا عندما تجتمع كلمتان أو ثلاث تكفي لتحديد المعنى، وعندما تتعقد وتتشابك النصوص يصبح الأمر أشبه بمطاردة لذاكرة أشبعها صاحبها بمعرفته التراكمية الذاتية، وقد تستحضر ملكة الإدراك في الأعمال البحثية، وهنا الأمر أسهل في الالتقاط بعكس ما يتوقعه القارئ مقارنة بتلك المطاردة اليائسة التي لا تحكمها معاهدات ولا قوانين ولا اعتراف بأي محاولة تكرِّر نفسها. وأقصد هنا مَلَكَة التخيل في الأعمال الفنية التي تنتمي إليها الرواية، فوجود المؤسسات الأكاديمية والبحثية يحمي القيمة العلمية للأعمال البحثية، وبالتالي يحصن القارئ الباحث عن المعنى، بينما في الأعمال الفنية فلا وجود لأسس موضوعية متكاملة معتمدة من المؤسسات الأكاديمية؛ وإن كانت هناك بعض الأطر والمعايير الشكلية. وهنا إشكالية لها أن تتعقد أكثر شأنها شأن الحديث الفلسفي لتمرير أفكار باتت أقدم عهدًا، لا وجود لها إلا لمن يبحث عن تأريخ يكشف عن التحولات. وإذا جنحنا إلى الحديث عن الفنون فلسفيًّا وعن تاريخ الفلسفة تحديدًا، فسنجد أن فكرة الفن بعد بومغارتن تختلف عنها قبل عصره. حتى التأمل بعده في أعمال كانط وهيغل، أو شوبنهاور ونيتشه، أو ماركس وفرويد لن يكفي لتقديم رؤية تحليلية نقدية في فلسفة الفن، ففي الأفق فنون تقدم موضوعات وأخرى لا تقدم موضوعات، والتركيز في واحدة على حساب الأخرى يفضي إلى القصور. وثمة إشكالية تتعلق باختلاف فلسفة الجمال عن فلسفة الفن، ذلك لأن الأحكام الجمالية ليست وقفًا على الأعمال الفنية، والنظر إلى الجمال كعلم قوبل باعتراضات، ميّز الرد عليها بين الجزء النفسي في أحكامنا الجمالية وبين الجزء التجريبي في عملية البحث في الفن نفسه.
ولحل هذه الإشكالية الفلسفية لا بد من التذكير بـ«إتيان سوريو» الذي قسم الفنون سبعة أقسام، وصنفها تصنيفًا لم يسبق إليه؛ ردًّا على التفسيرات التقليدية التي تشكلت بدايتها في الحقبة الإغريقية (أفلاطون وأرسطو). ولنبدأ بما انتهى إليه سوريو؛ في محاولة لاستقراء تحولات الفن الراهنة والمستقبلية، التي لن تنفصل حتمًا عن تطور الآلة والثورة التكنولوجية.
الحديث عن معرفة تراكمية ذاتية هو حديث عن الهوية الفردية بقدر ما، ولا أعني الهوية التي تجعل الآخر نموذجًا فكريًّا للحياة الأخلاقية، بحيث تتماهى الذات مع الآخر؛ لأن الحديث يتعلق باللغة الكونية، ولأن الجملة تنتهي بـ«ذاتية» فهذا يعني تمايز ذاكرة عن ذاكرة. فكل ما يكتسبه الإنسان من قناعات وتصورات؛ نتيجة لتجارب حياتية، أو لقراءات، يُعدُّ معرفة، وهذه المعرفة تتراكم مع الأيام، وهي في النهاية ذاتية تخص صاحبها. وإذا نظرنا إلى مفهوم «المعرفة» وجدناه أشمل من مفهوم «العلم»، واللغة الشخصية (الذاتية) تُعدُّ من مصادر المعرفة ولا وجود لتمييز بينها وبين العلم إلا بالبحث رفقة أداة واحدة هي ملكة الإدراك. وقد يبدو الاعتراف بدور المؤسسات الأكاديمية في حفظ كونية اللغة من تدخلات اللغة الشخصية وكأنه نسف لدور الأعمال الفنية، لكنّه في حقيقته عكس ذلك، فهو حماية لها من تلك العقول التي تطبق ما هو أصل في الأعمال البحثية في الأعمال الفنية، فتفرض قيودًا تعسفية ساعية إلى تطبيق أدوات العلم الصارمة على عمل تحقق بفضل ملكة التخيل.
وأي حديث في الفن هو حديث في الفنون كلها، فالفنون مجموعة واحدة فلسفيًّا، والأفكار الفلسفية الحديثة –بعد حقبة بومغارتن– تكاد تتفق على أن الانفراد بفرع واحد من دون البقية والتفصيل فيه يخرج من المجال الفلسفي إلى لغة أقرب أن تكون لغة الشخصية، وعليه تكون معارف الأفراد في خطر التسليم بما هو أشبه بالعدم.
تقابل اللغة الشخصية لغة كونية، تحتضن نظريات المعرفة وتفصل بين ما هو داخل في العلم المحسوس وما هو خارج عنه، وبين حدود التجربة وما هو خارج عن حدودها، وفي التقاط ثنائية الذات والموضوع أهمية كبيرة في الرد على منظري الفلسفة المثالية، في مسألة أن ما يتصل بالذات يُرجع فيه إلى علم النفس، وكل ما يتصل بالموضوع يُرجع فيه إلى العلوم الطبيعية، فكان التسليم بأن كل نظرية في المعرفة تعتمد على علم النفس ليست إلا وجهة نظر سيكولوجية، تشكَّلت في أتون الفلسفة المثالية.
مراحل نظرية
وقد مرت نظرية المعرفة بمراحل سادت بعضها النظريات والاتجاهات العقلانية التي كانت تحكم العقل وتمجده، وسيطرت في بعضها الاتجاهات الحسية التجريبية، التي جعلت التجربة أساسًا للمعرفة، ليبقى السجال حقبة من الزمن، إلى أن ظهر الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، الذي صنفه بعض مؤرخي الفلسفة (وهو الفيلسوف التجريبي) مؤسسًا حقيقيًّا لنظرية المعرفة الحديثة؛ لأنه أطَّر البحثَ وجعله يتخذ شكلَ العلم المستقل في مؤلفه المعنون: «مقالة في التفكير الإنساني» الذي نشر في سنة 1690م. ولا غرو أن الإدراك الحسي والإدراك العقلي أصلان في المعرفة؛ لوجود عدد من العناصر العقلية البسيطة التي تتألف منها المعرفة الإنسانية لتنمو في أنساق مختلفة التعقيد والتركيب. وقد جاء إيمانويل كانط بفكرة أنَّ جميع أحكامنا الصادرة من الحس أو من العقل تحتوي عناصر أولية، فالزمان والمكان فكرتان أوليتان تدخلان في جميع إدراكاتنا الحسية، وتوجدان في العقل بفطرته، وبفضلهما أمكننا الوصول إلى علمين يقينيين هما علما العدد والمكان (الحساب والهندسة). والمقولات الاثنتا عشرة في الكم وفي الوحدة والكثرة والكل، ومقولات الكيف في الوجود والعدم والتحديد، ومقولات الإضافة في الجوهر والعرض والعلة والمعلول والتبادل، ومقولات الجهة في الإمكان والامتناع والوجود واللاوجود والضرورة والحدوث، جميعها معانٍ أولية موجودة في العقل بفطرته، ونستعين بها للوصول إلى المبادئ العامة في العلوم الطبيعية؛ كالمادة والتغير والاطراد في وقوع الحوادث الطبيعية، وفي التعبير عن هذه المبادئ في صورة قضايا ضرورية، وهذه المعاني الأولية هي الأساس الذي نبني عليه أحكامنا الضرورية وأحكامنا العامة.
إلى أن أقام هوسرل اتجاهًا جديدًا في المنهج الفينومينولوجي يعتمد على الحدس لا على العقل ولا على التجربة، ومن بعده توالت الدراسات، فكانت الوجودية التي تُسقط كل معرفة على الإنسان، والماركسية بنظرتها الاقتصادية، والبراغماتية بنزعتها العملية، فتزاحمت الأفكار على مورد نظرية المعرفة، حتى بات كل اتجاه يؤخذ به ولا ضير، ولم يعد ممكنًا النظرُ إلى أي اتجاه على أنه تقادم عهده وأحيل إلى أرشيف تاريخ الفلسفة، وإن كانت فكرة الفيلسوف الموسوعي قد انتهت تمامًا لصالح الفيلسوف المتخصص في اتجاهٍ ما، فكان نتاجها أعمالًا فلسفية أكثر تركيزًا، وأكبر في قيمتها المعرفية.
وفلسفة العلم بدورها لم تخلُ من اتجاهات متباينة، مثل: النظرة إلى حقيقة مسار العلم، وما إذا كان في سيرورة متصلة مستمرة لا انقطاع لها، أم أن له مسارًا متقطعًا، يرتبط بالاضطرابات والأزمات والثورات، ولعل أبرز ممثلي هذا الاتجاه: غاستون باشلار، وألتوسير، وميشيل فوكو، وقد يدعم هذا التصور تتبع الأحداث الكبرى في تاريخ البشرية ومآلاتها، وأيضًا عند النظر في تاريخ الدراسات النظرية، فمثلًا أزاحت ميكانيكا الكم والنظرية النسبية بعض مقولات نيوتن ومكسويل، وكيف أن علوم البيولوجيا جددت أفكارها بسبب التقدم المثير في الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة… إلخ، ولبسط القول أكثر في التمثيل لاتجاهات فلسفة العلم، كان المصباح الكهربائي حاضرًا كحجة، وأنه مجرد استمرار للمصباح القديم، وكان الرد عليها: أن المصباح الكهربائي ليس سوى ثمرة علمية للعلاقات بين الظواهر، ولدراسة وصلت إلى مرحلة التعبير عن هذه العلاقات بصيغ رياضية. ولا شك أن نظرية المعرفة أو الإبستمولوجيا تدرس المعرفة العلمية في شرطها التاريخي من دون أن تنزع إلى إجابات مطلقة، وذلك قبل أن تتصل المشكلة الإبستمولوجية بالتكنولوجيا وبالبيانات الضخمة، فكان لها أن واجهت المشكلة الكبرى والمعضلة الأخلاقية التي تتعلق بكيفية استخدام البشر لها.
وإذا قبلت نظرية المعرفة أي اتجاه مما أشرنا إليه كفكرة يعتد بها معرفيًّا، إلا أن فكرة اتصالها بالتكنولوجيا التي أصبحت أمرًا متداولًا مؤخرًا، وخصوصًا بعد نشر لوتشيانو فلوريدي كتابًا عن الثورة الرابعة في سنة 2014م، عرض فيه المشكلة الإبستمولوجية في توظيف إسهامات التكنولوجيا، وربطها بمعضلة أخلاقية، ما زالت تحتاج إلى المزيد من الأساليب والتكنولوجيات لتقليص البيانات الضخمة وانكماشها إلى حجم يمكن التعامل معه، فيكون الحل للمشكلة الإبستمولوجية حلًّا تكنولوجيًّا. وبحسب فلوريدي فللتكنولوجيا مراتب أولاها: علاقة الإنسان بالطبيعة وبالتكنولوجيا، والثانية: علاقة الإنسان بالتكنولوجيا (أسقط فيها الطبيعة)، والثالثة: أسقط الإنسان نفسه لتحل التكنولوجيا محل الطبيعة ومحل الإنسان.
وقد عزز الحديث عن التكنولوجيا صدور كتاب: «موجات جديدة في فلسفة التكنولوجيا» (2018م)، لجان كير وإيفان سلنجر وسورين ريس، وخلاصة ما جاء فيه من أفكار مدركة لإشكالية التكنولوجيا تعود إلى الأميركي دون إيهد المولود في سنة 1935م، الذي يُعدُّ المؤسس الحقيقي لجيل قادم بقوة إلى الساحة العلمية، وينقب في تاريخ الفلسفة وفي تاريخ الآلة التي سبقت بدايات الفلسفة في اليونان بمراحل، وتحديدًا مع أول أدوات صنعها الإنسان؛ كالمطرقة التي لم تكن سوى وسيلة من وسائل الهومو فابر، التي تطورت منذ العصر الحجري حتى الآن، لكن جوهرها في التحكم بالطبيعة ومعالجتها من أجل الأهداف البشرية بقي ثابتًا. ومع هذا التنقيب استطاع الجيل الجديد تجاوز عقبة تسبب فيها فلاسفة مدرسة فرانكفورت الذين جعلوا التكنولوجيا سببًا للتشاؤم، وتجاوزوا عقبة تاريخية أخرى، تعود إلى ما قبل الثورة الصناعية، عندما لم تكن التكنولوجيا بارزة بالشكل الذي أصبحت عليه بعد الثورة الصناعية، عبر مفهوم الهومو فابر الذي يؤكد المنفعة، ويعمل لوضع قواعد الفاعلية المؤسسة على قوانين الطبيعة، ولتبقى مهمة العلم في إثبات قوانين الطبيعة. هذا المشروع الفلسفي الجديد يربط الفلسفة بالتكنولوجيا ربطًا مختلفًا، وقد لقيت الفكرة انتشارًا وتأييدًا واسعين في الأوساط الأكاديمية.
هذه النقلة في الالتقاط قد تدفع بفكرة جديدة تنسف مجمل الأنساق المعرفية في العلوم الإنسانية؛ كونها باتت علومًا أقدم عهدًا، وقد يصل الأمر للفلسفة نفسها، فلا يمكن القبول بدراسة ما لم تستحضر فكرة تطور الآلة، وهذا يعني أن فكرة البناء ستكون هرمية في العلوم الإنسانية مثلها مثل العلوم التطبيقية، وهذا أشبه بالحلم لكون الباحث في العلوم التطبيقية لا يسمح له بتناول فكرة سابقة. بخلاف العلوم الإنسانية. ولعل هجوم كارل بوبر الحاد على فرع علم النفس كان الأشد؛ إذ صنّفه تحت العلوم الزائفة، ولم يكن هذا الرأي بمعزل عن الفجوة الهائلة ما بين العلوم نفسها. ولا يتسع المجال لإيراد هذه الجدلية كاملة، ولا لعرض دفاع بعض المتخصصين عن علم النفس، ولا لسرد الاتجاهات المنحرفة التي تجاهلت الأسس الجادة والحتمية للعلم، واستعاضت عنها بقراءات غيبية، ودراسات أشبه بالتصوف اللاعقلاني.
وبالعودة إلى «فلسفة التكنولوجيا» التي تعتمد في دراستها على مفهوم «ما بعد الفينومينولوجيا» سنرى أنها تعتمد المنهج الفينومينولوجي والبراغماتي جنبًا إلى جنب، عبر مفهوم الهومو فابر الذي ارتبط بفكرة المشغول الفني من أجل الالتصاق قدر الإمكان فلسفيًّا بأرسطو وعِلَله الأربع. التي يمكن التمثيل لها بعمل فني منحوت؛ فتكون المادة أصل العِلَّة المادية، والنحات هو أصل العلة الفاعلة، وهيئة المجسم أصل العلة الصورية، ومراد النحات من هذا العمل هو أصل العلة الغائية، وهكذا في بقية الفنون. وجوهر الهومو فابر في النهاية هو التحكم بالطبيعة ومعالجتها من أجل أهداف بشرية، ومن هنا كانت بداية التاريخ فلسفيًّا قبل الثورة الصناعية وقبل «الكوانتم فيزك» التي قسمت الناس فريقين: المؤيد للتطور العلمي، والخائف المتوجس منه. ولعل مقولة السياسي الذي صرح بعد إلقاء القنبلة الذرية على اليابان بأن: العالم سيعود إلى العصر الحجري على أجنحة العلم البراقة، مثال للفريق الثاني، وكم هو مؤلم المعنى خلف هذه الجملة.
وكأن التقدم العلمي -إذا سلمنا بمقولة ذلك السياسي- ينتصر في النهاية لهوبز على حساب ديدرو الذي نشر مقالة هجومية في الموسوعة الأنوارية الشهيرة على النزعة الهوبزية، فكانت المقالة أشبه بتوجيه لأغلب القراءات لأعمال هوبز بعد ذلك. وما كان هجوم ديدرو على هوبز إلا حلقة في سجال فلسفي مستمر للنظر في طبيعة الإنسان الأنانية في جوهرها، والسلطوية في تصورها للأخلاق، وأيضًا للبحث أكثر في حقيقة أن البشر لو تركوا لطبيعتهم لأفنى بعضهم بعضًا، وما أشد النتائج عندما تتطور الآلة. لكن إذا سلمنا بأن تطور التكنولوجيا يشمل مجموع المعلومات الأداتية المفيدة ثقافيًّا والقابلة للنقل وليس مجرد التطور المادي للآلة فحسب، أو سلمنا بفكرة ديفيد هيوم عن التعاطف الاجتماعي، سنزيح بعض هذا العناء الفكري، وسنلتفت ولو قليلًا إلى سيناريوهات من شأنها أن تؤثر في مستقبل البشرية وقد تفضي إلى الانهيار المجتمعي، ومنها العوامل البيئية، والتزايد السكاني، والتغير المناخي،… إلخ.
الفنون والتكنولوجيا
وضع دون إيهد تاريخًا كاملًا لـ«فلسفة التكنولوجيا»؛ ليقترب من ملازمة هوسرل كفيلسوف يعتدّ به معرفيًّا، ومنطلق من الفينومينولوجية الهوسرلية. هذا التاريخ يبدأ مع أول أداة صنعها الإنسان البدائي لتأمين بقائه؛ ومن أجل تحقيق الذات. ولكن ما علاقة كل ذلك بفكرة الْتِحام الفنون بالتكنولوجيا؟
وما أهم الوسائل التكنولوجية التي أثرت في عالم الفن، وربما أساءت لمعنى ما من معاني عوالم الفن؟ سرعان ما سيطرت الهواتف الذكية على العالم بعد بدايات الإنترنت، فغيرت أشياء كثيرة، وتسابقت تطبيقات الهواتف ومنصاتها الإعلامية لنشر فنها الخاص؛ الباحثة عن عدد مشاهدات أكثر، الكاشفة عن محتويات أي متحف، والعارضة لأشهر الأعمال الفنية بضغطة زر، بغض النظر عن أصالة هذه الأعمال من عدمها. حتى المنحوتات العظيمة التي تعتمد عِلَّتها المادية كأصل في تقييم الحالة الإبداعية؛ باتت على منصة واسعة الانتشار من دون الاهتمام بحقيقة ما هو أصل علتها المادية.
وقد لا أجد مدخلًا للحديث أفضل من عبارة الفيلسوف ألبرت الكبير (ت: 1280م): «أن تبدع شيئًا من لا شيء فهذا يعني أن تنتج». قد يختصر هذا النص اللاهوتي كل صراعات منظري الفنون الجميلة الحديثة في توظيف ملكة التخيل وكل ما فيها من: إحساس، وشعور، وحدس، وتخيل، ورغبة، لخلق عمل فني من العدم. وأيضًا قد يتعقد الأمر أكثر مع قراءة تأويلية لهذه العبارة، مثل حقيقة وجود مجموعة من الأفكار تقف في خانة الضد، وسلاحها أن الفن ليس إلا محاكاة للواقع، ومن عساه أن يكون ألبرت الكبير مقارنة بأفلاطون أو حتى بتلميذه أرسطو؟ هذه المقولة قد لا تعجب ذلك الناقد الفني الذي يلتقط الإبداع كقيمة جمالية من دون الحاجة إلى المؤسسات الأكاديمية، وهي حقيقة بذاتها، لكنّه يمارس هذا الحق ليعزز سلطته هو الآخر وبكل حرية على من كان أشقى الناس بواقعه، وأسعد الناس بخياله.
وقبل الخوض في هذه المسألة نتوقف قليلًا مع استطراد تاريخي موجز؛ لمعرفة ملامح تشكُّل نظرية الفن ممتزجة بفلسفة الأخلاق، التي لم تكن قريبة بما يكفي من دراسة الأحكام التي تعبر عن الشعور الوجداني، مثل: فكرتي الجمال والجلال في الفلسفة الإغريقية، وما جاءت به العصور الوسطى نجد القديس أوغسطين أولًا؛ الذي كان يرى أن الجميل ما هو ملائم لذاته، ومنسجم مع الأشياء الأخرى، والقديس توما الأكويني ثانيًا؛ الذي كان يرى أن الجميل هو ما يسرُّ حين يُرى (مع عدم تجاهل النقودات والمعارضات لهما)، مرورًا بصراعات إمبريقية المنحى، استحضرت كل أدواتها ضد أية محاولة في الاتجاه العقلاني. وما إن أقام بومغارتن في سنة 1750م، أساس نظرية معرفية حسية، حتى أصبح بإمكان فلسفة الفنون أن تحتل المساحة، لتكون الوعاء الحاضن لكل الفنون، فكانت النهاية الحالمة بأن عالم المعاني لا يقتصر على المعرفة العلمية فحسب، لأن الإنسان لا يستخدم قدراته العقلية في العلم فقط، بل يستخدمها في مجالات أخرى، وذلك بعد أن صدر كتاب كانط «نقد ملكة الحكم»، الذي أكد فيه أن الحكم على الجميل بات ممكنًا لكنَّه محكوم بشروط من ناحية الكيف والكم والجهة والعلاقة، من أجل أن يحدد للجمال ميدانًا مستقلًّا عن مجال المعرفة النظرية ومجال الأخلاق، وهو ما أرجعه بينيدتو كروتشه إلى الحدس، وعلى خطى كانط اجتهد الفلاسفة، مثل: فيخته ومن بعده شيلنغ، حتى جاء هيغل ليجعل الفن في الروح المطلق. لقد اتخذ الحديث اليوم عن الفنون طابعًا فلسفيًّا، من خلال الاتصال بين الفنون كافة (موسيقا وشعر وفنون معمارية ونحت)، ولهذا هي الآن تؤخذ بشكل كامل ولا وجود لفن بارز بعينه، وأي حديث يفصل بينها مجرد ثرثرة أو تفكير بصوت عالٍ.
لا شك أن كل الدراسات حول الفن ساهمت في خلق آلية للتمييز، لكن لو أخذنا مقولة ألبير الكبير التي جاءت بعد إسهامات أفلاطون وأرسطو في الفن، أو محاولات كانط التي جاءت بعد إعلان بومغارتن مصطلح «الأستطيقا»، أو كروتشه (المتأثر بالفيلسوف الفرنسي هنري برغسون) الذي جعل للحدس منزلة توازي منزلة الاتجاهات المعرفية سواء أكانت عقلانية أم حسية تجريبية، لظهر لنا أن تلمس القيم الجمالية لأي حالة إبداعية شأن خاص بالمخيلة، ويمتد إلى الشعور باللذة أو بالألم، وقد يتطلب ذلك سعة اطلاع المتلقي أولًا لكشف حلقات التكرار… إلخ؛ لأنه المعني بكل محاولة لإبراز الجمال.
عليه، كانت هذه المقالة لقراءة واقع بعض الفنون الجميلة، وخصوصًا تصنيفها القائم على عاملي الزمان والمكان، لنصل إلى أن هذا التصنيف وصلت به الحال كغيره من التصنيفات إلى النهاية على يد إتيان سوريو، فمن أبحاث سوريو تحديدًا التي نعتمدها هنا تبدأ الحكاية، ولا يعني ذلك تجاهل غيره، مثل: إميل أوغست شارتييه المعروف بـ(آلان)، ولسنغ، لكن لأن أبحاث سوريو هي أساس معظم رحلة البحث للقبض على مخيلة الفنان، والابتعاد من شطحات الأحلام فيها، والتحقق من إلهامه. ولا شيء أصعب من الكشف عن عمل إبداعي تتحقق فيه مقولة ألبير الكبير: (شيء له قيمة جاء من لا شيء).
مثّل إتيان سوريو الاتجاه المضاد للتصنيف القائم على فكرة الزمان والمكان، مع أن الزمان والمكان عاملان مهمان في كل الفنون، لكن سوريو استند على كيفيات سبعة؛ لتفسير العمل الفني، هي: الخطوط، والأحجام، والألوان، والإضاءة، والحركات، والأصوات المفسرة في اللغة، والأصوات الموسيقية الخالصة، فكانت الحصيلة مسارين، الأول: فنون تجريدية بحتة، لا تقدم موضوعات، وهي فنون من الدرجة الأولى؛ لأنها تكتفي بتقديم كيان منظم لموضوعاتها كالموسيقا. والثاني: فنون محاكية تتفرع من تلك الفنون التجريدية؛ لتقدم موضوعات، وهي فنون من الدرجة الثانية، وهذا الهيكل يشير إلى موضوع آخر، يوحي به الشكل الظاهري لموضوعها، شكل ظاهري مباشر للموضوع الحسي، وشكل آخر غير مباشر للموضوع الذي يقدمه هذا المظهر الحسي المباشر، ففن الزخرفة مثلًا من فنون الدرجة الأولى، لكن الرسم -بحسب سوريو- فن من الدرجة الثانية؛ لأنه قادر على تقديم موضوع من الواقع الخارجي، وكذلك الموسيقا الحاضرة في تصنيف سوريو كفن من الدرجة الأولى، لكن الموسيقا الدراميّة أو الوصفية فن يطرح موضوعًا، وبالتالي هي فن من فنون الدرجة الثانية، وكذلك فن العمارة التجريدي وفن النحت المحاكي.
عبقرية اللغة
وبالنظر إلى وضع الرواية مع فكرة الالتحام بالتكنولوجيا، نجد أن التكنولوجيا لا تختزل في الآلة وحدها، بل تشمل الوفرة في المعلومات الأداتية المفيدة القابلة للنقل، ولعل الإشكال يكمن في كون الرواية من فنون الدرجة الثانية -بحسب سوريو- التي تطرح موضوعاتها كحالة إبداعية، ولا تلقي بالًا للمعرفة التراكمية، ومع تطور الآلة، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا للحصول على المعلومات والخبرات، قد يصاب بالحيرة من يوظف المقارنات التي لا تتجه إلى الأعمال الفنية نفسها، بل إلى التشابهات بين الطرائق الإبداعية المختلفة، أو إلى الهيكل العام للفنون. وهنا لا بد لنا من تأكيد الاختلاف الذي يتكشف بشكل بيِّن عن الأعمال البحثية؛ إذ لا يوجد فيها تطبيق لأدوات العلم الصارمة، وحين تكون اللغة مادة العمل الفني فهذا يعني أن هناك موضوعًا، فهي حتمًا من فنون الدرجة الثانية، ولكن هذه اللغة تبقى ذات طابع ذاتي وإنْ لامست قضايا كونية أشمل وأوسع محيطًا، وقد تكون اللغة فيها منفلتة من عقالها بجنون، ولا حد فيها للاستعمال الاصطلاحي للفظ، وهذا الوصف على حد تعبير الباحث جورج طرابيشي يكون بتعقل، بمعنى: أن الخلط بين الأنساق يبعثرها، وفي البعثرة محاولة استفزاز لمعرفة القارئ التراكمية، ومتى ما لَمْلَمَ القارئ هذه البعثرة كانت الكتابة، وهي عبقرية اللغة التي أتمت مهمتها الأولى بإنتاج شيء ابتداءً من لا شيء، وثانيًا أنها تمت بتعقل. وهنا تكون شهادة القارئ هي بوابة العبور إلى حقيقة العمل الفني، القارئ الذي باتت تؤثر في تلقيه ما وصلت إليه وفرة المعلومات الحاضرة عنده قبل الراوي، فانزاحت حاجة العمل الفني عن عرض المعارف والمعلومات لحساب عرض التجارب الحياتية الذاتية، عبر حالة إنسانية ثانوية من خيال الأديب، تلتحم بالعمل الفني وبالقارئ. وتطور الآلة سيجعلنا بحاجة إلى قراءات مكثفة في العلوم الإنسانية؛ كي يصمد العمل الفني أمام هذا التطور ولا يفسد، ومع التذكير بأن اللغة الكونية لا اللغة الشخصية ستبقى عاملًا رئيسًا لخلود بعض الأعمال الروائية، مثل: سأم ألبرتو مورافيا، وغثيان سارتر، وغريب ألبير كامو،… إلخ.
وإذا انتقلنا إلى فن العمارة فقد نشعر بالقلق، لأنه من فنون الدرجة الأولى التي لا تقدم موضوعًا، وبالتالي قد يفقد قيمته مع تطور الآلة، تمامًا كتأثير تطور الآلة على مهارة الصيد، فاحتلت الآلة مكان المهارة. والحال أن مستقبل فن العمارة سيكون من صنع الآلة أولًا وأخيرًا.
وبالانتقال إلى فن الموسيقا، سنجد أنه فن من الدرجة الأولى أيضًا ولا يقدم موضوعًا، لكنّ الآلة حتى الآن لم تستطع إزاحة المهارة من مكانها في هذا الفن، وسيبقى فنًّا تحكمه المهارة، وكل ما سيحدث سيكون امتدادًا لتطور الآلات الموسيقية، التي بدأت في التطور عندما اكتشف الإنسان البدائي أن امتداد صوته يمكن أن يتسع إلى مدى أبعد، وما قد تم تأريخه فعلًا تجسد في وسائل إصدار الصوت؛ كالطبول والصافرات والمعادن التي تطرق. ولعل اكتشاف تلك العظمة المثقوبة التي تبدو كأنها استعملت كصافرة يعد أقدم أثر موسيقي. ولقد وثَّق ثيودور م. فيني في كتابه عن تاريخ الموسيقا العالمية، أن فجرها يعود إلى زمن إنسان النياندرتال قبل مئة وأربعين ألف عام تقريبًا. ولعل اللحظة الفاصلة في تاريخها تبدأ مع بداية ظهور مفردة «موسيقا» الإغريقية التي كانت تعني: كل فن يشتمل على الشعر والرقص والتمثيل والأصوات الموسيقية، وما غياب الاعتراف بالآلات الموسيقية في حقبة الفلسفة السكولاستيكية إلا غياب ظاهري؛ لأن الفنون المرتبطة بالموسيقا بقيت حية لخدمة الطقوس الدينية، وفي قصص تطور الموسيقا إثبات أن الآلة انحصر دورها في تحسين أصوات الآلات الموسيقية ولم تنل من مكانة المهارة كعامل حاسم لإتقان هذا الفن، وهو ما سيستمر مستقبلًا. وإن كان لنا وقفة مع تاريخ الموسيقا، فهي: أن توقف تطور الآلات الموسيقية في بدايات الحقبة المسيحية في أوربا، واحتلال الأناشيد والتراتيل الدينية مكانها، قد أزاح فنًّا من فنون الدرجة الأولى من مكانه واستبدل به فرعًا آخر من فنون الدرجة الثانية، وقد يحدث ذلك من جديد بطريقة أخرى.
وإذا عرجنا على السينما، سنجدها فنَّا من فنون الدرجة الثانية، ولعله أكثر فروع الفن استفادة من التطورات التقنية المتجددة؛ لأنه بكل بساطة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة اعتمادًا كليًّا. وإذا نظرنا إلى فن النحت، وهو فن من فنون الدرجة الثانية، فسنجد أن العلة الغائية (قصدية النحّات) ستبقى حاضرةً، لكن الأهم مستقبلًا يكمن في العلة المادية، أي: أصل المادة المنحوتة، التي بقيت صعوبة تطويعها عاملًا حاسمًا في القيمة الجمالية للعمل المنحوت، لكن تدخل الآلة في تطويع مواد يعجز عنها البشر سيلقي بظلاله على القيمة الفنية، وهذا التدخل متى ما تجاوز النسبة الضئيلة المسموح بها كفيل بالقضاء على كل إحساس بجمالية تتلقاها النفس البشرية، وسينهي رحلة البحث عن الحالة الإبداعية، فمن يبحث عن المعنى الجمالي في هذا الفرع تحديدًا لقدرة المبدِع لن يقبل بتغير أصل العِلة الفاعلة، أي: تبادل الأدوار بين النحات والآلة.
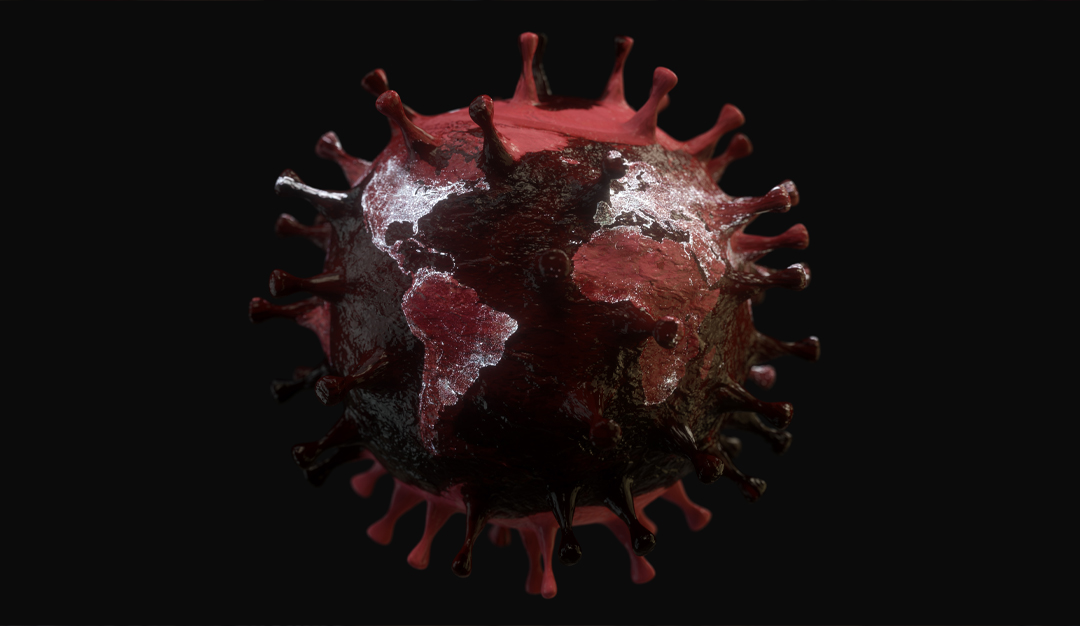
 ونجد أيضًا في عملية توثيق أقدم اختبار معروف على سوائل الجسم لتشخيص مرض السكري، التي نستعرض فيها هذا النص الذي جاء توثيقًا من الدكتور نهيد علي في كتابه «أنت والسكري»: «فقد تضمنت الكتابات الهندية القديمة أن النمل الأسود والذباب كان يحوم حول بول السكريين. وقد كتب سوشروتا، وهو طبيب هندي عاش في فترة تقرب من أربع مئة سنة قبل الميلاد، يصف البول لدى السكريين وطعمه الحلو، وبعد ذلك اعتقد الأطباء أن حلاوة البول هي إحدى علامات السكري».
ونجد أيضًا في عملية توثيق أقدم اختبار معروف على سوائل الجسم لتشخيص مرض السكري، التي نستعرض فيها هذا النص الذي جاء توثيقًا من الدكتور نهيد علي في كتابه «أنت والسكري»: «فقد تضمنت الكتابات الهندية القديمة أن النمل الأسود والذباب كان يحوم حول بول السكريين. وقد كتب سوشروتا، وهو طبيب هندي عاش في فترة تقرب من أربع مئة سنة قبل الميلاد، يصف البول لدى السكريين وطعمه الحلو، وبعد ذلك اعتقد الأطباء أن حلاوة البول هي إحدى علامات السكري».

