
لماذا التنوير الآن؟
لعله لم توجد فيما مضى لحظةٌ تستدعي سؤال التنوير، فحصًا ومساءلة ومراجعة، بقدر هذه اللحظة الراهنة التي يتلظَّى العرب بحروبها الوحشية ونزاعاتها الحادة، لحظة عدمية لا ينتج منها سوى ظلام عميم له رائحة الدم ولونه، ظلام لا تعود معه الرؤية ممكنة ويستحيل معه أيضًا التقدم أو حتى التراجع عما يحدث اليوم.
هنا لا نبحث عن مناسبة لفتح مثل هذا الملف، ولكن سعيًا لتكثيف الحاجة في مثل هذه الأوقات الكالحة إلى الاستنارة، بما هي فعل لا يجلو الظلام الماثل بيننا وبين المستقبل فحسب، إنما أيضًا ممارسة تعيد إلى الواجهة تلك المشاريع الكبرى التي أنتجها مفكرون وفلاسفة عرب طوال مئة عام، لطرح الأسئلة عليها تارةً، وبحثًا عن أجوبة في صفحاتها تارة أخرى.
لقد سعى مفكرون إلى إيجاد صيغ نهضوية تتعاطى مع الراسخ الموروث وتتقدم بالثقافة العربية إلى المستقبل، كانت العودة إلى التراث شرطًا شارطًا لديهم، ورأوا أنه بدون قراءة جديدة للتاريخ العربي لن نستطيع معالجة أزمات العقل العربي في حاضره ولا تهيئته للحاق بالمستقبل، فيما تداول باحثون آخرون القيم الغربية المنطلقة من ثورات أوربا الثقافية والصناعية، ورأوا فيها العلاج المجرب، وما بين المناهج والمدارس الفكرية من يسار ويمين، ومن الماركسية إلى الليبرالية تقلب الفكر العربي محاولًا إيجاد دواء لعلل التقهقر والتبعية.
وكان من المنتظر أن تكون حصيلة كل هذه الأعمال الفكرية العميقة ثورةً ثقافية كبرى، تنهي حالة الركود والتخلف عن أمم الغرب والشرق، فجاءت ثورات الأقطار العربية لتعيد رسم الاستبداد وترسخ طبائعه وتصعد بأصوليات متوحشة وتعزز التناحر المذهبي والأيديولوجي.. لقد تفوّق الواقع العربي اليوم على أسوأ كوابيس المفكرين العرب.
ترى هل كانت مشاريع النهضة العربية فاشلة، وما تحصده المجتمعات العربية اليوم نتيجة لقصور هذه المشاريع عن الفهم وتهافتها؟ أم أن المفكرين كانوا يحذرون مما آل إليه الحال ولم يكن أحد يستمع إليهم؟ في معنى آخر: هل كان هناك –حقًّا- مشروعٌ نهضوي واضح المعالم وذو اتجاه واحد إلى المستقبل؟
إشكالية التنوير في العالم العربي

مراد وهبة – مؤسس الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير
إن لفظ إشكالية يعني أن ثمة قضية يقال عنها: إنها صادقة، ومع ذلك فإنها تبدو كاذبة. وإذا كان الصدق والكذب متناقضين، فمعنى ذلك أن الإشكالية تنطوي على تناقض.
والسؤال إذن: أين يكمن التناقض في التنوير؟
كان للفيلسوف الألماني العظيم كانْت الذي يقف عند قمة التنوير في القرن الثامن عشر مقال عنوانه «جواب عن سؤال: ما التنوير؟» (1784م)، ويمكن إيجازه في شعاره القائل: «كن جريئًا في إعمال عقلك». وقد كان يقصد به أن لا سلطان على العقل إلا العقل نفسه. وترتب على ذلك القول بأن قياس مدى التنوير مردود إلى مدى سلطان العقل.
وتأسيسًا على ذلك يمكن إثارة السؤال الآتي: أين تكمن أزمة العقل فى إشكالية التنوير؟
في نوفمبر من عام 1978م انعقد في الجزائر «مهرجان ابن رشد» بتنظيم من الجامعة العربية والحكومة الجزائرية، وإذا بأبحاث المهرجان، في معظمها، تُضعف من شأن العقل عند ابن رشد. مثال ذلك بحث الدكتور عبدالكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأردني إذ يقول: إنه يجب إخراج الصراع الفلسفي بين الغزالي وابن رشد من مجال البحث الفلسفي الرصين؛ لأنه ينطوي على نبرة انفعالية، في حين أنه كان الصراع التاريخي الذي حدد مسار العالم العربي في اتجاه الأصولية الدينية التي تبطل إعمال العقل في النص الديني، وبالتالي في النصوص الأخرى أيًّا كانت.
أما زكي نجيب محمود فيطمس معالم التأويل عند ابن رشد؛ إذ يرى أن ابن رشد لا يلجأ إلى التأويل إلا للضرورة، حتى هذه الضرورة إن وجدت إنما تدلل على أن ظاهر الشريعة يؤيد ما نذهب إليه من تأويل، وبذلك يقضي زكي نجيب محمود على التفرقة التي يجريها ابن رشد بين المعنى الظاهر والمعنى الباطن للنص الديني. أما ألبير نادر فيذهب إلى أبعد مما ذهب إليه زكي نجيب محمود؛ إذ يرى أن من يقر بسلطان العقل فإنه سرعان ما ينزلق إلى التشكيك في الوحي.
تنويريون عرب يجتمعون في باريس
في مارس من عام 1980م اجتمع في باريس أربعون عضوًا من مشاهير مفكري العرب لتأسيس «حركة تنوير عربية». وكانت فكرة التأسيس هذه قد راودت أسرة تحرير مجلة «الطليعة» القاهرية في عام 1979م. والمفارقة هنا أن ذلك الاجتماع التأسيسي كان هو الأول والأخير، أي أنه قد أصيب بالفشل.
والسؤال إذن: لماذا فشل؟
وأجيب بسؤال: لماذا انعقد ذلك الاجتماع في باريس ولم ينعقد في أي بلد عربي، وبخاصة أنه يدعو إلى حركة تنوير عربية؟
بنبرة تشاؤمية يمكن القول: إن أسرة تحرير مجلة الطليعة لم تعثر على بلد عربي يقبل استضافة مؤتمر عن التنوير. وبنبرة تفاؤلية يمكن القول: إن اختيار باريس كان مردودًا إلى أنها عاصمة النور، حيث بزغت فيها حركة تنويرية في القرن الثامن عشر من فلاسفة التنوير، من أمثال ديدرو ودالامبير وروسو وفولتير ومونتسكيو. أما أنا فمنحاز إلى النبرة التشاؤمية؛ لأن التساؤل يظل قائمًا: لماذا لم تقبل الدول العربية استضافة مؤتمر التنوير؟ للجواب عن هذا التساؤل أستعين بحوار دار بين اليسار المصري وتوفيق الحكيم في يناير 1975م. وفي ذلك الحوار كان رأيي أن أوربا قد مرت بحركتين للتنوير: «تحرير العقل»، و«التزام العقل بتغيير الوضع القائم».
أما الدول العربية ومن بينها مصر فلم تمر بهاتين الحركتين. وقد وافق توفيق الحكيم على هذا الرأي، ثم استطرد قائلًا: لقد ارتددنا إلى الوراء من بعد العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين؛ بسبب الرجعية الدينية الخرافية التي لا تتفق مع جوهر الدين، ولكنها تتستر باسم الدين لتلغي دائمًا دور العقل. انظروا كمثال لمهرجان الملابس في الجامعة. إنهم يقولون: هذا زي إسلامي، وذاك زي غير إسلامي. وهنا تذكر توفيق الحكيم المقالات التي كان يكتبها في عام 1939م بمناسبة صراعه مع السلطة الدينية. ومن هنا دعا إلى ضرورة نشر العلمانية في التفكير وفي المنهج العلمي.
إلا أن هذا الصراع الذي تحدث عنه توفيق الحكيم كان سابقًا على زمانه؛ ففي عام 1834م أصدر رفاعة رافع الطهطاوي كتابًا عنوانه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» جاء فيه أنه ترجم اثنتي عشرة شذرة لمفكري التنوير الفرنسي، ومع ذلك وضع شرطًا لقراءة هذه الشذرات، وهو التمكن من القرآن والسُّنة؛ لأنها محشوة بكثير من البدع، وبها حشوات ضلالية مخالفة لسائر الكتب السماوية، يقيمون على ذلك أدلة يعسر على الإنسان ردها. واللافت للانتباه ههنا أن مخطوط كتاب «تخليص الإبريز» كان به فقرات حذفها رفاعة قبل نشر كتابه. ومن هذه الفقرات المحذوفة فقرة تتحدث عن إثبات علماء الإفرنج لدوران الأرض حول الشمس.
والشيخ علي عبدالرازق في كتابه المعنون «الإسلام وأصول الحكم» أنكر الخلافة الإسلامية بدعوى أنها ليست من الخطط الدينية ولا القضاء، ولا غيرها من وظائف الحكم ومراكز الدولة، إنما كلها خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، إنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل. وكانت النتيجة محاكمته أمام هيئة كبار العلماء بدعوى أن كتابه يحوي أمورًا مخالفة للقرآن الكريم والسُّنة النبوية وإجماع الأمة، ومن ثم صدر الحكم بإجماع الآراء بإخراج الشيخ علي عبدالرازق من زمرة العلماء، وطرده من كل وظيفة لعدم أهليته للقيام بأي وظيفة دينية أو غير دينية.
واللافت للانتباه ههنا أن كتاب الشيخ علي عبدالرازق قد صدر بعد عام من إلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا في 3 مارس 1924م. ومن هنا يمكن القول بأن قرار هيئة كبار العلماء بطرد الشيخ علي عبدالرازق يتضمن ضمنيًّا انحياز هؤلاء إلى الخلافة الإسلامية. وكل ما هو حادث من إرهاب تثيره حركات إسلامية أصولية مثل حركة الإخوان المسلمين وحركة داعش وحركة النصرة وغيرها، إنما هو من أجل إعادة الخلافة الإسلامية، ليس فقط في الدول الإسلامية، إنما أيضًا في جميع الدول الموجودة على كوكب الأرض.
وإذا كانت الأصولية تعني إبطال إعمال العقل في النص الديني، فالأصولية ضد التنوير الذي هو إعمال العقل، ليس فقط في مجال الدين، إنما أيضًا في جميع مجالات الحياة الإنسانية.
الخروج من الأزمة

جان جاك روسو
والسؤال بعد ذلك: هل في الإمكان تأسيس تيار تنويري للخروج من أزمة التنوير؟
جوابي بالإيجاب، بشرط أن يستند هذا التيار التنويري إلى تأسيس رشدية عربية لمواجهة الأصوليات العربية، على أن تكون مكونات هذه الرشدية على النحو الآتي:
إن للنص الديني معنيين أحدهما ظاهر والآخر باطن.
مشروعية إعمال العقل في النص الديني للكشف عن المعنى الباطن، وهو ما يسمى بالتأويل، وتعريفه عند ابن رشد أنه: «إخراج اللفظ من دلالته الحقيقية – أي الحسية – إلى حقيقته المجازية».
عدم تكفير المؤول بدعوى خروجه عن الإجماع. وفي هذا المعنى قال ابن رشد: «لا يقطع بكُفر مَنْ خرج على الإجماع» في كتابه المعنون «فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال».
الدخول في علاقة عضوية بين الرشدية العربية والرشدية اللاتينية حتى يزول التوتر الحاد بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، ومن ثم تتوارى عبارة «تصادم الحضارات» التي روَّج لها صموئيل هنتنغتون في كتابه المعنون هكذا في عام 1997م؛ إذ التفت إلى ظاهرة جديدة بزغت في السبعينيات من القرن الماضي، وهي الأصوليات الدينية التي أحدثت تغييرًا في موازين القوى في البلدان الإسلامية من انحياز إلى الحكومات الغربية إلى معاداتها بعد ذلك. ومن هنا أثار هنتنغتون السؤال الآتي:
هل المؤسسات الكوكبية وتوزيع القوى، وسياسات واقتصاديات الدول في القرن الحادي والعشرين هي التي ستشيع القيم الغربية، أم أن الأصولية الإسلامية هي التي ستشيع قيمها المستندة إلى إبطال إعمال العقل على نحو ما ارتأى الفقيه ابن تيمية من القرن الثالث عشر؟
الرأي عندي أن التنوير، أو بالأدق إعمال العقل بجسارة، هو محور التغيير المقبل. ويترتب على ذلك نتيجة حضارية هي أن العالم العربي ليس في إمكانه إزالة إشكالية التنوير إلا بالالتزام بقيم التنوير. إن هذا الالتزام لن يكون ممكنًا إلا بإحياء فكر ابن رشد بديلًا عن ابن تيمية. وهذه هي مفارقة العالم العربي.
التنوير العربي كمنقذ من الطائفية والمذهبية
هاشم صالح
كاتب سوري
بداية أود طرح هذا السؤال: لماذا يرفض الغربيون العودة إلى الأصولية المسيحية؟ لأنهم يعرفون معنى التدين الأصولي القديم وكل العصبيات الطائفية والمذهبية التي يحملها معه أو تحت طياته. وهذا شيء يريدون تحاشيه بأي شكل كان؛ فقد عانوا حروب المذاهب المسيحية ما عانوا إلى درجة أن مجرد ذكراها يبث الرعب والاشمئزاز في النفوس. يكفي أن نعلم أن حرب الثلاثين عامًا (1618-1648م) دمرت نصف ألمانيا تقريبًا، واجتاحت معظم أنحاء أوربا الأخرى. وهم لا يريدون العودة إلى هذه الحروب الطائفية التي مزقتهم تمزيقًا. وقُل الأمر ذاته عن الحرب الأهلية الرهيبة التي جرت بين الكاثوليكيين والبروتستانتيين في فرنسا. أصلًا التنوير جاء كرد فعل على هذه الحروب المذهبية التي حطمت أوربا. الكاثوليكيون والبروتستانتيون كانوا أيضًا يكفّر بعضهم بعضًا مثلما تفعل المذاهب والطوائف عندنا حاليًا. كل طرف كان يدعي أنه يمثل العقيدة المسيحية القويمة المستقيمة التي لا تشوبها شائبة، وأن الطرف الآخر منحرف عنها ومهرطق وزنديق، ومن ثم فهو كافر يحل دمه.
وهذا يعني أن عقيدة الفرقة الناجية موجودة أيضًا في المسيحية. جماعة البابا والفاتيكان يعتقدون اعتقادًا جازمًا أنهم هم الذين يمثلون المسيحية الحقة وليس البروتستانتيون أو الأرثوذكس الروسيون أو غير الروسيين من يونانيين وصرب ومسيحية شرقية عربية. وعلى هذا الأساس كان الكهنة والقساوسة يهيجون المتدينين البسطاء بعضهم على بعض لارتكاب المجازر والذبح على الهوية. عندئذ قرر فلاسفة التنوير فتح ملف العقيدة اللاهوتية المسيحية. واتخذوا قرارًا بتفكيكها والانتقام منها حتى العظم! ماذا فعل بيير بايل وسبينوزا وفولتير ومونتسكيو وروسو وديدرو والموسوعيون… إلخ؟ هذا ناهيك عن كانط وهيغل وفويرباخ ونيتشه… إلخ. هنا بالضبط يكمن جوهر مشروع التنوير الكبير الذي يريد بعض المثقفين العرب القفز عليه بحجة أنهم تجاوزوه ووصلوا إلى مرحلة ما بعد الحداثة! برافو!
سؤال فلسفي مطروح على واقعنا العربي الإسلامي
السؤال المطروح الآن هو: ما معنى اللحظة التاريخية التي نعيشها حاليًا؟ في أي لحظة من التاريخ نتموضع نحن كعرب وكمسلمين؟ هل حقًّا تجاوزنا مرحلة الحداثة إلى ما بعد الحداثة، والتنوير إلى ما بعد التنوير، كما فعلت مجتمعات أوربا المتقدمة؟ أم أننا لا نزال متخلفين عقليًّا ومتأخرين فكريًّا؟ لماذا لم تعد تحصل أي مجزرة طائفية أو مذهبية في فرنسا أو ألمانيا أو سويسرا في حين أنها كانت شائعة طيلة القرون الوسطى بل حتى القرن الثامن عشر؟ ينبغي أن نعترف بأننا: لا نزال نتخبط في متاهات العصور الوسطى الطائفية التكفيرية. نحن نتخبط في خضم الحروب المذهبية التي حذَّر منها بالأمس القريب الأمير الشاعر المثقف خالد الفيصل. أطرح عليكم هذا السؤال: هل تجاوز المجتمع الباكستاني مرحلة المجازر الطائفية؟ ماذا حصل فيه مؤخرًا من مجازر طائفية بل يحصل بشكل دوري من وقت لآخر؟ وقل الأمر ذاته عن المجتمع الأفغاني. ماذا يحصل في نيجيريا أو العراق أو سوريا… إلخ؟ وقس على ذلك بقية المجتمعات الإسلامية والعربية من دون استثناء.
إن مناهضي التنوير يتحدثون عن الأمور بكل خفة -أو استخفاف- وكأن المجتمع السوري أو المصري أو السعودي يقف على نفس مستوى الاستنارة العقلية عند المجتمع الهولندي أو الفرنسي، أو الأوربي عمومًا. وأقصد بالاستنارة العقلية هنا انحسار العصبيات الطائفية والمذهبية بفضل هضم جماهير الشعب (وليس فقط المثقفين) للفلسفة العقلانية الحديثة وتجاوز المرحلة القروسطية للدين أو التدين. أحيانًا يخيل إليَّ وكأنهم يقولون: لا توجد طائفية عندنا ولا مذهبية ولا حروب أهلية مضمرة أو صريحة. كل شيء على ما يرام عندنا والحمد لله. نحن لا نشكو من أي شيء. من قال لكم بأن عندنا مشكلة؟ نحن تجاوزنا مرحلة الحداثة والتنوير بسنوات ضوئية ووصلنا إلى مرحلة ما بعد الحداثة وما بعد التنوير القديم التافه! لماذا يريد هذا الشخص أن يعيدنا مئتي سنة إلى الوراء؟ وأنا أقول: إني أريد إعادتكم أربعمئة سنة إلى الوراء وليس فقط مئتين! ليتكم توصلتم إلى مستوى الوعي الأوربي في القرن السادس عشر! ليت شمس النهضة الإيطالية العظيمة أطلَّت عليكم ولو لحظة واحدة فأضاءت عتماتِكم ودياجيرَكم المتراكمة بعضها فوق بعض منذ إغلاق باب الاجتهاد والدخول في عصر الانحطاط قبل ألف سنة. ومن ثم كفانا مكابرة أيها الأصدقاء. ورحم الله امرءًا عرف قدر نفسه.
الفرق بين المعاصرة الزمنية
والمعاصرة الفكرية أو الإبيستمولوجية
إ ذا لم نأخذ في الحسبان الفجوةَ التاريخية الكبيرة التي تفصل الفكر الأوربي عن الفكر العربي، أو تؤخر المجتمعات العربية عن تقدم المجتمعات الغربية، فإننا لن نفهم شيئًا من شيء ولن نستطيع طرح أي مشكلة بشكل صحيح، ناهيك عن حلها وعلاجها. وهنا تطرح علينا مشكلة التحقيب الزمني والإبيستمولوجي للفكر الأوربي من جهة، والفكر العربي الإسلامي من جهة أخرى. ينبغي لنا أن نعلم أن الفكر الأوربي مر بمختلف المراحل حتى الآن وبشكل طبيعي تدريجي؛ مرحلة العصور الوسطى المسيحية، فمرحلة الحداثة، فمرحلة ما بعد الحداثة. وهنا ينبغي لنا أن نتفق على أمور؛ فمرحلة ما بعد الحداثة لا تعني إلغاء منجزات الحداثة، إنما تعني تصحيحًا للانحرافات التي طرأت على الحداثة.
ذا لم نأخذ في الحسبان الفجوةَ التاريخية الكبيرة التي تفصل الفكر الأوربي عن الفكر العربي، أو تؤخر المجتمعات العربية عن تقدم المجتمعات الغربية، فإننا لن نفهم شيئًا من شيء ولن نستطيع طرح أي مشكلة بشكل صحيح، ناهيك عن حلها وعلاجها. وهنا تطرح علينا مشكلة التحقيب الزمني والإبيستمولوجي للفكر الأوربي من جهة، والفكر العربي الإسلامي من جهة أخرى. ينبغي لنا أن نعلم أن الفكر الأوربي مر بمختلف المراحل حتى الآن وبشكل طبيعي تدريجي؛ مرحلة العصور الوسطى المسيحية، فمرحلة الحداثة، فمرحلة ما بعد الحداثة. وهنا ينبغي لنا أن نتفق على أمور؛ فمرحلة ما بعد الحداثة لا تعني إلغاء منجزات الحداثة، إنما تعني تصحيحًا للانحرافات التي طرأت على الحداثة.
أما منجزات الحداثة كالتنوير الديني وتجاوز الطائفية بوساطة العقل العلمي والدولة المدنية، فلا أحد يريد التراجع عنها. لا ريب في أنهم أصبحوا يدعون إلى علمانية إيجابية منفتحة على البعد الروحاني للإنسان ولكن من دون العودة إلى النظام الأصولي الطائفي القديم، أو التراجع عن الفكرة الأساسية للعلمانية والدولة المدنية. لا أحد يريد التراجع عن دولة الحق والقانون الذي ينطبق على الجميع. ولا أحد يريد التراجع عن الحرية الدينية المطلقة: أي حرية أن تتدين أو لا تتدين على الإطلاق، بمعنى آخر فإن آية: ﴿لا إكراه في الدين﴾ مطبقة في أوربا وليس في العالم الإسلامي. ولذلك قال الإمام محمد عبده عبارته الشهيرة: في أوربا يوجد إسلام بدون مسلمين، وعندنا يوجد مسلمون بلا إسلام. بمعنى أن مكارم الأخلاق والدقة في المواعيد والإخلاص في العمل كلها أشياء موجودة في أوربا ولكن ليست عندنا.
أكاد أسمعهم يقولون: «يا أخي، هذا الشخص يريد إعادتنا إلى عصر التنوير الأوربي. إنه يريد إعادتنا مئتي سنة إلى الوراء. ما هذا الهراء؟! نحن تجاوزنا كل ذلك. نحن في القرن العشرين، بل الحادي والعشرين. متى سيفهم هذا الشخص أننا لم نعد في القرن الثامن عشر؟!». كردٍّ على هذه المغالطة السهلة والمكابرة المضحكة(1) سوف أقول ما يلي: إني لا أريد إعادتكم إلى القرن الثامن عشر فقط، إنما إلى القرن السادس عشر أيضًا! هل تعتقدون أنكم تجاوزتم الأسئلة التي طرحتها النهضة الإيطالية العظيمة على الدين؟ بل أريد إعادتكم إلى القرن الثالث عشر وبدايات النهضة الأوربية الأولى؛ حيث انهمكوا في ترجمة علمائنا وفلاسفتنا وبنوا على ذلك نهضتهم الكبرى.
بل أريد إعادتكم إلى ما قبل ذلك بكثير: إلى القرن الثامن والتاسع والعاشر للميلاد؛ أي إلى العصر الذهبي العربي الإسلامي بالذات. هل تعتقدون أننا تجاوزنا التساؤلات التي طرحها ابن المقفع والتوحيدي والرازي والفارابي وابن سينا وابن رشد والمعري وسواهم على الدين؟ بل حتى الأسئلة التي طرحتها فرقة المعتزلة المتنورة العظيمة التي لا نستطيع طرحها الآن. أيها السادة، العالم الإسلامي ليس متخلفًا عن ركب الحضارة علميًّا وتكنولوجيًّا وفلسفيًّا فقط. إنما هو متخلف دينيًّا ولاهوتيًّا أيضًا بالدرجة الأولى. ما يقال عن الدين في العالم العربي والإسلامي حاليًا شيء مضحك ومخجل. إنه يفضحنا أمام البشرية كلها. إنه يعرينا على حقيقتنا. هل تعتقدون أننا سنخرج من هذا المغطس الكبير الذي وقعنا فيه عن طريق مثل هذا الخطاب القروسطي التكفيري الذي يبثه شيوخ الفضائيات على مدار الساعة، ويملأ العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه؟
لقد أصبحنا مهزلة العالم كله، بل أصبحنا بعبعًا يرعب العالم، بعد أن كنا ذروة الحضارة إبان العصر الذهبي. ومن ثم فالمسألة ليست مضحكة على الإطلاق.
الصراع الجدلي الخلَّاق
بين مثقفي الحداثة ومثقفي القدامة
قلتها مرارًا وتكرارًا في كتبي المتلاحقة: هناك فرق بين التنوير الوسطي المؤمن والتنوير المتطرف الملحد؛ الأول يمثله (فولتير، وجان جاك روسو، ومونتسكيو، وكانط) وسواهم من عمالقة الفكر، والثاني يمثله (ديدرو، والبارون دولباك، ونيتشه) وآخرون عديدون. وقد اخترت معسكري منذ البداية بكل وضوح؛ فأنا مع التنوير المؤمن بالله والعناية الإلهية والقيم الأخلاقية العليا لتراثنا العربي الإسلامي العريق، وقلت أيضًا بأن تنويرنا لن يكون نسخة طبق الأصل عن التنوير الأوربي، ولا معاكسًا له على طول الخط؛ فهناك إيجابيات عديدة في التنوير الأوربي، وخصوصًا في بداياته عندما كان لا يزال بريئًا ولم ينحرف بعد. ولا بأس من استلهامها والاستضاءة بها. وعلى أي حال فإن صراع الأضداد الذي جرى في أوربا بين الفلاسفة ورجال الدين المسيحيين سوف يحصل ما يشبهه في الساحة العربية، بل قد بدأ يحدث من الآن، وبخاصة بعد أن وصل الإخوان إلى سُدَّة السلطة في بعض البلدان العربية قبل أن يزاحوا عنها لحسن الحظ من متنوري مصر وتونس.
فمن الواضح أن الفهم الإخواني للإسلام يتعارض مع الفهم العقلاني المستنير. والصراع محتوم بين الطرفين. ولن نستطيع تحاشي ذلك مهما فعلنا؛ فإما إسلام الأنوار وإما إسلام الإخوان. انظر إلى ما حصل في مصر إبان حكم مرسي من صراعات حادة حول «الأخونة»: أي أخونة الإدارة الحكومية والتلفزيون والإعلام والثقافة وكل شيء. ولكن الصراع ليس كله سلبيًّا كما ذكرت سابقًا. على العكس تمامًا. كان هيغل يقول ما معناه: «لا شيءَ عظيمًا في التاريخ يتحقق بدون صراعات البشر وأهوائهم الهائجة». ومن ثم فما نشهده حاليًا من اضطرابات في العالم العربي قد يكون ظاهرة صحية وليست مرضية؛ فالمجتمعات الراكدة الهامدة هي وحدها التي لا تعرف معنى الصراع، ومن ثم تجهل معنى الابتكار والإبداع والانتقال من حال إلى حال.
وعلى مدار التاريخ كان هناك صراع جدلي خصب بين العقل الديني والعقل الفلسفي. وحضارتنا العربية الإسلامية لم تبلغ أوجها إلا عندما كان هذا الصراع متألقًا إبان العصر الذهبي المجيد. ولكن عندما توقف هذا الصراع وماتت الفلسفة أُغلق باب الاجتهاد ودخلنا في عصر الانحطاط الطويل والفكر الأُحادي الممل والتكرار والاجترار… لم يعد هناك توتر ذهني أو صراع فكري في الساحة الإسلامية؛ لأن أحد طرفي المعادلة، أي العقل الفلسفي، هُمش وقُضي عليه، بل تم تكفيره وزندقته. وبموت العقل الفلسفي حصل جمود للعقل الديني فأصبح فقيرًا جدًّا من الناحية الفكرية؛ لأن الفلسفة لم تعد موجودة لكي تغذيه وتستفزه وتدفعه إلى المزيد من النضج والانفتاح. للتدليل على ذلك يكفي أن نقارن بين العقل الديني عندنا والعقل الديني في الغرب. بصراحة لا وجه للمقارنة؛ فرجال الدين في أوربا يطلعون على كتب الفلسفة ويستفيدون منها في تعميق الإيمان وفهم الدين، أما عندنا فيكتفون بقراءة الكتب التقليدية التي أكل عليها الدهر وشرب. نضرب على ذلك مثلًا: عالم اللاهوت السويسري الألماني هانز كونغ(2). إنه مطلع على أحدث النظريات الفلسفية والإبيستمولوجية، ولهذا السبب فإن دراساته عن الدين تبدو قوية ومقنعة، على عكس دراسات التقليديين المملة من كثرة التكرار والاجترار. وهذا يعني أن الاحتكاك بين الدين والفلسفة مفيد لكلا الطرفين. ومن ثم فلا بد من إعادة الاعتبار إلى الفلسفة والعقل الفلسفي إذا ما أردنا النهوض واستعادة العصر الذهبي مرة أخرى.
وختامًا فإن تخبطات الربيع العربي شيء إجباري لا مندوحة عنه؛ لأنه «لا بد دون الشهد من إبر النحل»؛ كما يقول شاعرنا الكبير المتنبي الذي اكتشف معنى الجدل وقانون التقدم قبل هيغل! وهذا يعني أن المرور بالمرحلة الإخوانية الأصولية على الرغم من صعوبتها وخشونتها شيء لا بد منه لكي نتحرر منها على طريقة: «وداوني بالتي كانت هي الداء»؛ كما يقول الشاعر الكبير أبو نواس. لهذا السبب أقول بأننا نعيش لحظة تقدمية من التاريخ العربي حتى لو كانت تبدو في ظاهرها تراجعيةً، بل فجائعية.
——————————————-
الهوامش:
(1) للرد عليهم كان يكفي أن أستشهد بذلك المهرجان الكبير الذي أقامته المكتبة الوطنية الفرنسية للاحتفال بالتنوير وفلاسفته تحت إشراف المفكر المعروف تزفيتان تودوروف عام 2006م. وقد نظموه تحت الشعار الكبير التالي: التنوير كإرث للمستقبل! بمعنى أن التنوير لا ينتمي إلى الماضي حتى بالنسبة إلى أوربا، فما بالك بالنسبة للشعوب التي لم تشهده بعد؟ لا ريب في أن أوربا الغربية استنارت إلى حد بعيد. ولكن ماذا عن أوربا الوسطى والشرقية؟ ماذا عن روسيا السلافية الأرثوذكسية؟ بولونيا لا تزال كاثوليكية جدًّا، على عكس فرنسا مثلًا. ومن ثم فهناك شعوب كثيرة لا تزال تنتظر أن تستنير. لا ريب في أنهم نظموا المعرض والمهرجان كرد فلسفي على ضربة 11 سبتمبر، لا ريب في أنهم كانوا يقصدون به الشعوب العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، ولكن مسألة التنوير تخص الجميع.
انظر الكتاب الجماعي الذي أصدروه بعد المؤتمر والمعرض تحت نفس العنوان: الأنوار إرث للمستقبل. مطبوعات المكتبة الوطنية الفرنسية 2006م.
Lumieres! Un heritage pourdemain. Collectif Bibliotheque Nationale de France 2006.
ومن ثم فالتنوير لم يصبح في ذمة التاريخ على عكس ما يتوهم بعض المثقفين العرب!… بل إنه لم يبتدئ بعد بالنسبة لثقافات عديدة وشعوب كثيرة في العالم، إنه أمامنا لا خلفنا.
(2) انظر كتابه الكبير عن الإسلام ويقع في نحو ألف صفحة. وقد ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية: Hans Kung :L’Islam.Cerf.Paris 2010.
للأسف الشديد! لا نستطيع أن نقارن مشايخنا بهذا العالم الكبير. وهذا أكبر دليل على مدى تخلف الفكر الديني في بلادنا. هناك مفكر واحد يستطيع أن يرتفع إلى مستواه وربما يتفوق عليه هو: محمد أركون، أكبر مجدد للفكر الإسلامي في هذا العصر. ولكن من يستمع إلى محمد أركون؟ لحظته لم تحن بعد..
مآلات التنوير في الفكر العربي المعاصر
كمال عبداللطيف – كاتب وباحث مغربي، أستاذ الفلسفة في جامعة محمد الخامس
يضمر سؤال مآلات التنوير في الفكر العربي موقفًا من الراهن العربي، وما يتفاعل داخله من أنماط الصراع التي أفرزتها تداعيات الحراك الاجتماعي الذي شمل العديد من البلدان العربية طيلة سنوات العقد الثاني من الألفية الثالثة. وهو يضمر أيضًا موقفًا من نمط استيعاب الثقافة العربية المعاصرة لمكاسب عصر الأنوار، كما تَمَثَّلَها جيل الرواد في عصر النهضة العربية، ومن سار على دربهم من النخب التي واصلت عمليات توطين وتوظيف قيم التنوير في ثقافتنا، انطلاقًا من إيمانها بأن القيم المذكورة تشكل سندًا داعمًا لمتطلبات المشروع النهضوي العربي.
نفترض أن الذين يقبلون المضمرات المشار إليها يعتمدون تصوُّرات محدَّدة للتاريخ ولأدوار الفكر في التاريخ، وهي تصوُّرات تُغفل تعقُّد المجال التاريخي ولا تعيره الاهتمام المطلوب؛ لقوة التقليد والتقاليد في مجتمعنا وثقافتنا. ونحن نرى أن الذين يعتقدون بتراجع قيم التنوير في فكرنا يُغفلون أن التاريخ لا يسير بطريقة خطية متصاعدة، وأن موجات الحماسة لمشروع التنوير وموجات الاعتراض عليه مقابل الإعلاء مجددًا من شأن الفكر المحافظ والقيم المرتبطة به، كما حصلت وتحصل في فكرنا المعاصر، تُعَدّ مجرَّد عناوين كبرى في صراع تاريخي متواصل، وهو صراع لا يُحَلُّ بين ليلة وضُحاها، إنه صراع يتطلَّب مسافات من الزمن تَطُول أو تَقْصُر، تختفي ثم تعود، وذلك حسب أنماط بنائنا وصور تفاعلنا مع مقدمات أسس التنوير وقواعده.
قد لا نكون مجازفين عندما نعلن أن مظاهر التوتر والتناقض والتراجع، التي تشكل اليوم السمات الأبرز في فكرنا المعاصر، تعود في بعض جوانبها إلى قصر النفس النظري المهيمن على معاركنا في الفكر والسياسة والمجتمع.. نحن هنا لا نفسر ظواهر تاريخية مركبة بعامل واحد، ولكننا نتصور أن القصور النظري يعد واحدًا من العوامل المساعدة على فهمٍ أكثر دقةً لجوانب عديدة من إشكاليات التحول السياسي الحداثي والتحديثي في عالمنا العربي.
نحو استيعاب مقدمات الأنوار
لقد انطلقت معاركنا في الإصلاح الديني والثقافي والسياسي وإصلاح المؤسسات منذ ما يقرب من قرنين من الزمان، وأتاحت لنا المعارك المذكورة في صورها المتعددة، استيعاب جملة من العناصر في موضوع المرجعية السياسية الحداثية وما يرتبط بها من قيم التنوير. تكشف مظاهر التأخر العامة في مجتمعاتنا اليوم، بما لا يدع أي مجال للشك؛ أن مُحصلةَ معاركنا وتجاربنا في المجال المشار إليه لم تثمر ما يسعف بناءَ قواعد ارتكاز نظرية وتاريخية قادرة على تحصين مشروعنا في النهوض، والتقليص من حِدَّة أزماتنا المزمنة في مجال التواصل مع ذاتنا ومع الآخرين في العالم.
ولأننا نتصور أن التحولات الهامة في التاريخ من قبيل استيعاب وتمثُّل مقدمات التنوير ومكاسب عصر الأنوار، ومحاولة تبيئتها بصورة مُبْدِعَة داخل نسيج حياتنا في الفكر وفي المجتمع، تتطلب مواصلة الجهد والعمل دون كلل؛ لعلنا نتمكَّن من تجاوُز العوائق التي حالت وما فتِئت تحول بيننا وبين انخراط فاعل في العالم؛ وهو الأمر الذي يسهم في تهيئة الشروط المساعدة على بلوغ المرامي التي سطَّرها النَّهْضَوِيُّون العرب في تاريخنا المعاصر.
وقبل تشخيص بعض جوانب من معارك التنوير في فكرنا، نشير إلى أن تصورنا للتنوير وقيمه لا يرتكز على مبادئ فكرية مغلقة، فليس فكر الأنوار في تصورنا مجرد جملة من المبادئ والمفاهيم المرتبطة ببعض الأنساق والمنظومات الفلسفية والوقائع التاريخية الحاصلة في أوربا بدءًا من القرن السابع عشر، بل إنها -كما نتصورها ونفكر فيها- تستوعب ذلك وتتجاوزه، وذلك بناء على معطيات التاريخ الذي أسهم في تبلورها وتبلور المكونات المركبة والمتناقضة التي نشأت في سياقات صيرورتها وتطورها.
لا نستكين في نظرتنا لعصر الأنوار ومكاسبه إلى تصورات ورؤى فكرية مُغلَقة، قدر ما نسلم بجملة من المبادئ النظرية التاريخية العامة، التي تنظر إلى الإنسان والمجتمع والطبيعة والتاريخ من منظور يستوعب ثورات المعرفة والسياسة، كما تحققت وتتحقق في التاريخ الحديث والمعاصر، وفي أوربا تحديدًا، موطن التشكل الأول للمشروع الأنواري، ثم في باقي مناطق وقارات العالم الأخرى بحكم شروط التحول العالمية، التي واكبت بعد ذلك عملية تعميم التنوير في مختلف ثقافات العالم.
إن قوة الموقف الفلسفي الذي يحمله مشروع التنوير، تتمثل أولًا وقبل كل شيء في الوعي بمبدأ المخاطرة الإنسانية الساعية إلى التغيير استنادًا إلى قيم بديلة لقيم التقليد المتوارثة؛ حيث فجرت مغامرةُ البحث الإنساني بدءًا من عصر النهضة في القرن 16م، آفاقًا واسعة أمام العقل البشري، وهو الأمر الذي ترتب عنه تبلوُرُ مجموعة من القيم المعرفية والأخلاقية الجديدة في النظر إلى الطبيعة والإنسان والمستقبل.
لا تنفصل إذن في نظرنا معارك المجال الثقافي والديني الحاصلة في مجتمعاتنا عن مشروع ترسيخ مقدمات الأنوار وقيمها في فكرنا. وضمن هذا السياق نعتبر أن انتشار دعاوى تيارات التطرُّف، ودعاوى تيارات التكفير والعنف في ثقافتنا ومجتمعنا، يمنحنا مناسبة تاريخية جديدة، لإطلاق مجابهات يكون بإمكانها أن تكشف فقر ومحدودية وغُرْبَة التصورات المتصلة بهذه التيارات، وهو الأمر الذي يتيح لنا بناء الفكر المبدع؛ أي إنشاء خيارات مطابقة لتطلعاتنا في النهضة والتقدم.
نحو إبداعِ تنويرٍ عربي
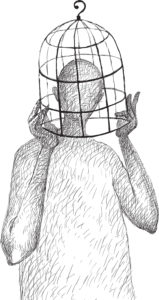 اعتاد الذين يناهضون قيم التنوير في فكرنا العربي وصفَ المتنورين في ثقافتنا بنعت الناقلين لفكرٍ لا علاقة له بتاريخنا ولا بثقافتنا ومجتمعنا. وقد تأكد في العقود الأخيرة من القرن الماضي -ويزداد تأكدًا اليوم وسط ما نعانيه في مجتمعاتنا من تنامي تيارات التطرف الديني بمختلف ألوانه- أن حاجة المجتمعات العربية إلى مبادئ الأنوار وقيم التنوير تتطلبها معركة الإصلاح الثقافي والإصلاح الديني في حاضرنا.
اعتاد الذين يناهضون قيم التنوير في فكرنا العربي وصفَ المتنورين في ثقافتنا بنعت الناقلين لفكرٍ لا علاقة له بتاريخنا ولا بثقافتنا ومجتمعنا. وقد تأكد في العقود الأخيرة من القرن الماضي -ويزداد تأكدًا اليوم وسط ما نعانيه في مجتمعاتنا من تنامي تيارات التطرف الديني بمختلف ألوانه- أن حاجة المجتمعات العربية إلى مبادئ الأنوار وقيم التنوير تتطلبها معركة الإصلاح الثقافي والإصلاح الديني في حاضرنا.
لا يتعلق الأمر إذن بعملية نسخ لتجربة معينة في التاريخ؛ تجربة حصلت في مجتمعات مختلفة اختلافًا كليًّا عن مجتمعاتنا، بل إنه يتعلق أساسًا بتجربتنا الذاتية في التاريخ. وحاجتنا إلى التنوير اليوم تمليها وقائع ومعطيات عينية قائمة في مجتمعاتنا وثقافتنا. أما النموذج الآخر، الذي حصل في التاريخ في سياقات أخرى وداخل مجتمعات أخرى، فيمكن أن نستفيد من رصيده الرمزي والتاريخي، كما يمكننا أن نعمل على تطوير بعض معطياته ومكاسبه في ضوء خصوصياتنا التاريخية، التي لا تستبعد ولا تنفي تشابه بعض معطيات التاريخ، وإمكانية الاستعانة بموضوع مواجهة قضاياه بالاستفادة من دروسه.
إن تزايد مظاهر التطرف في مجتمعاتنا -وقد أسهمت جملةٌ من العوامل في توليدها- تجعلنا نتصور أن معارك مواجهتها ينبغي أن تكون متنوعة بتنوع الأدوار التي تمارسها اليوم في واقعنا. وكلما ازداد عنف هذه المظاهر في محيطنا الاجتماعي والسياسي، ازدادت الحاجة إلى تطوير آليات ووسائل المواجهة، بهدف توسيع مساحات التنوير والتسامح، والانفتاح في ثقافتنا ومجتمعنا، وهو الأمر الذي يقلص -متى عُمِّم- من أدوار التطرُّف والمغالاة وأدوار بعض الفقهاء الذين يمنحون أنفسهم امتيازات الكهنوت، وامتيازات مانحي صكوك الغفران، وذلك بإصدارهم فتاوى التكفير والجهاد ومخاصمة العالم.
يطرح مشكل تنامي إسلام التطرف في واقعنا مطلب المواجهة بالتنوير والنقد؛ حيث لا يمكن أن تُحَوِّلَ جماعات معينة التجربة الروحية في التاريخ الإسلامي إلى تجربة متحجّرة مغلقة. إن التجربة الروحية في الإسلام تتجاوز الأحكام النمطية المحفوظة في تراث لا يعدو أن يكون جزءًا من تاريخ لم ينتهِ. لهذا السبب نرى أن عودة المحفوظات التقليدية بالصورة التي تتمظهر بها اليوم في ثقافتنا وفي مجالنا التربوي والسياسي، يعود إلى عدم قدرتنا على إنجاز ما يسعف بتطوير نظرتنا للدين والثقافة والسياسة في مجتمعاتنا. إن فشل مشاريع الإصلاح الديني والإصلاح التربوي في فكرنا يُعَدُّ من بين العوامل التي كرست –وتكرس- مثل هذه العودات العنيفة إلى المعطيات العتيقة في تراثنا وثقافتنا.
لم نتمكن من ترسيخ قيم الاجتهاد، ولم نبنِ الفكر الإسلامي المنفتح والقادر على تركيب تصورات جديدة للعالم، تتيح لنا استيعاب مقدمات وأصول الحياة الجديدة في عصرنا. ولعل أخطر ما فعلته التيارات المعادية لقيم العصر وفي قلبها قيم التنوير والتقدم في فكرنا المعاصر، هو تعميمها لجملة من الدعاوى الرامية إلى استبعاد إمكانية تصالح ذواتنا التاريخية مع العالم، مستندة في ذلك إلى تصورات ومبادئ لا علاقة بينها وبين الإسلام في جدليته التاريخية الحية، وقد شكل -كما نعرف في تاريخنا- مهمازًا للحركة التاريخية المنتصرة لقيم الأزمنة التي واكبته خلال عصورنا الوسطى.
وهنا لا بد من توضيح أن قيم الإسلام كما تبلورت في التاريخ، لا علاقة بينها وبين ما هو شائع اليوم من أفكارٍ أقل ما يمكن أن توصف به هو غربتها عن التاريخ وعن الإنسان. فالإسلام في تاريخه النصي والحدثي أكبر من الأحكام والفتاوى المحافظة والمترددة، إنه في روحه العامة عبارة عن جهد في التاريخ مشدود إلى التسامي وإلى المطلق، لهذا السبب نحن لا نتصور الإسلام دون اجتهاد. وضمن هذا الأفق، نشير إلى أن الإسلام ينفر من قيم الموت والقتل والتخريب والانغلاق والتزمُّت، ليحرص بدل كل ذلك على إشاعة قيم الحياة، قيم توسيع مساحة مكانة الإنسان في التاريخ.
التنوير مطلب كوني في عالم متحول
لا يتعلق الأمر في موضوع دفاعنا عن قيم التنوير في العالم العربي اليوم، بعملية نسخ أو نقل لتجربة تمت في التاريخ، والأنوار لا تزال اليوم مطلبًا كونيًّا. وقيم عصر الأنوار التي نشأت في سياق تاريخي محدد في القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوربا، تتعرض اليوم لامتحانات عميقة في سياق تاريخها المحلي، وسياقات تاريخها الكوني، وذلك بحكم الطابع العام لمبادئها، وبحكم تشابه تجارب البشر في التاريخ، وتشابه عوالمهم الروحية والمادية وعوالمهم التاريخية في كثير من مظاهرها وتجلياتها.
ترتبط حاجتنا إلى التنوير بأسئلة واقعنا، كما ترتبط بسؤال الاجتهاد في فكرنا وفي كيفيات تعاملنا مع قيمنا الروحية. وإذا كنا نعرف أن المبدأ الأكبر الذي وجه فكر الأنوار يتمثل في الدفاع عن عدم قصور الإنسان، والسعي لإبراز قدرته على تعقل ذاته ومصيره بهدف فكّ مغالق ومجاهل الكون والحياة؛ فإنه لا يمكن لأحد أن يجادل في أهمية هذا المبدأ، الذي يمنح العقل البشري مكان الصدارة في العالم، ويمنح الإنسان مسؤولية صناعة حاضره ومستقبله. وتاريخ البشرية يقدم الدليل الأكبر على قيمة هذا المبدأ، ولهذا السبب نحن معنيون بإشاعة القيم التي تتضمن وتستوعب الاعتزاز بالإنسان والإعلاء من مكانته ورسالته في الوجود.
ولعلنا نزداد تشبُّثًا بهذا المبدأ عندما نعاين في حاضرنا كثيرًا من مظاهر تحقير الإنسان والتنكيل به، فندرك بصورة أفضل أهمية الانخراط في تعزيز قيم التنوير في حياتنا، وندرك في الآن نفسه أن حاجتنا اليوم لهذه القيم لا تُمليها شروطٌ خارجية، ولا تمليها إرادة نقل تكتفي بنسخ الجاهز، بل إن حاجتنا الفعلية لهذه القيم تحددها بكثير من القوة شروط حياتنا الواقعية والفعلية؛ حيث يصبح توسيع فضاء العقل والنقد والتنوير مجالًا للمعاناة والتوتر والجهد الذاتي الخلّاق، في عمليات بناء القيم والمبادئ التي تتيح لنا الخروج من مأزقٍ موصول بإرث تاريخي لم نتمكن بعدُ من تشريحه ونقده تمهيدًا لإعادة بنائه بتجاوزه.
نسي كثير من الذين يتحدثون اليوم عن إخفاق مشروع التنوير في فكرنا، أن المأثرة الكبرى إنما هي لرواد الإصلاح الذين عملوا على غرس قيم العقل في فكرنا الإصلاحي، ونسي هؤلاء أن مهمة تركيب فكر التنوير في ثقافتنا لم تكن مسألة نظرية خالصة، بل إنها كانت منذ بداياتها الأولى أشبه ما تكون بعملية في المواجهة، مواجهة سقف في النظر واللغة، ومواجهة تاريخ من الاستبداد، وتاريخ من الهيمنة النصية. لهذا اختلطت وتداخلت كثير من عناصر مهمتهم، رغم كل الجهود المضنية التي بذلوا في باب دعم وتعزيز منطق العقلانية ولغتها في ثقافتنا. ولعلهم نسوا أيضًا أن التوجهات النظرية التأصيلية الجديدة التي ما فتئت تنشأ في فكرنا منذ هزيمة 1967م، وميلاد ما أصبح يعرف بعتبة «النهضة الثانية»، تعد في العمق محصلة لمختلف صُور التمرين والتمرس التي مارسها الجيل الأول والثاني من النهضويين العرب. وهو ما يفيد أن مُحَصِّلَةَ تطور عقلانية الأنوار في فكرنا، تستمد قوتها من آلية التراكم، التي أسهم الفكر الإصلاحي العربي في بنائها، لتشكل جهود المتأخرين الأحياء من مفكرينا في أبعادها النظرية العميقة، الصورة المتطورة لإسهامات رواد الإصلاح في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.
الإصلاح ليس وصفة سحرية
ينبغي ألاّ نغفل هنا التأكيدَ على أننا لا نتصور سهولة المعركة التي تنتظرنا، ذلك أن الإصلاح ليس وصفة سحرية منقِذة من شرور عالم نحن صانعوه، إنّ الطريق مفتوح أمامنا على مشروع بذل جهود وتضحيات ومنازلات كبرى في مجالات عديدة، بهدف تعويد الذات على مواجهة أسئلة التاريخ والحرب والإصلاح، تعويد الذات على المواجهة بالتضحيات التي تَنْذِرُ الغالي والنفيس للانتصار على أعباء التاريخ، وما سيصنع لحظة حصول الإصلاح الذي نتطلع إليه؛ أي تعميم مكاسب التنوير ومغانمه الرمزية، سيعد خلاصة لتراكم تاريخي، قد لا نكون على بيِّنة تامة من مختلف أبعاده وأفعاله.
وبناء عليه، تعد معركة التنوير في بلداننا معركة شاملة ومركَّبة، إنها معركة في الفكر وفي السياسة والمجتمع والتاريخ، وكل إغفال لمجموع عناصرها في تكاملها وتقاطعها وتداخلها، يُقلِّص من إمكانية الإنجاز الذي نصبو إليه. ولهذا السبب، يشكل مشروع التنوير البؤرة الناظمة والجامعة لأسئلة اللحظة التاريخية الراهنة في مجتمعنا، وقد كان الأمر كذلك قبل أربعين سنة، ولعله سيستمر بعد هذه اللحظة بما يعادلها أو يفوقها في كَمِّ الزمان. إلا أن الأمر ينبغي عدم التراجع عنه أو التفريط فيه، هو أن نتخلّى تحت أي ضغط أو إكراه تاريخي أو نظري عن مواصلة العمل من أجل زرع قيم التنوير والحداثة، وإعادة زرعها دُون كَلَلٍ في حاضرنا المفتوح على أزمنة مضت وأخرى قادمة.
إن الممانعة التاريخية والْعِنَاد التاريخي الذي تمارسه قيود التقليد وأعباء التاريخ التي شكَّلت في الماضي جوانب من هويّتنا، كما نشأت وما فتئت تنشأ ويُعاد تشكُّلها في التاريخ، يقتضي منّا العمل المتواصل في اتجاه ابتكار أساليب جديدة في الفكر وفي الممارسة، لمواصلة توطين مبادئ التنوير في حاضرنا.
يمكن أن نؤكد إذن أنّ من الأمور المستعجلة اليوم في الثقافة العربية: العمل على تأسيس جبهة للتنوير، من أجل أن تساعدنا على إيقاف مسلسلات التراجع والانكفاء، جبهة يمكن أن تشكل درعًا أماميّة، لمواجهة أشكال الاندحار الثقافي الحاصل في بيئات الثقافة العربية منذ عقود من الزمن، وذلك بفعل اتساع تيارات الفكر النصي المحافظ وتناميها، وانقطاع -بل توقف- وتيرة مغامرة الاجتهاد والإبداع في فكرنا. نحن هنا لا نتحدث عن نموذج حداثي جاهز، ذلك أنّ الحداثة إبداع يجسده تاريخ من المعارك. وإذا كان الانفجار العربي المتواصل قد أفرز مشهدًا جديدًا في الواقع العربي، واكتشف الجميع بالملموس أنّ التغيير لا يكون فقط بإسقاط النظم الاستبدادية الفاسدة، بل إنّه يتطلب رؤية شاملة لمختلف زوايا النهوض والتنمية.
إنّ بناء مجتمع عصري يحتاج اليوم إلى جبهة للتحرك، جبهة مسلحة بمبادئ الفكر المعاصر ومقدماته، جبهة قادرة على إعادة بناء المجتمع من جديد. ونحن نعتقد أنّه لن تكون هناك مردودية لتحركات اليوم إذا لم تصنع الحدود التي تركب القطائع المطلوبة دون تردُّدٍ أو مخاتلة، مع مختلف أوجه التقليد والاستبداد ومظاهرهما في مجتمعنا؛ الأمر الذي يفيد أنّ المعركة مفتوحة.
العرب من الاستنارة إلى التشرذم

سيّار الجميل – مؤرخ عربي – المدير التنفيذي لمركز دراسات اكنك – تورنتو – كندا
سيقول مؤرخو العرب بعد مئات السنين: إنّ العربَ قد عاشوا في القرن العشرين بالرغم من كلّ تناقضاتهم السياسية والفكرية؛ أزهى أزمنتهم الحديثة، بعد أن أحيت فيهم مشروعات النهضة مجالات العقل والاستنارة والإبداع، وأنهم قد نفضوا عنهم غبار الماضي، وخرجوا من سكون أكفان القرون التي سبقت اللحظة الزمنية للقرن العشرين ليلبسوا أثوابًا جديدة، وقد أبدعوا بعد أن انفتحت عقولهم، وتعاملوا مع أصالتهم، وخلقوا لهم أشياء جديدة لم يكونوا يعرفونها من قبل، بل إنهم انسجموا مع مشروعهم النهضوي ويقظتهم الفكرية، وناضلوا من أجل أن يكون لهم مكانهم تحت الشمس، لكنهم انتكسوا انتكاسات مريرة عند نهايات القرن العشرين، ودخلوا زمنًا اختلفوا فيه عن أزمنة استنارتهم النهضوية، بافتقادهم الوعي بالتقدّم، فتغيّرت حالاتهم، وتبدّلت أوضاعهم، وازدادت تناقضاتهم وباتوا يكره بعضهم بعضًا، وأخذوا يزيفون تاريخهم، ولم يتعلّموا منه شيئًا، فهم لم يتوقفوا عن مشروعهم واستنارتهم فحسب، بل تراجعت خطاهم تراجعًا مخيفًا؛ إذ غلبت عليهم الجهالة، وتفشّت في أوساطهم الأميّة، وخبا فيهم الوعي بالزمن، بل ماتت فيهم جذوة التفكير والعقل، واندلعت عندهم الحروب، وعمّت في نفوسهم الكراهية! والأخطر من هذا وذاك ما حدث في مجتمعاتهم ونسيجهم الحضاري من تمزّقات جراء أسباب غير مباشرة ما كانوا يحسبون حسابها أبدًا لا في مرحلة الاستنارة الأولى، ولا في مرحلة الليبرالية الناشئة، ولا في خضم المدّ القومي العربي ونزاعاتهم الباردة، وصولًا إلى مرحلة الحروب المجنونة وأزمنة المستبدّين والطغاة، وخصوصًا بعد سنة 1979م، تلك السنة التي اعتبرتها أخطر سنة في القرن العشرين؛ إذ سحبت منهم مشروعاتهم الأولى، فتأخرت ثقافتهم، وتقلّصت علاقاتهم المتمدّنة، وباتوا يبحثون لهم عن حلول بليدة من العصور الوسطى! كيف؟
مشروعات نهضوية عربية
 قبل أن نحلل هذه اللحظة العربية الراهنة التي يكتنفها الغموض ويميّزها الاقتتال والتشرذم بأنواعه. دعونا نحلل باختصار ما كان عليه العرب إبان القرن العشرين؛ كي نرى حجم الهاوية التي انزلقوا فيها اليوم وبات من الصعوبة الخروج منها. مسترشدين بتطوّر أجيالهم المعاصرة التي بدأت مع نهايات القرن التاسع عشر؛ حيث كانوا قد انفتحوا على العالم، فترجموا جملة من الكتب الممتازة، وتأسّست مدارسهم الأولى، وطوّروا لغتهم العربية القاموسية، وعرفوا تأسيس الصحافة من جرائد ومجلات، وطوّروا أساليبهم الكتابية وفنونهم الأدبية وطرائق عيشهم. وفي غضون ثلاثين سنة مع دخولهم القرن العشرين، بدؤوا يشعرون بضرورة النهضة والتخلص من الأجنبي وتكوين الأوطان الحديثة، فعُرفوا فيما بين الحربين العظميين بوجود رجالٍ بُناةٍ أوائل كانوا وراء تأسيس عدد من المؤسّسات والوزارات والمجامع العلمية والجامعات، وتطوّرت الثقافة العربية تطورًا إبداعيًّا، وفكروا بالاستقلالات الوطنية؛ إذ عرفوا قيمة أوطانهم، وقوة مجتمعاتهم وروعة ازدهارهم الحضاري، وكيفية استرجاع زهرة ماضيهم المتمدّن، كما عرفوا القوانين وتناغموا عربيًّا مع بعضهم الآخر باستحداث الإذاعات العربية، والسينما، ودور النشر العربية. ويكفي على سبيل المثال لا الحصر، ظهور امرأة أسطورية عربية التفوا حولها ليسمعوها، وهي تشنف آذانهم بالطرب العربي الأصيل حتى أسموها: «كوكب الشرق»، فكانت وحدها عاملًا نهضويًّا وظاهرة تنويرية في تجمّعهم، وهي فنانة قلما يجود الزمان بمثلها، جاءت من ريف مصر العربي لتوحّد الأسماع والأذواق العربية بين المشرق والمغرب العربيين على مدى خمسين سنة مضت.
قبل أن نحلل هذه اللحظة العربية الراهنة التي يكتنفها الغموض ويميّزها الاقتتال والتشرذم بأنواعه. دعونا نحلل باختصار ما كان عليه العرب إبان القرن العشرين؛ كي نرى حجم الهاوية التي انزلقوا فيها اليوم وبات من الصعوبة الخروج منها. مسترشدين بتطوّر أجيالهم المعاصرة التي بدأت مع نهايات القرن التاسع عشر؛ حيث كانوا قد انفتحوا على العالم، فترجموا جملة من الكتب الممتازة، وتأسّست مدارسهم الأولى، وطوّروا لغتهم العربية القاموسية، وعرفوا تأسيس الصحافة من جرائد ومجلات، وطوّروا أساليبهم الكتابية وفنونهم الأدبية وطرائق عيشهم. وفي غضون ثلاثين سنة مع دخولهم القرن العشرين، بدؤوا يشعرون بضرورة النهضة والتخلص من الأجنبي وتكوين الأوطان الحديثة، فعُرفوا فيما بين الحربين العظميين بوجود رجالٍ بُناةٍ أوائل كانوا وراء تأسيس عدد من المؤسّسات والوزارات والمجامع العلمية والجامعات، وتطوّرت الثقافة العربية تطورًا إبداعيًّا، وفكروا بالاستقلالات الوطنية؛ إذ عرفوا قيمة أوطانهم، وقوة مجتمعاتهم وروعة ازدهارهم الحضاري، وكيفية استرجاع زهرة ماضيهم المتمدّن، كما عرفوا القوانين وتناغموا عربيًّا مع بعضهم الآخر باستحداث الإذاعات العربية، والسينما، ودور النشر العربية. ويكفي على سبيل المثال لا الحصر، ظهور امرأة أسطورية عربية التفوا حولها ليسمعوها، وهي تشنف آذانهم بالطرب العربي الأصيل حتى أسموها: «كوكب الشرق»، فكانت وحدها عاملًا نهضويًّا وظاهرة تنويرية في تجمّعهم، وهي فنانة قلما يجود الزمان بمثلها، جاءت من ريف مصر العربي لتوحّد الأسماع والأذواق العربية بين المشرق والمغرب العربيين على مدى خمسين سنة مضت.
عوامل الفشل وخطورة عام 1979م وبدء الزمن الكسيح
ومع نهايات الحرب العالمية الثانية، تفاقمت تناقضاتهم السياسية والأيديولوجية بحدوث انقلابات عسكرية ووصول ضباط ثكنات إلى سُدَّة الحكم ليحكموا من دون أيّة حكمة، ولا أي دهاء، ولا أيّ معرفة بطبيعة المجتمعات، مع أحزاب سياسيّة شمولية متشدّدة لا تفقه طبيعة الحياة الحزبية، وشغلوا الناس بتوافه الأمور وبالشعارات الخاوية. ناهيكم عن الانتقال من قوة العقل إلى العيش في الأوهام، فازداد جموح خيالهم للخروج إلى العالم كأمة موحدة من دون أية دراسات ومفاهيم؛ إذ إنهم لم يدركوا حجم التنوّعات والتباينات فيها، ولم يتدارسوا الخلل الذي كان فيها، فكان أنْ دفعوا أثمانًا باهظة من الضحايا والخسائر أمام أخطر تحدٍّ خطير واجهوه ممثلًا في إسرائيل، ومع تفاقم الانقسامات السياسية والثقافية والصراعات الأيديولوجية جراء التأثر بالحرب الباردة في العالم، بقي الوعي الجمعي بالاستنارة قويًّا، والأمل بالنهضة ساري المفعول، وخصوصًا لدى جيل جديد كان يطمح لبناء المستقبل أسوة بالأمم الأخرى حتى عام 1979م الذي أعتبره فاجعةً تاريخية؛ حيث هبّ إعصار مظلم للمرة الأولى بوصول رجل دين معمّم إلى أعلى سلطة في إيران، ومباشرة قال بتصدير ثورته الطائفية باسم الدين نحو مجتمعاتنا التي بدأت تهتز خلاياها الراكدة، وعندما سمعنا بمصطلح «الصحوة الدينية» قلنا: يا عجبًا! هل كانت مجتمعاتنا بلا دين حتى تصحو؟!
ومنذ تلك اللحظة البائسة، بدأ زمن كسيح تفاقم فيه الاستبداد من قبل حكّام جائرين حاربوا الاستنارة والانفتاح وآمنوا بالانغلاق والتفرّد بالسلطة، مع تبديد الثروات، وجعل الشعوب تلهث وراء لقمة العيش والسكن والعمل والأمان، بل وصل الأمر إلى إصدار قرارات جنونية، بإشعال حروب، وقصف مدن، وإفقار شعوب؛ فبدأت تنحسر القوى الاجتماعية الفاعلة، وتنكمش الحياة الإبداعية لدى العرب، وبدأ الوعي يَذْوِي، ودخل العرب في مرحلة حروب أهلية وداخلية وإقليمية قاتلة، في لبنان والعراق واليمن والجزائر وسوريا والسودان، وغيرها. وكانت هذه المرحلة كافية لخلق مافيات وعصابات وجماعات إرهابية، مع زيادة الانحرافات الفكرية بانعدام العقل والركض وراء الأخيلة والأوهام!
الدخول في بحر الظلمات، وتشكّل البنية العمياء
وعندما خرجنا من القرن العشرين كان عمالقة الأدب والفكر والطرب والثقافة والإبداع يغادرون الحياة واحدًا تلو الآخر. وغرقت مجتمعاتنا في لا وعي جمعي بالظلام الدامس، وأخذ الناس يفكرون بماضويات الزمن بعد مغادرتهم الاستنارة نهائيًّا، بل وصل الأمر إلى تكفير المبدعين والمفكرين والمؤسسين البناة الأوائل، وخصوصًا عندما غدت السياسة –على أيديهم- ممزوجةً بالإسلام السياسي، فتفاقم حجم الجماعات والأحزاب الدينية المتشدّدة بعد عام 1979م مع انقسام المجتمع العربي انقسامات حادة، وبدأت الطائفية تلعب لعبتها سياسيًّا وإعلاميًّا وثقافيًّا، بل انقسم كلّ المثقفين العرب انقسامات حادة مع غياب العقل وانكماش النخب المبدعة وتقلّص إنتاج القوى الفاعلة في أغلب مجتمعاتنا، وباتت الأوضاع تنتقل من سيئ إلى أسوأ بدخول القرن الحادي والعشرين.
لقد سجّل العرب في أكثر من مكان حالةَ انتفاضة مع تضخم قوة بشرية عربية شابة عانت في نهايات القرن العشرين التصلّب السياسي، واستبدادية الحكّام، وتبديد الثروات، وغلبة الإعلاميات الكاذبة والمخادعة بوعود في الإصلاح؛ فكانت لحظة 2010م التي أسموها: «الربيع العربي» تحمل في جوفها أسرار انتحارها؛ إذ استُلبت تلك الثورات استلابًا من قوى الظلام لتبدأ مرحلة ثلاثين سنة نعيشها اليوم؛ حيث يكتنفها الغموض ويسودها الإرهاب، ويميزها الاقتتال والتشرذم بأنواعه. ولعلّ أقسى ما يمكن تخيّله اختراق إيران لمجتمعاتنا باسم الطائفية ليتفجّر المزيد من الحروب والاقتتالات والتمزّقات الاجتماعية، والانقسامات الفكرية. لقد هُتكت أستار الثقافة العربية، وأصبحت عدة مدن وعواصم عربية ميادينَ لصراعات دموية مع ازدياد حجم التخلّف والتضليل، وابتذال التربويات والثقافات والفنون، وهجرة الملايين من العرب من أوطانهم بحثًا عن أوطان جديدة لهم فيما وراء البحار.
إن مأساة العرب اليوم ومحنتهم التاريخية تبدو للمؤرخ بنيويةً عمياءَ يستعصي حلّها؛ إذ تتشكّل من هياكل صعبة جدًّا، وهي: شمولية الحياة المعيشية، وغياب الحرّيات، مع استفحال التشبّث بالسلطة، وقهر الإبداع وانعدام فرص نضوج المبدعين، وتفاقم الإرهاب باسم الدين والنزول من سماحته إلى المعتقدات الرخوة، وغلبة الأساطير والخزعبلات، ومحنة الطوائف والملل والأقليات التي غدت تناحر الأغلبيات ردًّا على ثارات سيكولوجية قديمة، وكأنّ مجتمعاتنا لم تعرف التعايش والوئام منذ آلاف السنين.
هل من استعادةٍ للتنوير والعقل؟
لا أعتقد أبدًا أن الحالةَ التي يعيشها العرب اليوم مع غلبة المشكلات غامضةٌ للمفكّر بعيد النظر وعميق الرؤية، لكنها تبدو غامضة لتلك الجماهير العريضة التي تفاقم حجم الجهل عندها حتى بالأساسيات والبديهيات العامة. وممّا زاد من تفاقم حجم المحنة العربية اليوم: الوسائل الحديثة التي هي نتاج حقيقي للعولمة التي يمرّ بها العالم اليوم، فإنْ كان العالم يعيش ثورة معرفية وعلمية واسعة الأبعاد، فقد غدت هذه الوسائل الجديدة ليست سبيلًا للتواصل مع ثورة المعلومات، بل أدوات قهرية الاستخدام بتوظيفها في سفاسف الأمور، وفي توزيع العنف والعنف المضاد، فضلًا على دورها في حدوث صدوع واسعة في البنى الفكرية والقيم الأخلاقية مع انعدام التربويات القوية.
إنّ استعادة الاستنارة العربية بحاجة إلى مشروعات تحديث واسعة النطاق في العقلية وتبديل الذهنية من كونها مركّبة ومنغلقة ومتناقضة إلى موحّدة ومبسطة ومنفتحة بتغيير المناهج التربوية والتعليمية، واستحداث قوانين جديدة، وزرع قيم فكرية نظيفة تتقبّل الأشياء، وتخليص المجتمعات من ترسُّباتها وأمراضها المستعصية، إضافة إلى ولادة نخب لها ثقافتها الحقيقية التي تعتني بالمبدعين، وإشباع الناس لحاجاتهم الضرورية، وتهذيب أذواقهم، وتجديد أساليبهم في الحياة، وزرع قيم جديدة في التعايش مع الآخر، وتقبّل أفكاره الإيجابية مع احترام الزمن، ودقة الإنتاج، ونقد الظواهر، وإتاحة الفرص للحرّيات، وتهذيب الأذواق، وتجديد القيم، والاعتناء بالثقافة العامة، وتحديث المؤسسات في الدولة.
إنّ تنوير العقل من أصعب المهام التي تناط برجالٍ بُناةٍ من النهضويين الحقيقيين الذين لديهم القدرة على تربية أجيال جديدة كي يكونوا مادة أساسيّة في ازدهار العرب إبان القرن الحادي والعشرين. وهذا لا يتحقق في ظلّ الأوضاع الحالية التي وصلت إلى درجة أدنى من الاهتراء. إنني واثق بقدرة مجتمعاتنا العربية على الاستجابة للتحدّيات التاريخية، وكما أنجبت في الماضي أجيالًا من المبدعين والعمالقة في الفكر والأدب والفن والعلوم وصنع الحياة المتحضرة، فإن أبناءهم وأحفادهم لهم القدرات نفسها، وخصوصًا في توظيف وسائل العصر الحديث ليتفوّقوا في مجالاتهم ويكون لهم تأثيرهم في هذا العالم.
اختناق التنوير نتيجة حتمية

إبراهيم البليهي – كاتب سعودي
يقف بعض المهتمين حائرًا أمام عقم وعجز جهود التنوير منذ أكثر من قرنين عن التأثير في الواقع العربي البائس، ولكن الحيرة تزول حين ندرك الطبيعة التلقائية للإنسان، ونعرف الكيفية التي تتكون بها عقول الناس تلقائيًّا، ونتعقَّل أن الإنسان كائن ثقافي، ونستوعب حقيقة أن كل جيل يرث بشكل تلقائي ثقافة الجيل الذي قبله بانتظام تلقائي صلب، وأن الثقافات كيانات متمايزة نوعيًّا، وأن المجتمعات محكومة بحتمية ثقافية حاسمة، وأن كل القوى المهيمنة في المجتمع ترعى هذه الحتمية وتحميها، وتملأ نفوس الأجيال بإجلال السائد وتقديسه والولاء له والبراء، مما يُظَن أو يُتَوَهَّم أنه يتعارض معه، وأن لكل فرد بنية ذهنية ووجدانية تختلف عن كل الآخرين، فمن السهل أن يتبادلوا المعلومات والأخبار والمعارف، لكن لا يمكن أن تتطابق تصوراتهم وأفكارهم ورؤاهم تطابقًا تامًّا حتى وإن ساروا متحدين.

رينيه ديكارت
فالمواقف تقوم على محاولات التوافق وليس التطابق. إن كل هذه العوامل وغيرها تجعل رفض التغيير حتميًّا وتلقائيًّا، لأن التنوير يستهدف تغيير الواقع؛ فهو يتحرك باتجاه مضاد لما هو أثير ومخالط للنفوس، ومتجدد التأكيد، وكثيف التغذية، وعميق في الوجدان، ومستقر في العقول، ومتجذر في التاريخ، وراسخ في الواقع، ومألوف ومتوارث وسائد ومستحكم. إن التنوير يحمله أفراد عُزَّل لا يملكون سوى الفكر النيِّر، مقابل مجتمعات فخورة بثقافاتها المتجذرة، وقوية بكياناتها المتماسكة، لذلك لم يكن غريبًا أن تختنق كل جهود التنوير في العالم العربي خلال القرنين الماضيين.
إن الأصل في كل الثقافات أنها ترفض وتقاوم بشكل تلقائي أيَّ فكر طارئ مغاير، حتى أوربا لم يؤثر فيها التنوير ويتحقق التغيير النسبي إلا بعد حروب طويلة دامية، فقد انقسمت المجتمعات الأوربية معه وضده، فانحازت فئاتٌ مهمة وفاعلة إلى صف التنوير، وبقيت فئات أخرى تقاومه بشراسة؛ فالانتصار النسبي للتنوير لم يتحقق إلا بعد مقاومات عنيفة، فلو لم تصادف ثورة مارتن لوثر هوى الأمراء الألمان كذريعة للتحرر من الإمبراطورية المقدسة، ومن سلطة الكنيسة الكاثوليكية وقرارات البابا التعسفية لما كان لها أن تنتصر، ليس هذا فقط، إذ لم يكن ذلك وحده هو العامل الذي جعل أوربا تتقبل التنوير حتى وإن جاء التقبل ببطء وتلكؤ، وإنما تضافرت عوامل كثيرة انتهت بأوربا والغرب عمومًا إلى هذا التحرر النسبي من أغلال التاريخ، والانفكاك من بعض القوالب الثقافية الموروثة. وأهم هذه العوامل الإيجابية أن الثقافات الأوربية هي في الأساس تفريعات للثقافة اليونانية بفكرها الفلسفي وعقلها النقدي، كما أنها قد ورثت الثقافة الرومانية بتراثها القانوني العريق، وإرثها السياسي الفريد، ولكن على رغم كل هذا، وعلى رغم مرور القرون على التحرر النسبي للغرب، فإن الشعوب الغربية ما زالت كغيرها من الشعوب تقاد فتنقاد، فالكتل البشرية في كل الأمم ما زالت تعيش بوعي زائف، وسيبقى أكثر الناس في كل الأمم إمَّعات مهما نالوا من تعليم مهني، فالناس في كل المجتمعات هم مجرد ركاب في سفينة التغيُّر والازدهار، أو في سفينة التحجر والانحدار.
مفارقة صارخة
إن الواقع البشري ينطوي على مفارقة صارخة بين ما يملكه من إمكانيات عظيمة وقدرات هائلة في كثير من جوانب الحياة، وبين عجزه الفاضح عن معالجة مشكلاته، فنحن غالبًا تخدعنا الإنجازات الحضارية الهائلة في المجالات العملية والمهنية، وفي مجالات الوسائل والأدوات والتنظيم والمؤسسات والنُّظُم، فنتوَهَّم أن البشرية أفرادًا ومجتمعاتٍ وأممًا، قد قطعت مراحل متقدمة جدًّا من سلامة التفكير وعُمْق الإدراك، وأنها قد تجاوزت التفكير البدائي التلقائي، وأنها قد بلغت مستوى الرُّشد القائم على التحقُّق الموضوعي في كل أمورها، ولكن بقراءةٍ فاحصةٍ للتاريخ الإنساني، وبالتأمل العميق في ما يجري في العالم تنجلي الحقيقةُ المفزعة، وهي أن البشرية في شكل عام ما زالت من الناحية الفكرية والأخلاقية تعيش في مستوى بدائيّ سحيق غارق في التخلف والبؤس.
وأمام هذه المفارقة الصارخة بين التطور الحضاري المذهل في وسائل وأدوات الحياة وفي القدرات العملية، مقابل التخلف الشديد لعموم الناس ولأكثر القيادات الثقافية والسياسية في العالم في الجوانب الفكرية والأخلاقية والحكمة، قياسًا بما تحقق من إنجازات عظيمة، إن فهم هذه المفارقة الصارخة لا يتحقق إلا بقراءة تاريخ الحضارة قراءة فاحصة، حيث نجده يجيب عن هذه المفارقة بأن يؤكد الحقائق الآتية:
الأصل في المجتمعات أنها تبقى منتظمة في ما وجدتْ نفسها عليه، فالاستمرار تلقائي، أما التغيير فهو ضد هذا الانتظام التلقائي الحتمي، أما التطورات الحضارية المتحققة في كل المجالات فقد تمخَّضَتْ عنها عقولُ عدد محدود جدًّا من الرواد الخارقين الذين تحرَّكوا عكس التيارات السائدة خلال التاريخ البشري كله، إنهم منذ طاليس وديمقراطيس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وإقليدس وأرخميدس ودافنشي وكوبرنيكوس وجاليليو ونيوتن ومونتاني ومارتن لوثر وديكارت وكانْت وفراداي ودالتون وباستور وآينشتاين وأمثالهم من الأفراد الرواد الاستثنائيين، وكلهم لو اجتمعوا لن يتجاوز عددُهم عدَدَ ركَّاب طائرة كبيرة، أو عدد ركاب قطار كبير، إنهم يمثلون نشازًا في الكثرة الهائلة من البشرية العمياء، لكننا نغفل عن هذه الحقيقة الكبرى الصادمة، ونتحدث عن أن الإنسان بطبيعته طَلْعةٌ يَقِظٌ، وأنه متشوِّفٌ تلقائيًّا إلى أن يعرف، والتاريخ البشري والواقع كلاهما يؤكد العكس تمامًا، فالمندفعون خلال التاريخ البشري كله للاكتشاف، والمشغوفون بالمعرفة، والمستغرقون في محاولة الفهم الموضوعي العميق، هم أفرادٌ معدودون يمكن إحصاؤهم بأسمائهم، وهم في نصاعة تفكيرهم، ورفيع اهتمامهم، وعُمق تركيزهم، وفي النتائج التي يتوصلون إليها يكونون مغايرين تمامًا للأنساق الثقافية السائدة في كل العالم.
 إن الأفكار الريادية الخارقة في كل مراحل التاريخ قد جاءت كومضات خاطفة وسط ظلمات حالكة، وكلها من دون أي استثناء قد قوبلتْ بالرفض والمقاومة، وهو رفضٌ قد يمتد قرونًا، كما هي حالة اكتشاف أن الأرض ليست مركز الكون، فقد بقي هذا الاكتشاف مطمورًا أكثر من ثمانية عشر قرنًا حتى أعاد الاكتشاف كوبرنيكوس، ومع أن معظم الاكتشافات لا يمتد رفضها كل هذا الامتداد؛ إذ تجد من يستقبلها بالقبول بعد تلكؤ قد يطول أو يقْصُر حسب الحالة الثقافية السائدة، ولكن المؤكد أن الرفض يحصل دائمًا بشكل تلقائي، أما القبول فلا يأتي إلا متأخرًا، وقد لا يأتي أبدًا كما في الثقافات الشديدة الانغلاق. وفي الكتاب الذي لم أنشره بعدُ بعنوان «الريادة والاستجابة» قَدَّمتُ شواهد متنوعة على ذلك من التاريخ والواقع، ستكون كافية لمن يرغب في الاستبصار.
إن الأفكار الريادية الخارقة في كل مراحل التاريخ قد جاءت كومضات خاطفة وسط ظلمات حالكة، وكلها من دون أي استثناء قد قوبلتْ بالرفض والمقاومة، وهو رفضٌ قد يمتد قرونًا، كما هي حالة اكتشاف أن الأرض ليست مركز الكون، فقد بقي هذا الاكتشاف مطمورًا أكثر من ثمانية عشر قرنًا حتى أعاد الاكتشاف كوبرنيكوس، ومع أن معظم الاكتشافات لا يمتد رفضها كل هذا الامتداد؛ إذ تجد من يستقبلها بالقبول بعد تلكؤ قد يطول أو يقْصُر حسب الحالة الثقافية السائدة، ولكن المؤكد أن الرفض يحصل دائمًا بشكل تلقائي، أما القبول فلا يأتي إلا متأخرًا، وقد لا يأتي أبدًا كما في الثقافات الشديدة الانغلاق. وفي الكتاب الذي لم أنشره بعدُ بعنوان «الريادة والاستجابة» قَدَّمتُ شواهد متنوعة على ذلك من التاريخ والواقع، ستكون كافية لمن يرغب في الاستبصار.
حين تَدخُل فكرةٌ رائدة، أو حقيقةٌ علمية فارقة، أو تنظيمٌ اجتماعي جديد متطور إلى ثقافة أي مجتمع، فإنها لا تدخل عن طريق الفهم العام، وإنما تصير جزءًا من ثقافة المجتمع بواسطة الممارسة والمعايشة والتكيف والتعود، فعموم الناس في المجتمعات المزدهرة لا يدركون سبب أو أسباب ازدهارهم، فهم محمولون في مرْكبة التحضُّر أو مركبة التحجُّر من غير أن يعرفوا كيف تكوَّنت هذه المركبة الاجتماعية العامة، فقد تبرمجوا بما هم عليه تبرمُجًا تلقائيًّا بواسطة التكيف والتعود، وليس بواسطة التفهُّم والإدراك، فالأفراد في المجتمع كقطرات الماء في النهر الزاخر، فلولا هذه القطرات لما كان النهر لكن لا أهمية لأية قطرة إلا بكونها ضمن النهر.
التعلّم بمختلف مراحله، والتخرُّج من الجامعات، أو حتى إنهاء دراسات عليا في أي مجال، هدفه تكوين المهنيين من الممرض إلى جراح القلب، أو أستاذ الجامعة أو الباحث العلمي، فكل هذه المسارات لا تدل على تطور نوعي للوعي الفردي، فالوعي النقدي الفاحص المنفصل عن تفكير القطيع لا علاقة له بالتعليم الجمعي بمختلف تخصصاته ومستوياته، بل التعليم المقنَّن يكرس الوعي السائد.
تجسيد الأفكار الريادية الخارقة يرتبط باتجاه حركة المجتمع، فإذا كانت حركة المجتمع باتجاه الازدهار، فإن الأفواج الذين تخرجهم الجامعات والمعاهد يتولون تجسيد الرؤى والأفكار الريادية التي تقبَّلها المجتمع، إذ يعمل كلُّ فرد في مجال اختصاصه. إن إنتاجهم يمثل قطرات الماء التي يتكوَّن منها نهر الازدهار، ولكن الأفراد أنفسهم الذين أسهموا في تشييد الازدهار في مجتمع تتجه حركته في اتجاه النمو، لو عملوا في مجتمعات متخلفة فسوف يكون عملهم محكومًا باتجاه حركة المجتمع، وبذلك فقد يكون إسهامهم في تكريس الواقع وليس تغييره، أي في تكريس التخلف واستحكام أركانه وإغلاق منافذ الرؤية فيه.
الثقافة السائدة
إن استيعاب هذه الحقائق يجعلنا ندرك أن التعليم في أي مجتمع محكومٌ بالثقافة السائدة وليس حاكمًا لها، وأن أفراد كل بيئة يتبرمجون بثقافتها تلقائيًّا فيبقون محكومين بها، وتظل تتحكم بهم وتهيمن على اتجاههم وتفكيرهم ووجدانهم، وتحدد قيمهم واهتماماتهم، فالبرمجة التلقائية هي التي تحدد هوية الفرد حسب البيئة التي ينشأ فيها، فالإنسان لا يولد بماهية أو هُوية محددة، وإنما يتقولب تلقائيًّا في طفولته قبل بزوغ وعيه.
إن كل إنسان يولد بقابليات فارغة مفتوحة مطواعة، فيتشكل عقله ووجدانه بالأسبق إلى قابلياته، ثم يظل هذا الأسبق يتحَكَّم به مهما نال من تعليم، فهذا الأسبق يصير هو الذات عينُها، وهو المعيار المهيمن لتقييم كل ما هو مغايرٌ له. إن الفرد لا يفكر إلا من خلال هذا الأسبق، فهو لا يرى أيَّ شيء إلا بواسطته، فمن المحال أن يفكر المرء بتغيير ذاته إلا بهزة فكرية مزلزلة توقظه من سباته، وتخرجه من غبطته الغافلة، وتفصله عن التيار السائد، وهي حالة لا تحصل إلا نادرًا، أما عموم الناس فيبقون مأسورين بما تبرمجوا به في طفولتهم، فلا يرون الحياة والدنيا إلا من خلال هذا التبرمُج التلقائي.
أما التعليم الذي يضطرون لقضاء ربع قرن وهم يكابدونه فيبقى محصورًا في المجال المهني والعملي فقط، وكما يقول الدكتور فاخر عاقل في كتابه (سيكولوجية الإدراك): «إن المعلومات المبدئية تكون إطارًا ومفتاحًا للمعلومات التالية، وإذا كانت المعلومات التالية مخالفةً للمعلومات الأولى فإنها تُلوى لتناسب المعلومات المبدئية». إن الناس يجهلون عن أنفسهم هذه الحقيقة الأساسية، مع أنها أهَمُّ من ركام الحقائق الجزئية التي تمتلئ بها أذهانهم ويهتم بها التعليم.

ليوناردو دافنشي
إن هذه الحقيقة المحورية التي أكدها الدكتور فاخر عاقل قد باتت من الحقائق التي يكررها العلماء والباحثون، فهذا الطبيب المشهور العالم إدوارد دي بونو يقول بوضوح في كتابه (تعليم التفكير): «تقوم المعلومةُ الأولى بتغيير حالة العقل بشكل يجعل المعلومةَ الثانية ترتبط بها أو توافقها، وبهذه الطريقة يتم بناء الأنماط». ولأن الدماغ البشري لا يملك آلية للتحقُّق فإنه يعتمد المعلومات الأسبق كمعيار للحكم على المعلومات التالية مهما كانت الأولى خاطئة، ولأن مسائل العلوم التي يتلقاها الدارسون في التعليم لا تأتي ولا يمكن أن تأتي إلا متأخرة أي بعد أن تكون البنيات الذهنية والوجدانية قد تَشَكَّلَتْ في مرحلة الطفولة المبكرة، فإنه لا يكون لها أي تأثير إيجابي في تصحيح ما تبرمجت به القابليات بشكل تلقائي من دون أي تمحيص.
التعليم في المجتمعات المتخلفة
إن التعليم في المجتمعات المتخلفة يكرس التخلف، ويعمق أسبابه، ويزكي البيئة الحاضنة له. إن التعليم محكومٌ بالأوضاع القائمة؛ فإذا جاء ضمن ثقافة حرة ومنفتحة ونامية، فإنه يُمدُّ المجتمع بالطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تدفعه للمزيد من التقدم والازدهار، فكل تقدم هو تمهيدٌ لتقدم أعظم، أما إذا جاء التعليم ضمن ثقافة مغلقة ومتخلفة ومرعوبة من الأفكار المغايرة، فإنه يكرس الانغلاق، ويرسخ التخلف، ويوصد العقول، ويشحن العواطف بالرفض العنيد الأعمى لمقومات التقدم الطارئة.
إننا نتوهَّم أن تعميم التعليم، ونشر المدارس، والإكثار من الجامعات، وإغداق الإنفاق عليه، وتوفير فرص التعليم للجميع يؤدي تلقائيًّا إلى تهيئة المجتمعات لتحقيق التقدم والازدهار، لكننا نغفل عن أن التعليم محكومٌ بالثقافة السائدة، وليس بالعلوم الطارئة، ونتجاهل بأن المجتمعات محكومة بثقافاتها التلقائية المتوارثة، وليست محكومة بطلاءات مجلوبة من خارجها.
إن المجتمعات تتناسل ثقافيًّا بشكل تلقائي، وترفض ما يغاير تصوراتها وقيمها ومألوفاتها، فالأطفال يتبرمجون تلقائيًّا بالثقافة السائدة قبل أن يلتحقوا بالتعليم، فتنغلق قابلياتهم عن قبول ما لا يتفق اتفاقًا كاملًا مع البرمجة التلقائية، لذلك ينبغي أن يدرك رجال التربية والتعليم والمسؤولون عن التنمية هذه الحقيقة الأساسية، وأن يتفهموا التغيرات النوعية التي طرأت على الحضارة البشرية.
انتكاسة التنوير والبنى الاجتماعية والسياسية

عبدالباري طاهر – كاتب يمني

علي أومليل
لكي يكون التشخيص دقيقًا وعلميًّا لمعرفة داء انتكاسة التنوير في الوطن العربي، فلا بد من قراءة عميقة ودقيقة لنشأة «الدولة القُطْرية»، وللتدخلات الاستعمارية في هذه المنطقة، بما فيها اتفاقات سايكس بيكو، واصطناع دول قُطْرية بحدود اصطناعية خصوصًا: سوريا ولبنان والعراق، ووعد بلفور 1917م، ونكبة 48، وهزيمة 67.
فشل التنوير يُبحث عنه، وعن جذوره في البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. شهد الوطن العربي التشظي منذ البدايات الباكرة لبناء الدولة القُطْرية، وغياب أو تغييب الكيان الواحد، أو وجود كيانات حضارية تتوافر لها شروط الديمومة والتطور.
لكي يكون التشخيص دقيقًا وعلميًّا لمعرفة داء انتكاسة التنوير في الوطن العربي، فلا بد من قراءة عميقة ودقيقة لنشأة «الدولة القُطْرية»، وللتدخلات الاستعمارية في هذه المنطقة، بما فيها اتفاقات سايكس بيكو، واصطناع دول قُطْرية بحدود اصطناعية خصوصًا: سوريا ولبنان والعراق، ووعد بلفور 1917م، ونكبة 48، وهزيمة 67.
فشل التنوير يُبحث عنه، وعن جذوره في البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. شهد الوطن العربي التشظي منذ البدايات الباكرة لبناء الدولة القُطْرية، وغياب أو تغييب الكيان الواحد، أو وجود كيانات حضارية تتوافر لها شروط الديمومة والتطور.
ولدت الدولة القُطْرية مصابة بوباء ما يسميه قسطنطين زريق بـ «العجز العربي». معظم الأقطار العربية خرجت من دائرة أو مركز ما قبل عصر الدولة، وتحقق الاستقلال للعديد من هذه البلدان، ولكنها جلها لم تفلت من إرث القبيلة والطائفة، ولعب الاستعمار دورًا في الهيمنة على مصاير هذه البلدان وثرواتها، وهو ما باعد بينها وبين الانفتاح على عصور التنوير وتياراته، وحرمها الحداثة والتجديد.
يرى المفكر العربي علي أومليل في كتابه «الإصلاحية العربية والدولة الوطنية» أنه في العصر الوسيط، ثم في مستهل العصور الحديثة، التحقت ببلاد الإسلام هزيمتان كبيرتان أمام قوى أوربية، انتهت باحتلال مناطق من العالم الإسلامي: الأولى في مواجهة الحروب الصليبية، والثانية: أمام القوى الإيبيرية، ويرى أنه لم يجد ردة فعل إصلاحية، ولا وعيًا بالتأخر تجاه الأجنبي الغالب، ولا تساؤلًا عما يكون وراء تغلبه.
يستشهد أومليل بكتاب «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي، ويرى أنه محاولة لإصلاح الإسلام من داخله، وأضيف أيضًا كتابي الإمامين: أحمد بن تيمية الحراني (ت 728هـ) «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»، وتلميذه ابن قيم الجوزية (ت 751هـ) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»؛ فالإسلام المكتفي بذاته – كما رآه الغزالي وابن تيمية وابن القيم- لم يعد قائمًا بعد تدخل أوربا الحديثة منذ النصف الثاني للقرن الثامن عشر؛ فلم يعد مفكرو المسلمين يعبرون عن إسلام عليه أن يرتد إلى ذاته وحدها لكشف الخلل وطلب الإصلاح، إنما سيدخل الآخر كبعد أساسي، ولعل طرح سؤال التأخر الذي طرحه شكيب أرسلان ومفكرون عديدون في مراحل متأخرة يعبر عن هذا المنحى المغاير.
دولة ملغومة بالعنف
ولدت الدولة العربية ملغومة بالعنف، ومسكونة بالقوة؛ فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما قال عثمان بن عفان، أو السيف أصدق أنباء من الكتب، كقول أبي تمام، أو كقول المتنبي وهو شاعر (شغل الناس والأقلام والكتبا): حتى رجعت وأقلامي قوائل لي: المجد للسيف ليس المجد للقلم.
في عصر بناء الدولة القُطْرية بعد الحربين الكونيتين: 1914- 1918م، و1937- 1945م طُرح سؤال التأخر والتقدم، طرحه النهضويون العرب، وإن كان لا يعم المنطقة العربية كلها. الإسلام المكتفي بذاته عند الغزالي وابن تيمية وابن القيم، ظل حاضرًا في العديد من بلدان الجزيرة والخليج، وظلت البدعة والتكفير قائمين في العديد من مناهج التدريس ووعظ المساجد والإعلام الرسمي.
أدى تراجع المد التنويري بعد هزيمة 67 إلى عودة هذه الإشكالية إلى بلدان مثل مصر، وكانت قد بدأت التجاوز منذ محمد علي باشا وكتاب (الإبريز في تلخيص باريز)، وطرحت الإشكالية مجددًا في تونس بعد بروز تيار النهضة الإسلامي كامتداد للإخوان المسلمين في مصر مطلع الثمانينيات، لكن تونس التي عرفت كتاب (أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك) لخير الدين التونسي أبي النهضة منذ عام 1873م، كان الوضع فيها مختلفًا نوعًا ما؛ فخير الدين التونسي كالحاكم المصري محمد علي باشا، والسلطان محمود ومدحت باشا في تركيا يجمعهم موقف موحد قوامه كقراءة خير الدين ورفاعة الطهطاوي في مصر: أن المسلمين ضعفاء، وأن الطريق إلى عودة القوة إليهم إنما يكمن في أخذهم بالتكنيك والعلم اللذين أعطيا الغرب قوته.

فولتير
يتوافق هؤلاء الزعماء والمفكرون أيضًا على أن الأخذ بمعالم الحياة الأوربية لا يتعارض مع دعائم الدين الإسلامي، ولا يبتعد بالمسلمين من تعاليم دينهم. ساد موقفهم وقناعاتهم طابع التبسيط الذي أراد أن يسد الهوة بين الثقافتين: الإسلامية والأوربية عن طريق القفز فوق المشكلات الأساسية، والاكتفاء بموقف تبريري دفاعي، ولعل ذلك مصدر تأخر الإصلاحات، أو بالأحرى انتكاستها في تونس والمغرب العربي لعدة عقود، وهي أيضًا سبب تراجع المشروطية في تركيا، وانتكاستها في إيران حتى اليوم.
في كتابها (التنويري) تطرح دوريندا أوترام سؤالًا: ما التنوير؟ يعرِّف كانْت التنوير بكونه: «عملية خلاص الإنسان من سذاجته التي جلبها لنفسه، وذلك عن طريق استخدامه للعقل دون أن يشوه التعصب تفكيره».
إلى جانب اجتهادات وأعمال زمرة من الكتاب الآخرين مثل: فولتير، ومونتسكيو، وديدرو، ودالين برت، وروسو، وليسنغ، تضيف أن عملية التنوير لم تكن مقصورة على أوربا، وتحدد أسس التنوير بمحو الأمية، وشيوع المعرفة والتعلم، وزيادة الإنتاج الزراعي، والثورة الصناعية التي كان التنوير مدماكها الأساسي، وتربط بين الدين والتنوير في ثلاث قضايا: حركات الإصلاح الديني، والعلاقة بين الدين والعقل، والدين والتسامح. وإذا قرأنا المقدمات الضرورية والأساسية لعصر الأنوار في أوربا وأميركا، وعمدنا للمقاربة مع الحالة الراهنة عربيًّا، أو حتى بدايات القرن الماضي، فإن الوضع اليوم أن الأمية حسب إحصاءات منظمات دولية تصل إلى 60%، بما فيها أقدم البلدان تحضرًا: مصر. أما عن علاقة الدين بالعقل فقد افتعلت عداوات مقيتة بين الدين والعقل بما يزري بسلفية العلامة المجتهد أحمد بن تيمية الذي ألف كتابًا سماه (درء تعارض العقل والنقل)؛ فقد ساد في العديد من البلدان العربية معاداة بين العقل والدين، لكأن الدين ضد العقل بما يتصادم مع جوهر الدين ونصوص القرآن في غير آية.
وغاب عن أمتنا العربية الإصلاح الديني والتسامح أيضًا، وسادت موجة من التكفير والتخوين عمت البلاد والعباد، وضحاياها كثر في غير منطقة؛ وكلها أسباب رئيسة لانتكاسة التنوير الذي بدأ خجولًا متأولًا ومتواضعًا، وتعرض لهزات عنيفة وانتكاسات متتالية؛ فالطهطاوي يتأول للديمقراطية بالشورى، ولحرية الرأي بالاجتهاد، وللرأي العام بالحسبة.
بنية اجتماعية هرمة
والواقع أن المنطقة العربية كلها ظلت ترزح تحت حكم الغلبة والقوة، محتفظة بالبنية الاجتماعية الهرمة، ولم يجر تحول حقيقي في البنية الاجتماعية الاقتصادية، ولا تغير أساسي في القيم والتقاليد الموروثة من عصور الجهل والظلام، وجاءت الانقلابات العسكرية لتحقيق إنجازات في مجالات معينة، لكنها – وهذا هو الأهم – اتسمت بطبيعة مزدوجة، ووعي ملتبس، قطعت الطريق على التطور السلمي الديمقراطي، وغيبت الحرية، وريفت المدينة، وهمشت المجتمع المدني، وصادرت حرية الرأي والتعبير، وحافظت على العصبيات القبلية، والطائفية والجهوية، وغلبت الإرادوية والاعتداد بالقوة حد العجز عن حماية السيادة والاستقلال والتراب الوطني.
أسهمت الخلافات الداحسية في النظام العربي كله مشرقه ومغربه، ملكياته وجمهورياته، في تمزيق عرى الأخوة العربية، وأضعفت التضامن العربي، بل امتدت الخلافات داخل كل قطر بين الاتجاهات الفكرية والحزبية والسياسية؛ فتصدعت الوحدة الوطنية، وساد الوعي الزائف وعداوات الجاهلية الأولى؛ فتضعضعت حصانة العقل والجسد، وتراجع التنوير. لم تكن الصهيونية العالمية ولا إسرائيل والاستعمار غائبين عن هذا الصراع الذي أسهمت فيه المنظومة العربية جلها، وتنافست في نقش لوحته المفجعة. الخوف من الإبداع، ورفض الاجتهاد، وتجريم التجديد والحداثة، وسد الأبواب والنوافذ أمام التغيير السلمي والتحول الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير أعاقت، بل أدت أنوار العصر في الوطن العربي، وأشرعت النوافذ والأبواب لتسيد الجهل، وتطاول ليل الفتن والحروب والمآسي؛ فمقاصل التجريم والتخوين والتكفير لها الأثر المدمر في قتل المواهب وخمود التنوير، ولعل أنموذج اليمن دال وفاجع.
في منتصف القرن الخامس شهد اليمن ظهور فرقة من الزيدية تدعى «المطرفية»، طرحت بعض الآراء الكلامية حول حدوث العالم وإثبات الصانع، وأن الحوادث اليومية كالنباتات والمولدات والآلام ونحوها، حادثة من الطبائع الحاصلة في الأجسام، ويذهبون إلى عدم حصر الإمامة في البطنين (أبناء الحسن والحسين)، كما أشار العلامة الباحث أحمد محمد الشامي في موسوعته الفكرية (تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي)، وتعرضت هذه الفرقة للإبادة، وأسدل الستار على الجريمة.
كتاب الدكتور علي محمد زيد «تيارات معتزلة اليمن» أول من علق الجرس وتتالت الردود. في الأعوام 1937- 1941م صدرت في المتوكلية اليمنية مجلة «الحكمة اليمانية» مثلت البداية الحقيقية للحداثة والتجديد والتنوير، صدر منها 28 عددًا. تبنت المجلة دعوات الإصلاح الديني، والتحديث السياسي، ونشر الجديد: القصيدة الحديثة، والقصة القصيرة، والنقد الأدبي، والمقالة السياسية. كان معظم محرريها من علماء الدين، وشاع عنهم «اختصار القرآن»، وأعدم الكثيرون منهم بعد فشل حركة 48 الدستورية، وكانت الانتكاسة الثانية للتنوير في اليمن، ولكن بحد السيف.
وأصدر مجموعة من الأدباء في المتوكلية اليمنية مجلة «البريد الأدبي»، وقد صدرت منها بضعة أعداد ثم توارت. وفي عدن صدرت مجلة (المستقبل) 1949 -1950م، وكانت الأكثر حداثة وعصرية وتنويرًا، اتهم سكرتيرها المفكر العربي عبدالله عبدالرزاق باذيب بتهمة ازدراء الأديان، وحوكم على مقاله: «مسيح جديد يتكلم الإنجليزية».
مقاصل التخوين والتجريم والتكفير، ابتداء بالإمامة والاستعمار البريطاني والإسلام السياسي والأنظمة الشمولية والدكتاتورية في الشمال والجنوب، هي من تولى كبر إعاقة التنوير ووأده وتقتيل رواده.
التنوير و«ثنائيّة» المشرق والمغرب في مشروع الجابري

ناجية الوريمي – باحثة تونسية

محمد الجابري
تحتلّ مسألة التنوير في الفكر العربيّ المعاصر مركزًا محوريًّا يؤكّده تقاطعها مع سائر شروط النهضة والتحديث. ومصطلح التنوير يكاد يكون مرادفًا للعقلانيّة، التي اعتبرت نمطًا تفكيريًّا يضمن تجاوز التخلّف وعوامل الشدّ إلى الوراء؛ مثل التعصّب، والظلاميّة، والإيمان بقوى معرفيّة تلغي التفكير المنطقيّ الاستدلاليّ. غير أنّ الزاوية التي نُظِر منها إلى هذه المسألة كانت تختلف من مفكّر عربيّ إلى آخر، وبخاصّة من مشروع فكريّ إلى آخر، وذلك وفق المقاربات المنهجيّة و»الأيديولوجيّة» المعتمدة. فقد انطلق عددٌ من المفكّرين من حقيقة القصور الذي يشهده «العقل العربي» أو «العقل الإسلامي»، وراحوا يبحثون في الأسباب التاريخيّة والإبستمولوجيّة التي جعلت هذا القصور مزمنًا، وتسبّبت في فشل النهضة العربيّة وفي تعمّق التبعيّة للآخر. ومن اللّافت للانتباه أن نجدهم متّفقين على العودة بجذور هذا القصور إلى حِقَبٍ مضت، حقب النشأة والتطوّر والجمود التي شهدها العقل العربي الإسلامي.
ويعدّ مشروع محمّد عابد الجابري في هذا الصدد من أبرز المشاريع الفكريّة نظرًا إلى طابعه الشموليّ الذي اتّخذ نسقًا ذا بنيةٍ واضحةِ المنطلقات والنتائج، ونظرًا أيضًا إلى قدرته على إثارة الإشكاليّات المحرجة، واستثارة القارئ عبر استدراجه إلى المشاركة في الفعل النقديّ الذي انبنى عليه. ومجادلة هذا المشروع من خلال نقاط عديدة منهجيّة ومعرفيّة، لا يمكن بأيّة حال أن تمسّ قيمته في نقد «العقل العربيّ»، بل على العكس من ذلك تدعمه عن طريق التفكير معه وإثرائه بالمساءلة والحوار. وفي هذا المقال سنكتفي بمجادلة المعيار الجغرافي – الثقافي الذي بنى عليه الجابري مشروعه النقديّ الذي أسند إليه دورًا لا يُستهان به في تحديد عوامل التنوير العربيّ وعراقيله.
صرّح الجابري في أكثر من سياق بأنّ العقلانيّة مفتاح التنوير، واعتبرها -إلى جانب الديمقراطيّة- شرطَي النهضة العربيّة المنشودة. وراح يبحث في مدى حضورها في الأنظمة الفكريّة التي كوّنت -ولا تزال- العقل العربي، معتقدًا أنّ ذلك الحضور هو الذي يمكن أن يؤسّس لعقلانيّة عربيّة منفتحة على مكتسبات الحضارة الإنسانيّة من ناحية، ومتجذّرة في تاريخ الأمّة وهويّتها من ناحية ثانية؛ لأنّه –حسب رأيه- «لا سبيل إلى التجديد والتحديث إلا من داخل التراث نفسه وبوسائله الخاصّة وإمكانيّاته الذاتيّة»، وذلك بتوظيف «وسائل عصرنا المنهجيّة والمعرفيّة». (بنية العقل العربي: المركز الثقافي العربي، 1991م، ص568).
غير أنّ مشروع الجابريّ رغم قيمته في فهم الثقافة العربيّة فهمًا جديدًا، ظلّ خاضعًا في جانبٍ منه لنزعة أيديولوجيّة؛ ففيه تداخلت المعايير الإبستمولوجيّة العلميّة، والمعايير (الجغرا-ثقافيّة) في علاقتها بالانتماء الجغرافي للمفكّر. وكنّا نعتقد أنّ هذه المعايير قد ولّت مع ما ولّى عهده من مواقف تقليديّة، حاربها الجابري نفسه دون هَوادة. إنّها المعايير التي أنتجت فكرة المفاضلة بين المشرق والمغرب: أيّهما يتقدّم على الآخر داخل الإطار الحضاريّ الواحد الذي يجمعهما. وهنا يحقّ لنا أن نسأل: كيف يحقّق التنويرَ مشروعٌ يقسّم أنظمة العقل العربي وفق معايير قديمة أنتجتها ظروف سياسيّة لا علاقة لها بالفكر وبالإبستمولوجيا؟ وكيف يستقيم أن ننسب إلى جهةٍ ما كاملَ العقلانيّة، وننسب إلى الأخرى كامل اللّاعقلانيّة، رغم ما يجمع بينهما من سياق تاريخيّ واحد، واختيارات ثقافيّة واحدة؟
المنهج الإبستمولوجي في قراءة الخطاب:
 لقد استفاد الجابري من الرصيد الهامّ الذي حقّقته الفلسفة الغربيّة الحديثة –بحكم اهتماماته الفلسفيّة- في مستوى تحليل الفكر العربيّ الإسلاميّ ومنتجاته الفكريّة؛ فقام بتطبيق المنهج الإبستمولوجي في قراءة الخطاب، معتبرًا أنّنا في أشدّ الحاجة إلى عمل من هذا القبيل بهدف تبيّن الأسس المعرفيّة والمنطقيّة التي قام عليها الفكر العربيّ، وخصوصًا النجاح في حسن استثمار الجوانب العقليّة المميّزة في تراثنا والداعمة لمسار حداثة عربيّة. وصرّح بأنّ مشروعه «نقد العقل العربي» قائم على «تحليل الأساس الإبستمولوجي للثقافة العربيّة التي أنتجت العقل العربيّ». (تكوين العقل العربي: المركز الثقافيّ العربي، 1991، ص33). وذلك بهدف الكشف عن نوعيّة الآليّات العقليّة التي تمكّن من اكتساب المعرفة –انطلاقًا من مبادئ وقواعد محدّدة- وهو ما يؤسّس مفهوم «النظام الفكريّ – Epistémè». وتوصّل إلى بلورة ثلاثة أنظمة هي: البيان، والبرهان، والعرفان. وسنتوقّف عندها بعض الشيء؛ لأنّ دواعي تحديدها ومعايير توزيع الحقول المعرفيّة بينها هي التي ستكشف عن معايير المفاضلة بين المشرق والمغرب، التي كانت توجّه من الداخل كامل المشروع الفكريّ الذي أسّسه الجابريّ.
لقد استفاد الجابري من الرصيد الهامّ الذي حقّقته الفلسفة الغربيّة الحديثة –بحكم اهتماماته الفلسفيّة- في مستوى تحليل الفكر العربيّ الإسلاميّ ومنتجاته الفكريّة؛ فقام بتطبيق المنهج الإبستمولوجي في قراءة الخطاب، معتبرًا أنّنا في أشدّ الحاجة إلى عمل من هذا القبيل بهدف تبيّن الأسس المعرفيّة والمنطقيّة التي قام عليها الفكر العربيّ، وخصوصًا النجاح في حسن استثمار الجوانب العقليّة المميّزة في تراثنا والداعمة لمسار حداثة عربيّة. وصرّح بأنّ مشروعه «نقد العقل العربي» قائم على «تحليل الأساس الإبستمولوجي للثقافة العربيّة التي أنتجت العقل العربيّ». (تكوين العقل العربي: المركز الثقافيّ العربي، 1991، ص33). وذلك بهدف الكشف عن نوعيّة الآليّات العقليّة التي تمكّن من اكتساب المعرفة –انطلاقًا من مبادئ وقواعد محدّدة- وهو ما يؤسّس مفهوم «النظام الفكريّ – Epistémè». وتوصّل إلى بلورة ثلاثة أنظمة هي: البيان، والبرهان، والعرفان. وسنتوقّف عندها بعض الشيء؛ لأنّ دواعي تحديدها ومعايير توزيع الحقول المعرفيّة بينها هي التي ستكشف عن معايير المفاضلة بين المشرق والمغرب، التي كانت توجّه من الداخل كامل المشروع الفكريّ الذي أسّسه الجابريّ.
أدرج الجابري ضمن نظام البيان نصوص العلوم عربيّة المنشأ؛ وهي: الفقه، والكلام، والنحو، والبلاغة. (تكوين العقل العربي، 96- 133؛ بنية العقل العربي، 13- 248). وتتمثّل خصائص هذا النظام في أنّ «عمليّة التفكير محكومة دومًا بأصل؛ أي أنّ العقل البيانيّ فاعليّة ذهنيّة لا تستطيع ولا تقبل ممارسة أيّ نشاط إلا انطلاقًا من أصل معطى [نصّ، أي الكتاب والسنّة] أو مستفاد مـن أصل معـطى [ما ثبت بالإجماع والقياس]». (بنية العقل العربي، 113).
إذن ليس للعقل من دور في هذا النظام إلا الاستدلال على صحّة النصّ أو استثماره؛ لذلك هو محدود الفعالية ولا دور له إلا في حسن الاتّباع. والخطابات الممثّلة لهذا النظام لا تخرج عمّا أنتجه أعلام من المشرق، هم سيبويه والشافعي والقاسم الرسّيّ والجاحظ وابن الأنباري والسيرافي وأبو الحسن الأشعريّ وابن جنّيّ والتوحيدي والقاضي عبدالجبّار، وأبو الحسين البصريّ والسكاكي، والقائمة طويلة. لا يكشف تتبّعها عن أسماء مغربيّة إلا نادرًا. وكان حكم الجابري على هؤلاء أنّهم جانبوا العقلانيّة؛ لأنّهم خضعوا لسلطة مرجعيّة لا تعدو أن تكون «عالم الأعرابيّ» في شبه الجزيرة. (بنية العقل العربي، 248).
النظام الثاني هو العرفان: ويتمثّل في أنّ الحصول على المعرفة «لا يكون بالعقل ولا بالحسّ، بل بالكشف؛ وهو ما يُلقى في القلب إلقاءً عندما يرتفع الحجاب بينه وبين الحقيقة العليا». (تكوين العقل العربي، 374). فالعرفان إلغاءٌ للعقل. (بنية العقل العربي، 379). وتمثّل هذا النظام كلّ التيّارات العرفانيّة، الصوفيّة منها والشيعيّة، بروافدها الأجنبيّة الشرقيّة. وكان الجابري صريحًا في الإعلان عن وقوفه موقفًا نقديًّا من «العرفان»، من منطلق تحليله العقلاني المستنِد -كما قال- إلى «الإيمان بقدرة العقل على تفسير كلّ الظواهر تفسيرًا يعطيها معنى معقولًا»، ومن منطلق إيمانه «بقدرة العقل على تفسير ما يسمّيه العرفانيّون: الكشف». (بنية العقل العربي، 374- 375). ويؤكّد أنّ الكشف العرفاني هو «أدنى درجات الفعالية العقليّة». (بنية العقل العربي، 378)، وأنّ أعلامه لا يتجاوزون حدود المشرق، من قبيل إخوان الصفا والكليني والقشيري والهجويري وابن عربي، (نشأ في الأندلس وعاش في المشرق)، والطوسي وغيرهم. وعندما ذكر ضمن هذا النظام عَلَمًا مغربيًّا هو الشيعيّ القاضي النعمان، عرّفه بفترة انتمائه إلى المشرق مع المعزّ لدين الله الفاطمي مؤسّس القاهرة. (بنية العقل العربي، 321)؛ حتّى يحافظ على الصورة الناصعة لعقلانيّة مغربيّة كما سنرى.
النظام الثالث هو البرهان: يعرّفه الجابري بأنّه «يتأسّس بوسائله الخاصّة التي هي العقل وما يضعه من أصول، وليس له سلطات مرجعيّة خارجة عنه». (بنية العقل العربي، 416)، وبأنّه يقوم على «منطلقات منهجيّة وتصوّريّة مستمدّة من الحقل المعرفيّ العلميّ لذلك العصر (أي العصر القديم)؛ بل لكلّ عصر… مثل الاستنتاج والاستقراء والسببيّة». (بنية العقل العربي، 552). لكنّ العقل في نظام البرهان المشرقي ظلّ مُفرَغًا من محتواه العقليّ الإبداعيّ؛ لأنّ العقل فيه لا يعدو أن يكون شكليًّا، ولم يبتعد كثيرًا عن وظيفة خدمة البيان والعرفان، حسب استثمار الفلاسفة المشارقة له، مثل الكندي والفارابي وابن سينا وغيرهم.
العقل العربي وخيبة الأمل
إلى هذا الحدّ من تحديد أنظمة العقل العربي بحقولها المعرفيّة وأعلامها «المشارقة»، يُصاب القارئ بخيبة أمل في هذا العقل العربي الذي عمل وفق أنظمة تصادر العقل أو هي تحدّ من فاعليته وإبداعه المعرفيّ. لكن فجأة ينبعث أملٌ فريدٌ من نوعه، مصدره المغرب والفكر المغربيّ؛ فخارج النظم الثلاثة المذكورة، وفي سياق تفكّكها، يقدّم الجابري فكرًا مغربيًّا – أندلسيًّا تجاوز مآزقها الإبستمولوجيّة وأسّس عقلًا «برهانيًّا خالصًا»- حسب عبارته. ويتمثّل هذا العقل في منطق استدلال عقليّ صِرْف. كان هذا مع ابن حزم وابن باجة وابن رشد والشاطبي، ومع ابن خلدون بخاصّة. هؤلاء عنده هم «أعلام التجديد في الثقافة العربيّة الإسلاميّة في المغرب والأندلس»، برز الواحد منهم «كمَعْلَمة من معالم لحظة النقد التجاوزي»، حسب قوله. (بنية العقل العربي، 541). فابن رشد يمثّل قمّة ما وصل إليه العقل العربي في ميدان الفلسفة، وابن خلدون يمثّل أوج الفكر التاريخيّ والاجتماعي والسياسيّ في الثقافة العربيّة الإسلاميّة، والشاطبي يمثّل قمّة ما وصل إليه العقل العربي في ميدان الأصول». (بنية العقل العربي، 538). وهؤلاء جميعًا «يقعون على مستوى واحد من النضج العقلاني، وعلى درجة واحدة في مجال التجديد والإبداع العقليّين». (بنية العقل العربي، 538). ومن هنا يهيِّئ الجابري الفكرَ المغربي لتمثيل الحلقة العقليّة الأولى التي يمكن أن نربط معها اليوم أواصر التواصل في مجال التنوير العربيّ.
 كان هذا صريحًا في قوله: «ما ننشده اليوم من تحديث للعقل العربي وتجديد للفكر الإسلامي يتوقّف ليس فقط على مدى استيعابنا للمكتسبات العلميّة والمنهجيّة المعاصرة -مكتسبات القرن العشرين وما قبله وما بعده- بل أيضًا ولربّما بالدرجة الأولى يتوقّف على مدى قدرتنا على استعادة نقديّةِ ابن حزم، وعقلانيّةِ ابن رشد، وأصوليّةِ الشاطبي، وتاريخيّةِ ابن خلدون، هذه النزوعات العقليّة التي لا بدّ منها إذا أردنا أن نعيد ترتيب علاقتنا بتراثنا بصورة تمكّننا من الانتظام فيه انتظامًا يفتح مجالًا للإبداع، إبداع العقل العربي داخل الثقافة التي يتكوّن فيها». هذا ما بدا للجابري كفيلًا بتوفير «الشروط الضروريّة لتدشين عصر تدوين جديد في هذه الثقافة»، وذلك عن طريق «استعادة العقلانيّة النقديّة التي دشّنت خطابًا جديدًا في الأندلس والمغرب». (بنية العقل العربي، 552). ولا يخفي في هذا المستوى مفاضلته الصريحة بين هذه «المكتسبات» العقلانيّة المغربيّة وما اعتبره «تداخلًا تلفيقيًّا مكرّسًا للتقليد في عالم البيان، وللظلاميّة في عالم العرفان، وللشكليّة في عالم البرهان». وحمّل هذا التداخل التلفيقيّ المشرقيّ مسؤوليّةَ الأزمة التي تردَّى فيها الفكر العربي ولم يخرج منها إلى اليوم. (بنية العقل العربي، 558- 559).
كان هذا صريحًا في قوله: «ما ننشده اليوم من تحديث للعقل العربي وتجديد للفكر الإسلامي يتوقّف ليس فقط على مدى استيعابنا للمكتسبات العلميّة والمنهجيّة المعاصرة -مكتسبات القرن العشرين وما قبله وما بعده- بل أيضًا ولربّما بالدرجة الأولى يتوقّف على مدى قدرتنا على استعادة نقديّةِ ابن حزم، وعقلانيّةِ ابن رشد، وأصوليّةِ الشاطبي، وتاريخيّةِ ابن خلدون، هذه النزوعات العقليّة التي لا بدّ منها إذا أردنا أن نعيد ترتيب علاقتنا بتراثنا بصورة تمكّننا من الانتظام فيه انتظامًا يفتح مجالًا للإبداع، إبداع العقل العربي داخل الثقافة التي يتكوّن فيها». هذا ما بدا للجابري كفيلًا بتوفير «الشروط الضروريّة لتدشين عصر تدوين جديد في هذه الثقافة»، وذلك عن طريق «استعادة العقلانيّة النقديّة التي دشّنت خطابًا جديدًا في الأندلس والمغرب». (بنية العقل العربي، 552). ولا يخفي في هذا المستوى مفاضلته الصريحة بين هذه «المكتسبات» العقلانيّة المغربيّة وما اعتبره «تداخلًا تلفيقيًّا مكرّسًا للتقليد في عالم البيان، وللظلاميّة في عالم العرفان، وللشكليّة في عالم البرهان». وحمّل هذا التداخل التلفيقيّ المشرقيّ مسؤوليّةَ الأزمة التي تردَّى فيها الفكر العربي ولم يخرج منها إلى اليوم. (بنية العقل العربي، 558- 559).
هو ذا مشروع الجابري وفق توزيع (جغرافي – ثقافي): حظُّ المشرق فيه: نظامان غاب فيهما العقل أو كان حضوره فيهما ضعيفًا، وهما: البيان، والعرفان. ونظام عقلانيّ النزعة لكن غلبت عليه الشكليّة وغاب الإبداع وهو البرهان. أمّا حظّ المغرب من العقلانيّة النقديّة المبدعة فهو وافر، كما رأينا. غريبٌ هذا التوزيع الخاضع لفكرة قديمة مدارها المفاضلة بين جهتَيْ حضارة واحدة وثقافة واحدة وسياق تاريخيّ واحد. إنّه إعادة إنتاج لموقف سياسيّ افتتحه العبّاسيّون عندما خرجت من نفوذهم مناطق الغرب الإسلامي: الأمويّون في الأندلس، ودول خارجيّة أو شيعيّة في شمال إفريقيا. ومفاده أنّ الشرق أفضل من الغرب «الخارج عن الشرعيّة». وردّ المغاربة الفعل فقلبوا المفاضلة. إذن هو موقف مرتبط بالسياسة ومقتضياتها الظرفيّة، ولا علاقة له بالمعرفة وآليّات إنتاجها؛ فالبيان والعرفان موجودان في المشرق مثلما هما موجودان في المغرب. ولأنّ السياق لا يسمح بالتوسّع نكتفي بالإشارة إلى أنّ البيان في صيغته المالكيّة كان مسيطرًا على الإنتاج الثقافيّ في المغرب، وقاد الإمام سحنون حملته ضدّ المعتزلة بنفس الطريقة التي قاد بها ابن حنبل وأضرابه هذه الحملة في المشرق، والعرفان الشيعيّ في المغرب عُرِف مع الفاطميّين قبل انتقالهم إلى المشرق (مصر). والبرهان موجود في المغرب مثلما هو موجود في المشرق، بل لعلّه هناك أوضح حضورًا في مرحلة التأسيس، مع القدريّة أوّلًا، ثمّ مع المعتزلة، ومع قسم من الفلاسفة. ونعتقد أنّ إثارة الجابري لإشكاليّة المفاضلة رمت بظلالها على المعايير الإبستمولوجيّة التي اعتمدها في توزيع العلوم والحقول المعرفيّة داخل الأنظمة الثلاثة. فعند التدقيق في النماذج التي اعتمدها في الاستدلال على مادّة كلّ نظام نتبيّن تعمّده السكوت عن النماذج التي تخالف منطق توزيعه، أو تعمّده التأويل المتعسّف لبعض منها؛ لحملها على دعم مشروعه المحمول مسبقًا على مناصرة المغرب. ولنقدّم الأمثلة التالية لأنّ السياق لا يسمح بالتوسّع كثيرًا:
علم الكلام الاعتزالي في بداياته -أي مع عمرو بن عبيد ومع واصل بن عطاء والنَّظَّام والعلاّف والجاحظ- لا يمكن أن يُدرج في النظام البياني؛ لأنّ آليّات التفكير المعتمدة فيه ومنطق ترتيب مصادر المعرفة مباينة لما هو موجود في النظام البياني: ففي الوقت الذي يضع فيه علماء الكلام العقل في الصدارة محكّمين إيّاه في فهم النصّ وتأويله وفق منطق عقليّ، يضع الفقهاء النصّ في الصدارة، مؤخّرين العقلَ إلى المرتبة الرابعة باعتباره خادمًا لحقائق «النصّ» ليس أكثر. وعلم الكلام في بداياته مشرقيّ.
الجابري يقع في الخلط
ما أوقع الجابري في هذا الخلط بينه وبين الفقه أو أصول الفقه في آليّات إنتاج المعرفة، هو عدم انتباهه إلى خصوصيّات الخطاب الكلاميّ في مرحلته الأولى -أي قبل الحدث «الأشعريّ»- وهذا ما جعله يقحم علم الكلام ضمن النظام البيانيّ، جنبًا إلى جنب مع علم الفقه وأصوله. لقد اقتصر الجابري على المفهوم المتأخّر لعلم الكلام الذي أحدثه الأشعريّ، عندما خرج على المعتزلة وأوجد صيغة سنّيّة «نصّيّة» لهذا العلم بأن جعله خادمًا لحقائق الشريعة مدافعًا عنها ضدّ «أصحاب البدع». ونتبيّن من خلال ما وصلَنا من نصوص تمثّل هذا الخطاب أنّ مفهوم العقل عند المعتزلة الأوائل يخضع لنفس الآليّات الفكريّة التي حدّدها الجابري لدى بعض مفكّري الغرب الإسلاميّ مثل ابن باجة وابن رشد.
في المقابل، لا يمكن التسليم بأنّ كلّ الأعلام المغاربة الذين وضعهم في خانة العقل، أو في النظام البرهانيّ «الخالص» -كما قال- هم كذلك. ويكفي أن نقف بعض الشيء عند ابن حزم وابن خلدون؛ فمفهوم العقل عند ابن حزم هو ما خدم النصّ، ولا يمكنه حتّى القيام بعمليّة القياس. وهو يرى أنّ الواقع –واقع المسلمين- عليه ألا يتغيّر حتّى يبقى وفيًّا ومتطابقًا مع التشريع المكتمل والنهائيّ الذي أنزله الله. وما دور العقل إلا الوقوف على الأحكام الموجودة بالضرورة في «النصّ». ويؤكّد ابن حزم في مسألة المرجعيّة التي يجب أن توجّه فعل الإنسان، أن لا «حُسنَ» ولا «قُبحَ» إلا ما علّمنا الله، مخالفًا بذلك المعتزلة في مفهومهم للحسن والقبح العقليّين؛ لذلك فإنّ مكان ابن حزم هو «البيان» وليس «البرهان الخالص» وفق توزيع الجابري. أمّا ابن خلدون فإنّ كلّ ما ذكره الجابري في شأن عقلانيّته هو من باب الإسقاط والتوظيف الأيديولوجي الصريح؛ فهو خطاب لا يتجاوز –من حيث نوعيّة دلالاته ومن حيث آليّاته الفكريّة- ثوابتَ النظام البيانيّ؛ بل إنّه الخطاب الوحيد الذي نجح في رفع الثوابت «النصّيّة» التي يكرّسها نظام البيان، إلى درجة القانون الاجتماعيّ والتاريخيّ. وقد درسنا هذا الجانب في كتابنا «حفريّات في الخطاب الخلدونيّ: الأصول السلفيّة ووهم الحداثة العربيّة» (سوريا، دار بترا، 2008م)، ولا يمكن التوسّع فيه أكثر لضيق المقام.
لذلك كان حرص الجابري المسبق والواضح على جعل ثقافة الغرب الإسلامي عنوانَ العقلانيّة اللازمة اليوم لفعل التحديث، وراء سكوته عن مؤشّرات العقلانيّة في المشرق، داخل الفكر السنّيّ، أو الاعتزاليّ المبكّر، أو الفلسفيّ؛ ووراء تأويله الحداثيّ المسقط على نصوص مغربيّة مثل نصوص ابن حزم والشاطبي وابن خلدون. لقد قام في هذه المسألة بالذات بعمليّة تطويع للمادّة المعرفيّة حتّى تستقيم مع موقف أيديولوجيّ مسبق.
إنّ مجادلة الجابري في قراءته لنصوص الثقافة العربيّة، دليل على قدرة هذه القراءة على الاستحواذ على القارئ، لكن بطريقة لا تسلبه حريّة التفكير؛ فهي مبنيّة أساسًا على «العقلانيّة النقديّة» وعلى فعل الإبداع، وبقدر ما تنقد تقبل النقد. لقد توصّل صاحبها من ورائها إلى التنبيه إلى الشروط الإبستمولوجيّة اللازمة لفعل التنوير العربي، وهي الشروط التي لا تزال في حاجة إلى الكثير من المراجعات النقديّة، لعلّ في صدارتها مراجعة الثنائيّة البالية مشرق- مغرب. ثمّ أَلَمْ يقل ابن خلدون في هذه الثنائيّة: «ليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوتٌ بهذا المقدار الذي هو تفاوت في الحقيقة الواحدة»؟ ألم يكن أولى بالجابري -وهو الذي يعلي عقلانيّة ابن خلدون- أن يتّبعه في هذا الموقف؟!
التنوير يعني تحقيق الرقي لواقعنا العربي

موريس أبوناضر – كاتب وأكاديمي لبناني
يعد التنوير الأوربي من وجهة نظر تاريخية، وريث الحركة الإنسية التي سخّرت جهودها للتوفيق بين الفلسفة اليونانية وآدابها، وبين التراث المسيحي في الدين من جهة أخرى. كما يعد ردّة فعل على الظلامية الأصولية التي كانت تهيمن على البشر في أوربا. والتنوير بالمعنى الحرفي هو ضدّ الظلام، ولكنه بالمعنى المجازي الاستنارة العقلية المضادة للفهم المغلق للدين.
بدأ إشعاع هذه الحركة مع مارتن لوثر في ألمانيا الذي حاول زعزعة اليقينيات القديمة في منظومة الخطاب الديني، وأكمل انتشاره مع ديكارت الذي تمرّد على فلسفة القرون الوسطى القائمة على تراث الفكر الأرسطي، ورأى أن المناهج السابقة في الفلسفة مليئة بالعيوب، وبعيدة من مواكبة العلم الجديد في أوربا الذي ساد الأوساط الثقافية مع نيوتن وغاليليو. أما كانط فقد أوضح مفهوم التنوير بقوله: «التنوير يعني خروج الإنسان من قصوره العقلي. وحالة القصور العقلي تعني عجز المرء عن استخدام عقله، إذا لم يكن موجّهًا من شخص آخر، والخطأ يقع علينا إذا كان هذا العجز ناتجًا لا عن نقص في العقل، بل عن نقص في التصميم والشجاعة على استخدام العقل، بدون أن نكون موجّهين من شخص آخر. لتكن تلك الشجاعة والجرأة على استخدام عقلك أيها الإنسان». وفي مكان آخر من نصه الشهير حول التنوير، نلحظ أن كانط يقدّم لنا بعض العلامات على هذه العقبات التي تضغط على الإنسان، وترعبه فلا يعود يجرؤ على استخدام عقله المعطّل. يقول كانط في هذا السياق: «ليس هناك إلا طريقة وحيدة لنشر الأنوار هي الحرية، ولكن ما أن ألفظ هذه الكلمة، حتى أسمعهم يصرخون من كل حدب وصوب: لا تفكروا حذارِ من التفكير، الضابط يقول: لا تفكروا تمرّنوا، وجابي الضرائب يقول: لا تفكروا ادفعوا، والكاهن يقول: لا تفكروا آمنوا».

محاربة الوحش الضاري
رفع فولتير كبير التنويريين طيلة حياته شعار محاربة الوحش الضاري، أي التعصب والإكراه في الدين الذي يمارسه رجال الكنيسة، ونشط في محاربة الاستبداد السياسي المرتبط بكل ذلك، من دون أن يعني هذا أن فولتير كان ضد النظام الملكي، أو ضد الإيمان المطلق. فعلى عكس ما يروّج لم يكن فولتير ملحدًا ماديًّا على طريقة فلاسفة التنوير الآخرين، إنما كان مؤمنًا إيمان الفلاسفة لا إيمان الكهنة ورجال الدين، وكان كما نقول اليوم داعية إلى تنوير العامة حتى تخرج من ظلمات الجهل، والتعصب الديني، وتدخل في مرحلة التحضّر والتقدّم. وقد فعل فولتير كل شيء لكي ينتزع السلطة السياسية من براثن الكنيسة، ولكي يخفّف من هيمنتها على العقول، وقد صدّق المستقبل توجّهه الأساسي فيما يخصّ هذه النقطة؛ ذلك أن القرن التاسع عشر أنجز مشروعًا كبيرًا، عندما فصل الدولة عن الكنيسة، وحرّر السياسة من هيمنة المطارنة والكرادلة وبقية الأصوليين، وكان ذلك أحد الأسباب الأساسية لتقدّم أوربا، وتحوّلها إلى منارة حضارية. في كتابه المدعو بالقاموس الفلسفي يقول فولتير: إنه يهدف إلى إحداث ثورة في العقول، تكون مرتكزة على ممارسة العقل والروح النقدية، وتتيح لنا التحرّر من الأفكار المتعصبة التي نرثها عن أهلنا، وهي كارهة للآخر بشكل سابق؛ لأنه يختلف عنّا دينًا أو مذهبًا، أو أصلًا اجتماعيًّا، كما أنها تتيح لنا أن نفكّر بشكل حرّ. ومعلوم أن فرنسا في عصر فولتير كانت محكومة بالاستبداد السياسي الملكي المتحالف مع الأصولية المسيحية، وكان المجتمع خاضعًا للتصورات الطائفية التي تحاول الحركات الإسلامية المتطرفة اليوم فرضها في بعض المجتمعات العربية والإسلامية. ومن المعروف أن فولتير كان يكره التعصّب الديني كرهًا شديدًا ويراه عدوّه الأوّل، وقد كرّس كل حياته لمحاربته، ولذلك أصبح اسمه رمزًا لمناهضة المتشددين المتزمتين في أي مكان كانوا ولأي دين انتموا، وخلّد اسمه في التاريخ كمناضل شديد المراس من أجل حرية الفكر، وكان يقول جملته الشهيرة التي ذهبت مثلًا، وأسست العقلية الديمقراطية في الغرب يقول: «قد أختلف معك في الرأي، ولكني مستعدّ أن أدفع حياتي ثمنًا من أجل أن تقول رأيك». باختصار كانت مضامين التنوير بالنسبة لفولتير تتحقّق في انحسار نفوذ الكنيسة، وهيمنتها على الدولة والعقول في آن واحد، وتفكيك الأفكار الطائفية والمذهبية، والخرافات الدينية، وانبثاق إيمان جديد مضاد للإيمان القديم، قائم على فكرة التسامح وحرية الاعتقاد، وتوسيع دائرة الجمهور المثقّف، وأخيرًا نشر الفكر العقلاني.

طه حسين
جاء كوندروسيه بعد فولتير؛ لكي يرسّخ المواقع نفسها، ويعمّق الاتجاه ذاته، ومعلوم أن برنامج التنوير وصل على يديه إلى أفضل وجه. ولكن ما هذا التنوير بالنسبة إلى كوندروسيه، وكيف يمكن أن نصل إليه؟ يذهب هذا الأخير إلى القول بأنه لا يمكن التوصّل إليه إلا عن طريق عقلية التفحص والشك بكل ما ورثناه عن القديم، ولا يمكن التوصل إلى ذلك إلا عن طريق الثقة بالعقل، لماذا؟ لأن العقل هو الوسيلة الوحيدة التي نمتلكها من أجل التوصّل إلى الحقيقة. والتنوير يعني الحقيقة، يعني نور الحقيقة الذي يبدّد ظلمات الجهل والتعصّب والأحكام السابقة. ولكن كيف يمكن لنا التأثير في عقول البشر وإخراجهم من ظلمات الجهل. عن هذا السؤال يجيب المفكر الفرنسي بأن هناك ثلاث طرائق: إما الكتب، وإما التشريع، وإما التربية.
لم يكن فلاسفة التنوير الذين ذكرناهم في تيارهم العريض يستهدفون الدين بحدّ ذاته، ولا حتى فكرة التعالي الرباني، ولا العقيدة الأخلاقية لهذا الدين أو ذاك، إنما كانوا يستهدفون سيطرة رجال الدين على الحكم، والخلط بين السياسة والدين، وترسيخ نظام طائفي، أو مذهبي، أو نشر أفكار التعصّب الأعمى والدفاع عنها. بمعنى آخر، فلاسفة التنوير لم يكن هدفهم رفض الدين، أو حرمان الناس من أديانهم، إنما جعلهم أكثر تسامحًا في فهم هذه الأديان وممارستها، كما كان هدفهم الأساسي تدشين مبدأ حرية الوعي والضمير، لأوّل مرة في تاريخ الفكر البشري، فأنت حسب هؤلاء حرّ في أن تؤمن أو لا تؤمن، وكل إيمان قائم على القسر والإكراه لا معنى له.
تحرير فعل المعرفة

سلامة موسى
بكلام آخر، حرّر فلاسفة التنوير فعل المعرفة بحدّ ذاته، ففي الوقت الذي كان يكفي أن تقول: إن المسيح قال، أو قال القديسون، أو قال آباء الكنيسة لكي يصدّقك الناس، أي أن فعل المعرفة يعتمد على هيبة الأقدمين، ورجال الدين، أما في عصر التنوير فإن مرجعية المعرفة لم تعد كذلك، إنما أصبحت العقل والمعرفة. يلخّص المفكر البلغاري الأصل الفرنسي الجنسية تودوروف في كتابه الأخير «روح التنوير» يلخّص التنوير بقوله: «انتصار العقلانية العلمية في المجتمع، زائد انتصار دولة القانون والمؤسسات الحديثة، زائد انتصار الديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان».
بدأ خطاب التنوير في العالم العربي مع بزوغ فجر النهضة في القرن التاسع عشر بمرجعيات فكرية وأيديولوجية مختلفة، وقد سعى رجاله التنويريون؛ أمثال رفاعة الطهطاوي، وبطرس البستاني، مع الإصلاحيين الإسلاميين كمحمد عبده، ورشيد رضا، والليبراليين العلمانيين كفرح أنطون، وشبلي الشميل، وطه حسين، وسلامة موسى، سعى هؤلاء إلى بثّ مضامين التنوير الجديدة، وأهدافه الكبرى في السمو بالعقل، وغربلة التراث، ونقد الفقه القديم، وإعادة طرح المسألة الدينية بشكل نقدي، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتكريس قيم الحرية والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والدعوة إلى التعلّم للتمكن من المعارف والعلوم أسوة بالغرب الذي قطع أشواطًا جبارة في الرقي والتقدّم.
 تمحورت المضامين الجديدة التي جلبها المتنورون العرب وبثّوها في بلادهم، ودعوا إلى اعتمادها، في عدة مسائل: أولها «التمدّن» الذي تمثّل في إنجازات حققتها أوربا، وجعلتها في أوّل الأمم المتقدّمة، وهذا عائد إلى العمل والفكر الذي هو إنساني، ويخصّ جميع البشر. وقد آمن التنويريون بأن التمدّن يرجع إلى فضائل لا بدّ من اكتسابها كالعلم والحرية والعمران والوطنية. وثانيها مسألة التربية التي لا تعني اكتساب العلوم فحسب، بل اكتساب الفضائل أيضًا، فالتربية تعني تعويض التأخّر بالعلم والعمل، والعلم لا يكسب الإنسان المعارف فقط، ولكنه يهذّب طباعه ويشحذ هممه لخدمة الوطن. وثالثها مسألة الوطن، فالتربية الوطنية حسب البستاني والطهطاوي تؤسّس للرابطة المعنوية بين أبناء الوطن. وفكرة الوطن حسب رواد التنوير ترتبط بالفضائل، أكثر مما ترتبط بالسياسة ومفهوم الدولة، إلا أنها نتجت عن وعي بعمق التاريخ الذي يجمع أبناء الوطن، مهما اختلفت ديانتهم. ورابعها مسألة الحرية التي تحدّث عنها التنويريون ودعوا إليها، كانت مفهومًا واسعًا يتعلّق بحرية التعبير والعمل. يقول الطهطاوي في هذا السياق: إن التمدن منوط بحرية انتشار المعارف، أما خير الدين التونسي فيعرّف الحرية بأنها وراء التمدن في البلاد الأوربية. وخامسها مسألة الدستور التي تعني إقامة نظام سياسي يحدّ من السلطة المطلقة، وإقامة هيئات منتخبة تمارس الرقابة والمحاسبة.
تمحورت المضامين الجديدة التي جلبها المتنورون العرب وبثّوها في بلادهم، ودعوا إلى اعتمادها، في عدة مسائل: أولها «التمدّن» الذي تمثّل في إنجازات حققتها أوربا، وجعلتها في أوّل الأمم المتقدّمة، وهذا عائد إلى العمل والفكر الذي هو إنساني، ويخصّ جميع البشر. وقد آمن التنويريون بأن التمدّن يرجع إلى فضائل لا بدّ من اكتسابها كالعلم والحرية والعمران والوطنية. وثانيها مسألة التربية التي لا تعني اكتساب العلوم فحسب، بل اكتساب الفضائل أيضًا، فالتربية تعني تعويض التأخّر بالعلم والعمل، والعلم لا يكسب الإنسان المعارف فقط، ولكنه يهذّب طباعه ويشحذ هممه لخدمة الوطن. وثالثها مسألة الوطن، فالتربية الوطنية حسب البستاني والطهطاوي تؤسّس للرابطة المعنوية بين أبناء الوطن. وفكرة الوطن حسب رواد التنوير ترتبط بالفضائل، أكثر مما ترتبط بالسياسة ومفهوم الدولة، إلا أنها نتجت عن وعي بعمق التاريخ الذي يجمع أبناء الوطن، مهما اختلفت ديانتهم. ورابعها مسألة الحرية التي تحدّث عنها التنويريون ودعوا إليها، كانت مفهومًا واسعًا يتعلّق بحرية التعبير والعمل. يقول الطهطاوي في هذا السياق: إن التمدن منوط بحرية انتشار المعارف، أما خير الدين التونسي فيعرّف الحرية بأنها وراء التمدن في البلاد الأوربية. وخامسها مسألة الدستور التي تعني إقامة نظام سياسي يحدّ من السلطة المطلقة، وإقامة هيئات منتخبة تمارس الرقابة والمحاسبة.
مقاومة حقبة الانحطاط

تودوروف

خيرالدين التونسي
كما تكوّن مفهوم الأنوار في أوربا تعبيرًا عن وظيفة فكرية، هي مقارعة الكنيسة وفكرها الظلامي المعادي لحرية التفكير، والحقائق العلمية، كذلك تكوّن مفهوم التنوير في العالم العربي، تعبيرًا عن وظيفة مقاومة حقبة الانحطاط. لكن هذه المقاومة ما لبثت أن منيت بهزيمة تاريخية أمام قوة إسرائيل عام 1967م، وكان أثر هذه الهزيمة كبيرًا في الشعوب العربية التي اكتشفت تخلّفها على جميع الأصعدة، وأدركت أن مشروع التنوير الذي راهنت عليه، قد أجهض بمكوّناته القائمة على الحرية والعدالة والعقلانية. لقد فشل مشروع النهضة العربية الذي ساهم التنويريون في بنائه؛ لأنه أخفق في بناء خطاب عقلاني، وانكفأ على الذات الماضوية مرة، وارتمى في أحضان الغرب مرة ثانية. لذلك بقيت اليقينيات المطلقة في الدين والاجتماع سائدة، وبقيت حالة الاستبداد مهيمنة في الدين والسياسة أيضًا.
يعد بعض المفكرين أن مشروع التنوير العربي لا يزال يعاني الانسداد التاريخي، وتقف في وجه تحقيقه عدة معوقات، منها أن سياسة التحديث التي اتبعت منذ أيام محمد علي قبل مئتي سنة، ركّزت على نقل العلوم لا الفلسفة العميقة التي تقف خلف العلوم، وثانيها الخوف من الفكر الراديكالي، أي الجذري العميق الذي يدعو إلى القطيعة مع الماضي، والانفصال عن التراث، ومنها أطروحات الإخوان المسلمين التي استفادت منها الحركات الإسلامية المتطرفة اليوم لتقدّم صورة عن الإسلام الدموي، والنابذ للآخر، والداعي إلى التعصّب الديني والمذهبي.
استغلال فشل الأيديولوجيات
استغلّت الحركات الإسلامية المتطرفة فشل الأيديولوجيات القومية والماركسية والليبرالية التي تسعى لبناء دولة الحق والقانون، وراحت تقدّم خطابًا للجماهير يعد بالخلاص من الحاكم وظلمه وطغيانه، كما يعد بتحقيق قيم الدين في حالتها الصافية والنقية، الأمر الذي أدّى إلى توقّف الحوار بين العقل والدين، وإلى إشهار سيف العداء ضد قيم الحداثة والتنوير، وبذلك انتقل الفكر من القرن الحادي والعشرين إلى القرون الوسطى، وعصور الانحطاط الفكري التي تميّزت بالتعصب والتزمت، وبذلك كانت نتائج هذا التوجه كارثية ومأساوية على الإنسان في العالم العربي.
إن معاداة العقل، والبطش بالفكر الحرّ يؤخران الشعوب العربية في مسيرتها لتحقيق قيم التنوير، ويضعها في موقع النابذ لأفكار الآخرين واحترامهم، لكن الأمل ما زال معقودًا على صياغة رؤية مستقبلية تدفع بمشروع التنوير نحو أهدافه المأمولة، رؤية تؤكد على التنمية الشاملة في مجال العلوم والمعارف، وتكريس الإبداع في فضاء من الحرية، والتركيز على مسالة المثاقفة مع الغرب بغض النظر عن الاختلاف الحاصل بين حضارتين متباينتين ثقافيًّا.
دعوات التنوير بين السطوع والخفوت

رشيد الخيُّون – باحث عراقي دكتوراه في الفلسفة الإسلامية
 جاء النور مقابل الظلام، حتى إن هناك مَن ناقش المقابلة بينهما، على الحقيقة لا المجاز، وكان السُّؤال: إذا كان النُّور جسمًا محسوسًا فماذا يكون الظَّلام، هل هو جسم مِن الأجسام أم هو مجرد انقطاع النُّور؟ كان ذلك في عام (1911م) على صفحات مجلة «العلم»، التي أنشأها (1910م) رجل الدِّين هبة الدِّين الشَّهرستاني (ت 1967م)، وأحد المحاورين في تلك القضية كان الشَّاعر والمهتم بالفلسفة جميل صدقي الزهاوي (ت 1936م)(1).
جاء النور مقابل الظلام، حتى إن هناك مَن ناقش المقابلة بينهما، على الحقيقة لا المجاز، وكان السُّؤال: إذا كان النُّور جسمًا محسوسًا فماذا يكون الظَّلام، هل هو جسم مِن الأجسام أم هو مجرد انقطاع النُّور؟ كان ذلك في عام (1911م) على صفحات مجلة «العلم»، التي أنشأها (1910م) رجل الدِّين هبة الدِّين الشَّهرستاني (ت 1967م)، وأحد المحاورين في تلك القضية كان الشَّاعر والمهتم بالفلسفة جميل صدقي الزهاوي (ت 1936م)(1).
لن ندخل في تفاصيل المناظرة، لكنني أجد في هذه المناظرة، قبل أكثر مِن مئة عام، رمزية للحركة التَّنويرية، التي أخذت تدبُّ آنذاك، وكان رمزاها داخل العراق: الشهرستاني، والزهاوي، مع اختلافهما في الأسلوب، عرفهما الباحث الاجتماعي علي الوردي (ت 1995م) بالرائدين الفكريين(2)؛ سلك الشَّهرستاني لتحقيق «التَّنوير» طريق الدِّين، بينما سلك الثَّاني طريق العِلم حتى افتتن بنظرية داروين، وهو القائل: «المذهب القوي في رأيي هو مذهب داروين في النّشوء والارتقاء، وقد تبعته، ولم يتبعه غيري قبلي، وقد شاع بسببي في العراق»(3).
عندما ننظر في النتيجة التي أسفر عنها الوضع السياسي والاجتماعي بالعِراق، لا نجد نجاحًا قاطعًا لواحد منهما، مع أن التَّقدم المدني والحضاري قد ساد في المجتمع العِراقي منذ بداية الثلاثينيات حتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، لكن ذهب كل ذلك أدراج الرِّياح، وكأنْ لم تتحقق نهضة، سوى ما كانت على طريقة الشهرستاني أو الزَّهاوي، ومع مَن أيد كلًّا منهما، ولو عاش الوردي إلى يومنا هذا لراجع ما كتبه في شأن الرَّجلين: «نجحت دعوة الزَّهاوي أخيرًا، بينما أخفقت دعوة الشهرستاني؛ ذلك لأن التَّيار الحضاري جبار ساحق، لا يقبل بأنصاف الحلول»(4).
لأن العبرة بالثَّبات لا التذبذب، وهذا ما يميز التَّجربة الغربية في ترسيخ التنوير، بداية مِن القرن السَّادس عشر الميلادي، وكم ضحايا سقطوا بين قطع الرأس في المقصلة والحرق في المحارق التي عُدت لمن اتهموا بـــــ«الهرطقة»(5)، بينما تجربة التنوير بمنطقتنا اعتمدت على التقليد وليس الأصالة آنذاك، وبين تيارين متفقين على الهدف مختلفين في الأسلوب والعقيدة، وبهذا ظهر الانشغال عن تحقيق الهدف بالنزاع بين التنويريين أنفسهم؛ ففي حالة نموذج العِراق سطع التنوير، وخفت كأن لم يكن شيئًا، وبقية بلدان المنطقة أيضًا، ونموذج الربيع العربي أظهر هشاشة حركة التنوير التي لم تتوقف في يوم مِن الأيام، وهي بين نجاح وفشل، لكن ليس هذا الواقع كله، بل هناك عودة لتلك العودة، وبوسائل وآليات أخرى تقوم على أساس فشل تيار الإسلام السياسي بفروعه كافة.
شواهد المتقدمين
إني لأجد في العبارة التي قالها الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان (ت 60هـ)، بغضّ النظر عن مناسبتها أو غرضها، إلا أنها تبدو عميقة الدلالة والمعنى في التمييز بين الأزمنة، وهذا لا يتحقق إلا بالدعوة إلى التحديث؛ قال معاوية: «إن معروفَ زمانِنا هذا منكرُ زمانٍ قد مضى، ومنكرُ زمانِنا معروفُ زمانٍ لم يأتِ، ولو أتى فالرَّتق خيرٌ مِن الفتق»(6).
ألا يمكن اعتبار نزوع الأمير الأموي خالد بن يزيد (ت 85هـ) إلى العِلم والترجمة حركةً تنويرية؟ وكان «أول مَن ترجم كتب النجوم والطب والكيمياء»(7). ومعلوم أن الترجمة تعني التلاقُح في الأفكار، وأحد أسس التقدم الثقافي والعلمي، وركن من أركان التَّنوير، كذلك حركة الترجمة في العصر العباسي، وظهور فرقة المعتزلة (في القرن الثاني الهجري)، ورسائل إخوان الصَّفا (في القرن الرابع الهجري)، وحركة الفلسفة الإسلامية، وكتب الأدب التي أبرز مثال لها ما صنفه أبو حيان التوحيدي (ت 414هـ)، ثم ظاهرة أبي العلاء المعري (ت 449هـ). وتكفي نظرة على حضارة بغداد العباسية لنفهم كم كان التنوير حاضرًا في الاقتصاد والاجتماع والثقافة(8).
كل ما تقدم يمثل حركة تنويرية في المجتمع، لكن العبرة –كما أسلفنا- في الاستمرار والثبات، فكل ما تقدم ضاع وسط الصراعات السياسية حتى حصل سقوط بغداد (656هـ)، وها نحن نعود إلى تلك النتف؛ لأصالتها، والضحايا الذين سقطوا دونها. ولمحمد مهدي الجواهري (ت 1997م) ما يُعبر به: «لثورة الفكر تأريخٌ يُحدِّثُنا/ بأنَّ ألفَ مسيحٍ دونَها صُلِبا»(9).
تطلعات المتأخرين
بدأت في العهود اللاحقة حركاتٌ تنويرية بالدعوة إلى العلم والتقدم من دون النزوع عن الدين، ولم يُسجل أحد أنه كان عائقًا، لكنَّ الخوف من ضياع أو تقهقر السائد من الفكر والأعراف جعل المعارضين للتنوير يُشهرون الدين سلاحًا مِن دون نفي تطرف بعض أصحاب دعوات التنوير أنفسهم، ومحاولات استنساخ التجربة الغربية بحذافيرها؛ فبعد إصلاحات محمد علي باشا (ت 1848م) وإرسال البعثات الطلابية إلى أوربا، اشتدَّت الدعوات في أقطار الدولة العثمانية لتحقيق التحديث، التي برزت بدعوة للتقدم الاقتصادي واستخدام الآلات؛ ففي عام 1869م كتب إبراهيم صبغة الله الحيدري (ت 1882م) لـ«حث العامة على تعليم الصنائع والمعارف، بحيث لا يحتاجون إلى صنائع الدول الأجنبية وبناء المدارس والمكاتب»(10).
غير أن الذين تصدروا الحركةَ التَّنويرية دعاهم إلى هذا التصدر انبهارهم بالغرب، ويأتي في المقدمة الشيخ رِفاعة رافع الطَّهطاوي (ت 1873م)، فأخذ يُصنف ويترجم عن الفرنسية، ويبثّ وعيًا في طبقات المجتمع المصري، لكنه كالمنقطع عن الواقع، مع أن الواقع كان خاليًا من بذرة نهضة.
كان الطَّهطاوي منبهرًا وذائبًا في الحضارة الغربية، ولأنه منبهر بها حاول تأكيد الإيمان الدِّيني لفلاسفتها قياسًا على فلاسفة اليونان القدماء، وعلى ما يبدو للترغيب بهم. قال: «بلاد الإنجليز والفرنسيس والنمسا، فإن حكماءها فاقوا الحكماء المتقدمين، كأرسطو وأفلاطون وأبقراط وأمثالهم، وأتقنوا الرياضيات والطبيعيات والإلهيات وما وراء الطبيعة، أشدَّ الإتقان، وفلسفتهم أخلص مِن فلسفة المتقدمين؛ لِما أنهم يقيمون الأدلة على وجود الله تعالى، وبقاء الأرواح، والثّواب والعِقاب»(11). بعده طلب السيد جمال الدِّين الأفغاني (ت 1898م) التجديد عبر الوحدة الإسلامية، مع الحذر من الغربيين، ومِن استبداد فرد بأمة، ودعا إلى إنشاء حزب وطني للمسلمين، وعول على السلطان عبدالحميد (ت 1918م) في جمع كلمة المسلمين، محببًا بأمجاد الماضي البعيد، المصري القديم أو العِراقي القديم(12)، داعيًا إلى الخروج مِن الجهل بالتعليم للأولاد والبنات على حدٍّ سواء. قال: «إنْ كان العلم فيكم مقصورًا على الرجال، بل أعيذكم من أن تجهلوا أنه لا يمكن لنا الخروج من خطة الجهل، ومِن محبس الذل والفاقة، ومِن ورطة الضعف والخمول، ما دامت النساء محرومات من الحقوق، وغير عالمات بالواجبات»(13). إلا أن حلم الأفغاني تبخَّر بوفاته، ومِن بعد بانهيار الدولة العثمانية، واستحالة تحقيق التنوير عبرها، فلم تكن تملك الدوافع والمستلزمات.
 ثم ذاب بعده حلم تلميذه الشيخ محمد عبده (ت 1905م)، الذي حصر نهضة الشرق في المستبدّ العادل(14)، إلا أنه حمل رجال الدين فشل التجديد الديني، وتقهقر الشرق، بأبيات شعرية قالها في أواخر حياته: «ولستُ أبالي أن يُقال: محمدٌ/أبلَّ أو اكتظت عليه المآتم/ولكنه دينٌ أردت صلاحه/أحاذرُ أن تقضي عليه العمائمُ/وللناس آمالٌ يرجّون نيلها/إذا متّ ماتت واضمحلت عزائم»(15).
ثم ذاب بعده حلم تلميذه الشيخ محمد عبده (ت 1905م)، الذي حصر نهضة الشرق في المستبدّ العادل(14)، إلا أنه حمل رجال الدين فشل التجديد الديني، وتقهقر الشرق، بأبيات شعرية قالها في أواخر حياته: «ولستُ أبالي أن يُقال: محمدٌ/أبلَّ أو اكتظت عليه المآتم/ولكنه دينٌ أردت صلاحه/أحاذرُ أن تقضي عليه العمائمُ/وللناس آمالٌ يرجّون نيلها/إذا متّ ماتت واضمحلت عزائم»(15).
فـــي تلـك الآونـــة تـــصــــدَّر الــــشــيــــــــخ عــبـــــدالـــــرحـــمـــــــــن الـــكــــــــواكـــبـــــــــي (ت 1902م)، وأعـــضــــاء «أم الـــــقــــرى» -الجــمـــعـــيــــة الـــتـــــي يـــتـــــــرأســـهـــــا واشترك فيها علماء مسلمون من الأقطار كافة- الدعوة إلى التنوير، وذلك بالبحث عن أسباب ما سموه خفوتًا، قياسًا بما تقدمت به أوربا. كانت حوارات الجمعية تعقد بمكة، حدد الأعضاء أسباب الخفوت العام لدى المسلمين، في اجتماعات الجمعية (1897م)، ولخصها الكواكبي -وكان يُشار إليه بالفراتي، وكذلك الأعضاء أشير إليهم بالألقاب-:
أسباب سياسية وأبرزها: تفرُّق الأمة إلى عصبيات وأحزاب سياسية، والحكم المطلق، والحرمان من الحرية، وفقدان العدل والمساواة، ووجود علماء مدلِّسين وجهلة صوفيين.
أسباب دينية وأبرزها: تأثير عقيدة الجبر في أفكار الأمة، وتأثير فتن الجدل في العقائد الدينية، والتشدد في الدين، وإيهام الدَّجالين بأمور سرية في الدين، والتعصب للمذاهب والآراء وهجر النصوص، والعناد على نبذ الحرية الدينية.
الأسباب الأخلاقية وأبرزها: الاستغراق في الجهل، واستيلاء اليأس والإخلاد إلى الخمول، وانحلال الرابطة الدينية الاحتسابية، وفقد القوة المالية الاشتراكية بالتهاون في الزكاة، ومعاداة العلوم العالية، والتباعد عن المكاشفات والمفاوضات في الشؤون العامة(16).
لم تحن الفرصة لوضع العلاج لهذه الأسباب؛ فالكواكبي توفي بعد أربع سنوات، وتشتَّت شمل الجمعية، ولم يظهر من ينوب عنه، لكننا نجد كتاب الكواكبي «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»(17) (1902م) لا يزال مؤثرًا مستمرًّا، بل في الآونة الأخيرة بعد ظهور فرص للإسلام السياسي في الحكم والجماعات المتطرفة والتدين بلا وعي ديني سليم؛ بدا الاهتمام يزيد بالكتاب، حتى طُبع عدة طبعات، بالسوية مع كتاب الشيخ علي عبدالرازق (ت 1967م) «الإسلام وأصول الحكم»(18) (1926م)، الذي وضع حدًّا فاصلًا بين الدين والسياسة. ويأتي ثالثهما كتاب الشيخ محمد حسين النائيني (ت 1936م) «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» (1909م)(19)، القائل بحكم الدُّستور، على اعتبار أن الاستبداد الديني، وكما وضح الكواكبي أيضًا، متآخٍ مع الاستبداد السياسي، بل الأول أخطر درجة.
لا يخفى، مِن غير هؤلاء المتقدمين، هناك دعاة للتنوير، من خارج المجال الديني، ومن المثقفين المسلمين مثل قاسم أمين (ت 1908م) في دعوته لتحرير المرأة(20)، وجميل صدقي الزهاوي (ت 1936م) في شعره ونثره(21)، وما واجهه من عَنَت المجتمع (1910م)، ودعواته في مجلس المبعوثان العثماني (1914م) لاتخاذ السبل الحديثة والعلمية في الاقتصاد والتعليم، وكان يقول ذلك في جلسات المجلس، حتى كاد يفتك به رجال الدين بعد أن نعتوه بالزنديق والملحد(22)، وطه حسين (ت 1973م)، والضَّجة التي قامت ضده (1926م)(23)، ومَعْروف الرُّصافي (ت 1945م) في شعره ونثره(24)، وإسماعيل مظهر(25) في ترجمته لأصل الأنواع، وصالح الجعفري (ت 1979م) في قصائده ضد التَّزمُّت(26)، وعبدالله القصيمي (ت 1996م)، وله في هذا الغرض أكثر من كتاب(27)، وغير هؤلاء الكثير.
من يتحمل الفشل؟
لا نستطيع القول: إن كل تلك الجهود، ولم نأتِ إلا على جوانب منها لضيق المجال، قد انتهت مآلاتها من دون رجعة، لكن يمكن القول، وهذا ما حصل بالفعل: إنها تعرضت لانتكاسات على يد الأجيال التي تلتها. ومن قراءة للوضع الحالي فإن الدعوة إلى التنوير والتجديد ستعود من جديد، بطرائق وأساليب مختلفة، فما آلت إليه المنطقة أمسى لا يُطاق؛ من تصاعد الغلو والتطرف الديني والمذهبي، وكل هذه المفردات توضع في خانة الظلام، وببلدان كانت واحات لذلك التنوير، كالعراق ومصر والشام، وبلدان المغرب العربي كتونس مثلًا، بما يمكن تحميل الأنظمة الاستبدادية التي حكمت هذه البلدان، الحصةَ الكبرى من تقهقر مشاريع التنوير، وقد استعيض عنها بالأيديولوجيات والقهر الحزبي.
كذلك لم يُكتب النجاح للحركات أو الشخصيات الدينية، التي تدعو إلى التنوير بطريقتها؛ لأنها «ركَّزت على الإصلاح الديني، ثم تطورت إلى حركات سياسية تحررية، حققت قدرًا من الاستقلالية؛ فإنها -أي هذه الحركات- لم تستطع، لأسباب أيديولوجية وسياسية، أن تؤسس نظامًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا يؤهلها لبناء نهضة عصرية؛ لأن أصحاب هذه الحركات أو قادتها، كانت توجهاتهم منصبَّة بالدرجة الأولى على الإصلاح الديني، أو مقاومة المستعمر» (28).
ما يُساعد على قوة عودة الدعوة إلى التنوير بالمنطقة: وجود وسائل التواصل المتقدمة، وإباحتها للناس كافة، وما يُرافق ذلك من تأثير إيجابي على طرائق التفكير، صحيح أنها سيف ذو حدين، لكن الحاجة إلى التنوير قد تجاوزت الإخفاء، ومثلما حدث انتصار التنوير بأوربا بفعل المثقف والملك(29)، سيكون بمنطقتنا، إن استقرت سياسيًّا، هذا يكتب ويكشف ويحرض، وذا يصدر القوانين؛ فحكاية «خروج طائر الفينيق من الرَّماد» ليست خُرافة في رمزيتها. لم تختفِ الحاجة ولا الدعوة للتنوير؛ إنما ظلت تتأرجح بين سطوع وخفوت، والظرف الحالي سيدفع باتجاه السطوع من جديد.
——————————
هوامش:
(1) الظلمة حقيقة وجودية أم عدمية، مجلة العِلم (1910-1912م)، السنة الأولى، العدد الثاني عشر، صفر: 1329هـ/آذار (مارس) 1911م، العراق- النَّجف، المجلد الثاني: ص 530 وما بعدها.
(2) الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العِراق الحديث، بغداد: الطبعة الثانية، 1972م، الجزء الثاني، ص 9.
3 الرشودي، عبدالحميد (ت 2015م)، الزّهاوي دراسات ونصوص، بيروت: دار مكتبة الحياة، 1988م، ص 115.
(4) الوردي، مصدر سابق، ص 11.
(5) راجع: التجربة الغربية الثَّرية في تحقيق التنوير ومرادفه التسامح الديني: لوكلير، جوزيف (ت 1988م)، تاريخ التسامح في عصر الإصلاح، ترجمة: جورد سُليمان، نشر بدعمٍ من مؤسسة محمد ابن راشد آل مكتوم، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، 2009م.
(6) أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 279هـ)، أنساب الأشراف، تحقيق: سهيل زكار، ورياض زركلي، مج: 5، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1996م): 37. أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت 328هـ)، العقد الفريد، تحقيق: عبدالمجيد الترحيني، مج 4، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1983م): 171-172. هناك مَن نسب هذه الكلمة لعلي بن أبي طالب (اغتيل 40هـ)، مثلما جاء في خطبة لأنطوان الجميّل (ت 1948م) بالإسكندرية في جمعية الاتحاد اللبناني، ثم شاع عنه (الجميّل، التسامح، مجلة الهلال، 1 نوفمبر: 1918م)، وبعد البحث في “نهج البلاغة”، الذي قيل إنه تضمن كل ما قاله عليُّ بن أبي طالب، لم نجدها، وها هي منسوبة إلى معاوية في مصدرين معتبرين في البحث.
(7) الجاحظ، عمرو بن بحر (ت 255هـ)، البيان والتبيين، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، القاهرة: مكتبة الخانجي، الطبعة السابعة، الجزء الأول، ص 328.
(8) عواد، ميخائيل (ت 1995م)، حضارة بغداد في العصر العباسي، بيروت: دار اليقظة 1981م، نشر المؤلف تلك الفصول في مجلة النفط 1954م.
(9) ديوان الجواهري، دمشق: بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، 2000م، الجزء الثالث، قصيدة أبي العلاء المعري: (قف بالمعرة)، ص10 .
(10) الحيدري، عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد، لندن: دار الحكمة، الطبعة الأولى، 1998م، (منسوخة من طبعة قديمة)، ص 25.
(11) الطهطاوي، تخليص الأبريز في تلخيص باريز، دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، 2002م، ص 30.
(12) انظر: الأفغاني، سلسلة الأعمال المجهولة، تحقيق: علي شلش، لندن: رياض الريس للكتب والنشر، بلا تاريخ نشر، ص 78.
(13) المصدر نفسه، ص 81-82.
(14) الإمام محمد عبده، ديوان النهضة، اختيار النصوص: أدونيس، وخالدة سعيد، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، 1983م، ص 163.
(15) المصدر نفسه، ص 243.
(16) الكواكبي، ديوان النهضة، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، 1982م، ص 205-209.
(17) الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، تحقيق: محمد عمارة، القاهرة: دار الشروق، 2007م.
(18) عبدالرازق، الإسلام وأصول الحكم، تونس: دار الجنوب للنشر، 1996م.
(19) النائيني، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تعريب: عبدالحسن آل نجف، قم: مؤسسة أحسن الحديث، 1419هـ.
(20) كاتب وباحث مصري كردي الأصل، اشتهر بمناصرته للمرأة ودفاعه عن حريتها، أكمل دراسة الحقوق بفرنسا، وعاد لمصر (1885م)، وعين في المحاكم وكيلًا للنائب العمومي ثم مستشارًا في محكمة التمييز، له كتاب: “تحرير المرأة”، و”المرأة الجديدة”. (الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج 6، ص 19).
(21) كان نائبًا في مجلس المبعوثان بإستانبول عن العراق، وفي جلساته (1914م) أعلن عن آرائه في التطور، وقبلها نشر مقالًا في الحجاب وتحرير المرأة، وامتدح في شعره نظرية التطور، على الرغم من أن والده وأخاه كانا مفتيَيْن في بغداد. (راجع: نبيل عبدالحميد عبد الجبار، النزعة العلمية في الفكر العربي الحديث، عمان: دار دجلة، ط1، 2007م، ص 333 وما بعدها).
(22) انظر: فيضي، سليمان (ت 1951م)، مذكرات سليمان فيضي من رواد النهضة العربية في العراق، تحقيق: باسل سليمان فيضي، لندن- بيروت: دار الساقي، ص 188-189.
(23) كتابه: في الشعر الجاهلي، القاهرة: مطبعة الكتب المصرية، ط1، 1926م.
(24) ديوانه: ديوان الرُّصافي، القاهرة: المطبعة التجارية الكبرى بطلب من محمود حمي صاحب المكتبة العصرية ببغداد، ط6، 1959م. وكتابه الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس، كولونيا: منشورات الجمل، 2002م، وسلسلة الأعمال المجهولة، جمع: نجدة فتحي صفوة، لندن: رياض الريس للكتب والنشر، ويوسف عزّ الدين، الرصافي يروي سيرة حياته، دمشق: دار المدى، 2004م.
(25) نبيل عبدالحميد عبدالجبار، النّزعة العلمية في الفكر العربي الحديث (مصدر سابق)، ص 399 وما بعدها.
(26) راجع: علي الخاقاني (ت 1979م)، شعراء الغري (النَّجفيات)، قمّ: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، 1408هـ، ج 4، ص 299 وما بعدها. ومما قاله في نبذ التزمت (1926م): «وقَيْدٍ طالما قُيِّدْتُ فيه/ وأَهْوِنْ بالرجال مقيدينا/ نبذتُ به ورائي لا أبالي/ وإن غضب الكرام الأقربونا/ حنانًا يا أماثلنا حنانًا/ حنانًا أيها المتزمتونا/ تبعناكم على خطأٍ سنينا/ فأسفرت الحقيقةُ فاتبعونا». (محمد جواد الغبان، المعارك الأدبية حول تحرير المرأة في الشعر العراقي المعاصر، بغداد: وزارة الثقافة العراقية- دائرة العلاقات الثقافية، 2006م، ص 53).
(27) عبدالله بن علي القصيمي: مولود بقرية قريبة من بريدة من بلدات القصيم، هاجر إلى عدة بلدان، ودرس بالعراق وأقام بلبنان ومصر، يمكن التفريق بين مؤلفاته في الثلاثينيات، التي كانت في وقت سَلَفِيّته، ومنها “البروق النَّجدية في اكتساح الظُّلمات الدجوية» (1931م)، بعدها كتب “هذي هي الأغلال” (1946م)، و”عاشق لعار التاريخ”، “لئلا يعود هارون الرَّشيد”. (عن نبذة التعريف به، في كتابه: الثَّورة الوهابية، كولونيا- بغداد: منشورات الجمل، 2006م).
(28) كافود، محمد عبدالرَّحيم، إشكالية الثَّقافة العربية بين الأصالة والمعاصرة، الدَّوحة: دار قطري بن فجاءة، 1966م، ص 14.
(29) هذا ما يخرج به من نتيجة قارئ كتاب لوكلير، تاريخ التسامح في عصر الإصلاح، مصدر سابق.


