
تركي الحمد - كاتب سعودي | نوفمبر 1, 2021 | مقالات
في معظم، إن لم يكن في كل، الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة، وسواء في حاضر الزمان أو ماضيه، لا أجد تجربة ديمقراطية واحدة ناجحة، ولو بشكل نسبي كبير؛ إذ لا يوجد نجاح مطلق في أي شيء. نعم، هنالك «لحظات» ديمقراطية لكنها عابرة ولا تلبث أن تنتهي أو تنهار بعد مدة تطول أو تقصر، وغالبًا ما يكون ذلك بانقلاب عسكري، أو عبر حالة أزمة تطوى فيها أوراق الديمقراطية، ويعود الوضع إلى الحكم المطلق من جديد، ولعل أبرز الحالات هنا هي باكستان ومصر والسودان، أما ما يجري في لبنان والكويت مثلًا، فهو في النهاية حكم طائفي أو قبلي فردي مطلق، ولكنه مغلف بالديمقراطية شكلًا.
ليس المراد هنا مناقشة أو تحليل هذه الحالات، بقدر ما أن المراد هو إجابة هذا السؤال المؤرق: لماذا تخفق الديمقراطية في ديار المسلمين؟ إنه سؤال أشبه بسؤال شكيب أرسلان في بدايات القرن العشرين: «لماذا تأخر المسلمون، ولماذا تقدم غيرهم؟».
من المؤكد أنه ليس هناك جواب حاسم لهذا السؤال، وذلك ككل سؤال يتعلق بالظواهر الاجتماعية حيث تتعدد الأسباب، وتتفرع العلل، ولكن في تقديري هنالك سببان رئيسان، وإن كان أحدهما أقل رئيسية نسبيًّا، يقفان وراء إخفاق أو فشل الديمقراطية في عالم العرب خاصة والمسلمين عامة، وهما: الثقافة الإسلامية السائدة، الثقافة السياسية بوجه خاص، وابتسار الديمقراطية كنظام اجتماعي وسياسي.
بالنسبة للسبب الأول، وهو الثقافة الإسلامية السائدة، تلك الثقافة المتراكمة تاريخيًّا منذ وفاة الرسول، وحتى اللحظة الراهنة، والمحددة واقعًا لسلوك السلطة والمجتمع، أو لنقل الحاكم والمحكوم، ولنظرتها تجاه ما هو كائن وما يجب أن يكون، وفق قيم ممارسة وليست بالضرورة نابعة من ذات الدين الإسلامي نظريًّا. في هذا المجال، يرى بعض المفكرين، ومنهم برنارد لويس (1916 – 2018م)، وسامويل هنتينغتون (1927 – 2008م)، أن الثقافة الإسلامية السائدة تقع على طرفي نقيض مع القيم الديمقراطية والليبرالية الغربية، ولذلك فإن الديمقراطية محكوم عليها بالفشل مقدمًا في ظل سيادة هذه الثقافة. بل إن بعضًا منهم، برنارد لويس على سبيل المثال، يرى أن التناقض ليس بين هذه الثقافة السائدة والقيم الديمقراطية والليبرالية فقط، بل بين الإسلام كدين وبين تلك القيم.
وأنا وإن كنت أتفق مع من قال إن هنالك تناقضًا بين قيم الحداثة بشكل عام، وقيم الثقافة الإسلامية السائدة، إلا أني لا أتفق مع القول بأن ذاك التناقض هو بين تلك القيم، أي قيم الحداثة، وبين الإسلام ذاته، أو أي دين آخر، وبخاصة الديانات الإبراهيمية من يهودية أو نصرانية. فالنصوص المطلقة، سواء دينية أو غير دينية (أيديولوجية وفلسفية)، قابلة لمختلف التفسيرات والتأويلات التي قد تكون متناقضة في أحيان كثيرة، وذلك حسب الغاية العملية (سياسية، اجتماعية، اقتصادية) المراد تحقيقها من وراء استخدام النص.
فالنصوص المسيحية مثلًا، استخدمت في العصور الوسطى الأوربية «عصور الظلام» لتبرير استبداد الباباوات «سيفان في غمد واحد»، واستبداد الأباطرة في الوقت ذاته (مقولة الحق الإلهي في الحكم)، وهي ذات النصوص التي استخدمت لاحقًا لتبرير فصل الدين عن الدولة، مثل قول المسيح: «ما لقيصر لقيصر، وما لله لله»، أو «مملكتي ليست من هذا العالم». وذات الشيء يمكن أن يقال عن تعاليم الإسلام، فتارة تكون المشاركة السياسية مبررة: «وأمرهم شورى بينهم»، وتارة الاستبداد هو المبرر: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»، وغير ذلك من أمثلة. فالنص المطلق عجينة قابلة للتشكيل في أي صورة، والخيار العملي المراد هو من يحدد شكل تلك الصورة.
الثقافة الإسلامية وقيم الحداثة
إذن، فالقول بأن دين الإسلام تحديدًا في حالة تناقض مع قيم الحداثة عمومًا، والقيم الديمقراطية والليبرالية بصورة خاصة، مسألة فيها نظر، أما تناقض الثقافة الإسلامية السائدة مع تلك القيم، فهو أمر مشاهد وملحوظ تاريخيًّا وواقعيًّا. ولو أردنا أن نحلل عناصر هذه الثقافة السائدة في مقابل قيم الحداثة، ومن ضمنها قيم الديمقراطية والليبرالية، لوجدنا الأمور الآتية:
أولًا: هي ثقافة استسلام وانتظار، في مقابل ثقافة المبادرة التي تعد من أبرز قيم الحداثة المعاصرة. فالناشئ في ظل هذه الثقافة، وفي مواجهة الأحداث والمتغيرات، هو شخص مستكين، ما ستسفر عنه الأحداث والمتغيرات من نتائج وحلول «الله وحده» أعلم بها، ولا يد له فيها. لا يسأل: من أين تأتي الحلول والنتائج؟ ويؤمن بأن هذا أمر غيبي، تتحكم فيه قوى خفية، حتى لو لم تكن خفية عصية على التحليل في واقع الأمر، في مقابل «الفرد» المشارك في المتغيرات وحلولها، عن طريق المبادرة الذاتية بصفته جزء من مجموع متحرك فاعل، وليس مجرد مسمار في آلة كلية لا يعلم كنهها ولا إلى أين تسير.
قد يكون مثل هذا الوضع موجودًا في ظل أنظمة معاصرة، كالأنظمة الشمولية من فاشية ونازية وشيوعية، إذ إن ثقافة الاستسلام والانتظار والتلقي هي ذاتها في أيديولوجيات النظم الشمولية، وفي الثقافة الإسلامية السائدة. ثانيًا: هي ثقافة يسود فيها «العقل الجمعي» مقابل «العقل الفردي». مفهوم الفرد في الليبرالية تحديدًا، هو المفهوم الأساس أو المحوري في هذه الفلسفة الاجتماعية والسياسية: حريته، استقلاليته، مبادرته، مشاركته في الشؤون كافة، واحترام كل ذلك وحمايته قانونيًّا. وهو ما لا نجده في الثقافة الإسلامية، السائدة، حيث إن مفهوم «الفرد» يكاد يكون غائبًا عن هذه الثقافة، إن لم يكن معدومًا تمامًا.
مثل هذا الأمر، أي غياب مفهوم الفرد، قد نجده في ثقافات أخرى، كالثقافة الأوربية القروسطية، ولكن مثل تلك الثقافات قد انتهت أو تكاد، مع هيمنة وانتشار مفاهيم الحداثة المعاصرة، ما عدا زوايا ضيقة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث تسود ثقافات محلية شبيهة بالثقافة الإسلامية التقليدية السائدة حتى اليوم في مجتمعات هذه الدول. والعقل الجمعي يعني فيما يعني، فرض قيوده ومحرماته وتابوهاته التي لا يمكن التشكيك فيها، فهي من «الثوابت»، بل ولا حتى طرح السؤال حولها، حتى لو كان ذلك بطريقة «يحوم حول الحمي»، ومن يفعل ذلك، فهو بالضرورة مارق مفارق للجماعة، ومستحق للعقاب.
ثالثًا: هي ثقافة للأسطورة والخرافة فيها دور محوري، في مقابل الحقيقة العلمية في الثقافة الحداثية المعاصرة. هذا لا يعني التقليل من شأن الأسطورة، بوصفها بناء رمزيًّا غايته تفسير معين لظاهر معينة، أو الخرافة، بصفتها حكاية شعبية تشكل جزءًا من الفلكلور، ولكن أن تكون الأسطورة أو الخرافة هي محور الثقافة ومصدر الحقيقة الاجتماعية السائدة، هنا يكمن الخلل.
قد تكون الحقيقة العلمية التي تميزت بها المجتمعات الحداثية والمعاصرة حقيقة نسبية قابلة للدحض، وهي كذلك، وهنا مكمن قوتها، أي أنها متغيرة، مما يعطي المجتمعات حيوية دائمة، أما حين تكون أسطورة ما، أو خرافة معينة هي معيار الحقيقة، فإن ذلك يعني جمود العقل والثقافة وبالتالي المجتمع. أن يقال مثلًا، إن صندوق باندورا أو الشيطان هو مصدر الشرور في العالم فهذه (أسطورة)، خلاف أن يقال إن الخير والشر مسائل نسبية تتحدد بالثقافة الإنسانية، أو إن السلوك البشري، بخيره أو شره، مسألة قابلة للفحص العلمي، وهنا يكمن الفرق بين ثقافة حداثية منفتحة، وثقافة تقليدية مغلقة.
رابعًا: هي ثقافة جبر في مقابل ثقافة اختيار. كانت إحدى القضايا التي ثارت بين أهل الكلام في تاريخ الإسلام، هي قضية الجبر والاختيار، بين الجبرية والقدرة، أو القائلين بحرية الإنسان ومسؤوليته عن تصرفاته من المعتزلة، والقائلين بنفي هذه الحرية، وأن كل شيء بقدر مسبق. ونحن هنا لسنا في مجال مناقشة هذه القضية، بقدر ما نريد القول إن أهل الجبر قد انتصروا في النهاية، بدءًا من صعود الدولة الأموية وصاعدًا، لأغراض سياسية بالطبع، ، وأصبح الجبر من أحجار الزاوية في الثقافة الإسلامية السائدة، وتعطلت حرية الإنسان المسلم وفقًا لذلك، لصالح مفهوم مشوه للقضاء والقدر، فكل شيء مكتوب منذ الأزل لا يمكن تغييره، وتعطلت بذلك الإرادة الإنسانية، فالفقر قدر، والهزيمة قدر، والذل قدر، وما على المسلم إلا الاستسلام، و «دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال».
خامسًا: في ظل هذه الثقافة السائدة، فإن السلطة السياسية لا بد أن تكون قاهرة ومهيمنة، كانعكاس لسلطة الله على الأرض، وهو ما عبر عنه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، ومن قبله معاوية بن أبي سفيان، من أنه خليفة الله وخازنه على أرضه، أو ما عبر عنه عثمان بن عفان، حين أرادوا خلعه في زمن الفتنة الكبرى (الثورة وفق مفاهيم العصر الحديث)، حين قال: «والله لا أنزع قميصًا قمصنيه الله»، بينما السلطة السياسية في ظل النظم الديمقراطية هي خيار ضمن خيارات، وصناعة بشرية محضة، لا دخل للمفاهيم والمقولات الدينية المسيسة فيها.
الديمقراطية كآلية وممارسة
أما السبب الثاني لفشل الديمقراطية في عالم العرب والمسلمين، فهو ابتسارها، وعدم التعامل معها بشكل كامل. فمن المعلوم اليوم أنه لا ديمقراطية دون شقها الآخر وهو الليبرالية، ولذلك يقال الديمقراطية الليبرالية، تمييزًا لها عن أشكال أخرى من الديمقراطية، مثل الديمقراطية الاجتماعية، التي ساد مفهومها في الدول الشيوعية قبل سقوطها على سبيل المثال.
فحين تتبنى دولة عربية أو مسلمة الديمقراطية، فإنها تختزلها إلى إجراءات سياسية بحتة، مثل صندوق الاقتراع ومجالس الشعب والأمة، ولكنها تتجاوز الليبرالية وقيمها، التي لا تستقيم الديمقراطية إلا بها، وهذا على افتراض أن الإجراءات السياسية البحتة شفافة وسليمة، وتعبر عن مجمل الشعب، لا فئة محددة منه، وهو أمر مشكوك فيه في أغلب الأحوال.
حقيقة، فإن الحديث في هذا المجال يطول ويتشعب، ولكن المقال تجاوز الحيز المتاح، فكان لا بد للديك أن يؤذن، وأن يدرك شهرزاد الصباح.

تركي الحمد - كاتب سعودي | سبتمبر 1, 2020 | مقالات
أصبحت الديمقراطية «أيقونة» العصر السياسية، وبخاصة في منطقتنا العربية، فلا تجد كاتبًا أو مثقفًا أو سياسيًّا، حتى لو كان في غاية الاستبداد في سلوكه، إلا ويتغنى بها، تغني قيس بليلى، وكأنها تحولت إلى عصا ساحر قادرة على فعل الأعاجيب، قادرة على انتشال جذري للأنظمة السياسية والمجتمعات، من قاع التخلف إلى قمة الرقي والازدهار والحرية والكرامة وحقوق الإنسان.
والديمقراطية المتحدث عنها هنا هي الديمقراطية الليبرالية تحديدًا، فالديمقراطية بشكلها الصافي، وفي المجال السياسي، هي كما وصفها الرئيس الأميركي إبراهام لينكولن، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة (1809 ــ 1865م)، بأنها: «حكم الشعب بالشعب ولأجل الشعب»، بمعنى أنها حق الشعب في تقرير مصيره واختيار من يمثله ويعبر عنه في السلطة السياسية.
ولكن الديمقراطية بهذا المعنى لم تعد كافية، فمزجت، وفق تدرج تاريخي معين، بالليبرالية وقيمها، من تسامح وحرية فردية مطلقة، لا يقيدها إلا القانون، فلا تكتمل الديمقراطية والحالة هذه إلا بالقيم الليبرالية، ولم تعد مجرد آلية سياسية، بل تحولت إلى نظام سياسي اجتماعي، ولم تعد قاصرة على مجرد صندوق اقتراع وانتخابات، بل أصبحت مرتبطة بحقوق وحريات نابعة من القيم الليبرالية، التي تخلو منها «الديمقراطيات» العربية، ولذلك كانت انتكاساتها، ولكن ذلك حديث آخر.
أما الثقافة السياسية، التي هي فرع أو جزء من الثقافة العامة للمجتمع، فهي ببساطة مجموعة القيم والرموز التي يتصور بها هذا المجتمع وأفراده علاقته بالسلطة السياسية، والعملية السياسية بوجه عام، وكيف هي طبيعة هذه السلطة وعلاقته بها.
بمعنى، أن طبيعة السلطة السياسية وبنيتها في أي مجتمع، تتحدد بشكل كبير، بطبيعة الثقافة السياسية السائدة في ذلك المجتمع، أي المفاهيم والقيم والرموز التي يدرك من خلالها العقل الجمعي طبيعة النظام السياسي المهيمن على المجتمع، وعلاقته بأفراده وجماعاته. بمعنى أن استمرارية أي نظام سياسي، مرهونة بطبيعة الثقافة السياسية في ذلك المجتمع، والعلاقة بين النظام السياسي، والثقافة السياسية، علاقة جدلية، بمعنى أن كلًّا منهما يؤثر في الآخر: فالسلطة السياسية تسعى لترسيخ تلك الثقافة السياسية، أو لنقل الثقافة ككل، التي تدعم وجودها في الإدراك العقلي قبل السلوك الفعلي، كما أن الثقافة السياسية تدعم السلطة السياسية التي تتوافق مع تصورها لما يجب أن تكون عليه السلطة وكيف تعمل.
وبالعودة إلى حديث الديمقراطية، هناك سؤال يفرض نفسه في الحالة العربية: هل تنسجم الثقافة السياسية العربية مع قيم ومبادئ الديمقراطية الليبرالية؟ يقول غابرييل ألموند وسيدني فيربا، في كتابهما المشترك «الثقافة المدنية»: إن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح وتستمر في بلد ما من دون حد معين من الثقافة المدنية، التي من أبرز قيمها قيمة «التسامح»، والشعور الوجداني بالمشاركة السياسية والمجتمعية، والحرية السياسية، وحكم القانون، أي القيم الليبرالية بإيجاز العبارة، حين تصبح جزءًا من الثقافة العامة للمجتمع، فهل تُوجَد مثل هذه الثقافة وقيمها ومفاهيمها في الحالة العربية عمومًا؟
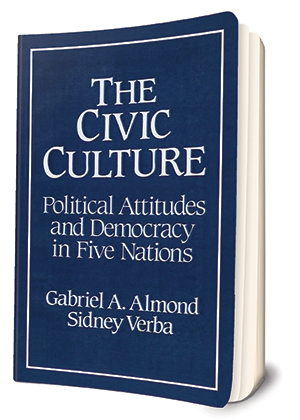 يقال إن رئيس العسكر المملوكي، سأل فقيه البلد، وهو يحمل رأس السلطان السابق المقطوع: «من هو السلطان؟ فرد الفقيه: السلطان هو من قتل السلطان». العنف هنا هو سيد الأحكام، وهو أمر قد تغلغل في الذهنية العربية عامة، وفي الثقافة السياسية العربية خاصة. وتداول السلطة لا يكون إلا بالعنف والقوة، ولا وجود لتداول سلطة سلمي أو مدني في تاريخ العرب القديم والحديث والمعاصر، إلا في لحظات خاطفة، لا تشكل إلا ومضات باهتة في تاريخ طويل يمتد.
يقال إن رئيس العسكر المملوكي، سأل فقيه البلد، وهو يحمل رأس السلطان السابق المقطوع: «من هو السلطان؟ فرد الفقيه: السلطان هو من قتل السلطان». العنف هنا هو سيد الأحكام، وهو أمر قد تغلغل في الذهنية العربية عامة، وفي الثقافة السياسية العربية خاصة. وتداول السلطة لا يكون إلا بالعنف والقوة، ولا وجود لتداول سلطة سلمي أو مدني في تاريخ العرب القديم والحديث والمعاصر، إلا في لحظات خاطفة، لا تشكل إلا ومضات باهتة في تاريخ طويل يمتد.
وربما كان بيت أحمد شوقي، الذي تغنت به أم كلثوم: «وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا» خير تعبير جزئي عن أحد مفاهيم الثقافة السياسية العربية، بل الثقافة العربية عامة، من أن الغلبة للأقوى، «فإن لم تكن ذئبًا أكلتك الذئاب»، ولا وجود لمفهوم «المشاركة»، في حلبة المصارعة تلك، سواء في ذهن الحاكم أو المحكوم، وفي ذلك يقول فؤاد إسحاق الخوري في كتابه «الذهنية العربية: العنف سيد الأحكام» (بيروت: دار الساقي، 1993م): «هي القوة أو الهيمنة أو السيطرة في المجتمع العربي التي تفصل النخبة أو الخاصة عن العامة، والوجهاء والأعيان عن أبناء الشارع. فالألفاظ والكلمات التي نستعملها للدلالة على أصحاب النفوذ والقوة تشير بشكل لا يقبل الجدل إلى عنصر القوة والهيمنة» (ص 91).
لفظة «سياسة» لدى الإغريق تعني المشاركة في شؤون المدينة، وفي ذلك يقول أرسطو إن الإنسان حيوان سياسي (مدني). أما في العربية، فهي مشتقة من ساس، يسوس، فسائس الخيل هو مدربها، وسائس الناس هو آمرها والمتحكم فيها، فليس هناك إلا آمر ومأمور، حاكم ومحكوم، وما يحدد موقع هذا وذاك هو القوة، وهو ما ينطبق عليه قول عمر بن أبي ربيعة: «إنما العاجز من لا يستبد»، رغم أن القصيدة غزلية وتشبّب بهند التي يحبها.
أما المشاركة الشعبية في تحديد طبيعة السلطة السياسية، وهو أمر جوهري بالنسبة للديمقراطية، فهو أمر غير وارد في الثقافة السياسية العربية، سواء كنا نتحدث عن الحاكم أو المحكوم. فمفهوم مثل «الشعب»، وهو مفهوم جاءنا من الغرب الحديث، لا وجود له في القاموس السياسي العربي، بل نجد لوصفه ألفاظًا مثل: الدهماء، الرعية، الغوغاء، العامة، وغير ذلك من ألفاظ فيها ما هو مسكوت عنه من تقليل أهمية هذه الكتلة من الناس، بل في أحيان كثيرة احتقارها.
الديمقراطية قائمة بكليتها على «الشعب» وحكمه، وبواسطته ولأجله، وهذا أمر غير وارد في أدبيات السياسة العربية. والشعب، في الأدبيات السياسية الحديثة، هو مجموع مواطني الدولة، والمواطنة مفهوم قانوني حديث يتحدث عن الفرد، بوصفه محل حقوق وواجبات، وهو الآخر لا محل له من الإعراب في الثقافة السياسية العربية، فهو، أي الفرد، ليس إلا رقم هلامي ضائع في كتلة الدهماء والعامة.
بمعنى، أن «الفردية»، وهي إحدى قيم الليبرالية، و«المواطنة»، وهي إحدى قيم الديمقراطية، غائبتان غيابًا شبه كامل عن الحياة السياسية العربية. حتى عندما جاءت مثل هذه المفاهيم من الغرب الحديث، فإنها ابتسرت واستهلكت من دون أن يكون لها مضمون فعلي في الممارسة الفعلية، وبخاصة في الأنظمة الانقلابية العربية، فيكثر استخدام كلمة شعب ومشاركة سياسية ونحوهما، ولكن في النهاية يُقتَل نصف الشعب باسم الشعب، وتقتصر المشاركة السياسية على نخب عسكرية وغير عسكرية، وأحزاب معينة، ويبقى «الزعيم» الأوحد هو سيد الموقف، ومرجعية كل شيء في السياسة والمجتمع، وبالتالي لا معنى «للتعددية» والاختلاف الذي ما وجدت الديمقراطية إلا للتعبير عنه.
الزعيم، أو المنقذ، هو المفهوم القابع في الذهن السياسي العربي، كطريق للنجاة من الذل والظلم والقهر والفقر، ولذلك كانت سياسة «الانتظار» هي الموقف شبه الوحيد لدى الجماهير (= العامة) حتى يأتي المنقذ، سواء بصفة دينية كالمهدي، أو بصفة سياسية بحتة كالزعيم. قد يقول قائل: إن قضية الزعامة والزعيم، المنقذ والإنقاذ، موجودة حتى في الغرب الحديث، وما حديث النازية والفاشية والستالينية منا ببعيد، وهذا أمر صحيح، ولكنه كان أمرًا تاريخيًّا طارئًا، فرضته ظروف أوربية خاصة، ثم ما لبثت مثل هذه الأنظمة أن تلاشت، ولكن المهم في المسألة، أو لنقل الأهم، أن مثل هذه المفاهيم لم تترسخ في الذهنية السياسية الأوربية وثقافتها السياسية، كما هو الوضع في الحالة العربية، والحالة – الإسلامية إلى حد بعيد.
خلاصة الأمر هو أن مفاهيم الثقافة السياسية العربية، القابعة في ذهن الحاكم والمحكوم معًا، تتناقض تمامًا مع مفاهيم وقيم الديمقراطية والليبرالية، ولا ديمقراطية حقيقية من دون حاضن فكري واجتماعي لها، ألا وهو الثقافة المدنية، كما أسماها غابرييل ألموند.
لذلك فإن محاولة «دمقرطة» المجتمعات والأنظمة السياسية العربية، من دون وجود ثقافة سياسية مناسبة تدعمها، هي محاولة فاشلة، ونظرة واحدة إلى «الديمقراطيات» العربية القائمة، إن كان لنا أن نسميها ديمقراطيات تجاوزًا، تُبيّن هذه الحقيقة. فالديمقراطية في عالم العرب، لا تعدو أن تكون صندوق اقتراع، تتحكم في أصواته القبلية والطائفية والإقليمية، وفوق ذلك كله الحاكم الفرد، أو الزعيم الملهم.
لذلك يمكن القول، أو لا بد من القول كنتيجة: إن دمقرطة المجتمعات كخطوة إصلاحية، يجب أن تبدأ من تغيير المفاهيم في الثقافة السياسية كما حدث في التاريخ الأوربي والمجتمعات الأوربية، قبل أن تبدأ رحلة الحداثة، سواء في الفكر أو السياسة أو الاجتماع.
بإيجاز ما هو موجز أصلًا، نحن في حاجة إلى خطاب عربي جديد في هذا المجال، ينقض ما هو قديم، ويبني ما هو جديد، والخطوة الأولى في كل ذلك هو نوع من «ثورة» ثقافية تجديدية جذرية، وليس مجرد تحسينات أو إصلاحات شكلية سطحية، والطريق طويل لا شك، ولكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة أولية واحدة.

تركي الحمد - كاتب سعودي | يوليو 1, 2020 | مقالات
في رواية «المثلث السري، دموع البابا: الحقائق الخفية عن الفاتيكان وصلب السيد المسيح وحراس الدم» للكاتب الفرنسي «ديدييه كونفار» (بيروت – دار الخيال 2008م)، تحاول جماعة سرية تفنيد رواية صلب المسيح، الواردة في الأناجيل الأربعة المعترف بها من الفاتيكان؛ السلطة المرجعية العليا في الكاثوليكية (أناجيل: مرقص، ومتى، ولوقا، ويوحنا). بطبيعة الحال، هناك أناجيل أخرى وروايات أخرى لدى مذاهب مسيحية أخرى، كالنسطورية والآريوسية، تخالف ما جاء من قرارات صدرت عن مجمع خلقيدونية عام 1461م، في طبيعة العلاقة بين الأقانيم الثلاثة للديانة المسيحية (الأب، والابن، والروح القدس)، بل إن بعضها ينكر ألوهية المسيح، بل حتى إنه وُلد مِن عذراء، بل له أب هو يوسف النجار، وبالتالي فهو نبي قد خلت من قبله الأنبياء.
المهم، تُعِيد هذه الجماعة السرية، وبناءً على تحليل مخطوطات البحر الميت، أو مخطوطات كهوف قمران، المكتشفة عام 1947م، قراءةَ العهد القديم من الكتاب المقدس خاصة، لتصل إلى نتيجة مؤداها أن المسيح لم يصلب على جبل الزيتون، إنما كان المصلوب أخًا توأمًا له، أما المسيح الحقيقي فقد هرب حتى وصل إلى فرنسا، وهناك عاش ومات ودفن. وهذه الرواية، تشبه إلى حد ما رواية: «شيفرة دافنشي» للكاتب الأميركي «دان براون» (بيروت: الدار العربية للعلوم 2004م)، التي تناقض الرواية الرسمية للمسيحية بأن المسيح لم يتزوج ومات بتولًا، بينما الحقيقة هي أنه تزوج مريم المجدلية، العاهرة التي آمنت به وتبعته.
كلتا الروايتين تدور حول بشرية المسيح، ولكن ذلك لم يعجب السلطات الكنسية العليا؛ إذ إن ذلك يعني انهيار المسيحية برمتها، فماذا يبقى من المسيحية الرسمية إذا انهارت رواية الصلب وألوهية المسيح، وبدرجة أدنى زواجه وإنجاب ذرية؟ في الروايتين، تُلاحِق السلطات الكنسية هؤلاء الساعين إلى الحقيقة، وتُصَفِّيهم، رغم علم البعض في هذه السلطات بحقيقة ما يسعون إليه، ولكن المهم هو بقاء المؤسسة وسلطتها، وإن كان ذلك على حساب الحقيقة المجردة، فالمهم هنا همّ بقاء وليس همًّا معرفيًّا.
ضرورات البقاء
أوردنا هاتين الروايتين، وهناك الكثير غيرهما، كمدخل إلى موضوعنا هنا وهو علاقة الحقيقة بالتاريخ، وبخاصة التاريخ الديني، فهل مثل هذا التاريخ، أو لنقل التراث حين يتعلق الأمر بالدين، هو مبني على الحقيقة المجردة، أم أن «ضرورات البقاء» تحتم على كاتب التاريخ الرسمي تحريفًا، أو لنقل تعديلًا، للحقيقة المجردة من أجل استمرارية المؤسسة الوصية على الحقيقة، في جانبيها المعرفي والروحي.
لو عدنا إلى المسيحية قليلًا، سنجد أن المؤسس الحقيقي لها هو «بولس الرسول» وليس يسوع المسيح، الذي لا يوجد من دلائل على وجوده وتعاليمه إلا شذرات يسيرة لا تكفي لتكوين صورة متكاملة أو واضحة عن شخصيته وسيرته، حين نرجع إلى تحقيقات المؤرخين الفعليين، وليس ما تخبرنا به الكتب المقدسة. بولس هذا كان من أعداء المسيح، ولكنه في النهاية آمن به، بعد رؤيا جاءه فيها المسيح، وعلى هذا بدأ يكرز (يبشر) بالدين الجديد وفق الأقانيم الثلاثة، وفي النهاية أصبحت المسيحية، وفق رؤية بولس الرسول، هي الديانة الرسمية للدولة الرومانية في عهد الإمبراطور قسطنطين، وعلى هذه الرؤيا تأسس الفاتيكان، المتحكم الروحي والمعرفي في ملايين الكاثوليك حول العالم، من دون أن يكون هنالك حقيقة جلية حول السيد المسيح وسيرته، إلا ما ورد في الأناجيل الأربعة، التي لم يقابل أصحابها، ولا بولس الرسول، المسيح وجهًا لوجه؛ لذا فمن الطبيعي حين تظهر حقيقة تتعارض مع ما تبشر به الكنسية، أن تقف الكنيسة ضد هذه الحقيقة، فالمسألة في النهاية قضية وجود وسلطة، وليست قضية معرفية صرفة.
ولماذا نذهب بعيدًا في هذا المجال، ولدينا قضايا مشابهة في تاريخ الإسلام والمسلمين. فلو نظرنا إلى مصادر التشريع في الإسلام، التي وضع أسسها وحددها فقهاء على مر الأزمان، وعلى رأسهم الشافعي، لوجدنا في النهاية أنها صناعة فكرية منظمة، تعبر عن عقول المؤسسين في المقام الأول. لو أخذنا كتابًا مثل «صحيح البخاري» الذي يُقدَّم على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، فهو الجامع لأحاديث الرسول وسنته، الذي وضعه البخاري بعد ما يقارب مئتي عام على وفاة الرسول، سنجد أن فيه أحاديث ضعيفة. وما قيل عن «صحيح البخاري»، يمكن أن يقال عن أكثر ما ورد في كتب تاريخ وتراث الإسلام والمسلمين، سواء كنا نتحدث عن كتب «الصحاح» الستة، أو تلك الكتب الشارحة لأمهات الكتب التراثية، أو كتب التاريخ المفترض فيها الدقة والموضوعية.
حاول ابن خلدون أن يغير شيئًا في كتابة التاريخ وتراث المسلمين، ولكن بقي صائحًا في برية في وجه التيار العام، ولم يأخذ حقه من التقدير إلا في العصور المتأخرة، عندما اكتشفه لنا المستشرقون من الغرب، بينما كان لدينا جوهرة مدفونة في صحراء قاحلة، حقيقة الأمر.
تناقض صريح
لماذا كان كل ذلك؟ نعود هنا إلى نقطة البدء حين الحديث عن المسيحية، ألا وهي ذلك التناقض الصريح بين الحقيقة المجردة ومتطلبات المؤسسة للبقاء واستمرار الهيمنة على العقول والأرواح. فحتى لو ثبت علميًّا «وتجريبيًّا» أن بول الأبل مجرد فضلات حيوانية لا أثر لها في علاج أو عافية، أو أن الحبة السوداء ليست علاجًا لكل داء، أو أن الذباب كله قذارة لا فرق بين جناحيه، أو أن ماء زمزم غني بالأملاح المضرة بمريض السرطان مثلًا، أو أن الماء المقدس في المسيحية لا قدسية له، بل هو مجرد ماء، فإن كل ذلك لا أثر فعليًّا له في التصديق العام بقوة هذه المواد العلاجية، وذلك لسببين رئيسيين: أولهما قوة تأثير المؤسسة الدينية التي تراكمت عبر العصور، والتي لا تألو جهدًا في سبيل هذا التأثير رغبة في البقاء والديمومة، والثاني هو شغف العامة بكل ما هو خارق للمعقول، ومتجاوز لطبيعة الأشياء، وهو الوتر الذي تجيد المؤسسة الدينية اللعب عليه في مختلف الأديان والعصور، فالمسيح هو الإله ابن الرب الذي تجسد بشرًا للتكفير عن خطيئة آدم الأولى بالأكل من شجرة الحياة، و«اليهوه» هو الرب المقاتل إلى جانب بني إسرائيل، شعبه المختار، وغير ذلك من روايات متجاوزة لحدود العقل والمعقول.
هل معنى ذلك أن الأديان مجرد خرافة ومجموعة أساطير لا أساس لها من الصحة؟ بالطبع لا، فالدين في أصله تجربة روحية كما مارسها الأنبياء، ولكن حين يتحول إلى مؤسسة همها البقاء، فإنه والحالة هذه، يتحول إلى كيان اجتماعي وسياسي مثل أي كيان آخر، هدفه البقاء والاستمرار، حتى إن كان ذلك على حساب الحقيقة، بل على حسابها.
التضحية بالحقيقة من أجل البقاء والاستمرار، ليست قاصرة على المؤسسات الدينية، وإن كان الوضع فيها أوضح، ولكنها شاملة لكل المؤسسات التي توظف كل ما يمكن توظيفه من أدوات من أجل ديمومتها واستمرارها، وبخاصة في النظم الشمولية، القائمة على أيديولوجيات هي أشبه بالدين، بل هي أديان ولكن بوجه دنيوي من دون رب خفي معبود. فالنازية مثلًا، مجَّدت دور العرق في التاريخ، وصنفت البشر، من ناحية الإبداع والفوقية على هذا الأساس، وخلال حقبة حكم «الفوهرر»، أدولف هتلر، كانت كل المناهج الدراسية تركز على هذه «الحقيقة» المنافية للحقيقة الموضوعية، ومن يخالف ذلك، أو يُشْتَمّ منه مخالفة ذلك، فإن مصيره هو النهاية. وفي روسيا الستالينية، أو الصين الماوية، وحاليًّا كوريا الشمالية، فإن من لا يرى الزعيم «ربًّا» معبودًا، تحيط به الأساطير من كل جانب، رغم «علمانية» هذه الأنظمة في العلن، فإن المصير هو الظلام.
خلاصة القول في هذه العجالة هي أن «الحقيقة» غالبًا ما تكون ضحية التاريخ، الذي تصنعه فعلًا المؤسسات والأديان الرسمية والأيديولوجيات الشمولية، وتختفي الحقيقة ذاتها. خذ مثلًا جائحة وباء كورونا الذي نعيشه، من أين أتى وكيف تفشى؟ هل هو لعبة صينية لأغراض اقتصادية، أم إنه قدر إلهي لإعادة الإنسان إلى تواضعه بعد أن طغى وتكبر، أم إنه مؤامرة رأسمالية لإعادة الاستثمار من جديد؟ حقيقة لا ندري أين الحقيقة في كل ذلك، فالحقيقة دائمًا هي الضحية في تاريخ البشرية، وكم من الجرائم ترتكب باسمك أيتها الحقيقة.

تركي الحمد - كاتب سعودي | مارس 1, 2020 | مقالات
في رواية «شيفرة دافنشي» للروائي الأميركي دان براون، يُقتَل راهب في متحف اللوفر بباريس، بيد متطرف مسيحي يأتمر بتوجيهات قس عالي المقام في الفاتيكان. وقبل أن يلفظ الراهب أنفاسه الأخيرة، يتعرى في دائرة رسمها مليئة بالرموز غير المفهومة، ويكتب اسم عالم الرموز الشهير «روبرت لانغدون»، الذي يستدعى من أميركا لحل الغموض حول هذه الجريمة المربكة لرجال الشرطة الفرنسية. لجعل القصة الطويلة قصيرة، يكتشف لانغدون أن الجريمة لها علاقة بالجمعيات السرية التاريخية، وأن المقتول كان عضوًا في جمعية سرية مهمتها حماية ذرية المسيح من التصفية الجسدية على يد أرباب الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، فالمسيح لم يكن أعزب،
بل تزوج من مريم المجدلية، التي توصم بالعهر في الرواية الرسمية الكاثوليكية، وأنجب منها ذرية قائمة حتى اليوم، ولكن كنيسة روما ترفض هذه الحقيقة رغم علمها بصحتها، وتقبل كل من يقول بها، بل تبحث عن ذرية المسيح لتصفيتها من أجل «نقاء العقيدة الكاثوليكية»، التي تقول ببتولة المسيح أو ألوهيته.
الاعتراف ببشرية المسيح وزواجه وإنجابه، تتعارض مع العقيدة الكاثوليكية، وتتعارض مع المؤسسة الراعية لهذه العقيدة، وبالتالي أصبح لدينا ثلاث «حقائق» متضاربة ومتناقضة: الحقيقة المعرفية الخالصة، هي أن المسيح بشر، والحقيقة العقدية، هي أن المسيح إله، والحقيقة المؤسسة، هي أن الكنيسة العليا في روما، هي الوحيدة القادرة على تفسير وإيضاح أي أمر يتعلق بالمسيح، وبالتالي يصبح الاعتراف بالحقيقة المعرفية، هو انتحار لهذه المؤسسة وبالتالي انهيارها، وهو أمر لا ترضاه المؤسسة لنفسها بعد تاريخها الطويل في «حماية» العقيدة، ولذلك هي تدافع عن نفسها في وجه كل من يشكك في معتقداتها، حتى كانت الحقيقة المعرفية واضحة وضوح الشمس في رابعة يوم من أيام الصيف، ولذلك يبقى المسيح إلهًا وثالث ثلاثة في الثالوث المقدس (الأب، والابن، والروح القدس) وهو ما يؤمن به معظم أتباع الكنيسة الكاثوليكية، رغم كل الدلائل التي تثبت خلاف ذلك (الحقيقة المعرفية).
التناقض بين هذه «الحقائق» الثلاث، ليس قاصرًا على المسيحية فقط، بل تجده في المؤسسات الدينية والأيديولوجية كافة، وذلك حين تتحول الفكرة أو الدعوة أو الرسالة الدينية إلى مؤسسة سياسية أو اجتماعية ذات مصالح معينة وبالتالي إصرار على البقاء.
وكل طرف من هذه الأطراف يتخذ «حقائق» الآخرين أوهامًا وأساطير؛ لأنها لا ترتكز على (معطيات) من الواقع وأحيانًا من المنطق.
وصاحب الموقف العقدي يرى في «حقائق» الآخرين هرطقة وكفريات، حين يتعلق الأمر بالدين، أو تآمر واستهداف في حالة الموقف الأيديولوجي خارج إطار الدين. أما المؤسسي المنتمي إلى مؤسسة معينة، فيرى في «الحقائق» الأخرى رِدَّة، أو خروجًا عن الجماعة، أو خيانة، في الحالة غير الدينية. ورغم أن الحقيقة المعرفية الخالصة تفرض نفسها في النهاية، كما حدث مثلًا بالنسبة لكروية الأرض، أو دوران الأرض حول الشمس وغيرها، إلا أن «الحقيقة» العقدية تبقى هي المهيمنة على عقول العامة أو الجماهير؛ إذ يبقى باطن الأرض مسكن الجن والشياطين مثلًا،
رغم عدم وجود دليل معرفي على ذلك، بل لا دليل معرفي، خارج إطار العقيدة، يثبت وجود الجن والشياطين من الأساس، ولكنها تبقى حقيقة ثابتة في الذهن العام إجمالًا.
الدولة والحقيقة
أما «الحقيقة» المؤسسية، فتتمثل في أجلى صورها في مؤسسة الدولة، فما تقوله، أو تأمر به الدولة هو «الحقيقة» ولا حقيقة غيرها، وبذلك تغيرت ديانات وعقائد و«حقائق» مجتمعات وأمم كثيرة، حين تغير شكل الدولة ومضمونها، لا أدل على ذلك مثلًا لا حصرًا، من تحول المجتمع العباسي من الاعتزال أيام المأمون إلى السلفية أيام المتوكل، ومن تحول إيران السُّنية إلى التشيع الصفوي، ومصر من التشيع الفاطمي إلى مذهب أهل السنة والجماعة، الذي هو بدوره نتاج قرار سياسي، وعلى ذلك قِسْ. هذا في تاريخنا، أما في التاريخ الأوربي مثلًا، فإن انفصال إنجلترا عن كنيسة روما الكاثوليكية، ونشوء الكنيسة الأنجليكانية، كان بقرار من الملك هنري الثامن. حقائق الدولة هي التي تفرض نفسها في النهاية، واعتناق الدولة لإحدى الحقيقتين الأخريين هو الفيصل في انتصار إحداهما على الأخرى.
في كتابه «حكايا محرمة في التوراة»، يروي جوناثان كيرتش، الكاتب الأميركي المتخصص في الدراسات اليهودية- المسيحية كيف أن «العهد القديم»، ومن ضمنه الأسفار الخمسة الأولى التي تشكل التوراة التي «أُنزِلت» على موسى، هو مجرد حكايات عن العنف والجنس المحرم، ومجموعة أساطير شرقية أوسطية (سومرية وبابلية وكنعانية)، جمعها مؤلفو العهد القديم من الأحبار، ورفعوها إلى عتبة المقدس، وقال بذلك كثيرون من دارسي التوراة والعهد القديم. ورغم أن معظم اليهود، وكذلك المسيحيون والمسلمون (الأديان الإبراهيمية)، يعلمون أن العهد القديم هو مجرد تجميع لأساطير الأولين في الشرق الأوسط القديم، من زاوية الحقيقة المعرفية، إلا أن ذلك لم يقلل من شأن العهدين القديم والحديث،
فعلى أساس «حقيقتهما» العقدية، قامت مؤسسات دينية وغير دينية من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، التقليل من شأنها. بل إن دولًا حالية وتاريخية،
استندت في شرعيتها إلى روايات وأساطير دينية لا تقرّها الحقيقة المعرفية.
فدولة إسرائيل الحالية استندت في شرعية نشوئها إلى «الحقائق» العقدية التي وردت في العهد القديم مثل وعد «يهوه» لإبراهيم بمنح أرض كنعان لذريته من ولده إسحاق (ابن الحرة)، وهو الوعد الذي كان وراء الفكرة أو الحركة الصهيونية التي أنشأت إسرائيل في النهاية، رغم أن مؤسسيها وآباءها لم يكونوا من المؤمنيين بالدين جملة وتفصيلًا في معظمهم، ولكن هذه «الحقيقة» العقدية تحقق لهم ما لا تستطيع الحقيقة المعرفية البحتة أن تفعله، بل إن دولة إسرائيل الحالية، لا تسير أمورها وفق شرع موسى وتوجيهات أحبار التلمود، بل هي دولة علمانية في أكثر جوانبها، رغم أن أساس شرعيتها هو أساطير منتقاة من التوراة والعهد القديم، فاليهودية في هذا المجال، لم تعد مصدرًا معرفيًّا أو مجرد دين، بل أصبحت هوية قومية، سواء آمن اليهودي بأساطير العهد القديم والتلمود أو لم يؤمن.
إشكاليات وتناقضات
ولماذا نذهب بعيدًا هنا، فلدينا في عالم الإسلام ذات الإشكاليات وذات التناقضات، فمحاولات نقد التراث الديني وتنقيته من أمور لا تتوافق مع الحقيقة المعرفية قائمة على قدم وساق، ولكن كل هذه المحاولات تبقى نخبوية، في دائرة ضيقة من الباحثين، أما معظم الناس، فإن «الحقيقة» العقدية تبقى هي الأساس، وبخاصة مع تحول هذه «الحقيقة» إلى مؤسسات هي الحاكمة على صلاح الفكرة أو طلاحها، وما تقوله هذه المؤسسات، التي هي جزء من مؤسسة أكبر وأشمل هي الدولة، هو الحق بالنسبة لمعظم الناس.
خذ مثلًا كتاب «صحيح البخاري»، الذي يُعَدُّ أهم وأصح كتاب بعد كتاب الله، والذي يشكل الحقيقة العقدية لدى معظم المسلمين السنة، ومثله كتاب «الكافي» للكليني لدى الشيعة، تجد أنه يحتوي على أحاديث لا يقر بها عقل أو منطق أو تجريب (الحقيقة المعرفية)، ومع ذلك فهو أصبح كتابًا بعد كتاب، والويل لمن ينتقده أو يقلل من قدسيته. لماذا كان ذلك؟ يقول الروائي «ميلان كونديرا»: إن «اليقين فكرة تحجرت»، فمن الصعب أن تغير فكرة راسخة في ذهن أحدهم، وبخاصة إذا أحيطت هذه الفكرة بقدسية معينة. فصحيح البخاري، وهو مثلنا هنا، لم يكتبه البخاري وحيدًا، بل هو جهد مشترك بينه وبين مريديه، كما ثبت ذلك من خلال البحث المعرفي الخالص، فأحاديث واردة فيه نجد فيها غيبيات مبالغ فيها، وربما كان هذا هو السبب في تعلُّق العامة بها، فالعامة في معظمها تعشق ما لا تدرك، وتتعلق بما يحيطه الغموض والأسطرة، ولذلك فإنه من الصعب التعامل معها وفق الحقيقة المعرفية المجردة. أدرك تجار الأوهام هذا الأمر، فلعبوا على وتره من أجل غايات لا علاقة لها بالحق والحقيقة.
من ناحية أخرى، فإن مؤسسات راسخة تاريخيًّا قامت على أساس كتب مثل: «صحيح البخاري» بكل ما يحتويه، بمثل ما قامت كنيسة روما على أساس «حقائق عقدية» وردت في الأناجيل الأربعة، وليس من المعقول أن تتنازل هذه المؤسسات عن وجودها لمجرد ثبات هذا الأمر معرفيًّا، فالقضية هنا قضية وجود ونفوذ وسلطة، وليست قضية معرفية خالصة. فحتى في أوربا وعالم الغرب، الذي اكتسحته فلسفة الأنوار والتنوير، لم تستطع الحقيقة المعرفية أن (تقضي) تمامًا على الحقائق الأخرى، وبقيت في حالة تعايش رغم كل التناقضات بينها، رغم أن الحقيقة المعرفية هي دليل العمل الفعلي في تلك البلاد. أما في بلادنا، بلاد العرب وكثير من بلاد المسلمين، فإن صراع الناب والمخلب، ومبدأ إما أنا أو أنت، فإنه ما زال قائمًا بين «الحقائق» الثلاث، وذلك كما كان الوضع أوربيًّا، فما نحن اليوم إلا أوربا الأمس. أنا واثق أن الحقيقة المعرفية سوف تهيمن في النهاية، فهي الحقيقة التي تشكل بوصلة عملية، قبل أن تكون حقيقة بذاتها، وإلى أن يأتي ذلك اليوم، فلنبشر بالتعايش بين المتناقضات، فالتناقض في النهاية هو أحد محركات التاريخ، بل هو مهماز التاريخ.

تركي الحمد - كاتب سعودي | مايو 1, 2019 | مقالات
تقوم حضارة اليوم على الحقيقة العلمية، حتى ظن البعض أنها هي الحقيقة الوحيدة التي لا حقيقة غيرها، ولكن هذا القول عارٍ عن الصحة إلى حد كبير، فالحقائق في حياة البشر عديدة، ووظائفها في الحياة متنوعة بتنوع الحياة البشرية. فإضافة إلى الحقيقة العلمية، التي استهلها فرانسيس بيكون (1561- 1626م)، بمنهجية القائم على الملاحظة والتجريب، هنالك حقائق كثيرة في حياة البشر، وتتميز الحقيقة العلمية عن كل هذه الحقائق بالقدرة على إثباتها أمبريقيًّا (تجريبيًّا)، وليس كونها الحقيقة الوحيدة، فهناك مثلًا الحقيقة الدينية، والحقيقة الفلسفية، والحقيقة الاجتماعية، والحقيقة بذاتها، أو الشيء في ذاته، وهكذا. وكل حقيقة من هذه الحقائق يتفرع عنها حقائق أصغر يختلف بعضها عن بعض، ولكنها تشترك في مرجعية واحدة. فالحقيقة الدينية مثلًا، وعلى اختلاف المذاهب والأديان، تقوم على أساس غيبيّ، من وجهة نظر الحقيقة العلمية، هو وجود قوة ما تتحكم في هذا الوجود وهي أساس هذا الوجود، فهي الله في الأديان السماوية، أو الموجود بذاته كما نستشف من فلسفة أرسطو (384 ق. م – 322 ق. م)، أو عالم المثل الغامض لدى أفلاطون (غير معروف الميلاد والوفاة)، وهي قوانين الوجود، كما عند سبينوزا (1632 – 1677م)، وهكذا. والحقيقة الفلسفية تعتمد على النظام الفلسفي للفيلسوف، فهي العقل المطلق لدى هيغل (1770-1831م) أو الحتمية التاريخية لدى ماركس (1818– 1883م)، أو الشيء في ذاته وفق فلسفة كانط (1724– 1804م).
أما الحقيقة الاجتماعية فهي ما تقرره الثقافة السائدة في مجتمع ما على أنه حقيقة، وإن ثبت أن هذه الحقيقة منافية تمامًا للحقيقة العلمية. فقد مر على الإنسان حينٌ من الدهر كان يظن فيه، بل موقن بذلك، من أن الأرض مثلًا هي مركز الكون وأنها مسطحة، وأن الشمس والكواكب والنجوم كافة تدور حولها، ونظم حياته وفق هذه الحقيقة، التي ثبت لاحقًا أنها ليست حقيقة من الناحية العلمية، ومع ذلك بقيت متحكمة في حياة الإنسان لقرون من الزمان.
المراد قوله هنا هو أن الحقيقة ليست واحدة، وهذا على الأقل هو ما نعرفه في هذه الدنيا بعيدًا من التصورات الميتافيزيقة، والفرق بين هذه الحقائق هو منهج الوصول إليها من ناحية، والوظيفة التي تؤديها في الحياة الإنسانية. فالحقيقة العلمية مثلًا، وكما ذكر آنفًا، لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق المنهج العلمي، أي المنهج التجريبي ابتداءً، وتتميز عن بقية الحقائق بكونها نسبيةً وقابلةً للدحض، وفق مفهوم فيلسوف العلم النمساوي كارل بوبر (1902- 1994م)، من ناحية أن هذه الحقيقة تبقى حقيقة حتى تُدحَض أو تُفنَّد، ومن ثم تنتفي من كونها حقيقة. أما الحقائق الأخرى، من دينية وفلسفية على وجه الخصوص، فتفترض الإطلاق في ذاتها، من ناحية كونها حقائق مطلقة غير قابلة للنقض أو الزيادة والنقصان، فإما أن يؤمن بها جُملةً وتفصيلًا، أو تُترَك جُملةً وتفصيلًا.
فالحقيقة الدينية مصدرها: الوحي الإلهي، في الأديان السماوية على اختلافها، أو في الرحلة الداخلية للبحث عن الذات، كما في الأديان الشرق آسيوية. منهج الوصول إلى تفاصيل هذه الحقيقة وتشعباتها، هو الإيمان المطلق أولًا بمصدر هذه الحقيقة ثم تأتي بقية التفاصيل. أما الحقيقة الفلسفية فمرجعيتها الأولى هي العقل، وفقًا لمفهوم صاحب النظام الفلسفي لهذا العقل، فلا يستقيم الأمر مثلًا أن تكون هيغيليًّا من دون الإيمان بالعقل المطلق وتجلياته في التاريخ والطبيعة. كما لا يستقيم الأمر أن تكون ماركسيًّا من دون الإيمان المطلق بالجدل (الديالكتيك)، سواء في التاريخ من خلال صراع الطبقات وتناقضات البنية التحتية والفوقية للمجتمع، أو في الطبيعة بمثل ما شرح ذلك فريدريك أنجلز (1820- 1895م) في كتابه «ديالكتيك الطبيعة». كما لا يستقيم الأمر أن تكون نيتشويًّا من دون الإيمان بمفهوم «الإنسان الأعلى» لدى نيتشه (1844- 1900م)، وعلى ذلك يمكن القياس.
والمشكلة هنا ليست في تعدد الحقائق ومصادرها ومناهج الوصول إليها، ولكنها، أي المشكلة، تكمن حين تتداخل هذه المناهج، فيحاول إثبات حقيقة دينية أو فلسفية، لدى المؤمن بها، مثلًا من خلال منهج آخر لم يؤسس بداية للتعامل مع حقائق غير تجريبية. فمثلًا لا يمكن إثبات وجود الجن، وهذه حقيقة دينية في الدين الإسلامي، من خلال المنهج العلمي، فوجود الجن هو جزء من البنية الدينية، لا يمكن إثباتها أو نفيها من خلال منهج آخر، كالمنهج العلمي أو المنهج العقلي الصرف، فهي مسألة إيمان أو عدم إيمان. كما أن استخدام المنطق العقلي في الاستدلال على حقائق علمية لا يستقيم، وذلك كما فعل أرسطو في منطقه الصوري. خلاصة القول هي أن تداخل المناهج، كأن تحاول إثبات حقيقة علمية من خلال مقولات دينية، أمر ليس في صالح هذه الحقيقة أو تلك.
الحقيقة العلمية مناطها التجريب في العالم المحسوس والملموس، والحقيقة الدينية مناطها الوحي من كائن سام على الوجود لمعرفة الوجود، أو ما هو شبيه بالوحي للوصول إلى ما لا تدركه العقول ولا يمكن التأكد منه، أو نفيه تجريبيًّا، والحقيقة الفلسفية مناطها منطق العقل وفق مفهوم صاحب البناء الفلسفي، والحقيقة الاجتماعية مناطها الثقافة السائدة في هذا الزمان أو ذاك، هذا المكان أو ذاك، ولكل حقيقة من هذه الحقائق وظيفتها التي إن تجاوزتها فسد كل شيء. فالحقيقة العلمية اليوم هي أساس كل هذا التقدم التقني الهائل في عالم اليوم، ومن أراد المنافسة في هذا العالم، فلا بد له من تبني هذه الحقيقة والإسهام في صنعها والإضافة إليها، فحضارة اليوم هي حضارة تقنية، بمثل ما كانت الحضارة الرومانية حضارة قانونية، والحضارة العربية الإسلامية حضارة لغوية فقهية، والحضارة اليونانية أو الإغريقية حضارة ذات أبعاد فلسفية، وحضارات ما بين النهرين حضارات أسطورية في المقام الأول، وإن كانت ذات إنجازات عملية معينة.
المراد قوله بإيجاز هو أن كل حضارة سادت في تاريخ البشرية، كانت تدور حول محور من الحقيقة، على اختلاف أنواعها، وللوصول إلى سر حضارة ما، لا بد من معرفة محورها الذي تدور به ويدور بها.
وإذا كان لكل حضارة محور رئيس تدور حوله، فهذا لا يعني انتفاء بقية الحقائق. فإذا كانت الحقيقة العلمية هي جوهر حضارة هذا العصر، فإن كل حقيقة أخرى وظيفة حيوية لا غناء عنها في حياة البشر. فالحقيقة العلمية مكَّنت وتمكِّن الإنسان من التحكم في الطبيعة وتسخيرها لصالحه من خلال مفهوم «التقدم»، الذي لم تعرفه الحضارات السابقة على حضارة العصر، ولكن الحقيقة العلمية لا تمنح «المعنى»، الذي من دونه يكتشف الإنسان أنه في النهاية يدور في دوامة لا أول لها من آخر، ويبرز في الخاتمة السؤال الوجودي الأهم: «ثم ماذا؟».
فالحقيقة العلمية لا تمنح إجابة لهذا السؤال، ولا هي قادرة على ذلك، فالسؤال وإجابته تنتميان إلى الفضاء الميتافيزيقي، وهنا يلجأ الإنسان إلى الدين أو الفلسفة أو حتى الأسطورة للإجابة عن هذا السؤال والبحث عن المعنى الكامن وراء كل شيء.
فالعلم لا يستطيع مثلًا الإجابة عن تلك الأسئلة الغيبية التي تلازم حياة الإنسان، مثل أسئلة: ماذا بعد الموت، أو هل العقل وحده قادر على اكتشاف المعنى وراء الأشياء، أو هل نحن أحرار فعلًا حين نتحدث عن الحرية، أم أنها، أي الحرية، مجرد وهم نحن فيه تائهون؟
الدين والفلسفة تمنح إجابات لمثل هذه الأسئلة الوجودية الكبرى التي تقع خارج دائرة العلم. بل إنه حتى الحقيقة الاجتماعية تسهم في الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، فالحقيقة الاجتماعية هي في النهاية مزيج من الدين وشيء من الفلسفة والعلم، والكثير من الأساطير المفسرة للمعنى الكامن وراء الأشياء، مثل أسطورة باندورا وصندوقها تفسيرًا لوجود الشر في العالم ونحوها. ولكن المعضلة تكمن في محاولات الدين، أو لنقُلْ مفسِّري ومؤولي الدين بشكل رئيس الدخولَ في منافسة مع العلم، وهنا تختلط المفاهيم وتضيع أهمية المناهج ووضوحها، ولكن هذا حديث آخر قد نستكمله لاحقًا.


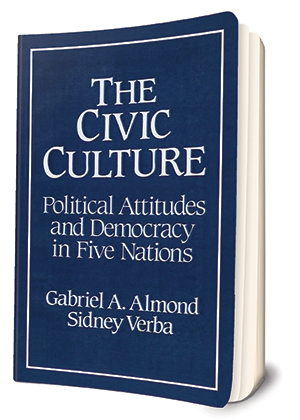 يقال إن رئيس العسكر المملوكي، سأل فقيه البلد، وهو يحمل رأس السلطان السابق المقطوع: «من هو السلطان؟ فرد الفقيه: السلطان هو من قتل السلطان». العنف هنا هو سيد الأحكام، وهو أمر قد تغلغل في الذهنية العربية عامة، وفي الثقافة السياسية العربية خاصة. وتداول السلطة لا يكون إلا بالعنف والقوة، ولا وجود لتداول سلطة سلمي أو مدني في تاريخ العرب القديم والحديث والمعاصر، إلا في لحظات خاطفة، لا تشكل إلا ومضات باهتة في تاريخ طويل يمتد.
يقال إن رئيس العسكر المملوكي، سأل فقيه البلد، وهو يحمل رأس السلطان السابق المقطوع: «من هو السلطان؟ فرد الفقيه: السلطان هو من قتل السلطان». العنف هنا هو سيد الأحكام، وهو أمر قد تغلغل في الذهنية العربية عامة، وفي الثقافة السياسية العربية خاصة. وتداول السلطة لا يكون إلا بالعنف والقوة، ولا وجود لتداول سلطة سلمي أو مدني في تاريخ العرب القديم والحديث والمعاصر، إلا في لحظات خاطفة، لا تشكل إلا ومضات باهتة في تاريخ طويل يمتد.


