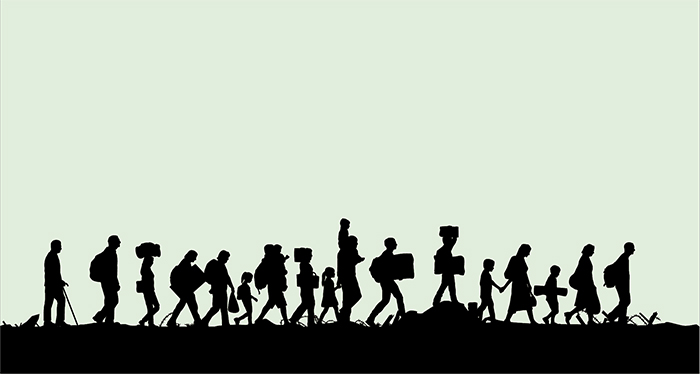سامر إسماعيل - صحافي سوري | ديسمبر 27, 2016 | كتاب الملف
ما يصح في السياسة قد لا تقبله الثقافة بمعناها المعرفي الواسع، فالتعدد الثقافي الإثني والمذهبي والطائفي في بلاد مثل سوريا كان على الدوام أحد أغزر المنابع الثقافية وأكثرها ثراءً وسط جغرافية تمتد بين بادية الشام مرورًا بالجزيرة السورية وصولًا إلى ساحل البحر المتوسط، ومن عين ديوار في أقصى شمال شرق سوريا إلى سهول حوران وجبل العرب جنوبًا. فلا السنة علب سردين مصفوفة بعضها فوق بعض، ولا الشيعة علب كبريت مصطفة بعضها فوق بعض، ولا المسيحي أو الدرزي عبوات كوكاكولا متناظرة في حجومها.
إن الخصومات التي مهدت لها النخب الحاكمة في المدن الرئيسة السورية، كانت على الدوام هي بذرة كل ما يحدث اليوم، كون معظم هذه النخب شكلت ما بعد الاستقلال عام 1946م نواة لبرجوازية وطنية جمعت أموالها من سرقة مواسم القمح والقطن يوم أن كانت لا تزال تمثل السلطة الإقطاعية الرسمية… هذا يحيلنا مباشرةً إلى طبيعة النص الذي أفرزته تلك النخب الهاربة، التي تركت الحبل على غاربه لنشوء برجوازية عسكرية عملت فيما بعد وعبر العديد من الانقلابات على تقليد سلفها البرجوازي، لكن هذه المرة عبر سرقة المال العام والهيمنة على امتيازات اقتصادية عملاقة داخل جسم الدولة. هذا النمط الاقتصادي من مراكمة الثروات جعل الصراع في سوريا دائمًا هو صراع بين الفقراء والفقراء. حرب يمولها الأغنياء بغض النظر عن الطائفة والمذهب والقومية. عائلات بعينها تسيطر على مقدرات البلاد، وتعمل ليل نهار على استنساب وريث دائم لثرواتها المنهوبة من قوت الجياع والمستضعفين والمغلوبين على أمرهم، والأهم من هذا وذاك هو استقواء هذه النخب الاقتصادية بالعائلة كمرجع نهائي يبتّ في أمور التجارة والصناعة وتحالفاتها مع شركات عابرة للجنسية والحدود الدولية، لصوص بلا حدود ترفعهم العائلة إلى مصافّ الأباطرة والمعصومين.
من هنا كانت الرواية السورية إشارةً قوية على عكس هذا الخراب العميم في إصداراتها. أقليات غنية مدعومة بعائلات أبدية في مواجهة أكثرية منكوبة ومحتقرة. لقد أسس هاني الراهب لهذه المفارقة في روايته «بلد واحد اسمه العالم» تمامًا كما هي الحال في روايته «الوباء» التي اعتمد فيها (الراهب) على تفكيك البنى القائمة ماركسيًّا في جدلية الدولة والعنف، مشرحًا القيم التي نشأ عليها الفقراء في الثقافات الفرعية، والتي برأيه «تتعارض مع قيم الطبقة المتوسطة التي اكتسبها الفلاحون والعمال وصغار الكسبة» متنبئًا بـ«مئة سنة قادمة ستكون عصر العنف، فضغط الدولة في العالم سيزداد، والخائفون سيخرجون من جلودهم ويصيرون مادةً للعنف. العنف الشامل وطغيان الدولة سيلغي القانون نهائيًّا، ويعيد الفقراء إلى وضع همجي، تفكك وانحلال، لكل قيمة وبنية وعلاقة»؟
نزاعات جانبية
 هذه النبوءة هي ما دفعت فيما بعد الكاتب سعد الله ونوس (1941- 1997م) لقراءة المدينة العربية المعاصرة من موقع الفقراء نفسه والشعور بغطرسة المركز على الأطراف، فنصوصه التي استلهمها من التراث العربي، وخصوصًا كتاب الليالي العربية «ألف ليلة وليلة» كانت جميعها تدور أحداثها في مدينة بغداد، على نحو «مغامرة رأس المملوك جابر» و«الملك هو الملك» حيث تحضر المدينة كفضاء للدسائس وحفلات التنكر، وسقوط الأقنعة، وقطع الرؤوس، في حقبة تاريخية وصفها المؤرخون بزمن «الشطار والعيارين» وتحالف السلطة مع عيونها وأصحاب شرطتها وجلاديها على الشعب ومصايره؛ فيما تحضُّر دمشق كمدينة تتألف في نصوص صاحب مقولة «محكومون بالأمل» من سجون ومواخير وأسواق وقلاع كما في مسرحيته «طقوس الإشارات والتحولات». ليصل الصراع إلى أشده في مسرحيته «سهرة مع أبي خليل القباني» النص الذي يعدّ مجابهة صادمة بين العقلية الرجعية وفن المسرح… مجابهة وضعت إشارات استفهام كثيرة على دور المدينة لمسؤولياتها الحضارية، لكنها لا تخلو من حزازات نخبوية مضمرة، تعلن انتماءها لقيم اجتماعية مرموقة، لكنها مواربة في تحديد موقفها من تطاحن «أكثريات ريفية فقيرة» و«أقليات مدن غنية»، وأسبقية سكان الثانية على الأولى. إذًا ليست الأقليات ولا الأكثرية، لا الغالبية المذهبية بل الغالبية السياسية التي تقهقرت عامًا بعد عام، لتجد النزاعات الجانبية ثغرات في هذا الجدار، ولتظهر فروقات هائلة بين عائلات ريفية وأخرى مدينية، أو انتمت إلى المدينة وتقمصت (الدمشقة) في سلوكها الحياتي ومظاهرها العامة، وصولًا إلى سيادة أخلاق السوق، وانهيار كبير للطبقة الوسطى في المجتمع السوري التي كانت تخفف من الغلواء بين جانبي الصراع، ما ظهر جليًّا في ازدياد أحزمة الفقر حول المدن الكبرى، من أحياء عشوائية يقعي فيها حطام هذه الطبقة المتوسطة السورية من متعلمين وحرفيين ومثقفين وعمال وموظفين حكوميين.
هذه النبوءة هي ما دفعت فيما بعد الكاتب سعد الله ونوس (1941- 1997م) لقراءة المدينة العربية المعاصرة من موقع الفقراء نفسه والشعور بغطرسة المركز على الأطراف، فنصوصه التي استلهمها من التراث العربي، وخصوصًا كتاب الليالي العربية «ألف ليلة وليلة» كانت جميعها تدور أحداثها في مدينة بغداد، على نحو «مغامرة رأس المملوك جابر» و«الملك هو الملك» حيث تحضر المدينة كفضاء للدسائس وحفلات التنكر، وسقوط الأقنعة، وقطع الرؤوس، في حقبة تاريخية وصفها المؤرخون بزمن «الشطار والعيارين» وتحالف السلطة مع عيونها وأصحاب شرطتها وجلاديها على الشعب ومصايره؛ فيما تحضُّر دمشق كمدينة تتألف في نصوص صاحب مقولة «محكومون بالأمل» من سجون ومواخير وأسواق وقلاع كما في مسرحيته «طقوس الإشارات والتحولات». ليصل الصراع إلى أشده في مسرحيته «سهرة مع أبي خليل القباني» النص الذي يعدّ مجابهة صادمة بين العقلية الرجعية وفن المسرح… مجابهة وضعت إشارات استفهام كثيرة على دور المدينة لمسؤولياتها الحضارية، لكنها لا تخلو من حزازات نخبوية مضمرة، تعلن انتماءها لقيم اجتماعية مرموقة، لكنها مواربة في تحديد موقفها من تطاحن «أكثريات ريفية فقيرة» و«أقليات مدن غنية»، وأسبقية سكان الثانية على الأولى. إذًا ليست الأقليات ولا الأكثرية، لا الغالبية المذهبية بل الغالبية السياسية التي تقهقرت عامًا بعد عام، لتجد النزاعات الجانبية ثغرات في هذا الجدار، ولتظهر فروقات هائلة بين عائلات ريفية وأخرى مدينية، أو انتمت إلى المدينة وتقمصت (الدمشقة) في سلوكها الحياتي ومظاهرها العامة، وصولًا إلى سيادة أخلاق السوق، وانهيار كبير للطبقة الوسطى في المجتمع السوري التي كانت تخفف من الغلواء بين جانبي الصراع، ما ظهر جليًّا في ازدياد أحزمة الفقر حول المدن الكبرى، من أحياء عشوائية يقعي فيها حطام هذه الطبقة المتوسطة السورية من متعلمين وحرفيين ومثقفين وعمال وموظفين حكوميين.
واقع معقد عكس صورة تحت مدينية في شؤون عديدة اختص بالقضاء والمحاكم الشرعية والأحوال الشخصية، ليدفع الكاتبة والأديبة روعة يونس إلى القول: «أبناء الأقليات أو المذاهب الذين يفضلون تبعية شؤونهم القضائية إلى غير القضاء الرسمي- وزارة العدل. أقصد تحديدًا: المسيحيين والشيعة والدروز، الذين يقصدون في تخاصمهم (المحكمة الروحية) لدى المسيحيين. و(المحكمة الجعفرية) لدى الشيعة. و(محكمة المشايخ) لدى الدروز. يُفترض بأتباع هذه الديانات والمِلل أن يوجّهوا ضرباتهم القاضية لرجال الدين- القضاة في تلك (المزارع) المسماة محاكم؛ لأنهم في معظمهم يمارسون (ظلمين) ظلم الدين وظلم رجاله، فضلًا عن الظلم المكتسب لدى البشر. وعدم اللجوء إليهم للتخاصم والاحتكام لديهم». إن شئتم بعض الجرأة، ولتكن وقاحة- تتابع يونس: «إن ظلم المؤسسة القضائية المتمثلة بوزارة العدل ومحاكمها أخفّ وقعًا على النفس من ظلم من يخبرك أنه ممثل المسيح، وممثل الإمام المهدي، وممثل الحاكم بأمره على الأرض».
الأقليات والأكثرية ومآلاتها
باستشهاد طويل لصبحي العمري، أحد الضباط الذين خاضوا غِمار الثورة ضد العثمانيين وشهد معركة ميسلون ضد الفرنسيين، يعكس فيه مسألة الأقليات والأكثرية ومآلاتها مع رحيل العثمانيين. إذ يقول العمري: «خرجنا من الحكم التركي ونحن متفرقون مفكّكون إلى مسلم، ومسيحي، وشيعي، وسني، وإسماعيلي، ونصيري، ودرزي… ومن القوميات الأخرى: تركي، وتركماني، وشركسي، وكردي، وألباني، وأرمني… وجميع هذه الديانات والمذاهب والقوميات مختلفة مع بعضها، كل منها تعتبر نفسها غريبة عن الآخرين، وتعتقد أنها مغبونة مهضومة الحقوق. فلقد كان المسيحيون بصورة عامة لا يزالون تحت تأثير الماضي. لقد كان المسيحي في العهد العثماني مواطنًا من الدرجة الثالثة، لا يشعر أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات، فلا يعقل أن ينقلبوا بمجرد خروج الأتراك قوميين عربًا، وينسوا كل ما مرّ بهم من مظالم وإهانات خلال تلك القرون الطويلة، وهكذا كانت أكثرية المسيحيين، غير مرتاحة للحكم الوطني، فبقوا أصدقاء لفرنسا؛ أما اليهود فهم شعب عدوّ لكل ما هو غير يهودي، يفضلون أن يكونوا تابعين لأي حكم أجنبي؛ والشيعة في حيّهم منكمشون يشعرون بغربتهم عن الأكثرية السنية، وقد لجأ عدد غير قليل منهم للحصول على الجنسية الإيرانية لتحميه من ظلم الدولة؛ والنصيرية في جبالهم منعزلين تحت وطأة الفقر والجهل والإهمال، لا يعرفون عن الحكم سوى أنه ضريبة إلى الجابي في يد الجندرمة (الدرَك)؛ وهكذا الإسماعيليون المرتبطون مذهبيًّا واجتماعيًّا بآغا خان؛ والدروز في مناطقهم الجبلية يشعرون بغربتهم عن جميع من يحيط بهم، وهم دائمًا في ريبة وعدم اطمئنان، والحكومة في نظرهم عدو متربص بهم. أما الأقليات العنصرية، كالأتراك والشراكسة والتركمان وغيرهم، فبقي ولاؤهم للأتراك، يعتبرون أن حركة القومية العربية، التي فصلتهم عن الأتراك المسلمين بالتعاون مع الإنكليز الكفار، حركة خائنة، ويتفق معهم بهذه الفكرة أكثرية رجال الدين المسلمين، والكثير من العامة».
في روايته «قصر المطر» يتعرض ممدوح عزام لهذا الموضوع راصدًا لأنماط عقائدية في محافظته السويداء – جبل العرب، مما دفع بعض المشايخ في الطائفة الدرزية التي ينتمي إليها الكاتب السوري عزام، إلى إصدار بيان بإهدار دمه بحجة أن «قصر المطر» أساءت إلى المجتمع الدرزي وأخلاقه، وشوهت عاداته وتقاليده ومقدساته وأبطاله الأسطوريين. طالب هذا البيان الذي وقّعه مشايخ طائفة عقل الدرزية الحكومة السورية بمنع تداول روايته وسحبها من الأسواق، علمًا بأن الرواية صادرة عن وزارة الثقافة السورية عام 1998 وقال البيان: إن الرواية والراوي على السواء شوَّها أبطال التحرير الأسطوريين أمثال (سلطان باشا الأطرش).
تجاهل الإعلام السوري وقتها هذا البيان وردود الأفعال الأخرى عليه، مثل بيان المثقفين للتضامن مع الكاتب. على حين غض النظر اتحاد الكتاب العرب آنذاك عن هذا الحدث، ولم يتضامن مع الكاتب، بل دعاه إلى طلب الغفران والتراجع عما فعل ومصالحة شيوخ طائفته. مازن عرفة في روايته «وصايا الغبار» يذهب أيضًا إلى استعراض واقع عيش الأقليات من خلال قصة حب يرويها بين شاب دمشقي من الطائفة السنية وبين فتاة من الطائفة الدرزية، تنتهي قصة العاشقين بزواج الفتاة من رجل ينتمي إلى طائفتها. الواقع الفني الأدبي للرواية السورية يزخر بهذه الأمثلة، ومنها روايات كل من روزا ياسين حسن «أبنوس» ورواية سمر يزبك «طفلة السماء» ورواية «تجليات جدي الشيخ المهاجر» لحسيبة عبدالرحمن؛ إذ تناقش كل من الروائيات السالفة الذكر موضوع التقمص والدين عند الطائفة العلوية.
حق منح الهوية الوطنية للأقليات

ممدوح عزام

سمر يزبك
«واحد واحد واحد… الشعب السوري واحد» أظنه شعارًا كشف وحشية ولا إنسانيّة الحرب السورية، وهو من أكثر الشعارات افتراء على الحقيقة والواقع، يقول الكاتب والناقد ياسر إسكيف ويتابع: «لم يعنِ هذا الشعار سوى إعلان أكثرية عن ملكيتها الحصرية لحق منح الهوية الوطنية للأقليات. فالشعب السوري لم يكن يومًا كتلة متجانسة ومتماسكة. فالشعب الواحد مقولة فارغة من أي معنى، أو محتوى، بعيدًا من وعي المواطنة في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية. وهذا ما لم يعرفه، أو يختبره، السوريون يومًا. وكان المجتمع السوري، تاريخيًّا، أكثريّة عربية مُسلمة (سنيّة)، وأقليّاتٍ دينيّة، وقومية، ومذهبيّة، تتعايش فيما بينها وفق علاقة، أو علاقات، مُركّبة ومُعقّدة. حيث تتقاطع هذه الأكثرية قوميًّا مع الأقلية المسيحية العربية، ومع الأقليات المذهبية الإسلامية. بينما تتقاطع إسلاميًّا مع أقليات أخرى (أكراد، وتركمان، وشركس) وتتباعد، أو تتناقض، كما في حالة الأكراد، قوميًّا».
إن الخصوصيات الثقافية هي الطاغية في التمييز بين الأكثرية والأقليات السورية، إذ لم تتوقف تلك الأقليات عن إنتاج مجموعتها الخاصة من القيم والمعايير، كما الأعراف والتقاليد والطقوس، وتجلى هذا بشكل شديد الوضوح في النتاجات الإبداعية (أدبًا وفنًّا) التي عكست فضاء الحريّة الذي تمنحه تلك الأقليات لأفرادها، من ناحية أنها بالأساس تكوّنت على المُفارقة والاختلاف والتمايز. ومن اللافت بهذا الخصوص حجم المُكابدة التي عانتها اللغة في الخروج من استنقاعها وتخثّرها لتتمكن من قبول واحتواء المُختلف من التصوّرات، والرؤى، والمشاعر، والأحاسيس، حتى بدت في أحيان كثيرة غريبة عن نفسها، أو مُختطفة منها، حتى إن بعضهم قد رأى في هذا تخريبًا للغة، أو أن اللغة ذاتها قد تواطأت مع خرابها وسعت إليه. وبالتالي لا أظنها مصادفة أن يكون، على سبيل المثال لا الحصر كل من أدونيس، وحنا مينة، وسعد الله ونوس، وسليم بركات، وممدوح عدوان، ممن ولدوا في بيئات تعود للأقليات.

سامر إسماعيل - صحافي سوري | نوفمبر 6, 2016 | تحقيقات
مشاهير السرقات الأدبية ماتوا جميعًا بعد أن أصابوا من «كتاباتهم» ما أصابوه في مشارق الأرض ومغاربها، يكفي فقط أن نقرأ كتاب «الكوميديا الإلهية» لدانتي (1256-1321م) حتى نعرف حجم السرقة الموصوفة للأديب الإيطالي من «رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري، و«الفتوحات المكيّة» لمحيي الدين بن عربي؛ الكتابان اللذان تُرجِما من العربية إلى «القشتالية» عام 1264م على يد الطبيب اليهودي إبراهيم الحكيم، بأمر من ملك قشتالة ألفونسو العاشر. لكن السرقات الأدبية أخذت شكلًا وتعريفًا «أدبيًّا» مغايرًا فيما بعد بين «تناص وتلاص»، وترجمة ونسخ، ونقل وتقليد، ومعالقة ومعارضة ومحاكاة؛ وهذا يجعل البحث هنا عن «الأصالة» ضربًا من المستحيل؛ فالبشر جميعهم «ورثة» من بعضهم الآخر بطريقةٍ أو بأخرى، على حد تعبير الفيلسوف الألماني نيتشه.

مافيات الصحافة الثقافية
ظاهرة السرقات الأدبية والفنية والإبداعية العربية عمومًا اكتست اليوم لبوسًا مختلفًا في التزوير والتحريف والسطو على المكتبة العالمية؛ ففي عصر «الميديا» المفتوحة، ومافيات الصحافة الثقافية الإلكترونية، وأبطال المدوّنات، وأدباء الفيسبوك، ونسخ موقع «غوغل» لملايين الكتب وتخزينها لصالحه من دون الاكتراث بحقوق مؤلفيها، أو الامتثال للدعاوى القضائية المرفوعة ضد القائمين على محرك البحث الأشهر في العالم من مئات الكتّاب وورثتهم؛ بسبب هذا وغيره بات من الصعب الحصول على «النسخة الأصلية» من دون تشويهات تُبذل على مدار الساعة في كل أرجاء الكوكب.
يتعرض النص الأصلي باستمرار إلى تحوير ممنهج يجعل من مهمة معرفته – حتى من أصحابه أحيانًا- أمرًا صعبًا جدًّا؛ كأن النسخة الأصلية باتت «خطيئة أصلية» في عرف من يحاولون إخفاء سرقاتهم وتمويهها؛ ناهيك عن مجموعات المترجمين الأحرار الذين لا يخضعون لأي سلطة معنوية أو قضائية تحدّ من نقلهم لذخائر المسرح والسينما والرواية والقصة إلى غير لغاتها الأصلية، ومن دون حسيب أو رقيب.

حسن م. يوسف
الكاتب السوري حسن م. يوسف يعرّف السرقة الأدبية بأنها: «أخذ ما للغير خفية، والسرقة الأدبية هي قيام أحد ما بنسخ نص أبدعه شخص آخر وتقديمه على أنه له. والحق أن هذا المصطلح يخضع لتأويلات شتى حتى ضمن إطار الثقافة الواحدة»، ويتابع يوسف: «من المعروف أن مبادئ حقوق المؤلف لا تحمي الأفكار، وإنما تحمي تعبير المؤلف عنها، إلا أننا نقرأ ما يشي بأن هذا المصطلح اكتسب طبيعة مطاطية؛ لأن كل مستخدم يعطيه ما يناسب وجهة نظره، حتى بات يختلف باختلاف المصالح كما مصطلح الإرهاب تمامًا!».
قبل سنوات نشرت الباحثة الإنجليزية آندي ميدهيرست دراسة لافتة في الملحق الفني لجريدة «الأوبزيرفر» الصادر يوم الأحد 4 أيلول «سبتمبر» 1994م، بعنوان «الرائعون السبعة، يستمرون ويستمرون»، وقد قالت في مقدمة بحثها: «لم تعد هناك أفكار جديدة، هناك طرق مختلفة لقول الأشياء نفسها». وبعد ذلك تشير الباحثة إلى سبع حبكات أساسية تكمن في قلب أي نوع من الكتابة النثرية. وهي تورد تلك الحبكات من خلال أسماء أشهر الأعمال التي تعبّر عنها: حبكة روميو وجولييت، حبكة الطرف الثالث، حبكة العنكبوت والذبابة، حبكة الضعف القاتل، حبكة الصفقة الفاوستية، حبكة كانديد أو انتصار البراءة، حبكة ساندريلا.
يتفق الأديب حسن م. يوسف مع كلام الباحثة الإنجليزية فيما ذهبت إليه: «الفنانون الأوائل، كما الجغرافيون الأوائل، اكتشفوا الحبكات الكبرى كلها، والقارات كلها، ونحن الآن، في الجغرافيا والفن، نعيش عصر اكتشاف التفاصيل! ما يؤسف له هو أن طلاب الشهرة سوقوا دسائسهم الأدبية كسرقات، فقاموا باتهام أهم الكتاب والأدباء العرب بالسرقة، بهدف سرقة الأضواء منهم، وقد طالت اتهامات هؤلاء المتنبي وطه حسين ومحمد مندور وإبراهيم ناجي وأدونيس».
سرقات خبيثة وأخرى حميدة!
الشاعر والمسرحي التونسي حكيم مرزوقي يدعو إلى إقامة «مرصد أدبي» يشهّر من خلاله بكل من يسطو على متاع الآخرين، وينسبه إلى نفسه في مختلف حقول الأدب والفكر والفن، أسوة بتلك المراصد التي تنشط في المجتمعات المدنية، وتتعقّب الانتهاكات الحقوقية فتفضح مرتكبيها في الدول والمؤسسات. ويعقب مرزوقي: «قد يبتسم ويسخر في سرّه كل من يعتبر الأمر دعوة طوباويّة، وضربًا من (الفذلكة الثقافية) في مجتمعات تنخرها شتى الأمراض ما عدا (أحمدها وأنبلها) في التهام الكتب، وإدمان حشيشة الفن والمعرفة؛ وقد يذهبون معي بعيدًا ويفرضون جدلًا أنّ المراصد الأدبية قد أُقيمت على قدم وساق وقلم. وأُحصِي المتلبسون من (اللصوص الأذكياء)، والزجّ بهم ضمن لوائح سوداء قصد التشهير، وردع كل من تسوّل له نفسه (الطمّاعة الذوّاقة) الاعتداء على أصحاب الأكفّ الناعمة من (بروليتاريا) الإبداع، فتعيد للأقلام حقها قبل أن يجفّ حبرها وتعود إلى غمدها».
لكن هل ستُفتح غرف التحقيق، وتُقام المحاكم، وتنصب المقاصل للأقلام المزوّرة، فينصف المعتدى عليه، ويمكّن من استرداد حقوقه المعنوية والمادية؟ يتساءل حكيم المرزوقي ويجيب: «الحقيقة التي لا تقبل الجدل هو أنّ فعل السرقة وآلياتها ومحرّضاتها النفسية والاجتماعية واحدة من حيث هي رغبة كامنة، وسعي للتفوّق المادي والمعنوي على الآخر؛ عبر الاعتداء على ممتلكاته من دون اعتبار أخلاقي أو رادع قانوني؛ وبتواطؤ مع مؤسسات اجتماعية ضمن منظومة فساد واضحة لا غبار عليها».
يقول فقهاء القانون: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني؛ لكن جرائم السطو الأدبي استمرت وتستمر حتى بعد سن القوانين الخجولة في الملكية الفكرية التي ظلّت ترفًا حضاريًّا في سوريا وغيرها من البلاد العربية؛ مجرد نمر ورقيّ وبلا مخالب، كما غابت العقوبات إلا فيما ندر، ذلك أنّ هذه النصوص جاءت في البلاد العربية كنوع من ذرّ الرماد، والتبجّح بأننا أمة تحترم المبدعين، وتدافع عنهم.
مسألة يرى فيها الأديب التونسي حكيم المرزوقي: «أنه لا بأس من غضّ الطرف فيما يخص الملكية الفكرية المتعلّقة بمنجزات عالميّة من شأنها أن تنقذ مجتمعات فقيرة بكاملها من الأوبئة كاللقاحات الدوائية، أو تتعلّق بأمنها الغذائي وثرواتها الطبيعيّة؛ إذ إنني لا أرى حرجًا إطلاقًا في عدم الاستجابة لجشع الشركات المحتكرة ذات النشاط الربحي. كما لا أجد مانعًا من تحويل النصوص العالمية إلى أعمال درامية محليّة من دون التغافل عن ذكر المصدر لدى المتخصّصين؛ فما زلت أنتصر لنظرية روبن هود وطرفة بن العبد في جدوى العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة عبر افتكاكها من خزائن المترفين لا من أدراج المبدعين طبعًا… ألم يكن هؤلاء الصعاليك مبدعين؟ فلماذا لم تسرق منهم جذوة الإبداع في العصور الحديثة المتسمة بثقافة الطمع والجبن؟».
لقد كان العرب على حق في تقديرهم لمبدأ «الاقتباس»؛ ذلك أنّ هذا المصطلح جاء من فعل اقتناء قبس النار من خيمة نحو الأخرى؛ كي تعمّ الفائدة وتُضاء مضارب القبيلة، وكذلك الشأن في مصطلح «الاستنباط» الذي يعود أصله إلى حضارة العرب الأنباط في منطقة وادي موسى، وعليه فقد سمّي كل تطوير في شؤون الدولة والمجتمع استنباطًا، خصوصًا في بدايات العصر الأموي؛ أمّا «التضمين» و«الاستعارة» و«المعارضة» في الشعر العربي القديم فتنمّ عن نبل في الإشارة إلى المصدر؛ لكنّ «التناص» الحديث كثير منه سرقة مبرّرة وغير موصوفة، وكان الأجدر تسميته بـ«التلاص».
موسوعة للسرقات

خليل صويلح

ناظم مهنا
«لا أعلم مصير (موسوعة السرقات الأدبية) التي أُعلن عن قرب صدورها قبل سنوات»، يقول الروائي السوري خليل صويلح، ويضيف: «لكنني علّقت على هذا الخبر وقتها، بأنها الموسوعة الوحيدة التي لا يتمنى كاتب عربي أن يجد اسمه في فهرسها. أظن أن (غوغل) لجم مثل هذه الاعتداءات، نظرًا لسهولة كشفها، وانتفاء المسافات بين الجغرافيات المتباعدة، بسطوة الميديا، على رغم أن محاولات الانتهاك لم تتوقّف، أقله في الشوارع الخلفية للكتابة، عن طريق كتّاب مغمورين لا يمتلكون رصيدًا سابقًا يخشون إهداره». اليوم هناك نوع من اللصوصية المضمرة، وذلك بتحويل فلم أجنبي إلى رواية، بإضافة توابل محليّة على الحدث، بقصد إخفاء معالم الجريمة، أو اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي ولطش شذرة من هنا وشذرة من هناك، من دون ذكر صاحبها، لمآرب عاطفية لا تتعدى الحائط الهش للموقع، يعقب خليل صويلح، ويقول: «ربما كان (ماريو) بطل رواية أنطونيو سكارميتا (ساعي بريد نيرودا) من أروع لصوص الأدب؛ إذ كان يهدي حبيبته مقاطع من شعر نيرودا لتعزيز علاقته بها، قبل أن تكتشفه أمها، وتدمّر شاعريته المستعارة. لكنني أظن أن فوضى ما نعيشه اليوم، جعلت من السرقة الأدبية في حالة اكتشافها، مجرد وجهة نظر، وليست خيانة، بدليل انطفاء مثل هذه الانتهاكات بسرعة، ليعود أصحابها إلى الساحة ببزة أدبية جديدة، وكأن شيئًا لم يحدث».
سرقة مع بعض التضليل
القاص والأديب ناظم مهنا يعقب على الموضوع ساردًا حكايته أيضًا مع السرقات الأدبية: «منذ أيام قليلة مضت، أنهيتُ قراءة كتاب مترجم يتجاوز السبعمائة صفحة، اشتبهت بترجمة الكتاب، وتذكّرتُ أن في مكتبتي طبعة قديمة للكتاب نفسه بجزأين لمترجم آخر من بلد آخر، وأن الترجمة مسروقة مع بعض التضليل، وهذا مشين، لا سيما أن الترجمة المسروقة صادرة عن مؤسسة نشر رسمية قد تفقد مكانتها إذا ما استمرت في التهاون بهذه الأمور». السرقات الأدبية أمر شائع جدًّا في التاريخ الأدبي، وقد أفرد لها النقاد العرب القدامى صفحات عديدة في كتبهم، ويكاد لا يخلو كتاب نقد قديم، بقليل أو بكثير، من ذكر هذا الداء- يضيف القاص السوري مهنّا ويتابع: «ابن رشيق يتحفنا بأنواع عديدة من السرقات في كتاب (العمدة) منها: الاصطراف، والاجتلاب، والانتحال، والاهتدام، والإغارة، والمرافدة، والاستلحاق، وكلها قريب من قريب في باب السرقات. ومنها عند بعضهم: الاختلاس، والعكس، والمواردة (التوارد)، والتلفيق، والالتقاط، وبعضهم يسميه الاجتذاب والتركيب. وابن الأثير جمعها في ثلاثة أقسام: نسخ: أخذ اللفظ والمعنى. وسلخ: أي أخذ بعض المعنى. ومسخ: أي إحالة المعنى إلى ما دونه». بعض النقاد خفف من قسوة المصطلح فقال ابن قتيبة بـ «الاحتذاء أو الأخذ». ورأى ابن رشيق أن اتكال الشاعر على السرقة بلادة وعجز، وتركه كل معنى سُبق إليه جهل، وخير الحالات الوسط، والمخترع له فضل الابتداع، غير أن المُتبع إذا تناول معنى فأجاده في أحسن كلام؛ فهو أول من مبتدعه، وله فضيلة حسن الاقتداء. وثمة من رأى منهم أن من أخذ معنى عاريًا، فكساه لفظًا من عنده، كان أحق به. إلا أن عبدالقاهر الجرجاني- كما يقول الأديب ناظم مهنا- رفض هذا لانعدام وجود معنى عار من لفظ يدل عليه، ولشكّه بإمكان أن يأتي أحد بلفظ من عنده لمعنى من المعاني، وأن التغير في اللفظ يتبعه تغير في المعنى والعكس أيضًا.
شعراء كبار اتهموا بالسرقة
شعراؤنا الأقوياء جُلُّهم اتهِموا بالسرقات! من امرئ القيس، مرورًا بأبي نواس، وأبي تمام، والبحتري، والمتنبي، وحتى أدونيس. إنما لا بد أن نميز السرقة الأدبية المذمومة، من التأثر الذي تتوالد منه السلالات الأدبية وتتفاعل- يشرح الكاتب ناظم مهنا وجهة نظره في ذلك قائلًا: «على رغم تداخل الحالتين أحيانًا يكون الخيط الذي يفصل بينهما واهيًا؛ ففي نصوص الحداثة وما بعد الحداثة، يأخذ التفاعل بين النصوص أشكالًا متعددة من التضمين أو عملية ابتلاع وهضم نصوص أخرى في نص واحد، ويعدّ بعضهم هذا سرقة. وفي ذاكرتي عشرات الشواهد التي عاصرتُها وسمعتُ بها عن سرقات أدبية تبلغ وقاحتها حد الطرافة، فلقد تعرّضتُ لحالتين مختلفتين من هذا التماس بين السرقة والتفاعل لا مجال ولا جدوى من الخوض فيهما؛ إلا أنه لا يشغلني كثيرًا موضوع السرقات الأدبية، ولا توجد ملكية خاصة للأفكار، وكما قال الأسلاف: المعاني مطروحة في الطرقات لمن يشاء. إلا أنني أرى أن على الكاتب أن يكون مخلصًا لمخيلته ولشخصيته. وأعتقد أن السرقة بشكلها البشع والوقح شائعة اليوم في عالمنا الصفيق، العدواني إلى هذا الحد، حيث كل شيء فيه مباح بما في ذلك الحياة ذاتها!».
السارق قاضيًا

نذير جعفر

إبراهيم المصري
من المفارقات العجيبة أن كثيرًا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم «السرقات الأدبية»، أو «معًا ضد السرقات الأدبية» تضم عضوية بعض لصوص الأدب والترجمة المشهود لهم! وشر البلية ما يجعل السارق قاضيًا! فكم هو واطئ حائط الأدب والفكر والفلسفة والعلم! – يعلق بدوره الناقد نذير جعفر متسائلًا: «كيف للص أميّ مبتدئ أن يحسب ألف حساب لسرقة مادية عينية صغيرة، ولا يتوانى لص «مثقف» عن سرقة شكسبير أو نجيب محفوظ أو أدونيس أو لوتريامون أو رامبو أو الحلاج بضغطة واحدة في وضح النهار! لا بل سرعان ما يُنصّب ذلك اللص (المثقف) نفسه قاضيًا، ويوجّه التهمة لهؤلاء الذين سرقهم ليبعد الشبهة عما اقترفه بحقّهم!».
كثير مما يسمى سرقات أدبية في التراث ليس سوى تناص وتوارد صور وأفكار وتشابه في سياق التجارب الإنسانية، ومع ذلك عدّه القدماء سرقات، ولم يتساهلوا مع أصحابها سواء على مستوى بيت من الشعر أو مطلع قصيدة أو صورة بيانية، أما اليوم فهناك سرقات موصوفة كاملة لكتب بعينها، وأبحاث، ورسائل جامعية، ودواوين شعر، وهي تمر دون ضجيج لأن هذا الحقل، حقل السرقات الأدبية بات ملتبسًا ومشبوهًا، بسارقيه ومسروقيه وشهوده وقضاته! لا بل إن كثيرًا ممن يدعون سرقة نتاجهم أو يسرقون نتاج غيرهم ليسوا سوى متطفلين على الإبداع، وغايتهم لفت الأنظار، أو تحقيق ربح ما، أو نيل شهادة ليس غير! حتى قوانين الملكية الفكرية لم تُفعّل في بلادنا حتى الآن لإحقاق الحقّ! فمن يملك شرعية توجيه الاتهام أو الحكم بالبراءة؟
قرصنة
سوف يُنظر إليكَ على أنك تُلقي مزحة، لو تحدثت عن (حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي) – يقول الشاعر والروائي المصري إبراهيم المصري: «تلك الحقوق المتصلة بإنتاجٍ أصيلٍ ينتجه إنسانٌ ما أو يخترعه، وإذا كانت هذه الحقوق واضحة الحدود إلى حد كبير في شأن المنتجات الصناعية على سبيل المثال، فإنها تكاد تنعدم في المنتجات الإبداعية، إذ عدا السرقة المباشرة التي يتم فيها سرقة كتاب بالكامل أو بعض فصوله، فإن الغموض هو السائد في عدد لا يُحصى من السرقات، لا تتطلب أكثر من تمويه أو إعادة صياغة، ليصبح ثمة مُنتج جديد لم يتعب صاحبه في إنتاجه. لكن حتى لو أمسكنا أحدًا بالجُرم المشهود، فمن سيحاكمه أو يحاسبه؟ حتى لو حُوسب قضائيًّا، فإنَّه يظل طليقًا بعد أن يدفع غرامة على سبيل التعويض، وثمة حكاية تم تداولها مدة طويلة عن (شاعر مصري مشهور تلفزيونيًّا) سرق كما قيل نصوصًا من شاعر آخر في صعيد مصر، وهذه النصوص مصنفة ضمن (فن الواو) أحد فنون القول الشعبي في الصعيد، وبعد الحكم على الشاعر الذي قيل إنه سرق وتغريمه خمسة آلاف جنيه، حكمت محكمة النقض بعد ثلاث سنوات من الجدل حول هذه القضية ببراءة الشاعر، إذ يُعدُّ من (الشطارة) في بلد كمصر أن تدوس القانون وتعبر عليه إلى مصلحتك الشخصية. وإذا خرجنا من السرقات الأدبية والفكرية إلى عالم النشر العربي، فماذا يمكن أن نقول عن الطباعة اللاقانونية للكتب، إلى حد أن روائيًّا مصريًّا مشهورًا يشكو من أنه يجد نسخ روايته المزيفة طباعيًّا أي (المقرصنة بالفعل) مطروحة للبيع على بسطات باعة الصحف في القاهرة!».
محمد مظلوم: تعرضت لأنواع من السرقة

محمد مظلوم
يرى الكاتب والشاعر العراقي محمد مظلوم أن عبارة (سرقة أدبية) تنطوي على «تناقض داخلي في هذا التضاد الظاهر بين الصفة والموصوف، فالسرقة تتناقض مع الأدب بوصفه إبداعًا، لذا لا يمكن للسرقة أن تكون أدبًا، مع أنها ترقى أحيانًا إلى أن تغدو ضربًا من الإبداع المحتال! النقاد العرب القدامى انتبهوا لهذا الجانب فكانوا متشدِّدين فيه، فصنَّفوا حتى السرقات في المعاني نوعًا من الإغارة والغزو بما تحمله من معاني السلب والنهب، وحتى القتل والأسر! وبخاصة عندما يكون المعنى المغار عليه شخصيًّا ومبتكرًا، وليس معنى عامًا مبذولًا. في تجربتي الكتابية واجهت هذا النوع من الاستحواذ غير الشرعي على عبارات وأفكار معينة بدرجات متفاوتة في نصوصي وكتاباتي الأخرى، لكنني لم أحفل للأمر كثيرًا، حتى إنني أوجدت لبعضها مبررًا من دون التدقيق في سوء النوايا المحتمل، فأحلتها إلى الإعجاب والتأثر وحتى التخاطر!».
في لحظتنا الراهنة انتعشت قضية السرقات الأدبية مع انتشار وسائل التواصل الحديثة لتبلغ مبلغًا خطيرًا، وسط هذا الكم المخيف من النصوص المتناسخة، ولا أقول المتشابهة حتى «تشابه البقر علينا» في ظلام هائل معبر عن ظلامية ثقافية راهنة. وهي ظاهرة استشرت ولم تجد من يرصدها أو يدينها، حتى أصبحت جزءًا من أخلاق العصر _ يضيف الشاعر العراقي متابعًا: «مع شيوع تقنيات (النسخ واللصق) في وسائل الكتابة الحديثة أصبح الأمر أقل عناءً من (الإغارة)، ولم يعد السارق بحاجة حتى إلى نسخ ما يسرقه بالقلم والورقة ليخطر له إبدال عبارة أو كلمة أو حتى فاصلة! وهنا لم نعد نتحدّث عن نصوص وأفراد، بل ثمة مؤسسات ومنابر قامت على هذا النوع من الاستيلاء غير الشرعي». بيد أن هذا النوع من السرقات يبقى ضربًا ساذجًا من السرقة، وما لصوصه سوى ضحايا لغوايات النص الآخر، ففي نهاية المطاف لا يمكن الاستحواذ التاريخي على نص الآخر. فالنص كالذكورة والأنوثة لا يمكن أن تُسرق، بل يمكن أن تشوَّه وتمسخ فحسب!
في موازاة هذا النوع ثمة سرقات أخرى يصفها محمد مظلوم «بأنها سرقات محترفين، كأن يقوم أحدهم بسرقة جهدك اعتباريًّا وماديًّا، وتسويقه في عمل يدر عليه مردودًا ماديًّا، هذا النوع من السرقة تعرضت له كذلك، وهو لصوصية صريحة من دون أدنى مواربة نقدية، فهي لا تحتمل الكثير من مقولات التناص والتأثر والتخاطر والقصة المأثورة عن الحافرين!».
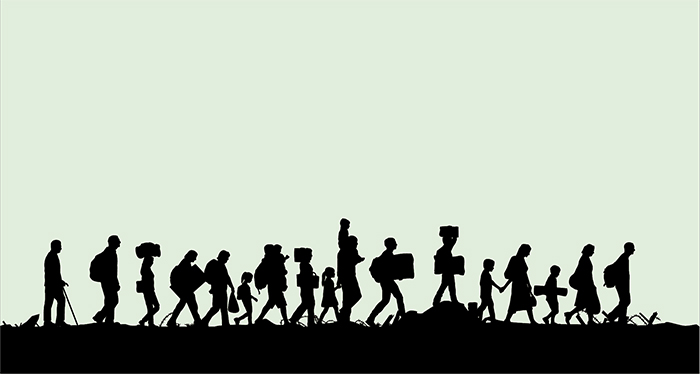
سامر إسماعيل - صحافي سوري | أغسطس 30, 2016 | الملف
لا تزال الحرب تُنبئ بتداعياتٍ كثيرة على مستوى الكتابة الجديدة في سوريا، فمن «هجمة الستينيات» التسمية التي أطلقها الشاعر شوقي بغدادي على جيله في تصديره لأنطولوجيا الشعر السوري المعاصر، مرورًا بـ«منعطف السبعينيات» أكثر المراحل تمردًا على القوالب الشعرية الجاهزة كما أطلق عليها الشاعر منذر مصري، الذي أصدر في الحرب كتابه اللافت «لمن العالم» (دار نينوى- 2016م)، وصولًا إلى شعراء الحرب في عامها السادس، والانقسام الذي أصاب النخب الأدبية بين داخل وخارج، نلحظ ثيمات جديدة لنصوص مفخخة حملت لعنة الاقتتال الدائر، مثلما حملت وزر أحلامها المنكوبة.

جمال شحيد
فالشعر السوري المعاصر وجد انحسارًا في السنوات الأخيرة، في رأي الناقد جمال شحيّد الذي يقول: إن «الرواية أخذت حيزًا كبيرًا ومهمًّا في الثقافة العربية؛ إذ إن الانحسار الذي تم للشعر عوضت عنه الرواية ولو كان جزئيًّا؛ لكن موت الشعر في بعض البلدان الأوربية والمجتمع الاستهلاكي لا يعني موته في بلداننا، فالشعر في سوريا ما زال إلى حد ما بخير رغم النكسة التي حصلت لهذا الفن الأدبي العظيم، علمًا بأن شعوب العالم الثالث بشكل عام تهتم بالشعر، فكل شاب في مرحلة حياته وبخاصة مرحلة المراهقة يكتب شعرًا كون القصيدة في النهاية هي تعبير عن الحياة والإنسان، وبحاجة لأن يعبّر عن مشاعره وأحاسيسه فيبدأ بالشعر ويتركه عندما ينضج إذا أراد». ويضيف الناقد شحيّد أنه شخصيًّا بات متأكدًا من أن الحرب التي تمر بها سوريا أنتجت شعرًا جميلًا، «فالشعر يصبح نشيطًا في الأزمات».
لم ينج الشعر السوري بطبيعة الحال مما ألمّ بالوطن برمته من كوارث. وكما انقسم الوطن إلى شظايا انقسم الشعر وشعراؤه إلى شظايا، يقول الشاعر تمام تلاوي المقيم حاليًّا في السعودية ويضيف: «ثمة شعراء وقفوا إلى جانب النظام، وآخرون وقفوا إلى جانب الحراك، وآخرون اختاروا الحياد، وثمة من آثر الصمت. وتبعًا لهذه المواقف جاءت أشعارهم، على أن هنالك من صمت عن قول الشعر ليس لأنه لا موقف له مما يحدث، وإنما لأن الكارثة ألجمت لسانه. ولا ملام عليه، فمن يستطيع النطق أمام كارثة كهذه، سوى أشخاص لديهم قدرات استثنائية على الكلام، فكلما اتسعت الكارثة ضاقت العبارة».
إننا نحتاج زمنًا حتى نستوعب هول الصدمة، نحتاج زمنًا حتى نستطيع أن ننظر بعين شاعرية إلى هذا الخراب العميم وهذا الموت المجاني وهذا التشرد المليوني عبر الحدود والبحار- يستطرد الشاعر تلاوي الحائز على جائزة الشعراء الشباب في دمشق عاصمة للثقافة العربية 2008م: «على المستوى الشخصي كان موقفي واضحًا منذ البداية مع التغيير السلمي ولاحقًا ضد السلاح وضد الأسلمة؛ لأنني أعتقد أن الموقف الأخلاقي والثقافي والوطني يجب ألا يكون منحازًا إلا لما يخدم مصلحة الوطن والتغيير نحو الأفضل بالوسائل الوطنية والسلمية التي لا تؤدي إلى مزيد من القتل والخراب، فكتبتُ قصائد عدة تتناول في الأساس البعد الإنساني لما آلت إليه حال الإنسان السوري منذ آذار 2011م، كما كتبتُ عن الموت وعن الهدم وعن التشرد وعن الشرخ الإنساني الذي جاء نتيجة للشرخ على المستوى الوطني».
ثمة شعراء كثر تهجّروا في المنافي، وكانوا في معظمهم مؤيدين للحراك، وكتبوا له وغنوا لشهدائه. ومنهم من التحق بالعمل الإعلامي أو الميداني، وهم شعراء مبدعون ومعروفون على نطاق واسع، بينما ظل معظم الشعراء المحايدين أو المؤيدين داخل سوريا- يضيف صاحب ديوان «تفسير جسمكِ في المعاجم»: ثمة شعراء استشهدوا بالقصف كالشاعر محمد وليد المصري، أو استشهدوا بسكين داعش كالشاعر بشير العاني، وشعراء آخرون اعتقلوا كالشاعر وائل سعد الدين الذي أفرج عنه النظام مؤخرًا، وثمة شعراء تهجّروا من بيوتهم ومدنهم أو هربوا، وهؤلاء أسماؤهم لا حصر لها. الشعر السوري في رأيي الشخصي حاليًّا يشبه مصاير هؤلاء الشعراء، فهو إما شاعرٌ مقتول أو أسير أو مهجّر أو هارب».
الشِّعر يقود المرحلة

زيد قطريب
الشاعر زيد قطريب الذي أدار وأشرف في سنوات الحرب على ملتقى «ثلاثاء شعر» في العاصمة السورية منتجًا عنها أنطولوجيا بعنوان «شعراء تحت القصف» باللغتين العربية والألمانية له رأي أقل تشاؤمًا في هذا السياق؛ إذ يقول: «نحن أمام انعطافة كبيرة على صعيد النص الشعري، سوف تتبلور لاحقًا لكن متى؟ لا أحد يعرف بالضبط! هذا الأمر تؤكده كثير من النصوص المكتوبة من أجيال شعرية مختلفة، فالمسألة لا تتعلق بالشعراء الشباب كما يتخيل البعض. هذه الانعطافة لا يُقصد بها حضور ألفاظ الحرب وأسماء السلاح ومفردات الانفجارات وأصوات الرصاص؛ لأن حضور هذا المعجم أمر طبيعي، ولا يمكن أن يعد انعطافة أو تجديدًا. إنما هناك انعطافة كبيرة على صعيد المعنى والشكل في آن واحد، فهذه الحرب كانت مناسبة لاستيقاظ كل الأسئلة الفكرية والفلسفية المؤجلة منذ أمد بعيد، وهو ما أدى عمليًّا إلى استيقاظ أسئلة الشكل المتعلقة بأسلوب الكتابة الشعرية، ولنقل: إن هناك علاقة جدلية بين الطرفين؛ بحيث لا خلاف على أسبقية المضمون على الشكل أو بالعكس، فكل واحد منهما يتسبب في إيقاظ الآخر . قريبًا، ستودّع كثير من الكتابات الشعرية معجمها المعروف والمستخدم حاليًّا وأقصد به اللغة العربية بشكلها الحالي، في إشارة إلى تشكّل معجم جديد يفكُّ عقد التحالف الذي نشأ تاريخيًّا بين النص الغيبي الديني والنص السياسي الاستبدادي، وكل ذلك بفضل الحرب التي أعادت أسئلة الانتماء والهوية والثقافة والذائقة الجمالية إلى الواجهة».
اليوم كما يخبرنا الشاعر قطريب: «سيتولى الشِّعر قيادة المرحلة الجمالية والثقافية القادمة ليعيد صياغة الذهنية والمخيلة السورية التي رزحت طويلًا تحت الاحتلال العربي، والآن نحن أمام حركة تحرر كبيرة يقودها النص الشعري، وهي تأتي تتمة لما فعله شعراء سوريون عظماء في التاريخ بدءًا من المتنبي والمعري وصولًا إلى السيّاب والملائكة والماغوط وأدونيس»!
جزيرة تنمو وسط المحيط
ويقول الشاعر باسم سليمان الذي أصدر خلال الحرب أكثر من كتاب شعري وروائي كان أهمها «تمامًا قبلة»: «الشعر ليس الهدف منه فنيًّا البتة بل سياسيًّا، فالربيع العربي الذي أراد القطع مع الخطاب الثقافي السائد والمتماهي مع السلطة المثار عليها، ذهب مغتربًا في وصف الجيل الشعري الذي نضج وأثمر خلال سنوات الصراع المستمرة، فوصفه بأنه جزيرة تنمو في وسط المحيط لها جملها واستعاراتها ومجازاتها الخاصة، وكأن اللغة ولدت الآن لكن المدقق والمتابع بشكل فني من دون التأثر بتجاذبات الجهويات السياسية المتبناة؛ يستطيع أن يرى التأثير الواضح للأسماء الكبيرة في الشعر السوري على هذا الجيل واستنساخ تجربته وتطويرها، وهذا ليس عيبًا فأمير الشعراء وقف وبكى كما فعل ابن حذام وبالتمعّن أكثر، يكتشف كيف تشتغل الآلة الثقافية السياسية في تعويم الأسماء وتوجيه الخطاب الشعري نحو سوق العرض للاستهلاك التطهيري وفق رؤية أرسطو»!؟

باسم سليمان
ليس ما سبق هو التقليل من المنجز الشعري السوري في سنوات الموت، بل دفاعًا عن الجمال وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التلوث الذي أصاب جوانب الحياة السورية كافة- يعقب الشاعر باسم سليمان مضيفًا: «إن كان من ثورة نقدية مضادة تعيد الشعر السوري إلى ريادته لا بد لها من أن تعترف بأن الشعرية السورية قبل الحرب وخلالها، سواء من ناحية الإيجابيات أو السلبيات- كررت إنتاج ذات المناحي السيئة والترويج لها على أنها الخير الوفير في الشعر السوري الآن، فالقطيعة التي أُمل منها أن تحرِّر الشعر من تجاذبات الجهويات السياسية؛ كي ينتصر لقيم الحق والجمال والخير، أكملت بنفس النسق الذي ثارت عليه».
أين الشعر؟ تتساءل الشاعرة السورية سوزان علي مردفةً: «عناوين كثيرة طُبِعت وتطبع منذ بداية المأساة السورية في الداخل والخارج، ومع إيماني العميق بأن الحرب بفوضاها وموتاها تجعلنا لا نرى، فإن النتاجات الشعرية فاقت أي إنتاج أدبي آخر، مع كل الغرق، مع كل الضبابية التي تحيط بالمشهد، هذا بلا شك ما تدل عليه أغلب النصوص الشعرية التي خلصت إليها السنوات الست الأخيرة في سوريا».
وتضيف سوزان علي: «للحظة تشعر فيها أن الشاعر يرقب ما يجري في الشارع، ثم يبدأ بتدوين أحداثه داخل ورقة في جيبه. تأخذ رحى الحرب مفردات الشعر وتطحنها، لتجرّدها من كل ما ألفناه من الشِّعر السوري».
الكارثة حدثت لنا في الموت، ولم يكن هناك من عمل يوازي هذا القتل- تشرح علي وتضيف: «لأننا في إثرهِ نمشي، نحن لم ننشف بعد، وإن نظرنا خلفنا لن نرى سوى ظلال تتكسر، وكما نضع كفًّا فوق جبهتنا أثناء ظهيرة حادة لنرى بصعوبة، الشعر اليوم يكاد لا يُرى؛ بالمقابل هناك عناوين تمسك خيط الألم من بدايته قبل حتى أن تفتح الكتاب لتقرأ».
كلا إن الشعر لا يلفظ أنفاسه الأخيرة، تقول سوزان علي وتضيف: «إنه يعطي الانطباع بأنه متعب حقًّا كما وصّف الشاعر المكسيكي (أوكتافيو باث) يومًا حال الشعر، فالبلاد متعبة أيضًا، حيث القبور مفتوحة سلفًا، والغبار غدًا سيكون سميكًا فوق الكتب، الوقت يترنح في ظلِّه، والشِّعر ينتظر طارقًا جديدًا يقوده إلى العماء الأول، صافيًا عذبًا كما كان».
شوقي بغدادي: شعراء يتشابهون كأنهم يحبون امرأة واحدة

شوقي بغدادي
الشاعر شوقي بغدادي له رأي مختلف في شعراء اليوم؛ إذ يقول: «الشاعر الحقيقي هو الذي يموت إن لم يكتب، فالشِّعر نابع أولًا وآخرًا من المعاناة الشخصية للكاتب، وهذا ما لا أراه عمومًا عند شعراء اليوم الذين يتشابهون في كتاباتهم وكأنهم يحبون امرأة واحدة أو كأنهم يكتبون من دون أن يعيشوا ويعايشوا ما يؤلفونه من قصائد».
الشعر العربي قديمًا كان له مكان الصدارة لكنه اليوم للأسف يجلس في الصفوف الخلفية من المشهد الثقافي السوري -يضيف بغدادي- فكون الشعر نابعًا من إصغاء الشاعر لصوته الداخلي هذا لا يعني أن تخلص قصيدة اليوم إلى نوع من الهوامات، بل يجب تكوين المناخ النفسي والعاطفي على أساس الصدق في القول الشعري، لا من باب التزيين والاحتفاء بالأفكار الكبيرة؛ بل بالتعويل على أهمية الشكل الفني وضرورته في إبداع النص الشعري المتوازن والمؤسس لإشراقات جديدة في القصيدة العربية المعاصرة». الشعر إذًا هو لغة الروح لا لغة العقل، فليس مطلوبًا من الشاعر أن يكون واعظًا أو داعيًا أو خطابيًّا، بل المطلوب منه أن يكون صادقًا وجريئًا في طرح الشكل الفني وترسيخه في نصوصه، وهذا لا يعني كما يرى بغدادي أن «الشعر الحر هو الصيغة الوحيدة للتعبير؛ إنما هناك الشعر العمودي الذي يعد أيقونةَ الشِّعر العربي، لكن من يستطيع الكتابة اليوم كبدويّ الجبل أو سليمان العيسى، فهؤلاء قلائل جدًّا، ولا يتقنون التعبير بأدوات قصيدة العمود التي لم تندثر لكن شعراءها يعدون على أصابع اليد الواحدة».

 هذه النبوءة هي ما دفعت فيما بعد الكاتب سعد الله ونوس (1941- 1997م) لقراءة المدينة العربية المعاصرة من موقع الفقراء نفسه والشعور بغطرسة المركز على الأطراف، فنصوصه التي استلهمها من التراث العربي، وخصوصًا كتاب الليالي العربية «ألف ليلة وليلة» كانت جميعها تدور أحداثها في مدينة بغداد، على نحو «مغامرة رأس المملوك جابر» و«الملك هو الملك» حيث تحضر المدينة كفضاء للدسائس وحفلات التنكر، وسقوط الأقنعة، وقطع الرؤوس، في حقبة تاريخية وصفها المؤرخون بزمن «الشطار والعيارين» وتحالف السلطة مع عيونها وأصحاب شرطتها وجلاديها على الشعب ومصايره؛ فيما تحضُّر دمشق كمدينة تتألف في نصوص صاحب مقولة «محكومون بالأمل» من سجون ومواخير وأسواق وقلاع كما في مسرحيته «طقوس الإشارات والتحولات». ليصل الصراع إلى أشده في مسرحيته «سهرة مع أبي خليل القباني» النص الذي يعدّ مجابهة صادمة بين العقلية الرجعية وفن المسرح… مجابهة وضعت إشارات استفهام كثيرة على دور المدينة لمسؤولياتها الحضارية، لكنها لا تخلو من حزازات نخبوية مضمرة، تعلن انتماءها لقيم اجتماعية مرموقة، لكنها مواربة في تحديد موقفها من تطاحن «أكثريات ريفية فقيرة» و«أقليات مدن غنية»، وأسبقية سكان الثانية على الأولى. إذًا ليست الأقليات ولا الأكثرية، لا الغالبية المذهبية بل الغالبية السياسية التي تقهقرت عامًا بعد عام، لتجد النزاعات الجانبية ثغرات في هذا الجدار، ولتظهر فروقات هائلة بين عائلات ريفية وأخرى مدينية، أو انتمت إلى المدينة وتقمصت (الدمشقة) في سلوكها الحياتي ومظاهرها العامة، وصولًا إلى سيادة أخلاق السوق، وانهيار كبير للطبقة الوسطى في المجتمع السوري التي كانت تخفف من الغلواء بين جانبي الصراع، ما ظهر جليًّا في ازدياد أحزمة الفقر حول المدن الكبرى، من أحياء عشوائية يقعي فيها حطام هذه الطبقة المتوسطة السورية من متعلمين وحرفيين ومثقفين وعمال وموظفين حكوميين.
هذه النبوءة هي ما دفعت فيما بعد الكاتب سعد الله ونوس (1941- 1997م) لقراءة المدينة العربية المعاصرة من موقع الفقراء نفسه والشعور بغطرسة المركز على الأطراف، فنصوصه التي استلهمها من التراث العربي، وخصوصًا كتاب الليالي العربية «ألف ليلة وليلة» كانت جميعها تدور أحداثها في مدينة بغداد، على نحو «مغامرة رأس المملوك جابر» و«الملك هو الملك» حيث تحضر المدينة كفضاء للدسائس وحفلات التنكر، وسقوط الأقنعة، وقطع الرؤوس، في حقبة تاريخية وصفها المؤرخون بزمن «الشطار والعيارين» وتحالف السلطة مع عيونها وأصحاب شرطتها وجلاديها على الشعب ومصايره؛ فيما تحضُّر دمشق كمدينة تتألف في نصوص صاحب مقولة «محكومون بالأمل» من سجون ومواخير وأسواق وقلاع كما في مسرحيته «طقوس الإشارات والتحولات». ليصل الصراع إلى أشده في مسرحيته «سهرة مع أبي خليل القباني» النص الذي يعدّ مجابهة صادمة بين العقلية الرجعية وفن المسرح… مجابهة وضعت إشارات استفهام كثيرة على دور المدينة لمسؤولياتها الحضارية، لكنها لا تخلو من حزازات نخبوية مضمرة، تعلن انتماءها لقيم اجتماعية مرموقة، لكنها مواربة في تحديد موقفها من تطاحن «أكثريات ريفية فقيرة» و«أقليات مدن غنية»، وأسبقية سكان الثانية على الأولى. إذًا ليست الأقليات ولا الأكثرية، لا الغالبية المذهبية بل الغالبية السياسية التي تقهقرت عامًا بعد عام، لتجد النزاعات الجانبية ثغرات في هذا الجدار، ولتظهر فروقات هائلة بين عائلات ريفية وأخرى مدينية، أو انتمت إلى المدينة وتقمصت (الدمشقة) في سلوكها الحياتي ومظاهرها العامة، وصولًا إلى سيادة أخلاق السوق، وانهيار كبير للطبقة الوسطى في المجتمع السوري التي كانت تخفف من الغلواء بين جانبي الصراع، ما ظهر جليًّا في ازدياد أحزمة الفقر حول المدن الكبرى، من أحياء عشوائية يقعي فيها حطام هذه الطبقة المتوسطة السورية من متعلمين وحرفيين ومثقفين وعمال وموظفين حكوميين.